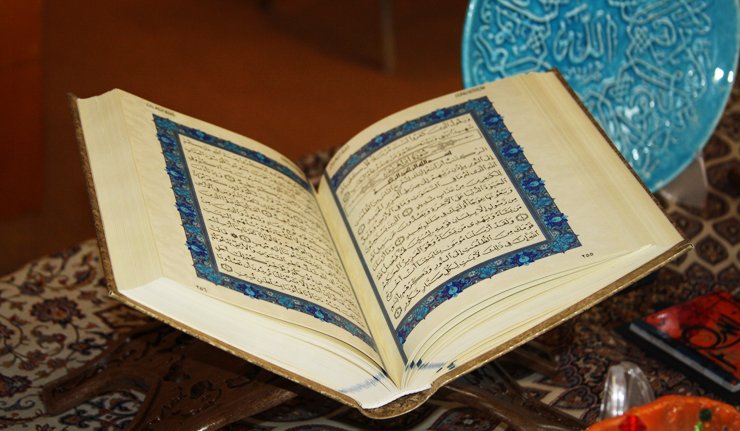فاعلية القانون الدولي في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير: “حالة فلسطين أنموذج”

اعداد : عبد المحسن خضر علامة – مرشح لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة قرطاج، تونس – وحدة الدراسات الدولية، معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، رام الله، فلسطين
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص :
تتناول الدراسة فاعلية القانون الدولي في تنفيذ مبدأ حق تقرير المصير، مع التركيز على الحالة الفلسطينية. تم اعتماد منهجية التحليل النصي لقرارات الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي والمنهج المقارن مع حالات مشابهة مثل كوسوفو وجنوب إفريقيا، هدفت الدراسة الى تحليل الإطار القانوني الدولي والتاريخي لتطور مبدأ حق تقرير المصير منذ عهد عصبة الأمم مع مقارنة الحالة الفلسطينية بحالات مشابهة، تسليط الضوء على دور الهياكل في انفاذ القانون. توصل الباحث الى عدة نتائج اهمها أن ضعف الآليات التنفيذية وازدواجية المعايير الدولية خاصة استخدام الفيتو يُعدان العائق الرئيسي أمام تحقيق الاستقلال الفلسطيني، رغم الاعتراف الواسع بحقهم القانوني. كما كشفت الدراسة عن تناقض بين المبادئ النظرية والممارسة العملية، حيث تُهيمن الاعتبارات الجيوسياسية على التفسير القانوني.كما تُظهر النتائج أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مثل التوسع الاستيطاني والعزل الجغرافي، تُعرقل تطبيق المبدأ، بينما تفتقر المنظومة الدولية إلى الإرادة السياسية للمحاسبة. تقدم الدراسة توصيات لتعزيز فاعلية القانون الدولي عبر إصلاح هياكل صنع القرار الدولية وتبني آليات مساءلة أكثر صرامة.
المقدمة :
يُشكّل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ركيزة أساسية في القانون الدولي، إذ يمنح الجماعات الخاضعة للاحتلال أو الاستعمار حقها في الاستقلال والسيادة، استناداً إلى مواثيق دولية كأحكام ميثاق الأمم المتحدة. لكن تطبيقه الفعلي يُواجه تحدياتٍ كبيرة، أبرزها ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب، وضعف الآليات التنفيذية رغم التزام الدول نظرياً باحترام الحقوق الإنسانية وحماية الحريات دون تدخل خارجي[1].
وتظل القضية الفلسطينية الاختبار الأكثر تعقيداً لفاعلية القانون الدولي، خاصة بعد تصاعد العنف بعد احداث أكتوبر 2023، والتي عمّقت الصراع العربي الإسرائيلي. حيث تواجه فلسطين سياساتٍ استيطانية وعزلاً جغرافياً وديموغرافياً في القدس، غزة والضفة الغربية مما يعكس فشل المنظومة الدولية في تحقيق العدالة أو محاسبة الاحتلال، رغم المحاولات الفلسطينية اللجوء إلى آليات قانونية دولية. يُظهر التعامل مع القضية الفلسطينية ازدواجية تهدد مصداقية القانون الدولي، إذ تتعارض المبادئ النظرية مع الواقع المعيشي، حيث تتحول فلسطين إلى رمزٍ للنضال المشروع من أجل إنهاء الانتهاكات العالمية وإثبات سيادة القانون.
أهمية الدراسة
تأتي اهمية الدراسة الأهمية العلمية كونها تساهم في إثراء الأدبيات القانونية من خلال التحليل النقدي لفجوة النصوص الدولية والواقع السياسي المتعلقة بمبدأ حق تقرير المصير من خلال كشف التناقض بين النصوص الدولية (كالمادة 1/2 من ميثاق الأمم المتحدة) والممارسة العملية وتحليل الإشكالية الفلسطينية كحالة دراسية لفشل الآليات التنفيذية، بالإضافة الى ذلك الدراسة تقدم الدراسة تطوير إطار نظري لربط مبدأ تقرير المصير بالأبعاد الاقتصادية والثقافية، وليس السياسية فحسب الى جانب تقديمها تحليلا لفاعلية مبدأ حق تقرير المصير في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة.
تبرز الأهمية العملية للدراسة كونها تساعد نتائجها لتقديم رؤى قانونية وسياسية لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتعزز فرص تطبيقه.
إشكالية الدراسة واسئلتها
تُسلط هذه الدراسة الضوء على الإشكالية المركزية لفاعلية القانون الدولي في ظل هيمنة القوى العظمى، باستخدام الحالة الفلسطينية نموذجاً. فبينما يُكرس المبدأ قانونياً، تتحول تفسيراته إلى أدوات سياسية تُعيق تحقيق العدالة.
يقودنا هذا الى طرح السؤال الرئيس والتي ستحاول الدراسة الاجابة عنه، وهو :
“مدى قدرة الآليات التنفيذية للقانون الدولي على فرض تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الحالة الفلسطينية؟” في ظل تنامي الانتهاكات الإسرائيلية وتراجع الإرادة السياسية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية في سعي الدراسة للإجابة عن السؤال الاساسي، ينبثق عنه عدة تساؤلات سنحاول في بحثنا الاجابة عن التالية:
- الى أي مدى تعتبر آليات القانون الدولي كقرارات مجلس الأمن كافية لتحقيق تقرير المصير؟
- ما مدى التزام إسرائيل بالقرارات الأممية المتعلقة بفلسطين؟
- الى أي مدى أثرت التحالفات الجيوسياسية على تفسير المبدأ؟
- كيف يمكن تعزيز فاعلية الآليات الدولية لمحاسبة الاحتلال؟
اهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي لمبدأ حق تقرير المصير، تقييم فاعلية المبدأ في تحقيق الاستقلال الفلسطيني، تحديد العقبات السياسية والقانونية التي تعيق التطبيق وتقديم توصيات لتعزيز دور القانون الدولي في دعم القضية الفلسطينية بالإضافة الى الاهداف الفرعية للدراسة التي يمكن ذكر بعضها.
- تتبع التطور التاريخي لمبدأ تقرير المصير في المواثيق الدولية.
- تحليل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ومدى التزامها بالقرارات الأممية.
- مقارنة الحالة الفلسطينية بحالات دولية مشابهة (كوسوفو، جنوب إفريقيا).
- تقييم دور الهياكل الدولية (مجلس الأمن، محكمة العدل) في إنفاذ القانون.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية (ميثاق الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن، آراء محكمة العدل الدولية).استقراء التطبيقات العملية للمبدأ في حالات مشابهة مثل كوسوفو وجنوب إفريقيا ودراسة الوثائق التاريخية المتعلقة بالانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.
1. مبدأ حق تقرير المصير في القانون الدولي
يُشكّل مبدأ حق تقرير المصير أحد الركائز الجوهرية في القانون الدولي، لكن غموض تعريفه وتعدد تفسيراته يُثير إشكاليات تطبيقية. سنستعرض في هذا المحور التطور التاريخي للمبدأ وأبعاده المتعددة، مع تحليل طبيعته القانونية والإلزامية.
1.1 الإطار النظري لمبدأ حق تقرير مصير الشعوب
برز المفهوم من خلال تعريفه “لجميع الشعوب الحق الثابت في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون تدخل خارجي، ونظرا للفترة التاريخية التي مر فيها المفهوم الى ان اقر في الامم المتحدة فقد تعددت مقاربات المبدأ ومضامينه نظرا لاختلاف المنطلقات والمصالح السياسية وتباين وجهات نظر الفقهاء ولكن المدلول يصب في تحرير الشعوب من الاستعمار والاستقلال بناءاً على الاطر الدولية[2].
1.1.1 المفاهيم والمرتكزات القانونية
تُعاني مسألة تحديد مفهوم حق تقرير المصير من إشكالية قانونية وفقهية، حيث تعددت التعريفات دون بلورة إطارٍ موحدٍ يُجمع عليه دولياً يعود هذا التباين إلى اختلافات فقهية واسعة بين خبراء القانون الدولي، فضلاً عن غياب تعريفٍ جامعٍ في الميثاق الأممي، الذي اقتصر على الإشارة إليه بشكلٍ عابرٍ في المادة (1 / ف (02) والمادة (55)، دون توضيحٍ لمضامينه أو تحديد المستفيدين منه[3].على الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة قرارات تؤكد هذا الحق، فإنها لم تُقدِّم توضيحاً قانونياً دقيقاً لمعناه أو آليات تطبيقه، مما فتح الباب أمام تناقضاتٍ في التفسير، وأثار خلافاتٍ مستمرة حول مدى انعكاسه على الممارسات الدولية، لا سيما في سياق النزاعات المرتبطة بالسيادة والاستقلال[4].
عرف مبدا حق تقرير المصير بأنه “لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيره دون أي تدخلات خارجية بكافة جوانبه الداخلية، الخارجية والدولية”[5]، وانه من المبادئ الاساسية التي يقوم عليه القانون الدولي والعمل على الساحات الدولية ونظرا لحالة الاستعمار التي شملت دول كثير من العالم فقد ارتبط المفهوم بالشعوب من اجل نيلها استقلالها واصبح مبدأ لا يجوز تجاهله عالميا[6]. فحسب توماس جفرسون يعرفه ان لكل امة الحق في حكم نفسها والتغيير كما شاءت[7]، اما كوبان الفريد فقد عرفه بانه حق لكل امة في ان تكون ذات كيان مستقل وتقرير مصير شؤونها بنفسها، أما الفيلسوف السوفيتي “كريلو” فقد عرفه في انه حق كل امة في اختيار شكل نظامها السياسي ومستقبلها وحق الانفصال عن الدولة التي تشكل جزء منها وتشكل دولة جديدة[8]. اما لينين يقول” ان حق الامم يعني حقها في الاستقلال بالمعنى السياسي والحرية في الانفصال عن الامة المضطهدة[9].
1.1.2 الطبيعة القانونية والإلزامية
شكّل النظام الدولي الذي أقامته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى إطاراً قانونياً مهدراً لحق الشعب الفلسطيني، عبر توظيف الانتداب البريطاني (1922) لتمكين المشروع الصهيوني، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى سلسلة ثورات (1920–1939) رفضاً لتحويل فلسطين إلى “وطن قومي لليهود”.
مع تأسيس الأمم المتحدة (1945)، تحوّل الموقف الدولي تدريجياً لصالح الحقوق الفلسطينية، بدءاً من قرار التقسيم رقم 181 (1947) الذي اعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وصولاً إلى القرار 1514\1960) الذي كرّس إنهاء الاستعمار، وأسفر عن استقلال أكثر من 40 إقليماً[10].
توالت القرارات الأممية المؤكدة على حق تقرير المصير الفلسطيني، مثل القرار 2672 \1970، والقرار 3236\1974) الذي اعتبره حقاً “غير قابل للتصرف”، وصولاً إلى القرارات الحديثة كـ76/150 (2021). كما أكدت المادتان (1) و(55) من ميثاق الأمم المتحدة[11]، والمادة 11 المشتركة بين العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والاقتصادية والاجتماعية (ICESCR) على أن هذا الحق يشمل السيادة الكاملة على الأرض والموارد، والقدرة على “تحقيق الانماء الحر”، دون تأثر بالاحتلال[12].
يتميز المجتمع الدولي بطبائع قانونية وسياسية واجتماعية وثقافية تختلف عن المجتمعات الوطنية، مما يفرض تفوق النظام القانوني الدولي على النظم الوطنية في تنظيم العلاقات بين الدول. وفي هذا السياق، تُطرح إشكالية فاعلية القانون الدولي العام عبر محورين رئيسيين:
لم يقدم القانون الدولي التقليدي الطبيعة القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل انه لم يتجاوز حدود انه مبدأ سياسي في تأثيره على الحكومات دون التزام، وغطى الغموض القرارات والمواثيق المتعلقة بذلك[13]، بناءا على هذا فقد كثرت التساؤلات حول اعتباره حقا او مبدأ استعماري هدفه انهاء الوضع الاستعماري، كل ذلك انتج فريقين احدهما ينكر الحق بصفته وطبيعته القانونية والزاميته[14].
الفريق الاول: يرى الاتجاه الاول ان المبدأ لا يتجاوز انه مفهوم سياسي يضع حد لوضعيه الاستعمار ولم ينتج صياغة قاعدة قانونية مستندين الى المادة 1، 55 من ميثاق الامم المتحدة الذين تم تفسيرهما في عدم تحديد المادتين في اقرار مفهوم حق تقرير المصير بذاته في تامين احترام مفهوم السيادة الوطنية كسبيل لاختيارات الشعوب في اختيار النظام السياسي[15].
الفريق الثاني: يرى الفريق الثاني انه مبدأ ملزم ويحمل طبيعة قانونية حسب نص الفقرة 2 من المادة 1 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على المساواة والحقوق وبهذا يكون مبدأ قانوني ويرتكز عليه في تنظيم الدول والساحات الدولية كمبدأ يحظر استعمال القوة في نسق العلاقات الدولية او التدخل في شؤونها الداخلية والخاصة وفيه تجسيد للحقوق القابلة لإنشاء التزام قانوني دولي[16] حسب المادة 56 الملزمة لكافة الاعضاء بالوفاء بالتزاماتها الناتجة الطبيعية من نصوص الميثاق في حق تقرير المصير بالإضافة الى ان المبدأ نشأ في سياق دمقرطة العلاقات السياسية بين الدول على اساس ان لكل دولة حدود واقليم ونظام قائم على الارادة الحرة للشعوب وهو ما يذهب اليه اغلب القانونيين الدوليين في تحرير الشعوب الخاضعة تحت الاستعمار الاجنبي[17].
يستنتج من ذلك ان مبدأ حق تقرير المصير احد المبادئ الاساسية الذي تجاوز حدود الصفة الاخلاقية والسياسية فقط، بل انه كباقي قواعد القانون الدولي الذي يمنع استعمال القوة او التهديد باستخدامها والاعتماد على التسوية السلمية في حل النزاعات، اضافة لكل ما سبق اذا يعتبر من القواعد القانونية الآمرة ويشكل حجر اساس في حياة الدول والسلم المجتمعي الدولي المعاصر كونه ذات طبيعة سياسية وقانونية في حماية الشعوب من السيطرة الاجنبية بهدف الغاية النهاية الاستقلال ودحر الاحتلال.
1.2 أبعاد واشكالات الهيمنة على مبدأ حق تقرير المصير
يتكون مبدأ حق تقرير المصير من مجموعة متكاملة من الحقوق غير القابلة للتجزئة، تشمل البُعد السياسي الذي يتمثل في السيادة الكاملة على الأراضي، بالإضافة إلى البُعد الاقتصادي المتعلق بالتحرر من التبعية، وصولًا إلى البُعد الثقافي الذي يدعم الهوية الوطنية. ومع ذلك، يظل تنفيذ هذه الأبعاد معتمدًا على تفاعلات معقدة تفرضها التوازنات الجيوسياسية، ما يحول المبدأ من إطار قانوني ثابت إلى ساحة للصراع الدولي حول تفسيراته واستخداماته.
1.2.1 البعد الداخلي والخارجي
يتمثل في حق الدولة في السيادة على إدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي، وهو حق تكفله المواثيق الدولية كالمادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة، ويُكرَّس عملياً عبر الدساتير الوطنية وممارسة الديمقراطية[18]. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 (1960) على حماية هذا الجانب عبر مبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية[19]“.
اما فيما يتعلق بالبعد الخارجي فانه ينطبق على الشعوب الواقعة تحت الاستعمار أو الاحتلال، ويضمن لها الحق في اختيار مصيرها عبر خيارات محددة كـ الاستقلال الكامل كما في حالة فلسطين، أو الاندماج مع دولة أخرى مثل حالة تيمور الشرقية مع اندونيسيا سابقا، أو تشكيل كيان اتحادي كحل الدولتين[20].
1.2.2 حدود البُعد الخارجي واستثناءات الانفصال
يستثنى من هذا الحق المطالبة بالانفصال داخل الدول المستقلة (مثل كتالونيا في إسبانيا)، حفاظاً على مبدأ “السلامة الإقليمية” الوارد في الميثاق الأممي.
ينطبق على الحالة الفلسطينية مثال رفض المجتمع الدولي طلب إسرائيل بضم القدس الشرقية (القرار 478) كونه انتهاكاً للبُعد الخارجي للحق داخل الدول المستقرة ذات السيادة، حفاظاً على مبدأ وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية[21]. فقد أسست الأمم المتحدة لجاناً لتصفية الاستعمار مثال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، مستندة إلى الفصل الحادي عشر من الميثاق، والذي يُلزم الدول المستعمرة باحترام إرادة الشعوب، ويرفض الاعتراف بأي ضمٍّ إقليمي ناتج عن استخدام القوة، حتى لو تم تحت مبررات القانون الدولي التقليدي الذي كان يُجيز الغزو[22].
1.2.3 البُعد الاقتصادي “حق السيادة عالموارد ومحاربة التبعية”
لا يقتصر حق تقرير المصير على الاستقلال السياسي، بل يشمل التحرر الاقتصادي، إذ تُدرك الدول النامية أن الاستقلال السياسي يفقد قيمته دون سيادة على الموارد الطبيعية[23].
حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المبدأ في قرارها رقم 1803 (1962) تحت عنوان “السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية”، والذي ينص على:” حق الشعوب في استغلال ثرواتها لتحقيق تنميتها الوطنية”، اضافة لتنظيم استيراد رأس المال الأجنبي وفق شروط تتفق مع إرادة الدولة[24].
كما عزز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دوراته (1964، 1972) هذه الفكرة، مُشدِّداً على: ربط التحرر السياسي بالاقتصادي، واعتبار الضغوط الاقتصادية شكلاً من انتهاكات حق تقرير المصير وحق الدول في تبني سياسات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية[25].
وتكمن الإشكالية في العلاقة الجدلية بين الاستعمار السياسي والاقتصادي؛ فوجود أحدهما يُنتج الآخر، مما يستلزم تصفية الآثار الاقتصادية للاستعمار لضمان استقلال حقيقي. وهذا ما ينطبق في السياق الفلسطيني “يفرض الحصار الإسرائيلي على غزة (منذ 2007) شكلاً من العقاب الجماعي، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35%، وارتفاع معدل البطالة إلى 70%، مما ينتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة[26].
1.2.4 بُعد حماية الموروث والهوية
يُعنى بحق الشعوب والأقليات في اختيار النظم الاجتماعية التي تتناسب مع عاداتها وقيمها، دون فرض نماذج خارجية. وقد أكد قرار الجمعية العامة رقم 2546 (1969) على أن السلام العالمي مرهون بتحقيق التقدم الاجتماعي، وربط بين التنمية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان يأتي تأكيد القرار انه مرهون بالتقدم الاجتماعي”، وهو ما يتجلى في حق الفلسطينيين في مقاومة التهويد الثقافي للقدس[27].حيث نص إعلان اليونسكو (1966) على حماية التراث اللغوي والديني، وهو ما تنتهكه إسرائيل عبر تدمير المواقع الأثرية الفلسطينية كما جاء في إدراج اليونسكو عام 2017 البلدة القديمة في الخليل كموقع تراثي فلسطيني تحت التهديد.
يشمل حق الشعوب في الحفاظ على تراثها اللغوي والفني والديني، وهو ما نص عليه إعلان اليونسكو للتعاون الثقافي الدولي (1966)، وقرار الأمم المتحدة رقم 3148 (1973) بشأن الحفاظ على القيم الثقافية. ويُعد هذا الحق أداة لاحتواء مطالب الانفصال، عبر تلبية تطلعات الأقليات الثقافية في إطار الدولة الواحدة حيث ويُبرز هذان البُعدان أن تقرير المصير ليس مجرد تحرر من الاستعمار، بل ضمانٌ لاستمرارية الهوية الجماعية[28].
1.3 اشكالات الهيمنة وازدواجية المعايير
رغم ترسيخ المبدأ قانونياً، تظل الفجوة بين النظرية والتطبيق واسعة، سيناقش الباحث في هذا المحور إشكالية التفسير الانتقائي للقواعد الدولية، وتأثير ازدواجية المعايير على مصداقية القانون الدولي.
1.3.1 الإشكاليات القانونية والتحديات التطبيقية
يُمثّل تحديد معنى القاعدة القانونية الدولية مرحلة جوهرية تلي إثبات وجودها وترتبط بتفكيك مضمونها لاستخلاص الحقوق والالتزامات الناشئة عنها. غير أن عملية التفسير تواجه تحدياتٍ بنيوية بسبب طبيعة الصياغات القانونية الدولية، التي غالباً ما تتسم بالغموض أو التناقض، مما يُثير خلافاتٍ بين الأطراف حول المدلول الدقيق للنصوص. وعلى عكس الأنظمة القانونية الوطنية، يفتقر القانون الدولي إلى مبادئ تفسيرية مُلزمة، إذ تعتمد العملية على اجتهادات فنية مستمدةٍ من أعراف تاريخية (كالقانون الروماني) أو ممارسات دولية غير مُوحَّدة، ما يسمح بتأويل النصوص وفقاً لمصالح القوى المُهيمنة[29].
ويُعزى هذا الإشكال إلى طبيعة التشريع الدولي نفسه، حيث تُعد الدول والمنظمات الدولية – كأشخاصٍ قانونيةٍ أصلية – هي المُنشئة للقواعد والمخوَّلة بتفسيرها، دون وجود سلطةٍ قضائيةٍ فوقيةٍ تُلزم الجميع بتأويلٍ موحَّد. فالدول الكبرى، عبر سيطرتها على صياغة النصوص (كالمواثيق وقرارات مجلس الأمن)، تتعمّد استخدام مصطلحاتٍ فضفاضةٍ تتيح لها لاحقاً توجيه التفسير لصالح أجنداتها، كما في حالات تبرير التدخلات العسكرية تحت مسمياتٍ مثل “حماية المدنيين” أو “الديمقراطية”، بينما تُنكر تطبيق النصوص نفسها في سياقاتٍ أخرى تتعارض مع مصالحها[30].
1.3.2 التوازنات الجيوسياسية
تُمثّل إشكالية تفسير القواعد الدولية مثالاً صارخاً في حالة “حق تقرير المصير”، الذي تحوّل من مبدأٍ سياسي غامضٍ بعد الحرب العالمية الأولى إلى حقٍ مُعترفٍ به في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1/2). لكن غياب تعريف واضحٍ لـ”الشعب” المُستحق لهذا الحق (هل هو الكيانات الخاضعة للاستعمار أم الجماعات الإثنية؟) أدى إلى انقسام فقهي وسياسي.
ففي الوقت الذي دعمت فيه دولٌ غربية انفصال كوسوفو استناداً إلى هذا المبدأ، رفضت تطبيقه على كتالونيا أو فلسطين، مما يُظهر تناقضاً يعكس هيمنة التوازنات الجيوسياسية على التفسير القانوني.
تشهد المنظومة الدولية أزمة عميقة في تحديد المفاهيم القانونية الأساسية، مثل “حق تقرير المصير”، الذي يظل غامضاً رغم كونه مبداً جوهراً في ميثاق الأمم المتحدة (المادتان 1/2 و55). يُعزى هذا الغموض إلى غياب تعريفٍ دولي مُوحَّد، واختلاف الفقهاء حول طبيعته (حق فردي أم جماعي؟)، ومَنْ يحق له المطالبة به (الشعوب المُستعمَرة فقط أم الجماعات الإثنية؟). هذا الالتباس يُسهّل على القوى العظمى توظيف المبدأ لخدمة أجنداتها، كدعم انفصال كوسوفو تحت ذريعة حق تقرير المصير، بينما تُنكره على كتالونيا أو فلسطين، مما يُظهر تناقضاً صارخاً في التطبيق[31].
فالقانون الدولي، الذي يُفترض أنه يعكس إرادة جماعية لتحقيق العدالة، يتحول إلى أداةٍ انتقائية تُكرس هيمنة الدول الكبرى، خاصة عبر آلية الفصل السابع من الميثاق، الذي يُخوِّن مجلس الأمن – المهيمَن عليه من قبل الدول دائمة العضوية – استخدام القوة لفرض قراراته[32].
1.3.3 ازدواجية المعايير وهيمنة القوى العظمى
تعتمد الدول الكبرى سياسية انتقائية في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير؛ فالاتحاد الأوروبي يدعم حق أوكرانيا ضد روسيا، بينما يتغاضى عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين رغم عشرات القرارات الأممية. هذه الازدواجية تُبرز أن “التفسير القانوني” ليس عملية محايدة، بل أداة لترسيخ هيمنة القوى العظمى، حيث تُحوَّل المبادئ الدولية إلى أدواتٍ مرنة تُستخدم وفقاً للحظة السياسية، لا كضوابط أخلاقية ملزمة[33].تتعمق الأزمة مع ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات؛ فبينما تُفرض عقوباتٌ صارمة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، تُغض الطرف عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 1967، رغم صدور أكثر من 100 قرار أممي يدينه، ويُعتبر مثالاً صارخاً على انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. بل إن الولايات المتحدة، كعضو دائم في مجلس الأمن، تستخدم حق النقض (الفيتو) بشكل منهجي لحماية إسرائيل من أي مساءلة، بينما تُدين انتهاكات مماثلة لدولٍ أخرى[34]. هذا التفاوت لا يعكس فشلاً في القانون نفسه، بل في النظام السياسي الذي يحكم تطبيقه، حيث تُهيمن المصالح الجيوسياسية على المبادئ الإنسانية، وتتحول “الشرعية الدولية” إلى غطاءٍ لسياسات الهيمنة.
شكّل الانتداب البريطاني انتهاكاً صارخاً للهدف الأساسي من نظام الانتداب (المادة 22)، الذي كان يفترض أن يكون مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقلال، لا تكريساً للاستعمار الاستيطاني. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الجدار العنصري (2004) أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حقٌ “ملزمٌ للجميع بموجب القانون الدولي”، مستنداً إلى الشرعية التاريخية المُمتدة من عهد عصبة الأمم، والتي لم تُلغها تشكيلات ما بعد 1945، بل عززها ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1/2) الى ذلك فان تسييس المادة (11) من الصك والتي سمحت لبريطانيا بـ”تشجيع الهجرة اليهودية”، لكنها حوّلتها إلى آلية لتمكين المشروع الصهيوني عبر فتح الباب للهجرة اليهودية المكثفة، وتمليك الأراضي لليهود، وتسهيل تشكيل الميليشيات الصهيونية (كـ الهاغانا)، التي ارتكبت جرائم تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.
رغم ترسيخ حق تقرير المصير في القانون الدولي عبر عشرات القرارات منها(1514، 1803، 2625)، إلا أن تطبيقه يواجه إشكالياتٍ جوهريةً كممارسة الدول الكبرى ازدواجية في تطبيق المبدأ إلى جانب العقوبات الأحادية أو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات لتكريس التبعية.
واخيرا فان إشكالية التفسير التي تتمثل في غياب تعريفات دقيقة لـ”الشعب” أو “السيادة” يسمح بتوظيف المبدأ لخدمة أجندات الدول الخارجية[35]. في هذا السياق تُستمد فاعلية القانون الدولي من كونه نظاماً تعاقدياً قائماً على إرادة الدول، حيث تُعد المواثيق الدولية (مثل ميثاق الأمم المتحدة) الإطار الرئيسي لتنظيم السلوك الدولي. فالمادة (2/4) من الميثاق تُحرِّم استخدام القوة في العلاقات الدولية، بينما تُجيز المادة (51) الحق في الدفاع الشرعي. كما أن المادة (1/1) تُؤكد أن حفظ السلم والأمن الدوليين هو الهدف الأساسي للأمم المتحدة.
في سياق متصل تعتمد فاعلية قواعد القانون الدولي على شروط موضوعية وإجرائية، أهمها نبذ الحرب كأداة لتسوية النزاعات حيث أضحى تحريم الحرب مبدئاً ملزماً بموجب المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، لا مجرد التزام أخلاقي. وقد عززت هذه القاعدة تطورات تاريخية كارتفاع كلفة الحروب الحديثة (كالأسلحة النووية والإلكترونية)، مما جعل اللجوء إليها يُهدد الوجود البشري نفسه[36].
2. عقبات وآفاق فاعلية القانون الدولي المستقبلية
في ظلّ تعثُّر الآليات التقليدية للقانون الدولي في إنفاذ مبدأ حق تقرير المصير وامكانية تجاوز العقبات الهيكلية التي تُكرس هيمنة القوى العظمى وتُعيق تحقيق العدالة، هذا الجزء سوف يناقش التحديات التي تواجه فاعلية القانون الدولي، مع استكشاف الحلول المُبتكرة التي قد تعيد التوازن لصالح الشعوب المُضطهَدة، عبر تحالفات دولية جديدة وآليات مساءلة غير تقليدية.
لا يمكن تجاوز العقبات دون فهم البنية الهيكلية للنظام الدولي. سنستكشف في هذا المحور التحديات الهيكلية، وآفاق الإصلاح لتحقيق توازنٍ عادلٍ بين القانون والسياسة.
1.4 تحديات هيكلية لفاعلية القانون الدولي
أدت التحولات الجيوسياسية (كانهيار الاتحاد السوفيتي 1991) إلى نظام أحادي القطبية تهيمن فيه الولايات المتحدة، التي تتدخل عسكرياً (كما في أفغانستان 2001، ليبيا منذ 2011 وحتى يومنا هذا) دون تفويض أممي كامل، متذرع بمفاهيم فضفاضة مثل “مسؤولية الحماية”. هذه الممارسات تُناقض المادة (2/1) من الميثاق، التي تُؤكد سيادة الدول، وتعكس اختلالاً في توازن القوى ويُضعف فاعلية القانون[37].
1.4.1 البنية الهيكلية للمجتمع الدولي “من التراتبية إلى إعادة التشكيل”
لا يمكن فهم أزمة فاعلية القانون الدولي دون تحليل البنية الهيكلية للمجتمع الدولي، القائمة على تراتبية غير متوازنة بين دول “المركز” المُسيطرة على صنع القرار (مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا)، ودول “الأطراف” المُهمَّشة التي تُعاني من تبعية سياسية واقتصادية[38].
فحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، الذي تمتلكه خمس دول فقط، يُكرس هذه التراتبية ويسمح بتعطيل أي قرارٍ يمس مصالحها، حتى لو كان يدعمه أغلبية المجتمع الدولي. هذا الخلل البنيوي ينعكس على مؤسسات العدالة الدولية؛ فمحكمة العدل الدولية، رغم كونها الذراع القضائي للأمم المتحدة، تظل عاجزة عن تنفيذ أحكامها ضد دولٍ كبرى، كما في قضية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي (2004)، التي تجاهلتها إسرائيل بدعم أمريكي[39].
وتتجاوز الأزمة الجانب السياسي إلى الاقتصادي؛ فالنظام المالي العالمي، المُهيمَن عليه من قبل الدولار الأمريكي، يُستخدم كأداةٍ للعقاب الجماعي، كما في العقوبات الأحادية على إيران أو فنزويلا، والتي تُسبب معاناة إنسانية دون سندٍ قانوني دولي. حتى المنظمات الدولية المُختصة، مثل منظمة التجارة العالمية، تُعاني من انحيازٍ هيكلي لصالح الدول الصناعية، التي تُفرض شروطها على الاقتصادات الناشئة. وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إصلاح جذري للمنظومة الدولية، يشمل إلغاء حق النقض، وتوسيع تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن، وربط الشرعية الدولية بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لا بموازين القوة[40].
لكن أي إصلاحٍ يبقى رهيناً بإرادة الدول الكبرى، التي تُقاوم التخلي عن امتيازاتها. لذلك، تُشكل الحركات الدولية التي تنادي بتحقيق “ديمقراطية عالمية”، ومبادرات دول الجنوب (مثل مجموعة الـ77)، أملاً في إعادة تشكيل النظام الدولي ليكون أكثر إنصافاً، حيث تُصاغ القواعد القانونية بشراكةٍ حقيقية، وتُنفذ بآلياتٍ تتجاوز منطق الهيمنة القديم[41].
1.5 المرتكزات القانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
يستند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى مرتكزين رئيسيين في القانون الدولي:
1.5.1 المرتكز السياسي
يتمثل في حريته في اختيار نظامه الدستوري، وممارسة السيادة الكاملة على إقليمه (بما يشمل القدس الشرقية)، والاستقلال عن أي سيطرة خارجية، وفقاً لمبدأ تقرير المصير المُكرس في المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1514 \ 1960.
1.5.2 المرتكز الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
يشمل الحق في السيطرة على الموارد الطبيعية (كالمياه والأراضي)، وحرية التنمية الاقتصادية دون عوائق، وحماية الهوية الثقافية، كما أكدت ذلك المادة (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ICESCR) والقرار 1803 \1962 الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد[42].
1.5.3 المعايير الدولية كأساس للحل
لا يمكن لأي مفاوضات سياسية أن تحقق سلاماً عادلاً دون استيفاء شرطين جوهريين اولهما الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها السيادة على الموارد وحرية التنمية، وهو ما يتطلب تفكيك المستوطنات وإنهاء الحصار المفروض على غزة. هذه المبادئ تُشكل الإطار الوحيد المقبول دولياً لحل النزاع، كما أكدته خارطة الطريق 2003 ومبادرة السلام العربية 2002.
1.6 مبادرات التصويت ضد إسرائيل في هيئة الأمم “تجربة جنوب إفريقيا”
برزت دول الجنوب، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، كفاعلٍ رئيسي في تحدي الانحياز الغربي داخل المنظومة الدولية، حيث حوَّلت تجربتها التاريخية في النضال ضد الأبارتايد إلى دعمٍ فعّال للحقوق الفلسطينية. تُشكّل هذه المبادرات محاولةً لإعادة تعريف دور القانون الدولي كأداةٍ لتحقيق العدالة، بدلًا من أن يكون غطاءً لاستمرار الهيمنة، عبر توظيف آلياتٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ تعكس صوت الشعوب المهمشة.”
1.6.1 الابعاد التاريخية والجيوسياسية للمبادرة
تعتبر جنوب إفريقيا رمزاً للنضال ضد التمييز العنصري، نظراً لتاريخها في مقاومة نظام الأبارتايد، وهو ما يمنحها شرعية أخلاقية لدعم القضية الفلسطينية. فكثير من التقارير الدولية، مثل تقرير “هيومن رايتس ووتش” (2021) ، تشير إلى تشابه سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة مع نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا. هذا التشابه دفع جنوب إفريقيا إلى تبني موقف متصلب ضد إسرائيل، حيث صوتت ضدها في ٨٥% من القرارات الأممية منذ عام 1994. يُعزى هذا الموقف إلى إدراك عميق بأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ليس مجرد نزاع إقليمي، بل قضية عدالة عالمية ترتبط بحقوق الإنسان الأساسي[43].
سعت جنوب إفريقيا إلى مواجهة الهيمنة الغربية، منتقدة ازدواجية المعايير في تعامل الدول الغربية مع إسرائيل يذكر ان جنوب إفريقيا انضمت إلى تحالفات دول الجنوب مثل مجموعة الـ77 والصين، والتي تضم 134 دولة بهدف تعزيز صوت الدول النامية في الأمم المتحدة. كما لعبت دوراً محوراً في تنسيق المواقف مع دول مثل البرازيل والهند، ومن خلال منصات مثل تجمع البريكس حيث تصوت هذه الدول بشكل متكرر لصالح القرارات المؤيدة لفلسطين[44].
1.6.2 التصويت على القرار 77/247
صوتت جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023 لصالح القرار الأممي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، والذي حظي بتأييد 145 دولة. أصدرت جنوب إفريقيا بياناً وصفت فيه الاستيطان بـ”جريمة حرب” وفقاً لنظام روما الأساسي. ومع ذلك، واجه هذا القرار معارضةً من إسرائيل والولايات المتحدة، التي استخدمت الفيتو ضد قرارات مماثلة في مجلس الأمن. يُظهر هذا التصويت الانقسام الحاد بين دول الجنوب المدافعة عن الشرعية الدولية، والقوى الغربية الحامية لمصالح إسرائيل[45].
يشار الى ان جنوب إفريقيا استندت في مبادراتها إلى القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948) [46] واتفاقية جنيف الرابعة (1949) [47]. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في يناير 2024، قدمت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بانتهاك المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة. كما استشهدت بالمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القسري للسكان، في إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. هذا النهج القانوني يعكس استراتيجية لتحويل الصراع من مجال سياسي إلى قضية عدالة دولية.
1.6.3 حدود وتحديات المبادرة
تواجه دول الجنوب ضغوط اقتصادية وسياسية لثنيها عن دعم فلسطين. فعلى سبيل المثال، تعرضت جنوب إفريقيا لعقوبات غير مباشرة، مثل تخفيض الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات الزراعية منها. بالإضافة إلى ذلك، هناك انقسامات داخلية، كالجدل الدائر بين الحكومة والجاليات اليهودية الموالية لإسرائيل. ورغم هذه التحديات، تظل فاعلية التصويت الأممية محدودة في ظل غياب آليات تنفيذية لإجبار إسرائيل على الامتثال[48].
حققت مبادرات دول الجنوب إنجازات رمزية، مثل تعزيز الشرعية الدولية لفلسطين عبر اعتراف 138 دولة بها كدولة مراقب. لكنها فشلت في تغيير الواقع على الأرض بسبب الفيتو الأمريكي وهيمنة إسرائيل العسكرية. ومع ذلك، تُعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لخلق ضغط أخلاقي وقانوني متواصل[49].
3. فاعلية القانون الدولي على “الحالة الفلسطينية”
تُعتبر فلسطين اختباراً صارخاً لفشل المجتمع الدولي في إنفاذ مبادئه، في هذا المحور سنحاول تحليل الشرعية التاريخية للحقوق الفلسطينية، والتناقض بين الاعتراف القانوني بها وغياب التنفيذ الفعلي.
3.1 الشرعية القانونية والتاريخية
منح صك الانتداب البريطاني على فلسطين 1922 بريطانيا سلطة إدارة فلسطين كـ”وكيل” لتحقيق الاستقلال التدريجي للشعب الفلسطيني لكن بريطانيا انحرفت عن هذا الهدف عبر إهدار المادتين (5) و(6) من صك الانتداب وهي المواد التالية:
المادة (5): التزمت بريطانيا بـ”حماية الوحدة الإقليمية لفلسطين” وعدم فصل أي جزء عنها[50].
المادة (6): أوجبت “حماية حقوق ومصالح السكان الأصليين”، وعدم المساس بـ”الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية”.[51]
اذ نخلص الى نتيجة هي ان الانتداب البريطاني تحوّل من إطار قانوني مؤقت لصالح الشعب الفلسطيني إلى أداة لإنكار حقه في تقرير المصير، عبر توظيف النصوص الدولية (كصك الانتداب) لخدمة أجندة استعمارية. وهذا ما يُبرر اعتبار الاحتلال الإسرائيلي امتداداً لهذا النهج، وانتهاكاً مستمراً لمبدأ تقرير المصير المُكرس في المواثيق الدولية.
بموجب معاهدة لوزان 1923، تنازلت الإمبراطورية العثمانية عن سيادتها على الأراضي الفلسطينية، مما فتح الباب أمام تطبيق المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم[52]، التي نصت على أن الشعوب الخارجة عن الحكم العثماني “وصلت إلى مرحلة من التطور تسمح بوجودها كأمم مستقلة مؤقتاً”، بشرط تقديم “المشورة الإدارية” من قبل دولة منتدبة حتى تصبح قادرة على إدارة شؤونها بنفسها. وقد أدرجت فلسطين ضمن هذه الفئة، حيث اعتُبرت “أمة مستقلة مُقبلة على الاستقلال الكامل” بسكانها وإقليمها، وفقاً للفئة (أ) من المادة 22.
شكّل النظام الدولي الذي أقامته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى إطاراً قانونياً مهدراً لحق الشعب الفلسطيني، عبر توظيف الانتداب البريطاني (1922) لتمكين المشروع الصهيوني، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى سلسلة ثورات (1920–1939) رفضاً لتحويل فلسطين إلى “وطن قومي لليهود”. ومع تأسيس الأمم المتحدة عام (1945)، تحوّل الموقف الدولي تدريجياً لصالح الحقوق الفلسطينية، بدءاً من قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947) الذي اعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وصولاً إلى القرار 1514 (1960) الذي كرّس إنهاء الاستعمار، وأسفر عن استقلال أكثر من 40 إقليماً[53]. وتوالت القرارات الأممية المؤكدة على حق تقرير المصير الفلسطيني، مثل القرار 2672 لعام 1970، والقرار 3236 لعام 1974) الذي اعتبره حقاً غير قابل للتصرف، وصولاً إلى القرارات الحديثة كـ76/150 لعام 2021. كما أكدت المادتان (1) و(55) من ميثاق الأمم المتحدة[54]، والمادة 11 المشتركة بين العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والاقتصادية والاجتماعية (ICESCR)، على أن هذا الحق يشمل السيادة الكاملة على الأرض والموارد، والقدرة على “تحقيق الانماء الحر”، دون تأثر بالاحتلال[55].
3.2 تناقض الارادة السياسية الدولية
رغم أن الميثاق يُكرس مبدأ المساواة القانونية بين الدول وفق (المادة 2/1)، فإن الفاعلية الفعلية للقانون تعتمد على توازن القوى السياسي. فالتدخلات العسكرية الأحادية (كاحتلال العراق 2003 تحت ذريعة التفتيش على اسلحة الدمار ومحاربة الإرهاب) تُناقض المادة (2/4)، لكنها تعكس هيمنة القوى العظمى كالولايات المتحدة التي تتجاوز الشرعية الدولية لتحقيق مصالحها[56].
تُظهر ايضا الأزمات الدولية (كأزمة دارفور أو الصراع السوري) أن احترام القانون الدولي رهنٌ بالإرادة السياسية للدول. فالفصل السابع من الميثاق (الخاص بتدخل مجلس الأمن) يُخضع التنفيذ لإرادة الدول دائمة العضوية، مما يُكرس ازدواجية المعايير[57].
3.3 الانتهاكات الإسرائيلية وتناقضها مع الشرعية الدولية
يفرض الحصار الإسرائيلي على غزة شكلاً من العقاب الجماعي، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35%، وارتفاع معدل البطالة إلى 70%، مما ينتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
حيث تواجه فلسطين سياساتٍ استيطانية وعزلاً جغرافياً وديموغرافياً في غزة والضفة الغربية، ما يعكس فشل المنظومة الدولية في تحقيق العدالة أو محاسبة الاحتلال، رغم المحاولات الفلسطينية اللجوء إلى آليات قانونية دولية. يُظهر التعامل مع القضية ازدواجية تهدد مصداقية القانون الدولي، إذ تتعارض المبادئ النظرية مع الواقع المعيش، حيث تتحول فلسطين إلى رمزٍ للنضال من أجل إنهاء الانتهاكات العالمية وإثبات سيادة القانون[58].
3.4 تنامي الانتهاكات الاسرائيلية
تواصل إسرائيل انتهاكها لهذا المبدأ عبر إنكار الصفة القانونية له، وادعاءاتٍ باطلةٍ مثل “اندماج الفلسطينيين في الدول العربية” أو “عدم أحقية لاجئي 1948”[59]. رغم ترسيخ القانون الدولي لحق تقرير المصير الفلسطيني عبر أكثر من 136 قراراً للجمعية العامة، و60 قراراً لمجلس الأمن، اضافة الى 14 قراراً لليونسكو، وتتناقض هذه الادعاءات مع أحكام رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري حول الجدار 2004 والقرارات الاخرى التي تلاها، الذي أكد أن الاحتلال لا يُبطل الحق في تقرير المصير، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء انتهاكاتها، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي. كما تُنتهك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بتهجير السكان قسراً، والمادة (1/3) من ميثاق الأمم المتحدة بمنع ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم السياسية. يُضاف إلى ذلك رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن، كـالقرار 2334 (2016) الذي أدان الاستيطان، مما يعكس تحويل “الشرعية الدولية” إلى أداة انتقائية تُكرس هيمنة القوة على القانون[60].
أكدت الأمم المتحدة في سلسلة قرارات (مثل القرار 242\1967 والقرار 338\1973 أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط مرهونٌ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة. وقد نص القرار 2334\2016) على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعرقل تطبيق حل الدولتين. كما أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري 2004 حول الجدار الفاصل أكد أن الاحتلال لا يلغي الحقوق الفلسطينية، بل يفرض على المجتمع الدولي واجب الضغط لإنهائه[61].
3.4.1 الاستيطان الاسرائيلي
وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة بتسليم حتى الانتهاء من كتابة هذا المبحث، فقد ارتفع عدد المستوطنين المستعمرين في الضفة الغربية من 200,000 عام 2000 إلى 475,000 عام 2023 بزيادة 137%[62].
| السنة | عدد المستوطنين | عدد المستوطنات |
| 2000 | 200,000 | 144 |
| 2023 | 475,000 | 279 |
كما ازداد عدد المستوطنات والمستعمرات من 144 مستوطنة عام 2000 إلى 279 مستوطنة وقاعدة عسكرية عام 2023 بزيادة 94%[63] حيث تسيطر إسرائيل على 62% من مساحة الضفة الغربية عبر مناطق ما يسمى بتقسيم منطقة “ج” الخاضعة لسيطرتها الكاملة، بينما يُسمح للفلسطينيين بالبناء في 18% فقط[64] بالإضافة الى مصادرة أراضي الضفة الغربية خلافا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث اقدمت إسرائيل على مصادرة ما يزيد عن 7,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في النصف الأول من 2023 فقط، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اوتشا[65].
3.4.2 انتهاكات الفصل الجغرافي العنصري
أثر انشاء الجدار الفاصل بالإضافة الى المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى 167 كانتوناً معزولاً، وهو ما ترسخ عمليا بعد احداث السابع من اكتوبر الذي يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً مستحيلة[66]،حيث لا يسمح لسكان المدن والقرى والمخيمات التنقل بحرية بسبب البوابات القائمة مؤخرا. اما فيما يتعلق بالقدس الشرقية فقد استولت إسرائيل على 35% من مساحتها منذ 1967، وهدمت 1,500 منزلاً فلسطيني فيها منذ عام 2000 اضافة الى فصل الضفة عن (قطاع غزة) الى جانب الانقسام الداخلي الفلسطيني فقد تم استخدامه كأداة للتفكيك حيث يُعتبر نتاجاً للسياسة الإسرائيلية المُمنهجة فرّق تَسُد[67].
وفق تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تنتهك الاجراءات الاسرائيلية المتخذة بحق الفلسطينيين المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة. بالإضافة الى انها تجاهلت 86% من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين[68].
وفق تقارير صادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 2021، يشكل نسبة المستوطنون 15% من سكان الضفة الغربية، لكنهم يسيطرون على معظم الموارد المائية، مما يُكرس عدم تكافؤ الفرص وهو ما يعتبر عائق ديموغرافي.
اذ لا يُمكن تجاوز إشكالية تفسير القواعد الدولية دون معالجة الخلل الهيكلي في النظام الدولي، الذي يسمح للدول القوية بالتحكم في التشريع والتأويل. ويتطلب ذلك تعزيز آليات قضائية مستقلة (كمحكمة العدل الدولية) ومنح صوتٍ أكبر للدول النامية في صناعة القانون وتفسيره، لتحقيق توازنٍ يُخفف من تحويل الشرعية الدولية إلى غطاء لمصالح النخب المسيطرة.
اذا القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي قضية اختبار لمبادئ العدالة الدولية وقدرة القانون الدولي على حماية الحقوق غير القابلة للتصرف. فمنذ قرار التقسيم ، تحولت فلسطين إلى نموذجٍ صارخ لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تُمارس إسرائيل سياسات تُجسد جريمة الاستعمار الاستيطاني المُحظورة بموجب نظام روما، وجريمة الفصل العنصري وفق اتفاقية 1973. وامام اعين العالم ينتهك الاحتلال الإسرائيلي مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مع استمرار توسيع المستوطنات رغم تصنيفها “غير قانونية” بوضوح في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الاخير ويتسامح النظام الدولي مع كل تلك الانتهاكات من قبل إسرائيل، وتستخدم اميريكا الفيتو ما يقارب 43 مرة لحماية إسرائيل هدف عرقلة تطبيق الفصل السابع من الميثاق، مما يُفقد مجلس الأمن شرعيته.
فالقضية الفلسطينية هي مرآة تعكس أزمة النظام الدولي في تحقيق العدالة. فانتصار الحق هنا سيكون انتصار لمبادئ المساواة وفاعلية القانون، بينما فشله يعني إعلان وفاة النظام الدولي كأداةٍ لتحقيق السلام. الفلسطينيون اليوم لا يناضلون من أجل أرضهم فحسب، بل من أجل إعادة تعريف العدالة الدولية ذاتها.
Ø نتائج الدراسة ومناقشتها
توصلت الدراسة الى جملة من النتائج يمكن تلخيص اهمها:
- التوسع الاستيطاني الإسرائيلي (بنسبة 94% منذ عام 2000) ليس انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل يُشكل نظاماً استعمارياً حديثاً يُعيد إنتاج أشكال الهيمنة عبر السيطرة على الموارد (المياه، الأراضي) وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية إلى ما يزيد عن 160 كانتوناً معزولا بين مخيم وقرية ومدينة.
- الفجوة بين الإطار النظري للقانون الدولي والممارسة العمليةليست مجرد إشكالية قانونية، بل انعكاس لهيمنة جيوسياسية تُحوِّل المبادئ الإنسانية إلى أدوات سياسية مرنة.
- تناقض صارخ بين الاعتراف الدولي الواسع بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (منذ قرار التقسيم) وغياب الآليات الفعّالة لإنفاذ هذا الحق، حيث تعطَّل 85% من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باستخدام الفيتو الأمريكي.
- على الصعيد الإنساني، فإن الحصار المُطبق على قطاع غزة (منذ 2007) وتحويلها إلى “سجن مفتوح” يُعد انتهاك صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تشير البيانات إلى أن معدل البطالة تجاوز 70%، مع اعتماد 80% من السكان على المساعدات الدولية.
- كشفت الدراسة عن أزمة مصداقية المنظومة الدولية، خاصة في ظل عجز محكمة الجنايات الدولية عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات من قتل وتهجير رغم مرور عقد على انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة. فالجمعية العامة تعترف بحق تقرير المصير (القرار 3236)، لكنها تفشل في إنهاء الاحتلال. بينما تُصدر محكمة العدل الدولية آراء استشارية لكنها تفتقر لآليات التنفيذ.
- ازدواجية المعايير من الدول الأوروبية التي تتبنى خطاباً حقوقياً من ناحية لكنها تستمر في توريد الأسلحة لإسرائيل من ناحية اخرى، أضف الى ذلك ان الشركات المتعددة الجنسيات تُموّل الاستيطان عبر استثماراتها في البنية التحتية غير القانونية في مناطق الضفة الغربية وغيرها.
Ø توصيات الدراسة
في ضوء النتائج المقدمة للدراسة، توصي بالتالي:
- إنشاء مركز فلسطيني للقانون الدولي ككيان مستقل، بالتعاون والشراكة مع الاخوة القانونيين المفرغين على هيكل السلطة الوطنية واجهزة الامن ودعوة الشركاء والاصدقاء في شبكة العلاقات العربية والاجنبية لهدف تدريب كوادر جديدة وشابه على صياغة الشكاوى الدولية وإعداد قواعد بيانات قانونية عن الانتهاكات بالشراكة مع الجامعات العربية والدولية العالمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي واخرى ذات العلاقة.
- مخاطبة المجتمع الدولي الرسمي لتشكيل محكمة خاصة لفلسطين (مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة) عبر قرار من الجمعية العامة وإعداد التقارير السنوية على سبيل المثال “فلسطين: مقياس العدالة الدولية” لقياس التزام الدول بالقانون الدولي.
- الاستمرار في مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمةالاستعمار الاستيطاني، مستندين إلى السوابق القانونية حالة ناميبيا ضد جنوب أفريقيا 1971 وإدراج إسرائيل في قائمة العار للأطراف المنتهكة لحقوق الأطفال وفق القرار 1612 واستخدام آلية الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 377 لفرض عقوبات عند تعطيل مجلس الأمن.
- التأكيد على التنسيق مع الاشقاء العرب في السعودية لإحياء مبادرة التحالف الدولي لعام 2024 على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في واشنطن بمشاركة عالمية واستثناء الولايات المتحدة والتي تدعم حل الدولتين على اساس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بهدف ممارسة الضغط لتنفيذ القرار 242. وتعد خطوة لامتداد مبادرة السلام العربية 2002 بشكل اوسع حيث ضمت 90 دولة ومنظمة عالمية منها دول عربية واسلامية مصر وتركيا، دول اوروبية كالنرويج وإسبانيا، باستثناء “ايران”
- استمرار ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتفعيل آلية”المسؤولية عن الحماية والتي دعى لها الرئيس الفلسطيني في عدة مناسبات أمام مجلس الامن ولقاءات دولية right 2 protect (R2P) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عبر تقديم طلب رسمي من الجمعية العامة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المُمنهجة.
- التأكيد على اهمية إعداد تقارير قانونية دورية بالشراكة مع منظمات دولية من خلال وزارة الخارجية ودوائر العمل الخارجي ذات الصلة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوثيق الانتهاكات وتقديمها إلى المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان، مع التركيز على جرائم الفصل العنصري وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي.
- الاستمرار في تطوير استراتيجية دبلوماسية تعتمد علىتحالف دول الجنوب العالمي مع البريكس ومجموعة الـ77 والصين لخلق كتلة تصويتية ضاغطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع استهداف الدول الصاعدة كالهند، البرازيل عبر خطاب يركز على “العدالة العالمية” بدلًا من الخطاب الإقليمي الضيق.
- تفعيل أدوات الضغط الاقتصادي عبر حث الاتحاد الأوروبي على تطبيقالتوجيه الخاص بتمييز منتجات المستوطنات(2013/50EU )، مع مقاضاة الشركات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية تحت مبدأ “الولاية القضائية العالمية” في دول مثل إسبانيا وأيرلندا.
- الاستمرار برفع دعاوى مقاضاة الشركات الداعمة للاستيطان من خلال الشركاء والاصدقاء الدوليين تحت مبدأالولاية القضائية العالمية في دول مثل إسبانيا وكندا.
- إطلاق مبادرات اعلامية على سبيل المثال (فلسطين: العدالة المرئية)، بالشراكة مع منصات إعلامية كتلفزيون فلسطين ومراكز الاعلام التابعة للسلطة الوطنية لإنتاج محتوى مرئي ممول بلغات متعددة يعرض:
- مقارنات بين سياسات الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا.
- برامج توثيقية تفاعلية لتأثير الاستيطان على الحياة اليومية للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية خاصة المهمشة وتوثيق اعتداءات المستوطنين المستعمرين في جنوب الخليل وقراها واعتداءات الاستيطان الرعوية في مناطق رام الله وقراها وشمال الضفة الغربية.
- تكثيف تنظيم زيارات ميدانية لبرلمانيين وصناع قرار دوليين إلى المناطق المُحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- التركيز على الهجمة التي تستهدف مخيمات الضفة وتوسيعها من جنوبها الى شمالها وتهجير ساكنيها بل وفرض واقع جديد واعاقة عمل الاجهزة الفلسطينية.
- إعداد تقارير دورية على سبيل المثال تحت عنوان (الاحتلال بالأرقام) تُوزع على الهيئات التشريعية العالمية من خلال وزارة الخارجية ودوائر العمل الخارجي ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني والمنظمات الشعبية المسئولة عن التواصل مع المجتمعات الاخرى.
- اعتماد آلياتالدبلوماسية البرلمانية عبر إشراك نواب فلسطينيين في جلسات برلمانات دولية مؤثرة (مثل البرلمان الأوروبي)، مع تقديم عروض مُفصلة عن الثغرات في تطبيق القانون الدولي.
المراجع والمصادر:
- الكتب والرسائل العلمية:
- ابن حجا، فريد. 2017. حقوق الانسان بين العالمية والعولمة. تونس: معهد الدراسات العليا للنشر.
- داوود، محمد ناظم. حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والانفصال، 2018، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج20-ع2 العراق.
- الفتاوي حسين،2011. الامم المتحدة، اهداف الامم المتحدة ج1 دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان.
- محمد سامي، عبد الحميد. القاعدة الدولية، المجلد الاول، الطبعة 1، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1972.
- كامل العنكود، 2001.ازدواجية المعاملة في التطبيق القانون الدولي العام “حالة العراق”، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد.
- علي جميل،2020. جريمة الارهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني، اقليم كردستان انموذجا، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1.
- أبو العطاء، رياض صالح. 2009. حقوق الجماعات في ضوء القانون الدولي العام. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر.
- الشافعي، بشير، المنظمات الدولية :النظرية العامة واهداف التنظيم الدولي للمنظمات الدولية العالمية والاقليمية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002.
- العنكبي، نزار.التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات مجلس الامن المتعلقة بأزمة الخليج. بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر.
- العبدلي، عبد المجيد. 1994. قانون العلاقات الدولية. الطبعة الأولى. دار اقواس للنشر.
- الغنيمي، محمد طلعت. 1977. الوجيز في قانون السلام. الطبعة الثانية. الإسكندرية: منشأة المعارف.
- القاضي، عزيز. 1971. تفسير مقررات المنظمات الدولية. القاهرة: المطبعة العالمية.
- النابلسي، تيسير شوكت. دون تاريخ. “تمايز مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير عن جرائم الإرهاب الدولي.” مجلة المعارف.
- بن عاشور، رافع. 2004. مؤسسات المجتمع الدولي. تونس: مركز النشر الجامعي.
- حمودة، منتصر. 2009. القانون الدولي المعاصر. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
- سعيد الله، عمر اسماعيل. 1986. تقرير المصير السياسي للشعوب. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.
- عامر، صلاح الدين. 1984. قانون تنظيم الدول، النظرية العامة. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار النهضة العربية.
- غريبي، علي، وعبد القادر يخلف. 2018. “القيمة القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها.” مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار ثلجي، العدد 3.
- مرار، صلاح الدين. 2022. حق الشعوب في تقرير مصيرها واشكالية الاعتراف الدولي. رسالة ماجستير في القانون الدولي العام. جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية.
- مبارك، سعيد. 1982. أصول القانون. الطبعة الأولى.
- ياسين، ضاري رشيد. 2001. فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. سلسلة دراسات استراتيجية، العدد 21. بغداد: مركز الدراسات الدولية.
- بن عامر تونسي. 1987. تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية. الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة.
- حافظ، محمد شوقي عبد العال. 1992. الدولة الفلسطينية: دراسة سياسية قانونية في ضوء القانون الدولي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- سلطان، حامد، وآخرون. 1984. القانون الدولي العام. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار النهضة.
- دندن، جمال الدين. 2022. “مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير بين النظرية والتطبيق: دراسة حالة فلسطين.” مجلة الدراسات القانونية، جامعة المسيلة، المجلد 7، العدد 1.
- السائح، أحمد محمد، وآخرون. 2017. “مبدأ حق تقرير المصير بين النشأة السياسية والطبيعة القانونية.” مجلة جامعة سرت، المجلد 7، العدد 2.
- يوسف، أوتفات. 2011. “تمايز مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير عن جرائم الإرهاب.” مجلة المعارف، العدد 10.
- عبد السلام ياسر رجب. 2019. “الإطار الدستوري لحق تقرير المصير.” مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، العدد 49.
- طوزان، أحمد محمد. 2013. “التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق الاستقلال والانفصال: دراسة تطبيقية لحالة السودان.” مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد 3.
- المراجع الإلكترونية:
- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). النص الكامل للقرارات. متوفر على الرابط https://info.wafa.ps/ar_aspx?id=7231
- الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1960. القرار 1514(د-15.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1970 (القرار 2625 د-25)
- مجلس الأمن. 2016. القرار 2334. متوفر على https://undocs.org/S/RES/2334(2016)
- اتفاقية جنيف الرابعة. 1949. متوفر على https://ihl-databases.icrc.org/
- ميثاق عصبة الامم التي جاءت بها معاهدة فرساي بتاريخ 28 يونيو1919المنشورة على موقعها http://www.ungeneva.org/en/library-archives
- نص القرار 77/247: متوفر على الرابط https://docs.un.org/en/A/RES/77/247
- بيان قمة بريكس 2023: متوفر على رابط الحكومة الجنوب إفريقية عالموقع President Cyril Ramaphosa: XV BRICS Summit Open Plenary | South African Government
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1966. متوفر علرابط المرفق https://urlz.fr/pbB5
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 1966. متوفر علىالرابط https://urlz.fr/pbB4
- تقرير بيتسيلم. 2023. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. متوفر علىhttps://www.btselem.org/settlements
- تقرير أوتشا. 2023. المعيقات في الضفة الغربية وأثرها على الفلسطينيين. متوفر على الرابطhttps://www.ochaopt.org/
- تقرير صادر عن مؤسسة السلام الان..التوسع الاستيطاني متوفر على الرابط Peace Now. Settlement Expansion Report. 2023. https://peacenow.org.il/en/settlements-watch
- نص اتفاقية الإبادة الجماعية متوفر على رابط الأمم المتحدة https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
- تقرير هيومن رايتس ووتش . متوفر على الرابط org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
[1] رضا بن سالم، محاضرات في القانون الدولي، جامعة البليدة 2، لونيسي علي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 2020–2021، ص2
[2] عمر اسماعيل سعيد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص75
[3] جمال الدين دندن، مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير بين النظرية والتطبيق، دراسة حالة فلسطين 2022، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة المسيلة، الجزائر، مج7 ع1 ص 288
[4] بن عامر تونسي، تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية، دون طبعة، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، 1987 ص 115
[5] صلاح الدين، عامر، قانون تنظيم الدول، النظرية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3 1984 ص 263
[6] داوود محمد ناظم، حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والانفصال، 2018، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج20-ع2 العراق، ص 101
[7] صلاح الدين مرار، حق الشعوب في تقرير مصيرها واشكالية الاعتراف الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 2022 ص10
[8] علي جميل، جريمة الارهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني، اقليم كردستان انموذجا، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1 2020 ص 274.
[9] السائح احمد محمد، واخرون، مبدأ حق تقرير المصير بين النشأة السياسية والطبيعة القانونية 2017، المجلة الخاصة بجامعة سرت العلمية، العلوم الانسانية مج7، ع2، ص 364-378.
[10] رافع بن عاشور، مؤسسات المجتمع الدولي، مركز النشر الجامعي، تونس، 2004. ص144.
[11] للمزيد من المعلومات انظر: النص الكامل للقرارات المشار اليها، وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا، على الرابط https://info.wafa.ps/ar_aspx?id=7231
[12] اذ تأكد المادة /11 المشتركة بين العهد الدولي الخاص المدني والسياسي والعهد الدولي الاقتصادي والثقافي الاجتماعي الذي ينص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق الانماء الكلي للشعوب. للمزيد من التعمق انظر العهد الدولي الخاص من خلال الروابط التالية: https://urlz.fr/pbB5 https://urlz.fr/pbB4
[13] علي غريبي، عبد القادر يخلف، “القيمة القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، 2018 مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، الاغواط عدد3 ص ص172.173.
[14] فريد ابن حجا، حقوق الانسان بين العالمية والعولمة، معهد الدراسات العليا للنشر، تونس 2017 ص60.
[15] طوزان احمد محمد، التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق الاستقلال والانفصال، دراسة تطبيقية لحالة السودان 2013، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية مج29 ع3، ص-ص 463.464.
[16] عبد السلام ياسر رجب، الاطار الدستوري لحق تقرير المصير 2019، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية ع49 ص389.
[17] طوزان احمد محمد ، مرجع سابق.
[18] تيسير شوكت النابلسي، تمايز مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير عن جرائم الإرهاب الدولي.” مجلة المعارف ص 254.
[19] أوتفات يوسف، تمايز مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير عن جرائم الإرهاب الدولي، مجلة المعارف، ع 10، 2011 ص 50.
[20] محمد طلعت الغنيمي المرجع السابق، ص-ص 102- 103.
[21] رياض صالح أبو العطاء، حقوق الجماعات في ضوء القانون الدولي العام، د ط دار الجامعة الجديدة للنشر مصر 2009، ص ص 116 -115.
[22] راجع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1514 لسنة 1960 (د 20)، والقرار 2625 لسنة 1970 الدورة 25 .
[23] صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة، ط الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، 1984، ص 267.
[24] أنظر مجموعة اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقر حق تقرير المصير الاقتصادي ومنها: اللائحة رقم 1802 بتاريخ 1962/12/14 حول السيادة الدائمة للدول على مصادرها الداخلية اللائحة رقم 2958 بتاريخ 1966/11/25 حول السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية. اللائحة رقم 3016 بتاريخ 1972/12/25 حول السيادة الدائمة للدول السائرة في طريق النمو على ثرواتها الطبيعية. اللائحة رقم 8132 بتاريخ 1974/12/12 حول ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.
[25] ريموش نصر الدين، المرجع السابق، ص 109.
[26] جميلة قرارجي، المرجع السابق، ص 19.
[27] حسام هنداوي، المرجع السابق، ص 89.
[28] ريموش نصر الدين المرجع نفسه، ص 110.
[29] حامد سلطان، واخرون: القانون الدولي العام، الطبعة 3، دار النهضة، القاهرة، 1984 ص 72.
[30] محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، المجلد الاول، الطبعة 1، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الاسنك\رية، 1972 ص74.
[31] سعيد مبارك، اصول القانون ، طبعة اولى، ب ن ،1982 ص-ص 33.36.
[32] نزار العنكبي، التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات مجلس الامن المتعلقة بأزمة الخليج، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص50.
[33] عزيز القاضي، تفسير مقررات المنظمات الدولية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1971، ص 8.
[34] الشافعي، بشير، المنظمات الدولية :النظرية العامة واهداف التنظيم الدولي للمنظمات الدولية العالمية والاقليمية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002 من ص-ص 41.42.
[35] حسام هنداوي، المرجع السابق، ص 89.
[36] محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في قانون السلام، الطبعة الثانية، منشأة المعارف الإسكندرية، 1977م، ص 49.
[37] ضاري رشيد الياسين، فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سلسلة دراسات استراتيجية ، العدد 21، مركز الدارسات الدولية، بغداد، 2001، ص-ص 31-30.
[38] كامل العنكود، ازدواجية المعاملة في التطبيق القانون الدولي العام “حالة العراق”، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2001، من ص-ص 182-196.
[39].منتصر حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2009، ص 135.
[40] عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، الطبعة الاولى، دار اقواس للنشر، 1994، ص 456.
[41] منتصر حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2009، ص 135 مرجع سابق.
[42] الفتاوي حسين، الامم المتحدة، اهداف الامم المتحدة ج1 دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان، 2011 ص 92.
[43] تقرير هيومن رايتس ووتش . متوفر على الرابط hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
[44] بيان قمة بريكس 2023: متوفر على رابط الحكومة الجنوب إفريقية عالموقع President Cyril Ramaphosa: XV BRICS Summit Open Plenary | South African Government
[45] نص القرار 77/247: متوفر على الرابط https://docs.un.org/en/A/RES/77/247
[46] نص اتفاقية الإبادة الجماعية متوفر على رابط الأمم المتحدة https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
[47] اتفاقية جنيف الرابعة .متوفر على رابط اللجنة الدولية للصليب الأحمر IHL Treaties – IHL Treaties
[48] مقال صحيفة هآرتس حول التوترات متوفر على الرابط Haaretz | Israel News, the Middle East and the Jewish World – Haaretz.com
[49] المرجع السابق
[50] تنص المادة الخامسة :تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل أي جزء من اراضي فلسطين الى حكومة دولة اجنبية وعدم تأجيرها الى الحكومة او وضعه تحت تصرفها باي شكل من الاشكال.
[51] تنص المادة السادسة على ان ادارة فلسطين مع عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالي الاخريين ان تسهل هجرة اليهود في احوال ملائمة، وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار اليها في المادة 4 حشد اليهود للأراضي الاميرية والاراضي “الموات” غير المطلوبة للمقاصد العمومية للمزيد من المعلومات : انظر صكوك الانتداب في فلسطين (https://urlzz.fr/pbhc)
[52]ميثاق عصبة الامم التي جاءت بها معاهدة فرساي بتاريخ 28 يونيو 1919 المنشورة على موقعها http://www.ungeneva.org/en/library-archives
[53] رافع بن عاشور، مؤسسات المجتمع الدولي، مركز النشر الجامعي، تونس، 2004. ص144.
[54] للمزيد من المعلومات انظر: النص الكامل للقرارات المشار اليها، وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا، على الرابط https://info.wafa.ps/ar_aspx?id=7231.
[55] اذ تأكد المادة /11 المشتركة بين العهد الدولي الخاص المدني والسياسي والعهد الدولي الاقتصادي والثقافي الاجتماعي الذي ينص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق الانماء الكلي للشعوب. للمزيد من التعمق انظر العهد الدولي الخاص من خلال الروابط التالية: https://urlz.fr/pbB5 https://urlz.fr/pbB4 .
[56] المرجع سابق، ص 10.
[57] محمد الجشعمي، رؤى العزي، مفهوم فاعلية في نطاق القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 9.
[58] حافظ محمد شوقي عبد العال، الدولة الفلسطينية. دراسة سياسية قانونية في ضوء احكام القانون الدولي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1992 ص 171.
[59] ترجمت هذه التطورات لمواقف من خلال قرارات عدة منها 136 قرار صادرة عن الجمعية العامة، 60 قرار صادر عن مجلس الامن و 10 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة الحقوق، 14 قرار عن اليونيسكو واخيرا 30 قرارا من الصحة العالمية بالإضافة الى اعتراف الامم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في قرار التقسيم واقامة الدولة المستقلة وتأكيدها على حقه في تقرير مصيره في القرار رقم 2672 الصادر عام 1970 والمادتين 1، 55 من ميثاق الامم المتحدة والقرارات 3236 عام 1974 و66/146 لعام 2011 اضافة الى القرار 57/158 لعام 2012 والقرار 76/150 للعام 2021.للمزيد من التعمق انظر – مجموعة مؤلفين: الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني، تحرير شفيق المصري، مركز دراسات الشرق الاوسط، عمان، 2015 ص 143 وما بعدها.
[60] حافظ عبد العال، الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء احكام القانون الدولي، الهيئة العامة المصرية للكتاب 1992 ص171.
[61] حق الفلسطينيين في تقرير المصير: الأرض، الشعب، العملانية، ورقة عمل رقم 28، مركز بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق والمواطنة وللاجئين 2021 ص-ص 5، 6.
[62] تقرير مؤسسة بيتسيلم متوفر على الموقع B’Tselem. Israeli Settlements in the West Bank. 2023. https://www.btselem.org/settlements.
[63] تقرير صادر عن مؤسسة السلام الان..التوسع الاستيطاني متوفر على الرابط Peace Now. Settlement Expansion Report. 2023. https://peacenow.org.il/en/settlements-watch..
[64] تقرير صادر من اوتشا )المعيقات في الضفة الغربية واثرها على الفلسطينيين(… OCHA. West Bank Barrier: Impact on Palestinians. 2023. https://www.ochaopt.org/.
[65] القرار 2334 متوفر على موقع مجلس الامن على الرابط : UN Security Council. Resolution 2334 (2016). https://undocs.org/S/RES/2334(2016)
[66]تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية حول تقسيم الضفة الغربية متوفر على رابط المؤسسة. 2022. https://www.alhaq.org/
Jerusalem Municipality. Demolition Statistics. 2023. https://www.jerusalem.muni.il/
Washington Institute. Israeli Non-Compliance with UN Resolutions. 2022. https://www.washingtoninstitute.org/