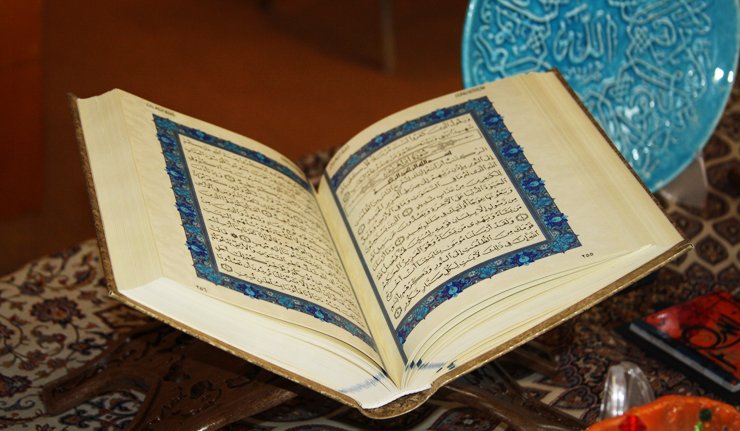لماذا تتردد المحكمة الجنائية الدولية في استخدام القوانين الإفريقية؟ بين نظرية المؤامرة والحقيقة

إعداد : عمرو سليم – باحث دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة
- المركز الديمقراطي العربي
يرى بعض الباحثين الأفارقة أنه قد يكون هناك تحيزًا في استخدام القوانين الدولية ضد الدول الإفريقية، وهناك من يعتقد أن تلك القوانين وضعت لتقييد حريتهم واستهدافهم أو حتى على الأقل تأتي لاستكمال مُخطط الاحتلال الأوروبي للقارة الإفريقية، ومحاولة للنيل من زعماء وقادة تلك الدول والتأثير عليهم لاتباع القوانين والتشريعات الغربية داخل دولهم، وإخضاعهم وتقييد حرية اتخاذ القرارات بتلك الدول، وجعلها تابعة للغرب لتستخدم كأداة للضغط القانوني عليهم وملاحقتهم دوليًا عند الحاجة لذلك، وهناك من يؤيد فكرة أن هناك قوانين إفريقية لا تتماشى مع الحريات والديمقراطية، حتى أن بعض الأفارقة يشتكون من أثارها، فضلا عن بعض الظروف السياسية والأمنية المتردية داخل أجزاء من القارة الإفريقية.
عرض عام
يتناول الباحثون ما وصفوه بحالة العداء من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الأفارقة، وتركيزها على القضايا الإفريقية وملاحقة قادة القارة بدون الالتفات للحصانة التي يمتلكونها، فضلًا عن تجاهل المحكمة الاستعانة بخبراء ومتخصصين من القارة الإفريقية ومؤسساتها القانونية كمشرفين يساعدونها خلال الاستشارات القانونية المتخصصة، وهو ما يوحي بالتحيز ضد القارة، كما يستحضرون الفترة الاستعمارية والعنصرية الغربية ضد إفريقيا، يستشهد الباحثون بذلك من خلال تقديم جامبيا وجنوب إفريقيا وبوروندي إخطارات بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حتى أنه خلال عامي ٢٠١٧ طالب الاتحاد الإفريقي دول القارة بالانسحاب الجماعي من المحكمة، على الرغم أنه لم يحدث إلا أنه يوضح التوتر بين المحكمة ودول القارة، والافتقار لأدوات تتيح لدول القارة الوصول لتفاهمات مشتركة مع المحكمة أو ربما تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للاستماع بجدية وبحث الأمر مع الدول الإفريقية.
تجاهل القوانين الوطنية الإفريقية
يعتقد الباحثون أن قضاة المحكمة الجنائية لا يرجعون إلى القوانيين الوطنية الإفريقية لتفسير مقاصدهم القانونية أو للاسترشاد بها في أحكامهم، واستدلوا على ذلك عبر البحث في قاعدة بيانات تحتوي على 16,192 استشهادًا للمحكمة الجنائية الدولية تم جمعها على مدار تسع سنوات، أظهرت أنه في السجلات التي تم فحصها، نادرًا ما تلجأ المحكمة إلى القوانين الوطنية، ولكن عندما تفعل، لا تعطي اهتمامًا تقريبًا لقوانين الدول الإفريقية ودول الجنوب العالمي الأخرى، بل تستشهد أكثر بالقوانين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولا يلجؤون إلى نهج العالم الثالث تجاه القانون الدولي (TWAIL)، ولا يستشهدون بقوانين الجنوب العالمي في القضايا التي تثار عبر المحكمة الجنائية الدولية.
واستهد الباحثون بذلك من خلال إيضاح أنه تبين الاستشهاد بـ 246 استشهادًا تتعلق بتفسير القانون من قوانين وطنية غير أفريقية و16 استشهادًا فقط بقوانين أفريقية.
وجد الباحثون – من خلال فحص الاستشهادات السابقة – أن المحكمة الجنائية الدولية تلجأ بشكل متكرر للقوانين الأوروبية والأمريكية وتبتعد عن القوانين الإفريقية التي تتعامل بصورة أكثر دقة مع الواقع والظروف التي تعيشها القارة الإفريقية، وذلك على الرغم من أن المتهمين أفارقة وليسوا من خارج القارة، وحتى عندما استشهدوا بقوانين إفريقية لجأوا إلى هيئات إقليمية إفريقية بدلا من القوانين الوطنية، وأرجعوا الأمر أنه قد تكون المحكمة الجنائية الدولية تعطي مصداقية أكبر للهيئات الإقليمية الإفريقية بدلا من القوانين الوطنية أو قد تعتبرها أكثر فائدة في تفسير نظام روما الأساسي أو تحديد مبادئ القانون الدولي.
نموذجي دارفور والكونغو
لجأ الباحثون إلي ضرب مثلا بقضية اتهام المحكمة الجنائية الدولية لكلا من “عبدالله باندا” و”صالح جربو”، بوصفهما قائدين للمجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة ولحركة جيش تحرير السودان/جناح الوحدة، مسؤولان عن الاشتراك في ارتكاب جرائم، والتورط في هجوم ضد بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدارفور في ٢٦ سبتمبر٢٠٠٩، حيث لجأت المحكمة إلي الأحكام القضائية الإنجليزية والأمريكية، ولم تستخدم القوانين الإفريقية أو السودانية على الأقل، ولم توثق استنادها إليها، وهو ما أوضحه الباحثون أنه تم فحصه من خلال سجلات المحكمة، واستخدم الباحثون مثلًا أخر للاستدلال على تحيز المحكمة ضد الأفارقة وعدم استخدام القوانين الإفريقية أو حتى الاهتمام بالبحث فيها وتسجيل ذلك الأمر في سجلاتها، وهي قضية السياسي الكونغولي “جان بيير بيمبا”، المُتهم بارتكاب جرائم ضد إدارة العدالة، شملت التأثير الفاسد على الشهود، وتقديم أدلة كاذبة والإدلاء بشهادة زور، حين استعانت المحكمة بقوانين ألمانيا وإيطاليا، فرنسا المكسيك، سلوفاكيا، سويسرا، والمملكة المتحدة، وأغفل القضاة التطرق وفحص القوانين في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي كانت مستعمرة فرنسية بالأساس، مع العلم بأن جنسية المتهمين ومكان وقوع الواقعة هي إفريقيا الوسطى.
مخرجات الفترة الاستعمارية
تطرق الباحثون إلى تأثير فترة الاستعمار الأوروبي للقارة الإفريقية، بطبيعة مصار القانون الإفريقي، حيث أوضح الباحثون في دراستهم أن الاستعمار أثر سلبًا على الشعوب الإفريقية وجعلهم بلا هوية وتحولوا ليكونوا مجرد مستعمرة تابعة للدول الأم “الأوروبية”، مما جعل الشعوب الإفريقية بعيدة كل البعد عن المشاركة في إصدار القوانين الدولية، ولم تشارك إلا نادرً في تطوير القانون الدولي، كما أن فقهاء القانون الدولي معظمهم أوروبيون، وهو ما ينتج عنه قوانين أوروبية بعيدة عن الثقافة والعقلية الإفريقية، وربما تكون غير مناسبة للمجتمعات الإفريقية، وهو ما يُستدل منه بالمركزية الأوروبية في القوانين الدولية، بدليل نقص الاستشهادات بقوانين دول الجنوب العالمي، كما أوضح الباحثون أن هناك افتراض يوضح اعتماد العدالة الجنائية الدولية – على افتراض أن المصادر القانونية توجد بشكل كبير في المحاكمات الأمريكية، ولكن ليس في القانون الإفريقية أو الصينية مثلًا – وهو ما يؤكد تشوه مصادر القانون الدولي، الذي تركه بعض فقهاء الأفارقة ودول الجنوب العالمي في أيدي الأوروبيين، وهو ما نتج عنه قيام فقهاء العالم الغربي بابتكار أساليب لفصل المصادر المادية والرسميّة للقانون الدولي العرفي، عن جذوره التاريخية، وهو ما ينعكس على تجاهل الثقافة والتاريخ الذي يُدعم المصادر المادية التي تتعلق بالأساس بأفكار وممارسات استعمارية لا تتفق مع طبيعة وتاريخ القارة الإفريقية.
استشهد الباحثون عن ذلك بأنه في معاهدة باريس ١٨٥٦ تم تغيير وصف المجتمع الدولي للدول الأوروبية من “أوروبا” إلى “الأمم المتحضرة”، أي أنه اقتصر التحضر على أوروبا وغير ذلك من الدول سيُعتبر خارج تصنيف التحضر، وهو ما يربط أوروبا بفكرة التأسيس المنفرد للقانون الدولي، وهو ما اعتبره الباحث تقصير أو عدم ظهور محوري لدور دول الجنوب العالمي في تطوير القانون الدولي والتأثير الفعال فيه.
هيمنة أوروبية أمريكية
افترض الباحثون أن القانون الدولي تم بنائه بشكل متساو بين الدول والثقافات المحلية والإقليمية، إلا ان الواقع يوضح أن معظم الاستشهادات التي يتم اللجوء إليها وتطبيقها في المحاكم الدولية تهيمن عليها القوانين الأوروبية والأمريكية، وهو ما يحدث بالمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لا يعكس فقط فشل قضاة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع القوانين الإفريقية بنفس معيار ووزن القوانين الأوروبية والأمريكية بل هناك تحيز ضد دول الجنوب العالمي وأطراف وصفها الباحثون بـ “المتأخرة”، وهو متجذر في جذور تطور القانون الدولي منذ نشأته، والدليل على ذلك استخدام المحكمة الجنائية الدولية لقوانين فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك، سلوفاكيا، وسويسرا لتحديد وصف دقيق لمدى شمول الشهادة الكاذبة لإغفال الحقيقة، خلال محاكمة السياسي الكونغولي “جان بيير بيمبا”، على الرغم من أن المكسيك تقع في الجنوب العالمي، إلا ان المحكمة استشهدت بها.
اعتمدت الدول التي حصلت على استقلالها من الاستعمار على قانون الدول المُستعمرة، لأن قوانين الدول المُتحررة كانت مرتبطة خلال فترة الاستعمار بتلك الدول مثلما حدث في نيجيريا وكينيا اللتان كانت أنظمتها القانونية تشبه مثيلتها في المملكة المتحدة، وزاد ذلك الارتباط بعد الاستقلال، وبالرغم من تلك النقطة يرى الباحث أن ذلك لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها ببساطة الاستناد إلى قوانين المستعمر كبديل للقوانين الأفريقية لدى الدول الأفريقية قوانينها الخاصة، سواء قبل الاستعمار أو بعده سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
تراجع دول الجنوب العالمي
يشير الباحثون في دراستهم إلى نقطة حيوية وهي أن بعض من دول العالم الثالث لا تقوم بنشر ممارساتها القانونية بشكل ممنهج ودوري يسمح بمتابعتها دوليًا، وأرجع ذلك إلى نقص الموارد المادية والبشرية، ولربما أن عملية التوثيق ليست من ثقافة تلك الدول الناشئة، كما أن إنتاجية علماء العالم الثالث أقل من نظرائهم بالعالم في الدول مرتفعة الدخل، وهو ما يجعل من الصعوبة العثور على مساهماتهم عبر شبكة الإنترنت، وتوافرها لجميع المهتمين عبر العالم باللغة التي يستطيع قضاة المحكمة وخبرائها فهمهما بدقة.
طالب الباحثون المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بجهود إضافية من أجل فحص القوانين الإفريقية باعتبارها “تعرضت للظلم والتمييز” وفضل قضاة المحكمة الاستعانة بالقوانين الأوروبية والأمريكية خلال نظر القضايا الدولية المختلفة حتى لو كانت أطرافها إفريقية ووقعت أحداثها في القارة الإفريقية أيضًا، مثلما حدث في محاكمة كلا من “عبدالله باندا” و”صالح جربو” في دارفور، وكذلك “جان بيير بيمبا” السياسي الكونغولي، حيث دعا الباحثون قضاة المحكمة للنظر إلى القوانين الوطنية للدول التي من شأنها عادة ممارسة الولاية القضائية، والتي تُشكل أحد الأنظمة القانونية المتنوعة التي يمكن استخراج المبادئ العامة للقانون منها، وتطبيقها، مع الأخذ في الاعتبار سلطات وقوانين المحكمة الجنائية الدولية، من خلال وجود بعض المصطلحات مثل “المناسبة” أو استعمالها “عند الحاجة” لأن هاتان الكلمتان يمنحان قضاة المحكمة سلطات واسعة قد تتجاهل التعامل مع القوانيين الإفريقية باعتبارها غير مناسبة أو لا تتفق مع المبادئ العامة للقانون – من وجهة نظر المحكمة – حتى وأن كانت مناسبة ومتفقة مع مبادئ القانون الدولي، بمعنى أن هناك بعض الدول تقوم بوضع آليات وإجراءات للتعامل مع المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية، حيث يمكن ممارسة الولاية القضائية على الجرائم الدولية من قَبل الّمحاكم الدولية على أساس الاتّفاقيات المعمول بها أو بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد تجد المحكمة أن تلك الآليات غير مناسبة من وجهة نظرها المنفردة.
لفت الباحثون النظر إلى نقطة هامة وهي أن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تنص المادة 38 ( (3على تطبيق “المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة”، وهي ما جعلها مُقتصرة على دول محددة واستثنى منها الدول الإفريقية ودول الجنوب العالمي الناشئة.
القوانين الوطنية في مواجهة القانون الدولي
كانت هناك تيارات ترى أنه يجب علي المحكمة الجنائية الدولية تطبيق القوانين الوطنية بشكل مباشر، لأن المتهم يكون على دراية بها، فليس من المعقول أن يستطيع شخص ما المعرفة بالقوانين المختلفة بمختلف أنحاء العالم، وأيضًا هو ما يتوافق مع رغبة بعض الدول في حماية سيادتها وقدرتها على فرض القوانين التي تُطبق على مواطنيها، وتمثلت أبرز تلك التيارات في الصين واليابان وإسرائيل وبعض الدول العربية، وكان هناك تيار يرى بأنه يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تطبيق القانون الدولي فقط وأن التطبيق المباشر للقوانين الوطنية سيؤدي إلى تناقضات في العدالة ويعيق تطور جسم متماسك من القانون الدولي، وهو ما يوضح بأنه يجب علي المحكمة فحص جميع جوانب القانون الدولي قبل أن تلجأ إلى القوانين الوطنية، وإذا لجأت إليها تكون في حدود القانون الدولي، لأنه بحسب وجهة نظر ذلك التيار إذا تم استيراد القوانين الوطنية بشكل مباشر، فسيكون من الضروري، أن يتم الحكم في القضايا المماثلة بشكل مختلف حسب موقع أو جنسية المتهمين.
أشار الباحثون إلى أن هناك عدد من الدوافع كانت خلف تمسك تيار الاعتماد على القانون الدولي بعيدًا عن القوانين الوطنية هو وجود اختلاف في اللغات التي تصدر بها القوانين وتُفسر، وهو ما يجعل قضاة المحكمة يميلون إلى اللجوء إلى الأنظمة القانونية التي هم أكثر إلمامًا بها، مثل الأنظمة القائمة على القانون الروماني، وبشكل خاص الأنظمة القانونية الأوروبية، لذلك قد يلجأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء الأولوية لمعرفة قوانينهم أو القوانين المشابهة لأنظمة قانونية أخرى، وقد يقتصر بحثهم على الوسائل المتاحة لهم وعلى القوانين باللغات التي يفهمونها تجنبًا لأي سوء فهم في تفسير بعض القوانين الوطنية، وهو ما سيؤثر على أحكامهم القضائية، كما أن اختيار القضاة يتم من دائرة ضيقة للغاية من مجموعة نخبوية من الدبلوماسيين والحقوقيين الذين يمتلكون خبرات أكاديمية، قانونية، دبلوماسية، سياسية، واقتصادية.
تهميش دول الجنوب العالمي
يوضح الباحثون أنه ليس مفاجئًا أن المحكمة الجنائية الدولية تستشهد بالقوانين الوطنية لدول الشمال العالم – أوروبا والولايات المتحدة – بصورة أكبر من الاستشهاد بالدول الإفريقية ودول الجنوب العالمي، لأنه يجب فحص جزء من هذه القوانين لتحديد مدى ملاءمتها لاستخلاص المبادئ العامة للقانون، ولذلك يدعون المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق البحث بشكل أكبر من خلال فحص القوانين الإفريقية وقوانين الدول الأخرى في الجنوب العالمي، لضمان العدالة، الشرعية، ومن أجل تحسين اجتهاد المحكمة، كما أنه سيجعل القانون الدولي أكثر تمثيلًا لمختلف البشر حول العالم، ويزيده شمولية، ويرفع من درجة الثقة في القانون الدولي، ويتلافى تهميش قوانين مجتمعات دول الجنوب العالمي، بخاصة أن نسبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية من أفريقيا مُشجعة، حيث أنه في عام 2010، كان خمسة من أصل 18 قاضياً أفارقة، وحاليًا وصل عددهم أربعة من أصل 18 قاضيًا.
يرى الباحث:
الاتفاق مع الباحثين في بعض النقاط التي وردت في ورقتهم البحثية، والتي أبرزها:
١– تركيز المحكمة الجنائية الدولية بشكل واضح علىs الانتهاكات والجرائم التي تحدث في القارة الإفريقية، والتغاضي وإغفال النظر “المُتعمد” عما يجري حول العالم من جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، وربما يرجع ذلك إلى أن معظم ممولي المحكمة الجنائية وربما الأمم المتحدة من أوروبا والولايات المتحدة، ولذلك من الصعب على قضاة المحكمة تجاهل تلك النقطة حتى وأن لم يتم الإعلان عنها صراحة بل نستطيع أن نراها بشكل واضح في القضايا الدولية التي تكون فيها الولايات المتحدة أو بريطانيا طرفًا فيها أو حتى إسرائيل، وربما ما حدث في العراق وأفغانستان وغزة، يؤكد ذلك بوضوح من جرائم حدثت خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى أنه في 1 يناير 2015، أودعت حكومة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة على جرائم تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، وحتى أنه بالرغم من انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع صك انضمامها لدى الأمين العام الأمم المتحدة، ودخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين في 1أبريل 2015، إلا أنه لم نرى حتى بوادر تحرك ضد إسرائيل أو أي من قادتها المتورطين في جرائم حرب أو انتهاكات ضد الإنسانية، بل هناك استمرار للتمويل الأمريكي الأوروبي لها. شحنت تلك الأمور بعض الأفارقة ضد المحكمة، وربما هو ما جعل وزير الإعلام الجامبي في عام ٢٠٠٩، “شريف بابا بوجانج”، يصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها “المحكمة القوقازية الدولية لاضطهاد وإذلال الملونين، وخاصة الأفارقة”.
٢- اثارت الاتهامات الموجهة لبعض القادة الأفارقة تساؤل عددًا من المراقبين السياسيين حول مدى تحركها بشأن المعلومات التي قدمت للمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم ارتكُبت في بلدان غير إفريقية مثل العراق وفنزويلا وفلسطين وكولومبيا وسوريا واليمن وأفغانستان، وقد وضعت المحكمة هذه الجرائم تحت الفحص الأولي ولم تقرر فتح تحقيق، ربما يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه المحكمة لائحة اتهام وأمر الاعتقال بحق الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، بتهمة ارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية، كم وجهت المحكمة اتهامات إلى الرئيس الكيني “أوهورو كينياتا”، ونائبه “ويليامروتو” في عام 2011، بتهمة رعاية العنف العرقي بعد الانتخابات الرئاسية المُتنازع عليها في عام 2007، وشخصين آخرين بارتكاب جرائم ما بعد الانتخابات، كما حققت المحكمة مع رئيس كوت ديفوار السابق “لوران غباغبو”، و”جان بيير بيمبا” نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي لم تحقق فيه المحكمة مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه قوى عظمى وهي روسيا وتستخدم الفيتو لمنع أي تدخل دولي في سوريا ضد نظامه، على الرغم من ارتكابه والقوات الروسية لجرائم على الأراضي السورية بحق مدنيين.
جعل ذلك بعض القادة الأفارقة يهاجمون المحكمة الجنائية الولية ويرفضون التعاون معها بل هناك دعوات للانسحاب الجماعي الإفريقي من المحكمة، على سبيل المثال اعتبر الرئيس الرواندي “بول كيجامي” أن المحكمة أنشئت لمقاضاة الأفارقة وغيرهم من البلدان الفقيرة، ووصفها بأنها نمط جديد من الاستعمار مُصمم لتقييد الأفراد من البلدان الإفريقية الفقيرة، كما أن هناك الهجوم الذي شنته كينيا على المحكمة عقب توجيه الاتهامات للرئيس الكيني ونائبه، وشُن هجوم على المحكمة في الصحف الكينية ووصفت بأنها “إمبريالية” و”استعمارية جديدة” و”محكمة الرجل الأبيض”، وهو ما دفع البرلمان الكيني على إنهاء عضوية كينيا وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت الذي اتفق فيه مع الباحثين في أن المحكمة الجنائية الدولية ركزت محور اهتمامها على القارة الإفريقية، واتهمت العديد من الزعماء الأفارقة ولاحقتهم قضائيًا إلا إنها في ذات الوقت تغاضت عن انتهاكات لزعماء دول أخرى، إلا أنه يبقى هناك عدة نقاط تغاضى عنها الباحثون خلال الاتهامات التي قاموا بتوجيهها للمحكمة تتمثل في التالي:
١- وافقت البلدان الإفريقية طواعية بدون أي إكراه أو ضغوطات الخضوع لولاية المحكمة الجنائية الدولية، وعندما تأتي المحكمة وتُصدر لائحة اتهامات أو تطلب القبض على بعض القادة الأفارقة يتم الهجوم علي المحكمة ووصفها بأنها استعمار جديد ومُتحيزة ضد القارة وقادتها، فليس من المعقول أن المحكمة قد تم أنشأوها خصيصا لملاحقة القادة الأفارقة الذين بعضهم في الأساس جزءًا من النظام الدولي، وربما فاعلون في بعض تحركاته المختلفة سواء السياسية أو العسكرية كل بحسب مصالحه، البرلمان الكيني الذي هاجم المحكمة وقرر الانسحاب منها، ووقف التعاون معها، هو نفسه من هاجم النظام السياسي الكيني بعد استقبال “البشير” في البلاد، بسبب قرار المحكمة بملاحقته والقبض عليه، أي هناك نظرة مزدوجة في التعامل مع المحكمة عندما لا يتصل الأمر بالبلاد وقادتها يُطالب باحترام قرارتها والامتثال لها، وعندما يتعلق الأمر بما يخص الشأن الداخلي يتم مهاجمتها ووقف التعاون معها.
٢- الحجة الرئيسية التي تستخدمها بعض الدول الإفريقية – وأشار إليها الباحثون باعتبارها تمارس ضد الدول الإفريقية – نحو قرارات المحكمة تتصل بالتدخل في شئونها الداخلية وتهديد سيادتها، الا انه ملاحظ أن هناك بين سيادة الدولة والسيادة الفردية داخل بعض الدول الإفريقية، في الماضي قبل انتشار الأفكار المتصلة بحقوق الانسان والحريات وتخطي تلك الحقوق النطاق المحلي، والعكس نفاذها من الإطار الدولي للمحلي، فأنه يتم إعادة تعريف سيادة الدولة، خاصة في الدول الإفريقية التي عانت من تبعات الاحتلال لعقود والذي كان تركيزه على نظام الحكم غير المباشر، والذي تضمن استخدام الزعماء المحليين للحفاظ على مصالحه وبقائه، وهو ما كان يستوجب التغاضي عن ممارسات هؤلاء الزعماء الاستبدادية الباطشة طالما أنها كانت مع مصالح الاحتلال الأوروبي للقارة، حتى من ناضل منهم ضد القوات الأجنبية جعلهم يستولون على الدولة باعتبارها ملكا ًشخصيًا لهم مستخدمين في ذلك حجة الدور الذي لعبوه خلال فترة النضال من أجل الاستقلال، ويتم التركيز على أن أجهزة الدولة وبعض مؤسساتها هي الأهم، بالتوازي مع إهمال حقوق بعض الشعوب، وهو ما رسخ فكرة نظام حكم الرجل الواحد في القارة، وجعل هناك حالة من فقدان الثقة في بعض القادة الأفارقة وبعض المؤسسات التشريعية الإفريقية، وكذلك إثارة شكوك حول مدى نزاهة بعض الهياكل الرسمية للحكم.
٣- هاجم الباحثون في ورقتهم البحثية المحكمة الجنائية الدولية واتهموها بأنها تتعمد إغفال تطبيق القوانين الوطنية الإفريقية وتلجأ في معظم الأحيان للقوانين الأوروبية والأمريكية وبعض الأوقات إلى الهيئات الإقليمية، ومردود على ذلك بأن بعض المؤسسات التشريعية في القارة عانت خلال فترة الاحتلال من تحكم السلطة التنفيذية في بعض قراراتها وأحيانًا تقوم بتوجيهها بحسب رويتها ومصالحها الخاصة، وهو جعل بعضها لا تتمتع بسلطة تشريعية حقيقية، وتم إسنادها ببعض المهام الاستشارية الروتينية، فعقب الاستقلال انقسمت دول القارة بين أنظمة الحزب الواحد والأنظمة العسكرية، وبقى أمام السلطة التشريعية أما الخضوع للحزب الحاكم أو النظام العسكري المُمسك بزمام السلطة، أو المطالبة باستقلال تشريعي حقيقي والدخول في مواجهات مع السلطة الحكمة، وهو ما يعني الدخول في مواجهة مع القوة الحاكمة، وهو ما أثر على كفاءة بعض أعضاءها ومدى الثقة فيهم، فضلًا عن افتقار العديد من الهيئات التشريعية إلى المعرفة والتدريب اللازمين للعملية التشريعية، وهو بالتالي ما جعل فقدان الثقة الدولية في تشريعاتها وقوانينها أمر مُبرر بعض الشيء، فليس من المعقول إنتاج قوانين ذات ثقة وتمثل المطالب الشعبية واحتياجاتها وتتصل بالعدالة بشكل نزيه في ظل تلك الأوضاع التي لا تتوافق مع أسس العدالة وسيادة القانون.
الخُلاصة
يبدو أنه من السهولة توجيه اللوم إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهامها بالتحيز ضد الأفارقة، وتهميش قوانينهم الوطنية وعدم اللجوء إليها خلال عمليات التقاضي الدولية، أو حتى عبر القنوات التشريعية والقضائية الدولية، ولكن… الحقيقة أن المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة لم يرى في البيئة التشريعية الإفريقية إلا الجانب السلبي وتحكم السلطة التنفيذية في العديد من قراراتها لدرجة أنها في بعض الدول تحولت لأداة باطشة ضد المعارضين وأصحاب الفكر، في ظل غياب الديمقراطية عن بعض دول القارة، وضعف مختلف المؤسسات، وغياب فقاء القانون الإفريقي عن الساحة الدولية، لظروف مادية وفكرية وربما سياسية، فمن غير المعقول أنه في خلال تلك الظروف نطالب النظام العالمي – اعتبر المحكمة الجنائية الدولية جزءًا منه – باحترام القوانين التي ربما وقع بعضها في ظل ظروف يغيب عنها الشفافية والعدالة والنزاهة، وقد يكون من وضعها غير متخصصين أو يفتقرون للمعرفة القانونية الكافية.
بالفعل تتحيز المحكمة ضد الأفارقة نوعا ما، وقد تكون أداة للضغط السياسي والاقتصادي ضد الدول الإفريقية، الغنية بالموارد الطبيعية، إلا أن تطوير البيئة التشريعية الإفريقية الوطنية، هو الحل الأمثل لتشريع قوانين قادرة على أن تنال ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، وليس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والهجوم عليها، في ظل انتشار الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية، والجرائم ضد الإنسانية داخل القارة، بل قد يكون ذلك هو عقاب للأفارقة بدلًا من المحكمة.
قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية:
أولًا- الوثائق:
- المحكمة الجنائية الدولية، تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأداء برامجها لعام ٢٠١٢،ICC ASP/12/9 ، لاهاي،٢٠-٢٨ نوفمبر٢٠١٣.
https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-9-ARA.pdf
- المحكمة الجنائية الدولية، الحالة في دولة فلسطين، لاهاي، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤.
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-06/2022-05-victims-info-palestine-ara.pdf
- موقع الأمم المتحدة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice
ثانيًا- دراسات وأوراق بحثية:
- هوارد فارني وكاتارزينا زدونكزيك، تعزيز المساءلة العالمية دور الولاية القضائية العالمية في مقاضاة الجرائم الدولية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ديسمبر ٢٠٢٠
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Universal_Jurisdiction_ARABIC_0.pdf
المراجع باللغة الإنجليزية:
A- Documents:
- The International Criminal Court, SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, ICC-01/05-01/13, 19 October 2016.
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_18527.PDF
- The Judges of the Court, The International Criminal Court (ICC), ICC-PIDS-FS-04-014/21_Eng,16 Nov 2024.
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/JudgesENG.pdf
B- Articles:
- Gichuki, J. W, African State Sovereignty and the International Criminal Court: Case Studies in Analytical Context, in the African Journal of Democracy and Governance (Soth Affrica: V.1, No,4, 2010) PP. 103-120
- James E. Archibong, The ICC: A Global Court to Fight Impunity or a Court Targeting Africans, in The International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) (India: ARC Publications, V.6, Issue 8, August 2019) PP. 22-32
https://www.arcjournals.org/pdfs/ijhsse/v6-i8/3.pdf
- Mojeed Olujinmi A. Alabi, The legislatures in Africa: A trajectory of weakness, in The African Journal of Political Science and International Relations ( Cairo: International Scholars Journals, V. 3, No.5, May 2009) PP. 233-241
- Rukooko, A. B., & Silverman, J, The International Criminal Court and Africa: A Fractious Relationship Assessed, in The African Human Rights Law Journal (South Africa: University of Pretoria, V.19, No.1, July 2019) PP. 87-108
https://www.ahrlj.up.ac.za/issues/2019/volume-19-no-1-2019
- Stewart Manley, Pardis Moslemzadeh Tehrani and Rajah Rasiah, The (Non-)Use of African Law by the International Criminal Court, in The European Journal of International Law (UK: Oxford University, V. 34, No. 3, 2023)
https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/555/7236903
C- Reports:
- Tim Murithi, The African Union and the International Criminal Court: An Embattled Relationship?, in The institute for Justice and Reconciliation (IJR) (Cape Town, No. 8, March 2013)
https://www.ijr.org.za/home/wp-content/uploads/2017/05/IJR-Policy-Brief-No-8-Tim-Miruthi.pdf