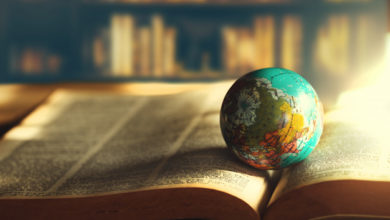أثر الصعود الشعبوي على المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية: دونالد ترامب أنموذجًا (2017 – 2021)
The Impact of Populist Rise on Political Institutions in the United States: Donald Trump as a Case Study (2017–2021)

إعداد : أسماء كرم محمد عبد المجيد , ثناء شريف السيد محمود , دنيا عاطف أحمد محمد , شهد جمال عبدالعال محمود , شهد محمد صبحي إدريس – إشراف : د. رجب الطلخاوي – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة :
تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا كلاسيكيًا للديمقراطية الليبرالية الحديثة، بنظام سياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، من خلال مؤسسات راسخة مثل المؤسسة الرئاسية، الكونغرس، القضاء، والأحزاب السياسية. وقد شكّلت هذه المؤسسات الضمانة الأساسية لاستمرار النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث لعب كل منها دورًا محوريًا في ضبط إيقاع الحياة السياسية، ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى، وذلك في إطار من القواعد الدستورية والتقاليد الديمقراطية المتجذرة.
غير أن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد تحوّلًا لافتًا في البيئة السياسية الأمريكية، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وعودة الانقسامات الثقافية والعرقية، ما مهّد الطريق لصعود خطاب شعبوي، وجد صداه في حملة دونالد ترامب الانتخابية، التي مثلت تحديًا مباشرًا للمؤسسات التقليدية، وللقيم التي يقوم عليها النظام السياسي الأمريكي. فقد خاض ترامب حملته باعتباره مرشحاً خارجياً، مهاجمًا النخبة السياسية، الإعلام، وحتى مؤسسات الحكم، مستندًا إلى قاعدة شعبية ناقمة على الوضع القائم، وتشعر بالتهميش والقلق من التغيرات الاقتصادية والديموغرافية.[1]
وخلال فترة حكم دونالد ترامب (2017-2021)، اتسمت العلاقة بين ترامب والمؤسسات السياسية بالتوتر والشد والجذب. فقد سعى إلى توسيع سلطاته التنفيذية على حساب الكونغرس، وهاجم استقلالية السلطة القضائية، وانتقد قرارات المحكمة العليا، بل ولوّح بعدم الالتزام بها. كما حاول التأثير في البنية الحزبية للحزب الجمهوري، دافعًا إياه نحو مزيد من الراديكالية والولاء الشخصي، على حساب الانضباط المؤسسي. [2]
تركّز هذه الدراسة على تأثير صعود الشعبوية، ممثلة في نموذج دونالد ترامب، على المؤسسات السياسية الأمريكية، مع تحليل التغيرات التي طرأت على علاقة المؤسسة الرئاسية مع باقي المؤسسات السياسية، وعلى ردود أفعال هذه المؤسسات تجاه محاولات ترامب لتجاوز القواعد التقليدية وتوسيع سلطاته.
أولًا: أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تناول تأثير الشعبوية على النظم السياسية الأمريكية في ظل التغيرات السياسية الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. تُعد الشعبوية ظاهرة مؤثرة على استقرار النظام الديمقراطي، ولها القدرة على تغيير توجهات السياسات الداخلية والخارجية.
1– الأهمية العلمية
تكمن أهمية الدراسة في إسهامها في الأدبيات العربية المتعلقة بالتيارات الشعبوية وأثرها على استقرار النظم السياسية. تهدف الدراسة إلى تقديم فهم أعمق للعلاقة بين صعود الشعبوية والمؤسسات السياسية الأمريكية، مع تسليط الضوء على تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كنموذج لتأثيرات الشعبوية.
2– الأهمية العملية
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في مساعدة صناع القرار العربي على فهم تأثير الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية، مما يعزز قدرتهم على تبني سياسات تعزز الاستقرار المؤسسي. كما تقدم الدراسة رؤى حول كيفية تعامل النظم الديمقراطية مع التحديات الشعبوية، مما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير سياسات أكثر مرونة وفعالية.
ثانيًا: مشكلة البحث
تُعتبر فترة رئاسة دونالد ترامب (2017-2021) مرحلة بارزة في تنامي الشعبوية بالولايات المتحدة، حيث تجلّى هذا الصعود بوضوح في انتخابه رئيسًا. وقد أثار ذلك تساؤلات حول تأثير الخطاب والممارسات الشعبوية على استقرار وعمل المؤسسات السياسية الأمريكية، و ارتباطًا بما تقدم تتمثل المشكلة البحثية في تساؤل رئيسي قوامه: ما أثر الصعود الشعبوي على المؤسسات السياسية الأمريكية في عهد دونالد ترامب خلال الفترة (2017–2021)؟
وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بالشعبوية وما أهم خصائصها؟
- ما أبرز المؤسسات السياسية الامريكية؟
- ما الجذور التاريخية للشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
- ما العوامل التي أدت إلى صعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
- ما أبرز السياسات الشعبوية التي تبناها دونالد ترامب خلال فترة حكمه؟
ثالثًا: هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية من خلال تجربة دونالد ترامب. توضح الدراسة مفهوم الشعبوية وأبرز خصائصها، وتستعرض أهم المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في النظام السياسي. كما تسلط الضوء على الجذور التاريخية للشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية والعوامل التي أدت إلى صعودها. بالإضافة إلى ذلك، توضح الدراسة السياسات التي تبناها ترامب خلال رئاسته ومدى تأثيرها على استقرار وعمل المؤسسات السياسية الأمريكية.
رابعًا: منهج الدراسة
المنهج الاستقرائي: يعتمد هذا المنهج على وصف وتحليل الواقع السياسي للوصول إلى نتائج واضحة بشأن موضوع الدراسة. تم اختيار هذا المنهج لأن الدراسة تركز على وصف الأحداث السياسية والظروف المؤثرة في السياسة الأمريكية خلال فترة حكم دونالد ترامب، مع محاولة لفهم التغيرات التي طرأت على المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة في تلك الفترة. كما يساهم المنهج الاستقرائي في تحديد دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مواجهة الشعبوية وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية. يساعد هذا المنهج أيضًا في التعرف على أهداف الولايات المتحدة خلال فترة حكم ترامب.
المنهج التاريخي: يعتمد المنهج التاريخي على جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحداث الماضية لفهم الحاضر في ضوء ما حدث في الماضي. تم اختيار هذا المنهج لتتبع تطور العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها السياسية (الرئاسة، الكونغرس، القضاء، والأحزاب) خلال فترة حكم ترامب (2017-2021). يتيح هذا المنهج دراسة التحولات التي طرأت على هذه المؤسسات خلال تلك الفترة، مع التركيز على المواجهات التي خاضها ترامب مع كل منها، وكيف أثر ذلك على النظام السياسي الأمريكي بشكل عام. كما يساعد في تتبع تأثيرات صعود الشعبوية على المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، وتحديد التغيرات التي شهدتها العلاقات بين هذه المؤسسات، بدءًا من خطاب ترامب الانتخابي عام 2016 وصولًا إلى أحداث اقتحام الكونغرس في يناير 2021.
المدخل المؤسسي: يرتكز هذا المدخل على تحليل كيفية تأثر المؤسسات الرسمية في النظام السياسي بتغيرات البيئة السياسية والفكرية. وفي إطار هذه الدراسة، يُستخدم المدخل المؤسسي لفهم كيفية تفاعل المؤسسات السياسية الأمريكية – كالمؤسسة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية – مع صعود التيارات الشعبوية، لا سيّما خلال فترة حكم دونالد ترامب (2017–2021). ويساعد هذا المدخل في توضيح العلاقة المتبادلة بين الشعبوية والبنية المؤسسية، من حيث ما إذا كانت المؤسسات قادرة على احتواء التوجهات الشعبوية أو التأثر بها وتغيير أنماط عملها، بما في ذلك سياسات الضبط والرقابة، واستقلالية السلطات، والتوازن بينها.
خامسًا: الإطار الزمني للدراسة
تعالج الدراسة الفترة من 2017 إلى 2021، وهي فترة تولّي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت صعودًا لافتًا للخطاب الشعبوي وتأثيره المباشر على المؤسسات السياسية. وتركز الدراسة على تحليل كيف أثّر هذا الصعود على عمل المؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل سياسات وتصريحات ترامب التي تحدّت الإعلام، القضاء، والكونغرس. وتنتهي الدراسة بأحداث يناير 2021، التي تمثل لحظة فاصلة مع اقتحام الكونغرس، ما يسلط الضوء على حجم التحدي الذي واجهته الديمقراطية الأمريكية خلال هذه المرحلة.
سادسًا: الإطار المكاني للدراسة
تغطي الدراسة الولايات المتحدة الأمريكية كإطار مكاني محدد، حيث يركّز البحث على تحليل أثر صعود الشعبوية، ممثلة في فترة حكم دونالد ترامب، على المؤسسات السياسية الأمريكية المختلفة، ومدى تأثر تلك المؤسسات بالتوجهات والسياسات الشعبوية خلال هذه المرحلة.
سابعًا: تقسيم البحث
تتكوّن الدراسة من ثلاثة فصول وخاتمة. يتناول الفصل الأول التعريف بالمفاهيم الرئيسة للدراسة، حيث يعرّف بمفهوم الشعبوية، وأسباب ظهورها، وأنماطها، بالإضافة إلى مفهوم المؤسسات السياسية الأمريكية، والتي تشمل المؤسسة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. ويعرض الفصل الثاني، فيتناول نشأة الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية وتطوّرها، مع تسليط الضوء على العوامل المحفّزة لصعودها. بينما يركّز الفصل الثالث على تحليل أثر صعود الشعبوية الترامبية على المؤسسات السياسية الأمريكية. وتختتم الدراسة بخاتمةٍ تستعرض أبرز النتائج التي توصّل إليها الباحثون.
التعريف بالمفاهيم الرئيسية للدراسة
تمهيد
يتناول الفصل الأول التعريف بالمفاهيم الرئيسية للدراسة التي تُعد أساسًا لفهم ظاهرة الشعبوية وتأثيرها على المؤسسات السياسية، وذلك تمهيدًا لتحليل التجربة الأمريكية في عهد دونالد ترامب.
ينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ يتناول المبحث الأول ظاهرة الشعبوية من خلال المنظورات النظرية الكبرى في العلاقات الدولية التي فسّرت صعودها، كما يناقش الأنماط المختلفة للشعبوية، سواء اليمينية أو اليسارية، موضحًا خصائص كل نمط والسياقات التي ظهر فيها. ويُسلط الضوء على العوامل المتعددة التي ساهمت في صعود الشعبوية، بما في ذلك العوامل الأيديولوجية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. أما المبحث الثاني، فيتناول المؤسسات السياسية الأمريكية من حيث بنيتها الدستورية ووظائفها وآليات التفاعل بينها. ويُعد هذا الفصل قاعدة نظرية ضرورية لفهم التغيرات اللاحقة في العلاقة بين الشعبوية والمؤسسات داخل النظام الديمقراطي الأمريكي.
أولاً: تعريف الشعبوية
يرجع أصل مصطلح “الشعبوية” إلى الكلمة اللاتينية populus التي تعني “الشعب”، وهي تقابل في اللغة الإنجليزية كلمتي popular وpeople على سبيل المثال، يُستخدم مصطلح populus Romanus للإشارة إلى “الشعب الروماني”، دون أن يدل بالضرورة على الأفراد بشكل فردي وتقوم فكرة الشعبوية من هذا المنظور على مبدأ الحكم من قِبَل الشعب ككل، في مواجهة مفاهيم مثل: البلوتوقراطية (حكم الأثرياء)، الأرستقراطية (حكم النخبة الوراثية) والنخبوية (حكم الصفوة) وهي أنظمة تستند إلى الامتيازات الطبقية أو الاقتصادية أو التعليمية.[3]
تُعد الشعبوية من أكثر المفاهيم إثارة للجدل والغموض في ميدان العلوم السياسية والاجتماعية، إذ يُستخدم المصطلح في سياقات متعددة ومتباينة. يُطلق على زعماء يساريين في أمريكا اللاتينية، كما يُستخدم لوصف أحزاب يمينية في أوروبا، وقد أدى هذا الاستخدام الواسع إلى خلق التباس في معناه.[4]
بشكل عام، تُعرّف الشعبوية على أنها أيديولوجية تقسم المجتمع إلى فئتين متضادتين: “الشعب النقي” و”النخب الفاسدة” وبهذا المعنى، توجه الشعبوية نقدًا جذريًا للمؤسسات التي تسيطر عليها النخب، وتدعو إلى تجسيد “الإرادة الحقيقية للشعب”، في ظل نظرة ريبة وشك إلى المؤسسات التمثيلية.[5]
وقد ناقشت ندوة عقدتها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 1967 هذا المفهوم، حيث اختلف المشاركون في تحديد طبيعته؛ فمنهم من اعتبرها أيديولوجية، وآخرون حركة سياسية، وهناك من وصفها بأنها متلازمة أو نتيجة لتحولات الحداثة الاجتماعية. وعلّقت الباحثة “إيزايا برلين” آنذاك بأن “صيغة واحدة لتغطية الشعبوية في كل مكان لن تكون مفيدة للغاية”، محذّرة مما أسمته “مجتمع سندريلا”، أي محاولة إيجاد تعريف واحد يلائم جميع السياقات.[6]
ويُفهم من الشعبوية أنها توجه سياسي يضع “الشعب” في مواجهة “النخبة”، ويعبر عن مشاعر عداء تجاه المؤسسات الرسمية والنظم القائمة. وقد بدأ استخدام هذا المفهوم في القرن التاسع عشر لوصف تيارات سياسية. ومع أنه نادرًا ما يُستخدم كوصف ذاتي، فقد تبنته بعض الحركات لتأكيد ارتباطها بالجماهير.
وقد وصفت موسوعة “عبد الوهاب الكيالي” الشعبوية بأنها تيار سياسي مثالي، يقوم على العودة إلى الشعب والثقة بعفويته وطاقته الثورية، ويرى فيها أداة للتغيير الجذري في المجتمع. وهنا يجدر التمييز بين: الشعبوية كموقف سياسي محدد والشعبية وهي الإيمان بالشعب كمصدر للسلطة والسيادة.[7]
وفي هذا السياق، يصف “مودي” الشعبوية بأنها ” أيديولوجية ضحلة” تتألف من بعدين أساسيين أحدهما الشعب النقي في مواجهة النخبة الفاسدة حيث تزعم تلك الأيديولوجية أن الشعب محاصر في صراع مع الغرباء أما البعد الآخر فهو الأعتقاد بأن السياسة يجب أن تكون تعبيرًا عن إرادة الشعب وأن لا شئ يجب أن يقيدها وبالتالي لا تقدم الشعبوية رؤية لنظام بديل مثل ” الأيدولوجيات العميقة” كالشيوعية التي لديها رؤية لتنظيم السياسة والأقتصاد والمجتمع. فمثلًا تعادي الشعبوية المؤسسات السياسية، ولكنها لا تقدم إجابة عمن سيحل محلها[8] فهي تفتقر للوضوح والمنطلقات الفكرية الواحدة، ولذلك تعددت الرؤى الفكرية في تحديد الشعبوية، حيث قدّم “جان فيرنر مولر” نظرية سياسية ترى في الشعبوية قوة أخلاقية، وليست مجرد مشاعر حماسية تندفع خلفها الحشود. أما “أرنستو لاكلاو”، فقد نظر إليها بوصفها استراتيجية سياسية تقسم المجتمع إلى مجموعتين أساسيتين: النخبة والشعب، ويتشكل هذان القطبان حول حدود المنازعة السياسية نفسها. في المقابل، “شن جاك أرنسيير” هجومًا على الشعبوية، معتبرًا أن استخدامها يشوبه الكثير من الفوضى والاستبداد، إلى جانب خلوّها من أي معنى محدد.[9]
ثانيًا: الشعبوية والنظريات الكبرى
مع ظهور الأنماط المختلفة لظاهرة الشعبوية، تعددت الأطر المفسرة لها في النظريات الكبرى في العلاقات الدولية. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
- المنظور الواقعي
يرى الواقعيون أن الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، مدفوعة بالمصلحة الوطنية، ويُستبعد في هذا الإطار مفاهيم مثل السيادة والإرادة الشعبية. يتبنى الشعبويون الواقعيون هذا التصور، مؤكدين أنهم يجسدون مصلحة الشعب كافة، وأن قراراتهم تهدف لبقاء الدولة وتحقيق رفاه المجتمع. يزعم هؤلاء أنهم يتخذون قرارات عن مؤسسات الدولة التقليدية لتحقيق السيادة والأمن والرفاهية. ورغم أن الواقعيين التقليديين لا يعطون دوراً مباشراً للشعب، فإن الشعبويين يقدمون أنفسهم كرجال دولة أقوياء ينفذون مطالب الجماهير. وغالباً ما يتبنون أفكاراً يمينية راديكالية في السياسة الخارجية.[10]
- المنظور الليبرالي
يؤكد الليبراليون على دور الفرد وأهمية التعاون والتكامل الدوليين لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، ويُعلي أنصارهم من شأن المؤسسات الدولية والشركات العابرة للحدود. أما الشعبويون الليبراليون، فيتبنون توجهات يسارية تدعو لتطوير هذه المؤسسات بما يخدم مصالح الجماهير الداعمة لهم. ويركزون على التفاوتات والمظالم التي أنتجها النظام الدولي القائم. لذا يسعون في سياساتهم الخارجية إلى تغييره بما يحقق المنفعة المتبادلة والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.[11]
ثالثًا: الأسباب التي أدت إلى ظهور الشعبوية:
ترجع نشأة الشعبوية إلى تداخل معقد بين أسباب أيديولوجية واجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث يُبرز المفكر عزمي بشارة في كتابه تحليلاً معمقًا لهذه الأسباب التي تهيئ السياق العام لبروز الحركات الشعبوية، إلى جانب تحليلات أخرى ترتبط بتغيرات ثقافية وبنيوية في المجتمعات المعاصرة.
- الأسباب الأيديولوجية والسياسية
تتجلى الأسباب الأيديولوجية في التصورات الشعبوية السلبية تجاه السياسة والمؤسسات التمثيلية. فالشعبويون غالبًا ما يرفضون السياسة التقليدية، ويستبدلونها بعلاقة مباشرة بين الزعيم و”الشعب”، وهي علاقة تتجاهل طبيعة العمل السياسي القائم على التفاوض والمؤسسات، مما يؤدي إلى تآكل التعددية. ويرى بشارة أن هذا التصور يُفرغ السياسة من مضمونها، وينتج عن وهم التمثيل المباشر الذي تدّعيه الحركات الشعبوية. كما يُصاحب ذلك نفور شديد من السياسيين والأحزاب، الذين يُنظر إليهم باعتبارهم نخبًا فاسدة ومعزولة عن هموم الجماهير. وتنعكس هذه النظرة في الصعود المتكرر لشخصيات من خارج المنظومة السياسية، مثل “ترامب” و”برلسكوني”، الذين اعتمدوا على خطاب شعبوي مدعوم بالمال والإعلام، دون امتلاك مشروع سياسي حقيقي.[12]
- الأسباب الاجتماعية
تلعب الأسباب الاجتماعية دورًا مهمًا في دفع الأفراد نحو الشعبوية، سواء على مستوى الخصائص النفسية والاجتماعية للأفراد، أو من خلال الديناميكيات العامة داخل المجتمع. يشعر كثير من الأفراد بالعزلة والتهميش، ويفتقرون إلى الانتماء لجماعات ثقافية أو مهنية، ما يجعلهم أكثر انجذابًا لخطاب شعبوي يعدهم بإعادة الاعتبار لهويتهم وتجربتهم. كما أن تراجع دور الأحزاب التقليدية في تمثيل “الأغلبية الصامتة”، يخلق حالة من الاستياء الجماعي والقلق من التغيرات الاقتصادية والثقافية، ما يُهيئ بيئة حاضنة لتصاعد الخطاب الشعبوي، خاصة في ظل تصاعد مشاعر الخوف على نمط الحياة والهوية.
- الأسباب الاقتصادية
ساهمت الأسباب الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالعولمة وتفكك الطبقة الوسطى، في تسريع وتيرة الشعبوية، حيث يشعر كثير من المواطنين بأن مصالحهم تُهدد نتيجة انتقال المشاريع إلى الخارج، وزيادة المنافسة بسبب تدفق المهاجرين والمنتجين الأجانب. هذا التدهور في الأمان الاقتصادي يصاحبه شعور بالإقصاء من النظام الاقتصادي والسياسي، مما يجعل الوعود الشعبوية – حتى وإن كانت مبسطة أو غير واقعية – أكثر جاذبية.[13]
- أزمات الديمقراطية التمثيلية
تعاني الأنظمة الديمقراطية التمثيلية من أزمة وظيفية عميقة، خصوصًا في المجتمعات التي شهدت تحولات بنيوية سريعة، وارتبطت جزئيًا بمسار التحديث والعولمة. هذه الأزمة تتمثل في عدم قدرة النظام السياسي على تلبية تطلعات المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا حقيقيًا، مما خلق فراغًا سياسيًا ملأته الشعبوية باعتبارها تعبيرًا عن “الشعب الحقيقي” في مواجهة نخب معزولة. وفي هذا السياق، تصبح الشعبوية نتيجة مباشرة لفشل المؤسسات الديمقراطية في تحقيق وعودها، فتبرز كبديل يُعيد الاعتبار للإرادة الشعبية.[14] وتُشير”كاترين دي بريه” إلى أن الأنظمة السياسية الأوروبية ما بعد الحرب العالمية الثانية قلّصت من سيادة الشعب بدعوى الحماية من التوتاليتارية، مما ساهم لاحقًا في تراكم أزمة التمثيل، بينما يعبر “فيكتور أوربان” عن هذا المزاج بالقول إن النخب “لا تخشى الفاشية، بل تخشى الجماهير نفسها”.[15]
- الأسباب المساعدة والتحويلات الثقافية
يرى بشارة أن التراجع في فاعلية الانقسامات الأيديولوجية التقليدية بين اليمين واليسار، وضعف التجمعات السياسية التقليدية، أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في النظام التمثيلي، وهو ما انعكس في انخفاض نسب المشاركة السياسية. كما أدى تصاعد “شخصنة” الحياة العامة، أي الاعتماد على الكاريزما الفردية للقيادة بدلًا من البرامج والأيديولوجيات، إلى تعزيز فرص صعود الشعبويين، كما حدث في تونس مع انتخاب قيس سعيّد. وإلى جانب ذلك، لعبت وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تعبئة الرأي العام، وأدت وظائف كانت تؤديها الأحزاب سابقًا، مما غيّر من قواعد اللعبة السياسية.[16]
- صعود الجماهير والنزعة المحافظة
مع تطور المجتمع الجماهيري، أصبحت السياسة تمارس من خلال تعبئة العواطف لا الأفكار، وهو ما ينسجم تمامًا مع الخطاب الشعبوي الذي يركّز على الإثارة والتبسيط. كما ساهمت النزعة المحافظة – بما تحمله من انتقادات للحداثة وميول نحو القيم التقليدية – في إضعاف الثقة بالتقدمية والعقلانية، وخلق حنين إلى ماضٍ يُمثله الزعيم الشعبوي بوصفه المنقذ من الانحلال القيمي والسياسي.[17]
رابعًا: الأنماط الرئيسية للشعبوية
- الشعبوية اليمينية
وهي ترتبط أكثر بالتيارات القومية المتطرفة، حيث تتبنى نهجاً يرفض التعددية، وعدائياً تجاه الآخر، والأهم، أنها تسعى إلى المعاملة التفضيلية للسكان الأصليين على حساب المهاجرين، فضلاً عن ميلها إلى القيم الدينية والاجتماعية المحافظة التي تدعم الأسرة في مواجهة القيم التقدمية والتحررية خارجياً. يميل هذا النمط إلى العزلة وانتهاج السياسات التجارية الحمائية، وتفضيل العلاقات الثنائية أكثر من المؤسسات الدولية التي يراها القادة الشعبويون تنتقص من سيادة الدول، وتعبّر عن مصالح نخب عابرة للحدود. لذا، يُنظر للشعبوية اليمينية على أنها تشكل تهديداً للنظام الليبرالي الدولي القائم على القواعد وعمل المؤسسات. ومن أبرز نماذجها قادة شعبويون، أمثال: “ترامب”، و”أوربان”، و”بولسونارو”، وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب الجبهة الوطنية في فرنسا.[18]
- الشعبوية اليسارية
وهي التي تدعم داخليًا الديمقراطية التفاوضية والتعددية، حيث تفضل الاستيعاب للآخر، وتناهض الإقصاء، كونها تعبر بالأساس عن مظالم وقضايا المجتمعات في مواجهة النخب الحاكمة وتداعيات السياسات النيوليبرالية. أما خارجيًا، فيستهدف هذا النمط بناء نظام دولي تضامني لا تهيمن فيه القوى الكبرى على المؤسسات الدولية. ينظر إلى تلك الشعوبية اليسارية على أنها تطالب بإصلاحيا للسياسات الليبرالية أو مؤسسات النظام الدولي. ومن أبرز نماذجها: حزب بوديموس الإسباني، وسيريزا اليساري اليوناني، والسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، فضلًا عن بعض القادة الشعوبيين اليساريين في أمريكا اللاتينية الذين عادوا للسلطة في السنوات الأخيرة، مثل “لولا دا سيلفا” في البرازيل.[19]
خامسًا: خصائص الشعبوية:
الشعبوية هي ظاهرة سياسية تتسم بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الحركات السياسية. في جوهرها، تُظهر الشعبوية معاداة للنخب السياسية والاقتصادية والثقافية، إذ تُعتبر هذه النخب فئة منفصلة عن واقع الشعب ولا تمثل مصالحه الحقيقية، بل تسعى فقط للحفاظ على امتيازاتها الخاصة. نتيجة لذلك، تتبنى الشعبوية خطابًا معارضًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، معتقدة أن هذه المؤسسات لا تعكس الإرادة الشعبية، بل تعمل وفق منطق بيروقراطي لا يراعي تطلعات المواطنين. علاوة على ذلك، تعتمد الشعبوية على خطاب جماهيري بسيط ومباشر يهدف إلى إثارة مشاعر الشعب، مما يعزز علاقتها بالجمهور ويُسهم في تجسيد معاناته اليومية. هذا الخطاب غالبًا ما يرتكز على الهوية الوطنية أو القومية، ويُستخدم لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني عبر التأكيد على مخاوف من الهجرة أو التأثيرات الأجنبية.[20]
من ناحية أخرى، يؤكد بول تاغارت على أن الشعبوية ليست ظاهرة ذات أيديولوجية متكاملة، بل هي ظاهرة غير نمطية تتميز بالمرونة وقلة الثبات، مما يجعلها صعبة الضبط أو التنظيم المؤسسي. تُظهر الشعبوية في كثير من الأحيان محدودية في تقديم إصلاحات جذرية، وقد تكون ثورية أو إصلاحية، ولكنها لا تقدم حلولًا شاملة.[21]
وعلى الرغم من أن الشعبوية تدعي تمثيل الشعب بشكل حصري، فإنها ترفض التعددية ولا تعترف بالآخرين، حيث تعتبر نفسها وحدها المخولة بتمثيل الإرادة الشعبية. وهذا يظهر بوضوح في خطاب العديد من القادة الشعبويين، مثل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الذي صرح في مؤتمر حزبي: “نحن الشعب… من أنتم؟”، موجهًا ذلك لخصومه في محاولة لإنكار حقهم في تمثيل الشعب. وهو ما يشبه قول الملك الفرنسي “لويس الرابع عشر”: “الدولة أنا، وأنا الدولة”. وعندما تصل الحركات الشعبوية إلى السلطة، تفقد غالبًا سبب وجودها بسبب افتقارها لمشروع سياسي واضح، وتصبح معارضتها للمؤسسات “مرفوضة” أيضًا.[22]
تأسيساً علي ما سبق فإن الشعبوية، بهذه الخصائص، لا تمثل فقط ردود فعل سياسية، بل هي أداة يستخدمها العديد من الحركات لتعبئة الجماهير، وتُظهر بمرور الوقت كيف يمكن أن تصبح ظاهرة معقدة تأخذ أشكالًا متعددة.
تُعدّ المؤسسات السياسية الأمريكية من أكثر النماذج المؤسسية تعقيدًا وتأثيرًا في العالم، نظراً لطبيعة النظام السياسي الفيدرالي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وقد تأسست هذه المؤسسات استناداً إلى دستور عام 1787، الذي يُعتبر الوثيقة التأسيسية الأقدم بين الدساتير المكتوبة الحديثة، والذي وضع الإطار العام لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة، وقسّمها إلى ثلاث سلطات رئيسية: السلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، والسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية الممثلة في المحكمة العليا وبقية المحاكم الفيدرالية..
يتميّز النظام السياسي الأمريكي بطابع ديمقراطي ليبرالي يركز على حماية الحقوق الفردية والحريات العامة، كما يُولي أهمية كبيرة لمبدأ الضوابط والتوازنات الذي يمنع تركّز السلطة في يد جهة واحدة. ومن خلال دراسة هذه المؤسسات، يمكن فهم كيف تعمل الآليات الدستورية والقانونية في إنتاج السياسات العامة، وكيف تتفاعل السلطات الثلاث فيما بينها فى التأثير فى عملية صنع القرار.
أولا: المؤسسة التشريعية:
تُعد المؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة، ممثلةً في الكونغرس الأمريكي، أحد الركائز الأساسية للنظام الفيدرالي والديمقراطي. ويُجسّد الكونغرس مبدأ التمثيل الشعبي، كما يمثل السلطة التي تمتلك صلاحية سنّ القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية حيث يُنتخب أعضاؤه بشكل مباشر من قبل الشعب، بما يعزز من شرعيته واستقلاليته حيث يتكون الكونغرس من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.[23]
- مجلس النواب:
يتألف مجلس النواب من 435 عضوًا يتم توزيعهم على الولايات الخمسين حيث يُنتخبون مباشرة من الشعب كل عامين، بشرط أن تتوفر في الناخبين نفس المؤهلات المطلوبة لانتخاب المجلس التشريعي الأعلى في كل ولاية. ويُشترط في من يترشح لعضوية المجلس أن يكون قد بلغ 25 عامًا، ويحمل الجنسية الأمريكية منذ سبع سنوات على الأقل، وأن يكون من سكان الولاية التي يترشح فيها. يتم تحديد عدد النواب وتوزيع الضرائب بين الولايات حسب عدد السكان، ويُستثنى من الإحصاء الهنود غير الخاضعين للضرائب، ويُحتسب ثلاثة أخماس من غير الأحرار ضمن عدد السكان. يُجرى إحصاء سكاني كل عشر سنوات، وتُحدد على أساسه حصص التمثيل، على ألا يقل تمثيل كل ولاية عن نائب واحد. وحتى إجراء أول تعداد، تم تخصيص عدد معين من النواب لكل ولاية. في حال شغور أي مقعد، تُجري السلطة التنفيذية في الولاية المعنية انتخابات لملئه. ويقوم مجلس النواب بانتخاب رئيسه ومسؤوليه، كما يملك وحده سلطة توجيه الاتهام في القضايا النيابية[24].
- مجلس الشيوخ:
يتألف مجلس الشيوخ الأمريكي من 100 عضو أى عضوين عن كل ولاية يُنتخبان لمدة ست سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضائه كل عامين لضمان الاستمرارية. يشترط في العضو أن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر، ويحمل الجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات، ويقيم في الولاية التي يُمثّلها. يرأس نائب الرئيس جلسات المجلس دون أن يصوّت إلا عند تعادل الأصوات، بينما يختار المجلس مسؤوليه ورئيسًا مؤقتًا عند الحاجة. ويختص مجلس الشيوخ بمحاكمة المسؤولين في قضايا الاتهام النيابي، ويشترط لإدانة أي شخص موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفي حال كانت المحاكمة لرئيس الدولة، يرأسها رئيس المحكمة العليا. وتقتصر العقوبات على العزل من المنصب والمنع من تولي مناصب عامة، دون أن تُسقط المحاكمة البرلمانية المسؤولية الجنائية أمام القضاء [25].
يبدأ الكونغرس الأمريكي دورته السنوية في3 يناير من كل عام، يتكون الكونغرس من لجان دائمة ومؤقتة تتمتع بسلطات تحقيق واسعة، تشمل استدعاء الشهود وإصدار أوامر إحضار وفرض العقوبات. وقد أنشئت لجان خاصة للتحقيق في قضايا محددة، مثل لجنة “كيفوفر” المعنية بالجريمة المنظمة، ولجنة “إرفين” الخاصة بفضيحة ووترغيت. هذه اللجان تُعد أدوات أساسية لإرشاد الكونغرس في اتخاذ قراراته من خلال جمع المعلومات وتقديم التوصيات، دون أن تحل محل السلطة التشريعية نفسها.[26]
كما يمتلك الكونجرس الأمريكي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة تشمل سن القوانين، وفرض الضرائب، وإقرار الميزانية، إلى جانب سلطته في التحقيق البرلماني والمساءلة السياسية، مثل توجيه الاتهام للرئيس حيث يعمل الكونجرس على تحقيق توازن بين سلطات الحكومة من خلال ممارسته دورًا رقابيًا قويًا على السلطة التنفيذية عبر لجان التحقيق والمراجعة المستمرة لأداء الوكالات الحكومية، مما يضمن عدم تركيز السلطة في يد واحدة. كما يساهم في ضمان الشفافية والمساءلة، ويساهم في حماية النظام الدستوري من التجاوزات التنفيذية، ليظل بذلك ركيزة رئيسية في الحفاظ على توازن القوى داخل الدولة.[27]
ثانيًا: المؤسسة التنفيذية
تتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الدولة والذي يعتبر هو المهيمن على زمام الأمور في الدولة وبحكم رئاسته للدولة نفسها والحكومة فله الحق في رسم السياسية الداخلية والخارجية للدولة وله سلطة البت وإتخاذ القرارات في الدولة وهو غير مسئول هو ووزرائه إلا أمام الشعب الذي قام بانتخابه.[28]
وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وتطبقها. وتتألف السلطة التنفيذية من الرئيس الذي هو رأس الدولة، ورئيس الحكومة الأمريكية، والقائد الأعلى للجيش الأمريكي. ونائب الرئيس لا يدعم الرئيس فحسب، بل يعمل أيضاً كرئيس لمجلس الشيوخ. وأعضاء مجلس الوزراء يرشح الرئيس أعضاء مجلس الوزراء ويجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ (بما لا يقل عن 51 صوتاً). وهم يعملون كمستشارين للرئيس ورؤساء لمختلف الوزارات والوكالات.[29]
- الرئيس
وقد حدد الدستور الأمريكي الذي أنشئت بموجبه السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أنشئت بموجبه ايضاً المؤسسات غير الرسميه والذي تمارس عملها وفقاً لأحكامه وتشريعاته، قام بتحديد مجموعة من المؤهلات والشروط في المادة الثانية من الفقرة الأولي لمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي ” أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة الأمريكية – وأن يكون بالخامسة والثلاثين من عمره – وأن يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أربعة عشر عاماً قبل الترشح ” ولم ينص الدستور في فقراته علي فكرة التجديد.[30]
الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب رأيا خطيا من المسؤول الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات تهم المسؤولين.[31]
تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتي سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس حسبما يرى أن ينيط بواسطة قانون بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزراء تعيين الموظفين الأدنى رتبة.[32]
مع هذه الصلاحيات، تأتي مسؤوليات عديدة، من بينها متطلب دستوري يقضي بـ”إطلاع الكونغرس من وقت لآخر على بيان حالة الاتحاد، والتوصية باتخاذ ما يراه ضروريًا ومناسبًا”. مع أن للرئيس الحق في تنفيذ هذا المطلب بأي طريقة يختارها، إلا أن الرؤساء دأبوا على إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في يناير من كل عام (باستثناء سنوات التنصيب)، موضحين فيه جدول أعمالهم للعام المقبل.[33]
وبذلك لقد نص الدستور على ثلاثة شروط فقط للرئاسة: أن يكون الرئيس بعمر 35 عامًا، وأن يكون مواطنًا مولودًا، وأن يكون قد عاش في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل. ورغم أن ملايين الأمريكيين يصوتون في الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، إلا أن الرئيس لا يُنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب. بل ينتخب الشعب في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر من كل عام رابع أعضاء المجمع الانتخابي. يُوزع الناخبون على الولايات الخمسين حسب عدد السكان – نائب واحد لكل عضو في وفدها في الكونغرس (مع حصول مقاطعة كولومبيا على 3 أصوات) – ثم يُدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم لاختيار الرئيس. ويبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي حاليًا 538 ناخبًا.[34]
- نائب الرئيس
المسؤولية الأساسية لنائب رئيس الولايات المتحدة هي الاستعداد فورًا لتولي الرئاسة إذا عجز الرئيس عن أداء مهامه. قد يكون ذلك بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه المؤقت، أو إذا رأى نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهام الرئاسة. ويُنتخب نائب الرئيس مع الرئيس من قِبل الهيئة الانتخابية، حيث يُدلي كل ناخب بصوت واحد للرئيس وآخر لنائب الرئيس. قبل التصديق على التعديل الثاني عشر عام ١٨٠٤، كان الناخبون يصوتون فقط للرئيس، وكان الشخص الذي يحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات يُصبح نائبًا للرئيس.[35]
ويمكن إعادة انتخاب نائب الرئيس عدد غير محدود من المرات ليشغل منصب نائب الرئيس لمدة أربع سنوات حتى في ظل رؤساء مختلفين.[36] ينص الدستور الأمريكي على أن نائب رئيس الولايات المتحدة هو رئيس مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ترؤسه الجلسة، يتمتع نائب الرئيس وحده بسلطة حسم التعادل في التصويت، ويرأس رسميًا عملية استلام وفرز الأصوات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.[37]
يشغل نواب الرئيس اليوم منصب المستشارين الرئيسيين للرئيس، ولكن من عام ١٧٨٩ وحتى خمسينيات القرن العشرين، كانت مهمتهم الأساسية رئاسة مجلس الشيوخ. ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، شغل نواب الرئيس مكاتب قريبة من قاعة مجلس الشيوخ. وعلى مدار تاريخ الأمة، تطور نفوذ نائب الرئيس مع تجارب نواب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، وفي بعض الأحيان نقاشات حادة، حول الدور الذي سيلعبه هذا المسؤول الدستوري.[38]
- حكومة الرئيس
مجلس الوزراء هيئة استشارية تتألف من رؤساء الوزارات التنفيذية الخمس عشرة. يُعيِّن الرئيس أعضاء حكومته ويُصادق عليهم مجلس الشيوخ، وهم غالبًا أقرب المقربين إليه. بالإضافة إلى إدارة الوكالات الفيدرالية الرئيسية، يلعبون دورًا هامًا في التسلسل الرئاسي للخلافة – بعد نائب الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، يستمر التسلسل الرئاسي مع مكاتب مجلس الوزراء حسب ترتيب إنشاء الوزارات. يحمل جميع أعضاء مجلس الوزراء لقب وزير، باستثناء وزير العدل، الذي يُلقب بالنائب العام.[39]
ختامًا، تمثل السلطة التنفيذية أحد الأعمدة الأساسية في هيكل النظام السياسي الأمريكي، حيث تُناط بها مسؤولية تنفيذ القوانين والسياسات العامة التي يقرّها الكونغرس. ويقف على رأس هذه السلطة رئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى والممثل الأول للدولة، يليه نائب الرئيس، ثم مجلس الوزراء الذي يضم رؤساء الوزارات التنفيذية الخمس عشرة. وتتميز هذه السلطة بتوازن دقيق بين الصلاحيات والمسؤوليات، يخضع لضوابط دستورية ومؤسسات رقابية، ما يضمن عدم الانفراد بالسلطة ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات. ومن خلال تفاعلها مع السلطتين التشريعية والقضائية، تضمن السلطة التنفيذية استمرارية النظام الديمقراطي الأمريكي وتحقيق مصالح الدولة والمواطن في آن واحد.
ثالثا: السلطة القضائية:
منذ أن تم اعتماد دستور الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٧٨٩، يُعدّ القضاء الأمريكي من أبرز الأنظمة القضائية في العالم، ويعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الفيدرالي الذي يُقسّم السلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. يتألف النظام القضائي الأمريكي من محاكم اتحادية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى محاكم على مستوى الولايات والمحاكم المحلية. ومن خلال هذه الهيكلية المعقدة، يلعب القضاء دورًا محوريًا في الفصل بين السلطات، ويضمن خضوع جميع فروع الحكم، بما في ذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأحكام الدستور، مما يضمن تحقيق العدالة ونزاهة القوانين وتطبيقها الدستوري.[40]
هيكل النظام القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية:
يتكون النظام القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة من عدة أنواع من المحاكم التي تؤدي أدوارًا محددة في معالجة القضايا القانونية. تتمثل هذه المحاكم في التالي:
- 1. المحكمة العليا للولايات المتحدة
تُعد المحكمة العليا الفيدرالية من أبرز المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة، نظرًا لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومؤثرة. فهي تملك سلطة الرقابة على دستورية القوانين الفيدرالية وكذلك القوانين الصادرة عن برلمانات الولايات.
كما تختص المحكمة العليا بالنظر في القضايا المتعلقة بالسفراء، والوزراء، والقناصل، وفي النزاعات التي تكون إحدى الولايات طرفًا فيها، بالإضافة إلى قضايا الاستئناف سواء من حيث القانون أو الوقائع. وبهذا تختلف المحكمة العليا الأمريكية عن مثيلتها الفرنسية، محكمة النقض، التي لا تنظر في الوقائع، بل تقتصر على مراقبة تطبيق القانون.
تعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتتكوّن المحكمة من رئيس يُعرف بـ “رئيس القضاة” (Chief Justice)، وثمانية أعضاء يُعيَّنون من قبل رئيس الولايات المتحدة، بعد موافقة مجلس الشيوخ، ويشغلون مناصبهم مدى الحياة. ويجوز لهم التقاعد عند بلوغ سن السبعين، مع الاحتفاظ بكامل رواتبهم، إلا أن القضاة نادرًا ما يتقاعدون فعليًا، ويُقال في هذا السياق إن “قضاة المحكمة العليا لا يموتون ولا يتقاعدون”.
يحظى أعضاء المحكمة العليا بهيبة واحترام كبيرين، وتُعادل رواتبهم رواتب كبار المسؤولين في الدولة، إذ يتقاضى كل منهم راتبًا يوازي راتب الوزير، بينما يحصل رئيس المحكمة على راتب يعادل راتب نائب الرئيس الأمريكي. وتحرص الصحف الأمريكية على إبراز أحكام المحكمة العليا في الصفحات الأولى نظرًا لما لها من أهمية وتأثير.
منذ عام 1922، أصبح لرئيس المحكمة العليا سلطة الإشراف الإداري على كافة المحاكم الفيدرالية، ويجتمع سنويًا مع كبار القضاة لبحث القضايا الأساسية وتوحيد التوجهات القضائية.[41]
- 2. محاكم الاستئناف الفيدرالية
محاكم الاستئناف الفيدرالية تشكل حلقة وصل بين المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا. تتألف من 13 دائرة قضائية، تشمل 12 دائرة جغرافية ودائرة متخصصة تعرف بالدائرة الفيدرالية، التي تختص بقضايا محددة مثل براءات الاختراع والقضايا المتعلقة بالحكومة الفيدرالية.
- 3. محاكم المقاطعات الأمريكية
تعتبر محاكم المقاطعات هي المحاكم الابتدائية في النظام القضائي الفيدرالي، حيث تنظر في القضايا المدنية والجنائية التي تدخل في نطاق القانون الفيدرالي. يوجد 94 محكمة مقاطعة في مختلف الولايات الأمريكية والأقاليم.
- 4. محاكم الإفلاس الفيدرالية
تختص محاكم الإفلاس بالنظر في القضايا المتعلقة بالإفلاس وفقًا للقانون الفيدرالي. وتعمل هذه المحاكم كوحدات تابعة لمحاكم المقاطعات الفيدرالية.
- 5. محكمة المطالبات الفيدرالية
محكمة المطالبات الفيدرالية هي محكمة متخصصة في النظر في القضايا التي تتعلق بالمطالبات المالية ضد الحكومة الفيدرالية، مثل القضايا المتعلقة بالعقود والمطالبات بالتعويضات المالية عن الأضرار.
- 6. محكمة التجارة الدولية
تختص محكمة التجارة الدولية بالقضايا المتعلقة بالقوانين التجارية الدولية والجمارك. وتنظر في القضايا التي تشمل النزاعات بين الأطراف المتعلقة بالتجارة الدولية.[42]
التنظيم القضائي على مستوى الولايات:
يتبع معظم الولايات الأمريكية نظامًا قضائيًا مشابهًا للتنظيم الفيدرالي، حيث يتكون عادة من محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، ومحكمة عليا على مستوى الولاية. ومع ذلك، يمكن أن تختلف التفاصيل التنظيمية بين الولايات من حيث عدد الدوائر القضائية، والمحاكم المتخصصة التي قد تكون موجودة في بعض الولايات (مثل محاكم الأسرة أو محاكم المخالفات). ورغم ذلك، تبقى الوظيفة الأساسية لهذه المحاكم هي النظر في القضايا المعروضة، وضمان خضوع التشريعات المحلية لدستور الولاية، بالإضافة إلى رقابة القوانين والقرارات الإدارية.”[43]
رابعًا: العلاقة بين المؤسسات السياسية الأمريكية الرسمية:
يقوم النظام السياسي الأمريكي على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وهو مبدأ أرساه الدستور الأمريكي منذ عام 1787، متأثرًا بأفكار الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي شدد على أهمية توزيع السلطة لمنع الاستبداد.[44]
يتمتع كل فرع من فروع الحكومة الفيدرالية باستقلال مؤسسي ووظيفي. فالرئيس، بصفته رأس السلطة التنفيذية، لا يملك حق حل الكونغرس أو التدخل في أعماله، كما لا يحق للكونغرس سحب الثقة من الرئيس، ولا يتداخل القضاة في الشؤون السياسية اليومية. ويخضع تشكيل السلطة القضائية لموافقة مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الفروع الثلاثة.[45]
بالتالي، يُبنى النظام على استقلال كل مؤسسة في أداء وظائفها، دون أن يعني ذلك غياب التفاعل أو التنسيق بينها، بل يُعزَّز هذا التفاعل من خلال نظام رقابي محكم يحكم العلاقة بين هذه السلطات، وهو ما يُعرف بـ “نظام الضوابط والتوازنات”.
أولًا: نظام الضوابط والتوازنات في النظام السياسي الأمريكي:
يُشكّل نظام الضوابط والتوازنات (Checks and Balances) أحد المبادئ الأساسية في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يهدف إلى منع تركّز السلطة في يد فرع واحد من فروع الحكومة الفيدرالية الثلاثة، وضمان توازن دقيق في الصلاحيات. وقد صُمم هذا النظام لضمان الرقابة المتبادلة بين الفروع، وتقييد تجاوزاتها، في إطار دستوري محكم.
يساهم الشعب الأمريكي بشكل غير مباشر في تفعيل هذا النظام من خلال ما منحه له الدستور من صلاحيات ديمقراطية، مثل انتخاب أعضاء مجلس النواب كل عامين، وأعضاء مجلس الشيوخ كل ست سنوات، مما يسمح له بالتأثير على السلطة التشريعية. كما يمتلك الشعب سلطة غير مباشرة في منع تعديل الدستور، إذا لم توافق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل المقترح، ما يُعد أداة رقابية قوية على أداء الكونغرس.
- صلاحيات السلطة التنفيذية في النظام التوازني
تتمتع السلطة التنفيذية بعدد من الصلاحيات التي تمكّنها من ممارسة رقابة على السلطتين التشريعية والقضائية. إذ يملك الرئيس صلاحية نقض (الفيتو) القوانين التي يصدرها الكونغرس، مما يمنحه أداة مؤسسية قوية للتأثير على التشريع. كما يُعيّن الرئيس القضاة الفيدراليين، ويملك صلاحية إصدار العفو، وهو ما يمنحه نفوذًا غير مباشر على أداء الجهاز القضائي.
- صلاحيات السلطة التشريعية في النظام التوازني
يمتلك الكونغرس أدوات رقابية فعّالة على السلطتين التنفيذية والقضائية. فمن جهة، يحق له مساءلة الرئيس وعزله من منصبه في حال ارتكابه “الخيانة العظمى أو الجرائم الجسيمة أو الجنح”. كما يمكن للكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ. ويشترط الدستور كذلك موافقة مجلس الشيوخ على التعيينات القضائية، ما يمنح المؤسسة التشريعية سلطة مشاركة في تكوين السلطة القضائية.
- صلاحيات السلطة القضائية في النظام التوازني
تُمارس المحكمة العليا والهيئات القضائية الفيدرالية الأخرى دورًا مهمًا في مراقبة دستورية أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالقضاء الأمريكي يملك صلاحية إلغاء أو تعطيل القوانين والتصرفات الرئاسية إذا تبيّن مخالفتها للدستور، وهو ما يُعرف بمبدأ “المراجعة القضائية” (Judicial Review). ومن خلال هذه الآلية، يُحافظ القضاء على التوازن بين السلطات، ويمنع تغوّل أحد الفروع على الدستور أو على حقوق المواطنين.[46]
وبهذا الشكل، يتجلى نظام الضوابط والتوازنات في كونه شبكة معقدة من العلاقات المؤسسية، تكفل حماية الديمقراطية ومنع الاستبداد السياسي، مع ضمان تفاعل مستمر بين الفروع الثلاثة، في ظل احترام الدستور وسيادة القانون.
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن المؤسسات السياسية في النظام الأمريكي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يشكل الأساس الذي يُبنى عليه النظام الديمقراطي. فالسلطة التشريعية، ممثلة في مجلسي الكونغرس، تضطلع بمهمة سنّ القوانين ومراقبة عمل الحكومة، بينما تمثل السلطة التنفيذية أداة تنفيذ السياسات العامة، ويتولاها الرئيس بالتعاون مع مجلس الوزراء والمكاتب التنفيذية. أما السلطة القضائية، فتعمل على تفسير القوانين وضمان توافقها مع الدستور، وهي بذلك تلعب دورًا محوريًا في حماية الحقوق والحريات. هذا التوزيع الدقيق للمهام والصلاحيات بين السلطات الثلاث يهدف إلى منع الاستبداد، وضمان التوازن، وتحقيق الرقابة المتبادلة، مما يجعل النظام السياسي الأمريكي نموذجًا فريدًا في التنظيم والفعالية. كما أن هذا التوازن يُسهم في استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها، ويمنح كل سلطة مساحة من الاستقلال، دون أن تكون بمنأى عن المحاسبة أو الرقابة.
ختامًا، يتّضح أن فهم الظواهر السياسية المعاصرة، وعلى رأسها الشعبوية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإطار المؤسسي الذي تتحرك داخله. فقد تناول المبحث الأول مفهوم الشعبوية من حيث النشأة والتطور والخصائص، باعتبارها ظاهرة سياسية مركبة تؤثر على شكل الخطاب السياسي، وتعيد تشكيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كما تم التطرق إلى المؤسسات السياسية الثلاث في النموذج الأمريكي، للتأكيد على أهمية الهيكل المؤسسي في احتواء أو مواجهة المدّ الشعبوي. ويكشف هذا الجمع بين البُعدين –الفكري والمؤسسي– عن ضرورة الربط بين المفاهيم النظرية والسياقات التطبيقية، لفهم ديناميكيات التفاعل بين التيارات الشعبوية والمؤسسات القائمة، خاصة في الأنظمة الديمقراطية. وعليه، فإن هذا المبحث يُمهّد لفهم أعمق لتجليات الظاهرة الشعبوية في الواقع، ويُعد مدخلًا أساسيًا لتحليل السياسات والمواقف في الفصول اللاحقة من البحث.
بعد أن تناولنا في هذا الفصل المفاهيم النظرية الأساسية للشعبوية والمؤسسات السياسية، فإننا في الفصل القادم سنتجه لدراسة السياق التاريخي الذي أفرز الظاهرة الشعبوية في الولايات المتحدة. وسنسلط الضوء على جذورها وتطورها والعوامل التي مهدت لظهورها في العصر الحديث.
الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية – النشأة والتطور
تمهيد
يتناول الفصل الثاني من هذه الدراسة المسار التاريخي والسياسي لصعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، مركّزًا على جذورها وتطورها وصولًا إلى الحقبة المعاصرة.
ينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ يتناول المبحث الأول الجذور التاريخية لظهور الشعبوية في السياق الأمريكي، بدءًا من حركة المزارعين في القرن التاسع عشر وتأسيس حزب الشعب، وصولًا إلى بروز شعبوية دونالد ترامب بوصفها امتدادًا لتلك التفاعلات التاريخية. أما المبحث الثاني، فيُحلل العوامل المحفزة لصعود الشعبوية، مثل التفكك الاجتماعي، والحرمان النسبي، والخوف من التعددية العرقية، إلى جانب تأثير التحولات الاقتصادية والعولمة، مما يساعد على فهم الديناميكيات التي أعادت تشكيل الحياة السياسية الأمريكية في العقود الأخيرة.
الجذور التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية
ارتبطت الظاهرة الشعبوية بالتحولات الكبرى التي شهدتها المجتمعات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث برزت الشعبوية كقوة سياسية متجددة تعكس احتياجات فئات واسعة من الشعب تجاه النظام السياسي القائم. لم تكن الشعبوية في الولايات المتحدة مجرد لحظة عابرة في التاريخ، بل شكلت امتدادًا لتفاعلات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة الجذور.
يسعى هذا الفصل إلى تتبع النشأة التاريخية للشعبوية في السياق الأمريكي، من خلال تناول جذورها الأولى وتحولاتها عبر العصور، ثم تحليل أبرز العوامل التي أسهمت في تعزيز حضورها وتكرار ظهورها في فترات متباعدة. وينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسيين: يتناول أولهما الجذور التاريخية للحركة الشعبوية في الولايات المتحدة، بينما يركز الثاني على العوامل المحفزة التي ساعدت على صعودها وانتشارها في أكثر من مرحلة سياسية.
أولا: الجذور التاريخية لظهور الشعبوية في الولايات المتحدة:
تعود الجذور التاريخية لظهور الشعبوية في الولايات المتحدة إلى نهاية القرن التاسع عشر، مع ظهور “الحركة الزراعية” أو “ثورة المزارعين” التي قادها جيمس ب. ويفر، حيث مرّت الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بتغيرات اقتصادية واجتماعية، أهمها التطور في مشاريع البنية التحتية، مثل مد سكك الحديد إلى مناطق الوسط الغربي والسهول الكبرى بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) وكذلك سك الفضة. وقد ساهمت هذه التغيرات في ظهور ما سُمّي “شعبوية المراعي”[47].
تدفق خلال تلك الفترة آلاف الأشخاص نحو المناطق الجديدة في ولايات نبراسكا وداكوتا ومينيسوتا وآيوا وكانساس للاستثمار الاقتصادي فيها، فأثقلوا كواهلهم بالديون لشراء الأراضي الزراعية والمعدات. وشهدت هذه الفترة كذلك وصول ملايين من العمال المهاجرين، لكن موجات الجفاف قضت على أحلام كثيرين منهم وساءت أوضاع المزارعين والعمال في هذه المناطق كثيرا. وفي هذا السياق، اندلعت الثورة الزراعية، وأسست روابط المزارعين ونشطت هذه الروابط في الشمال والجنوب الأميركيين، وكونت تعاونيات المواجهة تسلّط البنوك على المزارعين والعمال المثقلين بالديون.[48]
في هذه الأثناء، أُسس حزب الشعب في عام 1892 في أوماها، في ولاية نبراسكا. ويُسمّى أعضاء حزب الشعب “الشعبويين”. كما يُسميه أعضاؤه “الحزب الشعبوي”، وقد عقد الحزب مؤتمره الوطني الأول، في تاريخ له رمزيته في 4 تموز/ يوليو 1892. وقدم الحزب مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية في العام نفسه، وهو الجنرال “جيمس ويفر” من ولاية أيوا. وقد حصل على مليون صوت، أي ما يعادل 8 في المئة من الأصوات. وعد ذلك نجاحًا غير مسبوق للحزب الشعبوي في الولايات المتحدة.[49]
خرج من رحم حزب الشعب الأمريكي خلال القرن التاسع عشر حركة قومية عنصرية ذات أفكار شعبوية لعل أبرز خطوطها: معاداة الأجانب خاصة الصينيين واليابانيين، بما تضمن ذلك من ضغوطات من قبل تلك الحركة على الكونجرس الأمريكي ودفعه لإصدار قوانين وتشريعات تقضي بمنع دخول الصينيين واليابانيين. وكذا، عرف الواقع السياسي الأمريكي حركة سياسية ذات أفكار شعبوية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، والتي أفسحت المجال لظهور ما يعرف بـ “حفل الشاي” الذي تضمن جملة من المنظمات والشخصيات اليمينية والشعبوية التي تلاقت على مجموعة من المنطلقات أبرزها: الهجوم على الرئيس “باراك أوباما”، إلى جانب رفض مشروع “أوباما كير”.[50]
بالإضافة إلى تشجيع فكرة زيادة الضرائب على الأغنياء بحجة أنهم الأقدر على زيادة الإنتاج، ولعل ما يهمنا هنا أن هذه الحركة أو هذا الحزب لم يكن له تأثير كبير على السياسة الأمريكية غير أن أفكاره قد لاقت ترحيبًا لدى بعض الفئات من الأمريكيين البيض.[51]
وفي عام 2016، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الانتخابات الرئاسية بروز تيار شعبوي يُعرف بشعبوية دونالد ترامب، والذي يُعد امتداداً للشعبوية الأمريكية التي انطلقت مع الرئيس “أندرو جاكسون”. ارتكز هذا التيار على تأكيد الأولوية لمصلحة المواطن الأمريكي والسعي لتحقيق الحلم الأمريكي داخل الحدود الوطنية، مع استبعاد الانخراط في رسالة عالمية تتجاوزها. وظهرت في سياسات “دونالد ترامب” ملامح معاداة الأجانب، لا سيما المسلمين، عبر فرض قيود على الهجرة وبناء جدار حدودي مع المكسيك، إلى جانب مهاجمته للنخبة السياسية الحاكمة وادعائه تمثيل تطلعات وآمال المواطن الأمريكي.[52]
برز الانقسام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح خلال انتخابات عام 2016، عندما فاز “دونالد ترامب” بالرئاسة رغم افتقاده للارتباط التقليدي بالنخبة السياسية المهيمنة في العاصمة واشنطن، والتي يُشار إليها بالمؤسسة الحاكمة. كان فوزه بمثابة صدمة قوية لتلك النخبة، خاصة وأن مرشحته، “هيلاري كلينتون”، كانت تجسّد بمسيرتها وخلفيتها الأيديولوجية رمزاً لهذه المؤسسة. وقد مثّل “ترامب”، من خلال حملته الانتخابية وخطابه، تحدياً مباشراً لتلك المنظومة، حيث خاطب فئات اجتماعية واقتصادية مهمشة، مثل الأسر البيضاء، والمزارعين، وسكان المناطق الريفية، والطبقة الوسطى التي تأثرت سلباً بعمليات العولمة. ووجه اتهامات صريحة للنخب السياسية والإعلامية والفيدرالية بالفساد والابتعاد عن هموم المواطن الأمريكي، مقدماً نفسه كبطل شعبي قادر على تخليص الشعب من تلك المظالم واستعادة عظمة أمريكا ومكانتها.[53]
اعتمد ترامب في صعوده على تعبئة مشاعر الغضب والحنق الناتجة عن تراجع الصناعات المحلية وانتقالها إلى دول مثل الصين والمكسيك، وما تبع ذلك من بطالة وانخفاض في الدخول بين فئات واسعة من العمال محدودي المهارات. هذا الخطاب، الذي وظّف الشعبوية بأسلوب مباشر، مثّل نقطة تحول في الخطاب السياسي الأمريكي، حيث تعمّق الانقسام بشكل أكبر خلال فترة حكمه، متخذاً أبعاداً دينية وعرقية. وقد ظهرت آثار هذا الانقسام بوضوح في انتخابات 2020، التي خسرها “ترامب” بفارق ضئيل بلغ نحو أربعة ملايين صوت فقط ل”صالح جو بايدن”، رغم حصوله على أكثر من 73 مليون صوت، ما يعكس حجم التأييد الشعبي الذي حظي به الخطاب الشعبوي الترامبي حتى بعد أربع سنوات من تولّيه الحكم.[54]
ولقد شهدت الشعبوية في عهد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تحولات بارزة، حيث انتقلت من كونها مجرد خطاب انتخابي إلى نمط حكم وسياسة داخل مؤسسات الدولة. بدأ “ترامب” حملته الانتخابية عام 2015 مستغلًا مشاعر الغضب لدى قطاعات واسعة من الأمريكيين، لا سيما الطبقة العاملة البيضاء المتضررة من العولمة، مقدمًا نفسه كمرشح من خارج النخبة السياسية التقليدية. استخدم “ترامب” خطابًا قائمًا على العداء للنخب، والهجرة، والإعلام، ونجح في حشد قاعدة جماهيرية واسعة حوله، ما مكّنه من الوصول إلى سدة الحكم عام 2016. بعد توليه الرئاسة، ترجم هذا الخطاب إلى سياسات تنفيذية واضحة، من أبرزها فرض قيود صارمة على الهجرة، وتبني الحمائية الاقتصادية من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات الأجنبية، إلى جانب تقويض دور المؤسسات الفيدرالية التقليدية، كالإعلام والقضاء، وهو ما عُدّ مظهرًا من مظاهر النزعة السلطوية المتصاعدة.[55]
مع نهاية ولايته الأولى، ورغم خسارته في انتخابات 2020، لم تتراجع النزعة الشعبوية التي مثلها، بل شهدت مزيدًا من الترسخ داخل الحزب الجمهوري، حيث أصبح الولاء لترامب عاملًا حاسمًا في صعود السياسيين داخل الحزب. دعم “ترامب” مرشحين يتبنون خطابه، وحافظ على شعبيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستمرًا في تأجيج خطاب الانقسام والاستقطاب. وفي حال عودته إلى الحكم من الجديد، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من تصعيد الخطاب الشعبوي، ومحاولات متزايدة لتوسيع سلطات الرئيس، ما قد يعمق من التحديات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية، ويحول الشعبوية من حالة عابرة إلى مكون بنيوي في الحياة السياسية للولايات المتحدة.[56]
ختاما، تمثل الشعبوية ظاهرة متجذرة في التاريخ السياسي الأمريكي، بدأت ملامحها منذ القرن التاسع عشر مع صعود الرئيس “أندرو جاكسون”، الذي يُعد أول من وظّف الخطاب الشعبوي لمخاطبة الجماهير خارج إطار النخبة السياسية التقليدية. وقد ظلت هذه الشعبوية حاضرة بأشكال متفاوتة في الخطاب السياسي الأمريكي، سواء من اليسار أو اليمين، لكنها بلغت ذروتها مع “دونالد ترامب”، الذي جسّد امتدادًا حديثًا لهذا النمط، مستندًا إلى خطاب يمزج بين القومية الاقتصادية، والعداء للمؤسسات، وتغذية مشاعر الاستياء الشعبي. فترامب لم يُعد إنتاج الشعبوية الأمريكية فقط، بل أعاد تشكيلها بما يتناسب مع تحولات المجتمع الأمريكي في ظل العولمة والاضطرابات الاقتصادية والثقافية، مقدمًا نموذجًا غير تقليدي للرئاسة الأمريكية، يكرّس فكرة الزعيم الشعبوي الذي يزعم احتكار تمثيل “الإرادة الحقيقية للشعب” في مواجهة ما يصورها كـ “نخبة فاسدة”.
هذا الامتداد التاريخي للشعبوية، من “جاكسون” إلى “ترامب”، يُظهر أن الشعبوية ليست مجرد ظاهرة عابرة أو طارئة، بل هي استجابة دورية لأزمات الثقة في النظام السياسي والتمثيل الديمقراطي، تعود للظهور كلما شعر قطاع من المجتمع بالتهميش أو فقدان السيطرة. لكنها في عهد ترامب اتخذت أبعادًا أكثر حدة، من خلال التشكيك في نتائج الانتخابات، وتغذية الانقسامات العرقية والثقافية، ومهاجمة الإعلام والمؤسسات القضائية، ما جعلها تتجاوز كونها أداة سياسية إلى كونها أزمة بنيوية تهدد استقرار الديمقراطية الليبرالية الأميركية نفسها. ومع استمرار تأثير “ترامب” داخل الحزب الجمهوري، فإن مستقبل الحياة السياسية الأمريكية يبدو مرشحًا لمزيد من الاستقطاب، ما لم تُطرح بدائل ديمقراطية تعيد بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. وهكذا، تظل الشعبوية الأمريكية، بتجلياتها التاريخية والمعاصرة، مرآة لقلق مجتمعي وسياسي عميق يتطلب قراءة نقدية واعية وجادة.
العوامل المحفزة لصعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية
عند تناول ظاهرة الشعبوية، كثيرًا ما يُستند إلى مفاهيم علم الاجتماع، وتحديدًا علم الاجتماع السياسي، لفهم أبعاد هذه الظاهرة وتحليل خطابها ومواقفها ولذلك يمكن تفسير الصعود الشعبوي وفقًا لهذه الأطروحات
- أطروحة الانهيار الاجتماعي:
تُشير بعض الدراسات إلى أن الأفراد الذين يعيشون في بيئات تعاني من التفكك الاجتماعي، والذين يشعرون بالعزلة وفقدان الروابط التقليدية كالانتماء الطبقي أو الديني، يكونون أكثر ميلًا لدعم الحركات الشعبوية. فهذه الحركات تُعيد لهؤلاء الأفراد شعورًا بالانتماء والثقة بالنفس، مما يفسر جزءًا من جاذبيتها.[57]
- أطروحة الشعور بالحرمان النسبي:
يُعد الإحساس بالحرمان النسبي دافعًا أساسيًا لدى بعض الأفراد لتأييد الشعبوية، سواء من خلال مقارنة أوضاعهم الحالية بماضيهم، أو من خلال المقارنة مع فئات اجتماعية أخرى. ويؤكد سمور مارتن لبيست (2291–6002) أن الحركات الشعبوية غالبًا ما ترتكز على مشاعر الإقصاء والإحباط، مما يمنحها طابعًا نفسيًا–اجتماعيًا خاصًا.[58]
- أطروحة التنافس العرقي:
يُعَد التنافس العرقي أحد المحركات الأساسية للشعبوية، حيث ينجذب بعض الأفراد إلى الخطاب الشعبوي بسبب خشيتهم من فقدان الموارد المحدودة لصالح المهاجرين، مثل فرص العمل، والرعاية الصحية، والسكن. هذا الشعور يُغذّي التصورات القومية التي تلعب عليها الحركات الشعبوية.[59]
وتُظهر التجربة الأمريكية أن صعود الشعبوية لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات وتفاعلات متعددة، دفعت قطاعًا كبيرًا من المجتمع نحو تبني هذا التيار، وتأييد قياداته وخطابه. وتشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة تتغذى على مشاعر التفكك الاجتماعي، والحرمان النسبي، والخوف من التعددية الثقافية، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية الكبيرة، والانقسامات السياسية العميقة.
وفيما يلي أبرز العوامل التي ساهمت في صعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية:
أولاً: العوامل الداخلية
- دور القادة الكاريزميين:
في كلتا الفترتين القديمة والمعاصرة، برز قادة يتمتعون بالكاريزما أعادوا تشكيل الخطاب السياسي وأعادوا توجيه السخط الشعبي نحو النخب. مثّل “ويليام جينينغز براين” زعيمًا لحزب الشعب في تسعينيات القرن التاسع عشر، بينما لعب “دونالد ترامب” الدور ذاته في العصر الحديث[60] حيث اتهم “ترامب” النخب السياسية بـ “الغباء” والعجز عن حماية مصالح الأمريكيين، وظهر كـ “رجل أعمال ناجح” من خارج المؤسسة السياسية، مما منحه صورة المنقذ القادر على إعادة “عظمة أمريكا”. وقد وجد صدى واسعًا بين فئات فقدت الثقة في السياسيين والمؤسسات الحزبية التقليدية وقد اعتمد كلا القائدين على لغة شعبوية تُصور “الشعب الطيب” في مواجهة “النخبة الفاسدة”، ورفضا القيم الليبرالية العالمية لصالح القومية والهوية الأمريكية الأصيلة.[61]
- القلق الثقافي والتعددية العرقية:
ظهرت موجة من القلق بين بعض شرائح السكان، خصوصًا البيض من الطبقة العاملة، نتيجة تغيّر التركيبة السكانية وزيادة التنوع العرقي والثقافي. هذه الفئة شعرت بأن “القيم الأمريكية التقليدية” مهددة[62]، وقد أبدت القاعدة الداعمة لترامب، قلقها من احتمال تحوّلهم إلى أقلية بحلول عام 2020، بفعل تزايد أعداد المهاجرين من أصول لاتينية. هذا الخوف من “فقدان الهيمنة العرقية” لعب دورًا مركزيًا في تعزيز الخطاب الشعبوي المعادي للأجانب.[63]
ثانيًا: العوامل الخارجية
- العولمة والتحول الاقتصادي الهيكلي:
ظهرت كلتا الحركتين الشعبويتين – القديمة والمعاصرة – في فترات من التغيرات الاقتصادية الجذرية نتيجة العولمة والتغير التكنولوجي. ففي تسعينيات القرن التاسع عشر، كانت الزراعة تمر بمرحلة تحول إلى النشاط التجاري، حيث أصبح المزارعون يعتمدون على شبكات السكك الحديدية والتجار والمصارف لنقل منتجاتهم إلى الأسواق، بدلًا من الاكتفاء الذاتي، ما عرضهم لتقلبات الأسعار واحتكار الخدمات، وزاد من شعورهم بالعجز والغضب تجاه النخب. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة موجة جديدة من العولمة تمثلت في فتح الأسواق، والمنافسة مع الصين، وتقنيات التصنيع المتقدمة، ما تسبب في خسارة وظائف صناعية وتراجع الأجور، خاصة بين الطبقة العاملة البيضاء، وهو ما غذّى الاستياء الشعبي وسهّل صعود خطاب ترامب الشعبوي.[64]
- هجمات ١١ ستمبر ٢٠٠١:
كانت صدمة هجمات ١١ سبتمبر سببًا كافيًا السيطرة أنصار التفكير الشعبوي المحافظين الجدد على الحياة السياسية الأمريكية مطلقين شعارات أسست لخطاب يحمل هذا الطابع كشعار ” لماذا يكرهوننا “؟ وكذلك شعار بوش” من ليس معنا فهو ضدنا” مسكين اي صوت يرىد التعامل مع الصدمة بعقلانية، لتجد الأفكار الشعبوية اليمينية الفرصة للتمديد في المجتمع الأمريكي مرة أخرى. [65]
- الخوف من التهديدات الخارجية:
لعبت وسائل الإعلام المحافظة، مثل “فوكس نيوز”، دورًا في تضخيم التهديدات الخارجية (داعش، إيران)، وتعزيز صورة “أوباما غير القادر على حماية البلاد”، مما عزز من الحاجة إلى خطاب شعبوي.[66]
وتنهض الشعبوية في الولايات المتحدة على عدة مرتكزات:[67]
- الاتجاه نحو زعزعة الأوضاع السياسية والرغبة الجامحة في تغيير مسار الحكم، مع إعادة بناء مؤسساته وتحديد سلطاته.
- الادعاء بأن مصدر السلطة الوحيد في الأنظمة الديمقراطية هو الشعب الذي يمثل الأغلبية الصامتة التي تدافع عن الوطن، ومن ثم استخدام هذا التوجه كذريعة للطعن والتشكيك في وطنية كل من يعارضه.
- تحدي مؤسسات النخبة الحاكمة، بل والتشكيك في ادائها والهجوم على رموزها ووصمها بسمات سلبية فضلاً عن الهجوم على وسائل الإعلام الذي ينشر الإشاعات، وُيثير الاحتجاجات المأجورة وكذلك وصف القضاة بأنهم أعداء الشعب والعلماء على أنهم لا حاجة لهم والسياسيين بالفاسدين الذين يجب التخلص منهم.
- غلبة النعرة العنصرية والتوجه نحو معاداة الأجانب وخاصة العرب والمسلمين، مما يعزز شعور الأمريكان بالتفوق الثقافي والعرقي والحضاري الأمر الذي ُيغذى توجه الانعزالية لدى الشعب الأمريكي.
- التعامل مع السياسة ليس على أسس ديمقراطية، وإنما باللجوء إلى التلاعب في العملية الانتخابية وشراء أجهزة الإعلام والتحكم في المؤسسات وإثارة الشارع تمهيداً للمطالبة بالاستجابة لمطالبه.
- الهبوط بمستوى الخطاب السياسي إلى درجة استخدام الألفاظ السوقية والتشكيك في جدوى الوطنية.
ختامًا، يُبرز هذا الفصل كيف أن الشعبوية في الولايات المتحدة ليست مجرد حالة طارئة، بل ظاهرة متجذرة تتجدد كلما واجه النظام السياسي أزمات تمثيل أو فقدان ثقة. فقد كشف المبحث الأول عن الامتداد التاريخي للشعبوية، بينما حلل المبحث الثاني العوامل المحفزة لصعودها في السياقات المعاصرة. ويُعد هذا الفصل أساسًا لفهم التفاعل المعقّد بين الشعبوية والمؤسسات، تمهيدًا لتحليل انعكاساتها السياسية خلال فترة حكم “دونالد ترامب”.
بعد أن استعرضنا الخلفية التاريخية والعوامل المحفزة لصعود الشعبوية في الولايات المتحدة، سننتقل في الفصل الثالث إلى تحليل التأثير المباشر لصعود “دونالد ترامب” على المؤسسات السياسية الأمريكية، مع التركيز على التغيرات التي طرأت على آليات عملها وتوازناتها خلال فترة حكمه.
أثر صعود الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى
تمهيد
يتناول هذا الفصل دراسة أثر صعود الشعبوية الترامبية على المؤسسات السياسية الأمريكية، حيث مثلت رئاسة “دونالد ترامب” تحولا عميقًا في بنية النظام الديمقراطي الأمريكي. فقد تبنى “ترامب” خطابًا شعبويًا مناهضًا للنخب والمؤسسات التقليدية، مما أثر بشكل واضح على توازن السلطات والعلاقة بين فروع الحكم.
ينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ يتناول المبحث الأول ملامح السياسات الشعبوية خلال ولاية ترامب الأولى، من خلال تحليل الخطاب السياسي، واستراتيجيات استغلال القضايا الاجتماعية والدولية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بينما يناقش المبحث الثاني انعكاسات هذه الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية، خاصة الكونغرس، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، مع تقييم مدى تأثر النظام الديمقراطي الأمريكي بتلك التحولات.
يهدف هذا الفصل إلى فهم طبيعة التغيرات المؤسسية الناتجة عن صعود النزعات الشعبوية، واستشراف تداعياتها على استقرار الديمقراطية الأمريكية مستقبلاً.
شكلت سياسات “دونالد ترامب” الشعبوية تحولًا لافتًا في المشهد السياسي الأمريكي، حيث اعتمد على خطاب مباشر يستند إلى استثارة المشاعر الوطنية والقلق الاجتماعي. تبنى “ترامب” مواقف معادية للنخب التقليدية والمؤسسات الدولية، مقدّمًا نفسه كصوت للأمريكي العادي في مواجهة ما اعتبره نظامًا عالميًا فاسدًا. اتسمت سياساته بالتشكيك في القضايا العلمية، وتفضيل القرارات الأحادية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية للتواصل مع الجماهير. من خلال هذه الاستراتيجية، استطاع “ترامب” إعادة تشكيل الخطاب السياسي الأمريكي وصياغة قاعدة جماهيرية واسعة تقوم على مبادئ القومية والحمائية الاقتصادية.
- تبني عقيدة “أمريكا أولاً” كمرجعية سياسية جديدة:
منذ فوزه الأول عام 2016، عمل ترامب على تأسيس عقيدة جديدة في السياسة الأمريكية شعارها “أمريكا أولاً”، بحيث تكون جميع القرارات مبنية على حماية المصالح الوطنية الأمريكية داخليًا وخارجيًا. هذه العقيدة تستلهم بعض مبادئ العقائد السياسية السابقة مثل عقيدة “ريغان” و”مونرو”، لكنها تتميز بطابع شعبوي واضح، يرتكز على المشاعر الوطنية والقرارات الأحادية بعيدًا عن النماذج السياسية التقليدية. يظهر ذلك في مشاريع مثل إعادة بناء القبة الحديدية، ومحاولة السيطرة الاستراتيجية على مناطق مثل قناة بنما وكندا.[68]
- استغلال وسائل التواصل الاجتماعي:
استخدام “ترامب” لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، كان أحد الأدوات الرئيسية في حملته الشعبوية. من خلال التغريدات التي استفزت الرأي العام واستهدفت القضايا الاجتماعية والعرقية مثل الهجرة والإرهاب، استطاع “ترامب” تعزيز مكانته بين مؤيديه. كانت التغريدات التي يصف فيها المهاجمين المسلمين بالإرهابيين أو يحرض على كراهية الإسلام جزءًا من استراتيجية شعبوية تهدف إلى تأجيج القلق والخوف من الآخر، مما ساعد في تعزيز خطابه الشعبوي.
- رفض المؤسسات الدولية والنظام العالمي:
الخطاب الشعبوي الذي اعتمده “ترامب” كان يعتمد على رفضه للمؤسسات الدولية والنظام العالمي الذي وصفه بالفاسد. اعتبر “ترامب” أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مصالحها الوطنية وتبتعد عن الالتزامات الدولية. هذه المواقف كانت جزءًا من استراتيجية لتقديم نفسه كحامي لمصالح الشعب الأمريكي على حساب التعاون الدولي، وهو ما زاد من شعبيته بين من يشعرون بأن الولايات المتحدة قد تم استغلالها في النظام الدولي.[69]
- حماية مكاسب الأمريكي الأبيض وتعزيز التفوق العرقي:
سياسات “ترامب” تركز على الحفاظ على الأغلبية البيضاء في المجتمع الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية الناجمة عن الهجرة من أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى. في هذا السياق، قاد حملات لطرد المهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن الحفاظ على الغالبية البيضاء أمر ضروري لحماية الثقافة والقيم الأمريكية.[70] كما نجح في جذب دعم الطبقات العاملة البيضاء التي شعرت بالإحباط بسبب تراجع الاقتصاد الصناعي، خاصة في مناطق مثل Dundlak، حيث كانت هناك مخاوف من المهاجرين والتغيرات العرقية، مما ساهم في صعود شعبويته. قدم نفسه كمنقذ لهذه الطبقات، ووعد بحماية حقوقهم الاقتصادية.[71] كما عارض برنامج “DACA”، الذي كان يوفر الحماية للأطفال المهاجرين غير الشرعيين، مما أضاف إلى موقفه المعادي للهجرة.[72]
سياسات “دونالد ترامب” الشعبوية خلال أزمة كورونا:
- التحقير من شأن أزمة كورونا:
قلل ترامب، كغيره من الزعماء الشعبويين، من خطورة جائحة كورونا، مروجًا لخطابات تنكر خطورة الفيروس، ورافضًا القواعد العلمية. صاحب ذلك محاولات لتشويه الأدلة العلمية، وتبني مواقف غير مدعومة علميًا، مما أدى إلى استجابة مضطربة للأزمة.
- التقليل من دور المتخصصين وأهل الخبرة:
اتسم خطاب “ترامب” بالعداء تجاه النخب، خاصة العلمية، فهاجم العلماء والخبراء الطبيين وقلل من أهمية نصائحهم، مما أضعف فعالية السياسات الصحية، في نمط عام للشعبويين[73].
- ادعاء المعرفة:
اعتمد “ترامب” على إطلاق معلومات غير دقيقة عن الفيروس، مثل الزعم بأن الطقس الحار سيقضي عليه، وأنه أقل خطرًا من الإنفلونزا. كما روّج لاستخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” رغم التحذيرات العلمية، مما يعكس ميلًا شعبويًا لادعاء المعرفة في مسائل علمية متخصصة.
- تبني نظرية المؤامرة:
اتهم “ترامب” الصين بالمسؤولية عن انتشار الفيروس، وأشار لاحتمال تسربه من مختبرات بيولوجية، مما ساهم في زعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية وإضعاف جهود الاستجابة للأزمة.[74]
- الهجوم على المؤسسات الدولية:
أوقف “ترامب” تمويل منظمة الصحة العالمية متهمًا إياها بالانحياز للصين، وهدد بالانسحاب الكامل منها. كما انتقد أداء المنظمة خلال الجائحة وقطع العلاقات معها، مؤكدًا تحويل التمويل لمجالات صحية أخرى.[75]
- سياسة دونالد ترامب تجاه قضية التغير المناخي:
اتخذ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مواقف شعبوية حيال تغير المناخ، وكانت هذه السياسات تنبع من توجهاته اليمينية التي تركز على التشكيك في وجود تغير المناخ وتأثيره البشري. يمكن التمييز بين هذه السياسات على مستويين: الخطاب السياسي والسياسات التنفيذية.
على مستوى الخطاب السياسي: قبل وصوله إلى الرئاسة، كان “ترامب” قد شكك في وجود تغير المناخ عبر العديد من التغريدات على تويتر، مدعيًا أن الصين هي من صنعت فكرة تغير المناخ لصالحها. كما وصف “ترامب” التغير المناخي بأنه “خدعة” واعتبر أن العلماء كانوا يكذبون على الشعب الأمريكي بشأنه. وقد أعاد “ترامب” نشر العديد من التغريدات التي تشير إلى أن الطقس البارد في بعض الفترات يعارض نظرية الاحتباس الحراري. حتى عندما أقر بوجود علاقة بين النشاط البشري وتغير المناخ، فإنه عارض أي تحرك جاد للتعامل مع هذه القضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الطاقة وأنه لن يضحي بثروات الولايات المتحدة من أجل معالجة هذه المشكلة.[76]
على مستوى السياسات: خلال فترة رئاسته، تبنى “ترامب” سياسات متناقضة مع النهج الذي تبنته إدارة “أوباما”. فقد ألغى العديد من التشريعات البيئية، منها خطة “الطاقة النظيفة” التي كانت تهدف إلى الحد من الانبعاثات في قطاع الطاقة. كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ التي كانت تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون على مستوى العالم. عمل أيضًا على تقليص تمويل وكالة حماية البيئة الأمريكية وتعيين مسؤولين في المناصب الحكومية يتبنون شكوكًا حول تأثيرات تغير المناخ. وكان هدفه الأساسي هو دعم الصناعات المحلية مثل الفحم والنفط، حيث اعتبر أن سياسة أوباما قد أضرت بالوظائف في هذه القطاعات.[77]
كما عمل “ترامب” على حذف جميع الصفحات المتعلقة بتغير المناخ من موقع البيت الأبيض وحذف المعلومات التي كانت تقدمها وكالة حماية البيئة. وقد اتخذ إجراءات لتفعيل صناعة الفحم من خلال إلغاء السياسات البيئية التي كانت تحد من استخدامها، مشيرًا إلى أن ذلك ضروري لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية الوظائف المحلية.
بإجمال، كان موقف “ترامب” تجاه تغير المناخ يعكس تفضيلًا للاقتصاد الأمريكي على سياسات بيئية جماعية، وتركيزًا على حماية الصناعات الوطنية من أي تأثير سلبي قد تسببه السياسات البيئية العالمية.[78]
أهم مظاهر الشعبوية في الخطاب السياسي للرئيس “ترامب”:
يتسم “دونالد ترامب” بالغرور والنرجسية ووضوح الأنا العليا في خطاباته، حيث يظهر ذلك في وضع اسمه على مبانٍ مثل أبراج ترامب وكازينو ترامب. كما يقدّم نفسه دائمًا كمخلّص وصوت للناس المنسيين، موهمًا بقدرته على حل مشكلاتهم. في خطاب تنصيبه عام 2017، أكد أن الشعب أصبح حاكم الأمة، مستخدمًا الضمير “أنا” 256 مرة. وقدّم حلولًا سطحية لقضايا معقدة مثل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، واصفًا المكسيكيين بالمغتصبين والمجرمين. بنى لمؤيديه عالماً مثالياً بالوعود الرمزية. استخدم لغة بسيطة وعاطفية عند الحديث عن الجدار وخطر المسلمين والعظمة الأمريكية، وهي لغة تتسم بالغموض وعدم الدقة، بما يعكس طبيعة الخطاب الشعبوي.[79]
غالبًا ما يستخدم “ترامب” في خطبه مصطلحات شعبوية مثل “النخبة” و”الشعب”، حيث يحمّل النخب المالية والسياسية مسؤولية الأزمات الاقتصادية. في أحد خطاباته، قال: “قوبل ولاء عمالنا بخيانة تامة”، مشيرًا إلى أن سياسات العولمة أدت إلى فقدان الوظائف ونقل الثروات والمصانع إلى الخارج. كما اعتبر أن العولمة ساعدت النخبة المالية على الثراء على حساب العمال. استغل “ترامب” هذه الفكرة الشعبوية لتحديد المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهم النخب المالية والسياسية، وربطها بمفهوم “الخيانة”. كما أشار إلى “الشعب الأمريكي ” كمرادف للعمال في الولايات الوسطى والجنوبية، الذين يعانون من انخفاض الأجور وفقدان الوظائف نتيجة العولمة والاتفاقيات التجارية السيئة التي أبرمتها الإدارات السابقة.[80]
ركز خطاب “ترامب” الشعبوي على معارضة النخبة والهجرة والحدود الدولية الجماعية. ومنها الاتفاقيات التي أبرمتها واشنطن مع الدول الأخرى، ومع المنظمات الدولية. ويعتبر أن الأولويات السياسية الخارجية الأمريكية كانت تصب في مصلحة الخارج، أكثر من المصلحة المحلية للولايات المتحدة. ويرى أن اتفاقيات دولية، مثل النافتا أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ “صفقات سيئة”، لأنها تحقق النجاح للدول الأخرى، وليس للولايات المتحدة. وعبر نقل فرص العمل من المناطق الصناعية في الوسط الغربي الأمريكي.[81]
توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب:
بعد إعلان فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن من نوفمبر 2016 أطلق “ترامب” العديد من التصريحات، ويمكن تقسيم خطاباته في مجال السياسة الخارجية إلى شقين شق متعلق بالسياسة الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها مع خصومها وحلقاتها، والشق الثاني متعلق بسياساتها الاقتصادية والتجارية. فأمنيا يرى “ترامب” آن علاقات بلادة الأمنية وتحالفاتها العسكرية منذ الحرب الباردة بانت تشكل عبئًا اقتصاديا كبيرا عليها.[82]
وبذلك إن أهم منطلقات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة تظهر فيما يلي : [83]
- يُعد “ترامب” من أصحاب مبدأ العزلة في السياسة الخارجية isolationist، حيث يرى أنه لا داعي للولايات المتحدة في التدخل لتنظيم شؤون العالم وحل مشاكله.
- لا يؤمن “ترامب” بفكرة التدخل الإنساني Humanitarian intervention. وفي حال تهديد مصالحها فيجب عليها التدخل العسكري الأحادي دون الاعتماد على أطراف أخرى.
- يتبنى الرئيس “ترامب” مبدأ الحماية التجارية للسوق الأمريكي ” protectionist”، ويشكك في مدى فعالية الاتفاقيات والمعاهدات والتحالفات التجارية الدولية.
وقد ارتكز “ترامب” في إستراتيجيته على أربعة محاور رئيسية وهي : [84]
- حماية أراضي الولايات المتحدة وشعبها ونمط الحياة الأمريكية وهذا بمحاربة التطرف والهجرة.
- طرح “ترامب” مبدأ فرض ” السلام باستخدام القوة. وتطوير هياكل القوات المسلحة الأمريكية ومنظومة الدفاع الصاروخية.
- تبنى الرئيس “ترامب” إستراتيجية أمريكا أولا”.
- ضرورة تعزيز النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة عالميا بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
وهكذا، يتضح أن التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة خلال فترة حكم “ترامب” كان انعكاسًا واضحًا للفكر الواقعي الجديد، حيث اتسم بالسعي المحموم نحو تعزيز الأمن القومي، وحماية المصالح الحيوية، وزيادة التأثير الدولي عبر أدوات القوة الصلبة وتفكيك التحالفات المناوئة. لقد رسمت إدارة “ترامب” سياسة خارجية قائمة على إعادة تعريف الأولويات الأمريكية، مع التركيز على حماية الدولة وتوسيع نفوذها، حتى وإن كان ذلك عبر تأجيج الصراعات وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية. في النهاية، فإن هذه الاستراتيجية تعبر عن إدراك عميق لتحولات النظام الدولي ومحاولة مستمرة للحفاظ على التفوق الأمريكي وسط عالم متغير.
تأثير الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى
تُعدّ المؤسسات السياسية الأمريكية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة، حيث تمثل الضمانة لتحقيق مبدأ فصل السلطات وضمان التوازن بينها. ومع وصول “دونالد ترامب” إلى سدة الحكم عام 2017، دخل النظام السياسي الأمريكي مرحلة غير مألوفة اتسمت بالتحدي العلني للأعراف والمؤسسات، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية. فقد تبنى “ترامب” أسلوبًا صداميًا مع خصومه السياسيين، وعبّر مرارًا عن عدم رضاه عن أداء مؤسسات الدولة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثير سياساته على تماسك واستقلالية هذه المؤسسات.
أولا: تأثير الشعبوية على الكونغرس خلال ولاية ترامب الأولى:
شهدت ولاية “دونالد ترامب” الأولى تحولات ملحوظة في طبيعة العلاقة بين الرئاسة والكونغرس الأمريكي، حيث فرضت النزعة الشعبوية لترامب نمطًا غير تقليدي من التعامل مع المؤسسات التشريعية. وقد انعكست هذه التحولات في سلسلة من الصراعات، ومحاولات العزل، وتوسيع استخدام الصلاحيات الرئاسية، مما أثر بوضوح على مسار العملية التشريعية في الولايات المتحدة.
- الصراعات مع الكونغرس:
خلال ولايته الأولى، تميزت علاقة الرئيس “دونالد ترامب” بالكونغرس بالصراعات المتكررة، حتى مع وجود أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ. كانت هذه الصراعات ناتجة عن اختلافات في الرؤى والسياسات بين ترامب وأعضاء الكونغرس، بما في ذلك أعضاء حزبه. على سبيل المثال، كانت هناك خلافات حول قضايا مثل تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وإصلاح نظام الرعاية الصحية، وسياسات الهجرة. هذه الصراعات أدت إلى تعطيل العديد من المبادرات التشريعية التي حاول ترامب تمريرها، مما أثر على فعالية إدارته في تنفيذ أجندتها السياسية وفي خضم هذه الصراعات السياسية والتشريعية، تصاعد التوتر بين ترامب وبعض أعضاء الكونغرس إلى مستويات غير مسبوقة، ليتحول لاحقًا إلى مساعٍ رسمية لعزله من منصبه.[85]
- محاولات العزل:
تعرض “ترامب” لمحاولتي عزل خلال ولايته الأولى، الأولى في عام 2019 والثانية في عام 2021. كانت المحاولة الأولى نتيجة لمكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، حيث اتهم “ترامب” بمحاولة الضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة جو بايدن وابنه. أما المحاولة الثانية فجاءت بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث اتهم “ترامب” بالتحريض على التمرد. في كلتا الحالتين، تم تبرئة ترامب من قبل مجلس الشيوخ، لكن هذه المحاولات أثرت بشكل كبير على علاقته بالكونغرس وزادت من حدة الاستقطاب السياسي في البلاد.[86]
في المحاولة الأولى، اتهم “ترامب” بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد أن طلب من الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” التحقيق في أنشطة “جو بايدن” وابنه “هانتر بايدن”، مما أثار جدلاً واسعاً حول تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية [87]. أما المحاولة الثانية فجاءت بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث اتهم “ترامب” بالتحريض على التمرد من خلال خطاباته وتصريحاته التي شجعت أنصاره على اقتحام المبنى، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص وجرح العديد.[88]ومع تصاعد المواجهات مع الكونغرس، اتجه “ترامب” بشكل متزايد إلى استخدام صلاحياته الرئاسية المباشرة كوسيلة لتجاوز الجمود التشريعي وفرض أجندته السياسية.
- استخدام صلاحياته الرئاسية:
استخدم “ترامب” صلاحياته الرئاسية بشكل مكثف خلال ولايته الأولى، بما في ذلك إصدار العديد من الأوامر التنفيذية لتجاوز الكونغرس في بعض القضايا. على سبيل المثال، أصدر “ترامب” أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة، مثل حظر السفر على مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وإلغاء برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين المعروف بـ DACA. كما استخدم صلاحياته لإلغاء العديد من اللوائح البيئية التي تم تبنيها خلال إدارة “أوباما”. هذا الاستخدام المكثف للأوامر التنفيذية أثار جدلاً واسعاً حول حدود السلطة التنفيذية ودورها في النظام السياسي الأمريكي.[89] ورغم الاعتماد المكثف على الأوامر التنفيذية، إلا أن “ترامب” تمكن في بعض الحالات من تحقيق إنجازات تشريعية كبرى بموافقة الكونغرس، ما يستدعي الوقوف على أبرز هذه النجاحات والإخفاقات.
خلاصة القول لقد أفرزت علاقة “دونالد ترامب” بالكونغرس خلال ولايته الأولى نمطًا جديدًا من التفاعل بين الرئاسة والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة، اتسم بالصراع وعدم الاستقرار حتى مع وجود أغلبية جمهورية. فقد أدت الخلافات السياسية، ومحاولات العزل المتتالية، واللجوء المكثف إلى الأوامر التنفيذية إلى زعزعة التقاليد الراسخة في العلاقة بين السلطتين، وكشفت عن هشاشة بعض الآليات الدستورية أمام أسلوب القيادة الشعبوي الذي تبناه “ترامب”. وعلى الرغم من بعض النجاحات التشريعية، مثل تمرير قانون التخفيضات الضريبية، فإن إرث ترامب في تعامله مع الكونغرس يتمثل أساسًا في تكريس حالة من الاستقطاب السياسي وتعميق الانقسامات داخل النظام السياسي الأمريكي.
ثانياً: تأثير الشعبوية على المؤسسة التنفيذية الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى:
تُعد فترة رئاسة “دونالد ترامب” واحدة من الفترات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ السياسة الأمريكية، حيث شهدت تغييرات جذرية في طريقة ممارسة السلطة التنفيذية. لقد اتسمت رئاسة ترامب بصعود نمط جديد من الشعبوية الخطابية التي اعتمدت بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، كأداة مركزية لصنع القرار وتوجيه الرأي العام. يشير تحليل الخطاب الترامبي إلى أن الرئيس تجاوز القنوات التقليدية لصنع السياسات التنفيذية، معتمدًا على التواصل المباشر مع الجمهور لدفع أجندته السياسية وتبرير إجراءاته. وقد أسفر هذا النمط عن تآكل بعض الضوابط المؤسسية التقليدية، حيث استُخدم الإعلان عن القرارات المهمة عبر تغريدات مفاجئة بدلًا من اتباع الآليات الإدارية الرسمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتحويل الأموال نحو بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، متجاوزًا السلطة التشريعية للكونغرس. وبالتالي، شكّل الخطاب الشعبوي الترامبي تحديًا للبنية المؤسسية التقليدية، إذ أضعف من آليات المساءلة والتوازن داخل السلطة التنفيذية، ورسّخ نزعة تركّز السلطة في شخص الرئيس بدلًا من المؤسسة ككل.[90]
- تغييرات جذرية في السلطة التنفيذية:
شهدت المؤسسة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية تغييرات جذرية نتيجة لارتفاع الشعبوية الترامبية، حيث أثر الرئيس “دونالد ترامب” بشكل كبير على توازن السلطات من خلال توسيع سلطاته التنفيذية. لقد تميزت فترة حكمه بتحدي الأعراف الدستورية والتقليدية التي تحكم العلاقة بين فروع الحكومة، مما أدى إلى تعزيز دوره في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بعيدًا عن الإشراف المؤسسي.
علاوة على ذلك، قام ترامب بتطبيق سياسات تهدف إلى تقليص دور المؤسسات الرقابية مثل الكونغرس والمحاكم، مما أثر بشكل مباشر على النظام الديمقراطي الأمريكي. تم تسييس العديد من الأجهزة التنفيذية، وتعرضت قنوات الاتصال مع باقي الفروع الحكومية للضعف، مما أضر بالحيادية والكفاءة الإدارية التي كانت تتمتع بها هذه المؤسسات.[91]
- الشعبوية وتحدي المؤسسات خلال عهد ترامب:
النهج الشعبوي الذي اتبعه “ترامب” خلق حالة من الانقسام بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى، وفتح المجال للتساؤلات حول قدرة النظام السياسي الأمريكي على الحفاظ على توازن القوى في ظل هذه التوجهات. هذا التحول في سياسات الحكومة التنفيذية ألقى بظلاله على مستقبل الديمقراطية الأمريكية في مواجهة الشعبوية والصراعات الداخلية بين السلطات.
- تحدي المؤسسة التنفيذية:
ترامب صوّر نفسه كـ “شخص من خارج النخبة والمؤسسة الأمريكية” وهو ما كان محورياً في جاذبيته بين الناخبين الأمريكيين. في حملاته الانتخابية، لم يستهدف فقط الحزب الديمقراطي، بل أيضًا الأفراد داخل الحزب الجمهوري الذين كانوا يشككون في ترشيحه، وهو ما يعكس تحديًا مباشرًا للمؤسسة التنفيذية داخل النظام السياسي الأمريكي. لم يكن “ترامب’ يهتم كثيرًا بالقواعد التي تحكم العلاقة بين الفروع المختلفة في الحكومة، مما أدى إلى تعميق الاستقطاب في الداخل الأمريكي.[92]
- الخطاب المناهض للمؤسسة:
من خلال شعارات مثل “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (ماجا)، والتي حملت طابعًا مناهضًا للمؤسسة، كان “ترامب” يشير إلى أن السياسة التقليدية والسياسات المؤسسية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في الماضي قد فشلت في تقديم مصالح الشعب الأمريكي. في الوقت نفسه، دعم “ترامب” القومية الاقتصادية التي ركزت على دعم الصناعات الأمريكية وزيادة الوظائف داخل الولايات المتحدة، ما كان يتعارض مع سياسات العولمة التي يدعمها أعضاء المؤسسة التنفيذية.
- مناهضة النظام المؤسسي:
كان هدف “ترامب” هو “تجفيف المستنقع” في واشنطن، وهو ما يوضح عزمه على مواجهة المؤسسة التنفيذية القائمة وتقديم سياسات مناهضة للنظام الذي شكله الجيل السابق من السياسيين الأمريكيين. عارض “ترامب” بوضوح الإجراءات السياسية التقليدية التي تبنتها المؤسسة في عقود مضت، وكرر رفضه للأحكام القضائية التي تتعارض مع أجندته.
- مواجهة النخبة السياسية:
كان الخطاب الذي تبناه ترامب ينطوي على التصعيد ضد ما وصفه بـ “النخبة الفاسدة” من داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتي اعتقد أنها تعيق تحقيق مصالح الشعب الأمريكي. هذا الاستهداف للمؤسسة التنفيذية ساهم في تعزيز ثقافة معاداة المؤسسة.
- استمرار الاستقطاب داخل المؤسسات السياسية:
من خلال مهاجمته المستمرة للكونغرس والمحاكم ووسائل الإعلام، عمل “ترامب” على تقويض الضوابط والتوازنات التي تشكل الأساس في الحكومة الأمريكية. إصرار “ترامب” على رفض الانصياع لقرارات بعض هذه المؤسسات يوضح تأثيره العميق في تقويض الهيكل التنفيذي القائم.[93]
خلاصة القول لقد شكلت رئاسة “ترامب” تحديًا كبيرًا للبنية المؤسسية التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثرت الشعبوية الترامبية بشكل ملحوظ على قدرة السلطة التنفيذية على العمل ضمن إطار الضوابط والتوازنات التي تميز النظام السياسي الأمريكي. يتطلب هذا التحول في السياسات الحكومية إعادة التفكير في كيفية الحفاظ على توازن القوى داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، وضمان استمرارية النظام الديمقراطي في مواجهة التحديات الشعبوية المستقبلية.
ثالثا: تأثير الشعبوية على القضاء خلال ولاية ترامب الأولى:
شهدت فترة ولاية “دونالد ترامب” الأولى كرئيس للولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على القضاء الأمريكي، خاصة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية. هذا التأثير كان نتيجة لسياسات تعيين القضاة المحافظين، ومواقفه من قرارات المحاكم. يمكن القول إن “ترامب” سعى إلى إعادة تشكيل القضاء الأمريكي بطرق تعكس توجهاته السياسية والشعبوية.
- سياسات تعيين القضاة المحافظين:
تبنّى ترامب استراتيجية ممنهجة لملء المحاكم الفيدرالية بقضاة محافظين شباب نسبيًا، لضمان استمرار تأثير سياساته على مدى عقود قادمة. بلغ عدد القضاة الذين عينهم “ترامب” في فترة رئاسته الأولى نحو 234 قاضيًا، شملوا ثلاثة من قضاة المحكمة العليا (نيل غورساتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت)، إلى جانب 54 قاضيًا في محاكم الاستئناف، وأكثر من 170 قاضيًا في المحاكم الابتدائية الفيدرالية.استند “ترامب” إلى مشورة جمعية الفيدراليين (Federalist Society) — وهي منظمة قانونية محافظة مؤثرة — في اختيار مرشحيه القضائيين، مما جعل معظم المعينين يعتنقون توجهات قانونية نصية وأصولية في تفسير الدستور، هو ما يعكس توجهًا محافظًا في القضاء الأمريكي.[94]
- تأثير التعيينات على التنوع الديموغرافي:
أدت سياسات “ترامب” في تعيين القضاة إلى تقليل التنوع الديموغرافي في القضاء الفيدرالي. فقد عين ترامب عدداً أقل من القضاة من الأقليات والنساء مقارنة بالرؤساء السابقين، مما أدى إلى تراجع التنوع الذي كان يتزايد في العقود السابقة،هذا التوجه أثار قلقاً بشأن تسييس القضاء وجعله أقل تمثيلاً للشعب الأمريكي.[95]
- مواقفه من قرارات المحاكم:
خلال ولاية “دونالد ترامب” الأولى، أثرت مواقفه وتعييناته القضائية بشكل كبير على قرارات المحكمة العليا الأمريكية، خاصة في قضايا حقوق الإجهاض وحقوق مجتمع الميم. في عام 2022، أصدرت المحكمة العليا قرارًا في قضية “دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون”، ألغت فيه الحكمين السابقين في قضيتي “رو ضد ويد” و”بلاند بارينتهود ضد كيسي”، مما أعاد السلطة لتنظيم الإجهاض إلى الولايات الفردية، وأدى إلى فرض حظر أو قيود شديدة على الإجهاض في عدة ولايات. ثلاثة من القضاة الذين صوتوا لصالح هذا القرار—نيل غورساتش، بريت كافانو، وآمي كوني باريت—تم تعيينهم من قبل “ترامب” خلال ولايته الأولى، مما يعكس تأثير تعييناته على التوجه المحافظ للمحكمة. في عام 2023، حكمت المحكمة العليا لصالح مصممة مواقع إلكترونية رفضت تقديم خدماتها لحفلات زفاف المثليين، مستندة إلى حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور، في قضية “303 كرييتيف ضد إيلينيس”. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض تراجعًا عن حقوق مجتمع الميم، بينما رآه آخرون تعزيزًا لحرية التعبير مرة أخرى، كان للقضاة المعينين من قبل ترامب دور حاسم في هذا القرار، مما يبرز تأثيره المستمر على تشكيل السياسات القضائية المتعلقة بالحقوق المدنية.[96]
خلاصة القول، خلال فترة ولاية “دونالد ترامب” الأولى، أحدثت تعييناته القضائية تحولًا كبيرًا في النظام القضائي الأمريكي، حيث سعى إلى تشكيل محاكم فيدرالية تتماشى مع توجهاته السياسية. تم تعيين 234 قاضيًا في المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، مما أدى إلى تحول ملحوظ في التوجهات القانونية للمحاكم. اعتمد “ترامب” بشكل كبير على توصيات جمعية الفيدراليين لاختيار القضاة، مما ساهم في تعيين قضاة ذوي توجهات محافظة. هذا التوجه أثار مخاوف بشأن تقليل التنوع الديموغرافي في القضاء، حيث كانت نسبة القضاة من الأقليات والنساء أقل مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، أثارت مواقفه من بعض القرارات القضائية، مثل قضية “دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون”، جدلاً واسعًا حول تأثير التعيينات القضائية على السياسات الاجتماعية. بالمجمل، يمكن القول إن تأثير ترامب على النظام القضائي الأمريكي كان ذا طابع محافظ، مع تركيز على تعيين قضاة يتفقون مع رؤيته السياسية، وهو ما قد يكون له تداعيات طويلة الأمد على تطور النظام القضائي في الولايات المتحدة.
ختامًا، شكلت الحقبة الترامبية منعطفًا حاسمًا في السياسة الأمريكية، حيث أعادت الشعبوية صياغة الخطاب وتفاعلات المؤسسات. أظهرت كيف يستغل الزعيم الشعبوي المشاعر العامة ويتحدى الأعراف المؤسسية لتغيير السياسات.
وخلال ولايته الأولي، أحدثت الشعبوية الترامبية تحولًا عميقًا في المؤسسات السياسية الأمريكية، حيث سعى إلى إعادة تشكيلها بما يتماشى مع رؤيته السياسية. في السلطة التشريعية، تصاعدت حدة الصراعات بين الرئاسة والكونغرس، حتى مع وجود أغلبية جمهورية، مما أدى إلى تعطيل العديد من المبادرات التشريعية. أما في السلطة التنفيذية، فقد استخدم “ترامب“ صلاحياته بشكل موسع، معتمدًا على الأوامر التنفيذية لتجاوز الكونغرس، مما أثار مخاوف بشأن تآكل مبدأ فصل السلطات. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، قام بتعيين عدد كبير من القضاة المحافظين، مما أثر على التوازن الأيديولوجي داخل المحاكم الفيدرالية، وأثار جدلاً حول استقلالية القضاء. بالمجمل، يمكن القول إن شعبوية ترامب أدت إلى إضعاف الأعراف الديمقراطية التقليدية وزيادة الاستقطاب السياسي، مما أثار تساؤلات حول قدرة النظام السياسي الأمريكي على الصمود أمام مثل هذه التحديات.
استهدفت الدراسة الإجابة عن تساؤول رئيسي مفاده:”كيف أثر صعود الشعبوية على المؤسسات السياسية الأمريكية في عهد “دونالد ترامب”؟ للإجابة على هذا السؤال، كان علينا أولاً أن نفهم ما هي الشعبوية، وهو ما قمنا به في الفصل الأول.
من خلال تحليل الأفكار والنظريات المختلفة حول الشعبوية، وجدنا أنها ليست شيئًا واحدًا، بل هي مجموعة من الأفكار والحركات السياسية التي تتشابه في بعض النقاط. هذه النقاط تشمل التركيز على فكرة وجود صراع بين “الشعب النقي” و”النخبة الفاسدة، والاعتماد على قادة يتمتعون بشخصية قوية وجذابة.
كما أوضح الفصل الأول أن الشعبوية تنتشر لأسباب عديدة، منها تراجع ثقة الناس في السياسيين والمؤسسات، وزيادة الانقسام بين فئات المجتمع، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. هذه الأسباب تجعل الناس أكثر تقبلاً للخطاب الشعبوي، الذي يقدم نفسه كحل لمشاكلهم.
بعد ذلك، انتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة تاريخ الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تبين أن الشعبوية ليست ظاهرة جديدة في السياسة الأمريكية، بل ظهرت في أوقات مختلفة من التاريخ، ولكن بأشكال مختلفة.
ومع ذلك، فقد أوضحت الدراسة أن الشعبوية في العصر الحديث لها سمات جديدة، بسبب عوامل مثل العولمة، والتغيرات السكانية، وظهور وسائل الإعلام الحديثة. هذه العوامل ساهمت في انتشار الخطاب الشعبوي وتعبئة الجماهير حول قضايا مثل الهجرة والتجارة الدولية.
ثم جاء الفصل الثالث، وهو الأهم في الدراسة، ليركز على تأثير الشعبوية الترامبية على المؤسسات السياسية الأمريكية. وقد أظهر التحليل أن فترة حكم “ترامب” كانت فترة استثنائية في تاريخ السياسة الأمريكية، حيث تميزت بزيادة كبيرة في الخطاب الشعبوي، وتحدي الأعراف الديمقراطية التقليدية، وتوترات حادة في العلاقات بين السلطات المختلفة.
وقد تجلى ذلك في محاولات “ترامب” لتوسيع سلطاته الرئاسية، وانتقاده للقضاء ووسائل الإعلام، وتأثيره على الأحزاب السياسية. هذه الممارسات الشعبوية أثارت مخاوف بشأن استقرار النظام الديمقراطي الأمريكي.
ويمكن القول إن نتائج هذه الدراسة قد ساعدت في فهم أفضل للعلاقة المعقدة بين الشعبوية والمؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أظهرت الدراسة أن صعود الشعبوية الترامبية لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان ظاهرة عميقة تعكس تغييرات أوسع في المجتمع. كما أبرزت الدراسة أن المؤسسات السياسية الأمريكية واجهت تحديات كبيرة في التعامل مع الشعبوية.
وفي الختام، نأمل أن تكون الدراسة قد قدمت معلومات مفيدة حول هذا الموضوع المهم، وأن تشجع على المزيد من البحث والدراسة في المستقبل.
أولا: المراجع باللغة العربية:
أ-الدساتير:
١.دستور الولايات المتحدة الامريكية، المادة الأولى والمادة الثانية.
ب-الكتب:
١.اولتيت، إبراهيم، المتغير والثابت في الشعبوية (المغرب: جامعة الدول العربية، ٢٠١٧).
٢.حسن سيد، أحمد، النظام الساياسى للولايات المتحدة وانجلترا (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٧).
٣.منسي، ميلاد ممتاز، الكونجرس الامريكى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة (الامارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعى ،٢٠١٧).
ج-الدوريات العلمية:
- أبو طالب، حسن،” صراع الشعبوية والديموقراطية في الولايات المتحدة الامريكية”، مجلة آفاق استراتيجية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدد٢، (٢٠٢١)، ص ٦٨-٦٩.
- بكار، سعيد، “في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟”، مجلة سياسات عربية، العدد ٥٤، (يناير ٢٠٢٢)، ص١٤٨.
- الجوهري، محمد، يوسف، وعبد الرحمن، “محفزات صعود الشعبوية في الولايات المتحدة”، مجلة الديمقراطية، مجلد١٦، عدد٦٢، (إبريل٢٠١٦)، ص٩٣.
- حبيطة، لخضر، “تداعيات السياسة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب على منطقة الشرق الأوسط”، مجلة دراسات وأبحاث: المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 4، (جويلية ٢٠٢١)، ص٢٦٢ –٢٦٤.
- حسن محمد، دعاء، “النزعة الشعبوية والمفارقات الفكرية”، مجلة بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، العدد ١٠٨، (فبراير ٢٠٢٥)، ص٢٤٩.
- حسين خفاجة، رانيا، “حدود اتفاق واختلاف الرؤى الشعبوية حول النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل ٢٠٢٥)، ص١٥.
- الحفناوي، هالة، “أثر التحالفات الشعبوية العابرة للحدود في السياسة العالمية”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل ٢٠٢٥)، ص٢٥.
- حنفي على، خالد، “التحدي التفسيري لظاهرة الشعبوية في العلاقات الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل ٢٠٢٥)، ص٣_٤.
- داود علي، وفاء، “الشعبوية المعاصرة في تونس: ديمقراطية أم تهجين؟”، مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية، العدد ١، (أبريل٢٠٢٣)، ص٢٣٣.
- شعبان، عبد الحسين،”الشعبوية والديمقراطية”، مجلة يتفكرون، العدد ١٣، (ديسمبر ٢٠١٨)، ص١٥.
- صالح الذباح، طارق، رمضان، ومني، “النظام السياسي الأمريكي بين الأشكلية والموضوعية”، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد ١١، (يونيو ٢٠١٨)، ص ٢٥٢.
- العادلي، أسامة، قاسم، وليد، “قادة اليمين الشعبوي وسياسات تغير المناخ: دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد ٢٣، (يوليو ٢٤)، ص١٠٥- ١١٠.
- عدنان هادي، حسين، “الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية انحسار؟ ام صعود مؤجل؟”، مجلة حمورابي، العدد ٣٦، (٢٠٢٢)، ص١١٥.
- عمار، رضوى، “مداخل متعددة لفهم الشعبوية في نظريات العلاقات الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل ٢٠٢٥)، ص ٦.
- قاسم، وليد، “الشعبوية وجائحة كورونا: ادلة من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد ١٣، (يناير ٢٠٢٢)، ص٥٤-٥٩.
- مخيط أبو صليب، فيصل، “الشعبوية في السياسة الأميركية: حالة إدارة الرئيس دونالد ترامب (2017–2021)”، مجلة سياسات عربية، العدد ٦٤–٦٥، (نوفمبر ٢٠٢٣)، ص٩٩.
- مظهر خلف، حسين، “جذور وتطور ظاهرة الشعبوية في الحياة السياسية الامريكية وأثرها في صنع القرار السياسى”، مجلة حمورابي، العدد ٤٧، (٢٠٢٣)، ص٨٥.
- نبيل، سجى وآخرون، “الشعبوية والتطرف: دراسة في علم النفس السياسي: دونالد ترامب أنموذجًا “، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد ٨٨، (كانون الاول ٢٠٢٤)، ص ٢٩١-٢٩٢.
- يوسف، عبد الرحمن، “الترامبية عقيدة موجهة للسياسة الخارجية الأمريكية”، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مجلد٣٨، العدد ٢، (٢٠٢٤)، ص ٨٠٥-٨١٢.
د-مقالات:
- عيد أبو زيد، رجب، “التسويق السياسي وصعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية: دونالد ترامب أُنموذجًا”، “المؤتمر العلمي الخامس، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية”، ٢٠٢٣، ص ١٣-١٦.
ه-المواقع الإلكترونية:
- أحمد سيد عبد العزيز، رحمة وآخرون، “دور المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسة الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2012-2020″، المركز العربي للبحوث والدراسات، ١٧ أغسطس ٢٠٢٣، شوهد في ٢٠/٤/ ٢٠٢٥ علي الرابط: https://www.acrseg.org/43207
- سمير، ايمن، “تحول تاريخي: المبادئ العشرة للترامبية الجديدة في السياسة العالمية”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، شوهد في ٢٧/٤/٢٠٢٥، على الرابط: https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/9968 /تحول-تاريخي-المبادئ-العشرة-لـ-الترامبية-الجديدة-في-السياسة-العالمية.
- السويطي، أحمد، مترجم، “مصدر لكل فروع الحكومة الأمريكية ومؤسساتها الرسمية – بالعربي”، Ohio in Arabic ،أكتوبر ٢٠٢٢، شوهد في ٢٠/٤/٢٠٢٥ علي الرابط: https://ohioinarabic.com/ مقالة/مصدر-لكل-فروع-الحكومة-الأمريكي.
- عبد العاطي، عمرو، “فوز ترامب: تحد للمؤسسة والنخبة الأمريكية“، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٨ نوفمبر ٢٠١٨، شوهد في ٢٠٢٥/٤/٢٥، على الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/21301.aspx
- عبد المجيد، وحيد، “صعود القوي الشعبوية وأزمة الديمقراطية الغربية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٣ يناير ٢٠١٧، شوهد في ٢٠٢٥/٤/٢٦، على الرابط : https://acpss.ahram.org.eg/News/5634.aspx
- عطية عيسى البربري، علا، “الشعبوية وأسباب ظهورها”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية،١٨ أبريل٢٠٢٤، شوهد في ١٨/٤/٢٠٢٥ على الرابط :https://shafcenter.org/الشعبوية-وأسباب-ظهورها/.
ثانيا: المراجع باللغة الاجنبية:
A-Books:
- Aknade, Adebowale, “U.S. Democracy in Danger: The American Political System Under Assault” (Switzerland: Springer Nature, 2023), P. 57.
- Giurlando, Philip , Wajner, Daniel F., “Populist Foreign Policy: Regional Perspectives of Populism in the International Scene” (Switzerland: Springer Nature, 2023).
- Tagliarina, Daniel, “Judicial Nominations and Trump’s Complicated Relationship with the Courts” (Switzerland: Springer Nature, 2022), P.93–95.
B-Periodicals:
- Dwipayana Pulungan,Eska ,“Populism in the United States During Donald Trump’s Government: The Failure to Understand Human Identity from the Perspective of Constructivism”, Jurnal Politik Profetik, vol. 11, N 2, (2023), p.193-195.
- Lacatus, “Populism and President Trump’s Approach to Foreign Policy: An Analysis of Tweets and Rally Speeches”, Politics, Vol. 41, No. 1, (January 2021).
- Şahin, Osman ,et al, “Policymaking by Tweets: Discursive Governance, Populism, and Trump Presidency”, Contemporary Politics 27, No. 5, (2021).
- Weyland, Kurt, “Why US Democracy Trumps Populism: Comparative Lessons Reconsidered”, Cambridge University Press, 55, No.3, (2021), p.481.
C-Theses:
- Kickham III, Michael F., Trumpocracy: The Rise of Populism in Europe and America, (Ph.M thesis, University of Missouri,2017). P 35. Available at Trumpocracy: The Rise of Populism in Europe and America.
D-Online Resources:
- Barker, David,” President Trump’s Relationship with Congress in the First Year”, School of Public Affairs, American University Washington DC,24 October 2017, accessed on 20/4/2025, available at, President Trump’s Relationship with Congress in the First Year | American University, Washington, D.C.
- Dimock, Michael, Gramlich, John, “How America Changed During Donald Trump’s Presidency”, Pew Research centre, 29 January 2021, accessed on 20/4/2025, available at, How America Changed During Trump’s Presidency | Pew Research Center
- EBSCO Research Starters, “Judiciary”, 2025, accessed on 21/4/2025, available at, https://www.ebsco.com/research-starters/law/judiciary.
- Han,ze and others, “The Deep Roots of American Populism”, SSRN, 27 July 2023, accessed on 12/4/2025, available at, https://ssrn.com/abstract=4523224 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4523224 .
- Hawkins, Stacy ,“ Trump’s Dangerous Judicial Legacy“, UCLA Law Review,13 June 2019, accessed on 20/4/2025, available at, Trump’s Dangerous Judicial Legacy | UCLA Law Review.
- The White House – Obama Archives, “The Executive Branch,” accessed on 20/4/2025, available at, https://obamawhitehouse.archives.gov/1600/executive-branch.
- United States Senate, “Vice President of the United States (President of the Senate),” accessed on 21/4/2025 available at, https://www.senate.gov/about/officers-staff/vice-president.htm.
- United States Courts, (n.d.), “Court Role and Structure”, accessed on 21/4/2025, available at, https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure.
E-Articles:
- Bill of Rights Institute, “Essay: Separation of Powers with Checks and Balances”, accessed on 03/05/2025, available at,
https://billofrightsinstitute.org/essays/separation-of-powers-with-checks-and-balances/ .
[1] فيصل مخيط أبو صليب، “الشعبوية في السياسة الأميركية: حالة إدارة الرئيس دونالد ترامب (2017–2021)”، مجلة سياسات عربية، العدد ٦٤-٦٥، (نوفمبر ٢٠٢٣)، ص٩٩.
[2] حسين مظهر خلف، “جذور وتطور ظاهرة الشعبوية في الحياة السياسية الامريكية وأثرها في صنع القرار السياسى”، مجلة حمورابي، العدد٤٧، (٢٠٢٣)، ص٨٥.
[3] سجى نبيل وآخرون، “الشعبوية والتطرف: دراسة في علم النفس السياسي: دونالد ترامب أنموذجًا “، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، االعدد ٨٨، (كانون الاول ٢٠٢٤)، ص٢٩٢.
[4] المرجع السابق، ص ٢٩٠.
[5] رانيا حسين خفاجة، “حدود اتفاق واختلاف الرؤى الشعبوية حول النظام الدولي “، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠(إبريل٢٠٢٥)، ص١٥.
[6] وفاء داود علي، “الشعبوية المعاصرة في تونس: ديمقراطية أم تهجين؟”، مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية، العدد الأول (أبريل 2023)، ص٢٣٣.
[7] سجى نبيل واخرون، مرجع سبق ذكره، ص٢٩٠-٢٩١.
[8] هالة الحفناوي، “أثر التحالفات الشعبوية العابرة للحدود في السياسة العالمية”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل، ٢٠٢٥)، ص٢٥.
[9] دعاء حسن محمد أحمد، “النزعة الشعبوية والمفارقات الفكرية”، مجلة بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، ا العدد 108 (فبراير 2025)، ص٢٤٩.
[10] رضوى عمار، “مداخل متعددة لفهم الشعبوية في نظريات العلاقات الدولية “، مجلة السياسة الدولية، العدد٢٤٠، (ابريل٢٠٢٥)، ص ٦.
[11] المرجع السابق، ص ٦.
[12] سعيد بكار، “في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟”، مجلة سياسات عربية، العدد ٥٤، (يناير ٢٠٢٢)، ص١٤٨.
[13] المرجع السابق، ص ١٤٩.
[14] إبراهيم اولتيت، المتغير والثابت في الشعبوية، (المغرب: جامعة الدول العربية، ٢٠١٧)، ص١٢٥-١٢٦.
[15] علا عطية عيسى البربري، “الشعبوية وأسباب ظهورها”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، (أبريل 2024) شوهد في١٨/٤/٢٠٢٥ على الرابط
https://shafcenter.org/الشعبوية-وأسباب-ظهورها/.
[16] سعيد بكار، مرجع سبق ذكره، ص١٤٩.
[17] إبراهيم اولتيت، مرجع سبق ذكره، ص١٢٥.
[18] خالد حنفي على، “التحدي التفسيري لظاهرة الشعبوية في العلاقات الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٤٠، (إبريل ٢٠٢٥،) ص٣.
[19] المرجع السابق، ص٤.
[20] سجى نبيل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص٢٩١،٢٩٢.
[21] سعيد بكار، مرجع سبق ذكره، ص١٤٧.
[22] عبد الحسين شعبان،”الشعبوية والديمقراطية”، مجلة يتفكرون، العدد ١٣، (ديسمبر ٢٠١٨)، ص١٥.
[23]. حسن سيد أحمد، النظام السياسى للولايات المتحدة و انجلترا) القاهرة: دار النهضة العربية، القاهرة ،1977 (، ص ١٢.
[24] دستور الولايات المتحدة الامريكية، المادة الاولى.
[25] المرجع السابق، المادة الأولي.
[26] حسن سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ١٤- ١٥.
[27] ميلاد ممتاز منسي، الكونجرس الامريكى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة (الامارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعى، 2017)، ص ٢٤.
[28] رحمة أحمد سيد عبد العزيز وآخرون، “دور المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسة الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2012-2020″، المركز العربي للبحوث والدراسات، 17 أغسطس 2023، تم الاسترجاع في 20 أبريل 2025، https://www.acrseg.org/43207.
[29] أحمد السويطي، مترجم، “مصدر لكل فروع الحكومة الأمريكية ومؤسساتها الرسمية – بالعربي”، Ohio in Arabic، 11 أكتوبر 2022، تم الاسترجاع في 20 أبريل 2025، https://ohioinarabic.com/مقالة/مصدر-لكل-فروع-الحكومة-الأمريكي.
[30] رحمة وآخرون، مرجع سبق ذكره.
[31] دستور الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سبق ذكره، المادة الثانية.
[32] المرجع السابق.
[33] The White House – Obama Archives, “The Executive Branch,” accessed April 20, 2025, https://obamawhitehouse.archives.gov/1600/executive-branch.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36]أحمد السويطي. (مترجم)، مرجع سبق ذكره
[37] United States Senate, “Vice President of the United States (President of the Senate),” Accessed on 21/4/2025, https://www.senate.gov/about/officers-staff/vice-president.htm .
[38] Ibid.
[39] The White House, Op. Cit.
[40] EBSCO Research Starters, “Judiciary”, 2025, Accessed on 21/4/2025, available at, https://www.ebsco.com/research-starters/law/judiciary.
[41] حسن سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠.
[42] United States Courts, (n.d.), “Court Role and Structure”, Accessed on 21/4/2025, available at, https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure.
[43] حسن سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ٣١.
[44] طارق صالح الذباح، مني رمضان، “النظام السياسي الأمريكي بين الأشكلية والموضوعية”، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد ١١، (يونيو ٢٠١٨)، ص ٢٥٢.
[45] المرجع السابق، ص ٢٥٣.
[46]Bill of Rights Institute, “Essay: Separation of Powers with Checks and Balances”, Accessed on 03/05/2025, available at, https://billofrightsinstitute.org/essays/separation-of-powers-with-checks-and-balances/.
[47] فيصل مخيط أبو صليب، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٣.
[48] المرجع السابق، ص ١٠٣.
[49] المرجع السابق، ص ١٠٣.
[50] رجب عيد أبو زيد، “التسويق السياسي وصعود الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية: دونالد ترامب أُنموذجًا”، “المؤتمر العلمي الخامس، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية”، ٢٠٢٣ ، ص ١٣.
[51] المرجع السابق، ص ١٣.
[52] المرجع السابق، ص١٦.
[53] حسن أبو طالب،” صراع الشعبوية والديموقراطية في الولايات المتحدة الامريكية” ،مجلة آفاق استراتيجية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدد2 ، ( ٢٠٢١)،ص ٦٩-٦٨.
[54] المرجع السابق، ص ٦٩.
[55] Michael F. Kickham III, Trumpocracy: The Rise of Populism in Europe and America, (Ph.M thesis, University of Missouri,2017), P 35.
[56]عبد الرحمن يوسف عبد العزيز على،” الترامبية عقيدة موجهة للسياسة الخارجية الأمريكية”، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مجلد ٣٨،عدد٢ (٢٠٢٤) ، ص٨٠٥-٨١٢.
[57] حسين عدنان هادي، “الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية انحسار؟ ام صعود مؤجل؟”، مجلة حمورابي، العدد٣٦، (٢٠٢٢)، ص ١١٤.
[58] المرجع السابق، ص ١١٤.
[59] المرجع السابق، ص ١١٥.
[60] Ze Han and others, “The Deep Roots of American Populism”, SSRN, 27 July 2023, accessed on 12/4/2025, Available at, https://ssrn.com/abstract=4523224 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4523224
[61] محمد الجوهري، وعبد الرحمن يوسف،”محفزات صعود الشعبوية في الولايات المتحدة“، مجلة الديمقراطية، مجلد١٦، عدد٦٢، (إبريل٢٠١٦)، ص٩٣.
[62]Zehan, and others, Op., Cit, p.7.
[63] الجوهري، وعبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص٩٧.
[64]Zehan, and others, Op., Cit, p. 5_6.
[65] الجوهري، ويوسف، مرجع سبق ذكره، ص٩٥.
[66] المرجع السابق، ص ٩٧.
[67] عبد الرحمن يوسف، “الترامبية عقيدة موجهة للسياسة الخارجية الأمريكية”، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مجلد٣٨، العدد ٢، (٢٠٢٤)، ص ٨٠٥.
[68] ايمن سمير،” تحول تاريخي: المبادئ العشرة ل ” الترامبية الجديدة” في السياسة العالمية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، شوهد في ٢٧/٤/٢٠٢٥، على الرابط:
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/9968/
تحول-تاريخي-المبادئ-العشرة-لـ-الترامبية-الجديدة-في-السياسة-العالمية.
[69] Eska Dwaipayan Pulungan, “Populism in the United States During Donald Trump’s Government: The Failure to Understand Human Identity from the Perspective of Constructivism” ,Jurnal Politik Profetik ,vol. 11, no. 2 ,(2023), p.93,195.
[70] ايمن سمير، مرجع سبق ذكره.
[71] Eska Dwipayana Pulungan, op, cit, p. 192.
[72] Lacatus, Populism and President Trump’s Approach to Foreign Policy: An Analysis of Tweets and Rally Speeches, Politics. Vol.41, No. 1 (January 2021),P.20.
https://doi.org/10.1177/0263395720935380.
[73] وليد قاسم، الشعبوية وجائحة كورونا: ادلة من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد ١٣، (يناير ٢٠٢٢)، ص٥٤-٥٦.
[74] المرجع السابق، ص٥٦-٥٨.
[75] المرجع السابق، ص٥٨-٥٩.
[76] أسامة العادلي ووليد قاسم، قادة اليمين الشعبوي وسياسات تغير المناخ: دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد ٢٣، (يوليو ٢٠٢٤)، ص١٠٥- ١٠٦.
[77] المرجع السابق، ص١٠٦-١١٠.
[78] المرجع السابق، ص١١٠.
[79] أبو صليب، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٨-١٠٩.
[80] المرجع السابق، ص ١١٠.
[81]المرجع السابق، ص ١١٠.
[82] لخضر حبيطة، “تداعيات السياسة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب على منطقة الشرق الأوسط”، مجلة دراسات وأبحاث: المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية 13، عدد 4 (جويلية 2021): ص ٢٦٢.
[83] المرجع السابق، ص ٢٦٣.
[84] المرجع السابق، ص ٢٦٣.
[85] David Barker, “President Trump’s Relationship with Congress in the First Year”, School of Public Affairs, American University Washington DC,24 October,2017, accessed on 20/4/2025. available at President Trump’s Relationship with Congress in the First Year | American University, Washington, D.C.
[86] Michael Dimock and John Gramlich, “How America Changed During Donald Trump’s Presidency”,Pew Research center, 29January,,2021, accessed on 20/4/2025 .available at How America Changed During Trump’s Presidency | Pew Research Center.
[87] Adebowale Aknade, U.S. Democracy in Danger: The American Political System Under Assault (Switzerland: Springer Nature, 2023), p. 57.
[88] Philip Giurlando and Daniel F. Wajner, Populist Foreign Policy: Regional Perspectives of Populism in the International Scene (Switzerland: Springer Nature, 2023),p. 117- 119.
[89] Kurt Weyland, “Why US Democracy Trumps Populism: Comparative Lessons Reconsidered”, Cambridge University Press, Vol.55, No.3, (2021), p.481.
[90] Osman Şahin et al, “Policymaking by Tweets: Discursive Governance, Populism, and Trump Presidency”, Contemporary Politics Vol. 27, No. 5, (2021).
[91] وحيد عبد المجيد، “صعود القوي الشعبوية وأزمة الديمقراطية الغربية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٣ يناير ٢٠١٧، شوهد في ٢٠٢٥/٤/٢٦، على الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/5634.aspx
[92] عمرو عبد العاطي، “فوز ترامب: تحد للمؤسسة والنخبة الأمريكية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٨ نوفمبر ٢٠١٨، شوهد في ٢٠٢٥/٤/٢٥، على الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/21301.aspx
[93] المرجع السابق.
[94] Daniel Tagliarina, Judicial Nominations and Trump’s Complicated Relationship with the Courts, (Switzerland: Springer Nature, 2022), P.93–95.
[95]Stacy Hawkins, “ Trump’s Dangerous Judicial Legacy“, UCLA Law Review,13 June, 2019,accessed on 26/4/2025, available at: Trump’s Dangerous Judicial Legacy | UCLA Law Review.
[96] Ibid.