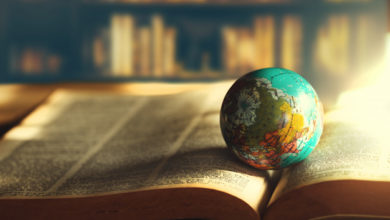أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين دراسة مقارنة بين حالتي تركيا وألمانيا الاتحادية 2011-2024

اعداد : حبيبة أسامة , داليا أحمد , ريڤان رأفت , نادين خالد , نرمين عبد الله – إشراف: د. رجب الطلخاوي – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة
تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد اللاجئين حول العالم نتيجة الحروب والصراعات والأزمات المتزايدة، مما جعل قضية اللجوء واللاجئين من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية؛ نظرًا لخطورة تأثيرها على الدولة داخليًا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى خارجًيا في تعاملها مع الدول الأخرى كالعلاقة بين الدول المرسلة والدول المستقبلة على سبيل المثال، فأصبح التعامل مع تلك الأزمة يشكل تهديدًا حقيقيًا للدول، خاصةً تلك التي أصبحت وجهة رئيسية للاجئين، على صعيد آخر، فإن مصطلح “اللاجئ” يتداخل كثيرًا مع مصطلحات متشابهة أخرى، مثل “المهاجر”، وهو مصلح أعم، كما حال مصطلح “طالب اللجوء”، وهو مصطلح أجدد نسيبًا، وهذا البحث سيركز على تلك السياسات الخاصة باللاجئين والتعامل معهم التي تتبعها الدول بشكل عام وحالتي الدراسة بشكل خاص، ويوضح من هو اللاجئ بالتحديد لتفادي المغالطات ومراعاة الضبط المفاهيمي.[1]
تُعد جمهوريتا تركيا وألمانيا الاتحادية أبرز النماذج التي يمكن دراسة سياساتهما في هذا السياق، فكلتاهما استقبل أعداد ضخمة من اللاجئين خاصةً بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 والتي كانت من ضمن أحداث الربيع العربي، حيث انغمست البلاد في حرب أهلية ما بين النظام والفصائل المسلحة وحتى المدنيين تسلحوا وأخذوا يشاركون في الأحداث الدامية مما دفع ملايين السوريين للفرار لدولة أخرى أكثر أمنًا[2]، ولكل من الدولتين نظام سياسي مختلف؛ إذ تعتمد تركيا على النظام الرئاسي بعد تحولها من النظام البرلماني بعد استفتاء 2017 متطبعةً بملامح شمولية، في حين تتبنى ألمانيا نظام برلماني ديموقراطي، فيهدف هذا البحث إلى كشف عن انعكاس هذا الاختلاف في طبيعة النظام السياسي على سياسيات اللاجئين من خلال مقارنة النظامين السياسيين في سبل التعامل مع أزمة اللاجئين وتبني السياسات المختلفة وتعاملهم مع أزمة اللاجئين. سيتم ذلك عن طريق عن طريق تناول أبرز المؤسسات المهمة، ودور الرأي العام والأحزاب المختلفة تجاه الأزمة والتداعيات السياسية والاقتصادية للأزمة داخل كل من الدولتين؛ للوصول نهايةً إلى التعرف على أوجه الشبه والاختلاف للحالتين.
أولًا: مشكلة البحث:
برزت على الساحة الدولية خلال العقود القليلة الماضية مشكلة اللاجئين والتي في ظل تفاقمها صارت أحد الموضوعات الرئيسية في علم العلاقات الدولية الراهن. ثم إن هذا التفاقم على الصعيد الواقعي قد أبرز الحاجة إلى سياسات نوعية تتعلق بالكامل مع التداعيات الكبيرة لتلك المشكلة التي صارت تؤرق عددًا هائلًا من الدول لاسيما الدول الأوروبية باعتبارها محل تفضيل للنسبة الأكبر من اللاجئين. وتتباين مواقف النظم السياسية المعاصرة وسياساتها في معالجة تلك المشكلة، وهذا ما يشير إليه التساؤل الرئيسي الذي تتمحور حوله هذه الدراسة وهو:
ما أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين داخل دولتي ألمانيا وتركيا؟
ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما تعريف اللاجئ؟
- ما الفرق بين اللاجئ والمصطلحات المشابهة الأخرى؟
- ما أثر تحول النظام السياسي التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي على سياسات اللاجئين؟
- ما موقف الأحزاب داخل كلٍ من حالتي الدراسة من أزمة اللاجئين؟
- ما أبرز المؤسسات واللاعبين المؤثرين في عملية صنع القرار داخل كلٍ من حالتي الدراسة؟
- ما أبرز سياسات اللاجئين المتبعة داخل كلٍ من حالتي الدراسة؟
- ما التداعيات الاقتصادية والسياسية لأزمة اللاجئين داخل كلِ من حالتي الدراسة؟
- ما دور الرأي العام الداخلي تجاه الأزمة ومدى استجابة كلٍ من حالتي الدراسة له؟
- ما أوجه الشبه والاختلاف بين حالتي الدراسة؟
ثانيًا: هدف البحث:
يهدف البحث إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أي أنه يهدف إلى تناول أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين مستهدفًا بذلك المقارنة بين حالتي تركيا وألمانيا كهدف أساسي، وبناءً على الهدف الأساسي نهدف لاستعراض أبرز السياسات المتبعة داخل الدولتين وأهم اللاعبين المؤثرين في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى الكشف عن مواقف الأحزاب المختلفة تجاه الأزمة وأهم التحديات الناجمة عن مشكلة اللاجئين داخل كل من حالتي الدراسة، نهايةً بتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الحالتين.
ثالثًا: أهمية البحث:
أ-الأهمية العلمية: يسعى البحث لتقديم إسهام إلى المكتبة العلمية بتناوله أثر الأنظمة السياسية المختلفة كالنظام الرئاسي في تركيا والنظام البرلماني في ألمانيا على سياسات اللاجئين، ويطرح تحليل جديد يربط بين نوع النظام وسياسات اللاجئين إذ لم يُتطرق له بصورة كبيرة من قبل، ويكشف عن أهم اللاعبين المؤثرين في عملية صنع القرار في كل منهم فيما يخص مشكلات اللاجئين داخل تلك الدول مع إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهم.
ب-الأهمية العملية: تكمن الأهمية العملية والتطبيقية للدراسة في سعيها لإقناع صناع القرار المختلفين بالمشاكل الناجمة عن أزمة اللاجئين سواء كانت الدولة مرسلة أو مستقبلة للاجئين أو دولة عبور أو حتى محاطة بدول بها عدم استقرار؛ حيث قد ينتج عنها تهديد لها من ناحية اللاجئين في المستقبل، فتعرض تلك الدراسة كيف يمكن أن يؤثر نظامها السياسي على طريقة تطبيقها أو تعاملها مع أزمة اللجوء بالإضافة إلى التعرف والتعلم من أخطاء الآخرين في تجربتي تركيا وألمانيا. تُفيد الدراسة صانع القرار العربي بسبب تضافر الأزمات في الوطن العربي مما يسبب تزايد اللاجئين العرب واستقبال البلدان العربية المحيطة للاجئين.
رابعًا: منهج البحث:
أ-المنهج الاستقرائي: سيتم اللجوء إلى المنهج الاستقرائي لدراسة سياسات اللاجئين في تركيا وألمانيا عبر تحليل الواقع واستخلاص تعميمات حول تأثير الأنظمة السياسية على هذه السياسات.
ب- المدخل النسقي: يعد منهج النسق لديفيد إيستون أداة فعالة لتحليل سياسات اللاجئين في ألمانيا وتركيا من خلال دراسة تفاعل مكونات النظام السياسي مع بيئته.
خامسًا: الإطار الزمني:
تركز هذه الدراسة على الفترة من 2011 وهو تاريخ انفجار أزمة اللاجئين السوريين بسبب نشوب الحرب الأهلية هناك مما أدي إلى هروب الملايين من السوريين خارج بلادهم، وتنتهي الدراسة عند عام 2024 وهو ما قبل سقوط نظام بشار الأسد السابق ورجوع العديد من اللاجئين لموطنهم.
سادسًا: الإطار المكاني:
تركز الدراسة على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا؛ إذ أنها المنطقة التي تقع بها الحالتين المراد بهم في الدراسة وهم: ألمانيا وتركيا، بالإضافة لكون المنطقة أحد أهم طرق تحرك اللاجئين.
سابعًا: تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول، عشرة مباحث وخاتمة على النحو التالي:
- الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة
- المبحث الأول: النظم السياسية وخصائصها
- المبحث الثاني: التعريف بسياسات اللاجئين
- الفصل الثاني: أثر النظام السياسي في جمهورية تركيا على سياسات اللاجئين
- المبحث الأول: النظام السياسي في تركيا
- المبحث الثاني: أبرز سياسات اللاجئين المتبعة في تركيا
- المبحث الثالث: تحديات الحكومة التركية في معالجة أزمة اللاجئين
- الفصل الثالث: أثر النظام السياسي في جمهورية ألمانيا الاتحادية على سياسات اللاجئين
- المبحث الأول: النظام السياسي في ألمانيا
- المبحث الثاني: أبرز سياسات اللاجئين المتبعة في ألمانيا
- المبحث الثالث: تحديات الحكومة الألمانية في معالجة أزمة اللاجئين
- الفصل الرابع: أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين: دراسة مقارنة بين حالتي تركيا وألمانيا
- المبحث الأول: دلالات التشابه
- المبحث الثاني: دلالات الاختلاف
ثامنًا: دراسات سابقة:
أ-دراسات متعلقة بالنظام السياسي التركي:
-أسامة أحمد العادلي، أحمد سيد حسين، هاجر محمد حسن عبدالغفور، تحولات النظام السياسي التركي تحت حكم “العدالة والتنمية”، مجلة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، المجلد 7، العدد14، (2022)، ص685-738.
يتناول هذا البحث التحولات الأيديولوجية في تركيا خاصة منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” للسلطة وما صاحبه من تراجع في العلمانية والتحولات في طبيعة الدولة. يناقش البحث ايضاً العوامل التي هيأت لوصول هذا الحزب للسلطة وأهم التعديلات الدستورية التي صاحبت هذا الحزب والتي من أهمها تحول النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي، بالإضافة إلى هوية الحزب الدينية وتأثيرها في التحول عن العلمانية، ركز هذا البحث على التحول الأيديولوجي في تركيا وتراجع العلمانية مع صعود حزب ديني وسوف يضيف هذا البحث تأثير هذا التحول على الجوانب المختلفة ومنهم الوضع الديمقراطي والحقوقي في تركيا بالإضافة لدور الحزب في ملف اللاجئين وموقفه منه.
– إيمان دني، الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة (الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،2014).
يقدم هذا الكتاب استراتيجيات تركيا الإقليمية في منطقه الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، مع التركيز على المؤسسات السياسية في تركيا، وسوف يستفيد البحث من ذلك الكتاب في فهم كيف تؤثر المؤسسة العسكرية على النظام السياسي التركي، وكيف أن مجلس الأمن القومي يعطى الحق للمؤسسة العسكرية للتدخل في الشأن السياسي بشكل قانوني، يفتقد الكتاب إلى تغطية المؤسسات الأخرى المؤثرة في عملية صنع القرار في تركيا، سيضيف هذا البحث تأثير المؤسسات الأخرى في عملية صنع القرار في تركيا وتوجهات الأحزاب المختلفة تجاه قضية اللاجئين بالإضافة إلى التركيز على فترتي ما قبل التحول وما بعد التحول للنظام الرئاسي المعمول به حاليًا.
ب-دراسات متعلقة بالنظام السياسي الألماني:
-Florian Grotz and Wolfgang Schroeder, The Political System of Germany, New Perspectives in German Political Studies (Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, 2023).
يقدم الكتاب رؤية شاملة وعميقة للنظام السياسي الألماني عن طريق تحليل كيفية توازن القوى بين البرلمان والحكومة الفيدرالية والولايات بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية، يتناول أيضًا كيفية تأثير النظام التوافقي الألماني، الذي يعتمد على تعدد الأحزاب والفيدرالية، على صناعة القرار السياسي موضحًا تفاعله مع المستويات الأوروبية والمحلية، كما ألقى الكتاب الضوء على التحديات الحديثة التي تواجه الديمقراطية الألمانية مثل أزمة اللاجئين، وعلى الرغم من القيمة العلمية الكبيرة التي يحملها في شرح البنية المؤسسية للنظام السياسي الألماني وآليات صنع القرار إلا أنه لم يمنح القضايا الاجتماعية، ولا سيما قضايا اللاجئين والمهاجرين، حقها الكامل في التحليل المستقل والمتعمق، سيضيف هذا البحث تحليل لما يقدمه الكتاب لفهم طبيعة التوازن المؤسسي داخل النظام السياسي الألماني عبر دراسة كيف أثرت هذه البنية التوافقية والفيدرالية على سياسات اللجوء والهجرة.
– Hans Vorländer, Maik Herold, Steven Schäller, PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany, New Perspectives in German Political Studies (Switzerland: Palgrave Macmillan Cham,2018).
يناقش هذا الكتاب قضية صعود اليمين المتطرف والشعبوية في ألمانيا ويتطرق إلى أحداث مظاهرات “بيغيدا” وتطورها من مجرد حركة حتى أصبحت مظاهرات منتظمة وصلت لخارج ألمانيا، بالإضافة إلى تحديد المسمى الخاص بها وتحديد صفات القادة بها ودوافعهم فضلًا عن تناول اليمين المتطرف في ألمانيا خاصةً وأوروبا عمومًا، سيستفيد هذا البحث من الكتاب في تناوله لدور اليمين المتطرف في حشد واستغلال أزمة اللاجئين لصالحه، كما سيضيف كيف استجابت الحكومة لمظاهرات “بيغيدا” ومدى نجاحها فعلًا في التأثير على الرأي العام وإذا ما شكلت تهديد ملحوظ تجاه نظرة الحكومة الألمانية المتمثلة في أنجيلا ميركل وقتها للاجئين بصفة عامة واللاجئين المسلمين بصفة خاصة، مع إيضاح تعامل ميركل عند تعطيل السلطات لتلك المظاهرات.
ج- دراسات متعلقة بسياسات اللاجئين:
– اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، تقرير الاجتماع التاسع والعشرين، اللجنة الدائمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (2004).
تشير الدراسة إلى التحديات التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين، خاصة من حيث التمويل، توفير الموارد، وضمان تنفيذ القوانين الدولية لحماية اللاجئين. كما تتناول الجهود التي تبذلها المفوضية بالتعاون مع الدول لتعزيز سياسات الحماية، مثل دعم الدول في وضع قوانين وطنية تتماشى مع اتفاقية ١٩٥١، وتقديم برامج تهدف إلى تسهيل إدماج اللاجئين، أو إعادة توطينهم، تبرز الدراسة أيضًا أهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تقديم حلول دائمة مثل العودة الطوعية الإدماج المحلي، أو إعادة التوطين في دول أخرى. وتشدد على ضرورة الشفافية في إدارة الموارد، والتأكد من توجيه المساعدات بفاعلية لضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم.
تركز الدراسة بشكل رئيسي على الجانب النظري للاتفاقيات الدولية، دون تقديم أمثلة عملية على نجاح أو فشل سياسات معينة في دول مختلفة. إضافةً إلى ذلك، لم تقدم تحليلاً معمقًا للأزمات الحديثة مثل تدفقات اللاجئين في مناطق النزاع الحالية، خاصة مع التغيرات سياسية الكبيرة في السنوات الأخيرة، نستفيد من هذه الوثيقة في بناء الإطار النظري للبحث، حيث توفر أساسًا قويًا لفهم كيفية تعامل المنظمات الدولية مع قضايا اللاجئين وبالتالي استخدامها لمقارنة سياسات الدول المختلفة خاصة في الدول التي أصبح لديها سياسات صارمة تجاه اللاجئين ومدى تطابقها مع التوصيات التي تطرحها الدراسة.
-Eytan Mayars, International Immigration Policy: A Theoretical and Comparative Analysis (USA: Parglave Macmillan,2004).
تهدف الدراسة في ذلك الكتاب إلى المقارنة بين سياسات اللاجئين المختلفة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا، مستعرضةً بذلك مشكلة الهجرة والهجرة غير المشروعة وتأثير تدفق المهاجرين واللاجئين على الداخل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تميزت الدراسة باستخدام الأداة المقارنة للكشف عن أوجه الاختلاف والشبه بين السياسات المختلفة وبين مدى فعاليتها في تحجيم تدفق اللاجئين وانفراج الأزمة داخل الدولة، مركزةً بذلك على الفترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر واستهدفت حل المشكلات الناجمة عن التغير الديموغرافي المصاحب لزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتكشف أيضًا عن دور سياسات اللاجئين في تشكيل نمط الهجرة.
تناول هذا الكتاب في الفصل الخامس سياسات اللاجئين بألمانيا في الفترة بين 1871 والحرب العالمية الأولى وسيضيف هذا البحث هو تحليل سياسيات اللاجئين في الوقت المعاصر وبالتحديد من عام 2011 منذ انفراج الأزمة السورية إلى عام 2024 وهو ما قبل سقوط نظام بشار الأسد السابق داخل دولتي ألمانيا وتركيا وسيكشف عن أثر طبيعة النظام السياسي في تشكيل وتحجيم مشكلة اللاجئين داخلهم.
الفصل الأول
الإطار النظري
تمهيد
سيتناول هذا الفصل مبحثين: أولًا النظم السياسية المختلفة وتوضيح العلاقة بين السلطات الثلاث ألا وهم السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية من حيث التفاعل بينهم وكيف يحدد الدستور علاقتهم، مستعرضًا بذلك النظام الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي، إلى جانب تحليل إيجابيات وسلبيات كل نظام، ومن ثم سيطرح المبحث الثاني شرح لمن هو اللاجئ والفارق بين ذلك المصطلح وغيره من المصطلحات المشابهة وبعض السياسات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين وأهم الاتفاقيات المنظمة لأمورهم مثل مبدأ الحماية من الإعادة القسرية والحق في التقاضي والمأوى المؤقت وأخيرًا مبدأ المساواة عدم التمييز .
المبحث الأول
النظم السياسية وخصائصها
أولًا: أنواع النظم السياسية:
أ-النظام الرئاسي
يعتمد النظام الرئاسي على استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، وفى هذا النظام يُنتخب الرئيس مباشرةً من الشعب، لذلك يُعتبر هيئة تمثيلية تُعبِر عن إرادة الأمة، وفى هذا النظام تُطبَّق فكرة فصل السلطات، حيث يستقل البرلمان بالتشريع، وتستقل السلطة التنفيذية بالوظيفة التنفيذية[3]
يتميز النظام الرئاسي بفردية السلطة التنفيذية وللرئيس في هذا النظام وضع متميز فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الوقت ذاته، وبالنسبة للوزراء، ليسوا سوى مساعدين للرئيس في تنفيذ سياساته، لذلك فهم يُعتبرون جهازًا إداريًا لا سياسيًا، يساعدون الرئيس في إدارة الدولة، ويُعتبر البرلمان مستقل عن السلطة التنفيذية، وله الحق في ممارسة الوظيفة التشريعية، باستقبال واختيار أعضاء البرلمان بحرية، وأيضًا ليس للرئيس حق في حل البرلمان.[4]
ب-النظام البرلماني
يقوم النظام البرلماني على التداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ويمكن للوزراء حضور جلسات البرلمان، وهذا يؤكد على أن النظام البرلماني يعتمد على الفصل المرن بين السلطات. كما يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية، حيث تتكون من الرئيس الذي يملك سلطة شرفية، والطرف الآخر مجلس الوزراء الذي يمتلك السلطة الفعلية في إدارة شؤون البلاد[5]
يُنتخب البرلمان في هذا النظام من الشعب، ويُعتبر ممثلًا للأمة، وفور تولّي عضو البرلمان منصبه يصبح مستقلًا عن ناخبيه، وليس لهم حق في عزله، ويكون للبرلمان الحق في وظائف الحكم كلها أو بعضها، وله سلطات حقيقية وفعّالة، خصوصًا في التشريع.[6]
ج-النظام شبه الرئاسي
يجمع النظام شبه الرئاسي بين الرئيس القوي، مثل النظام الرئاسي، والتداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (أي أن الحكومة تتكون من أعضاء منتخبين من البرلمان).[7]
يقوم النظام شبه الرئاسي على التوازن وتوزيع واضح للسلطات الثلاثة، وتقوم السلطة التنفيذية بالاشتراك بين رئيس الجمهورية والحكومة، حيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء، ولكن يجب أن يكون مدعومًا بالأغلبية في البرلمان وللرئيس الحق في حل البرلمان، وعندما يسيطر حزب الرئيس أو مؤيدوه السياسيون على البرلمان، يصبح الرئيس هو الفاعل المسيطر في العمل التنفيذي. وللوزراء الحق في اقتراح تشريعات على البرلمان. البرلمان في هذا النظام له الحق في إصدار القوانين، والموافقة على الميزانية، ومراقبة الحكومة من خلال جلسات الاستجواب.[8]
ثانيًا: الدستور:
يختلف محتوى وطبيعة كل دستور، وكذلك علاقته ببقية النظام القانوني والسياسي، بدرجة كبيرة من بلد إلى آخر، ولا يوجد تعريف عالمي موحد ومُتفق عليه للدستور، ومع ذلك، فإن أي تعريف عملي واسع القبول للدستور من المرجّح أن يتضمن الخصائص التالية:
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية والسياسية الأساسية التي تكون مُلزِمة للجميع في الدولة، بما في ذلك مؤسسات التشريع الأساسية، تتعلق تلك القواعد بهيكل وعمل مؤسسات الحكومة، والمبادئ السياسية، وحقوق المواطنين، وتستند إلى شرعية شعبية واسعة، ويكون تعديلها أصعب من القوانين العادية (مثلًا: يتطلب الأمر تصويتًا بالأغلبية الثلثين أو إجراء استفتاء).[9]
ثالثًا: الأيديولوجية:
تُعرف الأيديولوجية كما جاء في معجم العلوم الاجتماعية والفلسفية على أنها مجمل التصورات، والأفكار، والمعتقدات، وطرق التفكير لمجموعة سواء كانت أمة، أو طبقة، أو فئة اجتماعية، أو طائفة دينية، أو حزب سياسي، وتكون الأيديولوجيات عادة مشروطة ومحددة بالظروف والعادات، وجاء في قاموس إلياس العصري 1985م كلمة أيديولوجية “Ideology” أي فن بحث في الأفكار والتصورات، ومؤلف “الأيديولوجيا الألمانية” لماركس وانجلز يرد مصطلح الأيديولوجية عند الحديث عن البناء العلوي الأيديولوجي بأنها الصور الكاذبة التي يرسمها الناس؛ لتعبر عن أنفسهم، أو آراء تبرر الأوضاع الاجتماعية الخاصة، وفى “بؤس الفلسفة لماركس” و”البيان الشيوعي” لماركس وانجلز يرد مصطلح الأيديولوجية أنها: “كل العلوم الإنسانية وخاصة العلوم الاجتماعية، بما فيها الاقتصاد السياسي والتاريخ، أو هي برامج وتصريحات الأحزاب السياسية المختلفة والتصورات والآراء وردود الأفعال السيكولوجية، و الأماني المعبرة عن مختلف الطبقات الاجتماعية”.[10]
المبحث الثاني
التعريف بسياسات اللاجئين
أصبح من الضروري تبني الدول سياسات لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم، وذلك بسبب زيادة الصراعات والثورات داخل الدول وزيادة أعداد اللاجئين حول العالم، ويتناول هذا الجزء من البحث المبادئ الأساسية التي أقرها القانون الدولي مثل: سياسة الحماية من الإعادة القسرية، الحق في التقاضي، سياسة المأوى المؤقت، وسياسة المساواة وعدم التمييز، كما سيتم تسليط الضوء على انواع النظم السياسية.
أ-تعريف اللاجئ:
تنصّ المادة 1 الفقرة أ من اتفاقية 1951 على أن اللاجئ هو أي شخص:
“… وجد بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو آرائه السياسيّة، خارج البلد الذي يحمل جنسيّته، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسيّة له، وهو خارج بلد إقامته الاعتياديّة السابقة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد”، إلى جانب اتفاقية اللاجئين التي تناولتها اتفاقية 1951، أعلنت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية أن اللاجئ هو: “أي شخص اضطر إلى مغادرة بلده بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة خارجيّة أو أحداث تعكّر بشكل خطير النظام العام في كامل بلده الأصل أو بلد جنسيّته أو في أي جزء منه”.[11]
يتداخل مصطلح “اللاجئ” كثيرًا مع مصطلحات متشابهة أخرى، مثل “المهاجر” وهو أعم مصطلح فليس بالضرورة أن كل مهاجر هو لاجئ؛ إذ أن المهاجر هو الذي يغير مكان إقامته بشكل عام، أما اللاجئ هو الذي اضُطر لترك بلاده لظروف قهرية تهدد أمنه وسلامته كما تعرفه اتفاقية جينيف عام 1951. ويعد مصطلح “طالب اللجوء” هو مصطلح جديد نسيبًا، ويتضمن المصطلح أولئك الذين فروا من بلادهم وتقدموا بطلب للجوء إلى دولة أخرى ولم يتم اعتبارهم كلاجئين أو أي مسمى إنساني آخر.[12]
ب-سياسات اللاجئين:
1.مبدأ الحماية من الاعادة القسرية:
تُعتبر هذه السياسة من أهم السياسات التي لا يمكن التخلي عنها لحماية اللاجئين، حيث يحظر على الدول المتعاقدة إعادة أو طرد اللاجئ بأي طريقة كانت إلى الحدود التي قد تعرض حياته أو حريته للخطر. وتعتمد باقي سياسات اللاجئين على هذه السياسة، وجاء في الفقرة الأولى من المادة (2) من إعلان الأمم المتحدة.[13] وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 قد تضمنت هذا الحق في الفقرة الأولى من المادة (33)،[14] وتناولت الاتفاقية الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين لعام 1969 وقد نصت في الفقرة الأولى من المادة (5) على هذا الحق.[15]
2.سياسة الحق في التقاضي:
يُعتبر اللاجئ شخصًا مجبرًا على ترك مكان ولادته بسبب الحروب، أو الاضطهاد السياسي أو العرقي أو الديني أو الطائفي، ومن الممكن أن يدخل في خلافات مع غيره من أفراد بلد اللجوء أو لاجئ آخر. لذلك، يحق للاجئ اللجوء إلى قضاء بلد اللجوء للحصول على حقوقه، وهذا ما أكدته المادة 16 من اتفاقية اللجوء في فقراتها الثلاث حيث نصت على أنه ” يكون لكل لاجئ على أراضي جميع الدول المتعاقدة حق التقاضي الحر أمام المحاكم.[16]
- سياسة المأوى المؤقت:
لا يوجد نص يمنع الدولة من حق التصرف في تنظيم دخول الأجانب إلى إقليمها والبقاء فيه. لذلك، حاولت الجهود الدولية إيجاد توازن بين حق الدولة الكامل في السيادة على أراضيها ورفض دخول الأجانب دون إرادتها، وبين ضرورة حماية حقوق الإنسان في بعض الحالات التي قد يتعرض فيها الفرد لخطر على حياته أو حريته. بناءً على ذلك، تم تقديم سياسة الإقامة المؤقتة التي نصت على: “إذا لم تكن الدولة ملزمة بقبول اللاجئ على أرضها، فإنها على الأقل تسمح له بالإقامة لحين الذهاب إلى دولة أخرى”.[17]
وتأكدت فكرة المأوى المؤقت في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، والتي أُبرمت في النصف الأخير من القرن الماضي، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951، حيث نصت في الفقرة الأولى من المادة (10).[18]
وأكدت على هذا المبدأ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969 في الفقرة الأولى من (المادة 2).[19]
4.مبدأ المساواة وعدم التمييز:
ويعتبر الحق في عدم التمييز من الحقوق الأساسية في الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان بصفة عامة. جاء النص على هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في المادة السابعة، إذ تنص على أنه: “الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريضٍ على هذا التمييز”، وهو ما أكدته المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذه النصوص تعتبر أداة قيمة للقضاء على التمييز بين اللاجئين.[20]
وتعتبر من أشكال التمييز قيام بعض السلطات بإدخال تعديلاتٍ على اللوائح الخاصة باللجوء كما تم في تركيا عام 1992م، من إضافة فئة خاصة تُسمى “طالبي اللجوء” لتمييزهم عن اللاجئين. ويعتمد فحص الطلب على العنصر الأوروبي من عدمه، حيث يتعرض طالبي اللجوء من غير الأوروبيين إلى إجراءات معقدة من التسجيل.[21]
نستنتج مما سبق أن اللاجئ هو ذلك الذي فر من موطنه بسبب ظروف قهرية بحثًا عن مكان أكثر أمنًا، وأن المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان حقوق اللاجئ منها: عدم الإعادة القسرية، والمساواة، وعدم التمييز، والحق في التقاضي، وسياسة المأوى المؤقت. وكما أشرنا إلى تعريف الأيديولوجيا باعتبارها الإطار الفكري الذي يوجّه السياسات والممارسات، وأشرنا إلى تعريف الدستور باعتباره منظمًا للعلاقات بين السلطات ويحدد حقوق الأفراد، وتم توضيح أيضًا أنواع الأنظمة السياسية، ومنها: النظام الرئاسي، الذي يتميز بفردية السلطة التنفيذية ويكون للرئيس وضع متميز فيه، والنظام البرلماني، الذي يكون فيه تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنظام شبه الرئاسي، الذي يجمع بين خصائص النظام الرئاسي والبرلماني.
سوف نتناول في الفصل القادم عن أثر النظام السياسي في تركيا على سياسات اللاجئين، وسوف نستعرض أهم المؤسسات المؤثرة في عملية صنع القرار قبل تحول النظام إلى الرئاسي وبعد، مرورًا بالأيدولوجيات التركية والدستور التركي بعد تعديل 2017.
الفصل الثاني
أثر النظام السياسي في تركيا على سياسات اللاجئين
تمهيد
يتناول هذا الفصل تركيب النظام السياسي في تركيا منذ عام 2011، مما يعني التطرق لنظام التركيا قبل التحول للنظام الرئاسي وبعده، موضحًا أدوار السلطات الثلاث في كل من الفترتين مع ذكر أهم الأيديولوجيات المؤثرة بدايةً من العصر العثماني وصولًا للأيديولوجية التي يتبعها حزب العدالة والتنمية منذ توليه الحكم، إلى جانب التعرض لمواقف الأحزاب التركية المختلفة جراء ملف اللاجئين، ومن ثم سنعرض أبرز سياسات اللاجئين التي اتبعتها، وأخيرًا سوف نتناول التحديات المختلفة التي تواجهها الحكومة التركية عند التعامل مع ملف اللاجئين مثل التحديات المحلية والإقليمية والدولية من الناحية السياسية، ومشكلات التضخم والبطالة من الناحية الاقتصادية إلى جانب موقف الرأي العام المتسم بالغضب تجاه اللاجئين.
المبحث الأول
النظام السياسي في تركيا
شهد النظام السياسي التركي تحولات مهمة، أثرت على النظام السياسي للدولة وأيضًا المؤسسات الموجودة داخل الدولة، ومع تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، أُعيد توزيع الصلاحيات بين المؤسسات وفى هذا الجزء، سوف نتناول أبرز المؤسسات السياسية، مثل البرلمان والأحزاب ومجلس الأمن القومي، وتأثير جماعات المصالح على القرار السياسي، مع إلقاء الضوء على مواقف الأحزاب التركية من قضية اللاجئين السوريين.
أولًا: أهم المؤسسات المؤثرة في عملية صنع القرار قبل التحول للنظام الرئاسي:
أ-السلطة التنفيذية:
الرئيس:
تُجرى عملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، ويجب أن يحصل على أغلبية الثلثين من أصوات البرلمان، ولكن بعد تعديل 2007أصبح يُنتخب من الشعب، وتستمر مدة انتخابه لمدة 5سنوات، ويجوز انتخابه مرة ثانية فقط.[22]
تكمن صلاحيات رئيس الجمهورية في: دعوة البرلمان للانعقاد في حالة الضرورة، دعوة الحكومة للاجتماع، وأن يتولى رئاسة جلساتها، دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع، وله الحق في رئاسة جلساته، تعين رئيس الأركان، فرض حالة الطوارئ، وفي حالة لم يوافق البرلمان على القوانين، يكون للرئيس الحق في إعادة القوانين للبرلمان للنظر فيها، وإذا أعادها البرلمان مرة أخرى فإن الرئيس ملزم بها.[23]
ب-السلطة التشريعية:
البرلمان:
يتكون المجلس الوطني من 550 عضوًا، ويُنتخبون كل خمس سنوات باقتراع نسبي، ولكل نائب أحقية الترشح لأكثر من مرة، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتبدأ الدورة الأولى للفصل التشريعي للمجلس كل عام في الأول من شهر أيلول، ولا تتجاوز إجازته التشريعية ثلاثة أشهر في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد خلال تلك الفترة بناءً على طلب رئيس الجمهورية بمفرده، أو مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس بمفرده.
تكمن اختصاصات المجلس الوطني في: وضع القوانين وتعديلها، تغيير الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، انتخاب رئيس الجمهورية، الإشراف على مجلس الوزراء، وذلك من خلال الاستفسار أو التحقيق البرلماني، مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة، الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.[24]
ج-السلطة القضائية:
تُعتبر المحكمة الدستورية في تركيا الهيئة القضائية العليا في البلاد، وظهرت هذه المحكمة في عام 1960، وأُعيد تشكيلها في عام 1982.وتُعد حماية الدستور والدفاع عنه من المهام الأساسية للمحكمة. تحظى هذه المحكمة بأهمية خاصة ولأحكامها تأثير بالغ في الحياة السياسية؛ فهي التي أقصت حزب “الرفاه” ومن بعده “الفضيلة” بتهمة تهديد النظام العلماني.[25]
د- مجلس الأمن القومي:
يتكون المجلس من رئيس الأركان والقادة الأربعة: الجيش، والبحرية، والجوية، وقائد الجندرما، إلى جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والداخلية، وتُعتبر المؤسسة العسكرية ودورها السياسي من النقاط المثيرة للجدل في الدستور التركي، وذلك بسبب محاولة تدخلها بشكل مباشر من خلال الانقلابات العسكرية، أو بشكل غير مباشر من خلال ممارسة ضغوط على المؤسسات المدنية، وتم إنشاء مجلس الأمن القومي لضمان مشاركة الجيش في الأمور السياسية، ويقوم المجلس بإصدار قرارات تتعلق بالأمن القومي، ووحدة الدولة، وسلامة الأراضي، وتُرفع هذه القرارات إلى الحكومة التي تُعطي الأولوية لهذه القرارات.[26]
ثانيًا: أهم المؤسسات المؤثرة على عملية صنع القرار بعد التحول:
أ-السلطة التنفيذية:
الرئيس:
يُعتبر الرئيس أردوغان أول من بذل خطوات فعلية لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، ودخل هذا إلى حيز التنفيذ في عام 2017، وكان لهذا التحول تغير في بنية السلطة التنفيذية، حيث أُلغي منصب رئيس الوزراء ، وأصبح الرئيس هو المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية، وكان السبب وراء رغبة حزب العدالة والتنمية في التحول السياسي أن النظام البرلماني يعاني من كسور، حيث تشكو الحكومة من سيطرة البرلمان، ولذلك يوجد عدم استقرار سياسي، لذلك فإن التحول إلى النظام الرئاسي سيعالج هذا الخلل، وأيضًا سيحقق الاستقرار السياسي، ولأن شخصية أردوغان لا تسمح بأن يكون رئيسًا صوريًا بسلطات محدودة، كما هو الحال في النظام البرلماني.[27]
ولذلك تم تحويل النظام في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وأصبح الرئيس فقط هو المسؤول عن السلطة التنفيذية بعد أن كان منصبه شرفيا ومنحته الحق في أن يكون على رأس الحزب الحاكم بعد أن كان منصب الرئاسة منصبًا رمزيًا بعيدًا عن أية انتماءات حزبية، ومنح الرئيس حرية التصرف في اتخاذ قرارات واختيار نائب رئيس أو أكثر وتعيين الوزراء من خارج البرلمان وتجهيز الميزانية وإعلان حالة الطوارئ والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.[28]
ب-السلطة التشريعية:
البرلمان:
ازدادت سلطات الرئيس في النظام الرئاسي لكن في نفس الوقت فرضت بعض القيود ومنها (لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية في الأمور والموضوعات التي يحددها القانون) (وللمجلس الحق في توبيخ رئيس الجمهورية بإقرار القانون ذي الصلة وبموافقة ثلثي النواب)، ولكن يبقى القرار للمحكمة الدستورية التي يعين الرئيس أغلب أعضاءه، ولا يستطيع البرلمان أن يستجوب الوزراء ولكن له الحق في طرح الاسئلة ويجب على الوزراء ونواب الرئيس عدم التأخر في الرد على اسئلة البرلمان ويكون الرد خلال 15يومًا.[29]
ج-السلطة القضائية:
تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية في تركيا أثناء النظام الرئاسي من 17 عضوًا إلى 15 عضوًا فقط. وتعتبر مدة العضوية 12 عامًا ولا يجوز إعادة انتخابه مرة أخرى. وعلى الرغم من أن أعضاء المحكمة لهم الحق في انتخاب الرئيس ونائبه، إلا أنه تم زيادة سلطة وسيطرة الرئيس في تعيين الأعضاء في المحكمة الدستورية، ورغم الانتقادات المستمرة لرجب طيب أردوغان من قبل الأحزاب المعارضة ورفع شعار “إنهاء حكم الرجل الواحد” المدعوم من القضاء، إلا أن هناك أحكامًا قضائية وقرارات كانت ضد التوسع في سلطات أردوغان بعد الحكم الرئاسي. ومن هذه الأحكام، هو حكم ألغت به المحكمة الدستورية التركية عددًا من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في تعيين رؤساء الجامعات، وتغيير رئيس البنك المركزي قبل انتهاء مدة مهمته المحددة تاريخيًا بخمس سنوات.[30]
د- الأحزاب:
تزداد أهمية الأحزاب السياسية في تركيا للحصول على حياة سياسية ديمقراطية، وتنص الفقرة الأولى من المادة (68) في دستور 1982على أن “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، وحق الانضمام إليها، والانسحاب منها…”، وينص الدستور على أن “تُؤسَّس الأحزاب السياسية من دون الحصول على إذن مسبق، وأن تتابع أنشطتها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقوانين” [31]
يُعتبر حزب العدالة والتنمية من العناصر المهمة في الحياة السياسية التركية، حيث أنه تمكن من جذب قطاع واسع من المجتمع التركي، وذلك بفضل خطابه السياسي الذي جمع بين احترام الدين الإسلامي ومبادئه الأخلاقية والمبادئ الديمقراطية، وهذا جعله معبرًا عن مجموعة كبيرة من المواطنين. وتمكن الحزب أيضًا من الفوز في الانتخابات والحفاظ على وجوده في الحكم لفترات طويلة، ونجح الحزب في إقامة إصلاحات اقتصادية، ومنها رفع معدلات النمو وخفض البطالة.[32]
ه- جماعات المصالح
تلعب جماعات المصالح دورًا واصحا في الحياة السياسية التركية، حيث تتنوع ما بين جماعات عمالية، ومهنية، واقتصادية، وبيئية، وغيرها. وتُعد هذه الجماعات مؤثرة في عملية صنع القرار، خاصة في السياسة الخارجية، وتمارس هذه الجماعات دورًا ضاغطًا على صانع القرار لتحقيق مصالحها. في الوقت ذاته، تُعتبر جماعات المصالح مصدرًا مهمًا للتجنيد السياسي، حيث انضم عدد من قادتها إلى النخبة السياسية في مواقع ومستويات مختلفة داخل الدولة.[33]
تحاول الأحزاب في تركيا كسب ثقة وتأييد جماعات المصالح، وذلك لإعانتهم في الدعاية الانتخابية ماديًا وإعلاميًا، وحشد التصويت يوم الانتخابات، وتُعتبر إحدى أبرز جماعات المصالح في تركيا هي الجماعات الدينية، ومنها جماعة “منزل”، فضلًا عن جماعات دينية أخرى مثل “النورسية” نسبة لسعيد النورسي، و “الإيشيكتشيلار” ولديها استثمارات كبيرة مثل “مجموعة إخلاص القابضة”، “الكيركينجيلار”، “الآسيويون الجدد”، “وقف فرقان”، ويوجد أيضًا جماعات مصالح اقتصادية مثل جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “وصياد”، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين “موصياد”.[34]
ثالثًا: الدستور التركي بعد تعديل 2017:
تقر المادة (104) أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، يمثل رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، جمهورية تركيا ووحدة الأمة التركية.
تنص المادة )106( على تعيين نواب رئيس الجمهورية، وعزلهم من مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية، إذا أصبح منصب الرئيس شاغرًا لأي سبب من الأسباب، تُجرى الانتخابات الرئاسية في غضون خمسة وأربعين يومًا، ويعمل نائب رئيس جمهورية تركيا كرئيس للجمهورية ويمارس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية التالي.
وتنص المادة (87) على أن واجبات وصلاحيات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في سن القوانين وتعديلها وإلغائها، مناقشة واعتماد مشاريع قوانين الميزانية ومشاريع قوانين الحسابات الختامية، اتخاذ قرار بشأن إصدار العملة وإعلان الحرب، الموافقة على التصديق على المعاهدات الدولية، واتخاذ قرار بأغلبية ثلاثة أخماس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بشأن إعلان العفو العام والصفح.[35]
رابعًا: أبرز الأيدولوجيات المؤثرة في النظام التركي:
أ-الصراع الأيديولوجي في أواخر الدولة العثمانية: بين التغريب والأسلمة (القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين):
ترجع جذور الأيدلوجية التركية إلى آخر عصر الدولة العثمانية خاصة بعد معاهدة برلين 1878 نشأ صراع بين الفكر الإسلامي والفكر الداعي للتغريب بغرض الخروج من الأزمات الدولية التي وقعت بها الدولة العثمانية في آواخر عصرها.[36]
ب-الأيديولوجية الكمالية في تركيا (1950-1923)
تبنّى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، فكرة الكمالية التي كانت تسعى إلى تحوّل حضاري في تركيا. فقد دعت إلى تحوّل الدولة من دولة دينية إلى دولة قومية وأن تصبح تركيا علمانية، وتُركّز الكمالية على ستة مبادئ أساسية تُعرف باسم “الأسهم الستة”: الجمهورية، والشعبوية، والعلمانية، والقومية، والثورية، والدولة/الدولانية، وفي عام 1937، أدرج البرلمان التركي هذه الأسهم الستة رسميًّا في الدستور التركي.[37]
د-الحركة الإسلامية في تركيا بقيادة أربكان (1980-1950):
بدأت مجموعة من الشخصيات الإسلامية، وعلى رأسهم نجم الدين أربكان، بتشكيل حركة سياسية إسلامية جديدة تدعو إلى التوجه إلى العالم الإسلامي بدلاً من الغرب، فقامت في عام 1970 بتشكيل حزب النظام الوطني، ثم حزب السلامة عام 1972، متحولًا إلى حزب الرفاه عام 1983، الذي أصبح أقوى حزب إسلامي في تركيا، وفي عام 1995، فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وشكّل حكومة ائتلافية، وكان أربكان يريد التوجه ناحية العالم الإسلامي، واقترح عمل سوق إسلامية مشتركة بدلاً من السوق الأوروبية، وقلّل العلاقات مع حلف الناتو الذي تنتمي إليه تركيا، وأظهر توجهات إسلامية داخلية وخارجية، ولكن هذه السياسة أزعجت المؤسسات العلمانية في الدولة، خاصة الجيش والمحكمة الدستورية، فتدخلوا وأسقطوا حكومة أربكان، وقاموا بحل حزب الرفاه .[38]
د-التحول التدريجي في العلمانية تحت حكم حزب العدالة والتنمية:
حاول حزب العدالة والتنمية تغيير العلمانية بطريقة تدريجية، وكان هذا التغيير بطيئًا خوفًا من ردود الفعل من الجماعات العلمانية، وعلى رأس هذه الجماعات هو الجيش التركي. وقام حزب العدالة والتنمية بتعديلات ثلاث في أعوام 2007، 2010، 2017، وكان أهم تعديل في عام 2017، حيث تم تحويل النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي، وعلى الرغم من أن أردوغان كان يدّعي بأن تظل تركيا علمانية، إلا أنه كان يسعى لتخفيف تأثير العلمانية، وقد سمح للإسلاميين بالانضمام إلى الحياة السياسية، وتشكيل أحزاب بمفردهم، والوصول لمقاعد البرلمان، وأيضًا لمقاعد مجلس الوزراء.[39]
خامسًا: موقف الأحزاب المختلفة تجاه قضايا اللاجئين:
أ– حزب الشعب الجمهوري:
يُعتبر حزب الشعب الجمهوري الجهة السياسية المعارضة في تركيا، ويمتلك 135مقعدًا في البرلمان الحالي، ويتولى إدارة البلديات الكبرى في تركيا، ورئيس الحزب حاليًا هو كمال أوغلو، وعارض حزب الشعب الجمهوري فكرة وجود السوريين، وحاول توضيح وجهة نظره من خلال بيان التأثيرات الاقتصادية السلبية، وبما أن حزب الشعب الجمهوري هو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، فقد حاول استخدام قضية اللاجئين كوسيلة للمناورة السياسية لتوجيه النقد للحكومة.[40]
وأظهر حزب الشعب الجمهوري الدعم لنظام بشار الأسد من خلال زيارة مجموعة من نواب الحزب لبشار الأسد، والتقطوا معه مجموعة من الصور، وهذا يدل على الموقف الداعم له وحاول الحزب أن يصف المعارضين لنظام الأسد على أنهم إرهابيون، ومن وجهة نظره ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، وكذلك أنصاره يدعمون عودة اللاجئين السوريين، وانتقد الحزب سياسة الباب المفتوح مع السوريين، وكذلك تطبيق نظام الحماية المؤقتة للسوريين.[41]
ب- حزب العدالة والتنمية:
دعم حزب العدالة والتنمية ثورات الربيع العربي، خصوصًا في سوريا، حيث إنه تبنّى سياسة الباب المفتوح غير المشروطة للترحيب بجميع المواطنين السوريين الهاربين من الصراع، ولم تكن هذه السياسة إنسانية فقط، ولكن كانت مرتبطة بطموح تركيا للظهور كدولة قوية ومؤثرة في المنطقة، ومحاولة إظهار تركيا أنها قوة ناعمة عن طريق حل الأزمة بوسائل سلمية.
وحاول الحزب دعم الجيش السوري أكثر من مرة، كما في تصريحه “الجيش السوري الحرّ ليس منظمة إرهابية؛ وإنما هي مؤسسة وطنية تدافع عن وطنها ومواطنيها، وتضم أناسًا من كل الأعراق والأديان في بلدها”، وأكد أردوغان أن الجيش الحر ليس منظمة إرهابية، بل هو قوة وطنية شبيهة بالقوات التي خاضت حرب الاستقلال التركية وأعلن في خطاب آخر، منتقدًا دعم أمريكا لميليشيا قسد -وهي قوة سورية-: “يا أمريكا، نحن أسّسنا الجيش الحرّ معكم سويًا لمحاربة داعش قبل أن يكون هناك شيء اسمه ‘قسد’، لكنكم الآن تحاولون تنفيذ مناورة جديدة لتهميش الجيش الحرّ بتأسيس قسد”، وكما بدأ بإطلاق عمليات عسكرية للجيش التركي داخل الأراضي السورية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المتفرعة منه.[42]
ج- الحزب الجيد:
تأسس الحزب الجيد نتيجة خلاف بين قيادات الحركة القومية عام 2007، وكان الحزب يميل إلى الليبرالية الاقتصادية ويدعم التقارب مع الاتحاد الأوروبي، على عكس الحركة القومية التي كانت تعارض الغرب وتؤيد السياسات الاقتصادية غير التقليدي، واتخذ الحزب موقفًا معارضًا لسياسة الحكومة تجاه السوريين، وأيد التطبيع مع النظام السوري، ففي تصريح له، قال نائب رئيس الحزب، “جينك أوزاتجي”، إنه يجب على الحكومة التركية عدم دعم العمليات التي قد تُعيد إشعال الحرب الأهلية، كما طالب بعدم دعم التنظيمات السلفية الطائفية والتواصل مع دمشق لحماية وحدة الأراضي السورية، بعدها، انتقد رئيس الحزب، مسعود درويش أوغلو، الدور التركي في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الاشتباكات تُحركها أجهزة الاستخبارات العالمية التي ستستخدم هذه التنظيمات لنشر الفوضى في تركيا مستقبلاً، كما انتقد اتفاقيات الحكومة التركية مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين وطالب بعدم إدخال الجنود الأتراك في معارك لا تتعلق بأمن تركيا.[43]
المبحث الثاني
أبرز سياسات اللاجئين في تركيا
اتبعت تركيا تجاه اللاجئين السوريين في البداية سياسة “الباب المفتوح”، حيث تم استقبال السوريين على أساس التضامن الديني، واعتُبروا “إخوة مسلمين”. ولكن مع مرور الوقت وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بدأ هذا الخطاب يفقد زخمه وشهدت تركيا تحوّلًا فعليًا نحو ما يمكن تسميته بـ”سياسة الباب المغلق”.
أ-سياسة الباب المفتوح:
اعتمدت تركيا بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 سياسة الباب المفتوح، فسمحت بدخول السوريين عبر الحدود دون اعتراض أو إيقاف، ووفرت لهم الحماية المؤقتة رغم غياب إطار قانوني واضح في البداية، وذلك في إطار رغبتها بإظهار التضامن الإنساني وتعزيز نفوذها الإقليمي تمثلت هذه السياسة في:
- إنشاء المخيمات:
أنشأت تركيا 22 مخيمًا رسميًا في عدد من الولايات المختلفة لتستوعب أعداد اللاجئين المتزايدة، في إطار سياسة تهدف إلى تسكين اللاجئين بشكل منظم، ولكن لم يسكن جميع اللاجئين في هذه المخيمات، حيث أقام العدد الأكبر منهم خارجها، وتوزعوا على المدن والبلدات التركية، خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، تسبب هذا التوزيع في تحديات إضافية للحكومة التركية فيما يتعلق بتوفير الخدمات والرعاية لمن هم خارج المخيمات.[44]
- توفير التعليم للاجئين السوريين:
اعترفت تركيا بحق اللاجئين السوريين في التعليم، وأنشأت مراكز تعليم مؤقتة اعتمدت على المناهج السورية واللغة العربية، واستعانت بالمدرّسين السوريين في إدارتها. كما دمجت الأطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية، وقدّمت مساعدات مادية للأسر التي لديها أطفال راغبون في التعلم، وذلك بهدف تشجيعهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتحفيزهم على متابعة تعليمهم، وفرّت أيضًا خدمات مثل النقل والزي المدرسي، كما سمحت بإنشاء مدارس سورية داخل الأراضي التركية؛ ليتمكّن الأطفال من الالتحاق بها واستكمال تعليمهم في بيئة مألوفة لهم.[45]
3.السياسات الصحية:
أنشأت الحكومة التركية شبكة من 178 مركزًا صحيًا للمهاجرين واللاجئين في مختلف أنحاء البلاد، وقدّمت من خلالها خدمات طبية مجانية للاجئين، كانت المراكز تستقبل آلاف المرضى شهريًا، كما حرصت الدولة على دمج الكوادر الصحية السورية في النظام الصحي عبر توفير برامج تدريبية بإشراف كوادر تركية، مما أتاح توظيف عدد كبير من الأطباء والممرضين السوريين المؤهلين، ولتقليل الحواجز اللغوية، درّبت منظمة الصحة مترجمين باللغتين التركية والعربية وتم توزيعهم على مختلف المرافق الطبية، مما سهّل عملية التواصل بين المرضى والكوادر الطبية. كما أولت المبادرة اهتمامًا بالصحة النفسية للاجئين، اعتمدت تركيا في هذه السياسات نهجًا تشاركيًا يهدف إلى دمج اللاجئين في المنظومة الصحية بدلًا من عزلهم، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية واضحة.[46]
ب-سياسة الباب المغلق:
تحولت تركيا تدريجياً إلى سياسة الباب المغلق مع تغيّر النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي وصعود نبرة المعارضة الداخلية، مما دفع الحكومة لتبني توجهات أكثر تشددًا تجاه اللاجئين، خاصة مع ارتفاع أعدادهم وتزايد المخاوف الأمنية والضغوط السياسية، فتم إغلاق المعابر وفرض التأشيرات وبدأ بناء الجدار الحدودي لحماية الأمن القومي وتعزيز السيطرة على الحدود، تمثلت هذه السياسة في:
- الترحيل:
تُعلن الحكومة التركية أنها تتبنى سياسة “العودة الطوعية الآمنة والكريمة والمنظمة” في تعاملها مع اللاجئين السوريين. تنفذ السلطات التركية هذه السياسة من خلال إجراءات تبدأ بتقديم طلب شخصي من اللاجئ، ويُشترط أن تكون العودة ناتجة عن إرادة حرة دون أي ضغط أو إكراه. تُشرف منظمات دولية ومحلية على عملية العودة لضمان شفافيتها واحترامها للمعايير الإنسانية، ويُستكمل الإجراء بتسليم وثائق الحماية المؤقتة وإصدار تصريح طريق يُمكّن الشخص من الوصول إلى المعبر الحدودي المحدد لمغادرة الأراضي التركية. تؤكد الحكومة التركية أن هذه السياسة تُنفذ وفقًا للقانون الدولي ولا تتضمن أي نوع من الترحيل القسري [47]
ومع ذلك، صرّح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أن العودة الطوعية التي تنفذها تركيا غالبا ما تكون عودة قسرية محفوفة بالمخاطر ويشوبها اليأس.[48]
2.تقييد حرية التنقل:
فرضت تركيا قيودًا على حركة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، وهو ما جعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لهم وواجه السوريون صعوبات كبيرة في التنقل بين المدن؛ حيث لم يكن يُسمح لهم بالتحرك إلا بعد الحصول على إذن رسمي من السلطات وأدّت هذه القيود إلى الحد من قدرتهم على التنقل، ومنعت الكثيرين منهم من الوصول إلى فرص عمل مناسبة، تعاملت السلطات بصرامة مع من يُكتشف أنهم تنقّلوا بدون إذن، حيث كانت تقوم بإصدار تحذير، وفي بعض الحالات تهددهم بالترحيل من المدينة التي تواجدوا فيها.[49]
3.الدمج المحدود:
منعت تركيا اللاجئين السوريين من الاندماج الكامل في المجتمع، حيث عاملتهم كمقيمين مؤقتين، على أساس أنه سيتم ترحيلهم لاحقًا. حرمتهم من سهولة الحصول على الجنسية التركية، وقيّدت سياسات الدمج التي كانت مطروحة في السنوات الأولى، أعادت الحكومة فرض الرسوم على التعليم الجامعي بعد أن كانت قد أعفتهم منها، وفرضت قيودًا على الإقامة السياحية ومنعت الأجانب من السكن في بعض الأحياء وكل هذه السياسات أكدت أن الدولة لا تتعامل مع السوريين كجزء دائم من المجتمع التركي [50]
- التمييز في العمل:
واجه اللاجئون السوريون مشكلات كبيرة في الحصول على فرص عمل خلال الآونة الأخيرة، حيث ينص القانون على أنه لا يمكن تعيين عامل واحد من اللاجئين إلا بعد تعيين عشرة من المواطنين الأتراك. أظهر هذا القانون تمييزًا واضحًا بين السوريين والأتراك، ويدعم بشكل غير مباشر سياسة الدمج المحدود، إذ لم يُسمح للسوريين بالمشاركة الكاملة في سوق العمل أو الاندماج الفعلي في المجتمع التركي، زادت هذه الصعوبات مع غياب إتقان اللغة التركية، وكون الكثير من اللاجئين لم يُكملوا تعليمهم، مما جعلهم يقبلون بوظائف ذات رواتب أقل بكثير من متوسط أجور العمال الأتراك.[51]
المبحث الثالث
تحديات الحكومة التركية في معالجة أزمة اللاجئين
تواجه تركيا العديد من التداعيات الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين التي بدأت بعد حدوث الأزمة السورية، ففي هذا المبحث سيتم التركيز على التداعيات السياسية المنقسمة لمحلية، إقليمية ودولية إلى جانب عرض أبرز المشكلات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة.
أولًا: التداعيات السياسية لأزمة اللاجئين:
أ-محليًا:
تُعد أزمة اللاجئين أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة التركية حيث تختبر هذه الازمة قدرة الدولة على التكيف والتعامل مع التداعيات السياسية؛ فلم تكن تركيا مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين فواجهت الدولة مشكلة؛ حيث وجدت قصور في القوانين والتشريعات التي تخاطب اللاجئين فتم صياغة سياسات جديدة لمعالجة هذا الوضع بالإضافة إلى تغييرات في بنية أجهزة الدولة المختصة في التعامل مع شؤون اللاجئين وفي الوزارات المختلفة في الدولة، حيث تم استحداث المديرية العامة لإدارة الهجرة في بنية وزارة الداخلية وإنشاء مجلس لسياسات الهجرة ومركز اتصالات الأجانب ومراكز الاستقبال والإيواء.[52]
زادت معدلات الجرائم منذ تطبيق تركيا سياسة الباب المفتوح حيث أصبحت سوريا مركزًا للمتطرفين والإرهابيين خاصةً في المدن القريبة من الحدود التركية التي أصبحت عرضة للقصف والهجمات الجوية بالإضافة إلى انتشار العمليات الارهابية في الولايات التركية من بعد سيطرة هذه الجماعات على عدد من المعابر الحدودية السورية [53] ، بالإضافة إلى ارتكاب السوريين عدد من الجرائم في عدة مدن واتهامهم بتهديد النظام والقانون في تركيا، لكن تم إثبات أن هذه الزيادة في معدلات الجرائم ليست كلها بفعل اللاجئين، بل ان عدد من هذه الجرائم تم ارتكابها من السكان الأصليين للدولة كرد فعل و اعتراض على السياسات المتبعة مع اللاجئين.[54]
انتشرت ظاهرتَا تسييس الهجرة والاستقطاب السياسي لأزمة اللاجئين في تركيا، حيث يتم تحويل قضية الهجرة واللاجئين إلى أداة في الخطابات السياسية بهدف تحقيق مكاسب سياسية وحزبية. وتبرز هذه الظاهرة خاصة أثناء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، حيث يستخدم الأطراف المتنافسة أزمة اللاجئين لإرضاء الناخبين، سواء المؤيدين أو المعارضين.[55]
ظهرت هذه الظاهرة في تركيا مع نزوح اللاجئين السوريين الذين تم استقبالهم بترحيب من حزب العدالة والتنمية وقد ارتبطت سياسات الحزب باستقبال اللاجئين حيث عمل الحزب على استغلال الجانب الإنساني للأزمة لكسب تعاطف الشعب وزيادة شعبية الحزب خاصة وأن العديد من السوريين ممتنين لدور أردوغان في توفير ملجأ لهم واستضافتهم؛ إذ كان الحزب معتمدًا على تصويتهم لصالحه وهذا يمكن تحقيقه إذ يسمح قانون الجنسية التركية للأجانب الذين عاشوا في البلاد لمدة خمس سنوات بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.[56]
برزت أزمة الاستقطاب السياسي في الفترة السابقة لانتخابات 2019 عندما لاحظ حزب الشعب الجمهوري انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية بسبب رفض الرأي العام للسياسات التي يتبناها الحزب في التعامل مع اللاجئين فاستغل الحزب هذه الظروف ليتصدر الساحة السياسية عن طريق اتهام اللاجئين بتهديد المجتمع التركي وتشكيل عبء اقتصادي على الدولة، كما عارض سياسات حزب العدالة والتنمية واتهامه بإطالة فترة إقامة اللاجئين في البلاد بهدف استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وليس خوفًا على سلامة اللاجئين، واتجه زعيم الحزب في خطاباته بالدعوة لتشجيع العودة الآمنة للاجئين فور انتهاء الأزمة السورية وبالفعل قد نجحت محاولات حزب الشعب الجمهوري في استغلال مشاعر المعارضة للاجئين واستطاع التفوق في الانتخابات على حزب العدالة والتنمية.[57]
ب- إقليميًا:
ترفض الجماعات الكردية المقيمة في تركيا سياسات الدولة المتبعة مع اللاجئين حيث يتخوفون من التأثير السلبي على نتائج الانتخابات البرلمانية الناتج عن إقامة اللاجئين في الجنوب الشرقي حيث يتمتع حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد بالأغلبية في هذه المناطق، لكن دخول السوريين سيشكل خطرا على الهامش الانتخابي لهذا الحزب.[58]
استغل الأكراد السوريون هذه الأوضاع السياسية لصالح استقلالهم السياسي، حيث شرع الأكراد في إنشاء دولة كردية في شمال سوريا مما يزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن القومي لتركيا، لأنها ستعزز من قوة ونفوذ حزب العمال الكردستاني الذي يقود الأعمال الإرهابية في تركيا، قامت تركيا بإطلاق بعض العمليات العسكرية كعملية درع الفرات في عام 2016 لمنع الوحدة الكردية في شمال سوريا وتأمين حدودها، وفي عام 2020 بادرت تركيا بعملية نبع السلام على حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا لتأسيس منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين و إمدادهم بالمساعدات اللازمة.[59]
ج-دوليًا:
أدت رغبة الدولة في إنشاء منطقة آمنة في سوريا إلى وضع تركيا في موقف حرج مع الولايات المتحدة الامريكية اذ تريد تركيا التخلص من القوات الكردية الإرهابية في سوريا لتأمين المنطقة بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تؤمن الأسلحة لهذه التنظيمات وتعتبرهم حلفاء لها وتهدف لهزيمة الدولة الإسلامية في سوريا.[60]
أثرت الأزمة أيضا على علاقة تركيا بروسيا بسبب الاختلاف في الأهداف بخصوص الازمة السورية حيث أرادت روسيا انتصار نظام بشار الأسد لكن تركيا كان تركيزها على إضعاف نفوذ الأكراد السوريين وإنهاء النظام السياسي الديكتاتوري بهدف تأمين الدولة وعودة اللاجئين، ولكن تقاربت مصالح الدولتين في 2016 عندما رأت روسيا فرصة في مساعدة تركيا في حد نفوذ الأكراد مما سيضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.[61]
أدى وجود اللاجئين في تركيا الى توتر العلاقات التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ويعتبر أن العلاقات بين الطرفين وصلت أسوأ حالاتها في 2015،* حيث دخل العديد من اللاجئين إلى أوروبا عن طريق تركيا وخوفا من زيادة أعداد المهاجرين السوريين، [62] اقترح الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقية مع تركيا لتشديد القيود الحدودية وإعادة اللاجئين إلى تركيا على أن الاتحاد الاوروبي سيشارك تركيا في تحمل العبء الاقتصادي وفي المقابل سيتم فتح مجال جديد في مفاوضات دخول تركيا للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات سفر المواطنين الأتراك لأوروبا.[63]
وضعت هذه الاتفاقية تركيا في وضع حرج حيث لم يتمم الاتحاد الأوروبي جانبه من الاتفاق ولم تحصل تركيا على المساعدة المالية المتفق عليها لإبقاء اللاجئين إلا بعد أن قام أردوغان رئيس تركيا بالتهديد بفتح الحدود التركية للراغبين بالهجرة لأوروبا، ولم يحصل المواطنين الأتراك على حق السفر إلى أوروبا بدون /تأشيرة كما كان متفق عليه ، بل وقام الاتحاد الأوروبي باتهام الدولة التركية باستغلال أزمة اللاجئين للضغط على الاتحاد وأن مبادئها بعيدة عن مبادئ و قيم الاتحاد الأوروبي حيث تم انتقاد حرية الصحافة والتعبير في تركيا بالإضافة إلى تخوف ألمانيا من معدل النمو السكاني في تركيا الذي سيجعل منها خصم قوي لألمانيا في عمليات التصويت ولذلك فضلوا منح تركيا صفة شريك مميز في الاتحاد بدلاً من عضو دائم.[64]
تكررت الأزمة عام 2020 عندما قررت حكومة تركيا فتح حدودها مع اليونان بسبب غضب أردوغان من موقف الاتحاد الأوروبي غير الداعم العمليات التركية العسكرية في سوريا، أدى هذا القرار لإعلان حالة الطوارئ في اليونان واجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سريع لإدارة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اليونان.[65]
ثانيًا: التداعيات الاقتصادية:
أدى تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى تأثير كبير على الاقتصاد التركي في عدة جوانب، مثل تأثيره على الأسعار، الرواتب، البطالة، النقاقات الحكومية والمساعدات الأجنبية، في الوقت نفسه، كان هناك تأثير إيجابي تمثل في إنعاش الاقتصاد التركي من خلال المشاريع التي أنشأها اللاجئون السوريون بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال السوريين في القطاع الخاص.
أ-التضخم:
أدى تزايد أعداد اللاجئين السوريين في بداية موجات اللجوء إلى تركيا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات وبعض المنتجات الغذائية، وذلك بسبب زيادة الضغط على الموارد والخدمات المتاحة، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية في مناطق معينة، هذا الارتفاع أثر سلبًا على مستوى المعيشة لدى كثير من المواطنين الأتراك خاصة في المناطق التي شهدت كثافة كبيرة من اللاجئين السوريين، مثل بعض أحياء إسطنبول وغازي عنتاب وأورفا، فقد واجه السكان المحليون صعوبة في الحصول على سكن بأسعار مناسبة كما ارتفعت تكلفة المعيشة اليومية نتيجة لهذا الضغط المفاجئ على الأسواق المحلية مما أثار في حينها حالة من التذمر والنقاش المجتمعي الواسع حول أثر الوجود السوري على الحياة الاقتصادية في البلاد[66]، أظهرت بيانات البنك الدولي أن معدل التضخم في تركيا بلغ 8.6٪ في عام 2010، وارتفع إلى 15.2٪ في عام 2019، ما يعكس تأثيرًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال هذه الفترة.[67]
ب- البطالة:
كشفت الدراسات عن وجود علاقة طويلة المدى بين زيادة أعداد السوريين في تركيا وتدهور مؤشرات سوق العمل، دخل إلى تركيا أعداد كبيرة من السوريين الذين سعى معظمهم للعمل في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة والصناعات الخفيفة والبناء، عمل هؤلاء السوريون في هذه القطاعات دون أوراق رسمية وقبلوا برواتب أقل من تلك التي كان يطلبها العمال الأتراك، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة بين الأتراك، ومع ذلك كان التأثير أقل بكثير في القطاعات الرسمية حيث واجه السوريون صعوبة في الالتحاق بهذه القطاعات بسبب نقص المؤهلات أو بسبب القيود القانونية المعقدة التي فرضها النظام التركي لتوظيف السوريين في القطاعات العامة.[68]
كانت معدلات البطالة في تركيا تسجّل انخفاضًا تدريجيًا قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 وبدء موجات اللجوء السوري إلى الأراضي التركية. إلا أنه مع تدفق اللاجئين السوريين وازدياد أعدادهم، بدأت معدلات البطالة بالارتفاع؛ حيث ارتفعت من 9.2% في عام 2012 إلى 9.7%، واستمرت بالتصاعد سنويًا لتصل إلى 13.7% في عام 2019 [69]
ج- تأثير اللجوء السوري على الإنفاق الحكومي
أفادت تقديرات الحكومة التركية بأن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين بين عامَي 2011 و2022 تجاوزت 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وقد وُجّهت هذه الموازنة لتغطية الإيواء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وإلى جانب الإنفاق الحكومي، استفادت أنشطة التكامل من تمويل الاتحاد الأوروبي عبر صندوق اللاجئين في تركيا، الذي ضمَّ أكثر من 9 مليارات يورو موزعة على ثلاث دفعات، دعمت مشاريع الإسكان والتعليم والصحة والخدمات المجتمعية.[70]
ثالثًا: دور الرأي العام ومدى استجابة الحكومة التركية له
تشكل أزمة اللاجئين مشكلة تثير اهتمام الرأي العام حيث تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين و لكن تصعب عملية حرية التعبير عن الرأي في تركيا بسبب استحواذ الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية ، مما أدى إلى اتجاه المواطنين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي وكانت النتيجة هي انتشار ظاهرة مقابلات الشوارع التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن الرأي إذ تُناقَش المشكلات المتكررة التي تواجه المواطنين، ومن أبرز التحديات التي تُناقَش هي أزمة اللاجئين، المطلب المتكرر في هذه المقابلات هو إعادة ترحيل اللاجئين إلى أوطانهم، حيث يرى المواطنون الأتراك أنه حان الوقت أن يعود اللاجئين بشكل دائم خاصةً إن نسبة كبيرة منهم يذهبون مؤقتًا للزيارة ويعودون لذا فمن وجهة نظر الأتراك أنه إذا كانوا يستطيعون الذهاب مؤقتًا فإنهم يستطيعون البقاء بشكل دائم.[71]
انتشرت المشاعر المعارضة للاجئين، خصوصًا بعد أن شعر الأتراك أن الأزمة السورية مستمرة وأن اللاجئين بدأوا بالاستقرار بشكل دائم، فأصبح الأتراك يرون اللاجئين على أنهم عبء على الحكومة خاصة من الجانب الاقتصادي. ولذا بدأ الشعب في تبني الفكر القومي الإقصائي اعتقادًا منهم أنهم في مكانة فكرية واجتماعية أعلى من اللاجئين ومن أمثلة السلوكيات الإقصائية هي أن بعض الأتراك يرفضون السكن في بنايات يسكن فيها اللاجئين حتى أنهم أصبحوا يغادرون منازلهم كي لا يضطروا إلى الاختلاط مع اللاجئين.[72]
يرتبط رفض الشعب التركي لوجود اللاجئين السوريين بتعاطف اللاجئين مع سياسات الرئيس أردوغان وتأييدهم للأفكار المحافظة والدينية التي يتبناها حزب العدالة والتنمية ، حيث يرى الأتراك أن هذه الأفكار تهدد الاتجاه العلماني الذي تهدف إليه الدولة التركية و يرفضوا فكرة ارتباطهم ثقافياً بالسوريين مما يشجع أكثر على تبني الفكر القومي الإقصائي الذي يؤدي إلى تطبيع السلوك غير المتسامح والعدواني تجاه اللاجئين، و يتم تعزيز هذا الفكر الإقصائي من خلال خطابات السياسيين التي يكون محتواها معادٍ للاجئين ، إذ تم ملاحظة حصول هذه الخطابات على شعبية ودعم كبير حيث تدعو إلى لوم اللاجئين على تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعلى أغلب المشكلات التي تواجه المجتمع وتدعو لرفض فكرة حصولهم على الجنسية التركية خوفا منهم من تأثير وجودهم ثقافيا على الدولة. [73]
أدت الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمناخ السياسي الديكتاتوري في تركيا إلى تفاقم مشاعر العداء تجاه اللاجئين، وظهر هذا في هزيمة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2019، وقد كان السبب الاول وراء الهزيمة هو شعور المواطنين الأتراك بعدم الاستقرار بعد قرارات الحكومة بإغلاق مخيمات اللاجئين مما دفعهم للاتجاه لإسطنبول، والسبب الثاني المحرك لمشاعر المواطنين هو مدى تدخل الحكومة التركية في الأزمة السورية، إذ يعترض المواطنون الأتراك على موقف الحكومة ومدى الإنفاق العسكري الذي تتكبده الحكومة بسبب تدخلها في هذه الأزمة.[74]
يزيد وجود اللاجئين في تركيا مشاعر الاستياء لدى المواطنين الأتراك، وخاصة بسبب التغيير الديموغرافي في التكوين السكاني، حيث ظهر هذا التغيير في الزيادة في معدلات الإنجاب لدى اللاجئين السوريين مما أثار غضب الأتراك؛ حيث أنهم يرون تلك الزيادة بغرض تأمين الحصول على الجنسية التركية ويرغب العديد من المواطنين الأتراك في وضع قيود على معدلات الإنجاب للاجئات.[75]
يشعر المواطنون الأتراك بالتمييز للاجئين، حيث ازدادت أسعار استئجار المنازل بسبب الزيادة على الطلب، بالإضافة إلى الاستياء من تفضيل توظيف اللاجئين حيث إنهم يمثلون عمالة رخيصة وغير مكلفة لأصحاب الأعمال.[76]يعتقد السكان المحليون أيضًا أنهم لا يتلقون الخدمات المستحقة، كالخدمات الصحية حيث يروا أن اللاجئون يقومون باستنزاف الخدمات الصحية المجانية ويشكلون ضغطًا على الخدمات المتوفرة، وقد أثر هذا الضغط على القطاع الصحي بانتشار أمراض كشلل الأطفال الذي قد تم شفاؤه واستبعاده تمامًا من تركيا. تقدم البعض بشكوى من أن اللاجئين يتم معاملتهم بطريقة تفصيلية في الجامعات حيث يسمح لهم بعدم دخول بعض الامتحانات وحصولهم على منح مجانية لدخول الكليات.[77]
تراجعت حكومة أردوغان نسبياً عن سياسات الاندماج المقترحة وبسبب رفض أغلبية المواطنين نزوح اللاجئين إلى المدن التركية الرئيسية اضطرت الحكومة التركية إلى تبني سياسات جديدة لتنظيم أماكن إقامة السوريين هذا النزوح بهدف إرضاء الشعب و بعد رد فعل الجماهير المعارض لمقترحات الحكومة في منح الجنسية التركية للاجئين، خاصة بعد أن اعترض مؤيدو الرئيس على المقترح ، تحول موقف الرئيس إلى بث خطابات تؤكد على عودة اللاجئين إلى وطنهم فور انتهاء الأزمة، وتوجه إلى منح الجنسية لأعداد محدودة من اللاجئين الذين يزيدون قيمة الدولة تعليميًا أو اقتصاديًا وبدأت الحكومة في حملات الترحيل لمرتكبي المخالفات. تتجنب الحكومة استخدام ألفاظ كالاندماج، وتميل نحو بث فكرة الانسجام كي تتجنب إثارة غضب الشعب التركي. وتنفذ الحكومة خطة الانسجام عن طريق استخدام قطاع التعليم لتسهيل عملية التكيف في المجتمع،[78] إذًا فالحكومة تحاول من تقليص الفجوة بين رغبة الشعب وبين مخططاتها بهدف إرضاء الرأي العام والحد من انتشار العداء تجاه اللاجئين. [79]
يخلص الفصل إلى أن الأيديولوجية السياسية في تركيا كانت في البداية صراع بين أفراد أرادوا التغريب وتقليد أوروبا، وأفراد أرادوا إحياء الإسلام، ثم ظهرت الكمالية لمصطفى كمال أتاتورك، الذي دعا إلى العلمانية، ثم ظهرت مرة أخرى حركة تدعو إلى التوجه إلى العالم الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان، ثم حاول حزب العدالة والتنمية التحول إلى العلمانية تدريجيًا، وشهدت تركيا تحولات سياسية مهمة، أبرزها الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي عام 2017، وهذا التحول أدى إلى زيادة سلطات الرئيس، وأصبح هو المسؤول عن السلطة التنفيذية، وأُلغي منصب رئيس الوزراء، أما مواقف الأحزاب من اللاجئين، فمنها حزب العدالة والتنمية الذي أبدى دعم سياسة الباب المفتوح، وحزب الشعب الجمهوري الذي عارض استقبال اللاجئين، أما بخصوص الحزب الجيد، فقد رفض تدخل تركيا في شؤون سوريا، وطلب التوقف عن دعم المعارضة السورية، شهدت السياسة التركية تجاه اللاجئين السوريين تحولاً جذرياً من سياسة الباب المفتوح التي تميزت بالاستقبال غير المشروط وتوفير الخدمات الأساسية، إلى سياسة الباب المغلق التي اتسمت بإجراءات تقييدية صارمة كالترحيل الممنهج وفرض قيود على الحركة والعمل، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التداعيات التي تواجهها تركيا أن أزمة اللاجئين ليست فقط أزمة إنسانية لكنها لها تأثيرات متعددة خاصة على الدولة المضيفة للاجئين فتشكل الأزمة عبئًا على علاقات الدولة الاقليمية والدولية مما يتطلب من الدولة المضيفة أن تتبنى سياسات حكيمة لتضمن استقرار الوضع الداخلي وتأمين سياستها الخارجية.
سنتطرق في الفصل التالي لأبرز المؤسسات المؤثرة في عملية صنع القرار في ألمانيا، إلى جانب أبرز الأيديولوجيات مع عرض تحديات تواجهها الحكومة الألمانية حيال التعامل مع ملف اللاجئين، ومن ثم سنطرح قضية الرأي العام إزاء الملف ذاته، مع الإشارة لأشهر السياسيات الخاصة باللاجئين.
الفصل الثالث
أثر النظام السياسي في ألمانيا على سياسات اللاجئين
تمهيد
يطرح الفصل أهم اللاعبين المؤثرين في عملية صنع القرار في ألمانيا مثل المستشار وغرفتي السلطة التشريعية، إلى جانب التطرق لأبرز الأيدولوجيات المؤثرة مثل الأيديولوجية الرافضة للنازية مع عرض أبرز السياسات الخاصة باللاجئين ومنها الباب المفتوح وسياسات الاندماج، وتوضيح موقف الأحزاب المختلفة من ذلك الملف، فضلًا عن تناول أهم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الألمانية في التعامل مع أزمة اللاجئين التي تتنوع ما بين دولية ومحلية وإقليمية، ويختتم الفصل بطرح دور الرأي العام في تلك الأزمة الذي يتسم بالتوافق مع وجود اللاجئين إلى جانب وجود معارضة أطراف مثل حركة بيغيدا والأحزاب اليمينية المتطرفة وكيف يكون رد فعل الحكومة الألمانية إزاء تلك الآراء المختلفة.
المبحث الأول
النظام السياسي في ألمانيا
يتناول المبحث النظام السياسي لألمانيا باعتبارها دولة اتحادية ديموقراطية ذات طبيعة فيدرالية التي تعد من أبرز ملامحها السياسية حيث تتوزع السلطات بين عدة هيئات دستورية تتعاون لضمان التوازن السياسي في البلاد كما يستعرض دور ومشاركة الأحزاب المختلفة في إدارة وسنّ القوانين المتعلقة بشؤون اللاجئين.
أولًا: الدستور
ألمانيا هي دولة ديمقراطية برلمانية اتحادية ويُعرف دستورها المكتوب “بالقانون الأساسي”. ينص القانون الأساسي على مبدأ التقسيم الثلاثي للسلطات إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويستلهم الدستور في معظمه من الدساتير الألمانية السابقة في إطار التقاليد الديمقراطية. يُعد كل حكم من أحكام الدستور قاعدة مُلزِمة قانونيًا تتطلب التنفيذ الكامل والواضح ويجب أن تخضع العملية السياسية، قبل كل شيء، لهيمنة الدستور.[80]تلتزم حكومة ألمانيا بحماية اللاجئين، نظرًا لإدراج الحق الأساسي في اللجوء في الدستور”القانون الأساسي”في المادة 61 منذ عام 1949. ونتيجة لذلك، تمتلك ألمانيا نظام لجوء راسخًا وفعالًا بدرجة عالية من التطور.[81]
ثانيًا: الايديولوجية
تعددت الأيدولوجيات السياسية في ألمانيا حيث عرفت الحكم النازي الذي استند إلى أيدولوجية قومية متطرفة مبنية على العنصرية والتوسع؛[82] ولهذا السبب كان العديد من الألمان يخشون من إحياء أنماط السلوك النازية[83]. تركت تجربة ألمانيا تحت الحكم النازي أثرًا لا يمحى على ثقافتها السياسية وأيديولوجيتها العامة حيث تشكّل إجماع مناهض للفاشية والنازية العنصرية مُتجذّر في القانون والمجتمع الألماني معًا. ينصّ “القانون الأساسي” في المادة21 صراحةً على حظر الأحزاب والمنظمات التي تسعى إلى إضعاف أو هدم النظام الديمقراطي[84] مما يعتبر ردّ مباشر على استيلاء النازيين على السلطة والدكتاتورية الحزبية الواحدة في الوقت آنذاك. وبناءً عليه تُقابل أي محاولات لإحياء النازية أو تمجيدها بحظر قانوني ورفض شعبي واسع؛ ولذلك السبب المبدأ القائل “لن يتكرر أبدًا” ليس مجرّد شعار رمزي، بل هو نهج عملي وفعّال.[85]
ارتبطت الدوافع الرئيسية وراء سياسات الحزب الديموقراطي المسيحي برئاسة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين بتاريخ ألمانيا خلال الحقبة النازية، ووفقًا لميركل، تحتاج ألمانيا إلى الاستفادة من تاريخها والعمل على إبراز صورة جديدة تُجسّد الانفتاح والمبادئ الإنسانية. وقد سعت إلى إعادة تموضع ألمانيا كدولة تحتضن التنوع، وتتقبل وترحب بالأفراد من مختلف الخلفيات العرقية والقومية، وتوفر المساعدة للمحتاجين.
ثالثًا: أبرز المؤسسات المؤثرة في عملية صنع القرار
أ- السلطة التنفيذية:
- 1. الرئيس الفيدرالي:
تُعد مهام الرئيس الالماني في الاساس مهام تمثيلية وينظر اليه كحارس للدستور، تنقسم سلطات الرئيس الى سلطات داخلية متمثلة في توقيع بعض الوثائق والمراسيم والموافقة على حل البرلمان في حالات استثنائية واجراء الانتخابات المبكرة، وسلطات خارجية من أبرزها تمثيل المانيا على المستوى الدولي حيث يوقع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الاخرى واستقبال الدبلوماسيين لكن بالرغم من سلطاته المختلفة لم يمنحه الدستور حق الفيتو على القوانين التي تتخذها السلطة التشريعية.[86]
- الحكومة الفيدرالية:
تتكوّن الحكومة الفيدرالية من المستشار الفيدرالي، الذي تبدأ فترة ولايته عند استلامه خطاب التعيين من الرئيس الاتحادي بعد انتهاء عملية الانتخاب وتنتهي عادةً بانعقاد البوندستاغ الجديد[87]، والوزراء الفيدراليين يتم تعينهم من قِبّل المستشار وتنتهي مدة ولايتهم أيضًا عند أي انتهاء آخر لولاية المستشار الاتحادي[88]. يشغل المستشار موقع القمة في هيكل الحكومة، حيث يُشبه في كثير من الأحيان بـ”قائد السفينة” فهو يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة، إذ يختار الوزراء بنفسه ويقدّم ترشيحاتهم إلى رئيس الجمهورية الاتحادي، الذي يلتزم باقتراحه في التعيين أو الإعفاء يحدد المستشار ايضًا عدد الوزراء واختصاص كل منهم، ويضع الخطوط العريضة للسياسات الحكومية العامة، وهو ما يُعرف بـ”مبدأ توجيهات سياسة المستشار” ورغم أن للمستشار سلطة إصدار التعليمات للوزراء، فإن الدستور يؤكد في الوقت ذاته على مبدأ استقلالية الوزير، والذي يُتيح لكل وزير إدارة شؤون وزارته بشكل مستقل ومسؤول، طالما كان ذلك ضمن الإطار الذي تحدده توجيهات المستشار. ولذلك تمكن العديد من الوزراء من بناء مكانة قوية لأنفسهم داخل الحكومة، بفضل كفاءتهم المهنية، وقدرتهم على التعامل بذكاء مع الإعلام، إضافة إلى الدعم البرلماني أو الشعبي الواسع الذي يحظون به.[89]
ب– السلطة التشريعية:
- البوندستاغ:
يمثل البوندستاغ أعلى هيئة دستورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والهيئة الوحيدة في الدولة التي يتم انتخابها من الشعب مباشرة، ويعد أكثر الأجهزة الدستورية حضورًا في الإدراك العام، ينفرد البوندستاغ بالحق التشريعي على المستوى الاتحادي لذلك هو الذي يقود التطورات السياسية والمجتمعية، لا يقتصر دور البوندستاغ على سن وتشريع القوانين فقط، بل يتوسع ليشمل أيضًا انتخاب المستشار الاتحادي الذي يشكل قمة السلطة التنفيذية، كما أن لأعضاء البرلمان دور مؤثر ومهم في انتخاب رئيس الجمهورية الاتحادي[90]، حيث يُنتخب الرئيس الاتحادي من قِبَل الجمعية الاتحادية ، التي يدعوها رئيس البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) للانعقاد لهذا الغرض فقط. وتتألف من أعضاء البوندستاغ وعدد متساوٍ من الأعضاء تنتخبهم المجالس البرلمانية للولايات، يشارك البوندستاغ كذلك في تعيين أصحاب مناصب عليا أخرى فينتخب على سبيل المثال نصف عدد قضاة المحكمة الدستورية الإتحادية ورئيس ديوان المحاسبة الاتحادي وغيرهم، يمارس البرلمان وظيفة في غاية الأهمية ألا وهو الدور الرقابي على الحكومة الاتحادية.[91]
2.البوندسرات:
يعتبر البوندسرات المجلس الأعلى في البرلمان الألماني، يُعدّ مجلس البوندسرات “المجلس الفيدرالي” هيئة دستورية تُسمح للولايات “اللاَندر” من خلالها المشاركة في التشريع حيث تتمثل إما في إعطاء موافقته على مشاريع القوانين أو رفضها أو – وفقًا للترتيب الدستوري – الاعتراض على مشروع القانون المعني إذا لزم الأمر ، وفي إدارة شؤون الاتحاد، وكذلك في القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، ويعمل البوندسرات بوصفه قوة موازنة للأغلبية السياسية في البوندستاغ، إذ يُمثل مصالح الولايات على مستوى السلطة الفيدرالية العليا[92]، لكن لا يعني ذلك انه مخصصًا لمصالح الولايات فقط، بل يهتم أيضًا بمصالح الاتحاد.[93]
البوندسرات لا يتكوّن من ممثلين منتخبين مباشرة، وإنما من أعضاء حكومات الولايات. يتم تفويضهم وسحبهم من قِبل حكوماتهم، وهم ملزمون بتعليماتها (أي يخضعون لما يُعرف بالتفويض الإلزام)، وبالتالي، فإن أي التغيير الحكومي في ايٍ من الولايات يؤدي إلى تغيّر في التشكيل السياسي للبوندسرات. ونظرًا لأن الانتخابات في الولايات لا تُجرى في نفس الوقت، فإن أعضاء البوندسرات لا يُستبدلون دفعة واحدة. ولهذا السبب يُطلق على البوندسرات وصف “الهيئة الأبدية”.[94]
ج– السلطة القضائية:
تُشكل المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة دستورية مستقلة تتمتع باختصاصات يكفلها الدستور وتتمتع بإدارة مستقلة، يُنتخب 16قاضٍ بالتساوي من قِبل البوندستاغ والبوندسرات، ويُنتخبون لمدة اثني عشر عامًا لفترة واحدة. تشمل اختصاصات المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار القرارات الملزمة على سبيل المثال في النزاعات بين الهيئات الدستورية (مثلاً بين البوندستاغ والبوندسرات) بشأن دستورية القوانين، وغيرها من القواعد القانونية، والقرارات الفردية (المراجعة الدستورية، والشكاوى الدستورية)؛ كذلك بشأن التدابير اللازمة لحماية الديمقراطية (مبدأ سيادة القانون).[95]
د–المؤسسات غير الرسمية
يعد تأثير المؤسسات غير الرسمية مثل جماعات الضغط جانبًا أساسي في العملية السياسية. تقع مجموعات الضغط المعنية بقضايا الهجرة واللاجئين تحت فئة مجموعات المصلحة العامة التي تعمل من أجل قضية عامة أوسع. في ألمانيا، تنقسم هذه المجموعات إلى فئتين من المنظمات/الحركات: المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز حقوق اللاجئين، والحركات اليمينية المعادية للمهاجرين.[96]
رابعًا: مواقف الأحزاب المختلفة تجاه قضايا اللاجئين:
أ– موقف الأحزاب المؤيدة
يُعتبر الحزب الديمقراطي المسيحي حزبًا محافظًا، بينما يُنظر إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أنه حزب يساري التوجه، والاختلافات في التوجهات بين الحزبين لم تنعكس على السياسات الفعلية؛ يُشير هذا التوافق إلى تأثير القيم الثقافية والمعتقدات المرتبطة بنظام الرفاهية الديمقراطي المسيحي على السياسة العامة، وليس العكس. وشهدت ألمانيا، نتيجة للتحالفات بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي المسيحي، إصدار عدة قوانين خاصة باللاجئين والمهاجرين. وشهدت ألمانيا، نتيجة للتحالفات بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي المسيحي، إصدار عدة قوانين خاصة باللاجئين والمهاجرين، شعر الحزب الديموقراطي المسيحي، برئاسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، خلال أزمة اللاجئين عام 2015 أن من واجب ألمانيا أن تتحمل قيادة الجهود وبالتزاماتها الإنسانية في التعامل مع تلك الأزمة. إذ رأى الحزب أن على ألمانيا أن تكون نموذجًا يحتذى به في أوروبا من ناحية قبول اللاجئين واستيعابهم ودمجهم في المجتمع، يهدف الحزب إلى تقديم ألمانيا كدولة رائدة في التعامل مع أزمة اللاجئين، فبالإضافة إلى سعي ميركل للحصول على تمويل إنساني من جهات متعددة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تُركز على تقديم الدعم والمعونة الإنسانية، وإقامة تحالفات وشراكات مع منظمات أخرى.[97]
أكدت المستشارة الفيدرالية أن عدد طالبي اللجوء الذين يمكن قبولهم غير مقيد بالقانون الأساسي الألماني، وذكّرت الجمهور بأنه لا يوجد حد أقصى لحق اللجوء السياسي، مستشهدةً بالمادة الأولى من “القانون الأساسي” التي تنص على أن “كرامة الإنسان مصونة”[98]، وأثارت جدلاً واسعاً في ألمانيا وخارجها. تعرضت المستشارة ميركل للعديد من الانتقادات والضغوطات، ومن بين الجهات التي انتقدت ميركل كان الحزب الاجتماعي المسيحي الذي طالب بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين، وهو مطلب لاقى صدى واسعًا بين المواطنين، كذلك، واجهت ميركل انتقادات من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، ومن داخل حزبها أيضًا. وشكك المنتقدون في جدوى سياسات الهجرة المفتوحة التي اعتمدتها، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.[99]
شكّل دمج اللاجئين أولوية وطنية بالنسبة للمستشارة السابقة ميركل، وشدّدت على أهمية التعلّم من أخطاء الماضي، ورأت أنه إذا سارت عملية التكامل على ما يُرام، فقد تستفيد ألمانيا اقتصاديًا أكثر مما ستعاني وقد مارست شخصيات سياسية بارزة في حزبها، فضلاً عن شخصيات من أحزاب الائتلاف الأخرى، ضغوطاً على ميركل وانتقدتها في الداخل، ومع ذلك، أصرت على تمسكها باستراتيجيتها، مؤكدةً أنه بدلاً من الاعتماد على حلول سريعة أو مؤقتة تثبت عدم فعاليتها لأزمة اللاجئين، تقع على عاتقها مسؤولية المساعدة في إيجاد حلول مستدامة طويلة الأمد، وكان هدفها مسح الانطباع السلبي عن تعامل ألمانيا السابق مع قضايا المهاجرين، وترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في الترحيب باللاجئين ودمجهم بشكل فعال، وفي هذا السياق، أطلق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عددًا من المبادرات المختلفة لمساعدة اللاجئين، كان أبرزها الاحتفال باليوم العالمي للاجئين عام 2016.[100]
ب–موقف الأحزاب اليمينية المعارضة تجاه قضايا اللاجئين:
ترتبط أزمة اللاجئين بشكل لافت بصعود اليمين المتطرف في ألمانيا، فعلى عكس بقية الدول الغربية، من المتعارف عليه في ألمانيا أن الأحزاب اليمينة لا تتمكن من الوصول للمقاعد على المستوى الفيدرالي؛ بسبب رفض الماضي النازي الذي يلاحقها، فجاءت انتخابات عام 2014 مفاجئة، حيت تمكن “الحزب البديل لألمانيا” من الحصول على %7.1 من الأصوات وبعد عام فقط من تأسيسه[101]، تمكن الحزب كذلك من الفوز في2024 ضمن تحضيرات الانتخابات المفاجئة الأخيرة في ولاية “ثورينغيا” وأدى بشكل جيد أيضًا في ولايات أخرى شرق ألمانيا، وتم تدشين حملة من بعض التشريعيين حظر الحزب اليميني المتطرف بسبب اعتقاد اليساريين أن ذلك الحزب يهدد ديموقراطية ألمانيا، وتم أيضًا حظر ناشط يميني نمساوي من الدخول لألمانيا بسبب ترويجه لحملة نيو-نازية تدعو لترحيل المهاجرين.[102]
ساهمت أحزاب اليمين المتطرف بين عامي 2016 و2019 مثل الحزب الوطني الديموقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا في تفشي السلوك الإجرامي العنيف تجاه اللاجئين، استخدمت تلك الأحزاب خطابًا قوميًا متطرفًا وأبدت معارضة علنًا عن رفضها لسياسيات استقبال اللاجئين وتوطينهم، ساهم موقفهم على خلق بيئة معادية ومليئة بالكراهية تجاه اللاجئين، من الأمثلة على ذلك، أطلق سياسيون من الحزب الوطني الديموقراطي بتكرار تعليقات عنصرية ومعادية موجهة تجاه اللاجئين بينما صّور مسؤولو حزب البديل من أجل ألمانيا تدفق اللاجئين على أنه تهديد لهوية وتماسك الشعب الألماني، حذر الرئيس الإقليمي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية “براندنبورغ” بأن تدفق اللاجئين “يذيب” ألمانيا، ودعا ماركوس بريتزل، الرئيس الإقليمي لحزب البديل من أجل ألمانيا في شمال الراين “وستفاليا”، إلى شرعية استخدام ضباط حرس الحدود للأسلحة النارية لمنع اللاجئين من دخول ألمانيا، كما دعا حزب البديل من أجل ألمانيا إلى إغلاق الحدود لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ودعم بشكل أساسي سياسات الهجرة التقييدية.[103]
تُهيئ هذه التصريحات أجواء يُنظر فيها إلى اللاجئين كتهديدٍ أو أعداءٍ للمواطنين، مما قد يدفع البعض إلى اعتبار أسلوب حياتهم مُعرّضًا للخطر، والشعور بالحاجة إلى الوقوف في وجه هذا التهديد المُتصوّر، لذلك، فإنّ نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة على المستوى المحلي يحرض على العنف ضد اللاجئين وينشر الانقسام الاجتماعي.[104]
ج-موقف الأحزاب الحالي (2024):
تواجه ألمانيا منعطفًا وتوجه حاسمًا في سياسة اللجوء حيث يشير اتفاق الائتلاف المتفاوض عليه بين الأحزاب المحافظة، وهم الاتحاد الديموقراطي المسيحي التي رأسته المستشارة السابقة ميركل ، و الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديموقراطي، إلى تشديد جذري في قانون اللجوء وايضًا الى انحراف شديد عن المعايير الراسخة في مجال حقوق الإنسان، تتبني كذلك الحكومة الائتلافية سياسات تُضعِف تعزيز المبادئ الإنسانية، غيّر حزب المستشارة السابقة ميركل نهجه وتوجهاته خلال العقد الماضي بشأن قضايا اللاجئين، فثقافة “الترحيب باللاجئين” التي روجت لها ميركل خلال أزمة اللاجئين في عام 2015، استُبدلت منذ ذلك الوقت بموقف أكثر صرامة من جانب زعيم الحزب الحالي والمرشح لمنصب المستشار الفيدرالي فريدريك ميرتس.
المبحث الثاني
أبرز سياسات اللاجئين المتبعة في ألمانيا
واجهت ألمانيا تحديات في طريقة التعامل مع موجات اللجوء المتزايدة عندما ضربت أزمة اللاجئين أوروبا في عام 2015، ونفذت سياسات متغايرة بشكل ملحوظ مع سياسات الدول الأعضاء الأخرى. يعرض المبحث السياسات والبرامج المختلفة التي اتبعتها الحكومات الألمانية لتنظيم استقبال اللاجئين ودمجهم في المجتمع الألماني.
- سياسة الباب المفتوح
تُعد ألمانيا من الدول ذات تاريخ طويل في مجال استضافة اللاجئين الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي نتيجة تدفق العمال من جنوب أوروبا بسبب نقص يد العمالة لكن تزايدت أعدادهم مع أزمة اللاجئين في عام 2015 حيث دخل أكبر عدد من اللاجئين إلى ألمانيا، والذي قُدّر بنحو 1,139,000 لاجئ.[105]
انتهجت أنجيلا ميركل سياسات تُعرف باسم ” الباب المفتوح” أو “سياسة الترحيب” لاستضافة اللاجئين في ألمانيا مستخدمةً عبارتها الشهيرة “بإمكاننا فعل ذلك” عام 2015[106].يتمثل منطق المستشارة السابقة في أن قبول اللاجئين هو تفويض من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنظم حقوق اللاجئين، يعود تزايد عدد اللاجئين في ألمانيا إلى فتح نقاط الدخول من خلال السياسة الألمانية التي تبنتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وهي سياسة “الباب المفتوح” وغرضها تمكين اللاجئين من دخول الأراضي الألمانية دون المرور بلوائح الهجرة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، في بداية الأزمة فتحت ألمانيا حدودها أمام اللاجئين، متجاوزةً اتفاقية دبلن* للاتحاد الأوروبي وحصص توزيع اللاجئين، وأدى ذلك لدخول ما لا يقل عن 890 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا في غضون ثلاثة أشهر بعد تطبيق السياسة في أغسطس 2015 وطُبقت برامج اندماج شاملة حيث حصل اللاجئين الذين تقبلت الحكومة الألمانية طلبات لجوئهم، على العديد من المزايا، مثل توفير السكن المؤقت، والإعانات اليومية، وتصاريح العمل، بالإضافة إلى التدريب اللغوي المفيد، حتى يتمكنوا من التكيف مع الثقافة المحلية.[107]
ب– قانون الاندماج:
دخل ما سُمّي ب”قانون الاندماج” حيز التنفيذ في أغسطس 2022، بعد تطبيق سياسة “الباب المفتوح” التي سهّلت دخول طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة المؤقتة، قامت الحكومة الألمانية بطرح “قانون الاندماج” الذي نص على وجوب التزام اللاجئين المعترف بهم بمتطلبات الإقامة والمشاركة في دورات الاندماج للحصول على تصريح إقامة دائمة. وسّعت الحكومة الألمانية دورات الاندماج واللغة، مكّن القانون أيضًا طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة المؤقت من الحصول على إقامة آمنة طوال مدة التدريب المهني المؤهل (مثل التدريب المهني المعترف به من الدولة، والذي تبلغ مدته التدريبية العادية عامين). بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من طالبي اللجوء الانخراط في عمل مُجدٍ خلال عملية اللجوء، مثل المساعدة في تقديم وجبات الطعام في أماكن الإقامة. ولتحقيق هذه الغاية، أُطلق برنامج “تدابير إدماج اللاجئين” بقيمة 300 مليون يورو لتوفير 100,000 فرصة عمل غير ربحية في أغسطس 2016. ويسمح قانون الاندماج أيضًا تخفيض استحقاقات طالبي اللجوء في حال توقفهم عن فرص العمل أو دورات الاندماج أو رفضهم لها.[108]
لا يزال اللاجئون رغم ذلك يواجهون تحديات كبيرة في إيجاد فرص عمل والاندماج الكامل في سوق العمل. إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر هذه القوانين للعملية والتطبيق العملي الفعال، إذ ترفض بعض الولايات توظيف اللاجئين المؤهلين نظرًا لارتفاع معدل البطالة بين المواطنين الألمان. كما أن هناك نظامًا بيروقراطيًا طويل الأمد لتقييم مدى امتلاك اللاجئ لمؤهلات تؤهله لدخول سوق العمل.[109]
ج- تشديد قواعد اللجوء:
دخل التشديد لقانون اللجوء حيز التنفيذ منذ 2016 وسُمي ب “حزمة اللجوء الثانية” نتيجة عدة حوادث من ضمنها ليلة رأس السنة الجديدة 2015 في كولونيا حيث تم الاعتداء الجنسي على المئات من السيدات من قِبَل بعض اللاجئين مما اثار غضب الرأي العام وعزز التصور القائل بأن الوافدون الجدد واللاجئين يهددون قيم المجتمع الألماني، يشمل القانون إجراءات قاسية مثل إيواء اللاجئين في ثلاثة إلى خمس معسكرات اعتقال كبيرة -مراكز استقبال أو مراكز تسجيل- وفرض قيود صارمة على الإقامة. أما من لا يملكون “فرصة البقاء”، فسيتم احتجازهم ومراجعة طلباتهم في الموقع، عمليًا، يعني هذا رفض الطلب، ثم تنفيذ عمليات الترحيل “مباشرةً من مركز الاستقبال”. تُستكمل إجراءات اللجوء بالكامل في غضون أسبوع، إلى جانب ترحيل اللاجئين المرضى والمصابين بصدمات نفسية، إلا إذا أشارت إلى مرض يهدد الحياة عند تقديم طلب اللجوء. كما سيتم ترحيل الأطفال المرضى، مع أن ألمانيا وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1992 التي تحظر صراحةً هذا الإجراء.[110]
المبحث الثالث
تحديات الحكومة الألمانية في معالجة أزمة اللاجئين
تستقبل ألمانيا أعداد كبيرة من اللاجئين سنويًا، وكدولة مستقبلة للاجئين فهي بلا شك تواجه العديد من التحديات الناتجة عن تلك المعضلة، وهذا المبحث سيتناول التحديات المختلفة التي تواجه الحكومة الألمانية فيما يخص ملف اللاجئين، فنجد أن التحديات السياسية تنقسم لثلاث مستويات: المحلية، الإقليمية والعالمية، لكل منها تداعياتها الخاصة، كما بالطبع تواجه تحديات اقتصادية ناجمة عن تحمل
أعباء تلك الأعداد كونها أكثر مُستقِبل في قارتها بالإضافة إلى مشكلات اندماج اللاجئين في عجلة الإنتاج الألمانية، وختامًا يناقش المبحث دور الرأي العام بخصوص ملف اللاجئين وكيف استجابة له الحكومة الألمانية.
أولًا: التداعيات السياسية:
أ-محليًا:
تواجه الحكومات الألمانية تضارب ملحوظ، فبينما تدعو الحالة الديموغرافية المتسمة بالشيخوخة وانخفاض معدلات الإنجاب إلى دعم سياسة الانفتاح من ناحية؛ لمواجهة عجز العمالة في القطاعات المحورية لدى الاقتصاد الألماني، نجد أن سياسة الانفتاح تلك مهددة بسبب التحديات التي تواجه سياسات الاندماج، حيث تتزايد وتيرة رفض التعددية العرقية، بالإضافة إلى التشكك من زعزعة اللاجئين للأمن خاصةً بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر، يكمن التحدي في تطبيق سياسات اللجوء وتحصيل ثمارها المرجوة؛ إذ تواجه سياسة الاندماج عوائق مثل اتساع فارق العمالة وزيادة معدلات الفقر وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي المنتشر بين الأفراد ذوي أصول مهاجرة حتى وإن كانوا يحملون الجنسية الألمانية. علاوة على ذلك فإن ذوي اللاجئين الذين أتوا عن طريق برامج لم الشمل يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع والاقتصاد، فيترتب عليه عدم قدرتهم على العمل.[111]
تتجدد الشكوك الأمنية حول خطر وجود اللاجئين مع حدوث أي اعتداء إرهابي يقوم به أحد الجنسيات المماثلة لجنسيات اللاجئين، فمع وقوع حادثة ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا عام 2015، أُعيد للأذهان مرة أخرى خطورة اللاجئين بالنسبة للمواطنين الألمان، وهذا ما يُعاد إحياؤه كلما وقع حادث مشابه، وعلى إثره يُصعِب ذلك مهمة الحكومة المرتبطة بإرضاء مواطنيها مع محاولتها في إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني.[112]
يكمن التحدي الأكبر النابع عن ملف اللاجئين هو توجه الرأي العام، الذي يؤثر على السياسيين بشكل كبير خاصةً مع كون ألمانيا دولة ديموقراطية، فعلى السياسيين محاولة إرضاء مجموعة واسعة من الآراء إذا ما أرادوا البقاء في السلطة أو أن يتم انتخابهم.[113]
ب-إقليميًا:
لا تتوقف التحديات التي تواجه ألمانيا عند الجانب المحلي فقط، بل وتمتد إلى علاقاتها الخارجية؛ فعندما حدثت أزمة اللجوء في ذروتها عام 2015 كانت ألمانيا أكثر المتضررين، وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة والضغط حاولت بحث سبل التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي تارة ومع دول المحيط المتوسط المتمثلة في تركيا تارة، والمحاولتين كانت عقبتهما عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق[114]، فنجد عندما تزعمت ألمانيا اتفاقيات دبلن وأخرها دبلن الثالثة* التي تهدف لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي بشكل منطقي، رفضت دول أمثال الدنمارك وبولندا الالتزام بتلك الاتفاقية وأخذ أية لاجئين بينما رفضت النمسا استقبال المزيد وبقيت دول الشمال صامتة منذ البداية، والجدير بالذكر أن ألمانيا حاولت التملص من الاتفاقية الثالثة بشكل كامل إبان الأزمة السورية؛ وذلك بسبب تدفق أعداد كبيرة عند حدودها.
لم تلق سياسة الانفتاح لميركل الترحيب من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها بذلك اتخذت إجراءات معارضة للاتحاد الأوروبي، واقترحت ميركل نظام حصص إلزامية لتوزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحثّت على اتخاذ موقف أوروبي موحد. ورغم موافقة المفوضية الأوروبية على الخطة، طالب عدد من الدول الأوروبية بحلول سريعة وفورية؛ لأنها شعرت بالإرهاق من تدفق أعداد اللاجئين المتزايدة.[115]
حاولت ألمانيا وضع الخلافات والتوترات مع تركيا خلفها لأجل تحقيق منفعة متبادلة فيما يخص ذات الأزمة، قامت ألمانيا بعقد صفقة معها في مارس 2016 من شأنها تقليل تدفق اللاجئين القادمين من تركيا، وسُرعان ما أحُبطت تلك الصفقة بعد محاولة الانقلاب الشهيرة في يوليو 2016 والتي انتهت باستقالة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو الذي كان يقود المفاوضات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي وهو ما جعل العلاقات تعود لحالة التوتر من جديد.[116]
ج-دوليًا:
تحاول ألمانيا أن تصبح دولة عظمى ولاعب رئيسي في الساحة الدولية، فنظرًا لأنها تحمل وصمة تاريخية متمثلة في الماضي النازي، حاولت إعادة التسويق لنفسها عبر استغلال أزمة اللجوء لتظهر بمظهر تلك الدولة التي تساعد اللاجئين وضحايا الحروب عبر تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للاجئين وتميزها بنظم الرفاهة، ولكن تم تحدي تلك الصورة التي حاولت رسمها مع أخبار طرد لاجئين أفغان واستبدالهم بلاجئين أوكرانيين الهاربين من الحرب عام 2022،[117] فتُظهر تلك الحادثة مدى خروج عدد اللاجئين المتواجدين في ألمانيا عن طاقتها الاستيعابية، ووضعها تحت وطأة الاتهامات بالتفرقة بين اللاجئين حسب الأصل وعدم الامتثال بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.[118]
ثانيًا: التداعيات الاقتصادية:
رأت ألمانيا تدفق اللجوء كحل وفرصة بدلًا من كونها أزمة عندما أدركت أنه يمكنها الاستفادة من تلك العمالة الشابة لحل أزمة الشيخوخة التي تعاني منها، فعلى الرغم من تجهيزها لسياسات إدماج جيدة إلا أنها لم تخلو من المشاكل والتحديات؛ فنجد أن دورات التعليمية التي تخصصها لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية هي دورات غير فعالة أو ذات مستوى متقدم، ولا يمكن الاشتراك بها إلا في حالة حصول اللاجئ على الحماية الكاملة، إذ أنه شرط رئيسي للقبول بأية وظيفة، وذلك المستوى المتوسط قد لا يتناسب بالقدر الكافي مع العديد من الوظائف فبحسب الإطار الأوروبي المشترك، أن الفرد لا يُعتبر متقن للغة إلا عند وصوله للمستوى المتوسط المرتفع باللغة “B2” كأقل تقدير، بالإضافة لافتقار المعلمين الماهرين لتعليم اللغة فيؤدي ذلك إلى تعيين من هم أقل قدرة ومهارة ليصبح بذلك التدريب أقل جودة، كما يتم منح تلك الدورات على أساس تمييزي وبحسب حصحصة معينة.[119]
يُعد نظام التدريب المهني الألماني مشهور بكونه نظام يستهدف تنمية مهارات الفرد من الناحية العملية والتي تخدم فرص قبوله في سوق العمل، ويتلقى الكثير من الثناء لأجل ذلك، ولكن هذا النظام كان تمثيل الجيلين الأول والثاني به تمثيلًا ناقصًا*، فتكشف الدراسات أن عدد كبير من اللاجئ لا يحصلون على فرصة مقابلة للالتحاق بالنظام من ناحية، ومن الناحية الأخرى يصمم الكثير من أرباب العمل على عدم تعيين اللاجئين من الناحية الأخرى، والوظيفة داخله تساوي ثلاثة أعوام من التدريب بتقاضي قليل، فيترتب على ذلك أحيانًا أن بعض اللاجئين يتركون وظائفهم داخل النظام من أجل العمل بوظائف لا تحتاج لمهارات ليتمكن من كسب دخل أكبر سريعًا، وفقًا لتقارير برلمانية من ميونخ، فإن سبعون بالمائة من طالبي اللجوء يقومون بالانسحاب من النظام المزدوج بسبب توفير الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات رواتب أعلى كعاملي النفايات، وبالتالي يضر عجلة إنتاج دولة صناعية مثل ألمانيا.[120]
تتحمل ألمانيا كبقية أقرانها من الدول الكبرى عبء تحمل نفقة السلعة العامة -وهي الأمن- التي توفرها لبقية الدول على المستوى الإقليمي، من منطلق أن باستقبالها أعداد كبيرة من اللاجئين فهي تحمي نفسها وجيرانها من التعامل مع أزمة لاجئين محتملة، وتضطر الدول الكبرى مثل ألمانيا تأدية هذا الدور؛ إذ أن إهمالها لمثل تلك مشكلة يشكل تهديدًا أكبر عليها من البقية[121] فعليها التصدر لأجل حماية نفسها أولًا من المخاطر ومن ثم ينتفع البقية المحيطين بثمارها؛ هذا لإن لا يمكن منع أحد من الانتفاع بالمكاسب غير المادية، أي تظهر مشكلة الراكب المجاني بين الدول وبعضها، يزداد ذلك العبء مع تزايد صرامة سياسات الاستقبال واللجوء للدول المحيطة لألمانيا، ما يجعل اللاجئين يفضلون اللجوء لألمانيا وغيرها ممن هم أقل قيود وصرامة، فيؤدي ذلك إلى تنامي معضلة أخرى وهي زيادة الضغط على موارد ألمانيا؛ فمع زيادة استقبال اللاجئين يزداد عدد السكان، ويزداد معه الاستهلاك للموارد والعكس صحيح، فتتمتع الدول ذات القوانين الصارمة بمواردها بينما يزداد الحمل على الدولة المُستقبِلة. [122]
ثالثًا: دور الرأي العام تجاه الأزمة ومدى استجابة الحكومة الألمانية له:
يُمثل الرأي العام أحد أبرز دوائر اهتمام الحكومات خاصةً الدول الديموقراطية؛ إذ يرتبط تواجد الأشخاص والأحزاب في السلطة أو وصولهم إليها بتفضيلات الناخبين ومدى رضاهم واقتناعهم بها، فمن جانب ملف اللاجئين يلعب دور الرأي العام دورًا محوريًا فيه؛ فلفهم تكوين الرأي العام علينا الخوض في العوامل المؤثرة به ، ففي ألمانيا نجد أن تسليط الضوء على المشكلة ليس عامل مؤثر في تكوين الرأي العام تجاه قضية اللجوء، بل يتأثر بكيفية تصوير الإعلام للاجئين والمهاجرين، مثل إذا قام أحد اللاجئين بحادثة أطلق عليه الإعلام إرهابي، أما إذا فعلها مواطن أبيض يُطلق عليه لقب مريض نفسي. بالإضافة لا يكون ذلك التأثير بالمستوى ذاته في جميع انحاء الجمهورية، حيث يعتمد مدى التأثر بحسب المقاطعات، فيُلاحظ ازدياد التأثر في المقاطعات التي بها عدد قليل من اللاجئين، بينما يقل في المقاطعات التي تحتوي على عدد كبير من اللاجئين بطبيعة كون الناس هناك معتادون على التواجد والعمل معهم، إلى جانب ذلك، يتأثر الرأي العام مع الخلفية التعليمية؛ فبحسب دراسة نشرتها مجلة “European Sociological Review” التابعة لأوكسفورد عام 2018، أن كلما زاد المستوى التعليمي لدى المواطن الألماني كلما قل تأثره بما يدور في الإعلام حول تشويه صورة اللاجئين، حيث يصل مستوى التأثر إلى صفر عند ذوي التعليم العالي.[123]
يمكن أيضًا ملاحظة تأثير تفضيل حزب معين على رأي الفرد في قضية اللاجئين؛ فنجد أن من ينتمون للأحزاب الليبرالية مثل الحزب الأخضر يرون قدوم اللاجئين كمصدر للأفكار الجديدة والتنوع الثقافي، عكس ممن هم تابعين للأحزاب اليمينية مثل الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذين ينتابهم القلق حول اللاجئين حيث يرونهم سبب لزيادة معدل الجريمة في البلاد.[124]
لم تكن دومًا الأمور مستقرة ومرحبة باللاجئين طوال الوقت، ففي عام 2014، قبل الازمة الخاصة بعام 2015، كان الظهور الشهير لمجموعة “الأوروبيون الوطنيون ضد إسلامية الغرب” أو ما عُرف باسم “بيغيدا”، حيث بدأت تلك المجموعة من بين بضعة أصدقاء، ثم لاقوا بعض الدعم من آخرين يحملون ذات الفكر الذي يرفض انتشار المسلمين داخل أوطانهم، وعلى إثر ذلك قامت لتلك المجموعة مظاهرات في مقاطعة “درسدرن” في ألمانيا وأخذت في الانتشار في بقية المقاطعات وصولًا لأجزاء من أوروبا.[125]
وجاء رد الحكومة على تلك المظاهرات متمثلة فيما صرحت به المستشارة الألمانية ميركل فيما مفاده أن تلك المظاهرات والهتافات هي عنصرية وتعبر عن الكراهية، ورغم اعتراضها عليها إلا أن عند حظر السلطات للتجمعات بسبب وجود تهديدات بالموت لرئيس تلك المجموعة وهو ما عطل تلك المظاهرات، قابلته ميركل بما وصفته أنها “تشعر بالإحراج” لإن حتى ولو كانت ضد مثل تلك المظاهرات فالتعبير عن الرأي هو حق مكفول لا يجب منعه.[126]
استغلت الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل الحزب البديل الأزمة وما حدث من اعتداءات وحوادث إرهابية تسبب بها لاجئون لحشد تخوفات وقلق الرأي العام تجاه اللاجئين لصالحه ليس فقط داخل ألمانيا، بل امتد الأمر إلى البرلمان الأوروبي حيث حصل على سبعة مقاعد في انتخابات عام 2014 وخمسة عشر مقعد في 2024[127].
تواجد رغم ذلك صدى واسع لثقافة الترحيب والتي مرادها الاستعداد للانخراط في المجتمع المدني لمساعدة واستقبال أفواج اللاجئين المقبلة، وهو ما تم إثباته خلال استطلاع الرأي عام 2015 حيث وضح أن 69% من الناس رأوا أنه من حق اللاجئ أن يحتمي ببلدان أخرها منها ألمانيا، وهو ما لم يختلف عنه استطلاعات الأعوام من 2016 حتى 2018، بل وزادت تلك النسبة إلى 71% عام 2021، دعمت تلك الثقافة وقتها الحكومة المتمثلة في ميركل عبر سياسة الباب المفتوح.[128]
تزداد التداعيات بين المواطنين مع كل حادثة وجريمة يقوم بها أحد اللاجئين، ففي أغسطس 2024 قام أحد طالبي اللجوء السوريين بعملية طعن خلال احتفالية في “زولينغن”، ورغم أن تلك الحوادث نادرة الحدوث إلا أنها تجد ردود أفعال تفوق حجم الخطر الحقيقي، في حين أن أرقام جرائم اليمينيين المتطرفين تجاه اللاجئين شبه تضاعفت عام 2023 ولا تجد الريبة ذاتها، يُلاحظ أيضًا تزايد الأصوات الانتخابية للحزب البديل في انتخابات الولاية مع نجاح الهجمات الإرهابية بالرغم أن معظم الهجمات في الحقيقة تتم من خلال اليمين المتطرف، وذلك نتيجة لتركيز الإعلام على جرائم اللاجئين بقدر أكبر من اليمنيين، وخلاصة القول، أن الرأي العام في 2024 يساوره الريبة حول قضية اللجوء والاندماج وحول قدرة ألمانيا على تحمل المزيد خاصًة بعد استقبالها لأكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا.[129]
نستنتج مما سبق أن ألمانيا لا تزال تعاني من الانقسام بين مؤيدي استضافة اللاجئين ورافضيها في مجتمعها. فبينما يرى البعض أن استضافة اللاجئين كان له أثر سلبي على قيم المجتمع الألماني، يُشير آخرون إلى النتائج الإيجابية التي نتج عنها في الوقت الراهن، لا يملك أي طرف القدرة على تحديد نهج ألمانيا تجاه استضافة اللاجئين بشكل قطعي، على جانب آخر، تواجه ألمانيا أخطار سياسية تشمل تصاعد اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة إلى جانب تشتت الصف الداخلي الناتج عن مسألة اللاجئين فضلًا عن صعوبة تطبيق سياسات الإدماج بشكل كامل، أما على الصعيد الاقتصادي فتواجه ألمانيا مشكلات عدة منها مشكلات تتعلق بنظم تأهيل اللاجئين نفسها إلى جانب تضاعف العبء على الموارد الناتج عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، ويتأثر الألمان بخلفيتهم التعليمية وميولهم الحزبية عند استقبالهم للقضية.
سنحلل في الفصل التالي أبرز دلالات التشابه والاختلاف بين حالتي الدراسة، مستعينين بكل ما تم تناوله وعرضه سابقًا في هذا البحث.
الفصل الرابع
أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين:
المقارنة بين حالتي تركيا وألمانيا
تمهيد
سنتطرق في هذا الفصل إلى الجزء المقارن من الدراسة، حيث نتعمق في توضيح واستنتاج أوجه التشابه والاختلافي بين جمهوريتي تركيا وألمانيا الاتحادية في ضوء ما ذكرناه سلفًا في الفصول والمباحث السابقة، وعلى ذلك سوف نبدأ بتوضيح أبرز أوجه الاختلاف، ومن ثم نتناول أهم نقاط التشابه.
المبحث الأول
دلالات التشابه
نتناول في هذا المبحث أوجه التشابه التي تواجدت خلال شروعنا في هذه الدراسة وتمت ملاحظتها بين ألمانيا وتركيا، حيث سوف تكون نقاط المقارنة في هذا المبحث هي: الرأي العام وتأثيره خارج حدود الدولة، أبرز السياسات المتبعة لمعالجة أزمة اللاجئين ونختتم المبحث بنقطة التداعيات السياسية والاقتصادية.
أولًا: الرأي العام:
يُلاحظ تواجد تشابه بين ألمانيا وتركيا بخصوص الرأي العام في وجود الفكر القومي الرافض للتعددية الثقافية، فنجد ازدياد الدعم ليمين المتطرف في ألمانيا المعروف بأجندته القائمة على أن ألمانيا يجب أن تكون للألمان وتجلى ذلك في تمكنه من الفوز بولاية في “تورنيغيا” ألمانيا في انتخابات الولايات عام 2024، إلى جانب حدوث حركة بيغيدا الرافضة لتواجد المسلمين، يتضح الرفض ذاته أيضًا في تركيا في رفض المواطنين لفكر اللاجئين السوريين المحافظ بل ووصل الأمر لرفض السكن معهم في البناية ذاتها والاختلاط بهم، وظهر ذلك في خسارة حزب العدالة والتنمية المتسم بدعمه للاجئين في انتخابات 2019.
يتشابه البلدان كذلك في وصول تأثير الرأي العام لخارج حدود الدولتين، ففي ألمانيا وُجد تكوين “بيغيدا” صدى واسع في دول أخرى في أوروبا وحتى خارجها، كما تمكن الحزب اليميني المتطرف ألا وهو الحزب البديل لألمانيا من الفوز بمقاعد في البرلمان الأوروبي من بعد عام 2015 وحتى عام 2024، وفي تركيا نرى أن ضغط الرأي العام تجاه ترحيل اللاجئين الذي كان أحد أسباب فتح تركيا لحدودها وسماحها لمرور اللاجئين لأوروبا عبر أراضيها أدى إلى أزمة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي عام 2015.
ثانيًا: أبرز السياسات المتبعة لمعالجة الأزمة:
أ-التعليم:
وفرت الحكومة التركية فرصًا تعليمية للاجئين السوريين من خلال إنشاء مراكز تعليم مؤقتة تعتمد مناهج سورية، وسمحت ببناء مدارس سورية على أراضيها. كما قدمت دعمًا في شكل النقل لتشجيع الالتحاق بالتعليم، وكذلك وفرت ألمانيا فرصًا للتعليم من خلال دورات لغة تمهيدية للأطفال لمدة عام أو عامين قبل نقلهم للفصول العادية[130]، وأُطلقت برامج تدريب مهني للشباب لدعم تأهيلهم لسوق العمل شكلت سياسة التعليم في كل من تركيا وألمانيا تشابهًا ملحوظًا، حيث حرصت كلتاهما على توفير سبل التعليم للاجئين كوسيلة للدمج والاستقرار.
ب-الصحة
أنشأت الحكومة التركية شبكة من 178 مركزًا صحيًا للمهاجرين واللاجئين، وقدمت من خلالها خدمات صحية مجانية، بما في ذلك الرعاية النفسية، كما قامت بدمج الكوادر الطبية السورية ضمن النظام الصحي الوطني بعد تأهيلهم، في حين قدمت ألمانيا رعاية صحية أساسية وشاملة للاجئين، شملت الفحوصات الطبية والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية. وبعد حصول اللاجئين على الحماية الرسمية، تم تضمينهم في نظام التأمين الصحي الحكومي[131]، وبذلك تشكل السياسات الصحية في كلتا الدولتين تشابهًا واضحًا، حيث حرصتا على ضمان توفير الرعاية الطبية الأساسية والنفسية للاجئين بشكل منظم ومجاني.
ثالثًا: التداعيات السياسية والاقتصادية:
أ-السياسية
تتشابه الدولتان في المعاناة من ازدياد معدلات الإرهاب منذ قدوم اللاجئين، حيث إن تطبيق سياسة الباب المفتوح في الدولتين سمح بدخول لاجئين ذوي الأفكار الإرهابية المتطرفة.
تتشابهان كذلك في اللجوء إلى الدول المحيطة والاتحاد الأوروبي للإمدادات المالية وتتشابهان من حيث عدم التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ شروط الاتفاقيات مثلما حدث مع ألمانيا عندما رفضت الدول الأوروبية استقبال اللاجئين كما كان متفقًا عليه، ويشابه ذلك ما حدث مع تركيا عندما لم يحقق الاتحاد الأوروبي شرط انضمام تركيا للعضوية.
حاولت الدولتان استغلال أزمة اللاجئين لتحقيق مصالحهما السياسية، ففي ألمانيا كان الهدف هو أن تصبح قوة عظمى عن طريق استغلال الجانب الإنساني للأزمة مثلما فعل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في تركيا ليستغلوا مشاعر المواطنين سواء المؤيدين أو المعارضين بغرض حشد الأصوات الانتخابية.
ب-الاقتصادية:
استفادت الدولتان قليلًا من اللاجئين في تنشيط الاقتصاد، في ألمانيا كانت الدولة بحاجة للعمالة وفي تركيا قام العديد من اللاجئين إنشاء مشاريع وفرت فرص عمل لكل من اللاجئين والاتراك.[132] بالإضافة إلى الإمدادات والمساعدات المالية التي تقديمها للدولتين لمساعدتهم في تلبية احتياجات اللاجئين.
تحملت الدولتان عبء اقتصادي كبير، فإن أعداد اللاجئين رفعت من معدلات إنفاق الدول السنوية وشكلت ضغطا على الموارد الاقتصادية والاجتماعية مما أدى للارتفاع في تكلفة المعيشة وانخفاض معدلات الرخاء الاقتصادي.
المبحث الثاني
دلالات الاختلاف
يتناول المبحث تحليل جوانب الاختلاف بين حالتي الدراسة، وتلك المقارنة سوف تقوم على عدد من النقاط، ألا وهي: نوع النظام السياسي وأبرز المؤثرين في عملية صنع القرار، دور الدين والأيديولوجيا في تشكيل الصورة التي يستقبل بها الأفراد في كلتا البلدين ملف اللاجئين، دور الرأي العام ومدى استجابة الحكومة له، السياسات التي أقرتها كل دولة جراء التعامل مع الأزمة وأخيرًا التداعيات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الأزمة داخل كل من حالتي الدراسة.
أولًا: النظام السياسي:
أ-نوع النظام السياسي ودور أبرز المؤثرين به:
1.دور الأيديولوجية:
استندت ايديولوجية ألمانيا إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في قضية استقبال اللاجئين لإثبات تخليها عن الأيديولوجية المتطرفة التي اتبعتها سابقاً؛ حيث شهدت ألمانيا الحكم النازي الذي ادى إلى دمار شامل وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. بينما يظهر في تركيا دور الدين والأيدولوجية بتأثير الفكر الإسلامي، فيتم النظر إلى اللاجئين عادةً من منظور الأخوة في الدين أو الإسلام بشكل أخص.
2.السلطة التنفيذية:
تختلف الدولتين في تمركز السلطة التنفيذية حيث تعد مهام الرئيس الألماني في الأساس مهام تمثيلية ويُعد المستشار الاتحادي لاعبًا رئيسيًا ويُعتبر المحرك الحيوي للديناميكية الديمقراطية وذلك بسبب تحديده للخطوط العامة للسياسة الحكومية ويكون مسؤولاً عنها وتشمل هذه السلطة تحديد التوجهات السياسية وضع الإطار العام لعمل الحكومة الذي يقوم الوزراء الاتحاديون بعد ذلك بتنفيذه بينما الرئيس في تركيا هو المسؤول والمالك الوحيد للسلطة التنفيذية.[133]
3.السلطة التشريعية:
يمثل البرلمان الالماني (البوندستاغ) أعلى هيئة دستورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وينفرد بالحق التشريعي على المستوى الاتحادي لذلك هو الذي يقود التطورات السياسية والمجتمعية بينما يُعتبر موقف البرلمان التركي ضعيفًا أمام سلطة الرئيس، الذي أصبح له الحق في إصدار مراسيم رئاسية، وإعادة القوانين إلى البرلمان، ولا يحق للبرلمان اعتمادها إلا بالأغلبية المطلقة.
4.السلطة القضائية:
تُشكل المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا هيئة دستورية مستقلة ويُنتخب 16 قاضٍ بالتساوي من قِبل البوندستاغ والبوندسرات (المجلس الأعلى)، ولكن أصبح للرئيس التركي حق تعيين أعضاء من المحكمة الدستورية، مما أدى إلى زيادة نفوذ الرئيس ووصوله إلى السلطة القضائية.[134]
5.الأحزاب:
تلعب الأحزاب في ألمانيا دورًا محوريًا في الحياة السياسية وتُعدّ أحد مكونات النظام الديمقراطي الحر الأساسي المنصوص عليه في الدستور حيث يوفر القانون الأساسي ضمانات رسمية لمكانة الأحزاب داخل العملية السياسية، كذلك يتولى العديد من قادة الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية مناصب في الحكومة.
تسمح تركيا بحرية تكوين الأحزاب والانضمام إليها، لكن من الناحية العملية يُعتبر حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم والمهيمن في البلاد. أما الأحزاب المعارضة فلها تأثير ودور ضعيف.
ب-دور الرأي العام واستجابة الحكومة له:
يتأثر الرأي العام في ألمانيا بكيفية تصوير اللاجئين في الإعلام وليس تسليط الدور على المشكلة، فنرى استخدام عبارات صحفية مبالغ بها إزاء الحوادث نادرة الحدوث التي يرتكبها اللاجئون، عكس ما يحدث مع الحوادث التي تُرتكب تجاه اللاجئين فيصورها على أنها مجرد عمل فردي من قبل شخص غير متوازن عقليًا لا أكثر، يتأثر أيضًا الرأي العام بمستوى التعليم والانتماء الحزبي؛ إذ أن اختلاف كل منهما يؤثر على رؤية الفرد للقضية، بينما في تركيا، بسبب استحواذ الحكومة على وسائل الإعلام اضُطر المواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء أزمة اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي ورغبتهم في ترحيل اللاجئين إلى موطنهم، ويؤثر في الرأي العام المستوى الاقتصادي؛ حيث نرى رفض المواطنين غير الأغنياء الذين يعيشون بمنزل مُستأجَر غاضبين من اللاجئين؛ إذ أن الملاك يفضلون اللاجئين السوريين بسبب موافقتهم على دفع مبالغ أعلى للإيجار فيتم طرد المواطنين على إثر ذلك، كما أنهم يرون اللاجئين يستنزفون الخدمات الصحية المجانية فتزيد مشاعر الغضب تجاههم.
يُلاحظ رفض الأتراك للاجئين وانتشار مشاعر العداء ضدهم، وتزداد تلك المشاعر خاصةً مع تعاطف اللاجئين السوريين مع سياسات الرئيس أردوغان المحافظة والدينية التي في نظر المواطنين تكبت حريتهم، بل وأن رغم رفض الأتراك لتمنح اللاجئين الجنسية التركية استمر ذلك الأمر بحجة أن هؤلاء اللذين مُنِحوا الجنسية يستحقونها لمساهمتهم العلمية وما إلى ذلك للبلاد، ولكن رغم عدم مرونة الحكومة التركية مع الرأي العام في تركيا، إلا أنها لم تستطع فرض رغبتها في دمج اللاجئين وتسكينهم في المدن لرئيسية فاضطرت الحكومة إلى اتخاذ سياسة مختلفة تجعلهم يقيمون في مناطق أخرى، على الجانب الآخر، نجد أن في ألمانيا تنتشر ثقافة الترحيب فحتى عند بلوغ الأزمة في ذروتها عام 2015 كان يدعم الشعب سياسة الباب المفتوح التي تبنتها ميركل، وعندما حدثت حركة “بيغيدا” المعارضة لتواجد المسلمين في ألمانيا نجد سماح الحكومة للأفراد بالتعبير عن رأيهم في الشوارع حتى وإن كانت الحكومة معارضة لتلك الأفكار، بل واتسمت أيضًا بالتعاطف اتجاهها عندما حدث محاولة لإحباط تلك الحركة.
ثانيًا: أبرز السياسات المتبعة لمعالجة أزمة اللاجئين:
أ- سياسة الاندماج:
لم يحصل اللاجئون السوريون على الجنسية التركية بسهولة، إذ لم تعترف بهم الدولة كمواطنين رسميين، بل اعتبرتهم مقيمين مؤقتين تمهيدًا لترحيلهم لاحقًا، ومنعتهم من الاندماج الكامل في المجتمع التركي، بما في ذلك الحصول على الجنسية بشكل رسمي وواسع.[135]ويتجلى ذلك بوضوح في السياسات الحكومية التي لم تسعَ إلى إدماج السوريين، بل قيدت فرص وصولهم إلى سوق العمل الرسمي، من خلال قوانين تحد من مشاركتهم.
سعت ألمانيا إلى دمج اللاجئين بشكل منظم من خلال قانون الاندماج، والذي اشترط على اللاجئين المعترف بهم حضور دورات اللغة والاندماج للحصول على الإقامة الدائمة، كما أطلقت الحكومة برامج لتوفير فرص تدريب مهني ووظائف غير ربحية ومنحتهم أيضًا فرصًا للعمل دون تمييز مقصود.
ب-اختلاف الموقف من تعديل سياسة الباب المفتوح:
بدأت تركيا بسياسة الباب المفتوح بين عامي 2011 و2015، فاستقبلت اللاجئين السوريين وقدمت لهم الخدمات الأساسية دون قيود قانونية واضحة، بعد عام 2016، تحوّلت هذه السياسة تدريجيًا إلى سياسة الباب المغلق. تبنّت الحكومة خطاب “العودة الطوعية”، الذي يعكس رغبتها في تقليل أعداد اللاجئين وإعادتهم تدريجيًا إلى سوريا؛ بينما وضعت ألمانيا شروطًا قانونية أكثر تنظيمًا لاستقبال اللاجئين، لكنها لم تتجه نحو الإغلاق الكامل. ركّزت الدولة على تنظيم الإقامة من خلال دورات اللغة والاندماج، وربطت منح الإقامة الدائمة باستيفاء هذه الشروط، ما يدل على رغبتها في دمج اللاجئين داخل المجتمع، دون تبنّي خطاب العودة أو الطرد كما حدث في تركيا.
ثالثًا: التداعيات السياسية والاقتصادية:
أ-السياسية:
تختلف الدولتان في وضعهما عند قدوم اللاجئين، حيث ان تركيا لم تكن مستعدة لاستقبال هذه الأعداد فكان على الدولة أن تعيد صياغة بعض القوانين، وأن تضيف بعض المؤسسات الحكومية المختصة في شؤون اللاجئين، عكس الظروف في ألمانيا التي كانت مستعدة ولم تواجه نفس الصعوبات.
تتباين التداعيات المحلية بين تركيا وألمانيا، حيث استفادت ألمانيا من أعداد اللاجئين نظرًا للتركيب الديموغرافي للسكان، إذ أن الفئة العمرية للاجئين تنتمي للشباب بينما تعاني الدولة من زيادة معدلات الشيخوخة. أما بالنسبة لتركيا فإن اعداد اللاجئين شكلت أزمة من الناحية الديموغرافية بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب لدى اللاجئين.
تنفرد تركيا عن ألمانيا في توتر علاقاتها الدولية بسبب أزمة اللاجئين، خاصةً مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا في بعض الأحيان نتيجة لموقف تركيا من سوريا، بالإضافة إلى ظهور حركات انفصالية من الأكراد الذين حاولوا استغلال توتر الأوضاع بسبب أزمة اللاجئين لإنشاء دولة مستقلة. أما ألمانيا فتعاني من تشتت الصف داخل الحزب الواحد حول كيفية التعامل مع الأزمة.
ب-الاقتصادية:
تختلف الأوضاع الاقتصادية في نتائجها على المواطنين، حيث لم يعاني السكان الألمان في الحصول على فرص عمل؛ حيث أن الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف كانت صارمة وكان من الصعب على العديد من اللاجئين تحقيقها، بينما زادت معدلات البطالة بشكل كبير في تركيا نتيجة لتفضيل أصحاب الأعمال للاجئين لكونهم عمالة رخيصة
نستنتج من الفصل رجوح كفة الاختلافات عن كفة التشابهات، فنرى اختلاف الدولتين من حيث طغيان دور الرئيس في تركيا على الساحة السياسية مع محدودية أدوار اللاعبين الأخر، بينما تتزن الأمور بين المستشار والبرلمان في ألمانيا إلى جانب تواجد دور للمؤسسات غير الرسمية مثل جماعات المصالح، ويتسع الفارق إلى نقطة الرأي العام، فتتسم تركيا بمحدودية التعبير عن الرأي وأغلبية الفكر الرافض للاجئين، على عكس ألمانيا التي تتسم بحرية الرأي ودعم الحكومة له وتظل الأغلبية متقبلة للاجئين رغم تصاعد دعم اليمين المتطرف، ويعاني الاثنان تحديات مختلفة ناتجة عن الأزمة، إذ تعاني ألمانيا من تحملها تكلفة السلعة العامة والضغط على مواردها، بينما تعاني تركيا من التضخم وارتفاع معدلات البطالة من الناحية الاقتصادية، وتعاني ألمانيا من صعوبة جني ثمار سياسة الاندماج وتشتت الصف الداخلي للأحزاب كما حدث مع ميركل، ولا ينفي ذلك تلاقي الاثنين عند نقاط متشابهة إذ رغم كل تلك الاختلافات تشابها في حالات معينة في الرأي العام والتداعيات وأخيرًا السياسات المتبعة.
الخاتمة
استهدف البحث الكشف عن أثر طبيعة النظام السياسي على سياسات اللاجئين من المقارنة بين حالتي تركيا وألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى توضيح الفارق بين اللاجئ والمصطلحات المشابهة والإجابة عن مواقف الأحزاب المختلفة تجاه الأزمة والتداعيات السياسية والاقتصادية الناجمة عنها مع عرض الرأي العام تجاه الأزمة ودوره فيها مع التطرق لموقف الحكومة منه، وأخيرًا تحليل أبرز دلالات التشابه والاختلاف بينهم، فتنتهي الدراسة إلى تصنيف الأنظمة السياسية لفهم طبيعة العلاقة بين السلطات داخل الدولة، وقد تم تقسيم هذه الأنظمة إلى ثلاثة أنماط رئيسية: النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، والنظام شبه الرئاسي، حيث يختلف كل نمط في طريقة توزيع الصلاحيات. ففي حين يركّز النظام الرئاسي السلطة التنفيذية في يد الرئيس، يقوم النظام البرلماني على مبدأ التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما النظام شبه الرئاسي فيجمع بين خصائص كلٍّ من النظامين السابقين، ويظهر تأثير النظام السياسي على سياسات اللاجئين يظهر في تمتع النظام الرئاسي بسلطة أكبر للرئيس فيجعل تبني سياسات اللاجئين خاصة بميول الرئيس ورؤيته، فنرى الدعم الذي قدمه أردوغان للاجئين السوريين وفقًا لمصلحته فقط فنرى أن تداعيات الأزمة في الداخل مثل التضخم والبطالة وحتى الغضب العارم للعامة ضد تواجد اللاجئين السوريين إلى جانب معارضة الأحزاب مثل الشعب الجمهوري.
لم تدفع تركيا إلى فتح حدودها لتتخلص من عبء اللاجئين بل حدث ذلك عندما أراد أردوغان الضغط على الاتحاد الأوروبي في 2015 بعدما تم رفض تركيا من عضوية الاتحاد، وعندما كان الرأي العام في قمة غضبه تجاه مسألة إقامة اللاجئين في المدن الرئيسية قرر التراجع خطوات بسيطة فقط حتى لا تؤول الأمور إلى وضع كارثي من ناحية الغضب الشعبي، فنستنتج من ذلك أن النظام السلطوي الرئاسي مثل تركيا يتأثر بسياسات الرئيس وتباعًا تتشكل سياسات اللاجئين حسب ما يراه ويخدم سياساته الأعم، بينما في النظام البرلماني يبرز دور الرأي العام فيه؛ فالمواطنين من ينتخب البرلمان الذي تتكون منه الحكومة، خاصًة في الدول الديموقراطية حال ألمانيا حيث نجد استمرار سياسة الباب المفتوح بسبب دعم أغلبية كبيرة من المواطنين لها تحت ثقافة الترحيب، فمع تواجد تنافس للأحزاب المختلفة ما بين معارضة ومؤيدة لتواجد اللاجئين في ألمانيا تستمر ألمانيا في استقبال اللاجئين بسبب فوز الأحزاب التي لا تعارض وجود اللاجئين بشكل متطرف، فيتلخص تأثير النظام البرلماني الديموقراطي على سياسات اللاجئين في التفاعل بين مختلف اللاعبين المؤثرين في المجتمع مع بروز دور الرأي العام؛ فإذا كان الرأي العام متقبلًا للاجئين فازت الأحزاب التي تتبنى الرأي ذاته وتوافقت سياسات الحكومة مع ذلك ، وإذا ظهرت أعراض التوتر على الرأي العام فُيلاحظ دعم الأحزاب المعارضة للاجئين وتمكنها من إحراز تقدم في الانتخابات وتتبنى الحكومة سياسات ذات نبرة أقل ترحيبًا.
شهدت تركيا تطورًا أيديولوجيًا بدايةً من الكمالية التي تدعو إلى العلمانية مرورًا بنجم الدين أربكان الذي كان يسعى إلى إعادة ربط تركيا بالعالم الإسلامي، وانتهى بصعود حزب العدالة والتنمية الذي سعى تدريجيًا إلى تخفيف مظاهر العلمانية، وتمثل تحول نظامها السياسي عام 2017 من حيث الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو ما أدى إلى توسّع كبير في سلطات رئيس الجمهورية وأصبح بموجبه الفاعل السياسي الأقوى في النظام السياسي التركي متجاوزًا الدور التقليدي لرئيس الوزراء وتم إلغاء منصب رئيس الوزراء تمامًا، وعلى الرغم من استمرار وجود البرلمان إلا أن دوره أصبح مقتصرًا على التشريع والرقابة المحدودة،، ورغم تواجد أحزاب معارضة إلا أن تأثيرها يكاد يكون ملموسًا، حيث في الواقع العملي يملك الحزب الحاكم والتابع للرئيس أردوغان وهو حزب العدالة والتنمية اليد العليا في الحياة السياسية ويتبنى الحزب سياسة داعمة للاجئين، بينما يعارض حزبا الشعب الجمهوري والجيد وجود اللاجئين حيث يتبنى الأول موقف متطرف ويتبنى الأخير نبرة أكثر هدوءًا.
تواجه تركيا تحديات سياسية عديدة بسبب استقبالها للاجئين، تختلف هذه التداعيات على المستويات المختلفة للدولة فعلى المستوى المحلي تمثلت التداعيات في اضطرار الدولة لعمل تغييرات هيكلية وقانونية لتسهل تكيف اللاجئين في الدولة وانتشار ظاهرة الارهاب ومعدلات الجرائم بالإضافة إلى استغلال الأطراف المتنافسة لقضية اللاجئين لتحقيق مصالح سياسية مما أدي إلى استقطاب الفئات المختلفة من المواطنين سواء من المؤيدين أو المعارضين علي المستوي الاقليمي والدولي أدت الأزمة إلى توتر علاقات تركيا مع الدول الأخرى بسبب اختلاف موقف تركيا من الأحداث في سوريا وموقف الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية، وبالإضافة لذلك توترت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؛ بسبب استخدام الطرفين لقضية اللاجئين كوسيلة ضغط فقد بدأت تركيا باستغلال القضية للحصول على التمويلات الخارجية وفي المقابل اجبر الاتحاد الأوروبي تركيا على تبني سياسات أكثر صرامة مع اللاجئين ليتم النظر في اجراءات انضمام تركيا لعضوية الحزب.
تتمثل الأبعاد الاقتصادية لأزمة اللاجئين داخل تركيا في آثار مزدوجة، حيث أدّت الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين إلى ضغوط ملحوظة على الاقتصاد التركي، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة البطالة، وتحمّل الدولة لأعباء إنفاق كبيرة على الخدمات الأساسية. فقد تسبّب تركز اللاجئين في بعض المناطق بارتفاع أسعار الإيجارات والسلع، مما أثّر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين. كما أدّى دخولهم إلى سوق العمل غير الرسمي إلى منافسة غير متكافئة مع العمال الأتراك، خاصة في القطاعات الهشّة، أما علي صعيد الرأي العام فقد برزت وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن رفض وجود اللاجئين بسبب تهديدهم للحياة اليومية للمواطنين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وقد دفع هذا الرفض الحكومة انها تغير من سياساتها المتبعة وتعديل خطاباتها السياسية من الاندماج للتجانس والتأكيد علي أن هذه ظروف مؤقتة؛ وهذا بهدف إرضاء المواطنين، وأبرز ما يميز سياسات اللاجئين المتبعة في تركيا في انتقالها من سياسة الباب المفتوح التي اتسمت بالترحيب وتقديم الخدمات الأساسية كالإيواء، والتعليم، والصحة، إلى سياسة أكثر تشددًا تمثلت في تقييد الحركة، تقنين فرص العمل، والحد من الاندماج، مع التركيز على “العودة الطوعية” للاجئين. هذا التحول جاء نتيجة تغيرات داخلية مثل التحوّل في النظام السياسي وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع الدولة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه اللاجئين السوريين.
يرتكز النظام السياسي الألماني على أسس الديمقراطية البرلمانية الاتحادية إذ يرسّخ “القانون الأساسي” مبدأ الفصل الثلاثي للسلطات ويكفل استقلال القضاء ويضمن حقوق الإنسان للجميع سواء للمواطنين الألمان أو للاجئين، تلعب عدة جهات دورًا مهمًا في صنع القرار حيث يتشارك مجلسا البوندستاغ -اليد العليا- في سن التشريعات وانتخاب المستشار، فيما يوازنه البوندسرات بتمثيل مصالح الولايات في التشريع وأعمال الاتحاد ويعتبر التشارك نوع من أنواع المراقبة الدستورية للقوانين وحماية سيادة القانون. ويتولى المستشار والوزراء صياغة السياسة التنفيذية ضمن مبدأ التوجيه للسياسة العامة للدولة رغم تمتع كل وزير باستقلالية إدارية.
تباينت مواقف الأحزاب الألمانية حيال أزمة اللاجئين فبعد فتح الحدود وتبني سياسة الباب المفتوح وتجاوز قواعد دبلن عام 2015 بقيادة الاتحادَين الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي؛ حين سهّلت المستشارة ميركل دخول عدد كبير من اللاجئين خلال فترة قصيرة؛ انتقل التحالف نفسه تدريجيًّا إلى تشديد إجراءات طلبات اللجوء تحت ضغط الرأي العام حيث قامت الحكومة الألمانية بعكس سياسة “حزمة اللجوء الثانية” 2016 التي ركّزت استقبال المتقدمين وقامت بإنشاء مراكز لتسريع حسم طلبات اللجوء مع ترحيل الرافضين فورًا، بينما ظهر “البديل من أجل ألمانيا” برفض قاطع يطالب بإغلاق الحدود وحجب الحقوق الأساسية بحجة حماية الهوية القومية الألمانية، وبالرغم من الخلافات الحزبية قامت الحكومة بمحاولة إدماج اللاجئين عن طريق ربط منح الإقامة الدائمة بإتقان اللغة والمشاركة في دورات الاندماج والعمل اللامربحي وفق “قانون الاندماج” منذ أغسطس 2022 وكما نرى قد تبين التغير في السياسات من خلال تبني إطارات الضوابط الأمنية مع ضمان اندماج فعلي ومستدام للاجئين.
تواجه أـلمانيا العديد من التحديات الناتجة عن أزمة اللاجئين حيث تواجه من الناحية السياسية مشاكل تحصيل ثمار سياسات الاندماج والحوادث الإرهابية وتصاعد اليمين المتطرف محلياً، وتعاني من عدم التزام في مشاركة المسؤولية معها تجاه ذلك الملف إقليميا ويتم تحدي صورتها عالميًا؛ بسبب تفضيلاتها لجنسيات معينة عن الأخرى، وعلى الصعيد الاقتصادي تنغمس ألمانيا في تحمل تكلفة سلعة الأمن والحماية وحدها مع زيادة الضغط على مواردها، ويتعاظم دور الرأي العام في ألمانيا ويتسم بحرية التعبير عن الرأي بشكل كبير حتى وإن اختلف عن وجهة نظر الحكومة، ويتأثر الرأي العام بعوامل كالتعليم والانتماء الحزبي تجاه ملف اللاجئين، فنرى أن الطلاب الجامعيين لا يؤثر فيهم ما يدور في الإعلام من جرائم يبرزها للاجئين، ويميل الأفراد المنتمون للأحزاب الليبرالية للنظر للاجئين بصورة إيجابية بينما يفعل من يميلون للأحزاب اليمينية العكس، ورغم نجاح الحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف في استغلاله للأزمة والحوادث الترويعية فلحشد دعم مكنه من تحقيق تقدم خير مسبوق في الانتخابات ليس فقط محلًيا بل وحتى في البرلمان الأوروبي، إلا أنه يظل الجو العام والغالب تجاه اللاجئين متقبل له.
لم يمنع الاختلاف الجوهري بين الدولتين تلاقيهما عند نقاط تشابه متوافقة، فنرى اشتراك الدولتين في تواجد نغمة القومية إضافةً إلى وصول أثر الأزمة من خارج من حيث انتشار حركة بيغيدا وتأزم الاتحاد الأوروبي بسبب فتح تركيا للحدود، واتبعت الحالتين سياسات تهتم بأوضاع اللاجئين الصحية والتعليمية علاوةً على ازدياد الخوف من التداعيات الأمنية داخل البلدين، كما تم استغلال الأزمة من قبل الحملات الانتخابية داخل كل منهما، كما تأثر اقتصاد البلدين بشكل سلبي فتأثر الاقتصاد التركي بارتفاع التضخم والبطالة في حين يتأثر الاقتصاد الألماني بالضغط على الموارد، وختامًا تأثرت الحالتين بإرثهما الأيديولوجي.
كثُرت أوجه الاختلاف بين حالتي الدراسة وهو ما يعد طبيعيًا نسبةً لاختلاف الجوهري بين الدولتين من ناحية النظام السياسي والظروف الخاصة لكل منهما، فاختلف الاثنان في نوع النظام السياسي وانعكس ذلك في اختلاف دور المؤسسات الرسمية في التأثير في عملية صنع القرار إلى جانب اختلاف الأيديولوجيا فتتبنى ألمانيا الفكر العلماني الليبرالي بينما تتبنى تركيا وفقًا للنظام الحاكم الفكر الإسلامي الذي يريد خفض وتيرة الفكر العلماني، وجاء دور الرأي العام في الحالتين متباينًا؛ إذ اتسمت ألمانيا بمساحة واسعة للتعبير عن الرأي سواء بالمعارضة أو التأييد وكانت استجابة الحكومة متوازنة مع الرأي الأغلب وغير كابت للرأي المعارض، بينما اتصفت تركيا بمحدودية حرية التعبير عن الرأي مع تحكم الحكومة في الإعلام وعدم المرونة نسبيًا مع الرأي العام.
وتفاوتت تداعيات الأزمة على الاثنين فيُلاحظ تحمل ألمانيا مسؤولية أمن واستقرار القارة واستهلاك مواردها وعدم فعالية أنظمة دورات اللغات والتعليم المهني؛ إذ لا تُكسب اللاجئ المهارات المطلوبة لوظيفة جيد وتكون بمقابل مادي قليل، أما تركيا فتظهر التداعيات على اقتصادها من حيث ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وعلى الجانب السياسي تنفرد تركيا بمشكلة انفصال الأكراد بسبب انشغالها في قضية اللاجئين في حين تتأزم ألمانيا بسبب تشتيت الصف في الحزب الواحد وتصاعد اليمين المتطرف، ومن ناحية السياسات المتبعة ظلت ألمانيا تتبنى سياسة الباب المفتوح مع تشديد الإجراءات فيما بعد، في حين فرض تركيا لسياسة الباب المغلق.
ختاًما، يتوصل البحث إلى انعكاس النظام الرئاسي ذو صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية مثل تركيا كما يستنتج البحث على تشكل سياسيات اللاجئين؛ فتتبلور السياسات حسب توجه الرئيس ورؤيته مع ضعف دور أية لاعبين أخر في التأثير على تشكيل تلك السياسات فنرى أن تبني سياسة الباب المفتوح ومن ثم سياسية المغلق كان كلاهما طبقًا لرغبة الرئيس أردوغان، بينما يتضح في النظام البرلماني الديموقراطي كحال ألمانيا اتساع المساحة لتفاعل عدد أكبر من اللاعبين في تشكيل سياسات اللاجئين ولاسيما بروز دور الرأي العام فتأتي السياسات كنتيجة لذلك التفاعل، فيُلاحظ تفاعل الحكومة الألمانية وتعديل سياستها من الباب المفتوح لتشديد قواعد اللجوء أتت كنتيجة لتوتر الرأي العام وضغوط من جهات أخرى كأحزاب اليمين المتطرف والاتحاد الأوروبي.
قائمة المراجع:
أولًا: المراجع باللغة العربية:
أ-الوثائق الرسمية:
- اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، تقرير الاجتماع التاسع والعشرين، اللجنة الدائمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (2004).
ب-الكتب:
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مدﺧﻞ إلى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الدولية للاجئين: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص الذين هم موﺿﻊ اهتمام المفوﺿﻴﺔ (سويسرا: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،2005).
- إيمان دني، الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة (الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،2014).
- خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التّركية وتجارب الحركات الإسلاميّة العربيّة (فلسطين: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، 2008).
- رضا هلال، تركيا مِن أتاتورك إلى الأبكان (القاهرة: دار الشروق ،1999).
- [1] رنا عبد العزيز الخماش، النظام السياسي التركي في عمد حزب العدالة والتنمية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،2016).
- فراس محمد إلياس، تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدة، (عمّان: شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2016).
- محمد طه بدوي وآخرون، النظم السياسية والسياسات والعلاقات الخارجية الدولية (الإسكندرية: دار التعليم الجامعى،2013).
- محمد طه حسين الحسيني، النظم السياسية (النجف الأشرف: دار السلام القانونية،2023).
- محمد لطفي زكريا الشيمي، النظام البرلماني (القاهرة: الألوكة ،2013).
ج-الدوريات العلمية:
- أحمد النجم، النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع والتحديات: رؤية مستقبلية، مجلة العلوم السياسية، العدد 59، (2020).
- أحمد عبد الموجود، المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص، المجلة القانونية، العدد 2 (2021).
- أسامة أحمد العادلي، أحمد سيد حسين، هاجر محمد حسن عبدالغفور، تحولات النظام السياسي التركي تحت حكم “العدالة والتنمية“، مجلة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، المجلد 7، العدد14، (2022).
- أسامة علي خلف، موقع السلطة القضائية في النظم السياسية ودورها السياسي، قضايا سياسية، العدد 79، (2024).
- الوحدة المجتمعية، مواقف الأحزاب التركية المعارضة بعد تحرير سوريا، مركز الحوار السوري، (2025).
- دلاوهر عثمان وتارا عمر، التنظيم الدستوري لعاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية برلين، مجلة الدراسات السياسية والأمنية، العدد 2، (2023).
- رباب حسين إبراهيم مرسي، السياسة الخارجية التركية وتطورات الأزمة السورية، المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة أسيوط، العدد 78، (2023).
- سمير العبد الله ومحمد أغلو، ” مواقف الأحزاب التركية من السوريين المقيمين في تركيا”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، (2022).
- علي يشار صاريباي، لأحزاب السياسية والنظام السياسي وتركيا، مجلة الدراسات السياسية، العدد 6، (2017).
- عمار محمد على سليمان، تحليل دور الدستور الفرنسي في تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي الفرنسي، مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، العدد 3، (2023).
- غوكهان تونجل وسليمان اكيجى، الآثار السياسية للهجرة: تأثير المهاجرين السوريين في السياسة التركية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة (2019)، ترجمة على كمخ.
- كمال حسن علي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا، الجريدة الرسمية، العدد 20، (1982).
- هدير أحمد فؤاد أباظة، نشأة الأحزاب السياسية وتطورها في تركيا حزب العدالة والتنمية نموذجًا، مجلة الدراسات السياسية، العدد 32، (2025).
د-الرسائل العلمية:
- آمال عبدالرازق محمد النجدي، الأيديولوجيا في موت الأيديولوجيا: دراسة نقدية من خلال نماذج ممثلة (رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية،2015).
- خلات جمال حاجي، التعديلات الدستورية وأثرها على السياسة الخارجية التركية 2002-2020 (ماجستير: كلية العلوم الاقتصادية والادارية، جامعة الشرق الأدنى ،2021).
- عاهد فراونة، النظام السياسي الألماني (ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الازهر،2012).
ه-المواقع الإلكترونية:
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، شوهد في 25-4-2025، على الرابط http://hrlibrary.umn.edu/arab/b082.html .
- بكر القاسم، سوريون يواجهون ظروفا مزرية في “منطقة آمنة” تحتلها تركيا، Human Rights Watch، (2024)، تم الصفح في 27-4-2025، متاح على https://www.hrw.org/ar/news/2024/03/28/syrians-face-dire-conditions-turkish-occupied-safe-zone.
- زاهر البيك، جماعات الضغط في تركيا… دورها وتأثيرها في الانتخابات المحلية، العرب الجديد، 24 مارس 2024 – شوهد فى 26.4.2025، على الرابط https://search.app/1E4SEEVrCcbKvRnR8 .
- Kemal Kirişci and Gökçe Uysa, اللاجئون السوريون في تركيا بحاجة إلى قدرة وصول أفضل إلى الوظائف الرسمية, Brookings, (2019), accessed on 20-4-2025, available at https://shorturl.at/gxcjW.
Second: English References:
A-Official Documents:
- Basic Law “German Constitution”, Article 21, Section 1,2.
- François Crépeau, Regional study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants, Human Rights Council, United Nations General Assembly, Twenty-third session, (2013).
- Grand National Assembly of Turkey ،Constitution of the Republic of Turkey, (2019), p.69,79,83.
B-Books:
- Andrew I. Port, Never Again: Germans and Genocide After the Holocaust (London: The Belknap Press of Harvard University Press,2023).
- Anne Koch et. al, Integrating Refugees: Lessons from Germany since 2015–16: Background paper to the World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies, (Washington, DC: World Bank, 2023).
- Battal Yilmaz, The Presidential System in Turkey, (Switzerland: Springer, 2018).
- Eytan Mayars, International Immigration Policy: A Theoretical and Comparative Analysis (USA: Parglave Macmillan,2004)
- Francesco Siccardi, How Syria changes Turkey’s foreign policy, (Carnegie Endowment for International Peace, 2021).
- Hans Vorländer, Maik Herold, Steven Schäller, PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany, New Perspectives in German Political Studies (Switzerland: Palgrave Macmillan Cham,2018).
- IDEA, What Is a Constitution: Principles and Concepts, (Sweden: International IDEA, 2014).
- James C. Hatheway, The Rights of Refugees Under International Law (Cambridge: Cambridge University Press,2005).
- Ken Newton et al, Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World, (Cambridge: Cambridge University Press,2005).
- Souad Ahmadoun, Turkey’s policy toward Syrian refugees: domestic repercussions and the need for international support, (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, 2014).
- Tom Mannewitz and Wolfgang Rudzio, The Political System of Germany, (Germany: Springer,2023).
- Victoria Rieitg, Moving beyond crisis: Germany’s new approach to integrating refugees into the labor market (Washington DC: Migration Policy Institute, 2016).
- Wolfgang Bialas and Lothar Fritze, Nazi Ideology and Ethics, (UK: Cambridge Scholars Publishing,2013)
- Zeynep Sahin-Mencütek, Syrian Refugees in Turkey Between Reception and Integration, (Switzerland: Springer, 2023).
C- Periodicals:
- Ahmet İçduygu, and Doğuş Şimşek, Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies, Turkish Policy Quarterly, 15, No.3 (2016).
- Alessandro Indelicato al, A comparison of attitudes towards immigrants from the perspective of the political party vote, Heliyon, Vol.9, issue 3, (2023).
- Amandine Scherrer, Dublin Regulation on international protection, European Parliamentary Research Service, (2020).
- Annisa Nabilatul Khaira, Angela Merkel’s Perception and Open Door Policy during the 2015 European Refugee Crisis, Journal of International Relations, Vol. 18, No. 1 (2022).
- Baban, Feyzi, Suzan Ilcan, and Kim Rygiel, Syrian Refugees in Turkey: Pathways to Precarity, Differential Inclusion, and Negotiated Citizenship Rights, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.43, No.1, (2016).
- Bitte Hammargren, Syrians in Turkey – Cohabitation under increasing stress, Swedish association of local authorities and regions report, (2022).
- Branislav Stanicek “European Parliament briefing: Eu-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis” European parliamentary research service (2020).
- Cengiz Bahcekapili & Buket Cet, The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey, International Business Research, Vol. 8, No. 9, (2015).
- Christin Hess &Simon Green, Introduction: The Changing Politics and Policies of Migration in Germany,25, No.3, Routledge, (2016).
- Christian S. Czymara and Stephan Dochow, Mass Media and Concerns about Immigration in Germany in the 21st Century: Individual-Level Evidence over 15 Years, European Sociological Review, Vol.34 no.4, (2018).
- Crul M. et. al, How the different policies and school systems affect the inclusion of Syrian refugee children in Sweden, Germany, Greece, Lebanon and Turkey, Comparative Migration Studies, 7 (2019).
- Donald P. Kommers, German Constitutionalism: A Prolegomenon, German Law Journal, Vol.20, (2019).
- Eiko Thielemann, Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods: Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU, Journal of Common Market Studies, Vol.56 No.1, Jan 2018.
- Elif Çetin, the EU-Turkey relations under the shadow of the contested politics of migration, international journal of political studies8 (2022).
- Enayatullah Akbari and Najeebullah Mujadid, Immigration and Its Impact on Europe’s Societal Security: Examining the Rise of Far-Right Parties (2014-2024), Journal of Humanities and Social Sciences Studies, vol.6 no.9, (2024).
- Ezgi Irgil et al, Assessing the Domestic Political Impacts of Turkey’s Refugee Commodification, Journal of Ethnic and Migration Studies, No.16, (2024).
- Frank Decker The “Alternative for Germany”: Factors Behind its Emergence and Profile of a New Right-wing Populist Party, German Politics & Society, Vol.34, 2(119), summer (2016).
- Hanspeter Kriesi et al, Debordering and re-bordering in the refugee crisis: a case of ‘defensive integration, Journal of European Public Policy, vol. 28, no. 3, (2021).
- Hatice KOÇ, education of Syrian refugee children in turkey: policies, implementations, challenges and solutions, Research & Reviews in Social, Human and Administrative sciences, Vol. 2 (2021).
- Holloway, K. et. al, Public narratives and attitudes towards refugees and other migrants Germany country profile, ODI Country Study, Vol.2, (2021).
- Isiksal Huseyin et. al, The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market,International Journal of Operations Management 1, 1 (2020).
- Kalicharan Veera Singam, Assessing the Extreme Right in the West in 2024, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol.17, No.1, (2025).
- Kerem morgül et al, Attitudes toward Syrian refugees in Istanbul: partisanship, xenophobia, threat perceptions, and social contact, the social, economic, and political research foundation in Turkey, (2021).
- Kikhia S. et. al, Exploring how Syrian women manage their health after migration to Germany: results of a qualitative study, BMC Women’s Health, 21, (2021).
- Maysa Ayoub, International Migration in the Euro-Mediterranean Region, Cairo Papers in Social Science, Vol.35, No.2, (2019).
- Marcus Engler, Germany in the refugee crisis–background: reactions and challenges, Heinrich Böll Stiftung, (2016).
- Marie C. Hull, What Divides the First and Second Generations? Family Time of Arrival and Educational Outcomes for Immigrant Youth, IZA Institute of Labor Economics, (2022).
- Matthias Niedobitek, The German Bundesrat and Executive Federalism, Perspectives on Federalism, Vol.10, No.2, (2018).
- Mevlude Akbulut-Yuksel et al, the crime effect of refugees, national bureau of economic research working paper 30070, (2022).
- Patrik Bandúr, perceptions on Syrian refugees in Turkey Antakiyat Journal of Social and Theological Studies , Vol.3 (2020).
- Seda Gürkan ,Ramona Coman , The EU–Turkey deal in the 2015 refugee crisis: when intergovernmentalism cast a shadow on the EU’s normative power, centre d’étude de la vie politique and institute for European studies, issue 56 (2021).
- Sertif Demir and Muzaffer Ercan Yılmaz, An analysis of the impact of the Syrian crisis on Turkey’s politic-military, social and economic security, Gazi Akademik Bakış, 13 No.26 (2020).
- Semih Tumen, the case of Syrian refugees in Türkiye: Successes, challenges, and lessons learned, World Development Report,(2023).
- Suat kinikhoğlu, Syrian refugees in Turkey: changing attitudes and fortune, Stiftung Wissenschaft und Politik German institute for international and security affairs, 5 , (2020).
- Sude Akgündoğdu, Turkish backlash: how street interviews spread anti-Syrian refugee sentiment, the Washington institute for near east policy, issue No.31 (2023).
- Teresa Talo, “Public Attitudes to Immigration in Germany aftermath Migration Crisis”, Migration Policy, Vol.1, No.23, (2017).
- The populist right strengthened by terror acts: Germany pushed towards major changes, Mixed Migration Review 2024, (2024).
- Turning a Refugee Health Challenge into an Opportunity in Turkey: The Syrian Refugee Programme: Inaugural WHO Partners Forum Case Study, World Health Organization (WHO).
- Turkey’s refugee crisis: the politics of permanence, international crisis group, Europe report No.241 (2016).
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Submission for the Universal Periodic Review Germany, UPR 16th Session, (2013).
D- Academic Thesis:
- Anastasiia Kononova, Populist Far Right and Radical Movements: Analysing the AFD and Generation Identity’s Shared Narratives on remigration, (master’s degree: Central European University,2024).
- Anne Jeck, Post-Colognianism : How the Cologne Incident on New Year’s Eve Changed Germany’s Attitude Towards Male Muslim Migrants (master’s degree: Justus-Liebig University Giessen, 2017).
- Daher Joseph, Revolution and Counter-Revolution in Syria: origins and developments (PHD, Faculté des Sciences Sociales et politiques, Université de Lausanne, 2018).
- Emma Gutman, Germany as a “Melting Pot”? Conceptions of Otherness Over Time (bachelor’s degree: School of Arts, Brandeis University,2018).
- Erica Dunham, From the Young Turks to Kemalists: Links and Discontinuities (master’s degree: School of Global Affairs and Public Policy, AUC, 2017).
- Nourhan Mohamed, Integration Policy of Refugees: comparative study between Germany and Sweden (master’s degree: faculty of Economics and Political Science, Cairo University ,2023).
- Pelin Gul, Turkish civil society, public opinion, and the state in the syrian refugee crisis (master’s degree: School of Arts, San Francisco state university, 2020).
- Vladimir Sharapov, Refugee crises:Measurement and impact on selected European economies, (PHD: Adam Smith Business School College of Social Science, University of Glasgow, 2023).
E-Websites:
- Alan makovsky, Turkey’s refugee Dilemma, center for American progress, (2019), accessed on 26-4-2025, available at https://surl.li/ukdtpv.
- Alasdair Sandford, Merkel embarrassed by Dresden protest ban after threat to Pegida, Euronews, (2015), accessed on 21-4-2025, available at https://www.euronews.com/2015/01/19/merkel-embarrassed-by-dresden-protest-ban-after-threat-to-pegida.
- Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Policy Report 2015: Migration, Asylum and Integration in Germany,(2015), accessed on 22-4-2025,available at https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Politikberichte/emn-politikbericht-2015-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=8.
- German Bundestag, .Parliamentarianism in the Federal Republic of Germany, Bundestag Official Website, accessed on 23-4-2025, available at https://www.bundestag.de/en/parliament/history/parliamentarism/frg_parliamentarism-200324
- Inflation, consumer prices, Turkiye ,World Bank Group, accessed on 29-4-2025, available at https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2024&locations=TR&most_recent_year_desc=false&start=1960&view=chart.
- Mapping of Syrian Owned Enterprises in Turkey, United Nations Development Programme (UNDP), (2019), accessed on 5-5-2015, available at https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/syria_crisisresponse/mapping-of-syrian-owned-enterprises-in-turkey.html.
- Press and Information Office of the Federal Government, Acting in accordance with the constitution, Bundesregierung, accessed on 1-5-2025 , available on https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/acting-in-accordance-with-the-constitution-470512.
- Press and Information Office of the Federal Government, The election of the Federal Chancellor, Bundeskanzler, accessed on 30-4-2025 , available at, https://www.bundeskanzler.de/bk-en/chancellery/the-election-of-the-federal-chancellor.
- Press and Information Office of the Federal Government,Structure and Tasks, The Federal Government, accessed on 20-4-2025 , available at https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/structure-and-tasks-470508.
- Sooner Cagaptay and Oya Aktas, Cagatay Ozdemir, the impact of Syrian refugees on Turkey, the Washington institute for near east policy, (2016), accessed on (20/4/2025) available at https://surli.cc/ouvzfw.
- Stefanie Glinski, Germany Is Displacing Afghan Refugees to Make Way for Ukrainians, Foreign Policy, April 2022, accessed on 14-4-2025, available at https://foreignpolicy.com/2022/04/20/germany-refugee-policy-afghanistan-ukraine.
- unemployment total % of total labor force: national estimate, Türkiye, World Bank Group, accessed on 30-4-2025, available at https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=TR.
- voluntary, safe, dignified and orderly return, Republic of turkey ministry of interior presidency of migration, accessed on 26-4-2025, Available at https://en.goc.gov.tr/voluntary-safe-and-dignified-return.
[1] Vladimir Sharapov, Refugee crises: Measurement and impact on selected European economies, (PHD: Adam Smith Business School College of Social Science, University of Glasgow, 2023), p.6-8.
[2] Daher Joseph, Revolution and Counter-Revolution in Syria: origins and developments (PHD, Faculté des Sciences Sociales et politiques, Université de Lausanne, 2018), p.136.
[3] محمد طه بدوي وآخرون، النظم السياسية والسياسات والعلاقات الخارجية الدولية (الإسكندرية: دار التعليم الجامعى،2013) ص 191,192
[4] محمد طه حسين الحسيني، النظم السياسية (النجف الأشرف: دار السلام القانونية،2023)، ص.58,59,60
[5] محمد لطفي زكريا الشيمي، النظام البرلماني (القاهرة: الألوكة ،2013) ص2-3.
[6] محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 146,147.
[7] Ken Newton et al, Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World, (Cambridge: Cambridge University Press,2005) p65.
[8] عمار محمد على سليمان، تحليل دور الدستور الفرنسي في تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي الفرنسي، مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، العدد 3، (2023)، ص 2446- 2456.
[9] IDEA, What Is a Constitution: Principles and Concepts, (Sweden: International IDEA, 2014), P.1.
[10] آمال عبدالرازق محمد النجدي، الأيديولوجيا في موت الأيديولوجيا: دراسة نقدية من خلال نماذج ممثلة (ماجستير، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية،2015) ص1547-1548.
[11] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مدﺧﻞ إلى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الدول لللاجئين: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هم ﻣﻮﺿﻊ اهتمام اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ (سويسرا :المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،2005)،ص69-63.
[12] Vladimir Sharapov, Refugee crises: Measurement and impact on selected European economies, (PHD: Adam Smith Business School College of Social Science, University of Glasgow, 2023), p.6-8.
[14] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، شوهد في 25-4-2025، على الرابط http://hrlibrary.umn.edu/arab/b082.html .
[15] كمال حسن علي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا، الجريدة الرسمية، العدد 20، (1982)، ص1345.
[16] James C. Hatheway, The Rights of Refugees Under International Law (Cambridge: Cambridge University Press,2005) p.905.
[17] فيصل مبارك، ” الحماية الدولية للاجئين”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 43، (أكتوبر2023)، ص2083.
[18] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، مرجع سبق ذكره.
[19] كمال محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص1344.
[21] أحمد عبد الموجود، المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص، المجلة القانونية، العدد 2 (2021)، ص457.
[22] رنا عبد العزيز الخماش، النظام السياسي التركي في عمد حزب العدالة والتنمية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،2016) ص70.
[23] المرجع السابق، ص71.
[24] فراس محمد إلياس، تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدة، (عمّان: شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2016)، ص 41-43.
[25] إيمان دني، مرجع سبق ذكره، ص 93
[26] إيمان دني، مرجع سبق ذكره، ص93-94.
[27] أحمد النجم، النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع والتحديات: رؤية مستقبلية، مجلة العلوم السياسية، العدد 59، (2020)،
ص380-387.
[28] أسامة العادلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 717-718.
[29] خلات جمال حاجي، التعديلات الدستورية وأثرها على السياسة الخارجية التركية 2002-2020 (ماجستير: كلية العلوم الاقتصادية والادارية، جامعة الشرق الأدنى ،2021)، ص48.
[30] أسامة علي خلف، موقع السلطة القضائية في النظم السياسية ودورها السياسي، قضايا سياسية، العدد 79، (2024)، ص91-93
[31] علي يشار صاريباي، لأحزاب السياسية والنظام السياسي وتركيا، مجلة الدراسات السياسية، العدد 6، (2017)، ص42.
[32] هدير أحمد فؤاد أباظة، نشأة الأحزاب السياسية وتطورها في تركيا حزب العدالة والتنمية نموذجًا، مجلة الدراسات السياسية، العدد 32، (2025)، ص232.
[33] رباب حسين إبراهيم مرسي، “السياسة الخارجية التركية وتطورات الأزمة السورية”، المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة أسيوط، العدد 78
، (2023)، ص170.
[34] زاهر البيك، “جماعات الضغط في تركيا… دورها وتأثيرها في الانتخابات المحلية”، العرب الجديد، 24 مارس 2024 – شوهد فى 26.4.2025، على الرابط https://search.app/1E4SEEVrCcbKvRnR8 .
[35] Grand National Assembly of Turkey ،Constitution of the Republic of Turkey, (2019), p.69,79,83
[36] رضا هلال، تركيا مِن أتاتورك إلى الأْبكان (القاهرة: دار الشروق ،١٩٩٩)، ص 42-44.
[37] Erica Dunham, From the Young Turks to Kemalists: Links and Discontinuities (Master’s degree: School of Global Affairs and Public Policy, AUC, 2017) P. 35,36
[38] خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التّركية وتجارب الحركات الإسلاميّة العربيّة (فلسطين: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، 2008)، ص 13
[39] أسامة أحمد العادلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 690
[40] Ezgi Irgil et al, Assessing the Domestic Political Impacts of Turkey’s Refugee Commodification, Journal of Ethnic and Migration Studies, No.16, (2024), p. 6.
[41] سمير العبد الله ومحمد أغلو، ” مواقف الأحزاب التركية من السوريين المقيمين في تركيا”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، (2022)، ص15.
[42] Zeynep Sahin-Mencütek, Syrian Refugees in Turkey Between Reception and Integration, (Switzerland: Springer, 2023), p.52
[43] الوحدة المجتمعية، مواقف الأحزاب التركية المعارضة بعد تحرير سوريا، مركز الحوار السوري، (2025)، ص4.
[44] Souad Ahmadoun, Turkey’s policy toward Syrian refugees: domestic repercussions and the need for international support, (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit,2014), p.3.
[45] Hatice KOÇ, education of Syrian refugee children in turkey: policies, implementations, challenges and solutions, Research & Reviews in Social, Human and Administrative sciences, Vol. 2 (2021), p.27.
[46]Turning a Refugee Health Challenge into an Opportunity in Turkey: The Syrian Refugee Programme. Inaugural WHO Partners Forum Case Study, World Health Organization (WHO).
[47]voluntary, safe, dignified and orderly return, Republic of turkey ministry of interior presidency of migration, accessed on 26-4-2025, Available at https://en.goc.gov.tr/voluntary-safe-and-dignified-return
[48] بكر القاسم، سوريون يواجهون ظروفا مزرية في “منطقة آمنة” تحتلها تركيا، Human Rights Watch ، (2024)، تم الصفح في 27-4-2025، متاح على https://www.hrw.org/ar/news/2024/03/28/syrians-face-dire-conditions-turkish-occupied-safe-zone
[49] Bitte Hammargren, Syrians in Turkey – Cohabitation under increasing stress, Swedish association of local authorities and regions report, (2022) ,p.5.
[50]Ahmet İçduygu, and Doğuş Şimşek, Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies, Turkish Policy Quarterly 15, No. 3 (2016), p.59–62
[51] Kemal Kirişci and Gökçe Uysa, اللاجئون السوريون في تركيا بحاجة إلى قدرة وصول أفضل إلى الوظائف الرسمية, Brookings, (2019), accessed on 20-4-2025, available at https://shorturl.at/gxcjW .
[52] غوكهان تونجل، سليمان اكيجى ،الآثار السياسية للهجرة: تأثير المهاجرين السوريين في السياسة التركية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة (2019)، ترجمة على كمخ، ص 10-12
[53] Turkey’s refugee crisis: the politics of permanence, international crisis group, Europe report No.241 (2016) p.14.
[54] Mevlude Akbulut-Yuksel et al, the crime effect of refugees, national bureau of economic research working paper 30070, (2022) p.45
[55] Ezgi Irgil et. al, Op. Cit, p.3857-3860
[56] Sooner Cagaptay and Oya Aktas, Cagatay Ozdemir, the impact of Syrian refugees on Turkey, the Washington institute for near east policy, (2016), accessed on (20/4/2025) available at https://surli.cc/ouvzfw
[57] سمير العبدالله ، محمد طاهر أوغلو، مرجع سبق ذكره، ص15.
[58] International crisis group Op Cit p.18.
[59] Sertif Demir and Muzaffer Ercan Yılmaz , An analysis of the impact of the Syrian crisis on Turkey’s politic-military , social and economic security, Gazi Akademik Bakış, Vol.13 No.26 (2020) p.9.
[60] غوكهان تونجل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 18.
[61] Francesco Siccardi, How Syria changes Turkey’s foreign policy, (Carnegie Endowment for International Peace, 2021) p.18.
* توفى المئات من اللاجئين خلال محاولتهم للهروب عن طريق بحر إيجة والذهاب لليونان وإيطاليا؛ مما دفع الاتحاد الأوروبي للتدخل لوقف الخسائر البشرية وخاصةً مع عدم استعداد الدولتين لاستقبال هذه الأعداد من اللاجئين لذا تم اقتراح أجندة جديدة لمناقشة شؤون الهجرة و وقف تدفق اللاجئين (انظر في: Seda Gürkan ,Ramona Coman , The EU–Turkey deal in the 2015 refugee crisis: when intergovernmentalism cast a shadow on the EU’s normative power, centre d’étude de la vie politique and institute for European studies issue No.56 (2021) p.278).
[62] Elif Çetin, the EU-Turkey relations under the shadow of the contested politics of migration, international journal of political studies Vol.8 (2022) p.60.
[63] Branislav Stanicek “European Parliament briefing: Eu-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis” European parliamentary research service (2020) p1-2.
[64] Sertif Demir , Muzaffer Ercan Yılmaz Op. Cit p.15
[65] Branislav Stanicek Op. Cit p.3
[66] Cengiz Bahcekapili & Buket Cet, The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey, International Business Research, Vol. 8, No. 9, (2015),p.5-7
[67] Inflation, consumer prices , Turkiye ,World Bank Group, accessed on 29-4-2025, available at https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2024&locations=TR&most_recent_year_desc=false&start=1960&view=chart .
[68] Isiksal Huseyin, Isiksal Aliya Zhakanova, and Apeji Yossi, The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market, International Journal of Operations Management 1, no.1 (2020), p. 27-34.
[69] ,unemployment total % of total labor force: national estimate, Türkiye، World Bank Group, accessed on 30-4-2025, available at https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=TR
[70] Semih Tumen, the case of Syrian refugees in Türkiye: Successes, challenges, and lessons learned, World Development Report,(2023), p.7.
[71] Sude Akgündoğdu, Turkish backlash: how street interviews spread anti-Syrian refugee sentiment, the Washington institute for near east policy, issue N.31 (2023) p.4.
[72] غوكهان تونجل ، مرجع سبق ذكره، ص 9-10
[73] Patrik Bandúr “perceptions on Syrian refugees in Turkey” Antakiyat Journal of Social and Theological Studies , Vol.3 (2020) p.70
[74] Suat kinikhoğlu, Syrian refugees in Turkey: changing attitudes and fortune, Stiftung Wissenschaft und Politik German institute for international and security affairs, No.5 (February 2020) p.2.
[75] Kerem morgül et al, Attitudes toward Syrian refugees in Istanbul: partisanship, xenophobia, threat perceptions, and social contact, the social, economic, and political research foundation in Turkey, (2021), P 34-35.
[76] Pelin Gul, Turkish civil society, public opinion, and the state in the syrian refugee crisis (Master’s degree: School of Arts, San Francisco state university, 2020) p.44.
[77] Kerem morgül, Op. Cit, p. 40-42
[78] Alan makovsky , Turkey’s refugee Dilemma, center for American progress (2019), accessed on 26-4-2025, available at https://surl.li/ukdtpv .
[79] Suat Kınıklıoğlu, Op. Cit, p. 3.
[80] Donald P. Kommers, German Constitutionalism:A Prolegomenon,German Law Journal, Vol.20, (2019), p.534-539.
[81] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Submission for the Universal Periodic Review – Germany , UPR 16th Session, (2013), p.2.
[82] Wolfgang Bialas and Lothar Fritze, Nazi Ideology and Ethics, (UK: Cambridge Scholars Publishing,2013), p.16,17
[83] Emma Gutman, Germany as a “Melting Pot”? Conceptions of Otherness Over Time (Bachelor’s degree: School of Arts, Brandeis University,2018) p.33.
[84] Basic Law “German Constitution”, Article 21, Section 1,2
[85] Andrew I. Port , Never Again: Germans and Genocide After the Holocaust (London: The Belknap Press of Harvard University Press,2023),p,2-3
[86] عاهد فراونة، النظام السياسي الألماني (ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الازهر، غزة،2012 )، ص18.
[87] Press and Information Office of the Federal Government, The election of the Federal Chancellor, Bundeskanzler, accessed on 30-4-2025 , available at, https://www.bundeskanzler.de/bk-en/chancellery/the-election-of-the-federal-chancellor.
[88] Press and Information Office of the Federal Government, Acting in accordance with the constitution, Bundesregierung, accessed on 1-5-2025 , available on https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/acting-in-accordance-with-the-constitution-470512
[89] Press and Information Office of the Federal Government,Structure and Tasks, The Federal Government, accessed on 20-4-2025 , available at, https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/structure-and-tasks-470508
[90] Florian Grotz, and Wolfgang Schroeder, The Political System of Germany: New Perspectives in German Political Studies, (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2023), p.312,329
[91] German Bundestag, “Parliamentarianism in the Federal Republic of Germany,” Bundestag Official Website, accessed on 23-4-2025, available at, https://www.bundestag.de/en/parliament/history/parliamentarism/frg_parliamentarism-200324.
[92] Florian Grotz and Wolfgang Schroeder, Op.Cit,p.409
[93]Matthias Niedobitek, The German Bundesrat and Executive Federalism, Perspectives on Federalism, Vol.10, No.2, (2018), p.202.
[94] دلاوهر عثمان وتارا عمر،”التنظيم الدستوري لعاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية برلين”، مجلة الدراسات السياسية والأمنية، العدد الثاني، (2023)، ص52.
[95] Tom Mannewitz and Wolfgang Rudzio, The Political System of Germany, (Germany: Springer,2023), p.283-287.
[96] Maysa Ayoub, “International Migration in the Euro-Mediterranean Region”, Cairo Papers in Social Science,Vol.35,No.2,(2019),p.118
[97] François Crépeau, Regional study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants, Human Rights Council, United Nations General Assembly, Twenty-third session, (2013).
[98] Annisa Nabilatul Khaira, Angela Merkel’s Perception and Open Door Policy during the 2015 European Refugee Crisis, Journal of International Relations, Vol. 18, No. 1 (2022), p.2-5.
1 Annisa Nabilatul Khaira, Op.Cit, .p.6-7
[100] Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), “Policy Report 2015: Migration, Asylum and Integration in Germany,” accessed on 22-4-2025, available at: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Politikberichte/emn-politikbericht-2015-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=8
[101] Frank Decker The “Alternative for Germany”: Factors Behind its Emergence and Profile of a New Right-wing Populist Party, German Politics & Society, Vol.34, 2(119), summer (2016), pp.2.
[102] Kalicharan Veera Singam, Assessing the Extreme Right in the West in 2024, Counter Terrorist Trends and Analyses, vol.17, no.1, (2025), p.118-127.
[103] Anastasiia Kononova, Populist Far Right and Radical Movements: Analysing the Afd and Generation Identity’s Shared Narratives on remigration, (master’s degree: Central European University,2024), p.35-36
[104] Nourhan Mohamed, Integration Policy of Refugees: comparative study between Germany and Sweden (master’s degree: faculty of Economics and Political Science , Cairo University ,2023), p .132
[105] Ibid, p.5
[106] Anne Koch et al, Integrating Refugees: Lessons from Germany since 2015–16, Background paper to the World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: World Bank(2023),p.6
* *اتفاقيات دبلن: هي اتفاقيات حددت الإجراءات المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه تنظيم إجراءات اللجوء بين الدول الأعضاء، حيث تكون أول دولة يسجل بها لاجئ ما هي المسؤولة عن النظر في ملفه حتى يتم منع تجول اللاجئين وتسجيلهم في أكثر من دولة، دخلت أول اتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، وتجددت عام 2003، وأخيرًا عام 2013. (انظر في:Amandine Scherrer, Dublin Regulation on international protection, European Parliamentary Research Service, 2020.)
[107] Teresa Talo, “Public Attitudes to Immigration in Germany aftermath Migration Crisis”, Migration Policy,Vol.1, No.23,(2017),p.2.
[108] Ibid,p.26
[109] Holloway, K., Mosel, I., Smart, C. et al, “Public narratives and attitudes towards refugees and other migrants Germany country profile”, ODI Country Study, Vol.2,(2021),p.4-11
[110]Anne Jeck , Post-Colognianism :How the Cologne Incident on New Year’s Eve Changed Germany’s Attitude Towards Male Muslim Migrants (Master’s Degree: Justus-Liebig University Giessen, 2017),p.1
[111] Christin Hess &Simon Green, Introduction: The Changing Politics and Policies of Migration in Germany, Vol.25, No.3, Routledge, (2016), pp.267-8.
[112] Şeyma Akın, Op. Cit, p83.
[113] Christin Hess &Simon Green, Op. Cit, pp.267-8.
[114] Marcus Engler, Germany in the refugee crisis–background: reactions and challenges, Heinrich Böll Stiftung, (2016), P.1.
[115] Nourhan Mohamed, Op.Cit , p.131
[116] Şeyma Akın, Op. Cit, pp86.
[117]Stefanie Glinski, Germany Is Displacing Afghan Refugees to Make Way for Ukrainians, Foreign Policy, April 2022, accessed on 14-4-2025, available at https://foreignpolicy.com/2022/04/20/germany-refugee-policy-afghanistan-ukraine .
[118] Şeyma Akın, Op. Cit, pp.98.
[119] Victoria Rieitg, Moving beyond crisis: Germany’s new approach to integrating refugees into the labor market (Washington DC: Migration Policy Institute, 2016), pp5.
* الجيل الأول: هو الجيل ذو خلفية مهاجرة مباشرة ولديهم أي جنسية أخرى غير الألمانية، أما الجيل الثاني: أولئك الذين لديهم خلفية مهاجرة غير مباشرة أي الذين ولدوا بألمانيا لوالدين غير ألمانيين أو أحداهما، والجيل الثالث هو الجيل الذي ولد بألمانيا لأبوين ولدوا بألمانيا أيضًا. (انظر في: Marie C. Hull, What Divides the First and Second Generations? Family Time of Arrival and Educational Outcomes for Immigrant Youth, IZA Institute of Labor Economics, (2022), p.2.)
[120] Victoria Rieitg, Op. Cit, pp.6-7.
[121] Hanspeter Kriesi et al, Debordering and re-bordering in the refugee crisis: a case of ‘defensive integration, Journal of European Public Policy, vol. 28, no. 3, (2021), p336.
[122] Eiko Thielemann, Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods: Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU, Journal of Common Market Studies, Vol.56 No.1, Jan 2018, pp.69-71.
[123] Christian S. Czymara and Stephan Dochow, Mass Media and Concerns about Immigration in Germany in the 21st Century: Individual-Level Evidence over 15 Years, European Sociological Review, Vol.34 no.4, (2018), pp.383-392
[124] Alessandro Indelicato et. al, A comparison of attitudes towards immigrants from the perspective of the political party vote, Heliyon, vol.9, issue 3, (2023), p.6
[125]Hans Vorländer, Maik Herold, Steven Schäller, PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany, New Perspectives in German Political Studies, (Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, 2018), pp.1-2.
[126] Alasdair Sandford, Merkel embarrassed by Dresden protest ban after threat to Pegida, Euronews, 19-1-2015, accessed on 21-4-2025, available at https://www.euronews.com/2015/01/19/merkel-embarrassed-by-dresden-protest-ban-after-threat-to-pegida.
[127] Enayatullah Akbari and Najeebullah Mujadid, Immigration and Its Impact on Europe’s Societal Security: Examining the Rise of Far-Right Parties (2014-2024), Journal of Humanities and Social Sciences Studies, vol.6 no.9, (2024), pp.48.
[128] Kerrie Holloway et al, Op. Cit , pp.7-10.
[129] The populist right strengthened by terror acts: Germany pushed towards major changes, Mixed Migration Review 2024, (2024), p179-180.
[130] M. Crul et. al, How the different policies and school systems affect the inclusion of Syrian refugee children in Sweden, Germany, Greece, Lebanon and Turkey, Comparative Migration Studies, Vol. 7 (2019), p.6.
[131] Kikhia, S. et al. Exploring how Syrian women manage their health after migration to Germany: results of a qualitative study, BMC Women’s Health, Vol.21, (2021), p.3.
[132] Mapping of Syrian Owned Enterprises in Turkey, United Nations Development Programme (UNDP),(2019), accessed on 5-5-2015, available at. https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/syria_crisisresponse/mapping-of-syrian-owned-enterprises-in-turkey.html
[133] Battal Yilmaz, The Presidential System in Turkey, (Switzerland: Springer, 2018) P.36,37,38
[134] Battal Yilmaz ,Ibid, p.38
[135] Baban, Feyzi, Suzan Ilcan, and Kim Rygiel, Syrian Refugees in Turkey: Pathways to Precarity, Differential Inclusion, and Negotiated Citizenship Rights, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.43, No.1, (2016), p. 41