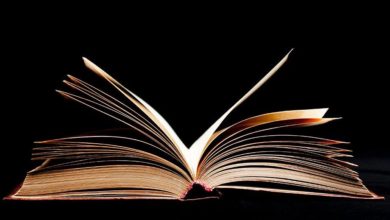دور الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية في عملية صنع القرار الخارجي دراسة لحالتي : بوتين وترامب

إعداد : ريهام أحمد أبوعيد , شريفة عصام حلاوة , ليلى محمد فتحي , مريم عصام محمد , نانيس أيمن أبوالنصر – إشراف : أ.د عادل عنتر – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
ملخص:
يركز هذا البحث على تحليل تأثير الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية على عملية صنع القرار الخارجي، وذلك من خلال دراسة حالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يسعى البحث إلى فهم كيفية مساهمة السمات السيكولوجية والشخصية للقادة في تشكيل مواقفهم واتخاذ قراراتهم الخارجية. يعرض هذا البحث سمات شخصيّتي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين مستنداً إلى نماذج ومعايير سيكولوجية مختلفة، كما يوضح ويحلل دور تلك السمات في تشكيل سياستهما الخارجية، كما يتناول البحث انعكاسات هذه السمات على طبيعة العلاقات الأمريكية الروسية، وعلى العلاقات الدولية بشكلٍ عام. واعتمد البحث لتحقيق أهدافه على المنهج الاستقرائي، مع توظيف مدخل صنع القرار والمدخل السيكولوجي لتحليل الحالتين المختارتين والقرارات الخارجية الأمريكية والروسية. وتمت هيكلة الدراسة على النحو التالي: مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة تستعرض أهم نتائج البحث.
Abstract
This research explores the role of the psychological characteristics of political leaders in foreign policy decision-making, using Russian President Vladimir Putin and American President Donald Trump as case studies. The research aims to examine how psychological attributes shape leaders’ decisions and approaches in the realm of foreign policy and international relations. It explores the psychological attributes of Donald Trump and Vladimir Putin using various psychological models and scales while analyzing the role of these attributes in the formulation of their foreign policies. It also considers the broader implications of these traits on American Russian relations, and international relations on a broader scale. In order for this research to fulfill its objectives, it adopts an inductive approach, incorporating the decision-making framework to analyze both case studies, as well as Russian and American foreign decisions. The structure of the study is organized as follows: an introduction, three chapters, and a conclusion that showcases the findings of the research.
مقدمة :
يُنظر عادةً إلى صنع القرار السياسي على أنه عملية نظامية عقلانية، تقوم على قواعد وخطوات منظمة أشبه بالعمليات المبرمجة. ولكن يكشِف الواقع السياسي أن عملية صنع القرار تُعد من أكثر العمليات السياسية تعقيداً، نظرًا لتداخل عوامل متعددة فيها، بعضها ينبع من طبيعة النظام السياسي وهيكله، وبعضها الآخر يرتبط بمتغيرات خارجية، كالصراعات، وتغيرات الرأي العام، والتقلبات الاقتصادية، والتفاعلات الدولية. وكما هو الحال في أي نشاط إنساني، يبقى العامل البشري – ممثلاً في القيادة السياسية بما تحمله من أفكار ومعتقدات وتحيزات وطباع – هو العنصر الأكثر تأثيراً، بل والأخطر، في تشكيل القرار السياسي.
يشهد التاريخ بأن العوامل النفسية والشخصية للقيادة السياسية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل العديد من القرارات، فقد قُتل ملايين بسبب تعصبات هتلر، فيما نجا ملايين آخرون بفضل حَذَر كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية، وتبدّلت مصائر دول بأكملها نتيجة تغير قيادتها. وعلى الرغم من تطور وانتشار الأساليب العلمية في مجالات السياسة والعلاقات الدولية، لا تزال شخصية القائد تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في التحليل السياسي. ومع ذلك، كثيرًا ما يتم تجاهل هذا البُعد في الدراسات السياسية المعاصرة، نظرًا لتعقيده وابتعاده عن معيار “العقلانية” الذي تُبنى عليه معظم النظريات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
يأتي هذا البحث –إلى جانب أدبيات أخرى– كمحاولة لفهم كيفية تأثير العوامل النفسية للقيادة السياسية على عملية صنع القرار الخارجي، من خلال دراسة نموذجين معاصرين يُعدّان من أبرز الشخصيات في ميدان العلاقات الدولية، وهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- Donald Trump والرئيس الروسي فلاديمير بوتين-Vladimir Putin. فعلى الرغم من الفروقات الجوهرية التي تفصل بينهما سواء من حيث التوجهات السياسية أو أساليب القيادة، إلا أن كليهما يشتركان في سمة محورية، وهي أن قراراتهما في السياسة الخارجية ومنهجيتهما في اتخاذ القرار كثيرًا ما تعكس سمات شخصيتيهما. كما أن هذه السمات تنعكس بشكلٍ واضح على أسلوب تفاعل دولتيهما في الساحة الدولية، وعلى صورة كل من الولايات المتحدة وروسيا في العالم.
يُمثّل دونالد ترامب حالة استثنائية في السياسة الأمريكية المعاصرة، إذ تتسم سياسته الخارجية بطابع فرداني وصدامي، تتجلّي في قراراته المتعلقة بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية، كاتفاقية باريس للمناخ. واعتبر العديد من المحللين أن هذه القرارات لم تكن انعكاسًا مباشرًا للدولة بقدر ما كانت تعبيرًا عن رؤية شخصية متشككة في جدوى النسق الدولي القائم.
أما فلاديمير بوتين، فقد تميز بشخصية أكثر تعقيدًا وغموضًا، تجمع بين الحذر الاستراتيجي في بعض المواقف والنزعة الهجومية في مواقف أخرى. ويتضح هذا في سياساته الخارجية، كالتدخل الروسي العسكري في سوريا، وقضية ضمّ القرم، والحرب في أوكرانيا. وتشير تحليلات عديدة إلى أن خلفيته الأمنية تشكّل عنصرًا محوريًا في تفسير سلوكه السياسي. حيث يُعزى إصراره على المضي في بعض القرارات – حتى في ظل كُلفة سياسية واقتصادية عالية – إلى طباع تشكّلت من تجربته الطويلة في أجهزة الأمن.
ينتج عن تفاعل هاتين الشخصيتين علاقة ديناميكية معقدة بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، وهي علاقة متجذرة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وتُعد من أبرز العوامل المؤثرة في مشهد العلاقات الدولية الراهن، كما أنها تحمل تداعيات مستقبلية قد تسهم في إعادة تشكيل النسق الدولي بأسره.
أولًا: مشكلة البحث
تُعد عملية صنع القرار في السياسة الخارجية من أكثر الجوانب تعقيدًا في مجال السياسة الخارجية، نظرًا لتداخل مجموعة واسعة من العوامل، سواء كانت داخلية أو خارجية، شخصية أو مؤسسية. وقد تناولت العديد من الدراسات هذه العوامل بمختلف التحليلات، إلا أن التحليل التقليدي غالباً ما يُغفل البُعد الشخصي والسيكولوجي للقيادة السياسية، رغم أن شخصية القائد وسماته النفسية تمثل عنصراً مؤثراً لا يمكن تجاهله في تشكيل القرار الخارجي.
يزداد وضوح تأثير شخصية القائد في الأنظمة التي تتركز فيها السلطة بيد شخص واحد، أو في تلك التي تتسم بسيطرة القيادة الكاريزمية أو الشعبية على عملية صنع القرار. ويتعين الإشارة إلى أن تجارب عديدة أثبتت أن القرارات المصيرية، لا سيما في أوقات الأزمات، تكون في كثير من الأحيان انعكاساً مباشراً لشخصية القائد ورؤيته للعالم. ومن هذا المنطلق، يثير سلوك قادة مثل فلاديمير بوتين ودونالد ترامب تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير السمات النفسية في توجيه السياسات الخارجية.
وارتباطاً بما تقدم، تتمحور المشكلة البحثية حول تساؤل رئيسي قوامه ما دور الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية في عملية صنع القرار الخارجي، لا سيّما الرئيسين بوتين وترامب؟
ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بصنع القرار؟
- ما الهيئات التي تشارك في عملية صنع القرار الخارجي؟
- ما المقصود بالخصائص السيكولوجية؟
- كيف تؤثر الخصائص السيكولوجية على صنع القرار؟
- ما أبرز السمات النفسية والشخصية لفلاديمير بوتين؟
- كيف انعكست السمات النفسية والشخصية لبوتين على المواقف والسياسات الخارجية الروسية؟
- ما أبرز السمات النفسية والشخصية لدونالد ترامب؟
- كيف أثرت شخصية ترامب السيكولوجية في سياساته الخارجية؟
- كيف أثرت الخصائص السيكولوجية لكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على السياسة الخارجية لدولتيهما مع الدول الاخرى؟
ثانيًا: هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤل الرئيسي وما يتفرع عنه من تساؤلات فرعية، والمتمثل في تحليل دور الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. ويقتضي ذلك بطبيعة الحال التطرق إلى الجانب النظري من خلال توضيح كافة المفاهيم الأساسية المستخدمة، مثل صنع القرار والخصائص السيكولوجية وغيرها، إلى جانب استعراض الجهات الفاعلة والمؤثرة في عملية صنع القرار الخارجي، كما يسعي البحث إلى استكشاف كيفية تجلّي هذه الخصائص السيكولوجية في مواقف وسلوكيات كل من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال فترات حكمهما، وما إذا كانت قد تركت أثراً ملموساً على قراراتهما في السياسة الخارجية.
ثالثًا: أهمية البحث
تنبع أهمية هذا البحث من إسهاماته على الصعيدين العلمي والعملي. فمن ناحية الأهمية العلمية، يسعى البحث إلى تقديم إسهام ضمن الأدبيات العربية المعنية في مجالي السياسة الخارجية وعلم النفس السياسي، لما لهذين المجالين من أهمية متزايدة ضمن اهتمامات العلوم السياسية. أما من ناحية الأهمية العملية، فيعالج هذا البحث أحد أكثر الموضوعات الحيوية في السياسة الخارجية المعاصرة، حيث يضع أمام صناع القرار المصري والعربي رؤى تحليلية ومعطيات مهمة تتعلق بتأثير الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية في عملية صنع القرار الخارجي. وتتمثل الأهمية العملية بشكلٍ خاص في تسليط الضوء على دور هذه الخصائص في توجيه قرارات اثنين من أبرز القادة على الساحة الدولية، وهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
رابعًا: منهج البحث
المنهج الاستقرائي: يهتم المنهج الاستقرائي برؤية ووصف الواقع وملاحظة المتغيرات المختلفة وتتبع الأحداث بهدف التعبير عن ظاهرة والوصول إلى نتائج موضوعية. يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي في تحليل أثر الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية على عملية صنع القرار الخارجي من خلال دراسة حالتي بوتين وترامب والتوصل إلى حقيقة تأثير الخصائص السيكولوجية لكل من الرئيسين على السياسة الخارجية للدولتين محل البحث.
مدخل صنع القرار: يهتم مدخل صنع القرار بدراسة وتحليل القرارات، ويعمل على توضيح العوامل ذات تأثير على عملية صنع بمراحلها المختلفة، والآثار الناتجة عنها. يستند هذا البحث إلى مدخل صنع القرار لتحليل قرارات كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وفهم تأثير العوامل السيكولوجية على عملية صنع القرار الخارجي على نحو عام، وبما يخص كل من الرئيسين.
المدخل السيكولوجي: يرى مؤيدي هذا المدخل أن القرارات الخارجية للدول تأتي متأثرة بالخصائص النفسية والسيكولوجية للقيادة السياسية، إذ تتأثّر القيادة السياسية وفق هذا المدخل بإدراكهم للبيئة الدولية وتصوراتهم عنها. كما يعتقد أنصار هذا المدخل أن السياسات الخارجية للدول هي أيضًا انعكاس للخصائص السيكولوجية للقادة السياسيين القائمين على صناعتها وتنفيذها. استند هذا البحث في جوهره إلى المدخل السيكولوجي، إذ قمنا بتحليل الخصائص النفسيّة والسيكولوجية لكلا الرئيسين بوتين وترامب، ومن ثم قُمنا بالإشارة لانعكاسات هذه الخصائص على استراتيجية كل منهما وأثرها على السياسة الخارجية لدولهما.
خامسًا: الإطار الزماني
يركّز البحث على الفترة الزمنية التي تغطي ولايات الرئيسين ترامب وبوتين، حيث تشمل بالنسبة لبوتين الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2008 (الولايتان الأولى والثانية) ومن عام 2012 وصولاً إلى عام 2025 التي تضم فترته الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى ولايته الخامسة الحالية. أما بالنسبة لترامب، فتشمل ولايته الأولي من عام 2017 حتى عام 2021، وولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025 وتستمر حتى وقت كتابة هذا البحث (أبريل 2025).
سادسًا: تقسيم البحث
الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للبحث
- المبحث الأول: مفهوم صنع القرار في السياسة الخارجية وأبعاده المختلفة
- المبحث الثاني: الخصائص السيكولوجية للقادة السياسيين وتأثيرها على عملية صنع القرار الخارجي
الفصل الثاني: التأثير السيكولوجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عملية صنع القرار الخارجي
- المبحث الأول: السمات السيكولوجية والشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- المبحث الثاني: تأثير الخصائص السيكولوجية والشخصية للرئيس فلاديمير بوتين على قرارات السياسة الخارجية الروسي
الفصل الثالث: التأثير السيكولوجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عملية صنع القرار الخارجي
- المبحث الأول: السمات السيكولوجية والشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
- المبحث الثاني: تأثير الخصائص السيكولوجية والشخصية للرئيس ترامب على عملية صنع القرار الخارجي
الفصل الرابع: تأثير التفاعل بين السمات السيكولوجية لكل من ترامب وبوتين على العلاقات الدولية
- أولاً: تأثير العوامل السيكولوجية على العلاقات الأمريكية الروسية
- ثانيًا: تأثير العوامل السيكولوجية على علاقات كل من الولايات المتحدة وروسيا مع الدول الأخرى
سابعًا: دراسات سابقة:
- محمد رشيد، تأثير العامل السيكولوجي على صانع القرار السياسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجًا، مجلة الريحان للنشر العلمي. عدد 25، مركز فكر للدراسات والتطوير، 2022، ص 128-154.
يركّز هذا البحث على تحليل الكيفية التي تؤثر بها شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عملية صنع القرارات الروسية، مع توضيح دور سماته الشخصية في توجيه وتشكيل المواقف والسياسات الروسية بشكلٍ عام منذ توليه الحكم. ويستند بحثنا في تحليله لشخصية بوتين وقراراته إلى ما توصل إليه رشيد في دراسته من نتائج وأفكار، بهدف تعزيز الفهم العميق لتأثير البُعد السيكولوجي في السياسة الخارجية الروسية. يعتمد كلا البحثين على محور متشابه، حيث يعالج كلاهما أفكار ومعتقدات وتوجهات الرئيس فلاديمير بوتين وانعكاساتها على القرار الروسي، إلا أن قد يركز رشيد في بحثه على عدداً من سياسات بوتين الداخلية بينما يتمحور هذا البحث بشكلٍ أساسي على القرارات الخارجية، كما يتوسع هذا البحث لعرض كيفية تفاعل شخصية بوتين مع شخصية نظيره الأمريكي دونالد ترامب وتأثير هذا التفاعل على العلاقات الأمريكية الروسية.
- Alex Mintz, Karl Derouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press, 2010.
يتناول هذا الكتاب السياسة الخارجية من منظور عملية صنع القرار، ويتطرق الى تأثير العوامل السيكولوجية على هذه العملية، كما يقدم أمثلة متعددة لدول تأثرت بالعوامل النفسية في قراراتها الخارجية – ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. يشترك هذا الكتاب مع بحثنا في فكرة أساسية، وهي أن للعوامل النفسية – أو “غير العقلانية” كما يصفها الكتاب – دور مؤثر في القرارات الخارجية. ويستعين هذا البحث بما يقدمه منتز وديروين من أمثلة على عوامل سيكولوجية تؤثر على صنع القرارات الخارجية كالمعتقدات، المشاعر، التصورات، وشخصيات القادة وتصنيفاتهم. ولكن بينما يتوسع الكتاب إلى عوامل أخرى مؤثرة في عملية صنع القرار الخارجي – من عوامل دولية وثقافية وعسكرية – ينحصر مجال هذا البحث في حدود العوامل السيكولوجية والتأثيرات النابعة عنها.
- Mary L. Trump, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. Simon & Schuster, 2020.
ترسم الأخصائية النفسية الإكلينيكية – وابنة أخ دونالد ترامب – ماري ترامب خلال هذا الكتاب صورة مفصلة للخلفية السيكولوجية للرئيس الأمريكي مستخدمة المواقف الشخصية والمقابلات مع أفراد من عائلة الرئيس ترامب والمقربين منه كمصادر أساسية لكتابها. يعتمد هذا البحث على بعض من تحليلاتها، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الشخصية التي تربط الكاتبة بعائلة ترامب، التي قد تؤثر على استنتاجاتها. تركز ماري في كتابها على البُعد الشخصي بشكلٍ أساسي، يُلاحظ أن معظم محتوى هذا الكتاب يتركّز على استعراض الجوانب الشخصية من حياة عائلة ترامب، مع تراجع واضح في مستوى التحليل السياسي. أما هذا البحث، فيُعنى بشكلٍ رئيسي بدراسة العوامل السيكولوجية للرئيس دونالد ترامب من حيث انعكاسها على قراراته السياسية، مع التطرق إلى حياته الشخصية فقط في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لتوضيح بعض الاستنتاجات أو دعم التحليلات المطروحة
- Dan P. McAdams, The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning, Oxford University Press, 2020.
في سياق تحليل التأثيرات النفسية على القيادة السياسية، يُعد كتاب The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning Dan P. McAdams مرجعًا أساسيًا في فهم العلاقة بين السمات الشخصية لترامب وسلوكياته السياسية. يقدم الكتاب تحليلاً عميقاً لشخصية ترامب من منظور علم النفس، ويبيّن كيف أن تركيبة ترامب النفسية—بما في ذلك النرجسية، والانفعالية العالية، وغياب الشعور بالتعاطف—أثّرت بشكلٍ مباشر على توجهاته في السياسة الخارجية. كما يربط McAdams بين القرارات الخارجية المثيرة للجدل، مثل الانسحاب من الاتفاقيات الدولية، وبين الاحتياجات النفسية لدى ترامب للسيطرة وتحقيق الانتصار الشخصي. وتتوافق رؤية McAdams مع تصوّر هذا البحث التي ترى في الخصائص السيكولوجية للقادة عاملاً مهماً في صنع القرار الخارجي، مما يمنح هذا الكتاب قيمة معرفية متميزة بسبب إسهامه في بناء أدبيات تحليل الشخصية السياسية في سياق العلاقات الدولية.
الفصل الأول
الإطار النظري والمفاهيمي للبحث
تمهيد
يسعى هذا الفصل إلى بناء الإطار النظري للبحث، وذلك من خلال تعريف وشرح المفاهيم الأساسية التي سيتم تناولها على مداره. ويبدأ المبحث الأول بالتعريف بعملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وتحليلها في ضوء ما تتسم به من تعقيد ناتج عن تداخل مجموعة من العوامل، تشمل الأبعاد المؤسسية، والبيئية، والشخصية. كما يقوم المبحث الثاني بتعريف الخصائص السيكولوجية المختلفة، وبيان أثرها على القيادة السياسية أثناء عملية صنع القرار الخارجي، بما يمهد لفهم أعمق لطبيعة هذا التأثير في الفصول التطبيقية لاحقاً.
المبحث الأول
مفهوم صنع القرار في السياسة الخارجية وأبعاده المختلفة
يرتكز هذا البحث على مجموعة من المفاهيم الأساسية، يأتي في مقدمتها مفهوم “صنع القرار”، وبوجه خاص “صنع القرار الخارجي”. وتتنوع و تتعدد تعريفات هذا المفهوم بتعدد السياقات التي يُستخدم فيها؛ فوفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة (ESCWA)، يُعرّف عملية صنع القرار بأنها “عملية اتخاذ القرارات من خلال تحديد قرار وجمع المعلومات وتقييم القرارات البديلة.”[1] في حين يقدّم عبدالجواد بكر تعريفًا أكثر تفصيلاً، إذ يري أن صنع القرار هو “عملية عقلية منظمة، تتضمن تحديد المشكلة أو القضية المطلوب اتخاذ القرار بشأنها، كما تتضمن البحث او التدقيق في الحلول المتاحة و المقارنة و المفاضلة بين الحلول ثم الوصول إلى قرار.”[2]
نخلص من استعراض المفاهيم المتعددة لعملية صنع القرار إلى أنها عملية متعددة المراحل، تهدف إلى تحديد المشكلة واختيار الحل من بين مجموعة من البدائل المتاحة. ومن المهم الإشارة في هذا السياق التمييز بين مفهومي “صنع القرار” و “اتخاذ القرار”، إذ يشير مصطلح “صنع القرار” إلى سلسلة من الخطوات المعقدة التي تبدأ بتحديد المشكلة، وجمع المعلومات ذات الصلة، وتحليل الأبعاد المختلفة للموقف، وتنتهي باختيار مسار محدد للاستجابة. أما “اتخاذ القرار” فيُشير تحديداً إلى المرحلة الأخيرة من هذه العملية، أي مرحلة الاختيار بين البدائل، والتي تُعد أكثر الخطوات حسماً وحساسية.[3] ويُعرّف عبد العزيز صالح “اتخاذ القرار” بأنه “الاختيار المدرك بين أكثر من بديل ممكن لمواجهة موقف أو مشكلة معينة.”[4]
تتكون عملية صنع القرار من مراحل عديدة، ويختلف العلماء حول عدد المراحل وأهدافها، ولكن يمكن تحديد أربع مراحل عامة لعملية صنع القرار، وهي:
- أولًا: تحديد المشكلة، وهي القضية التي يتعين على صانع القرار مواجهتها والتعامل معها[5].
- ثانيًا: فهم المشكلة، وهي المرحلة التي تتضمن جمع المعلومات المتعلقة بالقضية وتحليل أبعادها المختلفة. وتتطلب هذه المرحلة الاستعانة بمصادر متنوعة – سواء علمية مثل الكتب والأبحاث وأوراق السياسات أو ميدانية مثل الإحصائيات واستطلاعات الرأي العام.
- ثالثًا: صنع القرارات والحلول البديلة، وتتضمن هذه المرحلة تطوير مقترحات جديدة، مما يتطلب الابتكار[6]، أو تعديل القرارات الحالية التي تم اقتراحها أو تنفيذها مسبقًا، وهو ما يتطلب نظرة نقدية.
- رابعًا: اتخاذ القرار، وهي المرحلة النهائية في العملية وينتج عنها اختيار قرار واحد من بين البدائل المتاحة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى ملاحظتين رئيسيتين:
الأولى هي أن عملية صنع القرار ليست عملية “معزولة”، أي أنها تتأثر بالعديد من العوامل مثل الضغوط المادية والزمنية على صناع القرار، الرأي العام، المجتمع المدني، العلاقات الدولية، والهيكل السياسي والمؤسسي للدولة.[7] ومن بين هذه العوامل المؤثرة، تعد العوامل البيئية والسيكولوجية لصانع القرار من أهم العوامل التي ستتم مناقشتها في هذا البحث.
الثانية هي أن عملية صنع القرار تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بناءً على الفروقات في طبيعة الدول والأنظمة السياسية القائمة فيها. كما يمكن أن تؤثر طبيعة القضية أو المشكلة التي يعالجها القرار على أسلوب صنعه. فعملية صنع القرار أثناء الأزمات أو الحروب تختلف عما هي عليه في أوقات السلام، كما تختلف عملية صنع القرار المتعلقة بالشؤون الداخلية عن تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، وهي القضية التي تُعد محورية في هذا البحث[8]، ويجدر بنا الإشارة إلى الدور المنفرد للقادة السياسيين في النظم الشمولية في عملية صنع القرار الخارجي كما هي الحالة في روسيا تحت حكم بوتين[9]، خاصة لما تتسم به شخصيته من كاريزمية تزيد من ميوله السلطوية وقدراته على حشد الرأي العام الروسي[10]، على عكس النظم الليبراليه حال الولايات لما فيها من فصل بين السلطات بالإضافة إلى آليات ضبط ورقابة على قرارات الرئيس من سائر هيئات الدولة[11]، وهو ما ينعكس بالنهاية على عملية صنع القرار وقد يعيد تشكيلها بالكلية للتوافق مع مختلف الهيئات تلك.
يشير صنع القرار في سياق السياسة الخارجية إلى عملية دراسة وتحليل واتخاذ قرارات التي تؤثر على تصرفات الدولة على الساحة الدولية أو بقضايا ذات طابع دولي، بهدف تحقيق أهداف دولية يحددها صانع القرار.[12] ويمكن أن يشمل مصطلح “صانع القرار” هنا هيئات متعددة، سواء كانت أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات، التي تشارك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في مراحل عملية صنع القرار. وبشكلٍ عام، يمكن تقسيم الجهات أو الهيئات المشاركة في صنع القرار الخارجي إلى مؤسسات حكومية وأخري غير حكومية، حيث تتباين هذه المؤسسات في طبيعتها والأدوار التي تقوم بها.
أولاً: المؤسسات الحكومية، والتي تتمثل في السلطة التنفيذية، بما في ذلك رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات (يتحدد دورهم في عملية صنع القرار الخارجي وفقًا لطبيعة النظام السياسي القائم)، إلى جانب الوزارات والمؤسسات العامة، والسلطة التشريعية وما يندرج تحتها من لجان متخصصة.[13]
وفيما يخص السلطة التنفيذية، فإنها تُعد الجهة المحورية في تشكيل السياسة الخارجية، وتحمّل المسؤولية الرئيسية عنها، بغض النظر عمّا إذا كان النظام السياسي ديمقراطياً أو غير ديمقراطي، اتحادياً أو مركزياً. ويبرز هذا الدور بشكلٍ خاص في الأنظمة غير الديمقراطية، حيث تقتصر مهام الهيئات التشريعية – إن وُجدت – في الغالب على إضفاء الشرعية أو الموافقة الشكلية على قرارات سبق أن اتخذتها السلطة التنفيذية. حتى في الأنظمة الديمقراطية، تظل السلطة التنفيذية، وبالأخص رئيس الدولة، مهيمنة على السياسة الخارجية، نتيجة لما تتسم به القضايا الدولية من تعقيد وتشابك، وهو ما يتطلب عملية صنع قرار أكثر تركيزاً وفعالية.[14]
ثانياً: المؤسسات غير الحكومية، وهي جهات مجتمعية لا تنتمي إلى الهيكل الرسمي للدولة، إلا أنها تلعب دوراً بارزاً في التأثير على توجهات السياسة الخارجية. وتشمل هذه الجهات الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والرأي العام، وجماعات المصالح.[15]
يختلف تأثير الأحزاب السياسية باختلاف النظام الحزبي القائم في الدولة؛ ففي الأنظمة متعددة الأحزاب تتنوع الآراء وتتعدد التوجهات، بينما يفرض الحزب الحاكم سيطرته على السياسات في الدول ذات الحزب الواحد. وتؤدي وسائل الإعلام دوراً محورياً من خلال التأثير المزدوج على كل من الرأي العام وصانعي القرار، حيث تُعد وسيطاً بين الحكومة والمجتمع. ومع تزايد الوعي السياسي، بات للرأي العام دور متنامٍ في توجيه السياسة الخارجية، لا سيما في الدول التي تتيح له حرية التعبير والمشاركة. [16]
أما جماعات المصالح، فتسعى للتأثير على صناع القرار عبر الضغط السياسي والدعوة لتحقيق أهدافها، إلا أن تأثيرها على السياسة الخارجية يبقى محدوداً نظراً لافتقارها إلى سلطة رسمية مباشرة في عملية صنع السياسات. ويعتمد نفوذها أساساً على قدرتها على إقناع المسؤولين الحكوميين بتبنّي مواقفها أو مطالبها.[17]
وبذلك، يتضح أن عملية صنع القرار، وخاصة في السياسة الخارجية، لا تُعد مجرد خطوات إجرائية، بل هي عملية مركّبة تتداخل فيها عوامل متعددة، تبدأ من تحديد المشكلة وتنتهي باختيار الحل الأمثل من بين بدائل مطروحة، كما تتأثر هذه العملية بالسياقات المؤسسية، والبيئة السياسية، والضغوط الداخلية والخارجية، وبعد التعريف بهذه العملية ننتقل للمبحث الثاني من الإطار النظري والتعريف بالخصائص السيكولوجية للقادة السياسيين وتأثيرها بالتبعيّة على عملية صنع القرار الخارجي.
المبحث الثاني
الخصائص السيكولوجية للقادة السياسيين وتأثيرها على عملية صنع القرار الخارجي
تعتبر الخصائص السيكولوجية من أهم العوامل في فهم وتحليل السلوك السياسي والقرارات الدولية، وتشمل هذه الخصائص القيم والمعتقدات، التصورات، المشاعر، والسمات الشخصية التي تُشكّل أساس التفكير والسلوك لدى القادة في عملية اتخاذ القرار[18]. ويقصد بالسيكولوجية في هذا السياق العمليات الذهنية المتعلقة بالتفكير والإدراك والتصورات والعقائد التي يحدد من خلالها القائد كيفية تعامله مع العالم المحيط به، بمعنى آخر، هي التصور الذاتي الذي يتعامل به القائد في البيئة الواقعية[19].
يشير هذا المفهوم إلى أن قرارات السياسة الخارجية لا تصدر فقط بناءً على حسابات عقلانية موضوعية، بل تتأثر بدرجة كبيرة بالمعايير والتصورات الشخصية التي يتبناها الفرد. وتلعب هذه الخصائص دورًا حاسمًا في كيفية إدراك القائد للعالم من حوله، وتفسيره للمعطيات، وبالتالي في القرارات التي يتخذها [20]، ولكن تجدر بنا الإشارة لنسبية التحليلات النفسية للقادة السياسيين، لما تتسم به طبيعة الموضوع والمدخل المُستخدم؛ أي المدخل السيكولوجي، من ذاتية ونسبية تحيل بيننا وبين الجزم يقينًا بالنتائج.
تعود هذه الفكرة إلى ما أطلق البعض مصطلح “البيئة السيكولوجية” (Psychological Environment)، وهي تمثل منظومة التصورات والمعتقدات التي يحملها صانع القرار تجاه موقف معين، والتي تُوجه قراراته بشأنه. وتُقابل هذه البيئة “البيئة العملية” (Operational Environment)، أي الواقع الفعلي للموقف كما هو[21]، وتحدد الفجوة بين البيئة السيكولوجية لصانع القرار والبيئة العملية مدى نجاح أو فاعلية القرار المتخذ في نهاية المطاف.
يمكن تحديد عدد من العوامل الأساسية التي تسهم في تشكيل البيئة السيكولوجية، والتأثير عليها، ومن أبرز هذه العوامل:[22]
- الانحيازات المعرفية: وتشمل الأخطاء الذهنية التي تؤثر على طريقة تفكير الفرد، مثل انحياز التأكيد (تفضيل المعلومات التي تؤكد ما نؤمن به سابقًا)، والتفكير الرغبي (تشكيل تصورات إيجابية استنادًا إلى ما نرغب أن يكون صحيحًا).
- المشاعر: كالغضب، والخوف، والتعاطف، والتي تلعب دورًا جوهريًا في تشكيل الاستجابات السياسية، خاصة في أوقات الأزمات أو النزاعات.
- السمات الشخصية: مثل النزعة التسلطية، أو الانفتاح على التجديد، وهي خصائص تؤثر على ميل القائد للمجازفة، أو على أسلوبه في إدارة العلاقات الدولية. تُحدد هذه السمات الكيفية التي يرى بها القائد التهديدات والفرص، وكيفية تقييمه للمخاطر، وبالتالي فإنها توجّه سلوكه السياسي على الساحة الدولية. ولعل من الضروري الإشارة إلى أن هذه السمات ليست جامدة، بل إنها قابلة للتغير مع الظروف، والخبرات، والضغوط والبيئة المحيطة.
لا تُعدّ العوامل النفسية مجرد عنصر مكمل في التحليل السياسي، بل تشكّل في كثير من الأحيان محددًا رئيسيًا لما يعتبره القائد مهمًا أو غير مهم، وللخيارات التي يتبناها في مواجهة المواقف المختلفة. فالتصورات الذهنية والانفعالات والقيم التي يحملها القائد تؤثر بشكلٍ مباشر في كيفية تفسيره للأحداث واتخاذه للقرارات، مما يجعل السياسة الخارجية حصيلة لتفاعل معقد بين التحليل العقلاني والانطباعات الشخصية والعوامل الاجتماعية المحيطة[23].
يستدعي فهم الخصائص والبيئة السيكولوجية للقيادة السياسية وتأثيرها على قراراتهم التطرق أيضًا إلى عدد من المفاهيم الأخرى ذات الصلة، وهي: [24]
- الرموز المعرفية ((Cognitive Schemas: وتُشير إلى الأُطر الذهنية أو “القوالب العقلية” التي يستخدمها الأفراد لتفسير المعلومات وتنظيمها، وهي بمثابة خرائط ذهنية تساعد القائد على فهم العالم المعقد من حوله.
ب– الرموز العملية (operational codes): فهي تتعلق بمجموعة المعتقدات الأساسية التي يحملها القائد حول طبيعة السياسة العالمية، ونوايا الخصوم، والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف، مما يؤثر على توجهاته واستراتيجياته في التعامل مع القضايا الدولية.
- الاتساق المعرفي (Cognitive consistency): يشير إلى ميل العقل البشري إلى الاتساق الداخلي؛ بمعنى أن العقل يرفض أو يقلل من شأن أي معلومات خارجية لا تتسق مع منظومة المعتقدات التي تبناها الفرد مُسبقًا، كما يعطي أهمية مفرطة للمعلومات التي تتسق مع معتقداته، وكلّما واجه العقل تناقض داخلي بين المعلومات الخارجية ومعتقداته وقناعاته الداخلية تلك، فسّره كاستثناء عن القاعدة الفكرية المسبقة، وينعكس هذا سلباً على صانع القرار فيجعله متمسكاً بوجهة نظره مُهملًا لأي آراء أخرى وأن كانت ذات أهمية، وهو ما يُعجِزه عن التكيّف مع الظروف المتغيّرة، مما يؤدي إلى الجمود المعرفي والتصرف القاصر وغير الفعّال مع الأزمات[25].
- شخصية القائد: الشخصية هي ” التكامل المخصص فرديًا لعمليات الإدراك، والذاكرة، والحكم، والسعي نحو الأهداف، والتعبير عن العواطف وتنظيمها.” تؤثر الشخصية بشكلٍ مباشر على تفضيلات صانع القرار، وكيفية تفاعله مع الرموز والإشارات، وكذلك على طريقة تعامله مع عواطفه. ويطرح دايفيد وينتر تصورًا للشخصية باعتبارها مكونة من أربعة عناصر مترابطة: المزاج، والسياق الاجتماعي (بما يشمله من عوامل ديموغرافية وثقافية)، والإدراك (المعتقدات، القيم، والمواقف)، والدوافع، مع الإشارة إلى أن العنصرين الأخيرين (الإدراك والدوافع) يصعب قياسهما بشكلٍ مباشر.
وبناءً على هذا التصور، طوّرت “مارغريت هيرمان” تقنية لتقييم الشخصية عن بُعد، تعتمد على تحليل مضمون المقابلات العفوية للقادة بهدف قياس هذه الأبعاد واستنباط سمات محددة، مثل: القومية، والإيمان بالقدرة على التحكم بالأحداث، وانعدام الثقة بالآخرين، والتحيز للجماعة، والحاجة إلى السلطة، والاتجاه نحو حل المشكلات مقابل الحفاظ على تماسك الجماعة، والثقة بالنفس، والتعقيد المفاهيمي. ومن خلال الربط بين تركيبات مختلفة من هذه السمات، حدّدت هيرمان عددًا من “التوجهات” في السياسة الخارجية، وهي: التوسعية، والمستقلة الفاعلة، والمؤثرة، والوسيط، والانتهازية، والتنموية. ويمثل كل توجه منها نمطًا مميزًا للشخصية، ينعكس بشكلٍ واضح في سلوك القائد وتأثيره المحتمل على عملية صنع القرار[26].
ه- العواطف: “تتكون العاطفة من الأفكار، والدوافع، والشعور بالخبرة، والأحاسيس الجسدية وهي ليست مثل المزاج أو الشعور.”
فالعواطف تجعل من الصعب على القائد أن يفكر بشكلٍ موضوعي وتؤثر على معالجته للمعلومات واتخاذ القرار[27] ولكن في أغلب الأحيان لا يمكن الاعتماد على العواطف لتحليل قرارات القائد لأنه قد يتعّمد اخفائها[28].
و- الاختصارات الاستدلالية (Heuristic Shortcuts): في عملية صنع القرار، يحاول القائد فهم العالم من حوله باستخدام أدوات معرفية مثل الصور الذهنية لتصنيف الأحداث والأشخاص والقوالب النمطيّة وهي تصورات مسبقة عن الدول تتعلق بقوتها، ثقافتها، أو أهدافها السياسية، والتماثلات المعرفية المعنية بتفسير المواقف الجديدة استنادًا إلى مواقف قديمة مشابهة لها. بينما تساعد هذه الأدوات في تبسيط المعلومات المعقدة واتخاذ قرارات سريعة، لكنها تؤدي أيضًا إلى تحيزات معرفية تؤثر بدورها في مدى صحة القرارات[29].
- المعتقدات وأنظمتها والأنماط المعرفية: تلعب معتقدات القادة دورًا جوهريّا في تشكيل قرارات السياسة الخارجية، فتعمل كإطارات مرجعية تساعد صانع القرار في تفسير وفهم المعلومات.
تقوم هذه المعتقدات بتصفية المعلومات الواردة، وبالتالي توجّه استراتيجيات القائد وقراراته. ويتم تشكيل نظام المعتقدات لدى القائد من تفضيلات داخلية وإدراك تفضيلات الآخرين، مما يؤثر على عمليات صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، وتساعد الأنماط المعرفية في تحليل السياسة الخارجية، حيث أن المعلومات السابقة تؤثر بشكلٍ كبير على القرارات على جميع مستويات التحليل[30].
مما سبق، نستنتج أن الخصائص السيكولوجية للقادة تعد عنصرًا محوريًا في تفسير قرارات السياسة الخارجية، حيث تؤثر القيم، والتصورات، والانفعالات، والسمات الشخصية على كيفية إدراك القادة للمواقف وتفسيرهم لها. بالتالي لا تنبع القرارات من حسابات عقلانية منطقية وحسب، بل تتأثر أيضًا بالبيئة النفسية المحيطة بالقائد، مثل الانحيازات المعرفية والرموز الذهنية. لذا، يُعد فهم البعد النفسي ضروريًا لتحليل سلوك القادة على الساحة الدولية.
تناول هذا الفصل في مبحثه الأول الإطار المفاهيمي لعملية صنع القرار، موضحًا مراحلها الأساسية، ومبرزًا الفارق الدقيق بينها وبين اتخاذ القرار، كما عرّف بصور مختلفة الجهات الفاعلة في هذا السياق؛ من مؤسسات حكومية كالسلطة التنفيذية والتشريعية، إلى مؤسسات غير حكومية كوسائل الإعلام وجماعات المصالح.
أما في المبحث الثاني، فتم تحليل التأثيرات السيكولوجية على عملية صنع القرار، وهو ما اتّضح من خلاله أن عملية صنع القرار الخارجي ليست عملية خطية أو عقلانية بالكامل، بل هي نتاج لتفاعل معقّد بين عوامل داخلية وخارجية، ترتبط بالبنية المؤسسية للدولة من جهة، وبالخصائص الشخصية والنفسية لصانع القرار من جهة أخرى.
وعليه، يوفّر هذا الفصل أرضية نظرية ومنهجية ضرورية لفهم كيف تتجسد هذه المفاهيم بصورة عملية في شخصيات قيادية بعينها، وهو ما سيتم تناوله في الفصول اللاحقة من خلال تحليل حالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الفصل الثاني
التأثير السيكولوجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عملية صنع القرار الخارجي
تمهيد
يُشكّل تحليل الخصائص الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدخلاً أساسياً لفهم أبعاد توجهاته وسلوكياته في السياسة الخارجية. فقد أعاد خلال عقدين تشكيل مكانة روسيا في الساحة الدولية، متأثرًا بخلفيته الشخصية والمهنية. سنتناول في المبحث الأول السمات الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين كالميكافيلية والهيمنة والضميرية وغيرها من السمات وفقًا لأدوات مختلفة لتحليل الشخصية وسنستخدم أدوات تحليل مختلفة لفهم هذه الخصائص. كما سنحلل في المبحث الثاني انعكاس هذه السمات على قرارات روسيا الخارجية، سواء بالتدخلات العسكرية أو رسم الاستراتيجيات الكبرى.
المبحث الأول
السمات السيكولوجية والشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نظرًا لما تمثله الخصائص السيكولوجية من أهمية في فهم وتحليل قرارات الانسان العامة، والقادة السياسيين بالأخص، يقوم هذا المبحث بتحليل وتصنيف السمات النفسية والمعرفية المميزة لشخصية بوتين، في محاولة لفهم الكيفية التي أسهمت بها هذه السمات في بناء نمطه القيادي وبالتبعية في توجيه سياسات روسيا الخارجية.
أولاً: خلفية بوتين الاجتماعية، والأكاديمية، والمهنية
- طفولته ونشأته
وُلِد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في السابع من أكتوبر لعام 1952 بمدينة ليننجراد (المعروفة حاليًا بسان بيطرسبرغ) إبان حقبة الاتحاد السوفيتي، لأسرة وصفها بوتين بأنها “أسرة عادية”، بالإضافة لكونه “عاش كشخصٍ عادي على مدار حياته كلها”[31]. وعلى الرغم من وصفه لها بالعادية، إلا أن ظروف حياة ونشأة الرئيس الروسي أثّرت كثيرًا في شخصيته، فكان ابن لأسرة متواضعة الحال اتسمت بالخضوع لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وأب كان من المدافعين عن البلاد إبان الحرب العالمية الثانية[32] وهو ما صَبَغ بوتين بالصرامة[33] وزاد من ولائه للبلاد ورغبته في خدمتها ومحاولاته للعمل في جهاز المخابرات فيما بعد، خاصة أنه ترعرع في كنف الاتحاد السوفيتي ومن ثم شهد ضعفه وتفككه.
لا يخفى على أي محلل لشخصية بوتين أثر تفكك الاتحاد السوفيتي على شخصيته وقناعاته، فعلى سبيل المثال قال إيان روبرتسون، أستاذ علم النفس بجامعة تكساس: “لا يساورني شك في أن بوتين يشعر بالإهانة الشخصية بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي وإمبراطورتيه، وأنه سيعمل بجد أكبر من أجل تعويض هذا الإذلال من خلال المزيد من المغامرات الخطرة. سوف يكون مدفوعًا أكثر بشعوره بالتفوق الشخصي والوطني على القوى الغربية الضعيفة والمفككة والجبانة، كما يراها على الأرجح”[34].
- دور الجودو في تشكيل شخصية بوتين
يرى بوتين بصفة عامة أن الفنون القتالية تُعلّم الحكمة، كما قال “الجودو يعلّم السيطرة على النفس، القدرة على الشعور باللحظة ورؤية نقاط القوة والضعف في الخصم. أنا على يقين أنك ستتفق معي على أهمية وجود هذه الصفات في أي رجل سياسي[35]” وبتحليل قوله ذاك، يمكننا استنتاج شكل القيادة السياسية التي يمثلها بوتين والملخصة في: عقلية المحصلة الصفرية (Zero-Sum game)؛ أي ليربح في المنافسة السياسية، لابد أن يخسر خصمه تمامًا كما في الرياضة، وهو ما يُظهر تصوره للفاعلين السياسيين الآخرين باعتبارهم خصومًا ينبغي مواجهتهم، لا شركاء في صنع القرار.
يتضمن هذا التصور استخدامًا استراتيجيًا لمواطن القوة والضعف لدى الخصوم لتحقيق الأهداف الذاتية، إلى جانب ضرورة ضبط السلوك وإخفاء النوايا الحقيقية كوسيلة فعّالة للنجاح، انطلاقًا من افتراض أن الآخرين يسلكون المسار ذاته[36]. ومن هنا، تتشكّل لديه قناعة بأن المشهد السياسي تحكمه أجندات خفية، مما يبرر غياب الثقة في نوايا الفاعلين الآخرين.
إضافة إلى ذلك، وصفه مدربه أناتولي راكولين بأنه “مصارع ذهني لا يخشى الهزيمة أبدًا”[37]، كما يمكننا استنتاج أن ممارسة بوتين لرياضة الجودو ساهمت في إكسابه صفات كالقوة، الالتزام، التحدي، العناد في إحراز النصر[38]، الانضباط، المثابرة، الشعور العالي بقيمة الذات والثقة بالنفس، سرعة البديهة واليقظة[39]، زيادة قدرته في التحكم بمشاعره في مختلف الظروف وهو ما أدى بالتبعية لزيادة مستويات ذكاؤه العاطفي[40]، كما أبرزت نشأته بصفة خاصة إصراره على تحقيق الأهداف التي يضعها أمامه[41].
- التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي والمسار المهني
أظهر بوتين سلوكًا “مثيرًا للشغب لا رائدًا” خلال دراسته بالصف الأول حتى الثامن[42]، بالرغم من هذا لاحظت معلمته فيرا جوريفيتش شخصيته الفريدة وقدراته الكامنة وغير المستغَلة، بالإضافة إلي شغفه باللغات وسرعته في تعلمها، وامتلاكه لذاكرة جيدة وطريقة تفكير مرنة، لذا سعت فيرا لمساعدته ليصبح شخصًا أفضل، وهو ما بدأ بالحدوث بالفعل في الصف السادس، عندما وعى بوتين أنه ليصبح ذا أهمية ومكانة، لن يكفي كونه حذق، بل وجب عليه الاهتمام بدراسته مثلما اهتم بالرياضة[43]، وهو ما دل على تصميم بوتين وذكاؤه الفذ وقدرته على التحليل ووضع الأهداف والطرق المُثلى لتحقيقها.
ظهرت رغبة بوتين بالانضمام لجهاز الاستخبارات منذ صغره، وبعدما عَلِم أن لتحقيق هذه الرغبة، وجب عليه إما الخدمة بالجيش أو إتمام دراسته الجامعية -وحبذا أن تكون دراسة القانون-، بذل بوتين قصارى جهده في المدرسة الثانوية لتحقيق حلمه، وهو ما نجح فيه والتحق بقسم الحقوق لجامعة ليننجراد في عام 1970، ليتخرّج في عام 1975 ومن ثم انضم لجهاز المخابرات الروسي في موسكو (KGB School No.1)[44].
يتضح مما سبق أن هذه المرحلة من حياة بوتين تُظهر مزيجًا من الذكاء الفطري، الإرادة الصلبة، والمرونة النفسيّة، مع تطور تدريجي من شخصية فوضوية إلى شخصية ذات وعي استراتيجي. وهو ما أصبح حجر الأساس فيما بعد لشخصية قيادية ذات طابع حذر، مسيطر[45]، وبراغماتي[46] ستنعكس لاحقًا بوضوح في سلوكه السياسي والأمني.
خدم بوتين لمدة خمسة عشر عامًا كضابط استخبارات خارجية في جهاز المخابرات السوفييتي (اللجنة الأمنية للدولة، المعروفة حاليًا باسم جهاز الأمن الفيدرالي – FSB)، حيث قضى ست سنوات من خدمته المهنية في مدينة دريسدن، ألمانيا. وبعد تقاعده من الجهاز، عاد إلى روسيا ليشغل منصب نائب رئيس جامعة لينينغراد الحكومية، وكان مسؤولًا عن العلاقات الخارجية. وسرعان ما أصبح مستشارًا لعمدة المدينة آنذاك، أناتولي سوبتشاك، حيث تمكن من كسب ثقته بسرعة، واشتهر بقدرته على إنجاز المهام. [47]
وبحلول عام 1994، تمت ترقيته إلى منصب النائب الأول لعمدة المدينة[48] ليبدأ مساره المهني في أَخْذ منحنى مختلف أفضى به إلى أعلى قمة الهرم المؤسسي كرئيس فعلي للبلاد في عام 2000 ليخدم مدتين متتاليتين حتى عام 2008، ونظرًا لنص الدستور الروسي في عدم السماح للرئيس بأكثر من مدتين متتاليتين، تنحّى عن المنصب لخليفته دميتري مدفيدف وتقلّد هو منصب رئيس الوزراء. وأثناء شغله هذا المنصب، ظهرت حِنكة ودهاء بوتين في الوصول لأهدافه حينما قام بتعديل المادة الدستورية الخاصة بمدة حكم الرئيس، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، مما سمح له بالاستمرار لمدتين آخرتين[49].
يرى البعض أن بوتين وجد الاستقرار أثناء عمله في المخابرات السرية، مما ساهم في نجاحه سياسيًا فيما بعد بالرغم مما واجهه من صراعات سياسية، وهو ما انعكس على سياساته الخارجية التي تمحورت حول عدم إظهار الضعف، الموازنة بين الحذر والصبر، التأنّي في اتخاذ القرارات وعدم الاندفاع، النرجسية، علو الهمة، وأخيرًا الذكاء المتقد.[50]
ثانياً: تحليل سمات شخصية فلاديمير بوتين
- الظاهرة البوتينية
تبنّى بوتين استراتيجية روسيّة كبرى؛ تفردت في مصالحها وأهدافها عن ذي قبل، ومن أبرز أسباب تبنّي هذه الاستراتيجية هو ما بعرف بالـظاهرة البوتينية “Putinism”: وهي تعني الدوافع السيكولوجية لبوتين الراغبة في إعادة إحياء الأمجاد القيصرية لروسيا من خلال توحيد صف النخبة الحاكمة، وتسخير كافة الجهود والموارد الروسية لهذا الهدف المُفضي بعودة روسيا إلى منزلتها كقطب فاعل في النسق الدولي، وهو يتطلب صياغة استراتيجية روسية كبرى وشاملة لبلوغه.[51]
ويمكن تعريف البوتينية على أنها: نوع من الحكم الأوتوقراطي (حكم الفرد)، والذي يتسم بالشعبويّة، المحافظة، والطابع الشخصي. وتضع البوتينية الحفاظ على الوضع القائم كأولوية، مع إظهار التحفّز تجاه أي مسببات محتملة لعدم الاستقرار، بالإضافة لاعتمادها على تعيين وفصل المسئولين بناء على ولائهم للحاكم، وقدرتهم على حفظ الأمن واستقرار المجتمع بشكلٍ أساسي[52].
يرى البعض أن بوتين أعاد مركزية أشبه بمركزية حكم الاتحاد السوفييتي، ولكنها جاءت في صورة هرم مؤسسي موحّد ترأسه الإدارة الرئاسية بدلًا من الحزب الشيوعي[53].
مما سبق، تظهر بشكلٍ جليّ سمات كالاستقلالية، الهيمنة، القوة، حسن التخطيط، الانتماء، الرؤية المستقبلية، الاستغلال، الطموح لعودة أمجاد روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي، الحزم والعدوان ضد المعارضة أو أي مخاطر خارجية، بالإضافة إلى الذكاء الفذ والقدرة على اقتناص كافة الفرص.
- الميكافيلية (ثالوث الظلام –Dark Triad ) والبوتينية
تشير الميكافيلية إلى أن القيم الأخلاقية لا تمثل عنصرًا جوهريًا في عملية صنع القرار، إذ ينبغي على القادة التركيز على استخدام السلطة، بل وحتى اللجوء إلى التخويف والخداع من أجل تحقيق أهدافهم[54] اعتمادًا على المبدأ الميكافيلي “الغاية تبرر الوسيلة”[55].
تتلخص الشخصية الميكافيلية في ثلاث سمات أساسية، ندرج تحت كل منها مجموعة من السمات الفرعية، وهم النرجسية (تحتوي على الشعور بالعظمة، سلوكيات تعزيز الأنا، الميل إلى البحث عن الاهتمام والإعجاب)، الاعتلال النفسي تحت الإكلينيكي subclinical psychopathy (تشير إلى قلة الشعور بالندم، عدم الحساسية، الاندفاع) والميكافيلية (الميل إلى استخدام التلاعب والسلوكيات الإستراتيجية).[56]
أجرت دراسة حديثة قامت بمقارنة 14 قائد ذوي ميول أوتوقراطية (حال بوتين، ترامب، أردوغان، نتنياهو وغيرهم) وجدت أن بوتين أحرز نسبة عالية من سمات الشخصية الميكافيلية، فتتمثل كل صفات ثالوث الظلام من نرجسية، الاعتلال النفسي، والميكافيلية في قراراته وكيفية تطبيقه للاستراتيجية الروسية الكبرى لتحقيق طموحه في إعادة الأمجاد الروسية، فنجده لا يتورع عن استخدام أساليب قمعية ومتلاعبة بغيّة تحقيق هذه الأهداف[57].
- تحليل شخصية بوتين استنادًا للسمات الخمس الكبرى
أظهرت نتائج تحليل السمات الشخصية الكبرى (الانبساطExtraversion ، الثبات الانفعاليEmotional Stability ، الانفتاح على التجربةOpenness ، التوافقAgreeableness، والضميرConscientiousness) أن الرئيس فلاديمير بوتين يمتلك نمطًا مميزًا يتوافق مع منهج القيادة السلطوية التي ينتهجها[58].
سجّل بوتين معدلاً مرتفعًا في سمة الانبساطية، وهو ما يعكس قدرته على المبادرة والانخراط في مواقف قيادية تتطلب الحضور والتأثير، وإن كانت هذه الانبساطية مشروطة بالسياق السلطوي لا بالانفتاح الاجتماعي الحر. كما أظهر انخفاضًا ملحوظًا في سمة التوافق، وهو ما يُفسَّر بأسلوبه الصارم والحاد في التعامل مع الخصوم، وعدم انفتاحه لتقبل آراء الآخرين[59].
جاء تقييمه مرتفعًا في سمة الضميرية، بما يعكس مستويات عالية من الانضباط، والدقة، والتنظيم، وهي سمات تتسق مع مرجعيته في جهاز المخابرات. أما على مستوى الثبات الإنفعالي، فقد سجّل بوتين أعلى معدل بين القادة السلطويين الذين شملتهم الدراسة، مما يشير إلى قدرته الكبيرة على التحكّم في انفعالاته، والتصرف بهدوء وحذر حتى في أصعب الظروف. بينما لم يَبرُز بوتين في سمة الانفتاح على التجربة، مما يدل على ميله إلى المحافظة والتمسك بالأنماط التقليدية، وتفضيل تكرار الخبرات السابقة على الابتكار أو المجازفة في القرارات والسياسات[60].
- تحليل شخصية بوتين استنادا لأداة (MIDC) Millon Inventory of Diagnostic Criteria
تشير نتائج التحليل إلى أن بوتين يتميز بنمطين أساسيين وهما؛ الشخصية المهيمنة/المتحكمة (العدوانية) والشخصية الطموحة/الاستغلالية (النرجسية). يتمثل النمط الأول في ميل واضح إلى السيطرة والهيمنة، مصحوبًا بافتقار إلى التعاطف. يُظهر بوتين سلوكًا مهيمنًا، ويميل إلى فرض إرادته على الآخرين بطريقة تُظهر حزمًا صارمًا، بل وأحيانًا عدوانية سافرة. أما النمط الثاني، فيتجلى في سمات نرجسية وأخرى استغلالية، حيث يرى نفسه شخصية فريدة تتطلب اعتراف الآخرين بها، ويستخدم الآخرين كأدوات لتحقيق طموحاته، دون اعتبار كبير للمعايير الأخلاقية أو التحفظات الاجتماعية.[61]
أبرز التحليل وجود سمات ثانوية تتعلق بالنمط الواجباتي أو الضميري (Dutiful)، والذي يعكس التزامًا أخلاقيًا صلبًا وميلاً للكمالية، إلى جانب صفة الانطواء أو العزلة. هذا الطابع الانعزالي يدعم رؤيته لنفسه كمراقب عقلاني، غير متأثر عاطفيًا بما يدور حوله، كما يُفسّر جانبًا من التماسك العاطفي والانضباط السلوكي الذي يميّز شخصيته في المواقف الرسمية[62].
صنفته دراسة سيمونتون 1988 لأنماط الرؤساء (Five-Factor Model of Presidential Styles) ضمن نمط القيادة التداولية (Deliberative leadership)، وهم القادة الأكثر ميلًا لدراسة تبعات قراراتهم بعمق، ورؤية البدائل على المدى البعيد، دون انفعال لحظي[63].
لكنه وفق تصنيف باربر1992 يحمل نمطًا رئاسيًا “نشطًا-سلبيًا” (Active-negative)، أي أنه شديد الانخراط في المهام والمسؤوليات، دون أن يحقق بالضرورة رضاءً شخصيًا داخليًا عنها، بل يستخدم السلطة كوسيلة لتحقيق الذات أكثر من كونها غاية بحد ذاتها.[64]
وأخيرًا أظهرت الدراسة أن بوتين يندرج ضمن ما يُعرف في تصنيفات القيادة بـ”القائد التوسعي” (Expansionist leader) وفق تحليل هيرمان 1987، وهم القادة الذين ينظرون إلى النسق الدولي بوصفه فضاءً تنافسياً، تحكمه صراعات المصالح وتوازن القوة، ويعملون باستمرار على توسيع نفوذهم الإقليمي والدولي. يمتلك هذا النوع من القادة إيمان عميق بقدرتهم على التحكم في مجريات الأحداث، مع اعتمادهم على أسلوب توجيهي صارم في التعامل مع الآخرين، وتفضيلهم الواضح للحلول الأمنية والحاسمة على حساب الأدوات الدبلوماسية أو التوافقية[65]. وقد ظهرت تجليات هذا النمط في سلوك بوتين حيال عدد من القضايا، مثل التدخل في الشيشان، والقرم، وسوريا، وأخيرًا أوكرانيا[66].
- تحليل شخصية بوتين وفقا للهويات الست
يفسر كلٌّ من فيونا هيل وكليفورد غادي شخصية فلاديمير بوتين من خلال ست هويات رئيسية، يُقسمانها إلى مجموعتين. تضم المجموعة الأولى هويات يطلقان عليها مسميات: “رجل الدولةstatist – “، و”رجل التاريخ History man – “، و”الناجي Survivalist – “، وهي تعكس، في رأيهما، منظومة القيم والتصورات التي يتبناها قطاع واسع من الشعب الروسي[67].
يُجسّد بوتين في شخصية “رجل الدولة”، تقليد الدولة القوية المتجذّر في التاريخ السياسي الروسي، فيُقدّم نفسه كشخصية تعلو فوق التنافس السياسي، جاءت لخدمة الدولة بشكلٍ دائم، وتؤمن حصريًا بفكرة الدولة ذاتها. أما في شخصية “رجل التاريخ”، فإنه يستحضر الموروث الروسي والإحساس القومي بعظمة روسيا، كوسيلة لحشد الدعم الشعبي خلف سياساته. ويظهر بوتين في هيئة “الناجي” عندما يُذكّر الروس بأن بلادهم دائمًا ما تواجه تهديدات خارجية مصيرية، وتتعرض لاختبارات مستمرة من قِبَل القدر أو التاريخ أو حتى الإرادة الإلهية، ما يستدعي البقاء في حالة استعداد دائم[68]. في الثقافة السياسية الروسية، لا تُعد هذه الهويات متضادة، بل تدعم بعضها البعض، حيث يستخدمها بوتين بمرونة لتعزيز التأييد لسياساته الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع السلطوي والمركزي، وكذلك لقراراته الخارجية ذات النزعة الإمبريالية والمعادية للولايات المتحدة.[69]
تشمل المجموعة الثانية من الهويات، شخصية “الغريب” (أو الدخيل Outsider-)، و”الليبرالي الاقتصادي Free Marketeer”، و”ضابط الحالة Case Officer – ” (في إشارة إلى عمله الاستخباراتي السابق). وتُعد هوية “الغريب” من أكثر ما يثير الاهتمام في هذا التصنيف، لدورها في زيادة النزعة الاستقلالية والسلوك الفردي لدى بوتين، كما يرى هيل وغادي أن بوتين كان في كل مرحلة من مراحل حياته شخصًا يقع على الهامش: فقد نشأ في لينينغراد بينما كانت السلطة متمركزة في موسكو، وخدم في جهاز الـKGB لكنه عُيّن في ألمانيا الشرقية ثم لينينغراد، لا في قلب المؤسسة أو خارج الكتلة السوفيتية. وعندما انتقل إلى موسكو، كان آتي من “الأقاليم” لا من قلب النخبة[70].
ما زال بوتين، حتى بعد سنوات طويلة في الحكم، قادرًا على استخدام خطاب شعبي وإشارات ثقافية تجعله يبدو كمن هو خارج عن الطبقة السياسية الفاسدة، وهو ما يعزز صورته كقائد شعبي لا يمثل مصالح النخبة، بل يقف على مسافة منها.
خلص المبحث إلى أن السمات السيكولوجية لبوتين، المتأثرة بنشأته السوفييتية وخلفيته الأمنية، شكّلت نمطًا قياديًا حازمًا يميل للمركزية والسلطوية. أظهرت المؤشرات النفسية سمات نرجسية وميكافيلية واضحة. ووفق نموذج السمات الخمس، تبيّن ارتفاع الضميرية والثبات الانفعالي، مقابل انخفاض القبول والانفتاح، ما يعكس شخصية حذرة وأحادية التفكير، بعد التعريف بسمات بوتين السيكولوجية وتحليل شخصيته بمختلف الأدوات سنقوم في المبحث القادم بعرض أثر هذه الخصائص على قرارات بوتين الخارجية وسياساته.
المبحث الثاني
تأثير الخصائص السيكولوجية والشخصية للرئيس فلاديمير بوتين على قرارات السياسة الخارجية الروسية
سنتناول في هذا المبحث أثر السمات الشخصية لبوتين على السياسة الخارجية الروسية، من خلال فهم خلفيته الاستخباراتية وميوله الكاريزمية والميكافيلية. نركّز على كيفية انعكاس رؤيته العقائدية في استجابات روسيا للتحديات الدولية. وبالاستناد إلى نظريات نفسية وسياسية، نبيّن أثر نزعاته القومية والارتيابية في اتخاذ قرارات مصيرية تهدف لاستعادة مكانة روسيا العالمية.
لعبت شخصية القائد داخل النظم السياسية المركزية دورًا محوريًا في توجيه السياسات، خصوصًا الخارجية منها، إذ يُنظر إليها بوصفها أداة تحليل لفهم مسارات صنع القرار، لا سيّما حين ترتبط السلطة بشخص القائد لا بالمؤسسات. هذا الأمر يتجلى بوضوح في حالة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أصبحت شخصيته ذات مرجع لفهم التحولات في السياسة الروسية. فمنذ انتقاله من العمل الاستخباراتي في الـKGB إلى قمة هرم السلطة، تميز بوتين بتجسيده لسمات القيادة الفردية المتكاملة، مما ساعده على صياغة مسار استراتيجي خاص لروسيا في علاقاتها الخارجية والداخلية مع أقرانها بالإضافة لأعدائها في الغرب. وتُظهر النظريات والتحليلات الحديثة أن بوتين يدمج في سلوكه أنماط القيادة الكاريزمية، والتوجيهية، مما يعكس قدرة نادرة على التكيف وفرض النفوذ السياسي بطريقة لا تخلو من الهيمنة والشخصنة.[71]
جسّد الرئيس بوتين، من منظور نظرية السمات (Trait Theory)، ثمانية خصائص رئيسية حددها Stogdill كعلامات على فعالية القائد، وتشمل الذكاء، واليقظة، والبصيرة، والمسؤولية، والمبادرة، والمثابرة، والثقة بالنفس، والقدرة على التواصل الاجتماعي. فقد أثبت بوتين امتلاكه لهذه السمات من خلال قدرته على إعادة صياغة الهيكل المؤسسي الروسي، وتوسيع مجال النفوذ الجيوسياسي لبلاده، وتعامله بواقعية حذرة مع التحديات الداخلية والخارجية. كما تشير تحليلات Northouse وKotter إلى أن بوتين لا يكتفي بالمناورة الإدارية فحسب، بل يبادر بفرض رؤى استراتيجية طويلة الأمد، مُستندًا إلى تصور شخصي لدور روسيا كقوة كبرى يجب أن يُعاد تأكيدها على المسرح الدولي وتعاد أمجادها تيمنًا بحقبة الاتحاد السوفيتي.[72]
أولاً: الاستراتيجية البوتينية الكبرى
يجدر بنا الوقوف عند الفهم النظري العام لما يُعرف بالاستراتيجية البوتينية الكبرى التي توجه السياسة الروسية المعاصرة، قبل التطرق إلى الأزمات التي ساهمت في بلورة ملامح الاستراتيجية الروسية.
تقوم الاستراتيجية البوتينية الكبرى على تحوّل نوعي في طريقة روسيا بتعاطيها مع القضايا الدولية، حيث لم تعد ترتكز على الصراع المباشر أو “السلام السلبي”، بل تبنت فلسفة “روح الفريق” في إدارة العلاقات مع القوى الكبرى، خاصة في القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك. ترتكز هذه الاستراتيجية على التنسيق والتكامل في إدارة الأزمات العالمية بدلًا من المواجهة، مع الحرص على عدم الإضرار بمصالح القوى الأخرى مثل الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تعزيز الأمن الدولي وضمان استقرار النظام العالمي بما يتوافق مع مصالح روسيا.[73]
استخدم الباحثون عدة مداخل تفسيرية رئيسية لفهم هذه الاستراتيجية، منها المدخل الجيوبوليتيكي الذي يرى روسيا كدولة مركزية في قلب أوراسيا (Heartland)، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا مميزًا لتأمين مصالحها عبر توسيع نفوذها الجغرافي والمدخل العسكري يركز على استخدام روسيا للقوة الصلبة للحفاظ على مصالحها، كما في جورجيا وسوريا. أما مدخل الثقافة الاستراتيجية فيفسر السلوك الروسي من خلال البنية الذهنية والتاريخية للنخب السياسية، وخصوصًا رؤية بوتين لدور روسيا العالمي. تنعكس هذه المداخل الثلاثة بوضوح في السلوك السياسي الراهن، لا سيّما في الحرب الأوكرانية المستمرة، والتي تُجسّد التصور البوتيني لدور روسيا كقوة موازنة في النسق الدولي.[74]
تنعكس هذه السمات، في إطار الأزمات والسياسات الخارجية، في قرارات مصيرية مثل الأزمة في جورجيا عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، ثم التدخل العسكري في سوريا عام 2015، تلتها الحرب الشاملة في أوكرانيا التي اندلعت عام 2022، وصولًا إلى حادثة تمرد مجموعة فاغنر في عام 2023. حيث استخدم بوتين عدة أدوات لتنفيذ قراراته في السياسة الخارجية ومنها، الحسم العسكري والخطاب القومي لتعزيز شرعيته. كما يتمتع بوتين بالكاريزما الموجِّهة التي تُبرز صفاته كقائد مؤثر وجذاب، حيث يوظف قدرته على التأثير ليس لتغيير الواقع نحو الأفضل، بل لترسيخ مركزية سلطته حتى على حساب القيم الأخلاقية. ويجسد هذا الانعكاس ما سيتم تناوله وتحليله لاحقًا في هذا المبحث.[75]
ثانياً: تأثير السمات الشخصية لبوتين على سلوكه السياسي الخارجي
تشير النزعة الميكافيلية إلى أن القيم الأخلاقية لا تلعب دورًا في عملية صنع القرار، بل ينبغي على القائد التركيز على استخدام القوة، والخوف، والخداع لتحقيق أهدافه. ويُعد فلاديمير بوتين مثالًا واضحًا على هذه السمات، إذ تتجلى في شخصيته سمات “ثالوث الظلام” كاملة، من النرجسية والميكافيلية إلى السيكوباتية. وقد انعكست هذه السمات في سلوكياته المدمّرة، لا سيما في الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب في سوريا، والنزاعات حول ضم القرم وفي صراعات أخرى غذّتها طموحات نظامه نحو استعادة “العظمة” الروسية. ورغم طابعه التدميري، لا يزال بوتين قائدًا كاريزميًا ذا تأثير واسع.[76]
أوضحHouse أن القادة الكاريزميين أمثال بوتين يجذبون الأتباع عبر الثقة بالنفس، والهيمنة، وخلق هوية أيديولوجية قوية، كما في حالة “البوتينية”، وهي تركيبة سياسية تعكس شخصيته وتُكرّس الولاء الشخصي لا المؤسسي. في هذا السياق، يصبح فهم الشخصية القيادية ضرورة تفسيرية لفهم كيفية اتخاذ القرار السياسي الروسي اليوم، وتفسير الانعطافات الكبرى في علاقات موسكو مع الغرب. [77]
يمكننا الآن الانتقال إلى تحليل الأزمات الكبرى التي واجهتها روسيا خلال عهد الرئيس فلاديمير بوتين، بهدف استكشاف الكيفية التي انعكست بها سماته الشخصية على نمط اتخاذ القرار في السياسة الخارجية خلال تلك الفترات الحرجة.
- أزمة جورجيا (2008):
اندلع صراع مسلح بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008، حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين. بدأت جورجيا العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية، مما دفع روسيا إلى التدخل العسكري السريع، حيث توغلت قواتها داخل الأراضي الجورجية. انتهى النزاع بعد خمسة أيام بوقف إطلاق النار، ولكن روسيا اعترفت باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، مما أدى إلى توتر طويل الأمد في العلاقات بين البلدين.[78]
مثّلت أزمة جورجيا اختبارًا حاسمًا لما يُعرف بـ”البوتينية” في مرحلة ما بعد رئاسة فلاديمير بوتين الأولى، حيث كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء رسميًا كما كانت الأزمة أول اختبار يستكشف موازين القوي في الساحة السوفيتية السابقة، حيث أظهر بوتين قدرته على المناورة السياسية، مستفيدًا من تردد الغرب وخوفه من التصعيد النووي، لترويض جورجيا بالقوة العسكرية وإعادة الهيبة لروسيا الفيدرالية، مؤكدًا استعدادها لفعل أي شيء للحفاظ على نفوذها وأمنها القومي وجوارها القريب.[79]
يُنظر إلى بوتين كصاحب القرار الفعلي في روسيا، ويعكس سلوكه خلال الأزمة سماته الشخصية المرتبطة بالسيطرة المباشرة وعدم التسامح مع ما يعتبره “خيانة” من الدول السوفيتية السابقة، خاصة تلك التي تسعى للانضمام إلى الناتو. تتجلى هنا النزعة الدفاعية والهجومية في آنٍ واحد، والتي تتسم بعقلية الحصار والميل إلى التحرك الاستباقي العنيف.[80]
وبالتالي، فإن سلوك بوتين في جورجيا لم يكن مجرد رد فعل على استفزاز، بل تمثّل في استراتيجية محسوبة تنبع من سماته الشخصية المرتبطة بالحذر، الهيمنة، والاستعداد للمخاطرة وهو ما يتماشى مع شخصيته التي تشكلت في بيئة المخابرات السوفيتية (KGB)، حيث تُعد السرية والانضباط والارتياب من السمات المركزية كما ذكرنا سابقًا.
التدخل أيضًا أظهر ميل بوتين لاستخدام “القوة الخشنة” دون تردد، كأداة لتثبيت النفوذ، مما يؤكد سماته الميكافيلية والسيكوباتية المرتبطة بفرض السيطرة دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو الشرعية الأخلاقية، كما في حالة الحرب في سوريا وأوكرانيا أيضًا.
- ضم شبه جزيرة القرم (2014):
يُعد ضم القرم لحظة فارقة في السياسة الخارجية الروسية المعاصرة، حيث ظهرت بجلاء السمات الشخصية الحاسمة لبوتين، خصوصًا الحذر، النزعة القومية، والميكافيلية السياسية. بوتين اعتبر أوكرانيا منذ البداية جزءًا من المجال الحيوي الروسي، ومع سقوط حكومة يانوكوفيتش الموالية لموسكو، استشعر بوتين تهديدًا مباشرًا لمصالحه الأمنية فتجاهل العقوبات المفروضة وتحدي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، متهمًا إياهم بتجاوز الخط الأحمر. ووقع معاهدة إلحاق القرم بروسيا تصحيحًا لخطأ تاريخي -بناءً على رأيه- ارتكب قبل 60 سنة عندما أهدي خورتشوف أوكرانيا شبه جزيرة القرم.[81]
يعكس هذا التصرف تأثر بوتين بما يُعرف في الأدبيات بـ’البيئة النفسية والسيكولوجية’ للقائد، أي بالصورة الذهنية التي يُكوِّنها للعالم المحيط به. في هذا الإطار، فإن قرار ضم القرم لم ينبثق فقط من معطيات موضوعية، بل من تصورات بوتين عن الغرب كعدو يخطط دائمًا لتطويق روسيا.[82] ويُعزز ذلك الفهم أن قادة روسيا، وفي مقدمتهم بوتين، يعتقدون أنهم يدافعون عن أنفسهم في مواجهة الطموحات الهيمنية للغرب، وخاصة الولايات المتحدة.[83]
كذلك، تعكس هذه الخطوة تأثير سمات “ثالوث الظلام” في شخصية بوتين — النرجسية، السيكوباتية، والميكافيلية — والتي ظهرت في فرض الأمر الواقع بالقوة، دون الاكتراث بالشرعية الدولية.
- التدخل العسكري الروسي في سوريا (2015):
عندما قرر بوتين التدخل عسكريًا لدعم نظام الأسد، كان يتصرف انطلاقًا من منظور استراتيجي طويل الأمد، يعكس سمة الحذر الاستراتيجي والرغبة في إعادة روسيا كفاعل دولي لا يُمكن تجاوزه.[84]
يمكن تحليل تأثير الرئيس بوتين من خلال إبراز أسس عقيدته النظامية المتحكمة بتوجهات السياسة الخارجية لروسيا حيث استبدل مفاهيم الصراع الأيديولوجي بالبراغماتية الواقعية والندية مع الغرب دون قطع علاقات التعاون معه وأكد أن حل الأزمة السورية هو الذي سيحدد شكل النسق الدولي والذي تسعى روسيا إلى تغييره من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب.[85]
يُظهر بوتين، من المنظور السيكولوجي، سمات شخصية تتسم بالبراغماتية الحذرة مقرونة بنزعة سلطوية مستمدة من خلفيته في جهاز الاستخبارات السوفييتي (KGB) ، فإن بوتين يعاني مما يُسمى بـ”عقلية الحصار” (siege mentality)، وهي نزعة سيكولوجية ترى العالم كمكان عدائي يتطلب الحذر الدائم والسيطرة الاستباقية. هذا ما يفسّر سلوكه في سوريا، حيث سعى إلى كسر ما اعتبره تطويقًا غربيًا لروسيا عبر توسيع نفوذه في الشرق الأوسط.[86]
تُظهر تحليلات علم النفس السياسي أن سلوك بوتين في سوريا يُجسِّد ما يُعرف بـ”العدوان الأداتي” (instrumental aggression)، وهو نمط من العدوان المنظّم يُستخدم كأداة لتحقيق أهداف استراتيجية. فالتدخل لم يكن فقط لدعم نظام الأسد، بل جاء أيضًا كاستعراض محسوب للقوة أمام الغرب، خصوصًا بعد تدخل الناتو في ليبيا وسقوط القذافي، الذي اعتبره بوتين خيانة غربية أثّرت على تصورات موسكو للثقة الدولية.[87]
هذا القرار كان أيضًا مبنيًا على تصور نفسي يشمل “الخوف من الانهيار”، كما عبّر عنه بوتين نفسه عندما قال إن انهيار الاتحاد السوفيتي كان “أكبر كارثة جيوسياسية” . من هنا، فإن دعم نظام الأسد لم يكن فقط لحماية المصالح الروسية في المتوسط، بل جزء من تصوره لدور روسيا كموازن عالمي لهيمنة الغرب، وكقوة ضامنة “للنظام” مقابل ما يراه فوضى أمريكية.[88]
- الحرب الروسية في أوكرانيا (2022):
تتجلى الطبيعة التسلطية والعقائدية لبوتين بشكلٍ أوضح، مع تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ووفقًا لدراسة النسق العقيدي لبوتين، فإن رؤيته لنفسه كحامٍ للهوية الروسية وموروث الاتحاد السوفيتي تبرر له الانخراط في صراعات طويلة المدى دفاعًا عن “روسيا الكبرى”.[89]
وبالتالي فإنّ عقل الرئيس الروسي ينظر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا بوصفه “عملية إنقاذ” ومحاولة للمّ شمل العائلة التي تفككت بفعل الفتن والدخلاء، في ظل إصرار قائم لم يتغير على أن كل هذه البلدان المختلفة هي في الواقع “شعب واحد”، كتلة واحدة مصيرها البقاء إلى الأبد في كيان واحد مشترك.[90]
تتقاطع هنا الرؤية الشخصية مع متغيرات بيئية واقعية، مثل توسع حلف الناتو نحو الشرق، ومحاولات أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتصاعد النزعة القومية الأوكرانية بعد ثورة 2014، بالإضافة إلى سقوط النظام الأوكراني الموالي لروسيا وتبنّي كييف خطابًا سياسيًا يُجاهر بالانفصال عن الإرث السوفيتي. هذه المتغيرات مثّلت، في نظر بوتين، تهديدًا مباشرًا للمجال الحيوي الروسي ولمكانة موسكو الإقليمية، إلا أنه غالبًا ما يُغلّب بيئته النفسية الذاتية — التي تتسم بالشك، والانغلاق العقائدي، والإحساس العميق بالإهانة التاريخية من الغرب — على القراءة الموضوعية للواقع، وهو ما يفسر قرارات استراتيجية مكلفة، مثل الهجوم على كييف، رغم الإدراك الدولي لتكلفتها الباهظة.[91]
أظهرت الدراسات التحليلية لشخصية فلاديمير بوتين أن تصعيده العسكري في أوكرانيا يرتكز على سمات قيادية متجذرة فيه مثل الانغلاق العقائدي، والاندفاع نحو السلطة، والإحساس العميق بالمظلومية التاريخية. إذ تشير الدراسات إلى أن بوتين يحمل في تكوينه النفسي إرثًا من جهاز الاستخبارات السوفيتي (KGB)، ما عزز لديه الميل إلى السرية، ورفض التعددية، والشك في الآخر، وهي سمات تُصنف ضمن نمط “الشخصية الدوغمائية” أو المنغلقة إدراكيًا، التي ترى العالم في ثنائيات واضحة بين صديق وعدو.[92]
تُفسر هذه التركيبة المعقدة من السمات الشخصية ميله لتبني مواقف تصعيدية كالغزو العسكري، حيث تتداخل دوافعه النفسية مع حسابات استراتيجية تهدف إلى مقاومة ما يصفه بالاختراق الغربي وإعادة تأكيد السيادة الروسية على ما يعتبره “مجاله الطبيعي”.
ه- حادثة تمرد مجموعة فاغنر(2023):
مثّلت حادثة تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين في يونيو 2023 تطورًا غير مسبوق في تاريخ الحكم الروسي المعاصر، إذ كشف هذا التمرد المسلح عن انقسام داخلي خطير في بنية النظام الروسي بين الدولة الرسمية وقوى غير نظامية مدعومة ضمنيًا من الكرملين. تعاملت روسيا مع الأزمة بحذر تكتيكي، تميز أولًا بتهدئة فورية للأوضاع تجنّبًا لانزلاق داخلي، ثم تبعها تصفية هادئة لرأس التمرد، ما عكس البنية الأمنية الصارمة التي يتحكم بها بوتين.[93]
تعتبر حادثة التمرد من أحد أكثر التحديات حساسية لسلطة فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى الحكم. تكتسب هذه الحادثة دلالة خاصة إذا ما وُضعت ضمن السياق النفسي والسياسي لشخصية بوتين، بوصفه زعيمًا يسعى إلى ترسيخ مركزية السلطة والولاء الشخصي في آنٍ واحد. فقد أظهرت الأزمة صراعًا خفيًا بين اثنين من أهم أركان المنظومة الأمنية الروسية: الدولة الرسمية من جهة، والميليشيات شبه العسكرية ذات الولاء الشخصي من جهة أخري في تعاملها مع الخارج.[94]
برزت شخصية بوتين خلال هذا التمرد في حالة من التوتر بين سماته الميكافيلية المتمثلة في توظيف العنف لأغراض استراتيجية، وبين نزعة التملك الفردي للسلطة، التي ترى في أي تمرد، حتى وإن لم يكن موجهًا ضده مباشرة، تهديدًا وجوديًا للمنظومة بأكملها. فإن بوتين لم يعبّر عن ردة فعل غاضبة فورية فحسب، بل وصف ما حدث بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر”، وهو ما يعكس النزعة الشخصية في تفسير الأزمات السياسية من منظور الولاء الشخصي لا المؤسسي.[95]
في هذا السياق، يُمكن فهم طريقة تعامل بوتين مع التمرد على أنها استعراض دقيق لسماته السيكولوجية: النزوع نحو السيطرة التامة، الارتياب المزمن، ورفض أي تهديد محتمل حتى وإن جاء من حليف سابق. فإن تعامل بوتين مع بريغوجين شابه نوع من الانضباط الاستخباراتي البارد، الذي يسمح مؤقتًا بتفريغ الأزمة من تصعيدها، قبل أن يجري التعامل معها لاحقًا بطرق غير مباشرة.[96]
باختصار، أظهرت أزمة فاغنر هشاشة التوازنات داخل النظام الروسي وخارجه، لكنها في ذات الوقت عكست السمات الشخصية لبوتين في تعامل مع الأزمات من منظور الهيمنة الشخصية، ورفض المساءلة، والرغبة في إعادة ترتيب الولاءات عبر التهديد والاحتواء. وقد أدت لاحقًا إلى إضعاف قوة بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة غامض بعد أشهر قليلة، في سيناريو وصفه العديد من المحللين بأنه “رسالة سياسية” في غاية الوضوح.
تناولنا في هذا المبحث تأثير السمات الشخصية لبوتين في تشكيل السياسة الخارجية الروسية، حيث لعبت خصائصه الفردية دورًا حاسمًا في توجيه السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. فقد استطاع بوتين، من خلال مزيج من النرجسية والحذر الاستخباراتي والعقيدة القومية، فرض نمط قيادي قائم على السيطرة والمبادرة. كما سعي بوتين إلى إعادة تشكيل النسق الدولي بما يتماشى مع طموحات روسيا الجيوسياسية.
سلط هذا الفصل الضوء على الأثر المهم للسمات السيكولوجية في تشكيل القرارات الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين. أظهرت التحليلات أن الميكافيلية والهيمنة والثقة العالية بالنفس تلعب دورًا محوريًا في نمط قيادته. اتّخذ بوتين قرارات استراتيجية انعكست في التدخلات العسكرية والسياسات التوسعية الروسية. كما أكدت النتائج أن شخصيته لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الذي يديره. وساعدت النماذج النفسية المستخدمة في تقديم إطار منهجي لفهم هذا التأثير. في النهاية، بيّن الفصل أن الخصائص الفردية تُمثل عاملاً حاسمًا إلى جانب العوامل المؤسسية والجيوسياسية. ويمهّد هذا الفهم للانتقال إلى تحليل حالة أخرى ممثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما سنستعرضه فيما يلي.
الفصل الثالث
التأثير السيكولوجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صنع القرار الخارجي
تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى الدمج بين المقاربات النفسية والسلوكية لفهم دوافع وسلوكيات القادة السياسيين، مع التركيز على دونالد ترامب كرئيس فريد من نوعه في التاريخ الأمريكي الحديث. كما يتمحور الفصل حول فهم البيئة النفسية والشخصية للقائد لتفسير قراراته في مجال السياسة الخارجية.
يتناول المبحث الأول الخصائص الشخصية لدونالد ترامب من زاوية نفسية، من خلال توظيف نماذج في علم النفس كنموذج السمات الخمس الكبرى، وتصنيف الأمزجة الأربعة، إلى جانب نموذج تحليل سمات القيادة الذي طورته مارجريت هيرمان. ينتقل المبحث الثاني إلى دراسة أثر سمات ترامب النفسية على عملية صنع القرار الخارجي، موضحاً النزعة الحدسية التي تجعل ترامب يعتمد على نمط غير متسق، وثقته المنخفضة بالآخرين والتي تقوده إلى تفضيل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف، ورغبته في السيطرة على الأحداث التي تدفعه إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
المبحث الأول
السمات السيكولوجية والشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يحظى دونالد ترامب باهتمام واسع ليس فقط بسبب مسيرته السياسية غير التقليدية، بل أيضًا بسبب شخصيته المثيرة للجدل. لفهم سلوكه وقراراته من الضروري التعمق في أبعاد شخصيته من منظور نفسي وتحليلي. يتناول هذا المبحث الخلفية الأسرية والنفسية التي ساهمت في تشكيل شخصية ترامب، كما يستعرض السمات السلوكية والقيادية لديه من خلال نماذج تحليل الشخصية الرائدة، مثل السمات الخمس الكبرى، وتصنيف المزاج، ونموذج القيادة لهيرمان.
أولاً: نبذة عن دونالد ترامب ونشأته
دونالد جون ترامب هو رجل أعمال وإعلامي وسياسي أمريكي وُلد في 14 يونيو عام 1946 في مدينة نيويورك. بدأ ترامب انخراطه الجاد في السياسة عام 2015، عندما أعلن ترشحه رسمياً عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية. فاز ترامب في الانتخابات عام 2016، وشغل منصب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين خلال الفترة من 2017 حتى عام 2021. ثم أُعيد انتخابه في عام 2024، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.[97] كما يعتبر ترامب أول شخص يُنتخب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يتمتع بأي خبرة حكومية أو عسكرية.[98]
تستلزم محاولة فهم الخصائص السيكولوجية لدونالد ترامب التعرف على البيئة التي نشأ فيها، إذ وُلد كابن رابع من بين خمسة أبناء لفريد ترامب وماري آن ماكلويد، وقد أثّرت نشأته – في بيئة تتسم بالبرود العاطفي والإهمال الأسري – على تكوين شخصيته؛ فقد كانت والدته تعاني من المرض في طفولته المبكرة، مما أدى إلى غياب الحنان والرعاية، بينما كان والده صارمًا ومنشغلًا في أعماله، مما جعله قليل التفاعل مع أطفاله.[99]
ترى ماري ترامب، ابنة أخ دونالد ترامب، أن ترامب تعرّض لما يمكن اعتباره شكلاً من الإساءة في طفولته (Child Abuse). ففي مرحلة مفصلية من تطوّر شخصيته، عانى من الإهمال العاطفي من والديه؛ إذ كانت والدته شبه غائبة بسبب مرضها المتكرر، بينما اتّسم والده بالصرامة والجمود العاطفي. ونتيجة لذلك، لم تُلبَّ احتياجات ترامب النفسية في طفولته، مما انعكس لاحقًا في سمات شخصيته مثل القلق الداخلي، وعدم قدرته على تنظيم عواطفه، والحاجة المستمرة للتقدير. كما تبنى سلوكيات سلبية مثل التنمر والعدوانية.[100]
وصفت ماري ترامب والد ترامب بأنه كان مصاباً باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (sociopath) وأعراضه تشمل انعدام التعاطف، والقدرة على الكذب دون الشعور بالذنب، وعدم الاكتراث بالقيم الأخلاقية، بالإضافة إلى سلوكيات عدوانية وتجاهل تام لحقوق الغير.[101]
أثّر والد ترامب بشكلٍ بالغ في تشكيل ملامح شخصيته، لا سيّما من حيث تشجيعه على التنافسية المفرطة بين أبنائه واعتماده أسلوبًا تربويًا صارمًا. فقد وجّه الأب معظم اهتمامه وتوقعاته العالية نحو الابن الأكبر، فريد جونيور، الذي لم يتمكن من تلبية طموحاته، ما جعله عِرضه لانتقادات متكررة وإهانات مستمرة، وهي أساليب اعتاد الأب اللجوء إليها عند فشله. وفي هذا السياق، سعى دونالد ترامب جاهدًا لاجتذاب انتباه والده، وحاول تعويض فشل شقيقه ليأخذ مكانه في نظر أبيه. وقد ترك هذا الأسلوب التربوي أثرًا عميقًا في شخصية ترامب، إذ تبنّى سلوكيات مماثلة، مثل السعي القهري للنجاح، ورفض الاعتراف بالفشل، واستخدام الإهانة كوسيلة للسيطرة والتفوّق.[102]
تزعم ماري إلى أن نجاح دونالد ترامب لم يكن نتيجة لجهوده الذاتية، بل اعتمد بدرجة كبيرة على الدعم المتواصل من والده، الذي حرص دائمًا على إحاطته بأشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة، مما ساهم في تعزيز شعوره بالنجاح الزائف. هذا الدعم المتواصل أدّى إلى ترسيخ شعور العظمة لديه، وزيّف تصوّره للواقع، مما عزّز سلوكه النرجسي وميله للكذب.[103]
ثانياً: تحليل سمات شخصية دونالد ترامب
- نظرية الأمزجة وعلاقتها بتحليل شخصية ترامب
ننتقل بعد تناول نشأة ترامب وتأثيرها على شخصيته إلى بعض الأدوات الأخرى لتحليل الشخصية مثل المزاج، فيعتبر المزاج في علم النفس هو جانب من جوانب الشخصية يتعلق بالميول والانفعالات العاطفية من حيث طبيعتها وحدتها. وغالباً ما يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الحالة المزاجية العامة للفرد. ويُصنف المزاج إلى أربعة أنواع (Four Temperaments) وهي: المزاج الدموي، ويتميز بالحيوية والانفتاح؛ والمزاج الصفراوي، ويتميز بالحزم والنشاط والحدة؛ والمزاج السوداوي، الذي يتصف بالعمق والتفكير والتشاؤم أحياناً؛ والمزاج البلغمي، المعروف بالهدوء والاتزان والبطء في الاستجابة.[104]
يُصنف دونالد ترامب أنه مثال واضح للشخصية الصفراوية.[105](Choleric personality) وتتصف الشخصية الصفراوية بسرعة الانفعال والغضب وحدة المزاج والصلابة والعناد والقوة والثقة بالنفس، وتكون الشخصية الصفراوية مُسيطرة، وقيادية، وتميل إلى اتخاذ القرارات السريعة.[106] وهذه الصفات يمكن ملاحظتها في سلوك ترامب نظراً لما يظهره من سمات قيادية حادة والثقة الكبيرة في اتخاذ قرارته ورغبته القوية في السيطرة.
- تحليل شخصية ترامب استنادًا للسمات الخمس الكبرى
نستعرض بعد ذلك نموذج السمات الخمس الكبرى للشخصية (Big Five Personality Traits) الذي يُستخدم في تحليل الشخصية وفهم العلاقة بين الشخصية والسلوك. وتعتبر العوامل الخمس الكبرى للشخصية “نظام متكامل من السمات الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية الثابتة نسبياً والتي تميز الفرد عن غيره وتحدد أسلوب تعامله وتفاعله مع الاخرين وأيضاً مع البيئة الاجتماعية والمادية المحيطة به”.[107]
تُعرَف السمات الخمس الكبرى للشخصية ويُمكن توضيحها من خلال الآتي:[108]
- العصابية (Neuroticism): يتصف الأفراد ذو الدرجة المرتفعة من هذه السمة بالميل إلى القلق والاكتئاب وانعدام الثقة بالنفس وغيرها من المشاعر السلبية، في حين يتمتع منخفضو الدرجة باستقرار انفعالي يُمكّنهم من مواجهة الضغوط بشكلٍ أكثر فاعلية.
- الانفتاح (Openness) : يُجسّد هذا البُعد ميلاً إلى الفضول واكتساب التجارب الجديدة، مع رغبة في التجديد والابتكار والتعبير الصريح عن الانفعالات، في حين يعكس الطرف المقابل منه ميلاً إلى التحفّظ، وقلة الاهتمامات، والتمسك بالأنماط التقليدية.
- الانبساط (Extraversion) : يشير إلى الاجتماعية، الثقة بالنفس، حُب للقيادة والسيطرة، التفاؤل، والبحث عن الإثارة. أما الطرف الآخر من هذا البُعد فيتّسم بالميل إلى الانطواء والشعور بالارتياح في العزلة.
- القبول (agreeableness) : يشير هذا البُعد إلى التفاعلات الاجتماعية الإيجابية، مثل اللطف، والود، والتعاطف مع الآخرين، والمبادرة إلى تقديم المساعدة. ويقابله في الطرف الآخر الفظاظة، والشك، وقلة التعاون والتفاعل الاجتماعي.
- يقظة الضمير (conscientiousness): يشمل هذا البُعد النزاهة، الإرادة القوية، والدافعية للإنجاز والالتزام بالقواعد والانضباط، ويقابله على النقيض اللامبالاة وغياب الجدية.
يتواجد في كل شخص درجات متباينة من هذه السمات الخمس فلا يتصف الشخص بسمة واحدة فقط ولكن يتمتع بمزيج متباين من هذه السمات. ويتباين درجات حدية هذه السمات من شخص لآخر.
استخدم دان ماكآدامز السمات الخمس الكبرى للشخصية في تحليل شخصية دونالد ترامب فوصفه بأنه يتمتع بدرجة مرتفعة من الانبساط ودرجة منخفضة من القبول وهاتان تُعتبران السمتين الرئيسيتين الطاغيتين على شخصية ترامب. لكن ذلك لا ينفي هيمنة السمات الثلاث الأخرى في تفسير جوانب شخصيته، ولكن يتفاوت وجودهم لديه بدرجات مختلفة. كما يتجلى وصف ترامب بارتفاع الانبساط في سلوكه الذي يتمثل في سعيه لجذب الانتباه والظهور المستمر في الأوساط الاجتماعية، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على القبول الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك، يتمتع ترامب بالتفكير الإيجابي، الذي يجعله قادر على اتخاذ قرارات جريئة والمجازفة والميل إلى التهور والعفوية.[109]
ويرى ماكآدامز أن ترامب يمتلك مستوى بالغ الانخفاض في سمة القبول، وذلك يتضح في تفاعلاته مع الأشخاص طوال حياته. ويظهر ذلك في قسوته في التعامل مع الآخرين وعدم مبالاته بمشاعرهم، وتعجرفه وافتقاره إلى التعاطف مع الاخرين. وتدليلاً على ذلك، قام دونالد ترامب في تجمع انتخابي عام 2015 بالسخرية من الصحفي سيرج كوفاليسكي، الذي يعاني من إعاقة، من خلال تقليد حركته وصوته. جاء ذلك كرد فعل على مقال ناقد كتبه الصحفي قبل 14 عامًا.[110]
منح ماكآدامز ترامب درجة متوسطة في سمة العصابية، إذ إنه لا يعاني من القلق أو الاكتئاب، لكنه يتسم بتقلبات عاطفية ويجد صعوبة في ضبط انفعالاته، خصوصًا الغضب. أما بالنسبة لسمة الانفتاح فهي تعتبر منخفضة نسبياً لدى ترامب، فهو لا يميل إلى حب الاستطلاع كما أنه شخص شديد التعلّق بعاداته ومقاوم للتغيير، إلا أنه خلال فترة رئاسته لم يلتزم بالضوابط والسلوكيات التقليدية المرتبطة بمنصبه، وانتهج أسلوب تفكير غير تقليدي. وأخيراً سمة يقظة الضمير، يعتبر ترامب تصنيفه متوسط يميل نحو الطرف المنخفض، مع كون ترامب مجتهد في عمله ومصر على تحقيق النجاح، لكنه غير منضبط ويتصرف دائماً بقواعده الخاصة.[111]
- السمات الرئيسية في شخصية ترامب
ننتقل الآن إلى تحليل سمة محورية في شخصية ترامب، وهي النرجسية. ومن خلال قراءتنا، نرى أنه من غير الأخلاقي ولا المسؤول أن نُشخّص ترامب باضطراب الشخصية النرجسية (Narcissistic Personality Disorder)، إذ إن مثل هذا التشخيص يتطلب موافقته وخضوعه لتقييم من قِبل طبيب نفسي مختص. ومع ذلك، يمكن فهم سلوكه وتحليل جوانب من شخصيته من خلال السمات المرتبطة بهذا النوع من الشخصية.[112]
تُعرّف الجمعية الأمريكية لعلم النفس الشخصية النرجسية بأنها “نمط من السمات والسلوكيات يتميز بالاهتمام المفرط بالذات والمبالغة في تقدير الذات”.[113] ومن بعض سمات الشخصية النرجسية، الغرور والشعور بالعظمة، كما يرى صاحب الشخصية النرجسية نفسه استثنائي ومتميز عن الآخرين، لديه رغبة قوية في الحصول على الإعجاب المستمر، الافتقار إلى التعاطف، كما أن تصرفاته تتسم بالغطرسة والاستعلاء.[114]
تتضح نرجسية ترامب في حديثه المتواصل عن نفسه في مختلف السياقات وتمجيده الدائم لقدراته ونجاحه وذكائه وتفخيمه الزائد عن حده لإنجازاته ورغبته المستمرة في نيل الإعجاب والقبول من الجماهير. وللتدليل على ذلك، نستعرض بعض المواقف التي تبرز سمات شخصية ترامب، ومنها: أولاً، حرصه على ربط اسمه بعدد كبير ومتنوع من المنتجات والمشاريع، مثل Trump Tower في نيويورك. ثانيًا، تصريحه بعد شهر فقط من توليه الرئاسة بأن إدارته قد تكون الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة، وبأن رئاسته أنجزت ما لم تحققه أي إدارة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة. ثالثًا، سعيه الدائم إلى الظهور الإعلامي من خلال إثارة الجدل، واتباع سلوكيات استثنائية، واتخاذ مواقف غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. رابعًا، ميله إلى إحاطة نفسه بأشخاص يفتقرون للنقد، ويؤيدون قراراته دون اعتراض أو تشكيك.[115]
يصف دان ماكآدامز دونالد ترامب بأنه “رجل حدسي” (Episodic Man)، وهو ما يعني أن ترامب يتعامل مع الأحداث كلٌ على حدة كحلقات منفصلة دون ربطها بسياق زمني أو استراتيجي طويل الأمد. هذا يجعل من الصعب التنبؤ بأي تصرفات أو قرارات يتخذها.[116]
يتبنى ترامب نظرة للحياة مشابهة بما جاء به الفيلسوف توماس هوبز في القرن السابع عشر، حيث ينظر للحياة كصراع دائم يسوده الفوضى، وأن الإنسان مدفوع بالجشع والأنانية وأنه أشرس الحيوانات على الإطلاق وبالتالي، تكون الاستراتيجية هي المبادرة بالهجوم وبقوة. تمامًا كما في مفهوم توماس هوبز عن “حرب الجميع ضد الجميع”، وبالتالي فالحياة سلسلة من المعارك تنتهي إما بالنصر أو بالهزيمة.[117]
وانطلاقاً من نظرة ترامب الهوبزية وكونه رجل حدسي، فإن ترامب يستبيح كل الوسائل وينتهز جميع الفرص لينتصر في المعركة التي يخوضها. وهذا المنطق يجعله بلا منظور أخلاقي ثابت ونتيجة لذلك يظهر ترامب سلوكاً متكرراً من الكذب المزمن، ولكنه قد يلجأ إلى الحقيقة إن كانت ستساعده في الانتصار. مثالاً على كذبه المزمن، ففي الساعات الأولى لتولّيه الرئاسة، قدّم ترامب أولى تصريحاته الزائفة، عندما أعلن أن الحشد الذي حضر حفل تنصيبه هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. هذا الادعاء جاء رغم وجود أدلة واضحة تُظهر عكس ذلك؛ إذ بيّنت الصور الجوية أن عدد الحاضرين كان أقل بكثير من الحشد الذي شارك في تنصيب باراك أوباما عام 2009. ما يثير الانتباه هنا هو أن ترامب لم يتردد في إنكار حقيقة لا تقبل الجدل، حتى عندما كانت الأدلة المادية أمام الجميع.[118]
د- استخدام نموذج تحليل سمات القيادة لتحليل شخصية ترامب
ختاماً نستعرض نموذج تحليل سمات القيادة الذي استخدمته مارغريت هيرمان (Margaret Hermann) في تحليل السمات لتقييم أسلوب القيادة (Leadership Trait Analysis LTA)، يعتمد هذا الأسلوب على تحليل محتوى خطابات القادة ومقابلاتهم بهدف تقييم سماتهم الشخصية، وقد تبيّن أن هناك سبع سمات تُعد ذات فائدة خاصة في تحليل أسلوب القيادة ،وهم:[119]
- الإيمان بإمكانية التأثير في الأحداث أو السيطرة عليها. (Belief in the ability to control events)
- الحاجة إلى القوة والنفوذ. (Need for power)
- التعقيد المفاهيمي (Conceptual Complexity).
- الثقة بالنفس. (Self-confidence)
- الميل إلى التركيز على حل المشكلات وإنجاز الأمور مقابل الحفاظ على الجماعة والتعامل مع أفكار ومشاعر الآخرين. (Task orientation vs relationship orientation)
- انعدام الثقة العام أو الشك في الآخرين. (Distrust of others)
- شدة التحيز تجاه الجماعة التي ينتمي إليها الشخص. (In-group bias)
تُعرف هيرمان أنماط القيادة على أنها “الطرق التي يتعامل بها القادة مع من حولهم — سواء كانوا من المؤيدين أو المستشارين أو من القادة الآخرين — وكيفية تنظيمهم للتفاعلات والمعايير والقواعد والمبادئ التي يستخدمونها لتوجيه تلك التفاعلات”.[120] وبناءً على تصنيف أنماط القيادة التي وضعتها هيرمان يمكن أن يندرج ترامب تحت نمط القيادة “التوسعي”، والذي يتصف بانخفاض التعقيد المفاهيمي، وارتفاع الحاجة إلى القوة، ووجود قدر كبير من عدم الثقة بالآخرين، وانحياز واضح تجاه الجماعة التي ينتمي إليها.[121]
حصل ترامب على درجة أعلى من متوسط رؤساء الولايات المتحدة في سمة التحيز للجماعة. وترتبط هذه السمة بالنزعة القومية والسلوك العدواني تجاه أي تهديدات محتملة. هذا التفكير يعكس نظرة للعالم تقوم على فكرة (نحن في مواجهة الغير) “us vs them”. القادة الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من هذا التحيّز غالباً ما يرون السياسة العالمية كلعبة محصلتها صفر (zero-sum game)، حيث يرى أن مكاسب الدول الأخرى هي خسائر لأمريكا.[122]
حصل ترامب أيضًا من ناحية عدم الثقة بالآخرين على مستوى مرتفع للغاية مقارنة بمتوسط رؤساء الولايات المتحدة والقادة العالميين الآخرين. والقادة الذين يسجلون درجات عالية في هذا المؤشر يكونون على الأخص حذرين من أولئك الذين يتبنون أيديولوجيات مختلفة، حيث يتم تفسير أي تصرف يصدر منهم على أنه يحمل دوافع خفية تتجاوز ما هو مُعلَن.[123]
ترتفع لدى ترامب الحاجة إلى القوة والنفوذ بدرجة فوق المتوسط. تشير هذه السمة إلى رغبة القائد في ترسيخ أو الحفاظ على سلطته، كما تعكس رغبته في التأثير على الآخرين أو التحكم بهم. عندما يكون القائد لديه رغبة قوية للسلطة، فإنه يسعى للتلاعب بالبيئة المحيطة به ليظهر نفسه منتصراً. وغالبًا ما يتسم بالميكافيلية، حيث يحرصون على تفوق مكانتهم ومصالحهم. وأخيراً، يتسم ترامب بمستوى منخفض من التعقيد المفاهيمي. تقوم هذه السمة بقياس مدى التمييز الذي يُظهره الفرد عند تفسير الأشخاص، أو السياسات، أو الأفكار، أو الأحداث. فالقادة ذو الدرجات المنخفضة، أمثال ترامب، يميلون إلى الاعتماد على حدسهم، واختيار الخيار الأول المتاح، ويفضلون اتخاذ قرارات أو أفعال سريعة عن البحث عن معلومات أو التخطيط أو التفكير المتعمق.[124]
نستنتج من ذلك أن شخصية دونالد ترامب تتسم بتركيبة نفسية معقدة تعود جذورها إلى بيئة طفولته الصارمة والخالية من الدعم العاطفي، مما أدى إلى تكوين سلوكيات نرجسية وسعي دائم للقبول والسيطرة.
أظهر تحليلنا أن ترامب يتمتع بدرجة عالية من الانبساط وانخفاض في القبول، وأن ترامب ينتمي إلى نمط القيادة “التوسعي” الذي يتسم بارتفاع الحاجة إلى النفوذ، وعدم الثقة بالآخرين، والانحياز الشديد للجماعة. كما تؤكد هذه النتائج أن شخصية ترامب تؤثر بشكلٍ مباشر في طريقة ممارسته للسلطة واتخاذه للقرارات.
المبحث الثاني
تأثير الخصائص السيكولوجية والشخصية للرئيس ترامب على عملية صنع القرار الخارجي
يتناول هذا المبحث تأثير السمات السيكولوجية لترامب – مثل النزعة الحدسية، وانخفاض الثقة بالآخرين، والإيمان بالسيطرة الكاملة على الأحداث – على طريقة صنعه للقرار الخارجي، واستعراض كيف انعكست هذه السمات على انسحاباته المتكررة من الاتفاقيات الدولية، وتفضيله للصفقات الثنائية، بالإضافة إلى شعاره المركزي “أمريكا أولاً” الذي غيَر ملامح دور الولايات المتحدة في النسق الدولي.
تلعب الخصائص النفسية والشخصية لقادة الدول في عالم السياسة الدولية، دورًا محوريًا في توجيه القرارات المصيرية، لا سيّما في مجال السياسة الخارجية الذي يعكس توجهات الدولة ومصالحها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة مثيرة للاهتمام تتطلب التحليل، نظرًا لأسلوبه غير التقليدي في القيادة، وقراراته المفاجئة التي كثيرًا ما أثارت الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أولاً: تأثير نمط “الصفقة” وسمات القيادة لترامب على سياسته الخارجية
تمثل “الصفقة” نمطًا معرفيًا أساسيًا في علاقات ترامب مع الدول الأخرى، وهو نمط ذهني يحدد كيفية رؤيته للعالم وميله إلى تبني اتجاهات في السياسة الخارجية على نمط الصفقات التجارية Transactional) (Foreign Policy. كما تعود جذور هذا النمط إلى خلفيته المهنية كرجل أعمال، حيث تبنى ترامب في تعامله مع الآخرين مبدأ الربح والخسارة، حيث عبر أنه ينظر لكل شيء حوله كصفقة.[125]
استمر ترامب في تبني هذا النهج في تعامله مع الدول الأخرى، معتبرًا أن القضايا العالمية يمكن حلها من خلال عقد الصفقات بدلاً من بناء تحالفات طويلة الأمد أو الاستثمار في العلاقات الاستراتيجية. وقد دفعه هذا التصور إلى اعتبار الاتفاقيات الدولية التزامات غير ملزمة دائمًا، ولا تستوجب الامتثال التام لها، بل اتفاقيات مؤقتة قابلة لإعادة التفاوض أو الإلغاء أو الانسحاب حينما يرى أنها لا تحقق المصالح الأمريكية.[126]
أشرنا من قبل أن ترامب يُوصف بأنه “رجل حدسي” يعتمد على رؤيته اللحظية للأحداث، وينظر إلى العلاقات بوصفها سلسلة من الحلقات المنفصلة، دون رؤية شاملة أو استراتيجية متسقة على المدى البعيد. ونتيجة لهذه النظرة، اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى في عهد ترامب بقدر كبير من عدم الاتساق والابتعاد عن العلاقات التقليدية المعتادة بينهم. بناءً على ذلك، ركز ترامب خلال رئاسته على تحقيق مكاسب سريعة وأهداف قصيرة المدى، حيث تعامل مع الدول كما لو كانت أطرافًا في صفقة تنتهي بمجرد تحقيق المصالح.[127]
أدى هذا النمط إلى سياسة خارجية نتج عنها الانسحاب من الاتفاقيات الدولية، مثل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية كاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “النافتا”، وتدهور العلاقات الأمريكية مع العديد من حلفائها التقليديين بشكلٍ كبير حال اليابان والاتحاد الأوروبي.[128]
توصل الباحثون بعد تحليل سمات ترامب القيادية إلى أنه يتسم بدرجة عالية من الإيمان بإمكانية السيطرة على الأحداث، إلى جانب مستوى كبير من عدم الثقة بالآخرين. هذه السمات تؤثر على سياسته الخارجية حيث تجعله يُفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف، إذ يرى في الاتفاقيات الثنائية مرونة أكبر، بما يتيح له مجالاً أوسع للتحكم في الطرف الآخر وبنود الاتفاقية، لا سيّما عندما يكون هو الطرف الأقوى فيها.[129]
ينتج عن ذلك اتساق السياسة الخارجية لترامب في تبنّي موقف معادٍ للاتفاقيات الدولية. فإيمان ترامب بقوة إمكانية سيطرته على الأحداث يعزز اعتقاده أنه دائماً الشخص الأقدر لصياغة بنود الاتفاقية أو “الصفقة” -كما يسميها ترامب – لتحقيق أكثر مكاسب ممكنة لأمريكا. ويؤثر عدم ثقته بالآخرين في رؤيته أن هذه الاتفاقيات غير مشروعة ويفترض دائمًا سعي الدول الأخرى إلى استغلال دولته. ونتيجة لارتفاع مستوى هاتين السمتين لدى ترامب، فانه يتّسم بسلوك يتحدى القيود كما يسعى دائماً للتحرر من الاتفاقيات باستخدام جميع الوسائل الممكنة، ويرى الاتفاقيات الدولية معيبة إذ الالتزام بها يعيق الدولة من تحقيق أكثر استفادة لها.[130]
نَتَج عن هذه السمات، انسحاب ترامب من عدة اتفاقيات مثل: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران.
- اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (Trans-Pacific Partnership T.T.P)
انسحب منها ترامب في يناير عام 2017 – وهي اتفاقية تجارية كانت تربط الولايات المتحدة ببعض من دول أسيا والأمريكتين وقارة أستراليا – لأنه كان يراها بمثابة صفقة غير مجدية للولايات المتحدة بالإضافة لرغبته في محاولة السيطرة بشكلٍ أكبر على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الدول الأخرى. وهذا يُرينا ترامب كقائد ذا اعتقاد دائم بأن جميع الدول تسعى إلى استغلال الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار على الرغم من رفض العديد من الجهات السياسية الفاعلة الأخرى داخل الولايات المتحدة وأطراف الاتفاقية.[131]
- اتفاقية باريس للمناخ (Paris Agreement)
انسحب منها ترامب في يونيو عام 2017 وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث انبعاثات الكربون. جاء قرار الانسحاب لاعتقاد ترامب أن الدول الأخرى تحاول إضعاف حكومته وتقيد حرية بلاده في رسم مصيرها الاقتصادي المتمركز حول الكربون. بالرغم من سماح الاتفاقية لأطرافها بتعديل معدل الانبعاثات، تمسك ترامب بقراره ولم يكترث بوجود تداعيات سياسية من أطراف الاتفاقية لهذا الانسحاب. [132]
- اتفاقية إيران النووية (Iran Nuclear Deal)
صرح ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المعروفة باتفاقية إيران النووية (Iran Nuclear Deal) في مايو عام 2018 – التي فرضت قيوداً عديدة على البرنامج النووي الإيراني- لاعتقاده أنه أجدر بالوصول لاتفاق أفضل، ولرؤيته أن الأطراف الذين أبرموا الاتفاقية أقل جدارة، إضافةً إلى إصراره على عدم احترام إيران لبنود الاتفاقية على الرغم من تأكيد وكالات الاستخبارات الأمريكية بعدم خرق إيران للاتفاقية. اتخذ ترامب قرار الانسحاب، رغم معارضة الأطراف الأخرى الموقعة عليها، بالإضافة إلى وجود معارضة داخل إدارته نفسها، حيث دعا بعض المسؤولين إلى عدم الانسحاب من الاتفاقية.[133]
يتعين الإشارة أن في المثال السابق رفض ترامب لتصديق معلومات وكالات الاستخبارات الأمريكية يوضح انخفاض سمة الانفتاح -التي سبق الإشارة لها في المبحث الأول- من خلال رفضه لتقبل معلومات تخالف معتقداته. ودليلاً على ذلك أعلن مسؤولو الاستخبارات المكلفون باطلاع ترامب على المعلومات الاستخباراتية والتقارير الأمنية أنه لا يتقبل أي معلومات مخالفة لرؤيته للعالم.[134]
ثانياً: تأثير رؤية ترامب للعالم على سياسته وشعار “أمريكا أولاً”
أظهرت عدة دراسات كيف أثرت معتقدات ترامب ورؤيته للعالم في صياغة سياسته الخارجية. وكما أشرنا في المبحث الأول عن تبني ترامب لنظرة توماس هوبز المتشائمة للعالم التي ترى الحياة كصراع دائم وجب الانتصار في معاركها للبقاء، هذا الذي دفعه لاحقًا لاتخاذ سياسة شبه انعزالية تتمحور حول مبدأ “أمريكا أولاً” والذي تتعلق بالحماية التجارية والأحادية (protectionism and unilateralism) ، حيث جعل من تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية نقطة الانطلاق الرئيسية في صياغة قراراته الخارجية. وهذا يمثل تحولاً عن السياسات الخارجية التقليدية للولايات المتحدة، التي كانت تسعى دائمًا إلى تشجيع العولمة، والترابط الاقتصادي، والتدخل في شؤون الدول الأخرى بهدف نشر الديمقراطية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.[135]
كانت قرارات ترامب تحت سياسة “أمريكا أولًا” محورية في تحديد مواقفه في سياسته الخارجية، وشكّل الاتساق المعرفي دورًا رئيسيًا في ذلك. كما أوضحنا في الفصل الأول، يميل العقل إلى تجاهل المعلومات المتعارضة مع معتقداته وتضخيم ما يتماشى معها، مما يعزز الاعتماد على الصور النمطية لتفسير العالم.[136] بالنسبة لترامب، كانت صورته عن المسلمين والمهاجرين واللاجئين مدفوعة بهذه الصور النمطية التي تصوّرهم كتهديدات للأمن القومي الأمريكي.
تجلّى ذلك في اعتقاد ترامب بأن جميع المسلمين يُشكلون تهديدًا إرهابيًا، وأن المهاجرين القادمين من دول أخرى يمثلون خطرًا على الأمن القومي الأمريكي. فقد عمد إلى الربط بين المسلمين والإرهاب، وبين المهاجرين والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، إذ وصف المهاجرين من المكسيك بالمجرمين، ورأى أن عددًا كبيرًا من الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة “مدانون” أو “متورطون” في أنشطة إرهابية. كما اعتقد أن المهاجرين يسعون للاستحواذ على وظائف الأمريكيين، واستغلال قوانين الهجرة لأهداف خبيثة، واعتبر اللاجئين والمهاجرين القادمين من مناطق النزاع، كالعراق وسوريا، تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.[137]
استغل ترامب في إطار شعار “أمريكا أولًا”، هذه القناعات المعرفية لتبرير سلسلة من السياسات التي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من هذه التهديدات، فاتخذ عدة قرارات كوقف قبول اللاجئين مؤقتًا وحظر دخول الأشخاص من سبع دول ذات أغلبية مسلمة في عام 2017، وهي العراق، وسوريا، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن[138]. بالإضافة إلى قراراه عام 2017 ببناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين وتهريب المخدرات، وإعلان سياسة ال” لا تسامح ” (zero tolerance) التي تتضمن اعتقال المهاجرين غير النظاميين وأطفالهم قبل ترحيلهم قسريًا إلى بلادهم.[139]
يندرج أيضاً تحت شعار “أمريكا أولا” التشكيك المستمر لأهمية حلف شمال الأطلسي “الناتو” للولايات المتحدة، حيث زعم ترامب أن دولته تتحمل العبء العسكري والمالي الأكبر مقارنةً بدول الناتو الأخرى ويرى أن دول الناتو تقوم باستغلال الولايات المتحدة. ويشير ترامب إلى تخاذل دول الحلف في المشاركة المتناسبة في الميزانية ويرى أن أهمية الناتو تضاءلت من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وتوطيداً لموقفه، قرر ترامب سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا نتيجة لعدم وفاء ألمانيا في التزاماتها المالية في ميزانية الناتو.[140]
يعتبر التشكيك في الناتو فكرة ليست جديدة على الرؤساء الأمريكيين، حيث عبروا عن قلقهم منذ الستينيات حيال حلف الناتو. لكن ترامب كان أول رئيس يهاجم قادة الدول الأعضاء في الحلف، فقد تساءل علنًا عن جدوى استمرار الحلف وتردد في تأكيد التزامه بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تلتزم فيها الدول الأعضاء بالدفاع المتبادل.[141]
تجلت الآثار الاقتصادية لسياسة “أمريكا أولا” في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. بدأت الحرب التجارية في عام 2018 بعد توقيع دونالد ترامب على قرار فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25%، على مجموعة من السلع الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية. ومن جانب الصين، واتباعًا لسياسة المعاملة بالمثل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا رسميًا أعلنت فيه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على أكثر من 500 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ واصلت الولايات المتحدة والصين تبادل فرض العقوبات الجمركية بشكلٍ متتالٍ.[142]
تجددت الحرب التجارية في ولاية ترامب الثانية حين أعلن في نوفمبر عام 2024، أنه ينوي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 60% على معظم الواردات الأمريكية الصينية، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات المكسيك وكندا للولايات المتحدة،.[143] وبالفعل قام ترامب في أبريل عام 2025 بالإعلان عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، رافعًا الرسوم إلى 145% على السلع الصينية، وقد اعتُبر هذا القرار خطوة لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية. وردًا على ذلك، فرضت الحكومة الصينية تعريفات جمركية بنسبة 125% على مجموعة واسعة من الصادرات الأمريكية.[144]
يميل ترامب إلى تفضيل الاتفاقيات الثنائية، بدلاً من المشاركة في الاتفاقيات متعددة الأطراف، وهو ما يعكس نمط قيادته القائم على المعاملات (transactions). فبدلاً من تشكيل تحالفات دولية لمواجهة الصين، يتجه إلى فرض تعريفات جمركية من جانب واحد لتحقيق ما يعتبره “انتصارًا”، بما يتوافق مع رؤيته لنفسه كمفاوض قوي لا يقدّم التنازلات.[145]
توصّلنا من خلال ما عرضنا إلى أن دونالد ترامب يتّبع أسلوباً اندفاعياً وشخصياً في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، يبتعد فيه عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الاتساق، التنبؤ، والعملية المؤسسية. فهو يفضّل اتخاذ القرارات بناءً على حدسه وتفاعلاته الشخصية مع القادة الآخرين، ويتجاهل أحياناً المعلومات غير المتفقة مع معتقداته أو آراء الخبراء والمؤسسات.[146]
يتضح هذا الأسلوب في قراره المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا في19 ديسمبر عام 2018، والذي جاء بدون تحضير مسبق أو تنسيق مع الحلفاء، وحتى دون إخطار كبار المسؤولين في إدارته. وكانت القوات الأمريكية قد تدخلت في سوريا منذ عام 2014 في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وللحد من نفوذ إيران وروسيا في المنطقة. قرار الانسحاب فجأة يبرز أسلوب ترامب الذي يُقدّم رأيه الشخصي على أي عملية مؤسساتية، ما أحدث صدمة بين الحلفاء وأربك السياسة الأمريكية في المنطقة.[147]
أظهر تحليل الخصائص النفسية للرئيس ترامب أن شخصيته لعبت دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تبنّى نهجًا براغماتي قائمًا على مبدأ “الصفقة” وتفضيل الاتفاقيات الثنائية. وتجلّت تأثيرات سماته النفسية في قرارات مفاجئة وأحادية الجانب، ناتجة عن اعتماده على حدسه، انعدام الثقة بالأخرين، ورغبته في السيطرة.
توصل هذا الفصل إلى أن السياسة الخارجية لترامب لم تكن مجرد انعكاس لمصالح الدولة، بل كانت ترجمة واضحة لمعتقداته الشخصية، وإدراكه للعالم من حوله. كما أن طفولته القاسية أسهمت في بروز سمات مثل النرجسية، وحب السيطرة، والانفعالية. أظهر نموذج المزاج أن ترامب يمتلك شخصية صفراوية حازمة، وكشفت السمات الخمس الكبرى عن ارتفاع سمة الانبساط وانخفاض سمة القبول لديه، فيما صنفه نموذج هيرمان كقائد توسعي يسعى للنفوذ ولا يثق بالآخرين. انعكست هذه الصفات في رؤيته التشاؤمية للعالم ونهجه شبه الانعزالي، متبنّيًا شعار “أمريكا أولاً”. كما فضّل الاتفاقيات الثنائية وانسحب من معاهدات كبرى. ساهم الاتساق المعرفي في دعمه لصور نمطية، فأقر سياسات معادية للهجرة. كما شكك في فاعلية الناتو بنبرة عدائية غير مسبوقة.
وبناءًا على ما تعرّضنا له على مدار الفصلين السابقين من تعريف بالسمات السيكولوجية لكلًا من بوتين وترامب، وأثر تلك الصفات على قراراتهما وسياساتهما الخارجية، استهدفنا في الفصل القادم تحليل التفاعل بين كلا الرئيسين مع بعضهما البعض وفي العلاقات الدولية بصفة عامة في إطار ما ميزناه من صفات وخصائص مؤثرة في مواقفهم ورؤيتهم للأمور.
الفصل الرابع
تأثير التفاعل بين السمات السيكولوجية لكل من ترامب وبوتين على العلاقات الدولية
تمهيد
لم يكن النظر إلى أفعال الدول وتحليلها باعتبارها امتدادًا لأفعال ومشاعر قادتها اتجاهًا جديدًا أو مستحدثًا، فقد بنى مفكرون مثل أفلاطون وهوبز وغيرهما نظرياتهم السياسية على الصلة بين الطبيعة البشرية وأفعال الدول السياسية. فيقول هارولد تشابمان براون: “منذ أقدم تقاليدنا الفلسفية، كان يُفهم شكل الدولة دائمًا على أنه نتيجة للطبيعة البشرية”. وكما تناولنا حتى الآن في بحثنا، يكون للطباع والتصورات والعواطف والسمات النفسية الأخرى المختلفة تأثير عميق على كيفية صنع رؤساء الدول لقراراتهم الخارجية، كما يتضح في حالتي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وكما تؤثر السمات النفسية على القرارات الخارجية للدول، فإنها تؤثر بالتالي على العلاقات التي تربط الدول ببعضها البعض على المستوى الدولي.
تؤثر العوامل السيكولوجية لكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في قراراتهما الخارجية، مما ينعكس على العلاقات الدولية بطريقتين رئيسيتين: أولًا، على العلاقات الأمريكية الروسية، وثانياً، على العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى وعلى النسق الدولي بشكلٍ عام. يهدف هذا الفصل إلى معالجة وتحليل كيفية تأثير العوامل السيكولوجية للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العلاقات الدولية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ببعضهما، من حيث الاتجاه نحو العلاقات الثنائية والطبيعة المعاملاتية، وبالدول الأخرى، ما بين الاتجاهات الاقتصادية أو العسكرية والتداعيات المنعكسة على النسق الدولي.
أولاً: تأثير العوامل السيكولوجية على العلاقات الأمريكية الروسية:
بناءً على ما تناوله هذا البحث، تنعكس السمات السيكولوجية لكل من بوتين وترامب على قراراتهم وسياساتهم الخارجية بشكلٍ كبير، ومن ثم فهي تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل نمط العلاقات الأمريكية الروسية. ويشكل هذا النمط نوعًا من الانحراف عن المسار التقليدي للعلاقات بين “الدب الروسي” و”العم سام”، والذي في الغالب يقوم على المنافسة الحادة وفترات من العداء الصريح، حيث شهدت ولايتي ترامب حالة من التحسن النسبي في العلاقات بين الدولتين، وهو ما يمكن إرجاعه إلى بعض العوامل السيكولوجية.[148]
عندما أصبح دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في يناير عام 2017، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في حالة تدهور[149]، حيث كان لدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون نظرة سلبية تجاه الكرملين [150]، وكانت العلاقات الأمريكية الروسية في حالة مستمرة من الاستقرار[151]. ولكن مع بداية عهد ترامب، شعر بوتين بالتفاؤل بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحًا ذلك من خلال تصريحاته أثناء مؤتمر صحفي مشترك في هلسنكي عام 2018، زاعمًا أنه كان يتمنى فوز ترامب بالرئاسة، ومؤكدًا على ضرورة تطوير وتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين.[152]
يَرجع هذا التركيز على العلاقات الثنائية (Bilateral relations) إلى أول عامل سيكولوجي مؤثر، وهو النزعة الفردية وعدم الثقة في النسق الدولي. يشترك الرئيسان من حيث بنيتهما السيكولوجية في نزعة فردية قوية، وتترجم هذه النزعة الفردية إلى موقف “بلدي أولًا”[153] في السياسة الخارجية، حيث يُنظر إلى النسق الدولي ومنظماته على أنها قيدٌ، وإلى قيمه والمبادئ التي يفرضها على أنها منافقات غربية ومعايير غير واقعية[154]. عبَّر كل من الرئيسين عن عدم ثقتهم في النسق الدولي، حيث اتَّهَم الرئيس بوتين الغرب، والمنظمات الدولية التي يهيمن عليها، بالنفاق أكثر من مرة،[155] كما جاوب ترامب على سؤال حول كون الرئيس بوتين “قاتل” قائلًا: “لدينا الكثير من القتلة… هل تعتقد أن بلدنا بريء؟”[156]
أدت عدم الثقة في النسق الدولي إلى اعتماد العلاقات الروسية الأمريكية بشكلٍ كبير على العلاقات الثنائية، حيث يتم أغلب التواصل بين الزعيمين من خلال المكالمات الهاتفية الخاصة والاجتماعات الثنائية خارج أي إطار مؤسسي. على سبيل المثال، أثناء حضور الرئيسين لقمة ال “G20” في هامبورج عام 2017، قاموا بعقد اجتماع ثنائي خاص خارج إطار القمة.[157]
تُظهر المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعتمد بشكلٍ كبير على المفاوضات الثنائية (مثل تلك التي تم عقدها في المملكة العربية السعودية في شهر مارس عام 2025)، والمكالمات الشخصية بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين،[158] استمرار الولايات المتحدة وروسيا في الاعتماد على هذا النمط من العلاقات أكثر من نمط محادثات السلام الجماعية الذي كان سائدًا منذ بداية الحرب، مثل زيارة الوفد الأفريقي لأوكرانيا[159] أو قمة “السلام في أوكرانيا” التي استضافتها سويسرا وشاركت فيها الولايات المتحدة أثناء فترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن[160].
تُعدّ رؤية دونالد ترامب ‘المعاملاتية’ (Transactional) في إدارة العلاقات مع الدول الأخرى من السمات السيكولوجية التي أثّرت بشكلٍ مهم في العلاقات الروسية-الأمريكية، حيث يركز ترامب بشكلٍ كبير على العلاقات الدولية من منظور المنفعة، وهو ما يجعله غير متمسك بالمواقف الأمريكية المبنية على “المبادئ” أو “القيم” – مثل المساعدات المالية للدول النامية أو التدخلات العسكرية بحجة الدفاع عن الحرية أو السيادة أو حقوق الإنسان[161]. ويؤكد على ذلك بروس جينتلسون (أستاذ العلوم السياسية الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما) قائلًا: “الدبلوماسية في بعض جوانبها مُعاملاتية، ولكن دونالد ترامب مُعَاملاتي بطريقة لا ترتكز على ما هو أفضل للمصالح الأمريكية، بل على ما هو جيد لدونالد ترامب شخصيًا…” ويضيف “لم يُعجِب الرؤساء الذين عملت معهم مصطلح “المعاملاتية”، لأنه يبدو خاليًا من القيم، وهو ما يجعل دونالد ترامب مختلفًا تمامًا عن أي رئيس آخر.”[162]
يَنعَكس ذلك بشكلٍ كبير في التحسن الواضح في العلاقات الأمريكية الروسية، وتغيير الموقف الأمريكي تجاه القضية الأوكرانية منذ بداية ولاية ترامب الثانية، إذ خَلت معظم تصريحات ترامب الخاصة بأوكرانيا من أي التزام بمبادئ الدفاع عن السيادة أو الضمانات الأمنية التي تكاثرت أثناء حكم بايدن[163]، كما خَلت تصريحاته أيضاً من الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي تجاه بوتين، رغم من انتشار هذه الاتهامات في الرأي العام الأمريكي والجهات الحكومية الأمريكية ومن قِبَل بعض المنظمات الدولية [164].
ثانياً: تأثير العوامل السيكولوجية على علاقات كل من الولايات المتحدة وروسيا مع الدول الأخرى:
لا يقتصر تأثير هذه العوامل السيكولوجية على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل – بطبيعة الحال- تنعكس شخصيتيّ كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على العلاقات الدولية التي تربط دولتيهما بباقي الدول.
تنعكس النَزعة الفَرديّة المُشتركة بين الرئيسين، والتي – كما سبق أن ذكرنا – أدّت إلى تفضيل العلاقات الأمريكيّة الروسيّة الثُنائيّة، على العلاقات مع الدول الأخرى. في حالة الولايات المتحدة، تتم غالبية تعاملات ترامب الخارجية في شكل تعاملات أو “صفقات” ثنائية[165] [166] . كما دفع انعدام ثقة ترامب في النسق الدولي إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس مرتين (أولًا في عام 2017 ثم في عام 2025)[167]، وانسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) ، والانسحاب الأمريكي المُحتمل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” (UNESCO).[168] أدّى تراجع النفوذ الأمريكي في النسق الدولي إلى ظهور فجوة بين الولايات المتحدة والعديد من حلفائها التقليديين في غرب أوروبا.[169]
أدّى هذا التوجه، إلى جانب الرؤية المعاملاتية (وهي العامل السيكولوجي الثاني)، إلى إنهاء ترامب للعُرف الأمريكي في المساعدات الخارجية، والذي كان قائمًا على أساس الدوافع الأيديولوجية. وبدلًا من هذا، تقوم منهجية ترامب على منح المساعدات بشكلٍ استراتيجي للحلفاء المفيدين مقابل عوائد مجزية، وهو ما نتج عنه تقليص المساعدات الخارجية الأمريكية. ويظهر تأثير ترامب في تشكيل هذه السياسة في ديباجة تصريحات البيت الأبيض بشأن هذا الصدد، والتي نصت على الآتي:” تنص سياسة الولايات المتحدة على عدم صرف أي مساعدات خارجية أمريكية أخرى بطريقة لا تتوافق تمامًا مع السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة.”[170]
شكلت تخفيضات ترامب القاسية والمتزايدة للمساعدات الخارجية الأمريكية مصدر قلق متزايد للعديد من الدول والمنظمات الدولية المعتمدة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه السياسات قد ترتب عليها تداعيات سلبية تؤثر على علاقات الولايات المتحدة مع عدد من الدول النامية والمنظمات الدولية، كما قد تضيف بعداً جديداً في المنافسة الأمريكية الصينية، حيث بدأت الصين في محاولة سد الثغرة التي تركتها تلك المساعدات الأمريكية. [171]
تبنّى بوتين، بدلاً من الانسحاب التام من المنظمات، موقفًا متشككًا من النسق الدولي والمنظمات التي يهيمن عليها الغرب، ما شجّع توجّه روسيا نحو منظمات دولية منافسة تركز على الشرق، وأبرز مثال على ذلك هو الدور القيادي لروسيا في منظمة البريكس[172] (BRICS). ومن المهم الاشارة إلى أن انتقادات الرئيس بوتين هي ليست انتقادات لفكرة نسق دولي أو منظمات دولية، لكن هي انتقاد للنسق الدولي الأحادي التابع للهيمنة الغربية، حيث يتجسد أحد أهم اهتمامات بوتين من حيث السياسة الخارجية في استرجاع مكان روسيا كقطب مسيطر في النسق الدولي.[173]
تؤثر المسيرات المهنية المختلفة لكل من بوتين وترامب، إلى جانب النزعة الفردية والعوامل السيكولوجية الأخرى، على تركيباتهم السيكولوجية، حيث شكلت لديهما تفضيلات وطباع مختلفة ومن ثم أثرت بشكلٍ كبير على طريقة اتخاذهما للقرارات وإدارة السياسة الخارجية.
تُشكّل خلفية ترامب كرجل أعمال جزءاً كبيراً من كيفية إدارته للعلاقات الخارجية. وكما ذُكر سابقاً، يتبنى الرئيس الأمريكي رؤية معاملاتية للعلاقات الخارجية، تركز بشكلٍ كبير على المنافع المادية بدلاً من الأيديولوجية، وتتعامل مع العلاقات الدولية بنهج الصفقات التجارية. من أبرز الأمثلة على ذلك هو موقف ترامب تجاه العلاقات الأمريكية مع أوكرانيا فيما عرف بـ”صفقة المعادن الأوكرانية” [174]، وتمثل هذه محاولة من ترامب لتحويل علاقة الاعتماد الأحادي إلى علاقة استثمارية تحقق مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة.
يظهر ميل ترامب نحو إدارة علاقاته الخارجية على نهج الصفقات التجارية أيضاً في علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على صفقات أسلحة ضخمة[175]، حيث تُقدَر قيمة أحدث صفقة مقترحة بحوالي 100 مليار دولار[176]. وكما يستخدم ترامب الأدوات الاقتصادية لترسيخ العلاقات الخارجية الأمريكية، إلا أنه أيضاً يستخدمها كأسلوب للضغط واستعراض القوة، كحالة سلسلة التعريفات الباهظة التي فرضها ترامب على عدد من الدول، أبرزهم الصين- التي اعتبرت هذه التعريفات خطوة جديدة في الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة.[177]
تنعكس خلفية بوتين في الجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات على اعتماده بشكلٍ كبير على الأدوات العسكرية في السياسة الخارجية[178]، مما أدى إلى التوسع العسكري الروسي وتدخل روسيا عسكريًا في أكثر من دولة- أبرزهم سوريا وأوكرانيا. [179] كما أثر التدخل العسكري الروسي في كل من الدولتين على علاقات روسيا مع عدد من دول الشرق الأوسط والغرب.[180] ولا يعتمد بوتين على الجيش كأداة لتحقيق الأهداف الخارجية فقط، بل أيضاً كأداة لاستعراض القوة من خلال انتشار القواعد العسكرية الروسية في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا[181]. يشير دليل آخر لانحياز بوتين السيكولوجي تجاه الجهات الأمنية والعسكرية نتيجة لخلفيته، وانحيازه للجيش الذي يلعب دورًا مؤثرًا في السياسية الخارجية الروسية، وتكوين النخبة السياسية المؤثرة في السياسة الخارجية من أشخاص ذو خلفيات أمنية وعسكرية.[182]
تُعد النزعة “الدعائية” والأسلوب غير الرسمي سمة سيكولوجية بارزة لدى الرئيس ترامب، وقد شكّلت عاملاً مهماً في توجيه قراراته في السياسة الخارجية وفي طبيعة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بالدول الأخرى. تعتمد جميع الشخصيات السياسية على الدعاية للحفاظ على تأييدهم بين الشعب، لكن ما يجعل نهج دعاية ترامب فريد من نوعه هو أنه بدلاً من الاعتماد على شبكات الإعلام والاتصال الحكومية الرسمية لتشكيل صورته العامة، فإنه غالباً ما يعتمد على وسائل الإعلام الخاصة (مثل قناة فوكس نيوز)[183]، كما يعتمد ترامب أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به للإعلان عن آرائه حول مختلف القضايا السياسية الخارجية، مستخدمًا أسلوب شخصي وغير رسمي نادراً ما نراه في بيانات القادة الآخرين.[184]
ينتج عن هذا الأسلوب الشخصي وغير الرسمي المزج بين المواقف الرسمية للولايات المتحدة والآراء الشخصية لدونالد ترامب حتى يصعب الفصل بينهما، وهو ما يعطي انطباع قوي بأن السياسة الخارجية الأمريكية هي انعكاس كامل لآراء الرئيس دون وجود أي إطار رسمي أو مؤسسي. قد تصعب هذه الحالة من عدم الفصل بين ما هو رسمي وما هو شخصي، هو القيام بالعمل الدبلوماسي، حيث يوضح لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع السابق خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان: “إذا كنت من دولة أ أو ب ولدي قضايا مهمة أريد مناقشتها مع الولايات المتحدة، فهل سأولي أي اهتمام للسفير الأمريكي أو رئيس البعثة عندما أعلم أن الرئيس يضع سياسته الخاصة؟”[185]
يتّضح من خلال هذا الفصل أن العوامل السيكولوجية والشخصية لكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتوجيه علاقات دولتيهما، سواء على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا أو على المستوى الدولي الأوسع. فقد أظهرت النزعة الفردية المشتركة، وعدم الثقة في النسق الدولي، والرؤية المعاملاتية للسياسة الخارجية، إضافة إلى الخلفيات المهنية المختلفة، كيف أن القادة لا يتصرفون فقط من منطلق مؤسسي أو استراتيجي بحت، بل يتأثرون أيضًا بشكلٍ مباشر بتركيبتهم النفسية وتجاربهم الشخصية.
كما يُعدّ التحوّل نحو العلاقات الثنائية، وتراجع الالتزام بالمبادئ الدولية، واعتماد أدوات غير تقليدية في إدارة العلاقات الدولية، جميعها انعكاسات مباشرة لهذه العوامل النفسية. وبهذا، يمكن القول إن فهم السياسة الخارجية في حقبة ترامب وبوتين لا يكتمل دون تحليل الأبعاد السيكولوجية التي تُشكّل قراراتهما، وهو ما يؤكد على الأهمية المتزايدة لدراسة القيادة السياسية من منظور نفسي لفهم ديناميكيات العلاقات الدولية المعاصرة وتأثيرها على بنية النسق الدولي.
الخاتمة
سعى هذا البحث إلى معالجة دور الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية في عملية صنع القرار الخارجي، مع اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدراستي حالة. تطلب ذلك عرض مفهوم عملية صنع القرار الخارجي وأهم الخصائص السيكولوجية للقيادة السياسية وكيفية تأثيرها على صانع القرار. كما استدعى ذلك عرض وتحليل الخصائص السيكولوجية لكل من الرئيسين ترامب وبوتين وأثارها على صنع القرار الخارجي الأمريكي والروسي، وانعكاساتها على العلاقات الأمريكية الروسية وعلى العلاقات الدولية بشكلٍ عام.
استند هذا البحث إلى المنهج الاستقرائي ومدخل صنع القرار والمدخل السيكولوجي لعرض موضوعه والوصول إلى نتائج موضوعية بصدد تأثير الخصائص السيكولوجية على صنع القرار الخارجي، كما تطلب الأمر تقسيم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة. تناول الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي، حيث ركز على تعريف المفاهيم الأساسية المرتبطة بعملية صنع القرار في السياسة الخارجية، والخصائص السيكولوجية المختلفة ودورها في عملية صنع القرار الخارجي. تمحور الفصل الثاني حول أولى حالتي الدراسة وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عرض أهم خصائصه الشخصية من حيث تصنيفاتها وتكوينها على مدار خلفيته الشخصية والمهنية، ودورها في تشكيل القرارات الخارجية الروسية – بالتحديد في بعض أهم المواقف والأزمات. ركز الفصل الثالث على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع عرض خصائصه السيكولوجية استناداً إلى نماذج وتصنيفات نفسية مختلفة، وأثار تلك السمات على القرارات الخارجية التي يتخذها. كما تطرق الفصل الرابع إلى تأثير العوامل السيكولوجية لكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على العلاقات الأمريكية الروسية والعلاقات الدولية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالدول الأخرى.
وخلص البحث إلى العديد من النتائج، لعل من أبرزها:
- تتكون عملية صنع القرار من مراحل متعددة، ولا تعد عملية “معزولة”، بل تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة، منها عوامل خارجية وهيكلية، وأخرى بيئية وشخصية. وتهدف عملية صنع القرار في السياسة الخارجية إلى تحقيق أهداف دولية يحددها صانع القرار، وقد يشارك فيها هيئات متعددة، سواء أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات، منها هيئات حكومية وأخرى غير حكومية. كما يختلف دور هذه الهيئات مع اختلاف طبيعة النظام السياسي من دولة إلى أخرى.
- تعد الخصائص السيكولوجية للقادة من أهم العوامل في تفسير وتحليل قرارات السياسة الخارجية، حيث تؤثر السمات الشخصية المختلفة والعناصر النفسية الأخرى من المشاعر، والتصورات، والمعتقدات، والقيم، على كيفية إدراك القادة للمواقف وتفسيرهم لها. ولا تنبع القرارات من حسابات عقلانية منطقية وحسب، بل تتأثر أيضًا بالبيئة النفسية المحيطة بالقائد، مثل الانحيازات المعرفية والرموز الذهنية. لذا، يُعد فهم البعد النفسي ضروريًا لتحليل سلوك القادة على الساحة الدولية.
- تؤثر خلفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية والمهنية على سماته السيكولوجية، حيث تؤثر نشأته وخلفية والده في الجيش الروسي على ميوله العسكرية، كما يشكل انهيار الاتحاد السوفيتي نقطة محورية في عقلية بوتين، حيث ساعدت على تشكيل “الظاهرة البوتينية” والنهج الأوتوقراطي في حكمه. كما تنعكس ممارسة بوتين للجودو في حياته الشخصية على سماته السياسية، لا سيما صفات الالتزام والعناد ورؤيته للعلاقات الدولية على أنها محصلة صفرية. شكلت مسيرة بوتين المهنية في جهاز المخابرات الروسي والمناصب العامة المختلفة سماته كقائد سياسي، منها عدم الانفعال، والحذر، وعدم إظهار الضعف.
- يظهر بوتين سمات عديدة من سمات الشخصية الميكيافيلية، منها عدم اهتمامه بالقيم في عمله السياسي واستخدامه للأساليب القمعية. كما يشير تحليل السمات الخمسة الكبرى إلى تسجيل بوتين نسبة عالية من سمات الانبساط والثبات الإنفعالي، ونسبة منخفضة من سمات التوافق والانفتاح. تخلص تحليلات أخرى إلى امتلاك بوتين نمطيّ الشخصية المهيمنة والشخصية الطموحة، وهو ما ينعكس على سلوكه السياسي الصارم والنرجسي. كما يصنف بوتين من خلال الهويات الرئيسية الست على أنه قائد ذو نزعة استقلالية ونمط حكم سلطوي.
- تظهر سمات بوتين الشخصية في إطار السياسات الخارجية الروسية والأزمات العديدة التي واجهتها روسيا على مدار عقود حكمه، لا سيما أزمة جورجيا عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، والتدخل العسكري في سوريا عام 2015، وبداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، وحادثة تمرد مجموعة فاغنر في عام 2023. ينتج عن النزعة الميكافيلية في بوتين تجاهل القيم الأخلاقية في عملية صنع القرار الروسي، مع تركيزه على استخدام القوة والأساليب غير الأخلاقية لتحقيق الأهداف، كما يتضح في حالة الحرب الروسية الأوكرانية والتوسع العسكري في سوريا، وقضية ضم القرم.
- تلعب نشأة دونالد ترامب وأسرته دور مهم في تشكيل سمات شخصيته، حيث كان لوالديه وطفولته أثر واضح على تشكيل البيئة السيكولوجية لترامب وترسيخ سمات مثل النرجسية، والشعور بالعظمة، واللجوء للكذب.
- يصنف ترامب من بين أربع أنواع المزاج على أنه ذو “المزاج الصفراوي”، حيث يتصف بسرعة الانفعال والغضب، والثقة بالنفس، والعناد، كما يصنف حسب نموذج السمات الخمس الكبرى للشخصية على أنه يتمتع بدرجة مرتفعة من “الانبساط” (وينعكس ذلك في رغبته لجذب الانتباه والظهور المستمر في الأوساط الاجتماعية) ودرجة منخفضة من سمة “القبول”، والتي تؤثر على تعامله مع الأخرين. ومن حيث نموذج تحليل السمات لتقييم أسلوب القيادة، ينتمي ترامب إلى نمط القيادة “التوسعي” الذي يتسم بعدم الثقة بالآخرين والفردية، وبارتفاع الحاجة إلى النفوذ، والانحياز الشديد للجماعة.
- يمثل نمط “الصفقة” عامل أساسي في علاقات ترامب مع الدول الأخرى، وهو نمط ذهني يحدد كيفية رؤيته للعالم وميله إلى تبني اتجاهات على نمط الصفقات التجارية ومبدأ الربح والخسارة في السياسة الخارجية، ويعود هذا النمط إلى خلفيته المهنية كرجل أعمال. وذلك الى جانب امتلك ترامب نزعة حدسية، حيث ينظر إلى العلاقات بصفتها سلسلة من الحلقات المنفصلة، دون رؤية شاملة أو استراتيجية متسقة على المدى البعيد. وينتج عن تلك النظرة، اتسام علاقات الولايات المتحدة الخارجية بعدم الاتساق، ويركز ترامب في سياسته الخارجية على تحقيق مكاسب سريعة وأهداف قصيرة المدى، كما لو كانت العلاقات الدولية صفقات. كما يتسم ترامب بدرجة عالية من عدم الثقة بالأخرين، مما يجعله يفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف، مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات الدولية متعددة.
- تنعكس العوامل السيكولوجية لكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على العلاقات الأمريكية الروسية، وعلى العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى. أدى اشتراك الرئيسين في نزعة فردية إلى اتجاه العلاقات الأمريكية الروسية نحو نمط العلاقات الثنائية خارج إطار المنظمات الدولية، وتلعب عوامل سيكولوجية اخرى مثل نمط الصفقة أو “المعاملاتية” دور في تحسن العلاقات الأمريكية الروسية على مدار ولايتيّ ترامب. تنعكس السمات الشخصية المكتسبة من المسيرات المهنية لكل رئيس على العلاقات الدولية التي تربط دولته بباقي الدول، وأدوات السياسة الخارجية المستخدمة لإدارة تلك العلاقات، حيث تنعكس خلفية ترامب كرجل أعمال في اعتماده على الأدوات الاقتصادية في السياسة الخارجية، وينتج عن خلفية بوتين الأمنية توسع روسيا عسكريا واعتماده على الوسائل العسكرية لتحقيق أهدافه الخارجية.
يشير البحث إلى أنه ثمة تأثير لا يمكن إغفاله للخصائص السيكولوجية للرئيسي بوتين وترامب على استراتيجيتي الدولتي ( الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) لاعتبارهما أكبر دولتي في العالم، الأمر الذي يؤشر بأن تلك الخصائص لهذين الرئيسين قد تؤثر على طبيعية التفاعلات بالبيئة الدولية على النحو الذي يؤدي إلى التحول في النسق الدولي على نحو يتسع لكافة الدول الكبري، لا سيّما الصاعدة والتي من بينها روسيا.
قائمة المراجع
اولا: مراجع اللغة العربية:
- الكتب:
- عبد الجواد بكر، “السياسات التعليمية وصنع القرار” الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003)
- عبد العزيز صالح بن حبتور، “أصول ومبادئ الإدارة العامـة” )عمان: الـدار العلمية، 2000(
- الدوريات العلمية:
- أسماء عبدالمولى حسين علي، “سيكولوجية القادة وتأثيرها على صنع القرار في السياسة الأمريكية -دراسة مقارنة- (باراك أوباما- دونالد ترامب)”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد. المجلد 20 ، العدد 19، (2023)، ص 83-102
- اسيا جامعة عين شمس، العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للطلاب المتفوقين والمتأخرين أكاديميا من المرحلة الثانوية، مجلة الخدمة النفسية، مجلد 10 عدد 1. (2017) ص10-32.
- حنان أحمد عبد الله علي، “معوقات صنع القرار واتخاذه لدى مديري مدارس التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية (دراسة ميدانية)” – مستخلص بحث من رسالة ماجستير، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية. العدد 11، الجزء الخامس، (2017)، ص 193-233
- عادل عنتر على زعلوك، “الاستراتيجية الروسية الكبرى في عهد بوتن: دراسة في الدوافع والخصائص والمداخل”، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 22، عدد 4، جامعة بورسعيد، (2021)، ص 324-359
- فادي عبد الغني الأحمر، “السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية”، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد 49، عدد 4، (2021)، ص 77-108
- محمد رشيد، تأثير العامل السيكولوجي على صانع القرار السياسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجًا، مجلة ريحان للنشر العلمي، العدد 25، (2022) ص 128-154 .
- مروة خليل محمد، دور القيادة السياسية في تحديد مضمون المصلحة القومية: جورباتشوف وبوتين كدراسة حالة، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد 21، (2024)، ص269-310.
- مها بنت ناصر بن عائض النهاري، السمات الشخصية الخمس الكبار وعلاقتها بأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة (دراسة استكشافية)، المجلة الدولية للتعليم بالإنترنت، المجلد 19، العدد 1، (2020)، ص109-124.
- ندي شوقي عبد اللطيف، أسامة محمود عبد الرحيم، أميرة عبد العاطي، “سيكولوجية القيادة السياسية وأثرها على صنع القرار الخارجي قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالحرب على أوكرانيا 2022 “نموذجًا”، المركز الديمقراطي العربي، (٢٠٢٤)
- الرسائل العلمية:
- آلاء محمد محسن، دور القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية الرئيس فلاديمير بوتين نموذجًا (رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، 2015)
- ليلى أحمد السيد إبراهيم، السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية بين عهدي أوباما وترامب “دراسة تقويمية مقارنة” (رسالة ماجستير، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2020)
- المصادر الالكترونية:
- “عملية صنع القرار”، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأمم المتحدة (ESCWA).، شوهد في:9/4/2025، متاح على: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/1.
- ابتهال مبروك، “عملية صنع القرار الخارجي – Foreign Decision making process”، الموسوعة السياسيّة، 2020-12-02، شوهد في: 2025-04-10، متاح على: https://political–encyclopedia.org/dictionary/عملية صنع القرار الخارجي
- عزة هاشم، قراءة نفسية: كيف يُفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،17/04/2022، شوهد في 1/5/2025، متاح على: https://ecss.com.eg/19147/.
- مروة جابر وهشام حمدي، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في ظل ولاية ترامب الجديدة، السياسة الدولية، 13/1/2025، شُوهد في 28/4/2025 . متاح على: https://www.siyassa.org.eg/News/21932.aspx .
Secondly: English References:
- Books:
- Alex Mintz & Karl DeRouen, “Understanding Foreign Policy Decision Making” (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
- Christer Pursiainen and Tuomas Forsberg. The Psychology of Foreign Policy (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021)
- Clifford G. Gaddy, and Fiona Hill, Mr. Putin: Operative in the Kremlin (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2015(
- Dan P. McAdams, The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning, (United States of America: Oxford University Press,2020)
- Duygu Dersan Orhan et al, Research Anthology on Social Media’s Influence on Government, Politics, and Social Movements, (United States of America: IGI Global Scientific Publishing, 2022)
- Alexander Crowther, “NATO and hybrid warfare, seeking a concept to describe the challenge from Russia” in Hybrid Warfare Security and Asymmetric Conflict in International Relations, eds. Mikael Weissmann, Niklas Nilsson, Björn Palmertz and Per Thunholm, (London: I.B. TAURIS, 2021)
- R. McMaster, “At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House” (Unites States of America: Harper, 2024)
- Janice Gross Stein, “Foreign policy decision making: Rational, psychological, and neurological models”, in Foreign Policy Theories, Actors, Cases, 3rd edition, eds. Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (New York: Oxford University Press, 2016)
- Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, Foreign Policy Analysis: A Toolbox (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018)
- Lloyd Jensen, Explaining Foreign Policy (United States of America: Prentice Hall, 1982)
- Margaret G. Hermann, “Assessing Leadership Style: A Trait Analysis,” in The Psychological Assessment of Political Leaders, ed. Jerrold M. Post (United States of America: University of Michigan Press, 2003)
- Martin and Deidre Bobgan, Four Temperaments Astrology & Personality Testing (United States of America: EastGate Publishers, 1992)
- Mary L. Trump, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man , (United States of America: Simon & Schuster, 2020)
Robert C. Smith, Questions of Character the Presidency of Donald J. Trump (United States of America: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2022)
- Ronald E. Powaski, Ideals, Interests, and U.S. Foreign Policy from George H. W. Bush to Donald Trump (United States of America: Palgrave Macmillan, 2019)
- Susan Hennessey & Benjamin Wittes, Unmaking the Presidency: Donald Trump’s War on the World’s Most Powerful Office (United States of America: Farrar, Straus & Giroux, 2020)
- Tsuneo Akaha et al, Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific: Theoretical Analysis of Changes & Continuities, (Cham: Springer, 2021)
- Valerie M. Hudson and Benjamin S. Day. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 3rd edition (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2020)
- Yochai Benkler et al, Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics, (New York: Oxford Academic, 2018)
- Scientific Journals:
- Abigail White, Profiling the President: explaining Donald Trump’s nationalistic foreign policy decisions using Leadership Trait Analysis and Operational Code Analysis, STAGES in Security: Vol 1, (2022), p.5-48.
- Alessandro Nai & Emre Toros, The peculiar personality of strongmen: comparing the Big Five and Dark Triad traits of autocrats and non-autocrats, Political Research Exchange, 2, 1707697, (2020). p.1-24.
- Ambrues Monboe Nebo Sr., “Given Africa’s Position in the International System, Can It Leverage Peace Between Russia and Ukraine?”, International Journal of Research and Innovation in Social Science, 7, No. 7, (2023), p. 1501-1521
- Anastasjia Wagner & Elke Fein, “Vladimir Putin as a political leader: Challenges to An Adult Developmentally-Informed Analysis of Politics and Political Culture”. Behavioral Development Bulletin, 21, No. 2, (2016), p. 204–222.
- Anatolii Slobodianiuk et Al, “Political Aspects of Decision-Making”, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 13, No. 2, (2023), p.23-26.
- Andrei Korobkov, “Donald Trump and the Evolving U.S.-Russia Relationship”. Perceptions, 24, No. 1, (2019), p. 39-58.
- B J Bushman & C A Anderson. Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy? Psychological Review, Vol.108, No.1, (2001), p.273–279.
- Daniel Treisman, “Why Putin Took Crimea: The Gambler in the Kremlin”, Foreign Affairs, Vol. 95, no. 3 (2016), p.47-54
- Donald N. Jensen, “Ctrl-Alt-Del?: Obama Recalibrates the Reset with Russia”, Atlantisch Perspectief, 36, No. 8, (2012), p.20-23.
- Harold and Margret Sprout, “Environmental factors in the Study of International politics”, The Journal of Conflict Resolution. 1, No. 4, )1957(, p. 309-328.
- Harold Chapman Brown, “Human Nature and the State”, International Journal of Ethics, 26, No. 2, (1916) p. 177-192
- Jessica Yakeley “Current Understanding of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder”, BJPsych Advances, Vol. 24, No. 5 (2018) p.305–315.
- John Ehrman, Two biographies of Vladimir Putin. Studies in Intelligence, Central Intelligence Agency, Vol. 57, No.4, (2013), p.39-43
- Jorge Acebes-Sanchez et al, Emotional Intelligence in Physical Activity, Sports and Judo: A Global Approach, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, No. 16, 8695, (2021), p.1-12.
- June Park and Troy Stangarone, “Trump’s America First Policy in Global and Historical Perspectives: Implications for US – East Asian Trade”, Asian Perspective, 43, No. 1, (2019), p. 1-34.
- Steven Fish et al, “What is Putinism?”, Journal of Democracy, Vol.28, No.4, (2017), p.61-75.
- Nikolas Gvosdev, “Permanent Divergence – The Evolution of U.S.-Russia Relations in the Trump Era”, Horizons: Journal of international Relations and Sustainable Development, No. 12, (2018), p.98-111
- Rodney Eadie “An Overview of Contemporary Scientific Research into the Physiological and Cognitive Benefits of Judo Practice”. Martial Arts Studies Journal, Issue 14, (2023), p.78-82.
- Salvador Santino F. Regilme Jr. and Obert Hodzi, “Comparing US and Chinese Foreign Aid in the Era of Rising Powers”, The International Spectator, 56, No. 2, (2021) p. 114-131
- Samir Novruzov, “Vladimir Putin’s Leadership: Charisma, Power Dynamics, and Influence through the Lens of Leadership Traits and Theoretical Perspectives”. Open Journal of Leadership, Vol. 13, p.217-230.
- Scott Fitzsimmons, “Personality and adherence to international agreements: The case of President Donald Trump”, International Relations, Vol.36, No.1, (2020), p.40-60.
- Seung-Whan Choi and Patrick James, “Why Does the United States Intervene Abroad? Democracy, Human Rights Violations, and Terrorism”, The Journal of Conflict Resolution, 60, No. 5, (2016), p. 899-926
- Taher Ben Khalifa, “Bigotry, Sexism, and Xenophobia: How Do They Manifest in Donald Trump’s Discourse?”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6, No. 12, (2017), p.17-33.
- Theses:
- Lee Holmes, Russian Interventionism: A Case Study of President Vladimir Putin’s Personal Influence in the Syrian Civil War, (Honors Thesis, University of Mississippi, 2024)
- Research Papers & Reports:
- Agnieszka Rogozińska and Aleksander Ksawery Olech, The Russian Federation’s Military Bases Abroad, Report, Institute of New Europe, (2020)
- Aubrey Immelman and Joseph V. Trenzeluk, “The Political Personality of Russian Federation President Vladimir Putin”, John’s University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics, (2017)
- Brian D. Taylor, “Personality and Power in Russian Foreign Policy”, The Freeman Spogli Institute for International Studies, )2020(
- Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Report, Congressional Research Service, (2023)
- Claire Mills, Ukraine: The Swiss peace summit and what comes next?, Research Briefing, House of Commons Library – UK Parliament, (2024)
- Felix Reichling, The Economic Effects of President Trump’s Tariffs, Report, Penn Wharton, University of Pennsylvania, (2025)
- Fredrik Westerlund, The role of the military in Putin’s foreign policy: An overview of current research, Research paper, Swedish Defense Research Agency (FOI), (2021)
- Kadri Liik, Winning the Normative War with Russia: An Eu-Russia Power Audit, Research paper, European Council on Foreign Relations, (2018)
- Kateryna Stepanenko et al, “Russian Offensive Campaign Assessment “, Report, Institute for the study of war, (2023)
- Peter van. Ham, The BRICS as an EU Security Challenge: The Case for Conservatism, Report, Clingendael Institute, (2015)
- Robert J House., “A 1976 Theory of Charismatic Leadership”. Working Paper Series 76-06, University of Toronto, Faculty of Management Studies, (1976)
- Russia 2023 Human Rights Report, Report, United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, (2023)
- Emil Pain, The Political and Psychological Aspects of the Georgian-Russian Conflict” in Russia and Georgia: The Ways Out of the Crisis, eds. George Khutsishvili and Tina Gogueliani, International Center on Conflict and Negotiation, (2010)
- Electronic Resources:
- “Biography of Vladimir Putin“. President of Russia, The Kremlin, Accessed 30/4/2025. Available at: http://en.putin.kremlin.ru/bio/page-0.
- “Bill O’Reilly’s exclusive interview with President Trump”, Fox News, February 7, 2017, Accessed: 27/4/2025, Available at: https://www.foxnews.com/transcript/bill-oreillys-exclusive-interview-with-president-trump.
- “Outcomes of the United States and Russia Expert Groups on the Black Sea”, The White House, March 25, 2025, Accessed: 27/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/03/outcomes-of-the-united-states-and-russia-expert-groups-on-the-black-sea/.
- “President Trump’s America First Priorities”, The White House, January 20,2025, Accessed 27/4/2025 Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/.
- “Putting America First in International Environmental Agreements”, The White House, January 20, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/.
- “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”, The White House, January 20, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/.
- “Transcript: Trump and Putin’s Joint Press Conference”, npr (National Public Radio), July 16, 2018, Accessed 27/4/2025, Available at: https://www.npr.org/2018/07/16/629462401/transcript-president-trump-and-russian-president-putins-joint-press-conference.
- “Ukraine and the United States sign Economic Partnership Agreement and establish the Reconstruction Investment Fund”, Ministry of Economy of Ukraine, May 1, 2025, Accessed 01/5/2025, Available at: https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukraina-i-ssha-pidpysaly-uhodu-pro-ekonomichne-partnerstvo-ta-stvorennia-investytsiinoho-fondu-vidbudovy.
- “Withdrawing the United States from and Ending Funding to Certain United Nations Organizations and Reviewing United States Support to All International Organizations”, The White House, February 4, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/.
- American Psychological Association. “Narcissistic Personality.” APA Dictionary of Psychology. Last modified January 4, 2024. Accessed 25/4/2025. Available at: https://dictionary.apa.org/narcissistic-personality.
- Brain Duignan, “Donald Trump”, Encyclopedia Britannica. Last modified April 2025, Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.britannica.com/biography/Donald-Trump.
- Dmitri Trenin, “Russia’s Syria gambit aims at something bigger than Syria”, Carnegie Carnegie Endowment for International Peace, October 13, 2015, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/posts/2015/10/putins-syria-gambit-aims-at-something-bigger-than-syria?lang=en
- Harvey Mansfield, Niccolò Machiavelli, Encyclopedia Britannica, last modified February 6, 2024, Accessed 2/5/2025, Available at: https://www.britannica.com/biography/Niccolo-Machiavelli/The-Prince.
- Helen Davidson and agencies, “Trump Says China Tariffs Will Drop ‘Substantially – but It Won’t Be Zero’,” The Guardian, April 22,2025, Accessed 28/4/2025. Available at: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/22/trump-china-tariffs.
- com Editors, “Donald Trump,” History, November 2016, Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.history.com/articles/donald-trump.
- Howard LaFranchi, “Diplomacy is in part transactional. How is Trump’s different?”, The Christian Science Monitor, October 3, 2019, Accessed: 27/4/2025, Available at https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2019/1003/Diplomacy-is-in-part-transactional.-How-is-Trump-s-different .
- Jon-Christian Pass, “The Psychology of Trump’s 2025 Presidency: Traits, Behaviors, and Underlying Dynamics,” Simply Put Psych, April 14, 2025, Accessed 28/4/2025. Available at: https://simplyputpsych.co.uk/global-psych/the-psychological-of-trumps-2025-presidency-traits-behaviours-and-underlying-dynamics.
- Maha Yahya and Mohanad Hage Ali, “Russia’s Balancing Act in the Levant”, Carnegie Endowment, September 19, 2024, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/research/2024/09/russia-middle-east-levant?lang=en.
- Matthew Olay, “Biden, Zelenskyy Sign 10-Year Bilateral Security Agreement”, S. Department of Defense, June 13, 2024, Accessed 27/4/2025, Available at: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3806792/biden-zelenskyy-sign-10-year-bilateral-security-agreement/.
- Mike Stone and Pesha Magid, ”Exclusive: Trump poised to offer Saudi Arabia over $100 billion arms package, sources say”, Reuters, April 25, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.reuters.com/world/trump-poised-offer-saudi-arabia-over-100-bln-arms-package-sources-2025-04-24/.
- Romain Bertolino, “Editorial – Why Psychology is a Key Factor of International Relations”, ed. in Revue Diplomatique,Exploring the Central Role of Psychology in International Relations, July 29,2022, Accessed 22/4/2025, Available at: https://www.institut-ega.org/l/editorial-why-psychology-is-a-key-factor-of-international-relations/.
- Tatiana Stanovaya, Beneath the Surface, Prigozhin’s Mutiny Has Changed Everything in Russia, Carnegie Endowment for International Peace, July 27,2023, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2023/07/beneath-the-surface-prigozhins-mutiny-has-changed-everything-in-russia?lang=en.
- The Editors of Encyclopedia Britannica, “Temperament”, Encyclopedia Britannica. Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.britannica.com/topic/temperament.
[1] “عملية صنع القرار”، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأمم المتحدة (ESCWA)، شوهد في:9/4/2025، متاح على: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/.
[2] عبدالجواد بكر، “السياسات التعليمية وصنع القرار” الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003)، ص 80.
[3] المرجع السابق، ص83.
[4] عبد العزيز صالح بن حبتور، “أصول ومبادئ الإدارة العامـة”) عمان: الـدار العلمية، 2000(، ص 186.
[5] حنان أحمد عبدالله علي، “معوقات صنع القرار واتخاذه لدى مديري مدارس التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية (دراسة ميدانية)” – مستخلص بحث من رسالة ماجستير، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية. العدد 11، الجزء الخامس، (2017)، ص 205.
[6] عبدالجواد بكر، مرجع سبق ذكره. ص 81.
[7] Anatolii Slobodianiuk et Al, “Political Aspects of Decision-Making”, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 13, No. 2, (2023), p.23.
[8] Ibid, p.24.
[9] Report on Russia latest Development 2024, Freedom House. Last viewed on 22 May 2025, Available at: Russia: Country Profile | Freedom House
[10] Sertan AKBABA, “Personalization in Political Leadership: An Analysis of Vladimir Putin”, The Journal of Diplomatic Research. Vol.1 No.1 December 2019, p.5.
[11] USA Constitution, The U.S. Constitution Online, available at: Checks and Balances in the Constitution – U.S. Constitution.net
[12] Alex Mintz & Karl DeRouen, “Understanding Foreign Policy Decision Making” (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 3-4.
[13] ابتهال مبروك، “عملية صنع القرار الخارجي – Foreign Decision making process”، الموسوعة السياسيّة، 2020-12-02، شوهد في: 2025-04-10، متاح على: https://political–encyclopedia.org/dictionary/عملية صنع القرار الخارجي
[14] Lloyd Jensen, Explaining Foreign Policy (United States of America: Prentice Hall, 1982), p.116 & 117.
[15] ابتهال مبروك، مرجع سبق ذكره، متاح على: https://political–encyclopedia.org/dictionary/عملية صنع القرار الخارجي
[16] المرجع السابق.
[17] Lloyd Jensen, Op. Cit, p.137.
[18] Christer Pursiainen and Tuomas Forsberg. The Psychology of Foreign Policy (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021), p.1-3.
[19] ندي شوقي عبد اللطيف، أسامة محمود عبد الرحيم، أميرة عبد العاطي، “سيكولوجية القيادة السياسية وأثرها على صنع القرار الخارجي قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالحرب على أوكرانيا 2022 “نموذجًا”، المركز الديمقراطي العربي، (٢٠٢٤)، ص 33-34.
[20] Christer Pursiainen and Tuomas Forsberg, Op. Cit, p.24-26.
[21] Harold and Margret Sprout, “Environmental factors in the Study of International politics”, The Journal of Conflict Resolution. Vol. 1, No. 4, )1957(, p.314.
[22] Ibid, p.163-172, 209-221 and 253-255
[23] Valerie M. Hudson and Benjamin S. Day. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 3rd edition (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2020), p.42-56.
[24] Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, Foreign Policy Analysis: A Toolbox (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), p.78-85.
[25] Cited in:
Alex Mintz & Karl DeRouen, Op. Cit, p.98.
Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, Op. Cit, p.77-78.
[26] Alex Mintz & Karl DeRouen, Op. Cit, p.114 & 115.
[27] Ibid, p.99 & 100.
[28] Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, Op. Cit, p.72.
[29] Cited in:
Alex Mintz & Karl DeRouen, Op. Cit, p.101 & 103.
Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, Op. Cit, p.80.
[30] Alex Mintz & Karl DeRouen, Op. Cit, p.101 & 102.
[31] “Biography of Vladimir Putin“. President of Russia, The Kremlin, Accessed 30/4/2025. Available at: http://en.putin.kremlin.ru/bio/page-0.
[32] محمد رشيد، تأثير العامل السيكولوجي على صانع القرار السياسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجًا، مجلة ريحان للنشر العلمي، العدد 25، (2022) ص142.
[33] آلاء محمد محسن، دور القائد السياسي في صنع السياسىة الخارجية الرئيس فلاديمير بوتين نموذجًا (رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، 2015) ص84.
[34] عزة هاشم، قراءة نفسية: كيف يُفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،17/04/2022، شوهد في 1/5/2025، متاح على: https://ecss.com.eg/19147/.
[35] The kremlin. Op. Cit. Accessed 30/4/2025. Available at: Interests ∙ Vladimir Putin
[36] Anastasjia Wagner & Elke Fein, “Vladimir Putin as a political leader: Challenges to An Adult Developmentally-Informed Analysis of Politics and Political Culture”. Behavioral Development Bulletin, Vol. 21, No. 2, (2016), p.213.
[37] Samir Novruzov, “Vladimir Putin’s Leadership: Charisma, Power Dynamics, and Influence through the Lens of Leadership Traits and Theoretical Perspectives”. Open Journal of Leadership, Vol. 13, p.218.
[38] آلاء محمد محسن، مرجع سبق ذكره. ص86
[39] Rodney Eadie “An Overview of Contemporary Scientific Research into the Physiological and Cognitive Benefits of Judo Practice”. Martial Arts Studies Journal, Issue 14, (2023), p.78-82.
[40]Jorge Acebes-Sanchez et al, Emotional Intelligence in Physical Activity, Sports and Judo: A Global Approach, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, No. 16, 8695, (2021), p.2.
[41] آلاء محمد محسن، مرجع سبق ذكره، ص86.
[42] The Kremlin, Op. Cit, Accessed 30/4/2025, Available at: http://en.putin.kremlin.ru/bio/page-0.
[43] Ibid.
[44] Ibid.
[45] Samir Novruzov, Op. Cit, p.223.
[46] آلاء محمد محسن، مرجع سبق ذكره، ص91.
[47] Samir Novruzov, Op. Cit, p.218
[48] Ibid, p.218
[49] Ibid, p.218.
[50] مروة خليل محمد، دور القيادة السياسية في تحديد مضمون المصلحة القومية:جورباتشوف وبوتين كدراسة حالة، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد 21، (2024)، ص297.
[51] عادل عنتر على زعلوك ، “الاستراتيجية الروسية الكبرى في عهد بوتن: دراسة في الدوافع والخصائص والمداخل”، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 22 ، عدد 4، (2021)، ص331-332.
[52] M. Steven Fish et al, “What is Putinism?”, Journal of Democracy, Vol.28, No.4, (2017), p.61-63.
[53] Ibid, p.69.
[54] Samir Novruzov, Op. Cit, p.226.
[55] Harvey Mansfield, Niccolò Machiavelli, Encyclopedia Britannica, last modified February 6, 2024, Accessed 2/5/2025, Available at: https://www.britannica.com/biography/Niccolo-Machiavelli/The-Prince.
[56] Alessandro Nai & Emre Toros, The peculiar personality of strongmen: comparing the Big Five and Dark Triad traits of autocrats and non-autocrats, Political Research Exchange, Vol. 2, 1707697, (2020). p.5.
[57] Samir Novruzov, Op. Cit, p.226.
[58] Alessandro Nai & Emre Toros, Op. Cit, p.4.
[59] Ibid, p.10.
[60] Ibid, p.10-14.
[61] Aubrey Immelman and Joseph V. Trenzeluk, “The Political Personality of Russian Federation President Vladimir Putin”, St. John’s University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics, (2017), p.5-16.
[62] Ibid, p.17-21.
[63] Ibid, p.30.
[64] Ibid, p. 29-30.
[65] Ibid, p.31.
[66] مروة خليل محمد، مرجع سبق ذكره، ص297.
[67] John Ehrman, Two biographies of Vladimir Putin. Studies in Intelligence, Central Intelligence Agency, Vol. 57, No.4, (2013), p.40.
[68] Ibid, p.40.
[69] Ibid, p.40.
[70] Ibid, p.40.
[71] Samir Novruzov, Op. Cit, p.217 and 219.
[72] Ibid, p.220-222.
[73] عادل عنتر على زعلوك، مرجع سبق ذكره، ص348-353.
[74] المرجع السابق، ص348-353.
[75] Clifford G. Gaddy, and Fiona Hill, Mr. Putin: Operative in the Kremlin (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2015(, p.330,331,390 and 391.
[76] Samir Novruzov, Op. Cit, p. 226.
[77] House and Robert J., “A 1976 Theory of Charismatic Leadership”. Working Paper Series 76-06, University of Toronto, Faculty of Management Studies, (1976), p.7-9.
[78] Clifford G. Gaddy, and Fiona Hill, Op. Cit, p.330 and 331.
[79] Emil Pain, The Political and Psychological Aspects of the Georgian-Russian Conflict” in Russia and Georgia: The Ways Out of the Crisis, eds. George Khutsishvili and Tina Gogueliani, International Center on Conflict and Negotiation, (2010), p.22.
[80] G. Alexander Crowther, “NATO and hybrid warfare, seeking a concept to describe the challenge from Russia” in Hybrid Warfare Security and Asymmetric Conflict in International Relations, eds. Mikael Weissmann, Niklas Nilsson, Björn Palmertz and Per Thunholm, (London: I.B. TAURIS, 2021), p.22.
[81] Daniel Treisman, “Why Putin Took Crimea: The Gambler in the Kremlin”, Foreign Affairs, Vol. 95, no. 3 (2016), p.47.
[82] أسماء عبدالمولي حسين علي، “سيكولوجية القادة وتأثيرها على صنع القرار في السياسة الأمريكية -دراسة مقارنة- ( باراك أوباما- دونالد ترامب)”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد. المجلد 20 ، العدد 19، (2023)، ص88.
[83] Brian D. Taylor, “Personality and Power in Russian Foreign Policy”, The Freeman Spogli Institute for International Studies, )2020(, p.4.
[84] Dmitri Trenin, “Russia’s Syria gambit aims at something bigger than Syria”, Carnegie Carnegie Endowment for International Peace, October 13, 2015, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/posts/2015/10/putins-syria-gambit-aims-at-something-bigger-than-syria?lang=en
[85] فادي عبد الغني الأحمر، “السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية”، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد 49، عدد 4، (2021)، ص 78–82.
[86] Daniel Bar-Tal, “Siege Mentality.” Beyond Intractability, eds. Guy Burgess and Heidi Burgess, Conflict Information Consortium, University of Colorado, (2004). Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.beyondintractability.org/essay/siege-mentality.
[87] B J Bushman & C A Anderson. Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy? Psychological Review, Vol.108, No.1, (2001), p.273–279.
[88] Brian D. Taylor, Op. Cit, p.3.
[89] عزة هاشم، مرجع سبق ذكره، شوهد في: 28/4/2025، متاحع على: https://ecss.com.eg/19147/.
[90] المرجع السابق.
[91] المرجع السابق.
[92] Samir Novruzov, Op. Cit, p.224 and 225.
[93] Kateryna Stepanenko et al, “Russian Offensive Campaign Assessment “, Report, Institute for the study of war, (2023), p. 2 and p.14
[94] Ibid.
[95] Tatiana Stanovaya, Beneath the Surface, Prigozhin’s Mutiny Has Changed Everything in Russia, Carnegie Endowment for International Peace, July 27,2023, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2023/07/beneath-the-surface-prigozhins-mutiny-has-changed-everything-in-russia?lang=en.
[96] Ibid.
[97] Brain Duignan, “Donald Trump”, Encyclopedia Britannica. Last modified April 2025, Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.britannica.com/biography/Donald-Trump.
[98] History.com Editors, “Donald Trump,” History, November 2016, Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.history.com/articles/donald-trump.
[99] Dan P. McAdams, The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning, (United States of America: Oxford University Press,2020) p.141 & 144.
[100] Mary L. Trump, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, (United States of America: Simon & Schuster, 2020) p.21.
[101] Ibid, p.19.
[102] Ibid, p.19.
[103] Ibid, p.176.
[104] The Editors of Encyclopedia Britannica, “Temperament”, Encyclopedia Britannica. Accessed 20/4/2025. Available at: https://www.britannica.com/topic/temperament.
[105] Christer Pursiainen & Tuomas Forsberg, Op. Cit, p.276.
[106] Martin and Deidre Bobgan, Four Temperaments Astrology & Personality Testing (United States of America: EastGate Publishers, 1992) p.9 & 56.
[107]مها بنت ناصر بن عائض النهاري، السمات الشخصية الخمس الكبار وعلاقتها بأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة (دراسة استكشافية)، المجلة الدولية للتعليم بالإنترنت، المجلد 19، العدد 1، (2020)، ص116.
[108] اسيا جامعة عين شمس، العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للطلاب المتفوقين والمتأخرين أكاديميا من المرحلة الثانوية، مجلة الخدمة النفسية، مجلد 10 عدد 1. (2017) ص13 و 15.
[109] Dan P. McAdams, Op. Cit, p.68 & 69.
[110] Ibid, p.83 & 87.
[111] Ibid, p.74-78.
[112] Jessica Yakeley “Current Understanding of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder”, BJPsych Advances, Vol. 24, No. 5 (2018) p.305–15.
[113] American Psychological Association. “Narcissistic Personality.” APA Dictionary of Psychology. Last modified January 4, 2024. Accessed 25/4/2025. Available at: https://dictionary.apa.org/narcissistic-personality.
[114] Jessica Yakeley, Op. Cit, p.305–15.
[115] Cited in:
Dan P. McAdams, Op. Cit, p.174 & 200.
Robert C. Smith, Questions of Character the Presidency of Donald J. Trump (United States of America: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2022) p.59.
[116] Dan P. McAdams, Op. Cit, p.24.
[117] Robert C. Smith, Op. Cit, p.57& 58.
[118] Dan P. McAdams, Op. Cit, p.25, 26 & 115.
[119] Margaret G. Hermann, “Assessing Leadership Style: A Trait Analysis,” in The Psychological Assessment of Political Leaders, ed. Jerrold M. Post (United States of America: University of Michigan Press, 2003), p.184.
[120] Ibid, p.182.
[121] Abigail White, Profiling the President: explaining Donald Trump’s nationalistic foreign policy decisions using Leadership Trait Analysis and Operational Code Analysis, STAGES in Security: Vol 1, (2022), p.8.
[122] Ibid, p.30.
[123] Ibid, p.31.
[124] Ibid, p.31 & 32.
[125] Dan P. McAdams, Op. Cit, p.54-55.
[126] Ibid, p.58.
[127] Ibid, p.56
[128] Abigail White, Op. Cit, p.10.
[129] Scott Fitzsimmons, “Personality and adherence to international agreements: The case of President Donald Trump”, International Relations, Vol.36, No.1, (2020), p.40-60.
[130] Ibid, p.40-60.
[131] Ibid, p.40-60.
[132] Ibid, p.40-60.
[133] Ibid, p.40-60.
[134] Robert C. Smith, Op. Cit, p.107.
[135] Robert C. Smith, Op. Cit, p.108.
[136] Alex Mintz & Karl DeRouen, Op. Cit, p.98.
[137] Taher Ben Khalifa, “Bigotry, Sexism, and Xenophobia: How Do They Manifest in Donald Trump’s Discourse?”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 6, No. 12, (2017), p.17-33.
[138] Abigail White, Op. Cit, p.14.
[139] ليلى أحمد السيد إبراهيم، السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية بين عهدي أوباما وترامب “دراسة تقويمية مقارنة” (رسالة ماجستير، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2020)، ص120-121.
[140] Robert C. Smith, Op. Cit, p.109-110.
[141] Ronald E. Powaski, Ideals, Interests, and U.S. Foreign Policy from George H. W. Bush to Donald Trump (United States of America: Palgrave Macmillan, 2019) p.239.
[142] مروة جابر وهشام حمدي، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في ظل ولاية ترامب الجديدة، السياسة الدولية، 13/1/2025، شوهد في 28/4/2025 . متاح على: https://www.siyassa.org.eg/News/21932.aspx .
[143] المرجع السابق.
[144] Helen Davidson and agencies, “Trump Says China Tariffs Will Drop ‘Substantially – but It Won’t Be Zero’,” The Guardian, April 22,2025, Accessed 28/4/2025. Available at: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/22/trump-china-tariffs.
[145] Jon-Christian Pass, “The Psychology of Trump’s 2025 Presidency: Traits, Behaviors, and Underlying Dynamics,” Simply Put Psych, April 14, 2025, Accessed 28/4/2025. Available at: https://simplyputpsych.co.uk/global-psych/the-psychological-of-trumps-2025-presidency-traits-behaviours-and-underlying-dynamics.
[146] Susan Hennessey & Benjamin Wittes, Unmaking the Presidency: Donald Trump’s War on the World’s Most Powerful Office (United States of America: Farrar, Straus & Giroux, 2020) p.177-180.
[147] Ibid, p.177-180.
[148] Andrei Korobkov, “Donald Trump and the Evolving U.S.-Russia Relationship”. Perceptions, Vol. 24, No. 1, (2019), p. 47-49.
[149] Nikolas Gvosdev, “Permanent Divergence – The Evolution of U.S.-Russia Relations in the Trump Era”, Horizons: Journal of international Relations and Sustainable Development, No. 12, (2018), p.99-100
[150] Ibid, p.101.
[151] Donald N. Jensen, “Ctrl-Alt-Del?: Obama Recalibrates the Reset with Russia”, Atlantisch Perspectief, Vol. 36, No. 8, (2012), p.22-23.
[152] “Transcript: Trump and Putin’s Joint Press Conference”, npr (National Public Radio), July 16, 2018, Accessed 27/4/2025, Available at: https://www.npr.org/2018/07/16/629462401/transcript-president-trump-and-russian-president-putins-joint-press-conference.
[153] “President Trump’s America First Priorities”, The White House, January 20,2025, Accessed 27/4/2025 Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/.
[154] عادل عنتر على زعلوك، مرجع سبق ذكره، ص 338.
[155] Kadri Liik, Winning the Normative War with Russia: An Eu-Russia Power Audit, Research paper, European Council on Foreign Relations, (2018), p.3.
[156] “Bill O’Reilly’s exclusive interview with President Trump”, Fox News, February 7, 2017, Accessed: 27/4/2025, Available at: https://www.foxnews.com/transcript/bill-oreillys-exclusive-interview-with-president-trump.
[157] H. R. McMaster, “At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House” (Unites States of America: Harper, 2024), p. 167
[158] “Outcomes of the United States and Russia Expert Groups on the Black Sea”, The White House, March 25, 2025, Accessed: 27/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/03/outcomes-of-the-united-states-and-russia-expert-groups-on-the-black-sea/.
[159] Ambrues Monboe Nebo Sr., “Given Africa’s Position in the International System, Can It Leverage Peace Between Russia and Ukraine?”, International Journal of Research and Innovation in Social Science, Vol. 7, No. 7, (2023), p.1501.
[160] Claire Mills, Ukraine: The Swiss peace summit and what comes next?, Research Briefing, House of Commons Library – UK Parliament, (2024), p. 2
[161] Seung-Whan Choi and Patrick James, “Why Does the United States Intervene Abroad? Democracy, Human Rights Violations, and Terrorism”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 60, No. 5, (2016), p.900.
[162] Howard LaFranchi, “Diplomacy is in part transactional. How is Trump’s different?”, The Christian Science Monitor, October 3, 2019, Accessed: 27/4/2025, Available at https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2019/1003/Diplomacy-is-in-part-transactional.-How-is-Trump-s-different .
[163] Matthew Olay, “Biden, Zelenskyy Sign 10-Year Bilateral Security Agreement”, U.S. Department of Defense, June 13, 2024, Accessed 27/4/2025, Available at: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3806792/biden-zelenskyy-sign-10-year-bilateral-security-agreement/.
[164] Russia 2023 Human Rights Report, Report, United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, (2023), p.1-2.
[165] Tsuneo Akaha et al, Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific: Theoretical Analysis of Changes & Continuities, (Cham: Springer, 2021), p. 23.
[166] June Park and Troy Stangarone, “Trump’s America First Policy in Global and Historical Perspectives: Implications for US – East Asian Trade”, Asian Perspective, Vol. 43, No. 1, (2019), p.2.
[167] “Putting America First in International Environmental Agreements”, The White House, January 20, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/.
[168] “Withdrawing the United States from and Ending Funding to Certain United Nations Organizations and Reviewing United States Support to All International Organizations”, The White House, February 4, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/.
[169] June Park and Troy Stangarone, Op. Cit, p.10.
[170] “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”, The White House, January 20, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/.
[171] Salvador Santino F. Regilme Jr. and Obert Hodzi, “Comparing US and Chinese Foreign Aid in the Era of Rising Powers”, The International Spectator, Vol. 56, No. 2, (2021) p.114–115.
[172] Peter van. Ham, The BRICS as an EU Security Challenge: The Case for Conservatism, Report, Clingendael Institute, (2015), p.6.
[173] عادل عنتر على زعلوك، مرجع سبق ذكره، ص 339.
[174] “Ukraine and the United States sign Economic Partnership Agreement and establish the Reconstruction Investment Fund”, Ministry of Economy of Ukraine, May 1, 2025, Accessed 01/5/2025, Available at: https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukraina-i-ssha-pidpysaly-uhodu-pro-ekonomichne-partnerstvo-ta-stvorennia-investytsiinoho-fondu-vidbudovy.
[175] Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Report, Congressional Research Service, (2023), p.21.
[176] Mike Stone and Pesha Magid, ”Exclusive: Trump poised to offer Saudi Arabia over $100 billion arms package, sources say”, Reuters, April 25, 2025, Accessed 28/4/2025, Available at: https://www.reuters.com/world/trump-poised-offer-saudi-arabia-over-100-bln-arms-package-sources-2025-04-24/.
[177] Felix Reichling, The Economic Effects of President Trump’s Tariffs, Report, Penn Wharton, University of Pennsylvania, (2025), p.1-2.
[178] Fredrik Westerlund, The role of the military in Putin’s foreign policy: An overview of current research, Research paper, Swedish Defense Research Agency (FOI), (2021), p. 3
[179] Lee Holmes, Russian Interventionism: A Case Study of President Vladimir Putin’s Personal Influence in the Syrian Civil War, (Honors Thesis, University of Mississippi, 2024), p.19.
[180] Maha Yahya and Mohanad Hage Ali, “Russia’s Balancing Act in the Levant”, Carnegie Endowment, September 19, 2024, Accessed 28/4/2025, Available at: https://carnegieendowment.org/research/2024/09/russia-middle-east-levant?lang=en.
[181] Agnieszka Rogozińska and Aleksander Ksawery Olech, The Russian Federation’s Military Bases Abroad, Report, Institute of New Europe, (2020), p.3.
[182] Fredrik Westerlund, Op. Cit, p.44-45.
[183] Yochai Benkler et al, Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics, (New York: Oxford Academic, 2018), p.145.
[184] Duygu Dersan Orhan et al, Research Anthology on Social Media’s Influence on Government, Politics, and Social Movements, (United States of America: IGI Global Scientific Publishing, 2022) p.350 -351.
[185]Howard LaFranchi, Op. Cit, Available at: https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2019/1003/Diplomacy-is-in-part-transactional.-How-is-Trump-s-different.