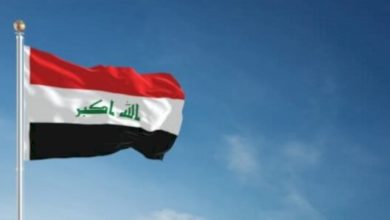الرَّقابَة على التَّحقيق الإِداري وضَماناتِه: “دراسة مقارنة بين التشريعين الفلسطيني والأردني”
Oversight of Administrative Investigations and Safeguards: Acomparative study between Palestinian and Jordanian legislation

اعداد : عبــد الله عبـاس عليـــان – باحث دكتوراة في القانون العام/ الجامعة الأردنية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
| ملخص |
| يَتمحور التَّحقيق الإداري حول جُملة من الإجراءات التي تَهدف إلى التأكد من صحة المُخالفة الإدارية ونِسبتها للفاعل، تمهيداً لتوقيع الجزاء التأديبي، وتَرتبِط هذه الإجراءات بِعددٍ من الضمانات القانونية، على نحو يَشمل ضمانات سابِقة على التحقيق، ومعاصرة له، وكذلك ضمانات لاحقة، وتَهدف هذه الضَّمانات بِمُجملها إلى تكريس حقِّ الدفاع للشخص الخاضع للتحقيق.
وقد تَناولت هذه الدراسة تِلك الضمانات من خلال اعتماد المنهج التحليلي المُقارن والتطبيقي، من خلال تَضمين الدراسة بمجموعة من التطبيقات القضائية ذات العلاقة، وقد حاولت الدراسة التركيز من خلال إشكاليتها على مدى مراعاة التشريع المقارن للأُسس السَّليمة في مَجال التَّحقيق الإداري، وخلصت الدراسة إلى جُملة من النَّتائج والتَّوصيات، حيث شَملت من حيث الأساس التشريعَين الفلسطيني والأردني، وهي في مُجملها تَستهدف تَجسيد ضماناتٍ أوسع على صعيد العَملية التَّحقيقية في المَجال الإداري، على نحو يَتضمَّن تكريس التَّوازن بين حق الإدارة في توقيع العقوبة التأديبية، وحق الشخص الخاضع للتحقيق في ضمان بَلوَرة ضمانات الدِّفاع الخاصَّة بِه. الكلمات المفتاحية: التحقيق الإداري، ضمانات التحقيق، العقوبة التأديبية، الجزاء التأديبي، المخالفة الإدارية، الموظف العام، الخدمة المدنية، الموارد البشرية. |
| Abstract |
| The administrative investigation revolves around a set of procedures aimed at verifying the validity of the administrative violation and attributing it to the perpetrator, as a prelude to imposing disciplinary sanctions. These procedures are intrinsically linked to a number of legal safeguards, encompassing guarantees that precede the investigation, accompany it, and follow it. Collectively, these safeguards are intended to reinforce the right of defense for the individual subject to investigation.
This study examines these safeguards by employing a comparative, analytical, and applied methodology, incorporating a set of relevant judicial applications. The study seeks, through its central question, to assess the extent to which comparative legislation adheres to sound principles in the field of administrative investigation. It concludes with a set of findings and recommendations, focusing primarily on the Palestinian and Jordanian legal systems. Broadly, the study aims to promote more robust safeguards within the administrative investigative process, in a manner that establishes a balance between the administration’s right to impose disciplinary measures and the individual’s right to effectively exercise his or her defense guarantees. Keywords: Administrative Investigation, Investigative Safeguards, Disciplinary Penalty, Disciplinary Sanction, Administrative Violation, Public Employee, Civil Service, Human Resources. |
- مقدمــة:
يُقاس مدى رقي الشعوب وتميزهم، بمدى تطبيقهم للأنظمة والقوانين المنصوص عليها في دولهم، وفي المقابل نَصَّت دساتير الدول أو قوانينها على حقوق وحريات شعوبها ومواطنيها، لما لهذه الدول من مسؤوليات والتزامات، وحقوق كفلتها سائر دساتير وقوانين هذه الدول، لتُشبع من خلالها رغبات الأفراد. بالمقابل فإن هذه الدول تقوم بتقديم الخدمات لمواطنيها في دوائر الدولة الرسمية ومؤسستها العامة من خلال موظفين، يتطلب منهم المهارة اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية. ويطلق على من يقدم هذه الخدمات في المؤسسات العامة (الموظف العام) وفي مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية (الموظف).
وإذا كان الموظف المُجِد يكافأ على جده واجتهاده بالترقيات وغير ذلك من الحوافز المادية وغير المادية، فإنه من الضروري بالمقابل أن يعاقب على إهماله بالعقوبة المناسبة، ولهذا يعتبر التأديب Discipline الضمانة الفاعلة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية (محارب، 2004، ص11).
مما يتطلب إجراء تمهيدي وهو التحقيق الذي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم بالمخالفة التأديبية وبين التهمة المنسوبة إليه، وإذا كان الاتهام جديا ويقوم على احتمالات قوية ترجح ارتكابه المخالفة أو الجريمة التأديبية المنسوبة إليه، وذلك حفاظا على سمعته ومكانته (الحلو، 2000، ص 524).
ويمكن تعريف التحقيق الإداري بأنه: مجموعة إجراءات إدارية بموجب القانون تهدف إلى تمحيص الأدلة المتعلقة بالمخالفة الإدارية (الجرم الإداري)، وصولاً إلى تقرير نتائج التحقيق بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي موضع دراستنا سنتناول الجهات المتخصصة قانوناً بإجراء التحقيق في المخالفات التأديبية للموظف، وسيكون استهدافنا في هذه الدراسة موظف الخدمة المدنية في مؤسسات الدولة، إضافة لدراسة الضمانات التي تضمن العدالة في إجراءات التأديب لهذا الموظف.
- أهمية الدراسة
- أهمية الدراسة النظرية: تبرز الأهمية النظرية تبعاً لما يشكله موضوع الدراسة من انعكاس للتطور الواقع في الميدان السياسي، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بوظائف الدولة. حيث تم تقسيم مذاهب وظائف الدولة إلى ثلاثة: المذهب الفردي، والذي يقوم على مفهوم الدولة الحارسة، التي تُعنى بإقامة العدل بين الناس، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي، وكذلك المذهب الاشتراكي: المستند إلى مبادئ الاشتراكية الشيوعية، وأخيراً المذهب الاجتماعي: القائم على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية. وحيث أن وظائف الدولة لم تعد تقتصر على مفهوم الدولة الحارسة، إذ أصبحت تتدخل في جملة من الأمور الحياتية الخاصة في المجتمع، فقد كان لزاماً عليها أن تتخذ أداة لبلورة تلك الوظائف، وهذه الوسيلة أو الأداة هي الموظف العام. ومن هنا برزت الحاجة لتأديب الموظف العمومي، ضمانا لحسن العمل وتحقيقاً لأهداف الدولة في كفالة حقوق الموظف العام.
- أما الأهمية العلمية: فتتمحور حول بيان مفهوم التحقيق الإداري وطرقه وإجراءاته وضماناته، وصولاً إلى تكريس الأسس السليمة لنجاعته على صعيد التطبيق الواقعي.
2.1. إشكالية الدراسة
تتمثل إشكالية الدراسة في وضع تساؤل جامع مانع مركب، ألا وهو: إلا أيِّ مدى راعى التشريع الأردني والمُقارن للأسس الرشيدة في مجال التحقيق الإداري؟ وبمعنى آخر، هل التزم المشرع المذكور بتلك الأسس أم لم يلتزم؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تتمثل بالآتي:
- ما هو مفهوم التحقيق الإداري وأهميته والجهة المختصة بإجرائه؟
- كيف نظم التشريع المقارن الضمانات السابقة على التحقيق الاداري؟
- إلى أي مدى وفر التشريع المقارن ضمانات فاعلة في مجال الرقابة المعاصرة واللاحقة للتحقيق الإداري؟
3.1. منهجية الدراسة
لقد اعتمد الباحث في إطار الدراسة على أكثر من منهج، على نحو يشمل المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، وفقاً لقواعد المقارنة الأفقية.
وللإجابة على إشكالية البحث، فقد قام الباحث بتقسيم البحث، وفق الآتي:
- المطلب الأول: طبيعة التحقيق الإداري وجهة الاختصاص
الفرع الأول: مفهوم التحقيق الإداري وأهميته
الفرع الثاني: الجهة المتخصصة بإجراء التحقيق
- المطلب الثاني: ضمانات الموظف في التحقيق الإداري
الفرع الأول: الضمانات السابقة على التحقيق الإداري
الفرع الثاني: الضمانات المعاصرة واللاحقة على التحقيق الإداري
- المطلب الأول: طبيعة التحقيق الإداري وجهة الاختصاص
إن مهمة الوقوف على فحوى هذا المطلب من الدراسة، تستلزم أن يتم تقسيمه إلى فرعين، بحيث نبحث في مفهوم التحقيق الإداري وأهميته (الفرع الأول)، والجهة المتخصصة بإجراء التحقيق (الفرع الثاني).
ولا بد لنا من تعريف (الموظف العام) و (الموظف)، و(الكفايات الوظيفية)، قبل الخوض في مفهوم التحقيق الإداري وأهميته في مطلبنا الأول.
وقد خلت معظم القوانين والأنظمة الوظيفية من وضع محدد، أو تعريف جامع مانع للموظف العام، إذ أن هذا التعريف في الواقع مجموعة من المعطيات أو المؤثرات التي تختلف ليس فقط من دولة إلى أخرى بل وأيضا من وقت إلى آخر، داخل الدولة الواحدة، وذلك تبعاً لما يسود من أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية وغيرها، فتعريف الموظف العام في النظم الاشتراكية يغاير دون شك تعريفه في النظم الرأسمالية، وتعريفه مختلف كذلك تبعاً لما كان سائداً في نظام الوظيفة المحدد أو نظام السلك وهكذا (بطيخ والعجارمة، 2012، ص 50).
حيث عرف المشرع الموظف في المادة (169) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 بأنه: “كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة”[1].
كما عرف مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، الموظف العام بأنه: “كل من يعمل في الجهاز الإداري أو الدوائر، أو المؤسسات، أو الهيئات التابعة لها”[2]..
إلا أن المستهدف في دراستنا هو الموظف في الخدمة المدنية، والذي عرفه نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 أنه: “الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ولا يشمل الشخص المستخدم بدوام جزئي او الذي يتقاضى أجراً يومياً”[3].
وعرفه قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته على أنه:” وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها”[4].
أما بخصوص مفهوم الكفايات الوظيفية، فرغم غياب تعريف صريح لهذا المصطلح إلا أن المشرع كَرَّس سياسة عامة لإدارة الموارد البشرية المتمثلة بمجموعة من المرتكزات والمبادئ والقيم التي تعزز أداء الموظف، وترسخ لديه ثقافة مؤسسية وهو ما نصت عليه أحكام المادتين (4 و5) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام[5]، وقد خلا أيضاً قانون الخدمة المدنية وتعديلاته الساري في فلسطين من تعريف لهذا المصطلح التي يعمل بها على أرض الواقع بتضمين بطاقات الوصف الوظيفي لها.
ويمكن القول إن الكفايات الوظيفية هي: إحدى المرتكزات الأساسية التي يتطلب امتلاكها من الموظفين لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، وعلى الرغم من انها لم تعرف بصورة صريحة في أحكام نظام الموارد البشرية الأردني، إلا أنه يمكن أن يكون مخالفتها مبررة للتحقيق الإداري، وتوقيع الجزاء التأديبي وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون، وتحديداً نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
- مفهوم التحقيق الإداري وأهميته
جادت أقلام الفقه بتناول وتعريف مفهوم التحقيق الإداري، إذ عرفه البعض أنه: “إجراء شكلي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها، أو التثبت من صحة اسنادها إلى فاعل معين، فالهدف منه الوصول إلى الحقيقة واماطة اللثام عنها” (محارب، 2004، ص 338).
كما عُرِّف على أنه: “تحري الحقيقة إزاء التهمة الموجهة إلى الموظف، وجمع المعلومات عنها من كافة العناصر المتصلة بها، والتي تشبه الإجراءات المتبعة قبل مرحلة المحاكمة في المحاكم، والتي تبدو أساسية، لأن السلطة الإدارية تجمع بين يديها سلطتي الاتهام والمحاكمة، ويشكل التحقيق أساساً في إحالة الموظف إلى اللجنة التأديبية، كما يشكل ضماناً للموظف من المساءلة بمجرد الشبهة أو الاتهام الكاذب، فلا يجوز توقيع عقوبة على الموظف، إلا بعد إحالته إلى لجنة تحقيق لسماع دفاعه وتثبيت ذلك في محضر رسمي، ويكون قرارها بهذا الشأن مسبباً” (عمرو، 2010، ص 252).
وعَرَّفه بعضٌ آخر من الفقه على أنه: “اجراء تمهيدي يهدف الى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمه المنسوبة إليه”، ورغم أن التحقيق ليس إلا إجراءً تمهيدياً، فيجب عدم إحالة الموظف إلى التحقيق، إلا إذا كان الاتهام جدياً يقوم على احتمالات قوية، ترجِّح ارتكابه للجريمة التأديبية المنسوبة إليه، وذلك حفاظاً على سمعته ومكانته (الحلو، 2000، ص 524).
كذلك يُعرَّف على أنه: “بعد اكتشاف المخالفة وضبطها وتوجيه الاتهام أو الوقوف بالإجراءات عند حد الضبط دون تحديد متهم بعينه يأتي دور التحقيق، وهو يستهدف استجلاء وجه الحق في الوقائع وتحديد المتهم بارتكابها على ضوء مبادئ العدالة، وفي ظل ظروف تكفل الاطمئنان للمتهم، وتبعد بالأجهزة الإدارية عن الاضطراب ولا تشبه فيها جواً من الترهيب والخوف، ويجب أن يصدر الأمر بإجراء التحقيق من السلطة المتخصصة، بموجب نص صريح” (رسلان، 2003، ص 993).
وأطلق البعض عليه التحقيق التأديبي وعرفه بأنه: “الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه، لاستبانة وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحه حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين، وذلك لوجه الحقيقة والصدق والعدالة” (مناصرة، 2012، ص 149).
ويمكن القول بأن التحقيق في المخالفات التأديبية يمر بمراحل عدة يجب على الجهة المتخصصة قانوناً أن تأخذ بعين الاعتبار الفحص والتحري وجمع الاستدلالات، لكشف حقيقة العلاقة بين الموظف المتهم والتهمة المنسوبة إليه ابتداءً، وفقاً لمبادئ العدالة، ومن ثم استكمال الإجراءات من خلال سماع إفادة الموظف وسماع الشهود ومن يلزم، والاستناد إلى الأنظمة والقوانين على قاعدة، “لا عقوبة إلا بنص”، وذلك حفاظاً على سمعة الموظف ومكانته (القبيلات، 2025، ص417).
وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن التحقيق التأديبي، له أهمية بالغة كضمانة للموظف من جهة وللتحقق قبل إصدار العقاب لجهة الإدارة من جهة ثانية، ويمكن توضيح هذه الأهمية من خلال الآتي:
- يعد التحقيق التأديبي من أهم الإجراءات الجوهرية التي يجب مراعاتها عند مساءلة الموظف العام تأديبياً، عن تصرفاته المخالفة للكفايات الوظيفية، ولقواعد الوظيفة العامة، وواجباتها وكرامتها، فهذا التحقيق يقوم على قواعد وأصول قانونية، يجب مراعاتها، بدءاً من السلطة المتخصصة بالتحقيق، مروراً باتباع القواعد الشكلية التي حددها القانون أثناء مباشرة التحقيق، سيما الضمانات الواجب مراعاتها للموظف المتهم، وكيفية استخلاص أدلة الاتهام، وانتهاء باتخاذ القرار المناسب بشأن هذا التحقيق (مناصرة، 2012، ص 149).
- أنه لا يهدف التحقيق التأديبي لمجرد توقيع عقاب، بل يمتد لكشف أوجه القصور، مبيناً الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفة التأديبية، الأمر الذي يتطلب إعطاء سلطة توقيع العقوبة للسلطة الرئاسية، ولتمكينها من سد الثغرات وإدخال التعديلات اللازمة على نظم العمل وإجراءاته، حتى يمكن تفادي حدوث مخالفات تأديبية مستقبلاً (رسلان، 2003، ص 870).
- إن التحقيق الإداري لا يقوم على الاعتبارات القانونية وحدها، بل توجد اعتبارات أُخرى يجب الأخذ بها، والإدارة هي الأقدر على مراعاتها، مثل: ظروف العمل، وعي الجمهور، مستوى الموظف، وتدريب الموظف (رسلان، 2003، ص 870).
- إذا كان البدء بالتحقيق، هو مجرد إجراء تمهيدي فإنه قد يرتب نتائج خطيرة قِبَل الموظف، وضماناً لاستقرار الموظف في عمله وعدم تعرضه للتجريح، فيجب ألا يبدأ التحقيق مع الموظف، لا سيما ممن يشغلون مناصب قيادية، إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية واحتمال معقول لارتكاب المخالفة المنسوبة إليه (الطماوي، 1979، ص 559).
- يكتسب التحقيق الإداري أهمية خاصة في المؤسسات العامة؛ حيث تساهم في الحفاظ على ثقة الجمهور في المنظمات العامة لأنها تُشكل آلية لضمان المساءلة والشفافية والنزاهة داخل هذه المؤسسات. فعمليات التدقيق المدني والضوابط الخارجية، كما تمت مناقشتها في سياق الإدارة العامة، توفر للمواطنين وسائل التحقق من أداء الهيئات العامة وتقييمه، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة والمساءلة (Romaniuk, 2022, P. 355).
على ضوء ما تقدم يتبين أن التحقيق يمنح الموظف المتهم، المساحة أو الضمانة، بالدفاع عن نفسه وتبرير موقفه تجاه التهم المنسوبة إليه، من خلال سماع أقواله والدفاع عن نفسه، لما لذلك من أثر على حياته الوظيفية ومكانتها، وحقوقه المالية، لا سيما إذا كانت التهم المنسوبة إليه، تصنف على أنها شكاوى كيديَّة أو كاذبة، ولا تَرقى لمستوى المخالفات الإدارية.
2.2. الجهة المتخصصة بإجراء التحقيق
لا يمكن إحالة الموظف إلى التحقيق في المخالفات التأديبية، إلا من سلطة متخصصة، تملك سلطة توقيع العقوبة، وإذا كانت هذه الأخيرة غير محددة، فإن الاختصاص يكون للسلطة التي عينته، استناداً للقاعدة الإدارية من يملك سلطة التعيين، يملك سلطة التأديب (عمرو، 2010، ص 252).
وتعددت أنظمة التأديب في الدول المختلفة، إلا أن العالم يطبق واحداً من مجالات ثلاثة في النظم التأديبية، وهي (الطماوي، 1979، ص 454-455):
- أولاً: النظام الرئاسي، ويقرر هذا النظام أن الذين يقدرون الأخطاء التأديبية ويقرون لها العقوبات، إنما هم الرؤساء المتخصصون في السلم الإداري، دون أي مساعدة أو أي تدخل سابق من هيئة جماعية استشارية.
- ثانياً: النظام شبه القضائي، وهو صورة من صور النظام الرئاسي، “ذلك أن سلطة توقيع الجزاء في ظل هذا النظام من اختصاص السلطات الرئاسية، ومع ذلك يلتزم هذا النظام قبل توقيع الجزاء نهائياً، استشارة هيئات تمثل فيها كلاً من الحكومة والموظفين بالتساوي، فيطلب إليها النظر في الإجراءات، واقتراح الجزاء، وكقاعدة عامة لا يقيد هذا الاقتراح السلطة الرئاسية ولا يلزمها في شيء”.
- ثالثا: النظام القضائي، “ويمتاز باقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية، ويتطلب هذا النظام فصلاً مطلقاً بين السلطة الرئاسية التي ترفع الدعوى التأديبية وتتبعها- وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة، تختص – بعد درجة معينة من شدة الجزاء، بتقدير الخطأ المهني المنسوب إلى الموظف، وبتوقيع شدة الجزاء، بتقدير الخطأ المهني المنسوب إلى الموظف وبتوقيع الجزاء الذي تراه مناسباً مع الوقائع الثابتة، ويعتبر قرارها ملزماً للسلطات الرئاسية”.
وبالنظر إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يتعلق بالسلطة المختصة بالتحقيق التأديبي، فقد بينت أحكام المادتين (72، 75)، لاسيما البند الأول من الفقرة (أ) من المادة (72) الذي أوضح أنه لا يجوز لأي من الجهات المحددة في المادة (69) من النظام اتخاذ أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) فقرة (أ) من المادة (68)، إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق بقرار من الوزير تتألف من ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة التي يسند إليها مهمة التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف[6].
وبينت المادة (75) من النظام كيفية تأليف المجلس التأديبي بحق الموظفين برئاسة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية كل من مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي والمدير التنفيذي في الهيئة الذي يسميه رئيسها ويسمي الوزير أحد موظفي دائرته ممثلا عنها في القضايا المتعلقة بموظفيها[7].
ويختص المجلس التأديبي وفق أحكام الفقرة (و) من المادة المشار إليها، بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (68) من النظام، وكذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف[8]، وهذه الحالة بدلالة المادة(98/أ/3)، من النظام ذاته، والتي بينت أن حالات عزل الموظف تكون بصدور قرار من المجلس التأديبي بعزله وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام ادار الموارد البشرية في القطاع العام.
أما الفقرة (ب) من المادة (75) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، فقد نصت على آلية اجتماع المجلس التأديبي، وذلك بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع الأعضاء، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه، على أن يبين العضو المخالف أسباب مخالفته خطياً، وترفق بقرار الأكثرية.
وبينت الفقرة (ج) من المادة ذاتها، أنه يحق لرئيس المجلس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أميناً لسر المجلس، ويناط به، اعداد جدول اعمال للجنة ومحاضر اجتماعها، ولتبليغ وتوثيق القرارات، وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي.
إضافة إلى ذلك بينت الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، بانطباق أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على رئيس وأعضاء المجلس التأديبي، ويقدم طلب الرد إلى وزير العدل، وفي حال إجابة الطلب يحل محل رئيس المجلس أو أي من أعضائه من يسميه رئيس الوزراء من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا، بناءً على طلب وزير العدل.
المشرع الأردني خص المادة (85) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام[9]، بمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بإيقاف أي من موظفي الفئة العليا في حال ارتكابه أي من المخالفات المسلكية، وصرف النسبة التي يقررها، من راتبه.
أما بخصوص لجان التحقيق للفئة العليا، وتحديداً المجموعتين الأولى والثانية، فقد نظمت المادة (86) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام[10]، لا سيما الفقرة (أ) مسألة تشكيل لجنة تحقيق للفئة العليا – المجموعة الأولى، بحيث تكون اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
أما بخصوص المجموعة الثانية من الفئة العليا، فقد نظمتها أحكام الفقرة (ب) من المادة ذاتها، والتي نصت على أن تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة ورئيس ديوان التشريع والرأي تتولى ما يلي:
| 1. النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا والأشخاص المشار إليهم في المادة (148) من هذا النظام المحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير، وهما المجموعتان الأولى والثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم طبقاً للمادة (148) من النظام.
2. دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف بناءً على تهم معينة يرى رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إحالتها إلى هذه اللجنة. وقد بينت المادة نفسها المسائل المتعلقة بعمل اللجنتين المذكورتين في الفقرتين (أ وب) من المادة سابقة الذكر، ونصت الفقرة(ج) على أن ترفع اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تنسيباتهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك، وإيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. وكذلك نصت الفقرة(د) لمجلس الوزراء تسمية أي وزير بدلاً من رئيس اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتسمية أي من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا بدلاً من رئيس الهيئة أو رئيس ديوان التشريع والرأي حسب مقتضى الحال”. |
وفيما يتعلق بإيقاف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، أوضحت المادة (87/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام[11]، أن جميع الإجراءات التأديبية توقف ولا يجوز الاستمرار فيها أو حتى إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت في حالة الوفاة.
وبالمقارنة مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، فقد عالج المشرع أحكام مواد تشكيل لجان التحقيق التأديبية لموظفي الفئة العليا فقط، وهذا ما أوضحته المادة (71) ، حيث نصت صراحة على:
- تكون إحالة موظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها.
- تتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق.
- ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبعد دراسة قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، لم ينظم في مواده آلية تشكيل لجان التحقيق فيما يتعلق بموظفي الفئة الأولى وحتى الخامسة، واقتصر التنظيم فقط على موظفي الفئة العليا، لا سيما أحكام المادة (71) التي بيناها سابقاً.
وتبين لنا على ضوء دراستنا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني أيضاً، أن المشرع الفلسطيني، ترك تنظيم لجان التحقيق وإجراءاتها وضمانات التحقيق فيما يتعلق بالفئة الأولى وحتى الفئة الخامسة إلى اللوائح التنفيذية.
وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005 (قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م)، نجد أن المادة (88) منها، قد أناطت صلاحية لجان التحقيق مع موظفي الفئة الأولى فما دون لرئيس ديوان الموظفين العام، كونه الجهة المشرفة على الخدمة المدنية وفق أحكام قانون الخدمة المدنية. في حين أن هذه المادة (88)، خضعت للعديد من التعديلات كان أولها ما جاء في اللائحة رقم (11) لسنة 2013 (قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م)، والتي نقلت صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية لتصبح من صلاحية رئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف أو من يفوضه رئيس الدائرة الحكومية خطياً، دون تحديد الدرجة الوظيفية للموظف الذي يجوز تفويضه بتشكيل اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يشكل إهداراً لضمان التحقيق، إذ يجعل من الموظف المحال للتحقيق عرضة للمساءلة من قبل موظفين أقل منه درجة أو خبرة، وعرضة للتعسف من الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف المتهم، وقد ينتج عنها غلو في العقوبة، ومن جهة أخرى فإن اللائحة ذاتها أعطت مطلق الصلاحية لرئيس الدائرة الحكومية بتحديد أعضاء لجنة التحقيق.
وفي تعديل آخر صدر بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني يحمل الرقم (14) لسنة 2020 (قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م) [12]، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعلى ضوء إخفاق الإجراءات التي حددها المشرع في اللائحة السابقة رقم (11) لسنة 2013 المشار إليها سابقاً، ذهب مجلس الوزراء باتجاه تعديل اللائحة السابقة رقم (11) من زاوية تقييد السلطة التقديرية لرئيس الدائرة الحكومية فقط، وذلك من خلال تحديد عضوية أعضاء اللجنة. حيث أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (14) لسنة 2020، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي من المفترض أن يكون قد بدأ العمل به، وفيما يتعلق بتشكيل اللجان التحقيقية للموظفين من الفئة الأولى وحتى الفئة الخامسة، بيّن القرار من خلال المادة الثانية منه الآتي: “تعدل الفقرة (3) من المادة (2) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو التالي: تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء، بحيث تشمل مندوباً واحداً عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف المحال للتحقيق، ومندوبين من دوائر حكومية أخرى، على أن يكون بينهم موظف بمسمى قانوني، ويعين أحدهم ليكون رئيس اللجنة، وتكون درجات الأعضاء مساوية أو أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق”.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكن القول أن جميع هذه الإجراءات والتعديلات المتعلقة بتشكيل اللجان التحقيقية وتحديد آلية عملها وإجراءاتها لا تتواءم مع نصوص القانون، سيما في المواد (69)و(70)و(71)[13]، وكذلك مع المواد التي تم الإبقاء عليها دون تعديل في اللائحة الأصلية رقم (45) لسنة 2005، وتخالف أيضاً نصوص اللائحة التي اشترطت كضمانة أساسية للتحقيق حفظ محاضر ووثائق التحقيق في ملف فرعي وسري يتبع للملف الوظيفي، المحفوظ للموظف لدى ديوان الموظفين العام، إذ أن التعديلات التي تمت بنقل صلاحية التحقيق للدائرة الحكومية، مما يستتبع ذلك إهدار هذه الضمانة بوصفها من الضمانات الأساسية في التحقيق التأديبي، بحيث يصبح ملف التحقيق محفوظاً لدى الدائرة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ونسخة منه لدى ديوان الموظفين العام.
- ضمانات الموظف في التحقيق الإداري
إن أي اجراء يتعلق بتأديب الموظف، يجب أن يبنى على ضمانات تكفل العدالة في الإجراءات، سواء كانت من خلال استجواب الموظف المتهم في التحقيق التمهيدي معه والتي خصصنا لها الفرع الأول: الضمانات السابقة على التحقيق الإداري، أو الضمانات المعاصرة واللاحقة على التحقيق الإداري كفرع ثاني، تكفل للموظف المتهم عدالة في العقوبة تتناسب مع المخالفة التأديبية المرتكبة (القبيلات، 2025، ص416).
- الضمانات السابقة على التحقيق الإداري
وكما ذكرنا سابقاً أن جهة الإدارة لا تفرض العقوبة على الموظف، إلا بمخالفته لواجبات ومهام ومسؤوليات الوظيفة الموكلة له، أو مخالفة الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات ومدونات السلوك الوظيفي الخاصة بعمله، وإن لم تراعِِ الإدارة في إصدار قرارها بشأن تأديب الموظف في حال المخالفة التأديبية لما سبق؛ يكون قرارها مخالفاً للقانون، وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم 78/99 بتاريخ 14/12/2004[14]، بقولها: “ما دام لم يثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة تتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، فإن قرار فصله يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون وواجب الإلغاء”.
تُعد الضمانات التي توفرها القوانين فيما يتعلق بالتحقيقات الإدارية متعددة الأوجه، وتختلف عبر الأنظمة القانونية المختلفة، ولكنها تهدف عمومًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة. ففي تركيا، يضمن مبدأ الفحص الرسمي في الإجراءات الإدارية عدم انتقال عبء الإثبات بشكل غير عادل إلى المتهم، مع الحفاظ على افتراض البراءة (Uçar & Türe, 2021, P. 973). وفي البرازيل، تعتبر مبادئ الدفاع الواسع والتناقض أمرًا بالغ الأهمية في العمليات الإدارية التأديبية، حيث يمكن أن يؤدي عدم مراعاة هذه المبادئ إلى جعل أعمال لجنة المعالجة غير شرعية (Silva & Diniz 2020, P. 364)، وفي إندونيسيا، يتم تنظيم سلطة موظفي الخدمة المدنية في إجراء التحقيقات لضمان اليقين القانوني، مع إجراءات محددة لإخطار محققي الشرطة والتعاون معهم (Nasution et al., 2023, P. 235).
وبشكل عام، تؤكد هذه الأطر القانونية بشكل جماعي على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في الدفاع، وافتراض البراءة كضمانات أساسية في التحقيقات الإدارية، مما يضمن حماية حقوق الأفراد مع السماح للدولة بإدارة النظام العام والحوكمة بفعالية.
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني، نص في المادة (74) على الدائرة دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والعمل على توعية الموظفين، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً[15]، وما يؤخذ على هذا النص أنه بالرغم من تحديد الجهة المنوط بها دراسة هذه الأسباب إلا أنه لم يوضح المعايير الكفيلة بوضع الآليات، وكان الأفضل على المشرع أن يضع جهة إجرائية مكونة من لجنة متخصصة لغايات تكريس هذه الآليات وتنفيذها على أرض
الواقع، باعتبار ذلك ضمانة أساسية تمنع أو تخفف من وطأة اللجوء إلى التحقيقات الإدارية حال ارتكاب مخالفة، وذلك يأتي في إطار التدابير الوقائية التي تحول دون اللجوء إلى إجراء التحقيق الإداري.
وجاء في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام من خلال المادة (72) لاسيما الفقرة (أ/1)، والمادة(75/و)[16]، التأكيد على عدم جواز إيقاع العقوبة على الموظف المتهم إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق أو مجلس تأديبي، بحسب الإجراءات القانونية الموضحة فيها.
وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، من خلال قرارها رقم (191) في الدعوى رقم 53 /2005، بشأن عدم إحالة الموظف إلى لجنة تحقيق، خلافا للمادة (69)[17]، من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، والذي جاء فيه: “ولما كان القرار محل الطعن قد صدر بحق المستدعي دون أن يتم تطبيق أحكام المواد سالفة الذكر ودون أن تتم إحالته إلى لجنة تحقيق وسماع أقواله، فإنه وتأسيساً على ما تم تبيانه، فإن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين مما يستوجب إلغاؤه)[18].
إن المادة (72/أ/3) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، نصت صراحة على أنه: يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن يكون رئيسها برتبة وظيفية أعلى أو مساوية للموظف المحال إلى التحقيق[19].
ويمكن تلخيص الضمانات السابقة على التحقيق الإداري بالآتي:
أولاً: المواجهة وكفالة حقوق الدفاع
يجب إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه ومواجهته بما ارتكب من أعمال مخالفة للقانون، وتمكينه الاطلاع على ملفه الوظيفي العادي والسري وملف الدعوى التأديبية نفسها، وذلك بما ينسب إليه من مخالفات وتهم موجه إليه، حيث أن المادة (72/ب/1) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بينت توفير الضمانات للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه[20]، والتي بينت أنه يراعى عند إجراء التحقيق ما يلي:
- اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابةً أو شفاهةً ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط ألا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني (الحسن، 2024، ص123).
- أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر موقعة من أعضاء لجنة التحقيق.
- أن تكون إفادات الموظف والشهود موقعة من قبلهم.
إلا أنه وبعد مراجعة الباحث لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تبين أنها تطرقت إلى واجب الحِينيَّة أو الفَوريَّة في توجيه الاتهام، وتبليغ الموظف المتهم الخاضع لإجراءات التأديب، بقرار إحالته للتحقيق، حيث ينبغي عند مواجهة المتهم أن يتم إعلامه بصورة واضحة وجلية ولا لبس فيها، بالتهمة الموجة إليه، وذلك لمسألتين:
- حتى لا يَنجر الموظف المتهم إلى الوقوع في دائرة الاتهام نتيجة عدم معرفته بالتهمة الإدارية الموجهة إليه.
- حتى يتسنى للموظف المتهم إعداد دفوعه ودفاعه وفقاً للأصول، وبمدة زمنية مناسبة، لدرء التهمة عن نفسه، وألا يكون ضحية للاتهام المتأخر (عليات، 2025، ص344).
وإن ما سبق ذكره قد جرى تأكيده بموجب المادة (73/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تنص على: “إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه”[21]،
وتطبيقاً لما سبق، فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه “… يتبين من نص هاتين المادتين انهما تستهدفان توفير الضمانات لسلامة التحقيق الاداري وتيسير وسائله بغية الوصول الى الحقيقة ومن الضمانات الجوهرية التي حرص الشارع على مراعاتها في التحقيق الاداري مواجهة المشتكى عليه بحقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته علما بالوقائع التي تنطوي على المخالفات المنسوبة اليه والتي تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلي بأوجه دفاعه ويكون على بينة من امره وخطورة موقفه ويتهيأ للدفاع عن نفسه كما يجب مواجهته بما يثبت ضده من ادلة اتضحت من الاوراق او شهادة الشهود ومناقشته في هذه الأدلة”[22].
وكذلك ما قضت به المحكمة نفسها، حيث أوضحت بأنه “…وحيث ان النعي على بطلان التحقيق لعدم تمكين المستدعى من الدفاع عن نفسه في غير محله اذ لا يوجد في التحقيق في الدعاوى التأديبية ما يوجب افراغها في شكل معين وضوابط التحقيق الاداري واصوله غير محكومية بنصوص ولكنها تصدر في كنف قاعدة اساسية كلية هي تحقيق الضمان والدفاع للمشتكى عليه والاخلال بهذه القاعدة يجعل التحقيق مشوبا بالقصور. وقد تم تامين هذه الضمانات في التحقيق المشار إليها للمستدعي. حيث تم سماع أقواله وتحقيق دفاعه بما يكفل الاطمئنان إلى صحة الوقائع المسندة إليه. وليس في إجراءات التحقيق أي إخلال بهذه الضمانات”[23].
وعلى نفس المنوال، فقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن “…كما يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيقات القانونية بمراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف ومواجهته بحقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه لأنه لا يجوز توقيع العقاب على الموظف إلا بعد الاستماع إلى أقواله وتحقيق دفاعه وأن تكون الوقائع المنسوبة له
تشكل بحد ذاتها مخالفة مسلكية يحاسب عليها وهذا ما حصل ما بين لجنة التحقيق والمستدعيين وقد جاء القرار المطعون فيه الثاني متفق مع الأصول القانونية وأحكام المادة (68) من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005، كما أن المستدعيين لم يقدموا أية بينة على الإطلاق تناقض ما جاء في محضر التحقيق مع الشهود مما يدل على أن القرار المطعون فيه الثاني جاء متفقاً وأحكام القانون”[24].
ويمكن القول إنه لا معنى لحق الدفاع ما لم يقترن بحرية الدفاع التي تكفل استعماله، والعبرة ليست بتقرير الحق أو الضمان، وإنما الوسائل التي تكفل فاعلية هذا الحق أو الضمان للمتهم. (عليات، 2025، ص354).
ثانياً: ضمانة التجرد من الاعتبارات الشخصية
تضمَّن نظام الموارد البشرية في القطاع العام ضمانة تنحي رؤساء وأعضاء لجان التحقيق المشكلة حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وعدم جواز كل من شارك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في ايقاع العقوبة أو الحكم فيها، وهذا ما بينته أحكام المادة (73/ب)[25].
ويعلق الباحث على أحكام هذه المادة أنها لم تتضمن تنحي رؤساء وأعضاء لجان التحقيق بشكل فوري في الحالات التي توجد فيها اعتبارات شخصية من شأنه التأثير على مجريات التحقيق وإيقاع العقوبة، كي لا يكون هناك مجال للتعسف من السلطة المختصة بالتحقيق.
وبخصوص موقف المشرع الفلسطيني بقانون الخدمة المدنية النافذ، فإن القانون ولوائحه التنفيذية وتعديلاتها قد خلت من تنظيم هذه الضمانة المهمة التي لها تأثير كبير في سير مجريات التحقيق وإيقاع العقوبة أو الحكم فيها؛ لهذا نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم هذه المسألة في أقرب فرصة.
ثالثاً: مدة إجراء التحقيق
مدة إجراء التحقيق لم يتطرق لها المشرعان الأردني والفلسطيني، بحيث يجب على لجنة التحقيق أن تَتقيَّد بالمدة المشار إليها في قرار تشكيلها، أو بالمدة التي يُحددها القانون.
إذ لا يُعقل منطقياً ألا يتم ضبط مدة التحقيق، على نحو يُمكِن أن تكون معه تلك المدة بلا ضابط أو رقيب، بما يُهدد الاستقرار الوظيفي للموظف، ويجعل من لجنة التحقيق سيفاً مسلطاً على ذلك الموظف، على نحو ينافي المنطق والعدالة والقانون.
رابعاً: حق الدفاع والاستعانة بمحام
يعتبر حق الدفاع حق مقدس في جميع المحاكمات لاسيما تلك المحاكمات التي ينتج عنها عقوبات، مثل المحاكمات الجنائية والتأديبية، وعليه فقد استقر القضاء التأديبي في مصر بتطبيق ذات المبادئ المقررة في القضاء الجنائي، وهذا ما نص عليه صراحة قانون مجلس الدولة الجديد، بأن للعامل المقدم الى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محامياً، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصياً (الطماوي، 1979، ص 618).
كذلك نص التشريع الفرنسي بجواز استعانة الموظف بمحام للحضور أمام هيئات التحقيق وذلك وفقاً لاختياره، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (311) الصادر في 14 فبراير، وأن لهذا الحق أهمية كبيرة إذ أن حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة يساعد على توضيح الحقيقة وفيه سلامة للإجراءات وعدم استعمال الوسائل المحظور استعمالها مع المتهم (محارب، 2004، ص 235).
وبالرجوع إلى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بينت المادة (79) إمكانية استعانة الموظف المحال إلى المجلس التأديبي توكيل محامٍ لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، واشترطت المادة ذاتها حضور هذا الموظف جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه[26].
في حين أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (45) لسنة 2005، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة1998وتعديلاته، لاسيما الفقرة (2) من المادة (89) من اللائحة المذكورة قد جاء فيها: للموظف أن يَحضر جميع جلسات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته، ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات، وعلى كافة الأوراق المتعلقة بها، وأن يستعين بمحام في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلك[27].
والأصل العام يقضي بعدم جواز الاستعانة بغير المحامي للدفاع أو الإنابة عن الموظف المتهم، تحقيقاً للعدالة وعدم الإخلال بحق الدفاع، إلا إذا كان أحد الزملاء أو الأصدقاء ويقتصر دوره على إيصال مذكرة منه للمجلس نيابة عنه لإيصالها فقط (كنعان، 2019، ص 191).
- الضمانات المعاصرة واللاحقة على التحقيق الإداري
1.2.3. الضمانات المعاصرة
ترمي هذه الضمانات إلى تحقيق العدالة وتوفير شعور بالاطمئنان والارتياح للموظف العام، والتي تعزز شعوره بحيادة لجنة التحقيق وعدم انحيازها إلى طرف دون الآخر، وخلق قناعة لديه في التزام السلطة الانضباطية بالاعتبارات القانونية في إيقاع العقوبة، وتكمن أهم الضمانات المعاصرة في حيادية لجنة التحقيق، وتسبيب القرارات التأديبية (المولى، 2012، ص 297)، وسيتم شرح هاتين الضمانتين على النحو الآتي:
الحيادة وعدم الانحياز
نصت المادة(72/ب/4)، من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على: “مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة”.
وتعتبر حيدة لجنة التحقيق الإداري من أهم الضمانات اللاحقة، حيث يشترط توفر مقومات التحقيق القانوني السليم في المحققين واستقلالهم ونزاهتهم وأمانتهم (الحسن، 2024، ص231).
وتطبيقاً لواجب الحياد وعدم الانحياز، فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه “… كما أن مدير عام سلطة الطيران المدني قد حضر التحقيق طالما أنه اشترك في التحقيق وأشرف عليه حسب الثابت من الأوراق، ولما كان الحال كذلك فإنه لا يجوز له أن يصدر القرار الإداري، لأنه ليس للمحقق أن يصدر حكماً”[28].
وبنفس التوجه، فقد قضت المحكمة الإدارية الفلسطينية بأنه “… والذي نجده إزاء ذلك أن القانون (نظام الهيئات المحلية) حينما اشترط وجود المدير التنفيذي أو أحد كبار موظفي الهيئة المحلية في لجنة التحقيق -ما لم يكن وجوده متعذراً- إنما قصد من وراء هذا الاشتراط توفير الحد الأدنى من ضمان حيدة لجان التحقيق وعدم انحيازها لمجلس الهيئة المحلية، وبالتالي ضمان التحقيق العادل مع الموظف”[29].
تسبيب الحكم أو القرار التأديبي
والتسبيب مهم لبث طمأنينة في نفوس المتقاضيين هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جوهرية لإعمال رقابة الجهات المختصة قضائياً، وعليه فإن المشرع نفسه قد فرض ضمانة التسبيب في القرارات الإدارية الصادرة في مجال التأديب، كما أنه اشترط المشرع في جميع قوانين العاملين الحكوميين أو في القطاع العام أن (….يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً)، ولكي يؤدي التسبيب دوره، يجب أن يتناول وقائع الدعوى من حيث شخص المتهم، الأفعال المسندة إليه، والأدلة التي استندت إليها اللجنة في تكوين قناعتها سلباً أو ايجاباً، وكافة النصوص القانونية المطبقة على أن يكون الحكم عبارة عن خلاصة منطقية لكل ما ذكر (الطماوي، 1979، ص 661) و(أبو ارميله، 2024، ص337-338).
ويؤكد الفقه أن تسبيب القرارات التأديبية يشكل ذكر الأسباب في القرار التأديبي ضمانة لحماية الموظف من غلو الإدارة والغاية من ذلك رقابة القضاء على صحة سبب اتخاذ العقوبة وتناسبه مع الفعل، والتأكد من أن اللجنة قد اطلعت على وقائع الخصومة والمستندات وما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع ومدى التزام اللجنة بالاعتبارات القانونية في توقيع الجزاء والتي بنت عليها الحكم التأديبي لكي يطمئن الموظف لسلامة الحكم وكله تحت رقابة قاضي الإلغاء (عمرو، 2010، ص 257).
وقد جاء نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ملبياً لأبجديات تسبيب القرار التأديبي طبقاً للمادة (73/هـ) التي تنص على أهمية تسبيب القرار التأديبي تحت طائلة تقرير البطلان الاجرائي.
وتطبيقاً لما سبق، فقد أكدت محكمة العدل العليا الأردنية على أن “…وبما أن نظام الخدمة المدنية المشار إليه قد اشترط تسبيب القرار التأديبي، فان هذا الاجراء اي التسبيب يصبح شكلا اساسيا في القرارات التأديبية يترتب على اهماله بطلانها، ولكي يحقق التسبيب الغرض المناط به يجب ان يكون واضحا بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته، فاذا اكتفى القرار التأديبي بترديد حكم القانون دون ان يوضح الاسباب التي من اجلها اخذ، اعتبر في حكم القرار الخالي من التسبيب”[30].
2.2.3. الضمانات اللاحقة على إصدار القرار التأديبي
تنبع أهمية هذه الضمانات في أنها الفرصة الأخيرة التي يلجأ إليها الموظف في حالة عدم اقتناعه بعدالة العقوبة الانضباطية المفروضة عليه، أو أن الضمانات السابقة والمعاصرة لم تسعفه في الحصول على حقه المقرر له تشريعياً وقضائياً، فمن الطبيعي أن يلجأ الموظف إلى الضمانات اللاحقة التي منحه إياها القانون والمتمثلة في التظلم من القرار التأديبي الصادر في حقه لدى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية التي تتبعها هذه الجهة، وهذا ما يسمى بالتظلم الإداري، وكذلك ممارسة حقه في الطعن أمام القضاء وهي قمة الضمانات اللاحقة على صدور القرار التأديبي (المولى، 2012، ص 309). وعليه سنقوم في شرح مفصل للضمانتين المذكورتين أدناه:
1.2.2.3. التظلم الإداري
بيّن المشرع في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بنص المادة (88) الغايات من تطبيق مفهوم التظلم، الذي يهدف إلى فتح قنوات الاتصال بين الموظف والإدارة، ويحد من المخالفات والتجاوزات، ويمنع من تكرارها مما يساهم في مكافحة الفساد، وقد أكد النظام على أحقية الموظف في تقديم تظلمه طبقاً للمادة (89) من ذات النظام[31].
ولم يتطرق النظام في باب التظلم على الجزاءات التأديبية بحالة التظلم الوجوبي وإنما التظلم الجوازي.
وتوضح المادة (92) من النظام المذكور، ما يتعلق في التظلمات المبنية على الكيدية الوارد بها معلومات غير صحيحة أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين، ومصير الموظف الذي تقدم بها.
إذ تبين المادة (90/أ/1) الإجراءات المتخذة في التظلم حيث يقوم الوزير بتشكيل لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات، ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها، ومروراً في عمل اللجنة المذكورة وفق إجراءات شفافة وموثقة استناداً إلى المعززات والبينات والقرائن[32].
وبعد رفع قرار اللجنة إلى الجهة التي حددها النظام يتم إعلام الموظف في قرار تظلمه خطياً خلال المدة التي حددها النظام[33]، حيث تنص المادة (91/ج) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على أنه “يجب على الدائرة اعلام المتظلم خطياً بنتيجة تظلمه”.
وقد بينت المادة (91/أ/ب، د) من النظام، مدد الفصل في التظلم وتقديمه سواء للدائرة أو الهيئة، وبينت البت فيه، حيث نصت المادة (91/أ)، على: “يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ علم الموظف بالإجراء الذي يؤثر على حقوقه أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير، على أن يتم تزويد الموظف المتظلم بنسخة من طلب التظلم مختومة بخاتم الدائرة”[34].
وفيما يتعلق بالبت في التظلم نصت المادة (91/ب) من النظام على أن يتم البت به خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.
وبينت المادة (91/د) من النظام أنه يجوز للموظف التقدم بتظلم للهيئة خلال سبعة أيام عمل في حال لم تتم الإجابة على تظلمه المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتقوم الهيئة بدورها بالتحقق من صحة التظلم المرفوع إليها وعلى الدائرة تزويد الهيئة بالوثائق ذوات الصلة كافة بناءً على طلب الهيئة، التي بدورها ترفع تنسيبها بشأن التظلم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه[35].
تتحرك هذه الرقابة نتيجة تقديم تظلم من ذوي الشأن في قرارات إدارية صادر بحقهم، وذلك لإعادة النظر في تلك القرارات، ويقدم هذا التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار مباشرةً، ويسمى التظلم في تلك الحالة بالتظلم الولائي، أو يقدم التظلم إلى الجهة الرئاسية لمصدر القرار، ويسمى التظلم في هذه الحالة بالتظلم الرئاسي، وهذا يعني أن الرقابة في تلك الحالتين هي رقابة ذاتية تقوم بها الإدارة لإعادة النظر في القرارات الصادرة منها سواء بإلغائها أو تعديلها (أبو سمهدانة، د.س، ص 171).
أما فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني النافذ لا سيما المادة (105) المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، حيث تتحدث حول الجهة التي يتوجب على الموظف التظلم إليها، والمدد القانونية للتظلم من تاريخ العلم بالقرار، وكذلك المدد الممنوحة للإدارة للبت في التظلم، والإجراء المتوجب اتخاذه في حال رفض القرار بلجوئه للقضاء[36].
وبينت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2005 وتعديلاته، لاسيما المادة (160)، آلية التظلم على أحكام القرارات الإدارية بما يشمل القرارات الإدارية وبما يشمل أحقية التظلم وإجراءاته ومدده وآليات الفصل به والتعقيب عليه[37].
ويمكن القول بوجوب تعديل هذه المادة ليكون التظلم إلى الوزير المختص لأنه صاحب الحق في تعديل القرار أو سحبه، وأن تضاف فقرة ثانية لنفس المادة ليكون ميعاد رد الوزير خلال ستين يوماً من تقديم التظلم، وإذا لم يقم بالرد خطياً يكون التظلم مرفوضاً، وأنه يجوز للمتظلم خلال ستين يوماً الطعن بالقرار لدى المحاكم الإدارية المختصة.
ويتضح جليا مما سبق أن الرقابة في هذه الحالة تأتي عقب قيام المضرور من التظلم من القرار الصادر بحقه، وتقوم الإدارة بمراجعة ذلك القرار وتستطيع الغاءه أو سحبه أو تعديله وفقاً للقانون.
2.2.2.3. الرقابة القضائية[38]
تعد الرقابة القضائية أكثر أنواع الرقابة فاعلية، نظراً لما يتمتع به القضاء من استقلالية وحيادية وضمانات قانونية، واتصافه بالموضوعية، وتوليه مهمة تحقيق العدالة والانصاف بواسطة ما يصدره من أحكام تحوز قوة الشيء المقضي به، ومن خصائص الرقابة القضائية أنها لا يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها عن طريق التصدي المباشر فهي لا تتحرك إلا بناءً على طعن من الأفراد والهيئات الخاصة (أبو سمهدانة، د.س، ص 186) و(الحسن، 2024، ص352).
في فلسطين تتولى المحاكم الإدارية مهمة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، وذلك سنداً لقانون المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020، حيث ينص القانون المذكور في المادة (20/1/د) على أن: “1. تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها بالآتي: د. الطعون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو التصنيف أو التثبيت أو الترقية أو النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستيداع أو التأديب أو الفصل من الخدمة أو الإيقاف عن العمل أو الرواتب أو العلاوات أو الزيادات السنوية أو الحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو المتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة، أو القرارات الصادرة عن السلطات التأديبية، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك” (الوقائع الفلسطينية، 2021، ص 19).
ومن الجدير ذكره، أن الرقابة القضائية تتم في شكل طعن أو دعوى أو طلب، وعليه ينبغي احترام مواعيد محددة لذلك، أي أنه لا يتم قبول الدعوى إذا تمت بعد فوات المواعيد المنظمة قانوناً (أبو ارميله، 2024، ص234).
وهذا ما أكدت عليه أحكام المادة (23) من قانون المحاكم الإدارية النافذ في فلسطين، حيث نصت على أن تقديم الاستدعاء إلى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو تبليغ صاحب الشأن به، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب إليها (الوقائع الفلسطينية، 2021، ص 19).
ومن الأهمية بمكان التأكيد من أن الرقابة القضائية تُصدر قراراتها في شكل أحكام قضائية تحوز قوة الشيء المقضي به، وتعتبر الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، وهذا ما أكده قانون المحاكم الإدارية، حيث نصت المادة (46/2) على أن: “2. أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية واجبة النفاذ بالصورة التي تصدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار”[39].
وتعتبر الأحكام الصادرة من المحكمة الادارية أحكام قابلة للطعن امام المحكمة الإدارية العليا، وهذا ما أكده قانون المحاكم الإدارية، حيث نص على أن “تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية كافة، وتنظر فيها من الناحيتين الموضوعية والقانونية”[40] .
أما في الحالة الأردنية فقد عالج المشرع الأردني، الجهة المختصة بالرقابة القضائية على القرار التأديبي، في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، والذي تضمن في أحكامه الاجراءات الواجب اتباعها من رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وأن الاختلاف بين الحالة الفلسطينية والأردنية أن الدستور الأردني في المادة (100)، نص على إنشاء القضاء الإداري على درجتين، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة (3) من قانون القضاء الإداري المشار إليه أعلاه، على إنشاء قضاء بالمملكة يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.
ويعد قانون القضاء الإداري الأردني، نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني، حيث تم الانتقال من مرحلة القضاء الإداري الموحد إلى مرحلة القضاء المزدوج (العجارمة، 2019، ص 312).
وبالعودة إلى موضوع الدراسة فإن المادة (5) من قانون القضاء الإداري الأردني، بينت اختصاص المحكمة الإدارية دون غيرها في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، وأشارت الفقرة الرابعة من المادة نفسها إلى اختصاص المحكمة بالنظر في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.
أما فيما يتعلق بالمحكمة الادارية العليا الأردنية التي أنشأت أيضاً بموجب أحكام قانون القضاء الاداري، وتنظر هذه المحكمة وفقاً لاختصاصها بالطعون بالأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية أي أنها تعد محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري الأردني وهذا ما نصت عليه المادة (25) من القانون[41].
ويرى الباحث أن النهج الذي اتبعه المشرع الأردني هنا في تكوين القضاء الإداري في الأردن على درجتين يعطي ضماناً أكبر ونتائج أفضل للطاعن في قرار الإدارة، مما يحقق العدالة وزيادة ثقة المواطنين بالنظام القضائي، ويحفز الإدارة على عدم السرعة في اتخاذ قرارات مُتعسفَّة بحق الموظف العام، لاسيما ما يتعلق بلجان التأديب، وهذا النهج نفسه قد اتبعه المشرع الفلسطيني بتفعيل المحاكم الإدارية المنشأة بموجب قانون المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020، وذلك بالتقاضي على درجتين، بعد أن كان يقتصر على درجة واحدة بواسطة محكمة العدل العليا الفلسطينية.
وتطبيقاً لما سبق، فقد مارست المحكمة الإدارية الفلسطينية رقابتها في مجال الرقابة على العقوبات التأديبية المنبثقة عن التحقيق الإداري، حيث قضت بأنه “…وفي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب – وهو انتظام المرافق العامة – وأن معيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معياراً شخصياً، وإنما معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع مقدار الجزاء وخاصة أن المستدعي هو من قام بإعلام وابلاغ مرؤوسيه باكتشاف التزوير والتلاعب على الايصالات البنكية من قبل احد التجار أو المتعاملين مع الدائرة الحكومية، ولم تقم أية بينة على علاقة المستدعي بذلك التزوير أو التلاعب، بل إن جل ما خلصت إليه لجنة التحقيق في استنتاجاتها المشار إليها في تقريرها المرفوع للمستدعى ضده الأول، أن عمليات التزوير والتلاعب التي جرت على الإيصالات البنكية من قبل أحد التجار المتعاملين مع الدائرة الحكومية، كان بالإمكان اكتشافها ووقفها لو قام الموظفون المكلفون بالدخول على شاشة البنك الموجودة في دائرة جمارك السيارات للتحقق من الدفعات، وأن التاجر المتلاعب معروفٌ لدى المستدعي بأنه شخصٍ خطر ومتلاعب ورغم ذلك لم يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بإجراء أي تدقيق اضافي على المعاملات التي
يحضرها للدائرة أو التعامل معه كشخصٍ خطر، بل على العكس من ذلك كان لديه الأفضلية بالتعامل عن بقية التجار وكان المستدعي يميزه بالتعامل دون أن يلتفت لتذمر موظفي الدائرة والتجار من هذا التمييز في المعاملة. وبإمعان النظر في هذه الاستنتاجات، وإن كانت تؤلف مخالفات مسلكية من جانب المستدعي تستوجب إنزال العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، إلا أننا نرى أن الاخذ بها كمسلمات على إطلاقها أو اعتبارها مخالفة جسيمة تستدعي أقسى العقوبات، إنما تاباه وتنقضه حقيقة أن المستدعي هو من أبلغ الإدارة عن التزوير والتلاعب بالإيصالات البنكية، وبالتالي فإن ما أقدم عليه المستدعي من مخالفات تمثلت بالتقصير وعدم تأديته للأعمال المنوطة به بدقة لا تستدعي عقوبة احالته على المعاش، وبالتالي فإن احالته على المعاش فيها غلو ولا تتناسب مع درجة خطورة الذنب الذي ارتكبه، وهو عدم تشديده ورقابته على تدقيق الموظفين للمعاملات الواردة للدائرة، لاسيما أنه لم تتم ادانته من قبل لجنة التحقيق الانضباطية بجميع ما نسب إليه من مخالفات. إزاء هذا الذي أشرنا إليه، نجد أن قرار توقيع العقوبة المذكورة ينضوي على غلوٍّ ولا يتلاءم مع الوقائع التي أسس القرار عليها، وبذلك ينجلي الخطأ الواضح في التقدير من طرف الجهة المستدعى ضدها، بما ينال من القرار المتظلم منه من حيث سلامة سببه”[42].
وفي الختام، فإنه يتوجب التأكيد على ضرورة شمول الرقابة القضائية لرقابتي المشروعية والملاءمة، حيث يمارس القضاء الإداري دوره إزاء القرارات المتعلقة بالتحقيق الإداري وما ينبثق عنه بما يشمل رقابة مشروعية القرار الإداري، وكذلك ملاءمته، وتحديداً في الحالة التي يكون فيها سلطة تقديرية للإدارة إزاء المسائل المتصلة بالتحقيق الإداري ونتائجه (الطماوي، 2017، ص26).
الاستنتــــاجــــات:
- إذا وقع نقص في الكفايات الوظيفية للموظف، وعدم قيام الموظف بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحقيق الإداري، وتوقيع الجزاء التأديبي وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون، وهذا أحد مبررات اجراء التحقيق الإداري، وصولاً لتحقيق أهدافه، بما يتناسب مع غايات التشريع المقارن.
- إن التحقيق في المخالفات التأديبية يمر بمراحل عدة، إذ يجب على الجهة المختصة قانوناً أن تأخذ بعين الاعتبار الفحص والتحري وجمع الاستدلالات، لكشف حقيقة العلاقة بين الموظف المتهم والتهمة المنسوبة إليه ابتداءً، وفقاً لمبادئ العدالة، ومن ثم استكمال الإجراءات من خلال سماع إفادة الموظف وسماع الشهود ومن يلزم، والاستناد إلى الأنظمة والقوانين على قاعدة، “لا عقوبة إلا بنص”، وذلك حفاظاً على سمعة الموظف ومكانته.
- هناك ثلاثة أنظمة معمول بها في أنظمة التأديب الإداري، وهي: النظام الرئاسي، والنظام شبه القضائي، والنظام القضائي، علماً بأن المعمول به في الأردن وفلسطين هو نظام التأديب الرئاسي والنظام شبه القضائي.
- ضمنت القوانين والأنظمة المختصة عدداً من الضمانات التي تكفل للموظف المتهم تحقيق عادل، وعقوبة تتناسب مع الفعل، إلا أنه رغم حداثة بعضها يشوبها النقص لا سيما في ضمانات التحقيق السابقة والمعاصرة واللاحقة مع الموظف المتهم.
- من أبرز الضمانات السابقة على التحقيق الإداري مواجهة الموظف المتهم بالفعل المنسوب اليه، وإعلامه به، وحق الدفاع عن نفسه وتوكيل محام للدفاع عنه، إلا أن نظام إدارة الموارد البشرية الأردني في القطاع العام لم يرد بذلك نصاً صريحاً فيما يتعلق بحق الموظف المتهم بتوكيل محامٍ.
- من الضمانات المعاصرة حياد المحكمة، وتسبيب القرار التأديبي، والضمانات اللاحقة هي التظلم الإداري، والرقابة القضائية.
- نظمت مواد قانون الخدمة المدنية الفلسطيني آليات التظلم والمدد القانونية له، وذلك بشكل يتعلق بنتائج التحقيق الإداري، ضماناً لتحقيق الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف التشريع المقارن المنصبة على بلورة ضمانات حقيقية للتحقيق الاداري.
- تعتبر الرقابة القضائية الفرصة الأخيرة للموظف للاعتراض والطعن في القرار التأديبي ويعتبر من أهم الضمانات.
- تختص المحاكم الادارية في فلسطين بالنظر في الطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة، بما في ذلك القرارات المتصلة بالتحقيق الاداري وما ينبثق عنه.
- وفق قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، وكذلك قانون المحاكم الإدارية الفلسطيني، تختص المحكمة الادارية العليا بالطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن المسائل المتصلة بالتحقيق الإداري والعقوبات التأديبية.
- يمتاز كل من القضاء الإداري في الأردن وفلسطين بأنه على درجتين للتقاضي، وهما المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا.
التوصيـــات:
تتمحور التوصيات حول جملة من التعديلات التشريعية التي يتوجب على التشريع المقارن القيام بها، ضماناً لنجاعة الرقابة على التحقيق الإداري وضماناته، وهي على النحو الآتي:
- ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ليصبح أكثر حداثة ومواءمة مع متطلبات الوظيفة العامة والإدارة العامة، ولكثرة الإشكاليات التي ترد في اللوائح التنظيمية والتي تتعارض مع أحكام القانون لا سيما فيما يتعلق بالشق الخاص بتشكيل لجان التحقيق للفئة الأولى فما دون.
- ضرورة حسم دور المجلس التأديبي بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني، تبعاً لعدم وضوح دوره، في ظل وجود لجان التحقيق المشكلة طبقاً للمادة (72) من نفس النظام، لذلك، على المشرع ان ينص بشكل صريح وواضح على طبيعة اختصاص المجلس التأديبي المذكور في المادة (75) من نفس النظام.
- تعديل قوانين الخدمة المدنية، بتضمينها نص صريح وواضح يتضمن إلى واجب الحِينيَّة أو الفَوريَّة في توجيه الاتهام، وتبليغ الموظف المتهم الخاضع لإجراءات التأديب، بقرار إحالته للتحقيق، فينبغي عند مواجهة المتهم أن يتم إعلامه بصورة واضحة وجلية ولا لبس فيها، بالتهمة الموجة إليه، وذلك لمسألتين:
- حتى لا يَنجر الموظف المتهم إلى الوقوع في دائرة الاتهام نتيجة عدم معرفته بالتهمة الإدارية الموجهة إليه.
- حتى يتسنى للموظف المتهم إعداد دفوعه ودفاعه وفقاً للأصول، وبمدة زمنية مناسبة، وألا يكون ضحية للاتهام المتأخر.
- ضرورة تضمين كافة تشريعات الخدمة المدنية نصاً صريحاً تتعلق بأحقية الموظف المتهم الخاضع لإجراءات التأديب، بإمكانية الاستعانة بمحام للدفاع عنه أو تمثيله في لجنة أو مجلس التحقيق التأديبي، وذلك تحقيقاً لضمانات التحقيق التأديبي الفاعل.
- تعديل عدد من مواد نظام إدارة الموارد البشرية الأردني في القطاع العام لتضمينه مدة محدد لإجراء التحقيق، حيث إنه لم يتطرق القانون ولا النظام، لمدة إجراء التحقيق ويجب على لجنة التحقيق أن تَتقيَّد بالمدة المشار إليها في قرار تشكيلها، أو بالمدة التي يُحددها القانون.
إذ لا يُعقل منطقياً ألا يتم ضبط مدة التحقيق، على نحو يُمكِن أن تكون معه تلك المدة بلا ضابط أو رقيب، بما يُهدد الاستقرار الوظيفي للموظف، ويجعل من لجنة التحقيق سيفاً مسلطاً على ذلك الموظف، على نحو ينافي المنطق والعدالة والقانون.
- ضرورة أن تشمل الرقابة القضائية لرقابتي المشروعية والملاءمة، بحيث لا يقتصر دور المحاكم الإدارية على فحص مشروعية إجراءات التحقيق والنتائج المترتبة عليه، وإنما ملاءمة ذلك أيضاً.
- ضرورة الاستفادة من التجربة الأردنية التي تتضمن التركيز على إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وتخصيص نظام قانوني لذلك، وتعميم هذه التجربة على الصعيد الفلسطيني، من خلال إيلاء أهمية للموارد البشرية بموجب تشريع قانوني خاص.
قائمة المصادر والمراجع
المصــــــادر:
أ. الأنظمـــة والقوانيـــــن:
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد 1487، تاريخ: 1/ 5/ 1960، ص 374.
- مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل الفلسطينية (نسخة ورقية).
- قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) الصادرة بتاريخ 1/9/1998 العدد 24، ص 20.
- نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتعديلاته رقم (33) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ: 1/7/2024 العدد رقم 5935، ص 3213.
- قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد 5297، بتاريخ:17 /08/2014، ص4866.
- قانون المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، عدد ممتاز (22)، بتاريخ: 11/1/2021، ص 19.
ب اللـــوائــــــح:
- قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، العدد (60)، بتاريخ: 9/11/2005، ص 97.
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م، بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م، باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، المشور في الجريدة الرسمية، (الوقائع الفلسطينية)، العدد (173)، الصادر بتاريخ 25/11/2020، ص 10.
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، العدد (102)، بتاريخ 22/10/2013.
ج. قـــرارات المحــــــاكم:
- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية / رام الله، رقم 78/99 بتاريخ 14/12/2004، المنشور في المقتفي، معهد الحقوق / جامعة بيرزيت.
- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية / رام الله، (هيئة ثلاثية)، رقم (191) رقم الدعوى 53 /2005، الصادر بتاريخ 22/01/2006، المنشور في المقتفي، معهد الحقوق / جامعة بيرزيت.
- حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 466/1999، الصادر بتاريخ 28/2/2000، منشورات قسطاس.
- حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 314/1997، الصادر بتاريخ 18/10/1997، منشورات قسطاس.
- حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 277/2009، الصادر بتاريخ 23/4/2012، منشورات قسطاس.
- حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 277/2009، الصادر بتاريخ 23/4/2012، منشورات قسطاس.
- حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 332/1998، الصادر بتاريخ 24/2/1999، منشورات قسطاس.
- حكم المحكمة الإدارية الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 95/2023، الصادر بتاريخ 8/7/2024، منشورات قسطاس.
- حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 517/2007، الصادر بتاريخ 27/2/2008، منشورات قسطاس.
- حكم المحكمة الإدارية الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 487/2022، الصادر بتاريخ 3/6/2024، منشورات قسطاس.
المراجــــــع:
أ. الكتب:
- أبو ارميله، بسام. (2024). القضاء الإداري المقارن، الأردن-مصر-فرنسا. ط 1. دار الثقافة. عمان. الأردن.
- أبو سمهدانة، عبد الناصر (د.ت). موسوعة القضاء الإداري في فلسطين، الكتاب الأول. دار الفكر. القدس. فلسطين.
- الحسن، مالك ونس (2024). الأمن القانوني للموظف العام في المجال التأديبي، دراسة مقارنة. الطبعة الأولى. دار الثقافة. عمان، الأردن.
- الحلو، ماجد راغب (2000). القضاء الإداري. منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر.
- رسلان، أنور احمد (2003). وسيط القضاء الإداري. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر.
- الطماوي، سليمان محمد (1979). القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب دراسة مقارنة. ط 2. دار الفكر العربي. القاهرة. مصر.
- الطماوي، سليمان (2017). النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، راجعه ونقحه، البنا محمود. ط 7. دار الفكر العربي. القاهرة. مصر.
- بطيخ، رمضا، والعجارمة، نوفان (2012). مبادئ القانون الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية الكتاب الثاني. ط 1. دار النهضة العربية. القاهرة، مصر.
- عمرو، عدنان (2010). مبادئ القانون الإداري، وسائل تنفيذ النشاط الإداري. المطبعة العربية الحديثة. القدس. فلسطين.
- القبيلات، حمدي (2025). أصول القانون الإداري. ط 1. دار الثقافة. عمان. الأردن.
- كنعان، نواف (2019). الوجيز في القانون الإداري الأردني -2. ط 5. زمزم ناشرون وموزعون. عمان. الأردن.
- محارب، علي جمعة (2004). التأديب الإداري في الوظيفة العامة، (دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي). ط 1. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن.
- المولى، خالد محمد (2012). السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام. دار الكتب القانونية. مصر والامارات.
ب. الرسائـــل العلميـــة:
مناصرة عيسى (2012). “التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثيره بالحكم الجنائي “. أطروحة دكتوراه منشورة. جامعة القاهرة، مصر.
ج. الدوريــــــــــات:
- العجارمة، نوفان العقيل. (2019). “المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني”. مجلة كلية القانون الكويتية. 7 (2): 279-316. .
- عليات، محمد نجم (2025). “حق الدفاع كأحد ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة (الامارات، الأردن، مصر)”. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية: (21): 338-393.
- Nasution, A. H., Setiadi, E., & Sumiati, Y. (2023). “Authorities of civil servant investigates in conducting investigations on acts of corporate maladministration in telecommunications according to law no. 36 of 1999 concerning telecommunications adjusted to the principle of legal certainty”. International Journal of Social Science, 2(5): 2235–2246 https://doi.org/10.53625/ijss.v2i5.4952
- Romaniuk, P. (2022). “Kontrola obywatelska jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej”. Acta Iuridica Resoviensia, 38(3): 345–355 https://doi.org/10.15584/actaires.2022.3.24
- Silva, É. N. da, & Diniz, T. A. N. M. (2020). Ilegitimidade da comissão processante disciplinar frente às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2: 363–387. https://doi.org/10.24302/ACADDIR.V2.2483
- Uçar, İ., & Türe, G. (2021). İdari̇ usulde resen araştirma i̇lkesi̇ ve suçsuzluk kari̇nesi̇: türki̇ye i̇nsan haklari ve eşi̇tli̇k kurumunun ayrimcilik yasağinin i̇hlali̇ i̇ncelemesi̇nde i̇spat yükü özeli̇nde bi̇r değerlendi̇rme. 25(2): 973–1026 https://doi.org/10.34246/AHBVUHFD.933629
[1] قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد 1487، تاريخ: 1/ 5/ 1960، ص 374.
[2] مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل الفلسطينية (نسخة ورقية)، ” ويعد أيضا من ضمن من هم في حكم الموظف العام:
- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني.
- رؤساء المجلس التشريعي واعضاؤه والعاملون به.
- رؤساء الهيئات المحلية، واعضاؤها والعاملون فيها.
- المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفون.
- رؤساء مجالس إدارة الشركات وأعضاؤها، والجمعيات والمؤسسات والبنوك التي تسهم الدولة، أو احدى الهيئات العامة في رأس مالها بنصيب ما وكذلك العاملون في اية منها.
- رؤساء الأحزاب السياسية، واعضاؤها، والعاملون فيها.
- رؤساء النقابات المهنية واعضاؤها، والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وكذلك العاملون في اية منها.
- ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً، على تكليف صادر اليه من موظف عام، يملك حق التكيف بمقتضى القوانين، أو الأنظمة المقررة، وذلك بالنسبة الى العمل المكلف به.
[3] نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتعديلاته رقم (33) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ: 1/7/2024 العدد رقم 5935، ص 3213.
[4] قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، الصادرة بتاريخ 1/9/1998، العدد 24، ص 20.
[5] أحكام المادتين (4 و5)، من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[6] أحكام المادتين (72 و75)، من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[7] أحكام المادة (68)، من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[8] نصت أحكام المادة (68/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، على العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف في حال مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها على النحو الآتي:
- التنبيه.
- الإنذار الخطي.
- الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة ايام في الشهر الواحد.
- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
- الاستغناء عن الخدمة.
- العزل.
[9] أحكام المادة (85) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[10] أحكام المادة (86) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[11] أحكام المادة (87/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[12] قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م، بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م، باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، المشور في الجريدة الرسمية، (الوقائع الفلسطينية)، العدد (173)، الصادر بتاريخ 25/11/2020، ص 10.
[13] أحكام المواد (69 و70 و71) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، مصدر السابق.
[14] حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية / رام الله، رقم 78/99 بتاريخ 14/12/2004، المنشور في المقتفي، معهد الحقوق / جامعة بيرزيت.
[15] أحكام المادة (74) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[16] أحكام المادة (75/و) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[17] قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، مصدر سابق، لاسيما المادة (69) والتي نصت على:
1- تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف.
2- فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
3- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة.
[18] حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة برام الله، (هيئة ثلاثية)، رقم (191) رقم الدعوى 53 /2005، الصادر بتاريخ 22/01/2006، المنشور في المقتفي، معهد الحقوق / جامعة بيرزيت.
[19] أحكام المادة (72/أ/3) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
20 أحكام المادة (72/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[21] أحكام المادة (73/أ)، من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[22] حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 466/1999، الصادر بتاريخ 28/2/2000، منشورات قسطاس.
[23] حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 314/1997، الصادر بتاريخ 18/10/1997، منشورات قسطاس.
[24] حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 277/2009، الصادر بتاريخ 23/4/2012، منشورات قسطاس.
[25] أحكام المادة (73/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[26] أحكام المادة (79) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[27] قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، مصدر سابق.
[28] حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 332/1998، الصادر بتاريخ 24/2/1999، منشورات قسطاس.
[29] حكم المحكمة الإدارية الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 95/2023، الصادر بتاريخ 8/7/2024، منشورات قسطاس.
[30] حكم محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم 517/2007، الصادر بتاريخ 27/2/2008، منشورات قسطاس.
[31] أحكام المادة (88) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[32] أحكام المادة (91/ج) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[33] نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[34] أحكام المادة (91/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[35] أحكام المادة (91/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مصدر سابق.
[36] قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، مصدر سابق، إذ نصت المادة (105) على أنه: “للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به. 2 – ويتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضاً. 3 – للموظف اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه. 4 – تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات الإدارية”.
أحكام المادة (160) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2005 وتعديلاته، مصدر سابق. [37]
[38] تتنوع النظم القضائية في دول العالم بين نظامين رئيسيين هما، نظام القضاء الموحد والذي تتزعمه إنجلترا ومن بعدها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية، ونظام القضاء المزدوج الذي انشأته وابتدعته فرنسا وتأخذ به مصر.
[39] أحكام المادة (46/2) من قانون المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، مصدر سابق.
[40] أحكام المادة (38) من قانون المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم 41 لسنة 2020 وتعديلاته، مصدر سابق.
[41] أحكام المادة (25) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد 5297، بتاريخ:17 /08/2014، ص4866.
[42] حكم المحكمة الإدارية الفلسطينية، قرارها في الدعوى رقم 487/2022، الصادر بتاريخ 3/6/2024، منشورات قسطاس.