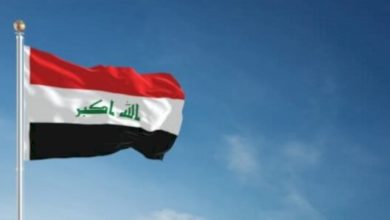تحليل تأثيرات الصراع الإيراني – الإسرائيلي في إعادة تشكيل نظام اقليمي جديد في منطقة الشرق الاوسط
Analyzing the impact of the Iranian Israeli conflict on reshaping a new regional order in the Middle East

اعداد : إبراهيم الحراحشة – باحث في العلوم السياسية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
| ملخص |
| هدفت الدراسة الى تقديم خلفية عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ، وتحليل العلاقة بين الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبيان طبيعة الصراع الإيراني–الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي في المنطقة، وللإجابة عن تساؤلاتها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي، وتبين من خلال الدراسة شكّل الصراع الإيراني–الإسرائيلي حدثًا تشخيصيًا كشف عن التصدعات العميقة التي تُشكّل البنية الأمنية المعاصرة في الشرق الأوسط، مُبيّنًا كيف يُمكن للاشتباكات التكتيكية أن تُنير التحولات النظامية الأوسع وإعادة التنظيم الاستراتيجي، قد تُؤدي التحولات في النظام الإقليمي إلى زعزعة الاستقرار، وتؤدي إلى زيادة التنافس، بل وحتى الصراع، بين القوى الإقليمية، مما سبق نجد أن التعاون الإقليمي ضروري لتحقيق الاستقرار في دول الشرق الأوسط، ويجب على المنطقة أن تندمج بشكلٍ أكبر في الاقتصاد العالمي، وإن بناء نظام إقليمي وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، ضرورةٌ ملحةٌ لمنع المنطقة من التوجه نحو الفوضى.
الكلمات المفتاحية: الصراعات، منطقة الشرق الأوسط، الصراع الإيراني– الإسرائيلي، النظام الاقليمي. |
| Abstract |
| The study aimed to provide background on the conflicts in the Middle East, analyze the relationship between conflict and security in the Middle East, and clarify the nature of the Iranian-Israeli conflict and attempt to reshape the regional order. To answer its questions, the descriptive-analytical and inductive approaches were used. The study revealed that the Iranian-Israeli conflict constituted a diagnostic event that revealed the deep fissures shaping the contemporary security structure in the Middle East, demonstrating how tactical clashes can illuminate broader systemic shifts and strategic reorganization. Shifts in the regional order may lead to instability and increased competition, and even conflict, between regional powers. From the above, we find that regional cooperation is essential to achieving lasting stability, and the same applies to international relations in the Middle East. The region must become more integrated into the global economy, and building a regional order and enhancing regional cooperation and integration is an urgent necessity to prevent the region from sliding into chaos.
Key words: Conflicts, the Middle East, the Iranian-Israeli conflict, the regional order. |
- المقدمة:
تتعدد العلاقات الاقليمية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وتتضارب مصالحها، مما يجعل من المستحيل عمليًا على أي دولة من دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، تحقيق الهيمنة، ولا تزال إيران رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية تحتفظ بنفوذ في العراق ولبنان واليمن، على الرغم من ضعف شبكات وكلائها، وتعد كل من تركيا بطموحاتها الإقليمية الخاصة والمملكة العربية السعودية بمواردها المالية منافسين غير راغبين في قبول الهيمنة الإسرائيلية، وبالرغم من أن سقوط النظام السوري عام 2024 اعتبر بمثابة ضربة لإيران، إلا أنه لم يغير ميزان القوى لصالح إسرائيل، حيث دخلت جهات فاعلة جديدة، مثل الجماعات السنية المدعومة من تركيا إلى الساحة، فالهيمنة تتطلب تفوقًا عسكريًا على الخصوم وإسرائيل لم تتمكن من فرض هيمنتها الكاملة حتى على جهة فاعلة واحدة مثل إيران التي لا تزال على الرغم من هجمات عام 2025 قادرة على الرد، فهذه التعقيدات الجيوسياسية، مقترنةً بالمقاومة الإقليمية المستمرة، مما يمنع إسرائيل من تحقيق وضع الهيمنة، ويؤكد الجمع بين نظريات الواقعية الهجومية والدفاعية وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية على الحاجة إلى نهج يراعي الصدمات التاريخية وديناميكيات القوة، لأن الصدمات التاريخية في المنطقة مثل الاستغلال الاستعماري، يمكن أن تغذي سياسات عدوانية لمنع تكرار نقاط الضعف، مما يعزز فهمًا أعمق للقوى التي تشكل صراعات الشرق الأوسط المستمرة.
من خلال دراسة التفاعل بين العوامل الفردية، وعوامل الدولة، والعوامل الإقليمية، والنظامية لفهم دوافع الصراع، تكشف الواقعية البنيوية سلوك الدولة والسعي وراء السلطة والأمن في ظل نظام فوضوي، لذا يتطلب التحليل العملي للسياسة الخارجية مراعاة عمليات صنع القرار، وقدرات التنفيذ، والتفاعل الديناميكي بين السلطة والتعامل مع المشهد المعقد والمتطور باستمرار في الشرق الأوسط، وفهمًا دقيقًا للترابط بين مختلف مستويات التحليل، واستخدامًا عمليًا لجميع الأدوات التحليلية، ويعد هذا النهج متعدد الأوجه أساسيًا لوضع استراتيجيات تحليلية سليمة للسياسة الخارجية وفهم الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط Asi, 2022)).
شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات عميقة مع نهاية عام 2024، حيث شكّل سقوط نظام بشار الأسد منعطفًا تاريخيًّا أعاد رسم ملامح الصراعات والتحالفات الإقليمية. هذه التغيرات تضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة، تتطلب رؤى إستراتيجية متكاملة لبناء مستقبل مستقر، في سوريا، تبرز إعادة بناء الدولة اختبارًا حاسمًا للقيادة الجديدة، مع الحاجة إلى إدارة الانقسامات العرقية والدينية، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتعزيز الهوية الوطنية. إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي ليست مجرد ضرورة محلية؛ بل هي اختبار للتعاون الدولي، وتحديد الأولويات الإقليمية، أما إيران، فتواجه أزمة تراجع نفوذها الإقليمي نتيجة المتغيرات الجديدة؛ مما يفرض عليها إعادة ترتيب أوراقها داخليًّا وخارجيًّا. في المقابل، ترى قوى مثل تركيا والسعودية فرصًا لتعزيز مكانتها الإقليمية وسط التحولات الجارية (بريجع، 2024).
تعد منطقة الشرق الأوسط بالفعل إحدى أكثر مناطق العالم تعقيدًا، دخل مؤخرًا مرحلة جديدة من الصراع، اتسمت بمستوى غير مسبوق من العنف وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتحولات في موازين القوى الإقليمية. بعد عام ونصف من هجمات حماس الإرهابية التي أثارت رد فعل إسرائيل غير المتناسب، تواجه المنطقة أزمة إنسانية حادة في غزة وآثارًا غير مباشرة للصراع على لبنان، وعليه جاءت الدراسة لتبحث في تحليل تأثيرات الصراع الإيراني – الإسرائيلي في إعادة تشكيل نظام اقليمي جديد في منطقة الشرق الاوسط.
- مشكلة الدراسة: تشهد منطقة الشرق الأوسط صراعات إقليمية معقدة ومتعددة الجوانب، تتشابك فيها عوامل تاريخية وسياسية ودينية وعرقية، وهذه الصراعات تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وتتطلب حلولاً شاملة ودبلوماسية، ومن الصعب التنبؤ بشكل النظام الإقليمي الجديد الذي قد يظهر في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط تغييرات كبيرة في السنوات القادمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، ويشمل هذا النظام تكتلات اقتصادية جديدة، أو تحالفات سياسية، أو حتى تقسيمات جديدة للمنطقة، وعليه تتحد مشكلة الدراسة في بيان واقع العلاقة بين الصراع والأمن في الشرق الأوسط، وتحليل تأثيرات الصراع الإيراني–الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي جديد في منطقة الشرق الاوسط، وعلية تسعى الدراسة الى الاجابة عن التساؤلات التالية:
- ما طبيعة العلاقة بين الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط؟
- ما طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي في منطقة الشرق الاوسط؟
1-2 مصطلحات الدراسة:
- الصراع: يعرف بأنه حالة من عدم الارتياح أو الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته، ويشير إلى موقف يكون لدى الفرد فيه دافعُ للتورط أو الدخول في نشاطين أو أكثر، لهما طبيعة متضادة تماما متعلقة بقدرة الفرد على التكيف الإنساني وموقف تنافسي خاص، يكون طرفاه أو أطرافه، على علم بعدم التوافق في المواقف المستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم، مضطراً فيها إلى تبنى أو اتخاذ موقف لا يتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو الأطراف الأخرى (بدوى،1997: 36).
- الصراعات الإقليمية: هي خلافات بين دولتين أو أكثر حول السيطرة على منطقة معينة، وقد تتضمن هذه الخلافات أراضي كاملة أو أجزاء منها، وقد تكون نتيجة لمطالبات مادية أو ثقافية أو نتيجة لتغيرات في البيئة المحلية أو الدولية (بيرهات، 2025).
- الشرق الأوسط: مصطلح سياسي جغرافي (جيوبوليتيكي) أكثر منه مصطلحاً دالاً على كيان جغرافي، له خصوصية معينة تميزه من غيره من الكيانات الجغرافية، فهو ليس إقليماً جغرافياً،وإنما هو وحدات سياسية غير متجانسة بشرياً أو طبيعياً، ويمكن اعتباره مصطلحاً سياسياً أطلقته الدول الاستعمارية في العصر الحديث على المنطقة التي تتوسط قارات العالم القديم، وتشكل عقدة مواصلات برية وبحرية وجوية، لكونها بوابة الجنوب الآسيوي والشرق الأقصى (Simon, 1996).
- النظام الإقليمي: عرف بأنه “عبارة عن شبكة العلاقات الكثيفة بين وحدات النظام ومجمل التفاعلات والروابط الرسمية وغير الرسمية، سواء تبلورت في إطار مؤسسي وأخذت شكلاً قانونياً نظامياً أم بقيت تفاعلات وروابط خارج الإطار المؤسسي والقانوني والتي تستمد معناها وشرعيتها من الانتماء القومي العربي” (الزبن، 2001 :19).
1-3 أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
- تقديم خلفية عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
- تحليل العلاقة بين الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
- بيان طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
1-4 اهمية الدراسة: تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين علمية (نظرية) وعملية (تطبيقية).
- الأهمية العلمية (النظرية): تكمن الأهمية العلمية للدراسة كونها تسهم في التأصيل النظري لموضوعها في المجال الأكاديمي مما قد يفيد المهتمين والمختصين والباحثين، في مجال الأمن الاقليمي، والنظام الاقليمي، والصراعات.
- الأهمية العملية (التطبيقية): تعود الأهمية العملية للدراسة إلى كونها من الموضوعات الحيوية والحديثة التي تتابع التطورات في منطقة الشرق الاوسط، كما تبرز أهمية الدراسة من محاولتها تحليل العلاقة بين الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبيان طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي.
1-5 فرضية الدراسة: هنالك علاقة ارتباطية سلبية بين طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي وإعادة تشكيل نظام اقليمي في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط منذ عام 2023.
1-6 منهج الدراسة: يتطلب فهم مواجهة يونيو 2025 الجمع بين عدة منظورات نظرية. تُوفر الواقعية الهيكلية، كما طورها والتز (1979) وصقلها ميرشايمر (2001)، الأساس لفهم كيفية تشكيل القدرات المادية والضغوط النظامية لسلوك الدولة. ومع ذلك، فإن محدودية المناهج المادية الصرفة تستلزم دمج رؤى البنائية، وخاصة تلك التي طورها ويندت (1992) وفينيمور وسيكينك (1998)، والتي تُلقي الضوء على كيفية تأثير المعايير والهويات والسرديات التاريخية على صنع القرار الاستراتيجي، اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها والإجابة عن تساؤلاتها على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي ويُعنى هذا المنهج بتعريف وتقويم الأجزاء التي يتكون منها الكل لأي قضية، وهو وسيلة للحصول على معرفة غنية وجديدة، والمنهج التحليلي يتخذ التحليل صوراً ومستويات مختلفة تبعاً لطبيعة موضوع البحث، ويُعّد تعدد عمليات التحليل شرطاً لتوفير إدراك أعم وأشمل للقضية قيد الدراسة إذْ يعمل على تحليل الموضوع إلى عناصر بسيطة أو تقسيم الشيء إلى مكوناته ووحداته، وتم استخدام المنهج في عرض وتحليل تحليل العلاقات الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبيان طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي ومحاولة لإعادة تشكيل نظام إقليمي.
1-7 الدراسات السابقة: من أهم الدراسة ذات الصلة ما يلي :
دراسة (بيرهات، 2025)، بعنوان: تداعيات الصراع الإيراني–الإسرائيلي وأبعاده الإقليمية والدولية، هدفت الدراسة لبيان أن منطقة الشرق الأوسط تشهد منذ عقود صراعات مركبة تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية والدينية والاقتصادية، وتشارك فيها قوى محلية وإقليمية ودولية، ومن أبرز هذه الصراعات المواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، والتي دخلت مرحلة علنية بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وخلصت الدراسة إلى أن إسرائيل ردّت بقوة على حماس في قطاع غزة، وتدخّلت إيران مباشرة عبر وكلائها وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية على مواقع نووية في إيران بتاريخ 13 حزيران 2025، ما يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ودخل الشرق الأوسط جراءها طوراً جديداً من التصعيد.
دراسة آهن Ahn, 2025))، بعنوانThe shifting dynamics of amity and enmity in the Middle East: analysing the 2023 Israel-Hamas war through the framework of regional security complex theory, ، الديناميكيات المتغيرة للصداقة والعداوة في الشرق الأوسط: تحليل حرب إسرائيل وحماس عام 2023 في إطار نظرية مجمع الأمن الإقليمي، هدفت الدراسة لبيان الديناميكيات المتغيرة للصداقة والعداوة في الشرق الأوسط وتحليل حرب إسرائيل وحماس عام 2023 في إطار نظرية مجمع الأمن الإقليمي، وبينت الدراسة أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كان عاملاً رئيسياً في تشكيل الديناميكيات السياسية، مما أدى إلى اتساع نطاق المشاعر المعادية لإسرائيل في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 تحول تركيز العداء تدريجياً نحو إيران، ومع تزايد نفوذ إيران في الربيع العربي، بدأت دول الخليج في استكشاف إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل كاستراتيجية جديدة للبقاء، وخلصت الدراسة إلى أن المشهد السياسي المتغير بسرعة شكل أزمة لحركة حماس، بلغت ذروتها بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وخلصت الدراسة إلى أن المواقف السياسية لدول الخليج لا تزال تدرس الفوائد المحتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأكد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أن العوامل العاطفية، مثل الصداقة والعداوة، لا تزال تلعب دوراً مهماً في تشكيل مجمع الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.
دراسة (السكري، 2025)، بعنوان: الردع المتبادل والهيمنة: قراءة في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها الجيوسياسية، هدفت الدراسة لبيان أن الفترة (2023-2025) شهدت تصعيدًا متسارعًا في المواجهة بين إسرائيل وإيران، انتقل خلالها الصراع من الحروب بالوكالة إلى الاشتباك المباشر، فقد شكل هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023 بدعم إيراني نقطة تحوّل مفصلية، إذ أعقبه تصعيد متزامن على جبهات عدة، أبرزها تحركات حزب الله اللبناني والفصائل الإيرانية في سورية والعراق، إلى جانب الحوثيين في اليمن، وردّت إسرائيل بسلسلة ضربات ضد مواقع الحرس الثوري ووكلائه، وامتدت ضرباتها إلى الداخل الإيراني، ومنها استهدف منشآت طاقة، مثل تفجير أنابيب الغاز في شباط 2024.
دراسة زرار وآخرون (Zarar, Imtiaz and Khurshid. 2025) بعنوانThe Fall of Bashar al-Assad: Implications for Syria and the Broader Middle East، بشار الأسد: التداعيات على سوريا والشرق الأوسط الأوسع، هدفت الدراسة إلى بيان التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة لسقوط بشار الأسد في سوريا، وديناميكيات اللاجئين، والعلاقات مع الدول المجاورة، وتأثير الفراغ المحتمل في السلطة على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك إيران وروسيا وتركيا والقوى الغربية، مع مراعاة التداعيات على التنظيمات الإرهابية والتوترات الطائفية، وخلصت الدراسة لوجود تحديات لإعادة الإعمار في سوريا بعد سقوط النظام السابق، ومنها هياكل الحكم، وآفاق التحوّل الديمقراطي، وأن سقوط الأسد قد يُحفّز إعادة ترتيب كبيرة للتحالفات الإقليمية، وقد يُعيد تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط، مع عواقب بعيدة المدى على الأمن الدولي والعلاقات الدبلوماسية.
دراسة أسوكو وآربن(Assoc and Arben, 2025) ، بعنوان:Fall Of Syrian Regime And Regional Implications – Analysis، تحليل سقوط النظام السوري وتداعياته الإقليمية ، هدفت الدراسة إلى بيان إن سقوط النظام السوري لا يعني نهاية الصراعات أو حل الأزمات التاريخية، فسوريا تظل دولة مجزأة، مع جماعات متمردة وميليشيات وقوى أجنبية وديناميكيات طائفية ستستمر في تشكيل مستقبلها، فإن سقوط النظام السوري السابق ليس نقطة نهاية، بل هو فصل جديد في حرب أهلية لا تزال تتسم بمصالح متنوعة وطموحات جيوسياسية متعددة.
دراسة (حيدر، 2020)، بعنوان: الشرق الاوسط افتراضات متصدعة وانماط جديدة من الصراع، هدفت الدراسة لبيان الافتراضات التي قامت عليها الاستراتيجيات الدولية والاقليمية تجاه الشرق الاوسط، نتيجة لأسباب متعددة، اهمها، اختلاف طبيعة التوازنات وتغير نمط الصراع والتوجه نحو بناء محاور صراع استراتيجية على اسس مختلفة، من أهمها تحولات القوة، فإن الأسس والمرتكزات القديمة التي كانت سائدة في السابق شهدت تحولاً او تكيفا مع معطيات المرحلة الراهنة، لأنها لم تعد قادرة على البقاء متماسكة، وخلصت الدراسة أن القوى المتنافسة ادركت طبيعة معطيات المرحلة الجديدة، وضرورة السير لإدخال تغييرات تكتيكية في استراتيجيتها كأحد انماط الاستجابة لتحول انماط العلاقات الاقليمية والدولية او تغير بيئة الصراع وشكل التوازنات.
التعقيب على الدراسات السابقة: ركزت دراسة (بيرهات، 2025) على بيان أن منطقة الشرق الأوسط تشهد منذ عقود صراعات مركبة تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية والدينية والاقتصادية، وتشارك فيها قوى محلية وإقليمية ودولية، فيما ركزت دراسة آهن Ahn, 2025)) على بيان الديناميكيات المتغيرة للصداقة والعداوة في الشرق الأوسط وتحليل حرب إسرائيل وحماس عام 2023 في إطار نظرية مجمع الأمن الإقليمي، ودراسة (السكري، 2025) على بيان أن الفترة (2023-2025) شهدت تصعيدًا متسارعًا في المواجهة بين إسرائيل وإيران، انتقل خلالها الصراع من الحروب بالوكالة إلى الاشتباك المباشر، وهدفت دراسة زرار وآخرون (Zarar, Imtiaz and Khurshid. 2025) إلى بيان التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة لسقوط بشار الأسد في سوريا، وديناميكيات اللاجئين، والعلاقات مع الدول المجاورة، فيما هدفت دراسة (حيدر، 2020) الدراسة لبيان الافتراضات التي قامت عليها الاستراتيجيات الدولية والاقليمية تجاه الشرق الاوسط، فيما تتميز الدراسة الحالية بتحليل واقع الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبيان طبيعة الصراع الإيراني – الإسرائيلي كمحاولة لإعادة تشكيل نظام اقليمي.
- الخلفية التاريخية للصراعات في منطقة الشرق الأوسط:
شهدت منطقة الشرق الأوسط صدمات عميقة نتيجة إنهاء الاستعمار في بدايات القرن العشرين، نتج عنه سلسلة من الأحداث المزعزعة للاستقرار، وقد أدى الصراع العربي-الإسرائيلي إلى تعزيز تنافس على الهيمنة الإقليمية والتدخل الخارجي من قبل القوى العالمية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انعدام الأمن وأدت هذه العوامل، بالإضافة إلى غياب التكامل والتعاون الإقليميين بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، إلى تأجيج الصراعات بين دول المنطقة والصراعات على السلطة، والتي غالبًا ما تكون عنيفة (Fernandez, 2015).
أشعلت هجمات 11 سبتمبر 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة، شرارة “الحرب العالمية على الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة من خلال غزو أفغانستان، وغزو العراق عام 2003 دون موافقة الأمم المتحدة، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتمكين إيران وتأجيج العنف الطائفي وإثبات فشل إعادة الإعمار، وأدى صعود محمود أحمدي نجاد في إيران عام 2005 إلى زيادة توتر العلاقات مع الغرب، حيث شكل البرنامج النووي تهديدات للتحالفات الإقليمية، ونشأت “حرب باردة” بين كتلة سنية بقيادة السعودية وكتلة شيعية بقيادة إيران، بما في ذلك حركات المقاومة، ودعمت هذه القوى الإقليمية جهات فاعلة مختلفة من الدول وغير الدول، وغالبًا ما كانت تغير التحالفات اعتمادًا على التهديد، مما يدل على الطبيعة المعقدة والمتغيرة للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وفي أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول 2023 تصاعد رد الفعل الإسرائيلي سريعًا إلى مستوى غير مسبوق من حيث الحجم والعنف، وأدى الغزو البري الإسرائيلي اللاحق للبنان، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، إلى تفاقم المخاوف من إندلاع حرب شاملة، فالمفاهيم التقليدية للحرب على أنها معارك محدودة في ساحات قتال محددة لم تعد مقياس للقوة في الوقت الحاضر، فالصراعات الحديثة تتضمن شبكة معقدة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، مما يتطلب إعادة تقييم كيفية فهم الصراعات الحديثة والاستجابة لها(Burke, 2024) .
فحروب الشرق الأوسط رسخت مفهوم الحرب في ساحة العلاقات الدولية، ولتوضيح مفهوم الحرب في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، القائمة الطويلة من النزاعات المسلحة منذ منتصف القرن العشرين، كتلك التي اندلعت في أعوام (1948، 1956، 1967، 1973، 1978، 1982، 1987، 2000، 2005، 2008، 2023 و2025)، وطالما كانت الحروب تعرف بأنها عنف منظم بين وحدات سياسية وأداة من أدوات سياسة الدولة، ومع ذلك، فهي تمثل اضطرابًا جوهريًا في المجتمع الدولي، يحتمل أن يحوله إلى حالة من الصراع العالمي ويهدد وجوده، والمجتمع الدولي استخدم الحرب لدعم القانون الدولي، والحفاظ على توازنات القوى، والحد من لجوء الدول إلى الحرب، إدراكًا منه لخطورتها، واعتمد على آليات عدة، مثل حصر حق شن الحرب في الدول ذات السيادة، ووضع قواعد حرب لتنظيم السلوك، وتطبيق قوانين الحياد لاحتواء النزاعات جغرافيًا، والأهم من ذلك، تقييد المبررات المشروعة للحرب، وتطورت الحرب العادلة إلى أدوات قانونية للحد من استخدام القوة في العلاقات الدولية (Bull, 2012).
أثارت الانتفاضات العربية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أوائل عام 2011 أزمات واضطرابات سياسية، ففي أعقاب هذه الثورات، سعت الدول العربية إلى تجاوز الأزمة بالتعاون عبر المؤسسات الإقليمية، وفي ظل اعتقاد واسع النطاق بإمكانية تعزيز آليات الأمن التعاوني، تبنّت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في تشرين الثاني 2011 ودعم التدخلات الدولية في ليبيا، ومثلت هذه الخطوات خروجًا واضحًا عن التزام جامعة الدول العربية وتقاليدها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها الأعضاءFarahmand ,2025) ).
لكن منذ عام 2013 تغيرت أنماط التعاون الإقليمي بشكل كبير، فقد أظهرت جامعة الدول العربية حالة من الانقسام، وأدت مقاطعة قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين في يونيو 2017 إلى ضعف مجلس التعاون الخليجي، وبدلاً من ذلك، ظهرت أنماط بديلة للتعاون الإقليمي في مواجهة الخصوم والتهديدات المشتركة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وما يُسمى بالرباعية العربية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وشهدت هذه الفترة تعزيز التعاون الثنائي بين القوى الإقليمية الكبرى، مثل التعاون بين السعودية والإمارات، وبين قطر وتركيا، واستمر هذا التوجه الثنائي مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية عام 2020، وتطور التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى عقد من الزمان، بدءًا من الانتفاضات العربية في أوائل عام 2011 وانتهاءً بتعليق مقاطعة قطر في يناير 2021، ولمعالجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأزمة الواضحة والرد عليها، كان أمام حكومات منطقة الشرق الأوسط خيارات تمثلت في خيار محاولة التعاون الإقليمي من خلال المنظمات القائمة كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، ولكنه كان إجراء روتيني عادي، أما الخيار الثاني فتمثل في إنشاء تحالفات جديدة ولم يتجاوز المناقشات التخمينية، كما يتضح من الخطط الفاشلة لإنشاء “تحالف أمن الشرق الأوسط”، الذي ستشكله الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، وأصبحت التحالفات الأمنية الفضفاضة والمتغيرة باستمرار، النمط السائد للتعاون والصراع في الشرق الأوسط بعد عام 2011 (الدسوقي، 2025).
ويعد الصراع عاملًا أساسيًا في تطور الوعي الوطني وتكوين الدولة، يجب على أي تحليل للسياسة الخارجية أن يستكشف هذه المسألة من خلال دراسة ثلاثة مفاهيم أساسية، وهي: (الأمن الجماعي، وتوازن القوى، والبنية الفوضوية للنظام الدولي) (Wight, 1986)، فإن افتراض أن الحرب داخل المجتمع الدولي يعزز الأمن المجتمعي، يعتمد على تدويل المبادئ المشتركة التي ينبغي على جميع الدول الالتزام بها، ويتطلب الحفاظ على الالتزام بهذه المبادئ من أجل السلام، ويتناول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة لحل النزاعات المسلحة أو منعها، وتسمح المادة (41) لمجلس الأمن بتحديد التدابير غير العسكرية، بينما تشدد المادة (40) على التدابير المؤقتة، وتحث على الالتزام بها دون المساس بالأطراف المعنية، فإن الهدف الأساسي للأمن المجتمعي هو منع الحرب، فالحرب عنف منظم بين وحدات سياسية تسعى إلى تحقيق أهداف دولة محددة كأداة أساسية لسياسة الدولة، والنظام الدولي يحدد القواعد التي تحكم سلوك الحرب والمعايير التي يمكن شنها في إطارها(Cammak, and Dunne, 2018) .
مما سبق يتبين أن فهم الوجود المستمر للصراع في الشرق الأوسط يتطلب تحليلًا متعدد الطبقات، فالاستعمار شكل تنافسات إقليمية وزادت أحداث 11 سبتمبر 2001 والحرب الأمريكية على العراق عام 2003 من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأظهرت التدخلات الخارجية وديناميكيات القوة الصراعات المعاصرة الطبيعة المتطورة للحرب، والتي تشمل جهات فاعلة متنوعة بعيدة عن المعركة التقليدية، وبينما يحاول المجتمع الدولي تنظيم الحرب من خلال الأطر القانونية وآليات الأمن الجماعي، تشير تجربة الشرق الأوسط إلى أن هذه الجهود لم تكن كافية، وإن دراسة التفاعل بين مصالح الدول الفردية وموازين القوى الإقليمية والطبيعة الفوضوية للنظام الدولي ومأسسة الصراع أمر بالغ الأهمية، لذلك، فإن الفهم الشامل للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط يستلزم مراعاة المستويات الفردية والدولية والإقليمية والنظامية لتحليل فهم العوامل المعقدة التي تحرك الصراع
- الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط
تتفاعل العلاقات الدولية المعاصر مع جهات فاعلة متعددة، ويحكم سلوك هذه الجهات وسياساتها الخارجية الفوضى، بينما مركزية الدولة متغير تعتمد على توزيع القوة، وتؤكد الواقعية البنيوية أن سلوك الدولة يتحدد أساسًا بقدراتها النسبية ضمن البنية الدولية (Griffiths, 2007)، ويجسد الشرق الأوسط مبادئ الواقعية البنيوية، لذا تشكل المنطقة ساحةً للتنافس بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، حيث يسعى كل منها إلى تحقيق مصالحه ضمن نظام دولي فوضوي تعد فيه المساعدة الذاتية أمرًا بالغ الأهمية، وتظهر مركزية الدولة بتنافس دول قوية مثل إيران وإسرائيل على الهيمنة الإقليمية، ويشكل توزيع القوة العسكرية والموارد الاقتصادية والتحالفات سلوك هذه الدول، على سبيل المثال، تدعم إيران الجماعات التابعة لها كاستراتيجية مساعدة ذاتية لاستعراض قوتها ومواجهة المنافسين ويجبر غياب السلطة المركزية الدول على إعطاء الأولوية لأمنها، وتوجيه أفعالها، وقرارات سياستها الخارجية(Hassenstab, 2024) .
إن تحليل السياسة في الشرق الأوسط يتضمن تحديد حدودها، والتعرف على الجهات الفاعلة الرئيسية داخل المنطقة، وتقييم الأهمية النسبية للعوامل النظامية والنظامية الفرعية، وفهم كيفية تفاعل التأثيرات والنتائج، وتحدد الواقعية الدفاعية الهياكل السياسية بناءً على التفاعلات بين الدول، وتوزيع القوة فيما بينها، وتخصيص الوظائف داخل النظم السياسية، وتجادل الواقعية الدفاعية بأن الدول مدفوعة بشكل أساسي بالرغبة في الأمن والبقاء وبالتالي، تؤكد الواقعية الدفاعية على أهمية توازن القوى كآلية رئيسية في النظام الدولي الفوضوي، حيث يعتمد بقاء الدولة على المساعدة الذاتية، ويؤدي التركيز على موازنة القوة إلى الاستقطاب، في إشارة إلى توزيع القوة بين الدول داخل النظام(Cruz, Barbazon, Halfhill, and Ritzel, 2020)
وتحدد الواقعية الهجومية ثلاثة دوافع رئيسية للعدوان بين الدول هي: (الخوف، والسعي وراء أقصى قوة، والرغبة في مساعدة الذات)، وتفترض أن النظام الدولي فوضوي ومتمركز حول الدولة، ويتميز بعدم يقين متبادل بشأن النوايا، والجهات الفاعلة العقلانية في الدولة، والهدف الأسمى للبقاء، وتجادل الواقعية الهجومية بأن تراكم القوة يعزز أمن الدولة، حيث تقدم القوة الضمانة الأهم للبقاء، وتشير الواقعية الدفاعية إلى أن أمن الدولة يمكن تحقيقه من خلال توازن القوى في ظل نظام دولي ثنائي القطب، قيما ترجع الواقعية الهجومية عدوان الدولة إلى الخوف وعدم اليقين بشأن نوايا الجهات الفاعلة الأخرى،
مما يدفع الدول إلى تعظيم قوتها لضمان بقائها، وأن نظامًا أحادي القطب تهيمن عليه دولة واحدة ذات قوة من شأنه نظريًا أن يفضي إلى نظام دولي أكثر سلمية(Burchill, Linklater, Devetak, Donnelly, Paterson, Reus-Smit, and True, 2005).
وشكلت السياسة الخارجية الإيرانية تفاعل معقد من العوامل، بما في ذلك موقعها الجغرافي، والتأثيرات الدينية، والتجارب التاريخية، والمخاوف بشأن سلامة الأراضي، والتطلعات للهيمنة الإقليمية، والتدخل من القوى العالمية، والديناميكيات السياسية الداخلية، وثروتها من الموارد الطبيعية، ففي أعقاب الحرب الإيرانية العراقية بين عامي (1980 و1988) أصبحت السياسة الخارجية الإيرانية أكثر “عقلانية”، مما أدى إلى زيادة الانقسامية في السياسة الخارجية، وأكدت قيادة خامنئي على توسيع نفوذ إيران من أجل استراتيجية أمنية براغماتية وشاملة، وعمليات الحرس الثوري الإيراني في سوريا دليل على نهج تعظيم القوة الإيرانية (Bazoobandi, Heibach, and Richter, 2024)
وتعد السياسة الخارجية الإيرانية نسيجًا متعدد الجوانب بين الواقعية الهجومية والدفاعية، وتفسر الواقعية الدفاعية تركيزها على سلامة الأراضي وبقاء النظام، وهو ما يتجلى في الدبلوماسية البراغماتية التي تعالج مخاوف الأمن القومي، ويظهر هذا بشكل خاص بعد الحرب الإيرانية العراقية، حيث أكد خطر الغزو على أهمية الحفاظ على الذات، فيما تظهر الواقعية الهجومية الإيرانية سعيها للهيمنة الإقليمية، ويظهر ذلك في دور الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهذا يعكس استراتيجية لتعظيم القوة التي تهدف إلى مواجهة الدول المنافسة والضغوط الخارجية، ويبرز تفاعل هذه النظريات التركيز المزدوج لإيران على الأمن والنفوذ في نظام دولي فوضوي(Hassenstab, 2024) .
إلى جانب التحولات الاقتصادية والدبلوماسية، فإن صعود الجنوب العالمي يدفع تغييرات جوهرية في المشهد الأمني العالمي في الشرق الأوسط، وأكدت جولة الرئيس الأمريكي ترامب الخليجية عام 2025 إعادة ترتيب تحالفات الأمن الإقليمي، وأعطت الولايات المتحدة الأولوية بشكل متزايد للشراكات مع القوى العربية السنية، ودعمت المبادرات التي تقودها الخليج لتحقيق الاستقرار في سوريا واليمن، وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، على الرغم من اعتراضات قوية من إسرائيل، وتسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المحصنتان بالأسلحة الأمريكية، إلى تحقيق الاستقلال الدفاعي من خلال تنويع الموردين، بما في ذلك الحصول على طائرات بدون طيار وأنظمة صاروخية صينية، وهذا يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر تعددًا للأقطاب، لذا تشكل الدول العربية كوكلاء للقوى الخارجية، ولكن كجهات فاعلة أساسية في آسيا، وتتسم إعادة ترتيبات الأمن باستراتيجيات تحوطية، في ظل تحرك الأطراف الإقليمية الفاعلة بين الولايات المتحدة والصين، ففي حوار “شانغريلا” في سنغافورة، المنتدى الأمني الأبرز في آسيا، أكد قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على ضرورة “الاستقلال الاستراتيجي” وعدم الانحياز، خشية الانجرار إلى صراعات القوى العظمى، وقد عبر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن نهج الرابطة بالتعاون مع جميع القوى الكبرى دون أن تنحاز إلى أي منها، مؤكدةً بذلك مبادئ السيادة، وحل النزاعات سلميًا، ومركزية آسيان، على سبيل المثال، بينما عززت الفلبين علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة (بما في ذلك منحها إمكانية وصول موسعة إلى القواعد العسكرية)، فإنها تشرك الصين في مفاوضات لوضع مدونة سلوك ملزمة في بحر الصين الجنوبي، كما تنوع إندونيسيا شراكاتها الدفاعية، بشراء معدات من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، لضمان عدم هيمنة أي طرف على المشهد الأمني فيها(Vinograd, and Sampson, 2025).
يمتد هذا النمط إلى ما هو أبعد من آسيا، فالدول الأفريقية تستورد الطائرات المسيرة من تركيا والصين، بينما تعمل دول أمريكا اللاتينية على تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية بشركاء تكنولوجيين متنوعين، وبرزت جزر المحيط الهادئ كنقطة محورية استراتيجية، حيث دفع اتفاق الصين الأمني مع جزر سليمان إلى زيادة المساعدات الأمنية الغربية للمنطقة، ويرفض الجنوب العالمي التحالفات التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، ويسعى إلى إقامة شراكات مرنة قائمة على القضايا تعمل على تعزيز استقلاليته الأمنية مع تقليل الاعتماد على أي قوة خارجية.
- الصراع بين إيران وإسرائيل وتشكيل نظام إقليمي جديد
اندلع الصراع بين إيران وإسرائيل منذ فترة طويلة، متحولًا إلى حرب شاملة في 13 حزيران 2025 التي استمرت اثنا عشر يومًا، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على أهداف عديدة في (27) محافظة إيرانية، وسجلت ضربات في أكثر من (150) موقعًا مختلفًا، ومن خلال عملية استخباراتية تضمنت تهريب صواريخ قصيرة المدى وطائرات بدون طيار انتحارية صغيرة إلى إيران، بالإضافة إلى إنشاء مصانع طائرات بدون طيار مؤقتة داخل إيران، كما تمكنت إسرائيل من شل منشآت رادار الدفاع الجوي الإيرانية وبطاريات الصواريخ أرض-جو، مما سمح لإسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي الإيراني، وضربت الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار الإسرائيلية الأصول الإيرانية الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية للصواريخ الباليستية وقواعد الحرس الثوري الإيراني ومراكز القيادة والمواقع النووية (عايش، 2025).
سمح التسلل الإسرائيلي في أجهزة الأمن الإيرانية بتنفيذ سلسلة من عمليات القتل المستهدفة، بما في ذلك أكبر ثلاثة جنرالات عسكريين، وأكثر من عشرين من كبار القادة، وما لا يقل عن (11) عالمًا نوويًا، وعلى الرغم من الهجمات الإسرائيلية الدقيقة على الأصول الاستراتيجية والعسكرية الإيرانية، فإن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن عدداً كبيراً من الضحايا ما لا يقل عن (1100) قتيل تم الإبلاغ عنهم كانوا من المدنيين، وسعت إسرائيل إلى دفع الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية على إيران، لكنها فشلت في ذلك في ظل الإدارات السابقة، ولكنها نجحت في توجيه ضربات أمريكية محدودة ومحددة الأهداف على ثلاث منشآت نووية، وشملت هذه الضربات استخدام قنابل خارقة للتحصينات ألحقت أضرارًا جسيمة بمنشأة “فوردو” تحت الأرض، وعلى الرغم من نجاح إسرائيل في استهداف مواقع تخزين الصواريخ وقاذفاتها في غرب إيران، إلا أن إيران لا تزال قادرة على إطلاق أكثر من (500) صاروخ طويل ومتوسط المدى على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل (28) شخصًا معظمهم من المدنيين وإصابة أكثر من (3000) شخص في الداخل الإسرائيلي، وتوقفت الأعمال العدائية عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب وقف إطلاق النار والذي صدر بعد الهجوم الانتقامي الإيراني المُقيّد والمُعلن عنه على قاعدة العديد الجوية، التي تضم قوات أمريكية، في قطر، ولا تزال التوترات مُرتفعة إذ ألحقت الضربات الإسرائيلية والأمريكية أضرارًا جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تُدمّرها بالكامل .(Kiran, 2025)
رغم تراجع قدرات إيران الصاروخية بشكل ملحوظ، إلا أن التهديد الذي تستشعره إسرائيل من إيران، التي تعتبرها الداعم الرئيسي للجماعات المعادية لها، لا يزال قائمًا على المدى الطويل ما لم تُغير إيران مسارها، ويشير نهج إسرائيل المُتشدد إلى أن الأمر قد يكون مسألة وقت فقط قبل ضربة أخرى، وسيعتمد الكثير على مسار الدبلوماسية واستعداد إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وتطوير الصواريخ وسياساتها الإقليمية، لقد تم تسهيل هجوم إسرائيل على إيران بشكل كبير
من خلال إضعاف شركائها الإقليميين، وهو ما حسبته إسرائيل بشكل صحيح أنه لن يوفر لها الدعم ذي المعنى(Tardot, 2025).
فحزب الله كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أصل استراتيجي رئيسي إيراني بالقرب من حدود إسرائيل والذي أعطى إيران النفوذ والردع في المنطقة، إلا أنه لم يتمكن من التدخل لدعم إيران، مع تقليص قدراته العسكرية بشدة في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف عام 2024، وفقدان القيادة العليا، فيما يواصل حزب الله التعامل مع الضغط السياسي المحلي والضربات الإسرائيلية الدقيقة المستمرة التي حدّت من قدرته على إعادة تنظيم صفوفها، ونفذت إسرائيل أكثر من (600) ضربة على لبنان منذ انسحابها من الجنوب في منتصف شباك 2025، وشملت هذه الضربات غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار قتلت رئيس وحدة المدفعية التابعة لحزب الله في الجنوب في 18 حزيران 2024، وضربات على الأصول السرية للجماعة ومع انهيار إيران حليف حزب الله الاستراتيجي في سوريا في كانون الأول 2024، ستظل الجماعة تواجه تحديات كبيرة في إعادة التسليح(Routers, 2025) .
على الرغم من علاقاتها طويلة حافظت معظم الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق على موقف ضبط النفس خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في حين هددت جماعات مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء باستهداف القواعد الأمريكية والمواقع الدبلوماسية إذا عمقت الولايات المتحدة من تدخلها، إلا أنها نفذت نشاطًا محدودًا للطائرات بدون طيار بالقرب من المنشآت الأمريكية في عين الأسد وأربيل، فيما أبقت إيران حلفائها العراقيين في الاحتياط عمدًا لتجنب الإفراط في التوسع وجر الولايات المتحدة إلى الصراع، كما ردت الحكومة العراقية بحث الميليشيات العراقية بشدة على عدم الانخراط ومع ذلك، وعلى نطاق أوسع، وأصبحت هذه الجماعات مستقلة بشكل متزايد عن إيران في السنوات الأخيرة وهي الآن أكثر رسوخًا في الهياكل السياسية في العراق، فالسلطة والنفوذ الاقتصادي الذي تخاطر بفقدانه إذا تم جر العراق إلى حرب أوسع(Zeidan, 2025) .
كما حافظت قوات الحوثيين في اليمن على موقف مقيد نسبيًا خلال الحرب بين إيران وإسرائيل وسجلت انخفاضاً بنسبة (31٪) في هجمات الحوثيين التي تستهدف إسرائيل مقارنة بشهر أيار 2025، مع تسجيل (15) حادثة، ولم يتم تسجيل أي هجمات جديدة على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار غير الرسمي بين الولايات المتحدة والحوثيين المعلن عنه في 6 أيار 2025، وجاء الانخفاض على الرغم من هجومين انتقاميين محدودين من قبل إسرائيل ضد أهداف الحوثيين في 10 حزيران 2025، قصفت القوات البحرية الإسرائيلية ميناء الحديدة، وهي أول ضربة بحرية موثقة من قبل إسرائيل في اليمن، وفي 14 حزيران 2025 قامت إسرائيل بغارة جوية على صنعاء أدت إلى إصابة رئيس أركان الحوثيين “محمد الغماري” وهو أبرز شخصية حوثية تستهدفها إسرائيل (القصيفي، 2025).
على مر التاريخ لم تنجح سوى قوى قليلة في الهيمنة على الشرق الأوسط. وتشمل هذه القوى الإمبراطورية، والإمبراطوريات الإسلامية في الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية، ومع ذلك، تعدّ هذه الحالات حالات استثنائية في منطقة تعرف بواحد من أطول تواريخ الحروب والإنقسام السياسي، ولطالما شكّلت الأناضول والهضبة الإيرانية ووادي نهر النيل مرتكزات جغرافية وثقافية للقوى الإقليمية المتنافسة، مما ساهم في نشوء دول متعاقبة قاومت السيطرة الشاملة لأي قوة
منفردة، وحتى مع تغير التركيبة الديموغرافية بفعل الهجرات ووصول نخب جديدة فإن الواقع الجغرافي لهذه المناطق أعاد تأكيد وجوده باستمرار، مشكلًا دولًا قوية بطبيعتها وقابلة للدفاع عنها، واستمر هذا التوازن حتى وفّر التوسع الأوروبي، بالتزامن مع الثورة الصناعية، للقوى البحرية قدرة غير مسبوقة على التأثير في الديناميكيات الإقليمية خارج الشمال العالمي.
بعد الحرب العالمية الثانية سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وخاصةً تحت تأثير المحافظين الجدد إلى ترسيخ دور مهيمن في الشرق الأوسط لاحتواء التوسع السوفيتي، وهدفت القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة إلى استقرار أسعار النفط والغاز مع وضع الموارد الرئيسية تحت الحماية الأمريكية بحكم الأمر الواقع، باستثناء إدارة نيكسون، وسعت هذه الاستراتيجية الحزبية إلى منع الدول الأصلية من الظهور كقوى إقليمية وروجت لأيديولوجية اقتصادية عالمية صديقة للسوق، كان من المتوقع أن توحد العالم بأسره في ظل نظام نيوليبرالي، واستُخدمت القوة الأمريكية بشكل منهجي لإجبار الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، ودامت هذه السياسة الهيمنة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 خططت أمريكا لحملة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال تدخلات عسكرية مباشرة وغير مباشرة، بهدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية، وتحت عنوان الحرب العظمى على الإرهاب، استهدفت هذه الاستراتيجية العراق وليبيا وسوريا والصومال والسودان، وهي دول عانت في السنوات التي تلت ذلك من العنف وعدم استقرار داخلي (Erik, 2024).
توحي التطورات بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023 بأن رؤية المحافظين الجدد للمنطقة قد تحققت، فإسرائيل تفرض وجودها في لبنان وتغزو أجزاءً من سوريا، وحزب الله في موقف دفاعي، وسوريا التي كانت يومًا ما معقلًا للقومية العربية إنهارت إلى حد كبير، فبدلًا من أن تُشير هذه الظروف إلى نجاح المشروع الهيمنة، فإنها تُؤكد فشله، فالهيمنة الأميركية على المنطقة أصبحت أكثر بعداً من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يُضعف السعي الدؤوب لتغيير الأنظمة إلا موقف أمريكا، وحتى مع تجاهل التكاليف البشرية والاقتصادية الباهظة لهذه التدخلات وطبيعتها الهامشية على أمن الولايات المتحدة Haass, 2024)).
بينما أنفقت الولايات المتحدة موارد طائلة على إبراز قوتها في الشرق الأوسط، أعادت دول محلية ذات عراقة حضارية تاريخية وقوة جيوسياسية تأكيد وجودها بهدوء كمحرك رئيسي للسياسة الإقليمية، ومع تناقص نفوذ الولايات المتحدة إلى حد ما عززت هذه القوى المتوسطة المحلية، مثل تركيا وإيران والسعودية، شبكاتها الجيوسياسية ومرونتها الاقتصادية من خلال سياسة خارجية متعددة التوجهات، وشكل هذا التحول التركيز من منافسة قوى عظمى صفرية المحصلة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى عالم متعدد المراكز تُشكله ديناميكيات توازن القوى في المنطقة، وقادت تركيا هذا التحول مستفيدةً من حماية الناتو، وسعيًا منها إلى بناء علاقات مستقلة لا سيما مع روسيا التي تتحدى قيود التحالف التقليدية، أما إيران التي لطالما كانت خصمًا للخطط الأمريكية في المنطقة، فتواصل حشد شبكة ضعيفة، لكنها واسعة ونشطة، من الجهات الفاعلة دون الدولية، تُوازن المخططات الإقليمية لمنافسيها وخصومها يُعيد البلدان إحياء نفوذهما المتجذر ثقافيًا وجغرافيًا، ويستعيدان مكانتهما التقليدية كقطبين إقليميين، مُعيدين بذلك إحياء التوترات التاريخية بين تركيا وإيران، فيما تُجسّد حالة العراق هذا التحوّل فرغم الاحتلال الأمريكي عام 2003 أصبح العراق أكثر انحيازًا لإيران منه لأمريكا، وبالمثل فإن سوريا التي
كانت يومًا ما بؤرةً للتدخل الأمريكي وحلفائه أصبحت تحت تأثير تركيا بشكل كبير، مما يُذكّر بمكانتها في عهد السلاجقة والعثمانيين، ومن المُرجّح أن تشتد هذه التنافسات الإقليمية بين تركيا وإيران UK Ministry of Defence, 2024)).
وتعد الواقعية المدرسة الأكثر ثباتًا في العلاقات الدولية، تُشير إلى أن القوى المهيمنة تسعى إلى الدفاع عن مصالحها الإقليمية من جيرانها الأقوياء وتدخلات القوى العظمى، مع تعظيم استقلاليتها، ففي مثل هذه الظروف، تُعطي الأولوية للمخاوف الأمنية بناءً على القرب الجغرافي، بدلًا من التوافق الأيديولوجي أو الالتزامات المعيارية بقضايا مثالية كالأممية، وبسبب عدم قدرتها على الثقة الكاملة بالمنافسين الإقليميين، فإن الدول الصاعدة غالباً ما ترسم سياسات خارجية متباينة، لأسباب أمنية لتأكيد سيادتها الوطنية والحصول على الدعم السياسي المحلي، بسبب عجزها عن الثقة الكاملة بمنافسيها الإقليميين، فهي تدرك أن قربها واستمرارها في السلطة في المنطقة يمنحها هيمنة تصعيدية على جهات فاعلة بعيدة، يكون وجودها اختياريًا وزائلًا بدلًا من أن يكون ضروريًا ودائمًا (Walt, 2024).
رغم تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، فإن إسرائيل لا تُعدّ قوةً مؤثرةً في المنطقة كتركيا أو إيران، ولا تزال دولة ملتزمة بإعادة تشكيل الحدود وهياكل السلطة في محيطها باسم الأمن، وبينما تضخيم السياسة الأمريكية المصالح الإسرائيلية على حساب الاستقرار الإقليمي، فإن لهذا الاعتماد على الرعاية الخارجية والدعم العسكري عواقب بعيدة المدى، كما هو الحال في أوكرانيا، فإنّ التعزيز المصطنع للقوة الإسرائيلية (بالوكالة) يدعو إلى توازنات عدوانية من قبل القوى الإقليمية المجاورة، وإذا استمرت إسرائيل في التوسع على حساب جيرانها، فإنها تُخاطر بزيادة عدد الصراعات التي تواجهها، وتدرك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا الخطر بالفعل، فقد يواجه دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل تدقيقًا محليًا أكبر، إن لم يكن رد فعل عنيفًا، مع تزايد تعارض المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة ومصالحها السياسية مع التورط المُستدام في الشرق الأوسط، فيما يُحدث احتكار إسرائيل النووي خللاً هيكلياً يُفاقم التوترات الإقليمية، فمع تنامي قوة إيران وتركيا، يزداد احتمال انتشار الأسلحة النووية من قِبَل هاتين القوتين المتوسطتين، مما يُضعف قدرة القوى العظمى الخارجية على التدخل لصالح إسرائيل، وفي المقابل، إذا طبّعت إسرائيل علاقاتها مع أقوى جيرانها من خلال الدبلوماسية وسياسات أكثر تحفظاً، وقلّلت اعتمادها على الولايات المتحدة بشكل فعّال، يُمكنها أن تتمتع بأمن أكثر استدامة على المدى الطويل، كمشاركة في الهيكل الأمني الجديد للمنطقة كدولة غرب آسيوية حقيقية، بدلاً من اعتبارها بؤرة غربية (Vaez, 2024).
كشف الصراع بين إيران وإسرائيل عن تفوق عسكري إسرائيلي كبير، وخلل في ميزان القوة العسكري بينها وبين أي قوة إقليمية أخرى، وذلك على الرغم من المواجهة والخسائر غير المسبوقة التي تتعرض لها، فقد أثبت الصراع حقيقة قوة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تجهيزاته التكنولوجية ودقة الاستخبارات والعمليات المشتركة، والتفوق الجوي، فضلًا عن الدفاعات الجوية غير العادية التي تحمي سماء الأراضي المحتلة، وكذلك إمكانية العمل على جبهات متعددة في آن واحد، كما أظهر الصراع نفوذ إسرائيل على الساحتين العالمية والإقليمية، حيث حيدت العديد من الحكومات في هذا الصراع، وهو ما يُشير إلى نفوذها السياسي والدبلوماسي، كما أثبت الصراع أن إسرائيل أصبح لديها سلطة كبيرة على الإدارات الأمريكية، التي بدت أكثر ضعفًا أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى وإن ذهب البعض إلى وجود تنسيق بين الجانبين، فالتفوق الإسرائيلي، دفعها إلى التفكير فيما هو أبعد من الانتصار وتحقيق أمن إسرائيل، بل التفكير في تغيير خريطة الشرق الأوسط، وترى
إسرائيل أن هذا الشرق الأوسط الجديد سوف تتمتع فيه بمكانة القوة المهيمنة والأكثر تأثيرًا، والتي توسع حدودها الجغرافية بناء على التفسيرات والنبوءات الدينية، ولا تُقيم فيه أي اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقهم في دولتهم المستقلة، وتستخدم فيه إسرائيل قوتها العسكرية في أي مكان بالمنطقة وفقًا لتقدير التهديدات التي تمس بأمن إسرائيل ولا تستثني في ذلك أي قوة إقليمية، مع ما يعنيه ذلك من تأكيد للمكانة وقوة الردع وإملاء الشروط والتدخل في شؤون الدول وقراراتها في المنطقة، وذلك ضمن رؤية لإحداث تغيير في البيئة الاستراتيجية وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية (Vinograd and Sampson, 2025).
تظهر نزعة الهيمنة الإقليمية لإسرائيل والخرائط التي يعرضها المسؤولون، التي تخلو من أي إشارة إلى دولة فلسطينية، بل ضمت إحداها الأردن ضمن حدود دولة إسرائيل، أن هناك عددًا من الوزراء في الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا يؤمنون بحل الدولتين، وقد عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه خلال كلمته أمام الأمم المتحدة خرائط للدول التي لديها علاقات مع إسرائيل أو التي تنوي التطبيع معها، وخريطة أخرى للدول التي تدور في فلك إيران، في إشارة إلى نظرة حكومته إلى مستقبل الشرق الأوسط المتسق مع أهداف إسرائيل، وهو المشروع الأمريكي نفسه الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة إلى محورين تدير من خلالهما إسرائيل نفوذها، وتحقق عبرهما تفوقها الإقليمي، وقد حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له مما سماه “الطموحات التوسعية الإسرائيلية”، وقال “سيطمعون في أراضي وطننا بين دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال خرائط يلتقطون الصور أمامها أنهم لن يكتفوا بغزة” (أبو طالب، 2025).
يمكن الإشارة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب: “عندما أنظر إلى خريطة الشرق الأوسط، أجد إسرائيل بقعة صغيرة جداً، في الحقيقة قلت هل من طريقة للحصول على المزيد من المساحات؟”، وتصريح ترامب ربما يُشير إلى احتمال وجود تفاهمات، أو وعود ترمي إلى تمكين إسرائيل من توسيع حدودها على حساب جيرانها، وهذا المشروع ربما يتخطى حدود السيطرة الكاملة فلسطين التاريخية مع ضم أجزاء من لبنان، وربما إزاحة الحدود مع سوريا ضمن مشروع إسرائيل الكبرى، وهو أمر ليس مستبعدًا في ظل التنافس بين الحزبين في الولايات المتحدة على إثبات الولاء لإسرائيل، وانجراف غالبية المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، والشعور بالتفوق الإقليمي على جيرانها، والإفلات من المسؤولية، وهي الأمور التي تغذي رغبتها في الهيمنة الإقليمية وإضعاف القوى المحيطة بها من خلال القوة أو الاختراق (ناجي، 2024).
- أبعاد مظاهر الأزمات الإقليمية الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط :
من مظاهر الأزمات الإقليمية الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط ما يلي:
- التدخل العسكري في دول الإقليم:عقب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والذي شنته حركة حماس على أراضٍ إسرائيلية، والذي أدى إلى قيام لإسرائيل يشن حرب في قطاع غزة، واتساع دائرة الصراع الإسرائيلي مع الجماعات المدعومة من إيران من لبنان إلى اليمن، كما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية التي أدت إلى تدمير الكثير من البنية التحتية العسكرية السورية مما أدى إلى خروج العديد من الفاعلين في المنطقة من معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي (Yohanan, 2025).
- تراجع السيادة الوطنية وبروز الدولة العاجزة:أدى الهجوم الإسرائيلي على كلا من اليمن ولبنان وسوريا وإيران، عبر عمليات عسكرية مكثفة، أدت إلى مقتل قيادات بارزة وإضعاف نظم الحكم في تلك الدول، وبروز الدولة العاجزة في كل من (إيران– سوريا) أو الدولة المنقسمة في كل من (اليمن–لبنان)، حيث برزت الجماعات المسلحة التي تعمل خارج الأطر النظامية للدولة، كما تجسد الانقسام السياسي والذي يمهد لوجود تغييرات كبيرة في طبيعة السلطة الحاكمة ومنها (سوريا–اليمن–ليبيا) (أبوطالب، 2025: 160).
- الهيمنة على دول الإقليم:سعت إسرائيل إلى تغيير المعادلات الأمنية القائمة في منطقة الشرق الأوسط من خلال محاولة تشكيل نظام إقليمي جديد قائم على الهيمنة الأمنية على دول الإقليم، يهدف لتحييد التهديدات الأمنية، والتحكم في الأنظمة القائمة في دول الإقليم، عبر عدة وسائل أبرزها الأختراق الاستخباراتي، وأضعاف البنى التحتية العسكرية، ويعد النظام السوري أبرز الأمثلة على ذلك; حيث أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تُزوّد بالوقود فوق شرق سوريا وتُنفذ ضربات في عمق الأراضي الإيرانية (Kajjo, 2025).
- تجاوز قواعد الاشتباك التقليدية:ابتعدت إسرائيل عن قواعد الاشتباك التقليدية التي سادت عام 2023، فقد حدث هذا التحول بالانتقال إلى الاستهداف المباشر في عمليات استهدفت العمق الاستراتيجي لإسرائيل وإيران، مما إنعكس في البيانات الرسمية لكلا الطرفين، والتي تشير إلى زيادة في حدة الاشتباكات والتصعيد، ومع ذلك، يبدو أن كلا الجانبين يتجنبان حرب الاستنزاف المفتوحة، مع مراعاة العوامل الإقليمية والداخلية لكل منهما (Fawzy, 2024).
- تحول الهدف الاستراتيجي للعمل العسكري : تنص الاستراتيجية العسكرية لدى إسرائيل على أن الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية على المستوى الاستراتيجي يتمثل في خلق وضع يضطر فيه العدو إلى الموافقة على ترتيبات سياسية جديدة، غير أن الاستراتيجية التي تم تنفيذها تقوم على أن العمل العسكري يخلق واقع سياسي ينبغي التمسك به، مثال ما يحدث في قطاع غزة، فبدلاً من تقليص قدرات حماس، عمد الجانب الإسرائيلي إلى استئصال حركة حماس والجماعات المماثلة لها بالكامل (التقرير الاستراتيجي العربي، 2024: 132).
- استخدامالقدرات السيبرانية في فرض هيمنتها إقليمياَ :تسعى إسرائيل إلى فرض الهيمنة على الإقليم اعتماداً على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة ومنها القدرات السيبرانية، مثل: الطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخي ، واستخدام الذكاء الاصطناعي على أرض المعركة، وهو ما سمح لإسرائيل إبراز نفوذها دون إسقاط القوة التقليدية، مما منحها نفوذًا مهيمنًا عبر كل من الأبعاد العسكرية والدبلوماسية للمنطقة، وتعد هشاشتها الديموغرافية وعدم وجود عمق استراتيجي لها، الدافع لسعيها الدائم للسيطرة على الإقليم وتحييد خصومها Farahmand, 2025))
فيما تنامي الدور الإقليمي التركي خصوصًا بعد إطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024، ودعم تركيا الفصائل السورية المسلحة التي انخرطت في عملية تغيير النظام بالقوة، ومتابعتها استراتيجية طموحة للانتقال السياسي في سوريا، وانتهاجها سياسة نشطة وتدخلية تجاه محيطها الجغرافي في الشرق الأوسط، اصطلح على تسميتها “العثمانية الجديدة “ويُقصد بها أن تركيا تتصور لنفسها دورًا فعّالًا وقائدًا، يرتقي إلى درجة الهيمنة في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط، الذي كان
بالفعل تحت الهيمنة والسيطرة التركية خلال فترة الإمبراطورية العثمانية، منذ الثلث الأول من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر على الأقل، وكأن العثمانية الجديدة، كما يوحي بذلك اسمها، هي دعوة لإحياء فترة الحكم العثمانية لبلدان المنطقة في صورة جديدة، تتضمن النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي واسع النطاق(Yavuz, 2025)
وتستمر إسرائيل مع الولايات المتحدة في سياستها لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط وبرغم إضعاف النفوذ الإقليمي الإيراني بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فيما لا تزال إيران ماضية في سعيها لتعزيز نفوذها والهيمنة في المنطقة من خلال استراتيجيات تجمع بين مزيج من الأيديولوجيا الطائفية والطموحات القومية، وتعتمد سياساتها على دعم الميليشيات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإثارة النزاعات الإقليمية.(Sachs, 2024)
ويتصاعَد الدور الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيّما السعودية والإمارات، ويواجه الدور الإقليمي المحوري لمصر تحديات اقتصادية وأمنية، وهذه الأدوار المتباينة للدول الرئيسية في الإقليم، بالإضافة إلى المحاور الإقليمية الناشئة أو المستمرة، مثل المحور التركي ومحور دول مجلس التعاون-مصر والمحور الإيراني، سوف تُحدد هيكل القوة الإقليمي، الذّي يرجَح أن يظل تعدّديًا صراعيًّا عام 2025Hussein, 2025) ).
- الخاتمة:
شهد الشرق الأوسط في عام 2025 تحولات كبيرة في مختلف القطاعات، فالمشهد السياسي يشهد تحولات في التحالفات وديناميكيات القوة، مما يؤثر بشكل خاص على نفوذ إيران الإقليمي وصعود الجماعات السنية، واقتصاديًا تواجه المنطقة تحديات بما في ذلك انتكاسات ناجمة عن الصراعات وتحول الطاقة، لكنها تُظهر إمكانات للنمو في بعض المجالات، لا سيما مع صعود الإمارات كمركز مالي، ولا تزال العوامل البيئية، مثل ندرة المياه وتغير المناخ، تشكل تحديات كبيرة، في حين تُعيد التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تشكيل المنطقة، ويتطور توازن القوى التقليدي في الشرق الأوسط، مع فقدان بعض اللاعبين التقليديين نفوذهم وظهور تحالفات جديدة، ويستمر التنافس بين القوى الإقليمية، حيث يسعى كل منها إلى حماية مصالحه ومنع الآخرين من اكتساب الهيمنة.
يتميز الشرق الأوسط بالعديد من الصراعات المستمرة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاشتباكات المستمرة في سوريا ولبنان، والصراع في اليمن، وتزيد هذه الصراعات من تعقيد ديناميكيات القوة الإقليمية، وتخلق فرصًا للتعاون والتنافس بين الجهات الفاعلة الإقليمية، ويُعد الشرق الأوسط في عام 2025 منطقة معقدة وديناميكية، تتميز بديناميكيات قوة متغيرة، وصراعات مستمرة، وبروز جهات فاعلة جديدة، ولم تبرز أي قوة واحدة كقوة مهيمنة واضحة، ولا يزال التنافس على النفوذ يُشكل المشهد الإقليمي في المنطقة.
- النتائج:
خلصت الدراسة الى النتائج التالية :
- لقد غيّرت المواجهة بين إسرائيل وإيران في حزيران 2025 المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فالتحولات الهيكلية ستشكل ديناميكيات المنطقة لعقود قادمة، فقد شكل الصراع حدثًا تشخيصيًا كشف عن التصدعات العميقة التي تشكّل البنية الأمنية المعاصرة في الشرق الأوسط، مبينًا كيف يُمكن للاشتباكات التكتيكية أن تُنير التحولات النظامية الأوسع وإعادة التنظيم الاستراتيجي.
- يمكن أن تؤدي التغيرات في البيئة الأمنية، مثل ظهور تهديدات جديدة أو اختلال ميزان القوى، إلى ترتيبات أمنية وآليات تعاون جديدة بين دول المنطقة في ضوء مصالحها.
- يشير النظام الإقليمي الجديد إلى تحول في طريقة تفاعل القوى الإقليمية وتعاونها، مما قد يؤدي إلى توزيع مختلف للنفوذ وإعادة هيكلة العلاقات داخل منطقة جغرافية محددة، وقد يشمل ذلك تغييرات في الترابط الاقتصادي، والتحالفات السياسية، وديناميكيات الأمن، ما يتأثر تشكيل نظام إقليمي جديد بتحولات القوة العالمية، والتقدم التكنولوجي، وتطور المعايير الإقليمية والدولية.
- قد تؤدي التحولات في النظام الإقليمي إلى زعزعة الاستقرار، وتؤدي إلى زيادة التنافس، بل وحتى الصراع بين القوى الإقليمية.
- يشهد الشرق الأوسط تحولات عميقة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، مما يستدعي فهمًا دقيقًا لهذه التطورات وتأثيراتها على المنطقة والعالم
- التوصيات:
مما سبق نجد أن التعاون الإقليمي ضروري لتحقيق استقرار دائم، وينطبق الأمر نفسه على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، ويجب على المنطقة أن تندمج بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، وأن تكون رائدة في مجال تحول الطاقة، وأن تبني علاقات مثمرة مع الاقتصادات الكبرى في العالم، ولكن ينبغي لقادة الشرق الأوسط أن يدركوا ضرورة منع المنافسة العالمية من إشعال فتيل الانقسام والصراع داخل المنطقة، وإن بناء نظام إقليمي وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، ضرورة ملحة لمنع المنطقة من التوجه نحو الفوضى.
المصادر والمراجع
باللغة العربية:
- بيرهات، أحمد (2025). تداعيات الصراع الإيراني – الإسرائيلي وأبعاده الإقليمية والدولية، طهران: مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية
- التقرير الاستراتيجي العربي (2024). إسرائيل الردع بالقوة المفرطة والحرب الطويلة، القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
- الزبن، سمير (2001). النظام العربي ماضيه ومستقبله، ابو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
- السكري، نوار (2025). الردع المتبادل والهيمنة: قراءة في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها الجيوسياسية، المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة.
المقالات:
- أبوطالب، حسن (2025). الشرق الأوسط بين أوهام إسرائيل وتحولات النظام الدولي ، مجلة السياسة الدولية ، 60 (240)، 150-173.
- بدوى، منير (1997). مفهوم الصراع دراسة في الاصول النظرية للاسباب والانواع، مجلة الدراسات المستقبلية، جامعة أسيوط ، 1 (3)، 21-43.
- بريجع، ديميتري (2024). 2025عام التحولات الكبرى في الشرق الأوسط وتحديات بناء المستقبل، https://eurasiaar.org/
- حيدر، علي (2020). الشرق الاوسط افتراضات متصدعة وانماط جديدة من الصراع، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 3 (2)، 124-139
- الدسوقي ، أبو بكر (2025). الشرق الأوسط في مفترق الطرق اتجاهات التفاعل، مجلة السياسة الدولية ، 60 (239)، 60-89.
- عايش، محمد (2025). الحرب بين إيران وإسرائيل ودلالاتها الاستراتيجية، صحيفة القدس العربي، بتاريخ،23 يونيو 2025.
- القصيفي، إيلي (2025). إسرائيل وإيران حرب البدايات أم النهايات؟، https://www.majalla.com/
- ناجي، محمد (2024). ارتدادات التصعيد: هل تتجه إيران نحو تغيير سياساتها الدفاعية؟، انتررجونال للتحليلات الإستراتيجية، 14 أكتوبر 2024م، https://n9.cl/gf0dx
المراجع باللغة الأجنبية:
Books:
- Bull, H. (2012) The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. 4th Edition, Palgrave Macmillan.
- Burchill, S, Linklater, A, Devetak, R, Donnelly, J, Paterson, M, Reus-Smit, C. and True, J. (2005) Theories of International Relations. 3rd Edition, Palgrave Macmillan.
- Griffiths, M. (2007). International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction. Routledge.
- Yavuz, M. (2025), ‘Erdogan’s Neo-Ottomanism’, Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism, New York;
- Cruz, M, Barbazon, J, Halfhill, D. and Ritzel, S. (2020) Between Theory and Practice: The Utility of International Relations Theory to the Military. Air University.
- Assoc A. Arben P. (2025). Fall Of Syrian Regime And Regional Implications – Analysis, Eurasia Review.
Articles:
- Ahn, S (2025). The shifting dynamics of amity and enmity, https://www.tandfonline.com
- Asi, Y. (2022) The Colonial Legacy in the Arab World: Health, Education, and Politics. https://arabcenterdc.org.
- Bazoobandi, S., Heibach, J. and Richter, T. (2024) Iran’s Foreign Policy Making: Consensus Building or Power Struggle? British Journal of Middle Eastern Studies, 51, 1044-1067.
- Burke, J. (2024) The Middle East in Crisis: 7 October, the Day that Changed the World. The Observer.https://www.theguardian.com.
- Cammak, P. and Dunne, M. (2018) Fueling Middle East Conflicts—Or Dousing the Flames. Carnegie Endowment for International, https://carnegieendowment.org.
- Erik, L (2024). Wars Are Not Accidents, foreign affairs, https://n9.cl/qrmqd
- Farahmand, B (2025). The Shifting Balance of Power in the Middle East After October 7: Israel’s Pursuit of Regional Hegemony, JURIST News, June 14.
- Fawzy, M (2024). Trajectories of Houthi-Israeli Escalation, Yemen & Gulf Center for Studies , 25 Jul 2024 , Retrieved from: https://ygcs.center/public
- Fernandez, A (2015). The Multiple Crises in the Middle East. European Institute of the Mediterranian, https://www.iemed.org.
- Haass,R (2024). The Lessons and Legacy of October 7, project-syndicate, Oct 2, 2024.
- Hassenstab, N. (2024) Understanding Iran’s Use of Terrorist Groups as Proxies. American University. https://www.american.edu.
- Hussein, M (2025). Mapping Israel’s expanding air attacks across Syria, Al Jazeera, 4 Jun 2025, Retrieved from: https://www.aljazeera.com
- Kajjo, S (2025). Israel-Iran Conflict Underscores the Imperative of Syria’s Neutrality, Middle East Forum, June 15, 2025, Retrieved from: https://www.meforum.org
- Kiran, A (2025). Trump and the New Era of Middle Eastern Policies”, Centre Français de recherche sur l’Irak (CFRI), www.cfri-irak.com
- Routers (2025), Turkish lawmakers discuss Mideast in closed session after Erdogan’s Israel claim,. https://www.reuters.com
- Sachs, J (2024). The Inevitable War with Iran, and Biden’s Attempts to Sabotage Trump, The Tucker Carlson Show, December 17, 2024, https://www.youtube.com.
- Simon, R (1996). Encyclopedia of the Modern Middle East, vol. 4 (Macmillan).
- Tardot, L (2025). Iran-Israel War: Origins, Developments, Future Prospects, US-Iran Relations: Why a Nuclear Deal Is So Difficult ? Is War Inevitable? https://eismena.com
- UK Ministry of Defence (2024) , Global Strategic Trends: Out to 2055, Seventh Edition, accessed: October 30, 2024, https://n9.cl/fh54c
- Vaez, A (2024). Iran’s Year of Living Dangerously, foreign affairs, accessed: October 30, 2024, https://n9.cl/s8ofmo
- Vinograd, E and Sampson, E (2025) Timeline: A Recent History of the Israel-Iran Conflict, https://www.nytimes.com/
- Walt, S (2024). Israel’s Mission Accomplished Moment in the Middle East, Foreign policy, October 2, 2024.
- Wight, M. (1986) Power Politics: The Definitive Study of International Politics. Penguin.
- Yohanan, N (2025). As Israel takes fight to Iran, where are Tehran’s terror proxies in its hour of need?, The Times of Israel , June 16, 2025, Retrieved from: https://www.timesofisrael.com
- Zarar B, Imtiaz, K and Khurshid, Z. (2025). The Fall of Bashar al-Assad: Implications for Syria and the Broader Middle East. Dialogue Social Science Review (DSSR), 2(5), 752–764.
- Zeidan, A (2025). Israel-Iran Conflict. https://www.britannica.com/event/Israel-Iran-conflict