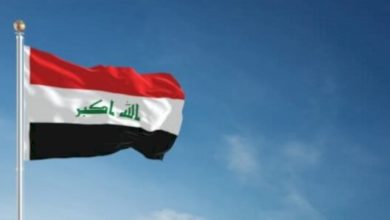إشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ” قراءة في الأدبيات النظرية “

اعداد : رفيق ايت تكنتا – باحث في العلوم الاجتماعية – جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء /المغرب
مقدمة:
لقد شكلت إشكالية تحديث الدولة _ ولا تزال _ محور النقاشات الدائرة في الفكرين العربي و الإسلامي ؛ فقد شكلت هموم الدولة وطبائعها وأدوارها مساحة مركزية من التفكير، سواء في زمن أطروحة الدولة الوطنية التي انشغل بها الاٍصلاحيون الإسلاميون ،أم في زمن الدولة القومية التي سعى إليها القوميون ؛ أو في زمن الخلافة التي أمل كثير من الإسلاميين بإقامتها أو استعادتها ، ولا يزالون ، وصولا إلى الدولة الإسلامية التي ظهرت كرد فعل على سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 م ، والدولة الدينية كما نجد مع أفكار الحاكمية وولاية الفقيه [1].
ولعل السبب في ذلك ، يرجع إلى أن في الواقع ثمة مشكلة في التفكير العربي والإسلامي بخصوص الدولة _ خصوصا الدولة في المشرق العربي _ شخصه البعض بأنه يعود _ في جوهره _ إلى أن الخلل الذي أصاب المجتمعات الإسلامية ومدنيتها إنما يرجع إلى تخلف نظمها السياسية ( بما تشمله من جيوش ومؤسسات قوية وإدارة فعالة وتنظيم مالي متقدم …) ، فكان أن لجئوا إلى فكرة الدولة الوطنية .
ولهذا، فالدولة القائمة في المشرق العربي ، وكيفما كانت طبيعة نظام الحكم السائد فيها ، يطلق عليها البعض ” نموذج الدولة التسلطية ” ، التي تختلف بشكل كبير عن الدولة الديمقراطية الحديثة بكل ما تتميز به من قدرة على ممارسة سلطتها ، كسلطة مؤسساتية وقانونية ، تلتزم فيها بقيم المساءلة والمحاسبة والاٍحتكام إلى الشعب .
وتعد الدولة التسلطية مفهوما حديثا في الفكر السياسي العربي والإسلامي، باعتبارها هي التعبير المعاصر للاٍستبداد التقليدي[2]، الذي أصبح يعاني منه العالم العربي . وذلك لأن ظاهرة التسلطية ، وهي ظاهرة خاصة بالقرن العشرين والشكل المكتمل للدولة البيروقراطية الحديثة ، التي انتشرت انتشارا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية في دول العالم الثالث _ ومنها دول المشرق العربي _ بعد مرحلة انحسار ، فقد امتلكت ناصية الاستبداد من مصدريه التقليدي والحديث ، وهو ما نطلق عليه الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع[3].
وهكذا ، فاٍن الدولة العربية هي تجسيد وتكريس حي للطبيعة التسلطية ، هذه الدولة التي تقف ضد المجتمع ، وتعمل على إفراغه من مضمونه الاجتماعي وتسيطر على كل مناحيه وأجزائه .
ولذلك ، فإذا كانت الغاية من الدولة ، هي تسخيرها لخدمة الصالح العام ، ولأن حياة الناس داخلها لا تستقيم إلا بوجود الدولة ، نظرا لما تضطلع به الدولة من مهام حيوية ، كالحفاظ على الأمن ، وتأمين الحقوق الأساسية ، كالحق في التعليم ،الصحة ،الشغل ،ضمان الحريات ،المساواة ، والعدالة ، فاٍن وجود الدولة التسلطية في الواقع السياسي العربي ، نتج عنه أن هذه الصورة الاٍيجابية للدولة التي تحدثنا عنها ، لا نجد لها تجليات على أرض الواقع ، إذ تنخرط الدولة التسلطية في العالم العربي في ممارسات لا تراعي خلالها أي حق من تلك الحقوق ، وتتحول أجهزتها ومؤسساتها إلى أدوات لنشر الفزع والخوف والعنف ، بدعوى المحافظة على الوحدة الاٍجتماعية ، هذا الأمر الذي جعل من مفهوم ” الدولة التسلطية ” ، مفهوما إشكاليا ظل مثار نقاش في الخطابات السياسية العربية المعاصرة .
من هذا المنطلق ، ستحاول هذه المقالة البحث في :
أولا ، تتبع بناء ونشأة الدولة ” التسلطية ” في المشرق العربي ، وكذا بيان أهم مميزاتها وخصوصياتها التي تنفرد بها بخلاف الدولة الديمقراطية الحديثة كما هي في الغرب . وثانيا ، البحث في أهم الأطروحات النظرية المفسرة لظاهرة ” التسلطية ” كظاهرة نفترض أنها تتميز بها الدولة في المشرق العربي .
ولهذا، ستحاول هذه المقالة الإجابة على تساؤل رئيس هو:
إلى أي حد يمكن تفسير إشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي باٍستمرارية ظاهرة ” الدولة التسلطية ” بالرغم من التحولات السياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي عرفها _ ولازال المشرق العربي في خضم ما يسمى ” بالربيع الديمقراطي ”؟
وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي :
- كيف نشأت الدولة التسلطية في المشرق العربي ؟
- وما هي خصوصياتها الثقافية ؟
- وما أسباب تجذر التسلطية السياسية في المشرق العربي ؟
- وما هي أهم الأطروحات النظرية التي تفسر لنا ظاهرة الدولة التسلطية ؟
- وما هي عوائق وإمكانات التحول الديمقراطي في المشرق العربي ؟
وتفترض هذه المقالة أن استمرارية ظاهرة الدولة التسلطية في المشرق العربي ، يعود بالأساس إلى قدرتها على ممارسة عنفها الرسمي وسياساتها الهادفة إلى تحجيم وقهر كل جمعيات المجتمع السياسية والمدنية ( تنظيمات سياسية ، نقابات ، اتحادات …) بجعلها تسير في فلك النظام القائم وفرض الخطاب السياسي الرسمي عبر المؤسسات التربوية والتعليمية وأجهزة الإعلام ، كل هذا أدى إلى تحييد القوى الاٍجتماعية وتشديد قبضة الدولة على المجتمع مما أجهض جل المبادرات الديمقراطية .
هذا إضافة إلى أنها تحافظ على استمراريتها من خلال السيطرة على الجهاز التنفيذي ، وكذا السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك تقوية أجهزة المخابرات، باٍستثمار نسبة كبيرة من إيرادات الدولة_ من النفط خاصة _ في الإنفاق على هذه الأجهزة من جهة ، والسهر على تحقيق السلم الاٍجتماعي بتوفير الحاجيات الاجتماعية لرعاياها عن طريق اقتصاد الريع .
كما تفترض هذه المقالة أيضا، انه إذا كانت الدولة الديمقراطية تقوم شرعيتها على تصور جديد لمفهوم المواطنة والعدالة والمساواة، وإعطاء الأسبقية للمصلحة العامة ، وأصبحت المواطنة لا تعني الاٍمتثال والطاعة المطلقة للقوانين المسطرة من قبل أجهزة الدولة ، بل تعني طاعة القوانين التي يكون فيها المواطن طرفا في صياغتها . فاٍن الدولة التسلطية في المشرق العربي تتميز بخاصية أساسية هي أنها تستمد شرعيتها من القوة ، ومن تركيز السلطات الثلاث واجتماعها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة ، وذلك من خلال آليات القمع والعنف، وبذلك يكون تفسير الإذعان الشعبي للتسلطية ليس فقط” ببراديغم ” الطاعة الذي تبدي فيه الشخصية العربية استعداد كبيرا للخضوع والتبعية كقدر ثقافي ملازم لها _ كما تؤكد مجموعة من الأطروحات النظرية _ ، بل بالآلة القمعية للدولة التسلطية العربية ، المعقدة والمتشعبة ، باعتبارها العامل الرئيس في تفسير الإذعان للسلطة أو الانطباع بوجود استعداد اٍجتماعي للٍاذعان للدولة العربية المعاصرة في المشرق العربي كما اتضح مع الثورات العربية .
لقد اشتغل العديد من الكتاب على إشكالية الدولة التسلطية في المشرق العربي ، بالبحث عن تفسيرات مقنعة توضح أهم العوائق التي تقف في طريق تحديث هذه الدولة وأسباب تجذر التسلطية في أنظمة حكمها. فذهب بعضهم إلى القول بأن غياب الديمقراطية وقيم الحداثة عن هذه الدولة، يرجع إلى الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي والإسلامي، الذي يقبل بالاستبداد والتبعية والخضوع كخاصية ثقافية تدخل في تنشئة المواطن العربي .
وفي هذا الإطار تندرج أطروحة ” الاستبداد الشرقي ” التي دافع عنها مجموعة من المفكرين الغربيين أبرزهم أرسطو و مونتسكيو ثم كارل ماركس . بالإضافة الأطروحة ” الأبوية ” التي انتصر لها كل من الفيلسوف الألماني “فريدريك هيجل” و الكاتب الفلسطيني “هشام شرابي ” . ثم أطروحة الانثربولوجي المغربي عبد الله حمودي التي طرحها في كتابه ” الشيخ والمريد ” .
كما نجد أيضا مفكرون آخرون يرجعون أصل الاستبداد العربي إلى عوامل داخلية تخص طبيعة وتركيبة الأنظمة السياسية في هذه البلدان العربية ، وفي هذا الإطار تندرج نظريات ” بطانة الحاكم وحاشيته ” ونظريات ” الدولة الريعية ” . وأخيرا جانب من المفكرون يفسرون أصل الاستبداد السياسي في المشرق العربي بعوامل خارجية ترتبط بتدخلات القوى الأجنبية وأثرها على عرقلة أية محاولة تصبو إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية .
بناء على ماسبق ، سنحاول الإجابة على إشكالية الدراسة وفق التصميم التالي :
المبحث الأول: التسلطية وإشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي
- أولا: إشكالية بناء الدولة في المشرق العربي
- ثانيا : خصوصيات الدولة التسلطية في المشرق العربي
- ثالثا: أسباب تجذر التسلطية السياسية في المشرق العربي
المبحث الثاني: الدولة في المشرق العربي وإشكالية استمرارية نمط السلطة التقليدية
- أولا: الأطروحات النظرية المفسرة للنمط التقليدي للسلطة
- ثانيا: التحول الديمقراطي في المشرق العربي : العوائق والإمكانات
خلاصـــة.
المبحث الأول: التسلطية وإشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي
ربما لا جدال أنه عند نشوء مجتمع ما، فاٍنه يكون بحاجة إلى سلطة تضبطه وتسير أموره، فلا مجتمع بدون سلطة. ولهذا، تأتي ضرورة السلطة من باب أنها، كظاهرة هي ” ظاهرة طبيعية في أي مجتمع سواء كان بدائيا، متطورا أو حضاريا، ففكرة العيش بدون سلطة هي في الحقيقة فكرة خيالية فكل شيء في الحياة يوحي بوجودها ” [4] . وعليه فلا يمكن لأي مجتمع أن يعبر عن تماسكه وحداثته إلا بعد حل مسألة السلطة في المجتمع ، بما يتماشى مع إرادات أفراده .
من هذا المنطلق ، وبالنظر إلى طبيعة أنظمة السلطة التي نشأت في المجتمعات العربية عبر التاريخ ، وخصوصا مجتمعات المشرق العربي ، يتضح لنا مدى تميزها بظاهرة الاٍستبداد أو التسلطية كشكل من أشكال العلاقة بين الحاكم والمحكومين .ومهما تعددت التفسيرات لهذه الظاهرة ( الحكم الفردي أو الأوتوقراطي ، الحكم المطلق ، الحكم الأرستقراطي أو الأوليغارشي…) – كما سنبين في هذه المقالة – فاٍن الظاهرة ” التسلطية ”هي حينما ” يكون الحكم الاستبدادي مبنيا على تسيد الدولة البيروقراطية على المجتمع من خلال قدرتها على تنسيق البني التحتية بحيث تخترق المجتمع المدني بالكامل وتجعله امتدادا لسلطتها، وتحقق بذلك الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع”[5] وهذا ما يميز أنظمة الحكم المعاصرة في المشرق العربي.
أولا: إشكالية بناء الدولة في المشرق العربي
إذا كانت ظاهرة التسلط والاٍنفراد بالحكم ترتبط بشكل الدولة في المشرق العربي المعاصر و تضرب بجذورها في التاريخ العربي والإسلامي، فاٍن فهمها وتفسيرها لن يتأتى إلا في إطار الوعي بالصيرورة التاريخية وتحولاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي كان لها الدور الأساسي في بلورة هذا النمط من طبيعة الحكم في المشرق العربي المعاصر.
وهكذا، فهذه الدولة تعود نشأتها وسياق تشكلها التاريخي إلى الاٍجتياح الاٍستعماري الغربي وما استتبعه من إعادة رسم التوازنات الدولية الناشئة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ، وتقسيم المنطقة جغرافيا وسياسيا [6]. ” وهذا ما يعبر عنه الباحث “نزيه الأيوبي” بتأكيده أن تشكل الدولة في المشرق العربي لم يكن نتيجة لصيرورة اجتماعية تكاملية نابعة من الداخل بل كان بدرجة كبيرة نتيجة لصيرورة سياسية مفككة مفروضة من الخارج”[7]، مما يعني أن الدولة في المشرق العربي شكلت نظاما سياسيا وحضاريا مخترقا اختراقا كاملا من قبل الدول الامبريالية التي تسيطر على العالم.
ومن نتائج هذا الاختراق، سعي الأنظمة في المشرق العربي إلى الانفلات من قبضة الاستعمار، وكذا فك الارتباط مع مرحلة التبعية للقوى الدولية المهيمنة على المنطقة. وأيضا عجز المجتمع العربي عن تأسيس “الدولة الحديثة الديمقراطية”، نظرا للتطور اللاعقلاني الذي لازم تشكلها وبسببه أصبحت نموذجا مشوها للدولة البيروقراطية الحديثة كما هي في الغرب .
على ضوء ما سبق، يمكن القول أن نشأة الدولة التسلطية في المشرق العربي ، كما ذهب إلى ذلك “خلدون حسن النقيب ” في كتابه ” الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر ، دراسة بنائية مقارنة” ، يعود بالأساس إلى مرحلتين أساسيتين مرت بهما الدولة في المشرق العربي في مسار تكونها وهي : أولا ، المرحلة الثورية بداية من سنة 1916 ، وثانيا ، مرحلة انهيار الحكم المدني .
- المرحلة الثورية بداية من سنة 1916
في ظل الحكم العثماني ثار العرب ضد العثمانيين وكانت الشرارة الأولى لثورتهم سنة 1916 من خلال “الثورة العربية الكبرى” ، لتتبعها بعد ذلك ثورة الشعب المصري سنة 1919 ، وثورة الشعب السوري في السنة نفسها بالدعوة إلى المؤتمر الوطني الذي أعلن الاستقلال في مارس 1920 ، هذا إضافة إلى ثورة الشعب العراقي في يوليوز 1920.
كل هذه الثورات كان المطلب الأساسي من اٍندلاعها هو الدعوة إلى الاستقلال وإلى حق تقرير المصير والسعي نحو إقامة نظم ملكية دستورية نيابية. وقد تدرجت هذه المطالب من الدعوة إلى اللامركزية إلى الإصلاح في داخل الدولة العثمانية كما تبلورت في المؤتمر العربي الأول عام 1913، إلى المطالبة بالاستقلال والحكومات الدستورية النيابية والمحافظة على حقوق الأقليات، كل هذه المطالب الثلاثة التي كانت تمثل القاسم المشترك بين الثورات أدت إلى صعود فئات اجتماعية جديدة إلى الحكم وهم فئة ملاك الأراضي والتجار من السكان المحليين، هذه الفئة كانت ذات توجه ليبرالي بميول قومي وهذا ما يفهم من قول خلدون حسن النقيب ” ففي مصر كان هؤلاء في الحزب الوطني ثم في حزب الوفد، بعد الزخم الذي حصلت عليه عملية تمصير الملكية الزراعية الكبيرة في الريف ( الذين كانوا في طور التحول إلى إقطاعيين) والضباط الشرفيين، وتجار المدن والأعيان المنضمون إلى حزب العهد، والحزب الوطني وحزب النهضة. وفي سوريا ظهروا من بين تجار دمشق وحلب خاصة، وملاك الأراضي في المناطق الأخرى من الضباط الشرفيين”[8].
وهكذا ، فوصول هذه الفئة الاجتماعية إلى الحكم باعتبارها فئة معارضة ومطالبة بالإصلاحات وتحقيق المصالح العليا لبلادها ، لم يعبر عنه في شكل أنظمة الحكم التي تبلورت في هذه الحقبة ، ويتضح ذلك بشكل أساسي في اٍهتمامها بالقضايا السياسية مثل الاستقلال والديمقراطية والدستور، على حساب الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية التي كان يعاني منها المواطن العربي آنذاك. فقد كانت القضايا السياسية قد صرفت انتباههم عن الفوارق الطبقية المتزايدة وعن حقيقة تركز الثروة والسلطة في أيديهم، وعن قضايا العدالة الاجتماعية[9].
في ظل هذا الوضع، برزت أزمة أنظمة الحكم الوطنية على المستوى الإيديولوجي والسياسي. فعلى المستوى الإيديولوجي ، تمثلت معالم هذه الأزمة في فشل التوجه “الليبرالي القومي ” الذي انتهجته تلك الحكومات، بينما على المستوى السياسي تجلى العجز في تزييف الديمقراطية، وتزوير الانتخابات، وطغيان الحزبية على المصالح العليا للبلاد، واحتكار الحكم، الأمر الذي عجل بتفكك وتفرق القيادات السياسية وتمزقها.
لكن نقطة التحول البنيوية – في هذه المرحلة- و التي زادت من أزمة أنظمة الحكم الوطني هي تحالف الفئات الحاكمة مع المصالح الغربية الرأسمالية وهزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين، الشيء الذي سرع بالحكم على التجربة الليبرالية في المشرق العربي بالفشل، وفتحت الباب أمام صعود التوجه الراديكالي المعارض.
2- مرحلة انهيار الحكم المدني:
تميزت هذه المرحلة بظهور عصر هيمنة الجيش أو العسكر على النظم السياسية القائمة في المشرق العربي، مما نتج عنه صعوبة بناء دولة مؤسسات أساسها ومبدأها الديمقراطية، لذلك ظهر نمط جديد من الاٍستبداد قائم على الدولة البيروقراطية التسلطية.
في هذا السياق، عرفت أكبر الدول في المشرق العربي مثل مصر والعراق واليمن انقلابات عسكرية ضد أشكال الحكم المدني التي كانت قائمة، وكان للطبقة المتوسطة دورا رئيسيا في ذلك. فاستولى الجيش على السلطة كما ينتمي أبرز ضباطه إلى الطبقة المتوسطة وهم من أصول ريفية. واتخذت الحكومات التي شكلتها الانقلابات العسكرية إجراءات لاستصلاح الأراضي، والقيام بإصلاح زراعي لاستقطاب سياسة جديدة، فضربت العلاقات مع الامبريالية وأنشأت علاقات صداقة مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية سابقا،وضربت الإقطاع وأنشأت القطاع العام[10].
وعليه ، رفع الجيش شعارات تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاٍجتماعية وأن تدخل الدولة أملته ضرورات التنمية ، لكن سرعان ما اتضح زيف هذه الشعارات وأن هدفها المضمر “ليس فقط تبرير استيلائهم على السلطة فحسب، وإنما تصفية كل المؤسسات الدستورية والديمقراطية في البلاد”[11] ، ومن الواضح أن المؤسسة العسكرية لم تستمد مشروعيتها من سند شعبي كبير عندما أتت إلى الحكم في البلدان العربية غير أن ذلك خلف ارتياح وتقبل لدى الشعب رغبة منهم في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة ، ووضع الدولة العربية في المشرق على المسار الصحيح، وما إن تتحقق هذه الأمور حتى يعود الجيش إلى مكانه الطبيعي أي الثكنات العسكرية تاركين إدارة الشؤون السياسية للمدنيين .
لكن ، حقائق الواقع كذبت هذه النوايا والشعارات ، واتضح أن أنظمة الحكم العسكرية لم تقدر على تحقيق الأمن والاستقرار وذلك راجع إلى خلل في رؤية العسكريين التي تهدف إلى دعم التيار المؤدي إلى تدخل الدولة على نطاق واسع في الاقتصاد والمجتمع ، وهذا ما يفهم من قول خلدون حسن النقيب بقوله أن “سبب فقدان الأمن وعدم الاستقرار في تصورهم هو تعدد الآراء واختلاف الميول وتكاثر الأحزاب والتنظيمات التي تدعم هذا الاختلاف وتذكي روح الفرقة بين المواطنين وتدفعهم إلى التعصب واستعمال العنف في حل الخلافات لذلك حتى يتحقق الأمن والاستقرار فلابد من حل الأحزاب، وإن كان لابد من وجودها فبالتضييق عليها وخنقها تدريجيا، لمصلحة الحزب الحاكم أو التنظيم الذي يدعمه العسكر”[12] ، وكانت نتيجة هذه الرؤية المغلوطة القضاء على الحريات الديمقراطية والضمانات الدستورية في البلاد العربية والرقابة الشعبية ، وبالتالي ازدياد تسلط هذه الأنظمة .
وعليه، شكلت بداية الخمسينات والستينات مرحلة أساسية في تغير ذهنية الإنسان العربي بوعيه أن الانقلابات العسكرية لم تكن ظاهرة زائلة مؤقتة عندما بدأ العسكر يضعون أسس التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة”[13]، الشيء الذي وضع أنظمة الحكم العسكرية أمام ضرورة إعادة إنتاج شرعيتها ، وبالفعل استطاعت أن تستثمر وأن تؤثر على الشعور الجماعي عن طريق قضيتا الاستقلال والوحدة العربية كقضايا تعتبر بالنسبة للإنسان العربي من الأولويات .
وهكذا استطاعت المؤسسة العسكرية التحكم في السلطة عبر مجموعة من الإجراءات ، أولا ، السيطرة الكاملة على هياكل الدولة ، من خلال حل كل المؤسسات السياسية التي كانت قائمة في النظام السابق ، وثانيا، توظيف القوة المنظمة للدولة وشرعيتها كسلطة للقضاء على كل التنظيمات السياسية وتعليق الدساتير وإلغاء الضمانات الدستورية وكذلك أغلب المكتسبات الديمقراطية. وثالثا، السيطرة على مصادر القوة الأخرى والمتمثلة في النقابات العمالية والاتحادات والتنظيمات المهنية الأخرى. وأخيرا، احتكار مصادر القوة والثروة عن طريق ترسانة قانونية تخدم مصالحها ، هذا إضافة إلى توسيع القطاع العام وتحجيم القطاع الخاص.
وعموما ، يمكن القول أن اٍنهيار الحكم المدني ، وبروز عصر هيمنة العسكر على الحكم ، وتسارع من جراء السياسات التي اٍتبعوها ظهور الدولة التسلطية التي عمت جميع المشرق العربي منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات [14] ، ومنذ ذلك الحين ، فإن النظم التي نصب فيها الجيش نفسه حكما على القيم الوطنية والقومية، واعتنق مبدأ الوطنية، واستمد شرعيته انطلاقا من الوعود التي قدمها للمستقبل. لم تستطع أن تبني مؤسسات سياسية ثابتة، وأن تطور بنية سياسية على أساس ديمقراطي[15]. وكل ذلك ، سيزيد من تبعيتها للقوى الاٍمبريالية ، واٍزدياد سلطويتها على شعوبها ، فتكون نتيجة ذلك تفتت العرب وتمزقهم إلى دول قطرية بعيدين كل البعد عن السير في مسار نماذج القوى المتحدة في العالم المعاصر .
ثانيا : خصوصيات الدولة التسلطية في المشرق العربي
مما لا شك فيه أن فهم ظاهرة الحكم التسلطي كأسلوب في الحكم ، وكشكل معاصر من أشكال الاٍستبداد التقليدي ، يرتبط بفهم معنى ومصطلح الدولة التي تجسده ، أي أنه يتصل بالدولة وترتيباتها المؤسسية ( أي علاقتها بالمجتمع ) ، وليس الحاكم فقط من حيث إساءته استعمال سلطاته [16]. فرغم موجة الاٍنفتاح السياسي التي عرفها العالم العربي ولازال يعرفها، يبدوا أنه تظل الدولة التسلطية أحد أبرز السمات السياسية للمنطقة،فهي تنفرد بمجموعة من الخصوصيات تجعلها تختلف عن باقي الدول في العالم المعاصر. ومن أهم مميزات الدولة التسلطية في المشرق العربي، أولا تعاني من أزمة الشرعية، كما تقوم على أساس احتكار مصادر القوة و السلطة في المجتمع باٍختراق المجتمع المدني، وسعيها عبر آلتها القمعية لصيانة الإذعان الاٍجتماعي .
- أزمة الشرعية السياسية :
1-1: في معنى مفهوم الشرعية :
يرتبط جوهر الشرعية بشكل عام بقبول الأغلبية حق فرد( أو جماعة) في الحكم وممارسة السلطة بما فيها حق اللجوء إلى القوة أو العنف المشروع إن اٍقتضى الأمر ذلك [17]. فالتأمل في هذا التعريف ، يوحي بأنه يرسم بدقة معالم الشرعية كما يرى الدكتور ”سعد الدين إبراهيم ” في كتابه ” مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية ” فأولا، يعد شرط ” قبول المحكومين ” وقناعتهم ، وليس ” إذعانهم ” ، جوهر الشرعية . وثانيا ، الشرعية لا تستلزم ” القبول” الأبدي لأنها ليست مكسبا نهائيا بل هي ذات طبيعة تطورية ومتقلبة تتجدد باستمرار ، وعلى الحاكم صيانتها دوما وإلا سقط ” العقد ” الذي بموجبه تحصل من قبل المحكومين على هذه الشرعية [18]. وعليه ، فالشرعية دائما متحركة على الدوام ، وكلما فقد نظام سياسي شرعيته ، فاٍنه يفقد مسوغ وجوده وبقائه.
يعد ماكس فيبر أبرز المنظرين والمؤسسين لمفهوم الشرعية و علاقته بطبيعة الأنظمة السياسية كما هي في الأدبيات الغربية. ويرى ماكس فيبر أن النظام السياسي الحاكم يكون شرعيا كلما شعر مواطنوه أن ذلك النظام يخدم مصالحهم وبالتالي يستحق الطاعة . لذلك ، فالمواطنون لا يضفون الشرعية على نظام الحكم، و لا يقبلون بحقه في أن يمارس السلطة والعنف المشروع إلا عندما يسعى هذا النظام إلى صيانة الإيمان بشرعيته وذلك يكون إما لأسباب دينية أو دنيوية، روحية، أو عقلانية.
من هذا المنطلق، فالشرعية، حسب فيبر، تستمد من مصادر ثلاث هي : التقاليد ، الزعامة الملهمة ، والعقلانية القانونية . وتعتبر الشرعية القانونية، المعمول بها في الديمقراطيات الغربية، أرقى نموذج وتعرف أيضا بالشرعية الدستورية أو المؤسسية [19]. فهذا النوع من الشرعية يتأسس على مجموعة من المبادئ القانونية التي تحدد واجبات وحقوق الحاكم ، وطريقة تداول السلطة وممارستها، كما تحدد وتقنن في المقابل واجبات وحقوق المحكومين في علاقاتهم البينية، أو في علاقتهم بالسلطة.
وهكذا ، فالشرعية العقلانية والقانونية هي النمط الذي على أساسه تشكلت الدولة القومية الحديثة في الغرب وفق تطورات تاريخية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، تطورات أدت إلى الحد من البيروقراطية الحديثة عن طريق القوانين والدساتير وفصل السلطات.[20]
في الأخير ، إن أساس الشرعية هو قبول المحكومين بأحقية الحاكم في أن يمارس السلطة ، وهذا القبول يجد سنده إما في التقاليد ( الأعراف ، المعتقدات …) أو شخصية الحاكم الكاريزمية أو العقلانية القانونية المؤسسية. لكن ما يلاحظ أن هذه المصادر – التي حددها ماكس فيبر – ليست بقانون عام تسير عليه جميع الأنظمة السياسية التي عرفتها الإنسانية، بقدر ما هي نماذج لها علاقة بأنظمة معينة وفقا لخصوصياتها. لهذا ، فالأنظمة السياسية عبر التاريخ قد تستمد شرعيتها من إحدى هذه المصادر أو من جميعها أو من مصادر أخرى لم يشير إليها ماكس فيبر . ففي ووقتنا المعاصر نجد الأنظمة السياسية العربية في المشرق العربي تستمد شرعيتها من مصادر أخرى يمكن الإشارة إلى بعضها كالقهر والعنف الغير المشروع و الايدولوجيا .
1-2: مصادر شرعية الأنظمة العربية في المشرق العربي
مهما اٍختلفت الأنظمة السياسية العربية في المشرق العربي ، وتعددت توجهاتها السياسية ، تبقى أزمة الشرعية أحد أبرز سماتها وخصائصها ، حيث تواصل سعيها لتقديم نفسها كأنظمة سياسية مستقرة عبر اٍستنادها في صيانة شرعيتها إلى مجموعة من المصادر .
يمكن القول أولا ، أن الايدولوجيا أصبحت تقريبا من مصادر شرعية بعض أنظمة الحكم في العالم الثالث وفي المنطقة العربية خلال العقود الماضية . فلقد كانت الايدولوجيا القومية مصدرا لشرعية العديد من الأنظمة العربية ، وحتى التي لم تتبن هذه الايدولوجيا كانت تعلن التزامها القضايا القومية حفاظا على اٍستقرارها [21].
وثانيا ، وأخذا بعين الاٍعتبار أزمة تشكل الدولة في المشرق العربي ، وما را فقها من اٍختلالات على جميع الأصعدة ، كانت نتيجتها تدهور العلاقة بين الحاكم والمحكومين ، فكانت علاقة أساسها عدم الثقة المتبادلة . “فالدولة العربية بسبب الوهن التاريخي المزمن الذي لازمها في صيرورة التكوين والميلاد كانت ومازالت تشكو خللا مزمنا في علاقتها بالقوى الوطنية المحلية، ثم بالجوار العربي الأوسع وفي محاولة للتغلب على أزمة الشرعية هذه تلجأ الدولة العربية إلى الإسراف في استخدام العنف والمبالغة في استعراض القوة إلى الحد الذي تتماهى فيه إدارة السياسي في إدارة العنف ، فكل نظام عربي بدون استثناء يعمل على احتكار السلطة والقوة[22] ، وكل ذلك كثيرا ما يمارس باٍسم العنف الرسمي لكبح جماح القوى المناوئة لها ، وبالتالي ، حتى واٍن وفقت ، فلا تحقق إلا استقرار سلطويا ، ظاهرا يخفي غليانا كامنا والسبب هو أن هذا ” الاستقرار ” لم يكن نتيجة لسعي ” النظام لتدعيم شرعيته ، وزيادة فاعليته ” ، وإنما نتيجة لضرب قوى التغيير في البلاد[23] .
هذا إضافة إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه التي تعاني منها الدول في المشرق العربي ، تتضح في العنف السياسي كمظهر من مظاهر عدم الاٍستقرار ، وتجلياته تظهر في إحاطة الحكام أنفسهم بجيش من قوات الحرس الملكي أو الجمهوري وجهاز مخابراتي قوي وفعال يراقب كل كبيرة وصغيرة داخل المجتمع. إلى جانب جهاز أمن داخلي يتمتع بأرقى تكنولوجيات الضبط والرقابة الأمنية وبإحداث أدوات فض التظاهرات وأساليب القمع والقهر والتعذيب.
كما يسعى كل نظام سياسي إلى الحفاظ على استقراره عبر خلق تحالفات مع القوى الدولية أو الإقليمية الكبرى حسب مصالحها، إما للحفاظ على أمنها الداخلي أو لخلق توازنات إقليمية بينها وبين الدول العربية الأخرى . وفي الأزمة السورية الدائرة – إلى حدود كتابة هذه المقالة – خير مثال على ذلك .
وأخيرا، يمكن القول أن أزمة الشرعية التي تعانيها الأنظمة السياسية العربية حاليا ناجمة عن عدم إدراكها لحقيقة تاريخية هي الطابع التطوري والمتغير للمقاربات النظرية للشرعية السياسية. فهذه الأنظمة التي تربعت على الحكم تحت مختلف المبررات ( تقليدية، قبلية، دينية، تاريخية وحتى ثورية…) في مرحلة من التاريخ وكذلك في تاريخنا الراهن مع ثورات الربيع الديمقراطي ، اعتقدت أن شرعيتها مكسبا لا رجعة فيه ، وتجاهلت بوعي منها أو بلاوعي أن العوامل الأساسية في تكريس الشرعية هي الكفاءة والفاعلية في تسيير الشأن العام ، وليس لغة القمع والقهر والعنف الغير المشروع التي لا تنتج إلا استقرار ظاهريا فقط قابل للاٍنفجار في أية لحظة.
- احتكار مصادر القوة والسلطة
إذا كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما رأينا سابقا ، هي علاقة مضطربة تقوم على فرض الطاعة تلبية لخدمة الحاكم ، وإخضاع المحكومين لإرادته ومتطلباته دون الأخذ بعين الاٍعتبار مصالحهم ولا طبيعة التعاقد الإنساني مابين الطرفين . فاٍن الأنظمة العربية تأتى لها ذلك بممارسة القمع والاٍستبداد كحق لها ، وذلك بهيمنتها على مراكز السلطة والقوة للحفاظ على وجودها لأنها تعي أنها فاقدة للشرعية .
لهذا الأمر عملت الأنظمة العربية بداية على تركيز السلطة واحتكارها باٍسم الجهاز التنفيذي الذي يعد رئيس الدولة أو الملك هو المحرك الأساسي له في خرق واضح لمبدأ فصل السلط . كما قامت كذلك بخلق أجهزة مخابرات متنوعة، لها وظائف بعيدة كل البعد عن مثيلاتها في البلدان الديمقراطية، فأجهزة المخابرات العربية صلاحياتها تفوق صلاحيات أي جهاز داخل الدولة، كما أنها ليست مسئولة أمام الأجهزة التشريعية أو الرأي العام[24]، وبهذا اٍمتلكت هذه الأنظمة أدوات العنف الغير المشروع ، تمارس بها الاٍستبداد باٍسم الأمن العام والمصلحة العليا.
هذا إضافة إلى سن ترسانة قانونية تعطي كل الصلاحيات للحاكم، سواء كانت صلاحيات تنفيذية، تشريعية أو قضائية. وكما نلاحظ فإن الدول في المشرق العربي لا تكتفي فقط بما سطرته لنفسها من الصلاحيات الدستورية والإدارية الواسعة، بل تستعين كذلك بقوانين الطوارئ التي ظلت سارية في بعض الدول لأكثر من أربعين عاما. وكل ذلك يتم من أجل هدف أساسي وهو تقويض دور المؤسسات والقوى الاجتماعية بما في ذلك مؤسسات الدولة[25]. فكما يؤكد الدكتور خلدون حسن النقيب فإن الدولة التسلطية البيروقراطية لها قدرة على اختراق المجتمع المدني بمعنى “هيمنة الدولة التسلطية المركزية المطبقة على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي ومختلف الجماعات والقوى الاجتماعية، من خلال سن واشتراع اللوائح والقوانين وتطبيقها على أنحاء البلاد جميعها”[26]
على هذا الأساس ، ترتبط ظاهرة التسلطية بالدولة في المشرق العربي ، نظرا لأنها ترفض كل ما من شأنه أن يؤسس لتجربة ديمقراطية ، وتعمل على إفراغ المشهد السياسي من معانيه وبناء مؤسسات شكلية فقط . وكل ذلك يبرر قولنا بأن لا ديمقراطية في واقع متخلف. وأن تحقيق الديمقراطية يتطلب مشاركة جميع الطبقات والفئات الاجتماعية في السياسة، وممارسة مختلف أشكال النشاط السياسي، كما تتطلب درجة عالية من المؤسساتية الفاعلة بوصفها قنوات يتم التعبير من خلالها عن هذه المشاركة السياسية[27]. وعندما نجد أن المجتمع يتم إبعاده عن السياسة في الدول العربية، فمعنى ذلك أن هناك خلل عميق في الممارسة السياسية لهذه البلدان لأن ثمة علاقة جوهرية “بين الإنتاج الاجتماعي والسياسة لأن السياسة متضمنة في العمل البشري والإنتاج الاجتماعي بكل المعاني الممكنة للإنتاج، والمجتمع الذي ينتج السياسة ينتج وحدته الاجتماعية والسياسية”[28].
وتماشيا مع طرح الدكتور خلدون حسن النقيب يمكن تحديد مظاهر اٍحتكار السلطة في النقط التالية:
- اٍجتماع السلطات الثلاث وتركيزها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة ( الجهاز التنفيذي ) يؤدي حتما إلى فساد السلطة .
- امتلاك آليات وأدوات القمع والعنف المتمثلة في الأجهزة الأيديولوجية للدولة .
- تقويض دور المؤسسات والقوى الاٍجتماعية بما في ذلك مؤسسات الدولة ( اٍختراق المجتمع المدني ).
ثالثا: أسباب تجذر التسلطية السياسية في المشرق العربي
تضرب ظاهرة التسلط والاٍنفراد بالحكم بجذورها في التاريخ العربي والإسلامي، ويمكن القول أنها ترجع إلى الانحراف التاريخي السياسي، لما فضل المسلمون خيار” من يحكم؟ ” على خيار ” شكل الحكم ” . وقد تأصل هذا الخيار في الواقع السياسي العربي وأصبح يشكل بؤس السياسة في واقعنا الراهن وذلك لتوافر مجموعة من الأسباب سنوردها على الشكل الأتي بشكل مقتضب [29]:
- أولا، مدخل الطاعة ( طاعة الحاكم) الذي يحجب الطابع السياسي المعارض الذي ميز المجتمعات العربية في الصراع مع السلطة، فالمعارضة السياسية في الإسلام كانت متأصلة ولو بمسوغ ديني.
- ثانيا، بالإضافة إلى الحديث عن ” طاعة الحاكم ” تفاديا للفتنة، فهذا البراد يغم لا يكفي لشرح الإذعان للسلطة مهما كان مصدر شرعيتها. فالحقيقة كما بينا سابقا أن سبب هذا الإذعان يكمن في القمع والقهر الاٍجتماعي الممارس على المجتمع.
- ثالثا، انزراع الدولة التسلطية واستمرارها بعنفها الرسمي وسياساتها الهادفة إلى تحجيم وقهر كل جمعيات المجتمع السياسية والمدنية ( تنظيمات سياسية ، نقابات، اتحادات…) بجعلها تسير في فلك النظام القائم وفرض الخطاب السياسي الرسمي عبر المؤسسات التربوية والتعليمية وأجهزة الإعلام ، كل هذا أدى إلى تحييد القوى الاٍجتماعية وتشديد قبضة الدولة على المجتمع مما أجهض المبادرات المستقلة.
- رابعا، تداعيات التحولات الاٍجتماعية والسياسية التي عرفها العالم العربي باٍندلاع ثورات الربيع الديمقراطي ، تجعل الحديث عن طاعة الحاكم غير واقعي . وبالتالي بدأ الشباب العربي يتغلب على الخوف والقهر وبدأ يتمرد على الوضع القائم .
- خامسا، وجود الدولة التسلطية في الواقع السياسي العربي يرجع إلى عدم التمكن من تحييد تدخل الدولة في الاٍقتصاد والمجتمع . فكما يقول خلدون حسن النقيب ” … ففي المشرق العربي فشلت الأقطار العربية في تقييد تدخل الدولة في الاٍقتصاد والمجتمع،مما أدى بالتالي إلى فشل التجربة الليبرالية البرلمانية فشلا ذريعا”[30].
هذه أسباب من بين أسباب عديدة تفسر سبب تجذر التسلطية في الواقع السياسي العربي ، مما يجعل من سؤال القطيعة مع الإرث التسلطي مسألة ضرورية وملحة في وقتنا الراهن ، خصوصا مع ثورات الربيع الديمقراطي ، هذه الأخيرة التي لاتزال تتطلب الوقت لتفعيل شعاراتها ومبادئها . هذا الأمر يعطي لنا مشروعية التساؤل عن مدى إمكانيتها ترسيخ والولوج إلى عالم الدولة الديمقراطية ودولة القانون، لأن عدم اليقظة السياسية قد يقود إلى مجرد انتقال من نموذج تسلطي إلى نموذج أخر. لهذا لا بد من الإشارة إلى أن الديمقراطية ليست وليدة قرارات ومراسيم سياسية، بل هي ثقافة وسلوك مدني وسياسي.
المبحث الثاني: الدولة في المشرق العربي وإشكالية استمرارية نمط السلطة التقليدية
لقد حركت ظاهرة التسلطية التي ميزت الأنظمة العربية ذهنية العديد من المفكرين الغربيين والمسلمين ، فقد حاولوا إنتاج مجموعة من النظريات والأطروحات التي من شأنها تفسير وتحليل تسلطية هذه الأنظمة واستعصائها على ولوج عالم الدولة الديمقراطية . وهكذا، نجد بعض هذه النظريات قاربت إشكالية الدولة التسلطية في المشرق العربي من منطلق التأكيد على أن هذه الدول لا تزال تمارس السلطة بمعناها التقليدي الاستبدادي، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تكريس مبادئ الديمقراطية. كما نجد البعض الأخر، حاولت تفسير هذه الظاهرة من خلال تسليط الضوء على العوامل الخارجية ودورها في القصور الديمقراطي الذي تعيشه الأنظمة العربية في المشرق العربي.
لكن ، كل هذه الأطروحات ، واٍن اٍختلفت في منطلقاتها ومرجعياتها ، فهي تتفق على نقطة أساسية مفادها أن الأنظمة العربية في المشرق العربي لا تزال تعيش استبدادا سياسيا ، يدور بين طرفين الأول يحكم ، والثاني محكوم ، الأول يملك زمام السلطة بما تمتلك من أدوات للقهر والعنف ، والثاني يخضع لمن يمتلك ويسيطر على السلطة فيكون محتكرا ومتأثرا بوخز أجهزة السلطة دون أن يكون في إمكانه مقاومتها . هذا الوضع يجعل البلدان العربية تعيش مفارقة بين أنظمة سياسية تسعى إلى الحفاظ على هذا الوضع اللاديمقراطي ، وبين شعوب تواقة إلى الديمقراطية والقطيعة مع الإرث التسلطي .
أولا: الأطروحات النظرية المفسرة للنمط التقليدي للسلطة
مهما تعددت التفسيرات لإشكالية التسلطية التي لازمت الأنظمة العربية في بلدان المشرق العربي ، فإننا نستطيع القول أن هذه الأطروحات تنتصر لفكرة مفادها أن الاستبداد السياسي الذي تعاني منه هذه البلدان يجد سنده في البنية و الخصوصية التفافية للمجتمع العربي السلطوي ، هذه البنية التي تلعب دورا أساسيا في تكوين شخصيات بدهنيات تقبل الخضوع له . ومن أبرز هذه الأطروحات التي تدافع عن هذه الفكرة نورد أطروحة “الاستبداد الشرقي”، أطروحة “النظام الأبوي”، وأطروحة “الشيخ والمريد”و أطروحة ”نظريات بطانة الحاكم ”.
- أطروحة “الاستبداد الشرقي”
تنتصر هذه الأطروحة لفكرة أساسها أن الحكم الاٍستبدادي هو نظام الحكم الطبيعي للشرق ، نظرا لأن تنشئة الإنسان الشرقي الاٍجتماعية والنفسية وتكوينه الفطري ، تجعل منه شخصية قابلة للخضوع وسهل الاٍنقياد للطاعة ، ولذلك تعد العبودية صفة محايثة له ولا تنفصل عنه.
وتعد هذه النظرية هي الأقدم تاريخيا في تفسير الحكم الاستبدادي في الشرق. ويعتبر أرسطو ( 348ق م – 321 ق م ) أول المنظرين لها.فأرسطو يرى أن العلاقة الاستبدادية هي في جوهرها بين إنسان حر وبين إنسان آخر قد حرمته الطبيعة هذه الحرية. والطبيعة في السياق اليوناني هي حالة الضرورة الاجتماعية التي تقتضي نمطا من العلاقات الهرمية تتوزع فيها الوظائف والأدوار تناسبا مع نظام الحاجات والملكات الذهنية للأفراد قياسا على منوال التراتبية الكونية[31].
في هذا السياق ، يعرف الطغيان بأنه حكومة الفرد الظالم الذي غايته المصلحة الشخصية وليس مصلحة المواطنين [32]، ومن هنا ، عمل أرسطو على وضع تقابل بين الطغيان والاٍستبداد ، حيث يرى أن كلا النظامين يعاملان المواطنين على أنهم عبيد ، وفي المقابل وضع محددات للحاكم ، فهو يعني رب الأسرة والسيد على عبيده . وكذلك ملك البرابرة الذي يحكم شعبه على أساس أنهم عبيد . ويعيد أرسطو التصنيف الأخير إلى الحكم الأسيوي ذلك أن المواطنين يخضعون للحاكم بإرادتهم ” لأنهم عبيد بالطبيعة “، لذلك فاٍن الاٍستبداد عادي عند الأسيويين في حين أن الاٍستبداد يمثل حالة شاذة عند الإغريق [33].
وهكذا، فمن خلال كتابه ” السياسة ” ركز على أن الاٍستبداد كامن في الشرق. وهذا ما يفهم من قوله : ” إن البرابرة أكثر خنوعا بطبيعتهم من الإغريق والأسيويين أكثر خنوعا من الأوربيين ، ومن هنا فإنهم يحتملون الحكم الاٍستبدادي دونما اٍحتجاج “[34]. وعليه ، فقد نسب أرسطو الاٍستبداد بشكل محدد إلى أسيا في كتابه ” السياسة ” الذي يعد الأصل والمنشأ للفلسفة السياسية في أوربا.
لقد عرفت نظرية الاستبداد الشرقي تطورات في الفكر الغربي مع رواد عصر النهضة وأبرزهم مونتسكيو في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حيث ذهب في كتابه ” روح القوانين ” إلى التأكيد أن الاٍستبداد هو نظام طبيعي بالنسبة للشرق في حين أن الشكلين الآخرين ( الحكم الجمهوري والملكي) هما من صفات الحكم في الغرب وأن الحكم الاٍستبدادي غريب عن الغرب [35]. لذلك يرفض مونتسكيو هذا النمط من الحكم وينزع عنه الشرعية ، لأن الحاكم يمسك بزمام السلطة ويحكم بحسب رغباته دون التقيد بقوانين تضبط أعماله . وهنا ، يركز الحاكم كما يرى أرسطو على مبدأ أساسي هو الخوف كوقود لاٍستمراره .
وعلى هذا الأساس ، فاٍن أرسطو للدفاع عن أطروحته هذه أتى بمجموعة من الأفكار شكلت الهيكل الاٍستدلالي لأطروحته ، وعليه ، فقد علق على الاٍستبداد الشرقي كحالة مميزة عن الاٍستبداد بشكل عام حيث يرى انه مرهون بالقوانين الدينية ، ويعود ذلك إلى أن هذا الدين يستعمل لمساندة الحكم الاٍستبدادي وتوطيده ، كما أن الاٍستبداد وحسب وجهة نظره لا يكن الاٍحترام للحريات الفردية والملكية الخاصة ، فالاٍستبداد الشرقي يمثل : ” حكم الجهل جهل المستبد ذاته وجهل رعيته ، من هنا الغياب التام لكل فضيلة “[36] ، كما أنه يرى أن ” أمراء الشرق قد انغمسوا انغماسا شديدا على الدوام في الميوعة والشهوة ” [37].
هذا إضافة إلى أسباب أخرى يوردها مونتسكيو ، تفسر الاٍستبداد الشرقي ، ومنها العادات ، الآداب ، تقاليد الحكم وأحكامه ، الدين ، والمناخ ، ففيما يخص المناخ مثلا يرى أن الطبيعة الفيزيائية والجغرافية تجعل الشعوب الآسيوية الشرقية متعايشة مع الحكم لاستبدادي، دونما اعتراض أو مقاومة. بمعنى أن هذه الطبيعة الفيزيائية والجغرافية قد أكسبت هذه الشعوب على حد قوله طبيعة ثابتة جعلتها منقادة طواعية للحكومات الاستبدادية. وبالتالي فاٍن هذه الطبيعة تؤثر مباشرة في مزاج الفرد وتطبع في حاجاته وميوله الخاصة . وأن الناس المصنوعين على هذا النحو والمشروطين هم الذين يكونون مؤهلين لمثل هذه القوانين وهذه الحكومات المستبدة.
وخلاصة القول ، يبدوا لنا أن مونتسكيو ، بالرغم من انه يهاجم الاٍستبداد ويدينه ، لأنه يهدد الحرية السياسية والحقوق الفردية ، فاٍنه لازال أسيرا للنظرة المركزية الغربية في تفسيره للاٍستبداد ، والتي تنظر إلى الأخر كغريب ليس من منطلق ” نظرة الباحث الموضوعي ” وإنما من منطلق ” نظرة الباحث الإيديولوجي ” . وبهذا ، نكون أمام إعادة إنتاج وإحياء للأرسطية أكثر مما هو تجاوز لها.
على هذا الأساس، عمل كارل ماركس على تفسير الاٍستبداد والنظر إليه من جهة أنه متجسد في الشرق على غرار أرسطو ومونتسكيو ، ولكن بتفسير محدد حول الاٍستبداد الشرقي حيث ربط ذلك ب “نمط الإنتاج الأسيوي “. وعليه فاٍن الطابع الراكد للمجتمع الأسيوي – حسب ماركس ورفيقه انجلز – رغم كافة التحركات اللاهادفة على السطح السياسي يمكن تفسيره بالنظر إلى النظام الاصطناعي للري الذي كان منتشرا في الشرق، فبفعل الظروف المناخية والتضاريسية التي ميزت الأراضي الشرقية “أدت إلى قيام نظام اصطناعي للري بواسطة القنوات وشبكات إيصال الماء ليشكل الأساس للزراعة الشرقية…” الشيء الذي استلزم تدخل السلطة المركزية للدولة في الشرق حيث كانت الحضارة متدنية جدا، والرقعة الأرضية واسعة بحيث لم يكن بالإمكان الاعتماد على وجود تعاون طوعي، فظهرت المسؤولية المركزية للدولة فيما يخص تجهيز الأشغال العامة[38]. ومن ذلك الدور المركزي في مجال الري استمدت الدولة في الشرق النمط الاستبدادي في ممارسة السلطة. وقد ميز ماركس الدولة في الشرق بسمتين أساسيتين وهما سيطرة الدولة على الإنتاج وغياب الملكية الخاصة للأراضي وهاتين السمتين مرتبطتين “افتراضا بالدور الاستراتيجي للحكومة المركزية في إدارة شبكة الري بواسطة منظومة متكاملة من الأشغال الهامة”[39].
وأخيرا يمكن القول، أن رغم اٍختلاف هذه الأطروحات في منطلقاتها ومرجعياتها في تفسير ظاهرة التسلطية التي لازمت الأنظمة العربية في المشرق العربي ، فهي تبدي قصورا واضحا في فهمهما لهذه المجتمعات ، هذا القصور يتضح من خلال تشبثها بأحكام قيمة ومسبقة ، تتمثل في وضع الجنس الأوربي كأرقى أجناس البشرية ، وجعل أوربا بمقياس الكوجيطو الديكارتي ” أوربا تفكر ، إذن أوربا موجودة ” . لذلك فهي تنهل رؤيتها هذه من التقاليد اليونانية التي تعتبر نفسها مركز العالم والحضارة وكل ما هو خارج ” أثينا ” ” فهو غريب وبربر “، وتقدم نفسها كأصل للإنسانية جمعاء ، بينما الواقع يفنذ إلى حد كبير هذه النظرة المركزية .
- أطروحة “النظام الأبوي”
هناك العديد من المفكرين الذين اهتموا بتفسير ظاهرة التسلطية ، من منطلق ” الأطروحة الأبوية ” ، ونستحضر منهم في الفكر الغربي موقف فريدريك هيجل ، ومن الفكر العربي والإسلامي أطروحة المفكر الفلسطيني هشام شرابي.
ينطلق ” هيجل ” في تفسيره لظاهرة التسلطية من كون الحكم الاٍستبدادي هو نظام الحكم الطبيعي للشرق ، لان العالم الشرقي كما يسميه ، هو عبارة عن مجتمعات طبيعية يحكمها نظام أبوي بطرياركي. وبما أن النظام الشرقي أبوي حسب وجهة نظره ، فاٍنه يرى أن الحكم السائد يقوم على مبدأ شخص واحد حر هو الحاكم ، وهذا هو الحاكم الاٍستبدادي ، فهذا الحاكم يمارس حكمه على أساس أو بطريقة الأب مع أبنائه وأن له حقوقا ولا يجوز معارضته لأنه أب الجميع ، وواجب طاعته أمر حتمي ، والأب هنا هو المشرع ، وهذا هو مبدأ الحكومة الأبوية البطرياركية[40]، في المقابل يظل دور الشعب هو تنفيذ الأوامر واٍحترام سلطات الحاكم .
ومن منطلقات مخالفة ، حاول المفكر الفلسطيني هشام شرابي من خلال أطروحته حول النظام الأبوي تفسير القصور الديمقراطي في البلدان العربية ،ولهذا ، يرى أن الأبوية كانت وما تزال صفة الثقافة العربية منذ ما قبل الإسلام الذي فشل في تجاوزها بصورة فعلية . حيث يؤكد “أن طرح الديمقراطية في الواقع العربي يعني أننا نطرحها ليس فقط في واقع متخلف اقتصاديا وإنمائيا، وإنما هو تخلف من نوع آخر إنه التخلف الكامن في أعماق الحضارة الأبوية، في المجتمع العربي”[41] ، الذي ميزته صفتين مترابطتين اللاعقلانية والعجز “اللاعقلانية في التدبير والممارسة والعجز عن التوصل إلى الأهداف التي ترنو إليها. اللاعقلانية في التحليل والتنظيم والعجز عن الوقوف في وجه التحديات والتغلب عليها”[42]
وقد اٍعتمد هشام شرابي في وحدة تحليله على ” مؤسسة العائلة الممتدة “، عبر النظر إلى علاقة الخضوع والولاء التي تكون اتجاه أب الأسرة الذي يشكل أداة القمع الأساسية[43]. فهو من يمتلك الحقيقة ، فالفرد الذي يعيش ضمن هذه الأسرة ينشأ متشبعا بمجموعة من المدركات والقيم تدخل ضمن تركيبته النفسية، فمن خلال التنشئة الاجتماعية التي تكون أساسها العائلة الأبوية يستمد الإنسان العربي نفسيته الخاضعة والقابلة بالحاكم المستبد، وبالتالي فإن، عملية التنشئة الاجتماعية لا تؤثر فقط في “تربية الفرد بل أكيد أنها أيضا تؤثر على تشكل وعيه وتصوغ فهمه لنفسه وللآخرين”[44] لذلك ، فإن نظام الولاء الذي تقوم عليه الأبوية “يشل فعالية أية بنية يهيمن عليها، وذلك لأن هذا النظام في وضعه الامتثال قبل الأصالة والطاعة قبل الاستقلال الذاتي يقضي على موهبة الإبداع وينمي فقط تلك القوى التي تساعد على الإبقاء عليه. وتصبح مصالحه ومتطلباته الخاصة، وليس ما يتعلق منها بالمؤسسة أو المجتمع اللذين ينشأ فيهما ، هي المقاييس النهائية للتقييم والعمل…”[45] في كل مؤسسات المجتمع والدولة.
على هذا الأساس، فإننا أحوج ما نكون إلى كشف زيف الثقافة الأبوية السلطوية وإبراز الجوانب السلبية في بنية الشخصية السلطوية التي تفرزها ، وهي مهمة تقع على المثقفين الواعين الذين يؤرقهم هاجس تغيير مجتمعنا العربي والإسلامي إلى مجتمع تسوده قيم العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان[46].
نظرا لأن هذه الثقافة الأبوية هي العائق الأكبر الذي يواجه الصرح الديمقراطي في الواقع العربي كنظام ونسق للحياة والتعامل والعلاقات، تكمن في هذه الذهنية التي تنزع إلى السلطوية الشاملة ورفض النقد وعدم تقبل الحوار، فهذه الذهنية تدعي امتلاك الحقيقة التي لا تعرف المراجعة، أو التفاعل بين الأفراد والجماعات، والتفاعل وإن وجد فإن هدفه لا يكون التوصل إلى الحلول الوسط بين وجهات النظر ولكن هدفه إظهار وتأكيد الحقيقة الواحدة[47]. هذه العقلية هي التي تهيمن على النظام الأبوي.
وحسب هشام شرابي، فإن النظام الأبوي في المجتمع العربي على مدى المائة عام الأخيرة لم يعمل على تحديث هذه الثقافة الأبوية. بل ترسخت وتعززت بأشكال التحديث المزيف. فهذا المجتمع الأبوي السلطوي ، نتيجة خبرته الطويلة في القمع ، اكتسب قدرة كبيرة على تغليف أهدافه ومراميه بمظاهر التحديث ، بحيث لا يتورع عن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي لا يتخلى في الواقع عن نزعته الاٍستبدادية وعن انتهاكاته لكرامة الإنسان وحقوقه [48].
ومن مظاهر ذلك ، طبيعة لنظام القائم في المجتمع العربي فهو ليس نظاما تقليديا بالمعنى التراثي، كما أنه ليس معاصرا بالمعنى الحداثي. بل هو خليط غير متمازج من القديم والحديث وعلى الرغم من أن المجتمع العربي تعرض لتغيير كبير من جراء اصطدامه بالحضارة الغربية الحديثة، إلا أن هذا التغيير لم يؤدي إلى استبدال النظام القديم بنظام جديد بل فقط إلى تحديث القديم دون تغييره جذريا”[49] مما أثمر في نهاية المطاف النظام الأبوي المستحدث وحضارته التي نعيش في ظلها والتي تتضمن خليطا من العناصر التراثية والحديثة معا.
من هذا المنطلق ، يؤكد شرابي أن ثقافة هذا النظام الأبوي ، تنتشر في المجتمع العربي بسبب الأسرة التي تلعب دورا رئيسيا في تكوين الشخصية الاٍستبدادية للإنسان العربي لكي ينشأ الطفل نشأة تجعله قابلا للتكيف بسرعة مع المجتمع الأبوي السلطوي .
3 – أطروحة “الشيخ والمريد”
ينطلق الأنثروبولوجي المغربي “عبد الله حمودي” في كتابه “الشيخ والمريد” من منطلقات معرفية مخالفة لما رأيناه عند سابقيه ، حيث ينطلق من وحدة تحليل هي مؤسسة ” الزاوية””، ليقدم دراسة مهمة حول النظام السياسي المغربي في محاولة منه لتفسير ظاهرة السلطة في المجتمع المغربي. وبالفعل قدم أطروحة تفسيرية بناءا على ثنائية “الشيخ والمريد”. كمدخل لتفسير النسق السياسي المغربي من خلال دراسة نمط العلاقات داخل مؤسسة الزاوية وتطبيق الخطاطة الفكرية الموجودة في الفكر الصوفي على الحقل السياسي المغربي، ليستنتج العلاقات القائمة بين الرئيس والمرؤوس في الحياة العامة تحكمها المحسوبية والزبونية.
في هذا السياق ، حاول عبد الله حمودي الإشارة إلى أن جل الفرضيات التي حاولت تفسير استمرارية النظام السياسي المغربي “فإنها ترجح كلها البنية الاجتماعية أو الاقتصادية في رصد حيوية هذا النظام السياسي، دون أن تنشغل بما يقود الأفراد والجماعات إلى قبول أو رفض نوع من الحكم والمبادئ التي ينبني عليها”[50]، هذا الأمر جعل عبد الله حمودي في أطروحته ينطلق من البنية الثقافية للمجتمع المغربي لإيجاد الآلية المفسرة لظاهرة السلطة في المغرب. فأكد أن النظام السياسي المغربي تتجذر فيه السلطوية من خلال العلاقات الشخصية التي تخضع لثلاثة براديغمات هي الهيبة/الخدمة/التقرب، ثم من نظام الأعيان.
وهكذا ، حاول عبد الله حمودي أن يقدم تفسيرا للخضوع الذي تتميز به الحياة السياسية ،الاجتماعية والتربوية في النظام المغربي من خلال ثنائية “الشيخ والمريد” ، والتي تعبر عن العلاقات داخل مؤسسة الزاوية، حيث تبدأ مرحلة الزهد في البداية بالتخلي عن كل مظاهر الحياة المادية، حتى يصبح المريد زاهدا ثم وليا. ولحصول ذلك لابد بالمرور بمرحلة المجاهدة النفسية والتربوية، وتنقسم مرحلة التربية بواسطة الشيخ إلى مرحلتين اثنتين : الأولى ، مرحلة التأهيل التي خلالها يقطع الصلة بالوالدين، ويترجم ذلك عمليا بالتخلي عن كل القيم الدنيوية، بينما المرحلة الثانية ، هي مرحلة التلقين خلالها يتم تخريب كل قوى النفس والشهوات والغرائز، فيسهل بذلك التحكم بالذات. وعبرها يرث المريد إرث شيخه من جهة ولايته، ومن جهة أخرى يعيد إنتاج نمط حياة الشيخ وسلوكه إزاء نفسه والآخرين. وبالتالي يكون المرور من مرحلة التأهيل إلى مرحلة التلقين بمثابة محطة أساسية في أدبيات الزوايا. فعبر هذا المرور يسلم المريد إرادته لشيخه لكي يرث سره، ليبدأ في إعادة تكرار نموذج هذا الشيخ وهكذا تعمل ثنائية الشيخ والمريد على تكريس السلطة والحفاظ على نسقها عبر عملية إعادة نفس الدور[51].
اٍنطلاقا من الخطاطة الثقافية التي استنبطها عبد الله حمودي من العلاقات داخل الزاوية استنتج آلية تفسيرية للنسق السياسي المغربي، ولظاهرة السلطوية وكيف تتم إعادة إنتاجها. وينطبق هذا التفسير على باقي البلدان العربية وليس فقط المغرب حيث يقول عبد الله حمودي ” يمكن أن نفهم المقاربات التي أقمناها في الفصول السابقة على مجموع المجتمعات العربية، ذلك أنه رغم التقلبات التاريخية والانقسامات تحافظ هذه المجتمعات على روابط ثقافية وبشرية قوية جدا بينها. وهذه الروابط تبينها الأصداء العميقة التي يحدثها كل تغيير يمس مجتمعا من هذه المجتمعات في باقي المجتمعات الأخرى” وعلى الرغم من الاختلافات التي تبدو شكليا تميز بين أنظمة الحكم العربية ” لا يمكن أن تخفي تشابها جوهريا يخص التعامل مع ممارسة الحكم: وسواء كانت الأنظمة ملكية أو جمهورية تدعي مشروعية مستندة إلى تمثيل مباشر بما يصطلح عليه بالجماهير وتتجاهل كل بديل أو تقمعه أو تقبل جزئيات منه، وتتميز البنية السلطوية بالإنفراد بالقرار في شأن طموحات ومصائر المجتمعات المحكومة”[52]
4 – أطروحة بطانة الحاكم وحاشيته
إن الحديث عن اٍستبداد الحاكم وتأصيله ، لن يتأتى دون الحديث عن بطانة الحاكم أو حاشيته ، ذلك أن الحاكم المستبد يحرص باٍستمرار على إيجاد حاشية تساند حكمه ، وهي لا تمثل اٍتجاها واحدا ، فقد تكون من المقربين ، وأبناء القبيلة ، والحراس الذين يمسكون بزمام المؤسسات الموجودة ، بالضرورة ، لخدمة الحاكم المستبد ، والمروجين له حيث تمتد أذرع البطانة القريبة من الحاكم إلى مفاصل الدولة كافة [53].ولهذا ، فالبطانة جزء لا يتجزأ من ضمانة اٍستمرارية الحكم المستبد ومقوماته . وقد يكون بين البطانة سياسيون، عسكريون، مثقفين، كتاب، فلاسفة، رجال الدين، وموظفون كبار، بالإضافة إلى أقرباء الحاكم وأصدقائه.
على ضوء ما سبق، يمكن القول أن الأنظمة العربية في المشرق العربي، تهتم بهذه البطانة كأساس لقوة حكمها وتعتمد عليها في تحقيق مأربها. وبهذا ، ترتبط البطانة بالحاكم المستبد اٍرتباطا عضويا ذلك أنه لن يتحقق التسلط إلا بوجود البطانة القادرة على فرض هذه العبودية التي تكرس الحكم الاٍستبدادي وتضمن استمراريته .
وأخيرا ، فالحاكم المستبد في ظل الدولة التسلطية يقيم دعائمها على ثلاثة جوانب أساسية : الحاكم ، والبطانة ، والمحكومين . والحالة هنا تمثل التجريد المتمفصل بين الأطراف الثلاثة حيث قمة الهرم فيها الحاكم ، وفي الأسفل المحكومون ، وفي الوسط هناك البطانة المنفذة لأوامر الحاكم . ودور البطانة متابعة الطاعة وتكريسها ، واستسلام المحكومين أمام طاغوت الذات التسلطية [54].
ثانيا: التحول الديمقراطي في المشرق العربي : العوائق والإمكانات
بذل مفكرون عديدون ، من العرب وغيرهم ،- كما رأينا سابقا – ، جهودا التمسوا بها الوقوف على إشكالية التسلطية كظاهرة ملازمة للأنظمة العربية في المشرق العربي ، ومن خلالها أنتجوا نظريات وأطروحات حاولوا أن يجدوا لهذه الإشكالية تفسيرات تكسبها حدا أدنى من المعقولية في تبريراتها لعدم اٍستجابة هذه البلدان لعملية الديمقراطية . فاليوم هناك حاجة ملحة لفهم البنى المادية والإيديولوجية التي تلعب دورا أساسيا في إعاقة مسار الديمقراطية في المنطقة العربية [55]، ومن اطلاعنا على مجموعة من أهم الدراسات والأبحاث التي نظرت إلى مسألة الديمقراطية في العالم العربي ( وخصوصا المشرق العربي ) أمكننا استقصاء عينة كافية من التفسيرات أولا ، التي تبين عوائق التحول الديمقراطي في العالم العربي ، وثانيا ، الإمكانات المتاحة لهذا التحول الديمقراطي .
- عوائق التحول الديمقراطي في العالم العربي (بلدان المشرق العربي خصوصا )
تعددت عوائق ترسيخ الديمقراطية في العالم العربي، بتعدد المقاربات النظرية التي اٍهتمت بمسألة الديمقراطية، فمنها من ركزت على العوامل الخارجية في تفسير استمرار النمط التسلطي في أنظمة الحكم العربية. فالدولة في المشرق العربي بعد حصولها على الاستقلال السياسي، بقيت القوى الدولية تتدخل في شؤونها من أجل خدمة مصالحها. وبعض هذه المقاربات ركزت على شكل الدولة الربيعية الذي يميز اقتصاديات بلدان المشرق العربي ، هذا إضافة إلى مقاربات ركزت على الصراع العربي-الإسرائيلي الذي ما فتئت أنظمة الحكم في المشرق العربي تستعمله كذريعة من أجل استمرارها في تسيد الدولة وهيمنتها . وبالتالي فإن التفاعل بين التدخلات الخارجية المرتبطة بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الدولية، وبين الاقتصاد الريعي، والصراع العربي-الإسرائيلي قد جعل المشرق العربي بشكل عام أقل استجابة لعملية الدمقرطة[56].
- الاٍختراق الخارجي لبلدان المشرق العربي
ربما لا جدال في أن الدولة في العالم العربي – وخصوصا في المشرق العربي – (من حيث هي دولة حديثة في نظمها ومؤسساتها ، أي من حيث هي تتوافق ، على سبيل المثال ، مع المقومات والشروط التي يحددها ماكس فيبر ) لا تزال في طور البناء والتكوين ، ثم إن عملية البناء تجابهها صعوبات هائلة . في مقدمة تلك الصعوبات ، وأهمها ، أن عملية البناء ( أو إرادته على الأقل ) قد جاءت مساوقة لحدث الاختراق الاستعماري ، ثم إن الاستعمار كان سببا مباشرا في تسريع عملية البناء ، بناء الدولة الحديثة[57] .لذلك، فحدث الاٍستعمار أحدث شرخا في نظام الدولة العربية وبنياتها الأساسية السياسية ، الاقتصادية ، والاجتماعية ، كما أنه أحدث خلخلة في نظام المجتمع ومؤسساته الاجتماعية .
وبالنظر إلى منطقة المشرق العربي، موضوع دراستنا، إبان تعرضها للتدخل الخارجي، يتضح لنا أنها تميزت بعدم قدرة العرب لا خلال مرحلة الاستعمار ولا مرحلة الاستقلال في رد طوق العوامل الخارجية المهيمنة عليهم، والمسببة لغياب التماسك الداخلي. فقد حلت هيمنة أمريكية-إسرائيلية بديلا عن الهيمنة الفرنسية الإنجليزية[58]. ويرجع الأمر حسب جورج قرم إلى ما يصطلح عليه “فراغ القوة” فبسبب هذا الفراغ كانت المنطقة دائمة الاختراق من طرف القوى الدولية، التي تسعى إلى تحقيق مصالحها ويتأتى لها ذلك من خلال دعم الأنظمة التسلطية.
وبالفعل ما سعت إليه تلك القوى ولازالت تسعى إليه هو دعم الأنظمة التسلطية في المشرق العربي لتظل متحكمة في زمام السلطة بكل الطرق والأشكال الممكنة.لأن في “تحقيق أهداف العرب العليا… تهديدا لمصالح دول المركز الامبريالي الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، مما يدفعها إلى مقاومتها في السر والعلن”[59] ولهذا،فإن الأنظمة السياسية في المشرق العربي أنظمة مخترقة. وقد قدم خلدون حسن النقيب في كتابه ” الدولة التسلطية في المشرق العربي” مجموعة من الخصائص التي تعكس الأعراض المرضية التي تصيب أي نظام سياسي يتعرض للاختراق الامبريالي. فهي تتميز بأن القوى الامبريالية الخارجية لا تقوم بإلحاقه بنظامها السياسي بالكامل ولكنها لا تتركه يفلت من قبضتها الخانقة أبدا، وفيها يعيش النظام السياسي المخترق في مجابهة مستمرة متصلة مع القوة أو القوى الامبريالية المهيمنة، كما تختلط القضايا السياسية المحلية والقومية والإقليمية والدولية بعضها ببعض بحيث لا يفهم النظام السياسي للمجتمع المخترق دون الرجوع إلى القوة أو القوى الامبريالية الخارجية المهيمنة، وفيها كذلك يكون النظام السياسي المخترق عبارة عن لعبة سياسية تلعبها القوى المحلية والإقليمية والدولية في تفاعلات متبدلة متغيرة.
من هذا المنطلق ، يمكن القول أن أنظمة الحكم في المشرق العربي لاتعبر عن تطلعات ومصالح أفراد المجتمع التي سيكون من ضمنها تحقيق الاستقلالية على مستوى اتخاذ القرارات داخليا وخارجيا بمعنى الانفلات من التبعية لهذه القوى المهيمنة وامتلاك الحرية الكاملة والتصرف وفق المصالح الوطنية، بل هذه الأنظمة تسعى للحفاظ على مصالحها بمباركة وترحيب من طرف القوى المهيمنة على النظام الدولي ، هذه الأخيرة التي هيئت لنفسها مجموعة من النخب المتغربة المرتبطة بمصالحها في هذه الدول المهيمنة عليها .
وهكذا ، أدى الاٍختراق الأجنبي للنظم السياسية العربية إلى التأثير سلبا في أداء المنظومة الجامعة والى عملية تقويض المقومات الضامة للنسيج المجتمعي ، كما أدى إلى القضاء على إمكان توليد آليات مناسبة لمعالجة النزاعات العربية المتبادلة ، أي إلى شل القدرة العربية على منع الصراعات الداخلية وردع مصادر التهديد[60]، كيفما كانت طبيعتها .
1-2 : شكل الدولة الريعية في المشرق العربي
تعد ظاهرة الدولة الريعية من بين أهم العوامل التي تفسر إشكالية التسلطية الملازمة للأنظمة العربية ، فلهذا الشكل من الدولة الذي ميز دول المشرق العربي دور رئيسي في صعوبة الاٍنتقال إلى طور بناء الدولة الديمقراطية . فالدولة الريعية هي التي تعتاش على عائدات من الخارج، إما من بيع مادة خام أو خدمات إستراتيجية، أو ضرائب تجبى على تحويلات من الخارج من نوع عائدات قوى عاملة في الخارج، وذلك من دون عمالة كبيرة موظفة في الاقتصاد المحلي في إنتاج هذه العائدات[61]. وظهرهذا الشكل من الدولة بحدة مع ظهور النفط في المشرق العربي ،حيث اعتبر العامل الأساسي في تعزيز نمط الاقتصاد ألريعي “ولم يكن استمرار الريوع التقليدية، ولا تدفق ريوع جديدة كالنفط أو الغاز، حافزا للدخول في التنافس الصناعي من أجل تأمين المستوى اللائق من النشاط الاقتصادي، وذلك على غرار ما حصل في كثير من بلدان آسيا التي لا تملك موارد طبيعية. وقد أضيفت إلى هذه الريوع حصيلة المساعدات الخارجية المتأتية من التطور الجيوسياسي والإقليمي”[62]
ويشكل الدخل الريعي مورد أساسي من موارد الدولة، هي من تتحكم وتشرف على إعادة توزيعه والحقيقة أن المجتمعات التي تقوم على الحياة الاقتصادية فيها على ريوع تسيطر عليها الدولة يصبح الميل فيها إلى احتكار السلطة من قبل فئة اجتماعية معينة سمة رئيسية في الحياة السياسية[63]. فالدولة الريعية تحصل على دخل كبير من الخارج وبالتالي تتمكن من إيرادا ت مهمة تجعلها في غنى عن فرض الضرائب من أجل سد نفقاتها العمومية. وبذلك فهي تقايض وتشتري السلم الاٍجتماعي عن طريق تجنب مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي يمكن أن تهدد سيطرتها على السلطة، ولهذا تجد الدولة الريعية نفسها قد تقوت بسبب سياستها الخاصة في التوزيع والتخصيص.وعليه ، فالدولة السعودية على سبيل المثال حملت مأزمها خلال عملية ” الانتقال من البداوة إلى العصرنة ” ولاسيما بعد اكتشاف النفط ، فتشكل نظام ريعي هو مزيج من تركيبة ثيوقراطية وأوتوقراطية، لامؤسسات تشريعية فيها ولا دستور..، وفي ظل تشكل الدولة الريعية ، اعتمد الناس في قوتهم ومعاشهم على ما توجد به أريحية الحاكم [64].
هذا الوضع لا يعني أن هذه الدول تحقق تنمية اقتصادية حقيقية ، بل هي بعيدة عن هذا المطلب ، فلا تحقق التنمية الاقتصادية ، ولا تضمن الحريات السياسية ، لأن غالبية مؤشرات التبعية تلتصق بها،فتسويق البترول لا زال يفلت من بين أيدي الدول المنتجة لكي يذهب أساسا إلى الشركات الكبيرة، وتقوم البنوك الغربية بإدارة الجزء الأكبر من رؤوس الأموال العربية ويتم إشباع معظم الاحتياجات الغذائية عن طريق الاستيراد، والحصول على آليات التصنيع من مصدر غربي بصورة شبه كاملة[65].
1-3 : الصراع العربي-الإسرائيلي وذريعة الخطر الخارجي
يعد الصراع العربي – الإسرائيلي من أبرز أولويات الإنسان العربي في بلدان المشرق العربي ، لذلك فلا غرابة ان تكون القضية الفلسطينية محور اٍهتمام الأنظمة السياسية في هذه البلدان العربية وخصوصا القريبة جيوسياسيا من إسرائيل . لكن ما يخفيه هذا الاٍهتمام أنه يعبرعن سلوك مزدوج : فالأنظمة العربية بقدر ما تبدي دفاعها عن القضية الفلسطينية وتناضل من أجلها ، بقدر ما تستغل وتوظف هذه القضية في تتبيث الشأن الداخلي لتبرير سلطويتها وهيمنتها الداخلية ، واتجاها نحو تقوية الأجهزة العسكرية والأمنية .
فباٍسم هذا الصراع تسعى هذه الأنظمة الديكتاتورية دوما إلى إضفاء شرعية على حكمها التسلطي وأن تبرر توجهها نحو الإنفاق المتزايد على الجهازين العسكري والأمني، فكل مرحلة كانت لها مبرراتها، من بينها التخويف من الخطر الإسرائيلي على المنطقة. غير أن ما أنفقته الأنظمة العربية من أموال طائلة في مجال التسلح لم يكن الهدف منه مواجهة إسرائيل ، بل إلى جانب ذلك يتم استثماره في الداخل من أجل قمع كل المحاولات أو التحركات التي من شأنها تهديد احتكار النخبة الحاكمة للسلطة.
على هذا الأساس ، تستثمر هذه الدول هذا الصراع خصوصا في أوقات الأزمات – كما هو الحال في الأزمة السورية الراهنة – كإستراتيجية للتلويح الدائم بالخطر الصهيوني وكذريعة لكسب أصوات جماهير المجتمع ، وتوهيمها بأولوية مواجهة وصد الخطر الصهيوني الذي يهدد الأمن القومي “وبخاصة البلدان العربية المحيطة بإسرائيل وبشكل خاص فإن الصرع العربي-الإسرائيلي والتدخلات الخارجية المتصورة للقوى العالمية في المنطقة وفرا ذرائع قوية لظهور نظم استبدادية”[66] ، لذلك في ظل هذا الوضع ، يبقى سؤال التحول الديمقراطي في خانة الانتظار .
- إمكانات التحول الديمقراطي في المشرق العربي :
من الراجح أن مرحلة انفجار أزمات الدولة التسلطية العربية بدأت تأخذ مجراها، فيمكن الافتراض أننا بصدد تجربة جديدة مت التاريخ العربي والإسلامي يجري تدشينها بدءا من العام 2011، بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. لكن لا يجب أن ننسى أيضا أنها مرحلة اختبار للثورات العربية والإسلامية الجديدة ، لقد ابتدأ الاختبار في كل من تونس ومصر ، وليبيا، واليمن .. وألان سورية ، اٍنه اختبار صعب ، ولكنه ضروري ، لأن النجاح فيه يؤسس لمرحلة جديدة من النهضة العربية والإسلامية ، بل لزمن عربي وإسلامي جديد [67].
من هذا المنطلق ، لاغرو أن فيما يحدث اليوم في العالم العربي ما يحمل على نفض حجاب التشاؤم الذي يكبل الأيدي ويمنع من الحركة ، بل ومن الرؤية الواضحة [68]. فنحن أمام أحداث تتسارع في اتجاه إعادة تشكيل المشهد السياسي وأنها تحمل إشعارا بتحول قد يكون فيه للديمقراطية ( أو لمقدماتها ) وجود فعلي وحقيقي وحجتنا في ذلك مجموعة من المؤشرات الواضحة، ويمكن تحديدها على الشكل الأتي:
- الرغبة في الديمقراطية ليست منعدمة، ويتضح ذلك في التوجه نحو التغيير الاٍجتماعي، الذي تساهم فيه فئة الشباب كنسبة أكثر اٍرتفاعا في الوطن العربي.
- الحركية والحيوية التي يشهدها المجتمع المدني اليوم في العالم العربي هي مؤشر قوي على ترسيخ ثقافة الديمقراطية وأيضا مقياس لدرجة الوعي بأهمية تقوية دور المجتمع المدني في المجتمعات العربية إلى جانب المجتمع السياسي.
- بروز مجموعة من المظاهر التي تكون مصاحبة لسيرورة التغيير الاٍجتماعي وهي فك عقدة الخوف والترهيب التي مارستها الأنظمة العربية في المشرق العربي بالتعبير عن الرفض والاعتراض على الظلم والقهر الاٍجتماعي ، وهذا ماعبرت عنه ثورات الربيع الديمقراطي .
- التطور التكنولوجي الهائل وأثره في خلق التواصل الاٍجتماعي بين الشباب في العالم العربي ، فهو يعتبر خطوة أساسية في التحول الديمقراطي لتكسير عقود من الرقابة والحرمان وإقفال النوافذ والمنافذ التي خلقت مواطن عربي مطيع وممتثل ، يرى في كل ما حوله قدر محتوم .
خلاصــــــة:
ربما لا جدال في أن تتبع بناء الدولة التسلطية في المشرق العربي يضعنا أمام مجموعة من الخصوصيات المميزة لصيرورة تكوينها ، فالدولة التسلطية في المشرق العربي لم تتشكل وفق صيرورة تكاملية نابعة من الداخل ، بل هي منتوج لقوى خارجية استعمارية. ومن نتائج هذه الأزمة في صيرورة بناء الدولة ، عدم قدرتها على التعبير عن طموحات وتطلعات المجتمع العربي . مما كرس النموذج السلطوي في أنظمة الحكم العربية الذي ضمن استمرار يته، بسبب مجموعة من العوامل.أولا، تتميز الدولة التسلطية بانعدام الشرعية، فتأمين شرعيتها يتحقق عبر توظيف الأجهزة القمعية للدولة باٍختلافها أشكالها، و ثانيا، تحتكر السلطة عبر إقصاء مكونات المجتمع الأخرى خصوصا المجتمع المدني. ولهذا، فإشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي له علاقة وثيقة بطبيعة الأنظمة التسلطية.
هذه الظاهرة التي حركت ذهنية العديد من الباحثين ، قصد إنتاج أطروحات تفسيرية لإمكانية تجاوز هذه الظاهرة وتحقيق الدولة الديمقراطية . فكان بعض هذه النظريات حاول تفسير الظاهرة من منطلق الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي كمجتمع يساعد على الخنوع والطاعة وقبول الاستبداد ، بينما البعض الأخر من النظريات حاول تفسيرها بالرجوع إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية لها علاقة بشكل الدولة الريعية .
وهكذا ، فإذا كانت ميزة الدول في المشرق العربي بأنها تسلطية ، وأنها تفتقر لأبسط معاني الديمقراطية أو كما يرى بعض الباحثين بان منطقة المشرق العربي باستثناء إيران و تركيا ، فهي لم تشهد أي نظام ديمقراطي [69] ، فاٍن هذه الأطروحات النظرية التي حاولت تفسير العجز في تحقيق الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي ، بالرغم من تقديمها تفسيرات موضوعية إلى حد ما لإشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، فهي اليوم مطالبة بإعادة تحيينها بعد ثورات الربيع الديمقراطي وما أدت إليه من تحولات سياسية واٍجتماعية مخالفة للصورة النمطية للمجتمع العربي كمجتمع ساكن وراكد.
على هذا الأساس ، فما يسمى بالاٍستعصاء الديمقراطي في المنطقة العربية الذي يروج له في الأوساط الغربية ، فهو لا يعبر عن سمة أصيلة وطبيعية في البنية الاٍجتماعية العربية ، بل هي ظاهرة محدودة ناجمة عن عوامل خارجية وأخرى داخلية . والدليل على ذلك ما شهده العالم العربي من ثورات ديمقراطية جاءت بمجموعة من المؤشرات التي تظهر أن هذه المجتمعات هي في مسار بناء دول ديمقراطية.
لائحة المراجع:
أولا : الكتب باللغة العربية:
- – توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، دراسة من منشورات اتحاد كتاب العرب، 1997.
- – ثناء فؤاد عبد الله، آليات التفسير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997.
- – جورج قرم، انفجار المشرق العربي، من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق 1956-2006، ترجمة، محمد علي مقلد، بيروت، دار الفارابي 2006.
- – عبد الله حمودي، الشيخ والمريد ،النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 2010.
- – نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة، أمجد حسين، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2010.
- -إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية :دراسة لصور من الاستبداد السياسي، عالم المعرفة،العدد 183، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، مارس، 1994.
- برتران بادي، الدولة المستوردة (تغريب النظام السياسي)، ترجمة لطيف فرج، دار العالم الثالث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996 .
- بيري أندرسون ، دولة الشرق الاٍستبدادية ، ترجمة بديع عمر نظمي ، الطبعة الأولى ، بيروت مؤسسة الأبحاث العربية 1983 ،.نقلا عن أرسطو ” السياسية ” .
- حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 1992.
- خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنائية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2004.
- زهير فريد مبارك ، أصول الاستبداد العربي ، دار النشر : مؤسسة الانتشار العربي ، الطبعة الأولى 2010 .
- سعد الدين إبراهيم ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005.
- سعد الدين إبراهيم، مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1987.
- سعيد بنسعيد العلوي ، عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان و دار الفكر دمشق ، سورية، الطبعة الأولى ، 2006 .
- عبد الجليل كاظم الوالي، “الاستبداد في الفكر الكلامي والفلسفي”، علي خليفة الكواري، الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005.
- علي الكواري ، أزمة الديمقراطية في البلدان العربية ، اٍعتراضات وتحفظات على الديموقراطية في العالم العربي ، دار الساقي للنشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 2004.
- علي خليفة الكواري، الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005.
- غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ، محور المجتمع والدولة ، الطبعة الثانية ، بيروت، كانون الثاني/يناير 1999.
- فواز جرجس ، تحفظات عربية على الديمقراطية ، أزمة الديمقراطية في البلدان العربية ،اعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم العربي ، تحرير علي الكواري ،دار الساقي للنشر ، الطبعة الأولى ، 2004 .
- محمد زيعور ، تطور الفكر السلطوي ( العلمانية،الإسلام ،المركسية ) ، الطبعة الأولى ، بيروت ، رشاد برس 2003.
- هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1992.
ثانيا: الكتب باللغة الانجليزية :
- Henner Furtig, The Arab Authoritarian Regime between Reform and Persistence, Cambridge Scholars Publishing , Hamburg , January 2007.
ثالثا: المـــقالات:
- باللغة العربية:
- إبراهيم البدوي و سمير المقدسي، “تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي”، مجلة المستقبل العربي، عدد 384، فبراير، 2011 .
- حيدر إبراهيم، “تجديد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية”، مجلة المستقبل العربي، عدد، 313، ماي،2005.
- عبد النور بن عنثر، التسلطية السياسية العربية ، مجلة فكر ونقد ، السنة الخامسة ، العدد 45 ، يناير 2002.
- عزمي بشارة، في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ القدس العربي، الطبعة الثانية، 2010.
- محمد عباس نور الدين ، لكي نغير المجتمع الأبوي السلطوي ، مجلة فكر ونقد ، السنة الرابعة ، ألعدد 38 ، أبريل 2001.
- محمد عباس نور الدين، لكي نغير المجتمع الأبوي السلطوي، مجلة فكر ونقد ، السنة الرابعة ، العدد 38 أبريل 2001.
- معتز الخطيب ، الدولة بين الإسلاميين و الليبراليين ، وجهات نظر في الثقافة والسياسة والفكر ، العدد 138، يونيو 2010.
- وجيه كوثراني ، أزمة الدولة في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 390 ، غشت 8/
[1] : معتز الخطيب، الدولة بين الإسلاميين والليبراليين، وجهات نظر: في الثقافة والسياسة والفكر، العدد 138، يونيو 2010، ص 30.
[2] : خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنائية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1996، ص 335.
[3] : ثناء فؤاد عبد الله، آليات التفسير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1997 ، ص 63.
[4] : محمد زيعور ، تطور الفكر السلطوي ( العلمانية،الإسلام ، المركسية ) ، الطبعة الأولى ، بيروت ، رشاد برس 2003 ، ص 15.
[5] : خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنائية مقارنة، مرجع سابق، صص 19-22.
[6] : توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، دراسة من منشورات اتحاد كتاب العرب، 1997، ص 717.
[7] : نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة، أمجد حسين، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2010، ص، 234.
[8] : خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص، 76.
[9] : المرجع نفسه ، ص 79.
[10] : توفيق المديني، مرجع سابق، ص799.
[11] : خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص 123.
[12] : خلدون حسن النقيب ، مرجع سابق ، صص 125-126.
[13] : خلدون حسن النقيب، المرجع نفسه ، ص129.
[14] : خلدون حسن النقيب، المرجع نفسه ، ص59 .
[15] : توفيق المديني، مرجع سابق، ص 799.
[16] : خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص 22.
[17]: عبد النور بن عنثر، التسلطية السياسية العربية ، مجلة فكر ونقد ، السنة الخامسة ، العدد 45 ، يناير 2002، ص 27.
[18] : سعد الدين إبراهيم، مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1987، ص 404 .
[19] : عبد النور بن عنثر، مرجع سابق ، ص 28 .
[20] : سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، صص 405-406.
[21] : عبد النور بن عنثر، المرجع نفسه ، ص 28 .
: حيدر إبراهيم، “تجديد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية”، مجلة المستقبل العربي، عدد، 313، ماي،2005، صص 76-77[22]
[23] : حسنين توفيق إبراهيم ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 1992، ص 57.
[24] : حيدر إبراهيم، “تجديد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية”، مجلة المستقبل العربي، عدد، 313، ماي،2005، ص17 .
: خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص 26. [26]
: توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، دراسة من منشورات اتحاد كتاب العرب، 1979،ص 821[27]
[29] : عبد النور بن عنثر ، مرجع سابق ، صص من 31 -36 .
[30] : خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص 336.
[31] : عبد الجليل كاظم الوالي، “الاستبداد في الفكر الكلامي والفلسفي”، علي خليفة الكواري، الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص، 305
[32] : زهير فريد مبارك ، أصول الاستبداد العربي ، دار النشر، مؤسسة الاٍنتشار العربي ، الطبعة الأولى ، 2010، ص 39.
[33] : إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية (دراسة لصور من الاستبداد السياسي)، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارس، 1994، ص 54.
[34] : بيري أندرسون ، دولة الشرق الاٍستبدادية ، ترجمة بديع عمر نظمي ، الطبعة الأولى ، بيروت مؤسسة الأبحاث العربية 1983 ، ص 46 .نقلا عن أرسطو ” السياسية ” ص 3 .
[35]: إمام عبد الفتاح إمام ، المرجع نفسه ، ص 57 .
[36] : زهير فريد مبارك ، أصول الاٍستبداد السياسي ، ص 49 .
[37] : زهير فريد مبارك ، المرجع نفسه ، ص 49 .
: نزيه الأيوبي، مرجع سابق، ص108. [38]
: نزيه الأيوبي، المرجع نفسه، ص109 . [39]
[40] : زهير فريد مبارك ، مرجع سابق ، ص 53.
[41] : ثناء فؤاد عبد الله، آليات التفسير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997.، ص، 47 .
: هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،1992، ص 14 . [42]
: هشام شرابي، مرجع سابق، ص، 61. [44]
: هشام شرابي، مرجع سابق، ص 66. [45]
[46] : محمد عباس نور الدين، لكي نغير المجتمع الأبوي السلطوي، مجلة فكر ونقد ، السنة الرابعة ، العدد 38 أبريل 2001، ص 41.
: ثناء فؤاد عبد الله، مرجع سابق، ص48 . [47]
[48] : محمد عباس نور الدين ، المرجع نفسه ، صص 44-45 .
: هشام شرابي، مرجع سابق، صص 15 – 16. [49]
[50] : عبد الله حمودي، الشيخ والمريد (النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة يليه مقالة في النقد والتأويل)، ترجمة، عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 2010، ص109 .
: عبد الله حمودي، المرجع نفسه ، صص،102 – 133. [51]
: عبد الله حمودي مرجع سابق ، ص، 242. [52]
[53] : زهير فريد مبارك ، مرجع سابق ، ص 252.
[54] : زهير فريد مبارك ، المرجع نفسه ، ص 253- 254 .
[55] : فواز جرجس ، تحفظات عربية على الديمقراطية ، أزمة الديمقراطية في البلدان العربية ،اعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم العربي ، تحرير علي الكواري ،دار الساقي للنشر ، الطبعة الأولى ، 2004 ، ص 19 .
[56] : إبراهيم البدوي و سمير المقدسي، “تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي”، مجلة المستقبل العربي، عدد 384، فبراير، 2011، ص، 89.
[57] .: جورج قرم، انفجار المشرق العربي (من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق 1956-2006)، ترجمة، محمد علي مقلد، بيروت، دار الفارابي 2006، ص، 32
[58] : جورج قرم ، المرجع نفسه ، ص 32 .
: خلدون حسن النقيب، مرجع سابق، ص 45. [59]
[60] : وجيه كوثراني ، أزمة الدولة في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 390 ، غشت 8/ 2011، ص 108.
: عزمي بشارة، في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-القدس العربي ، الطبعة الثانية ، 2010 ، ص73. [61]
: جورج قرم، مرجع سابق، ص 97[62]
[64] : وجيه كوثراني ، مرجع سابق ، ص 107 .
[65] : برتران بادي، الدولة المستوردة (تغريب النظام السياسي)، ترجمة لطيف فرج، دار العالم الثالث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996، ص ص،40-41.
[66] : إبراهيم البدوي وسمير المقدسي، تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2011، ص 102.
[67] : وجيه كوثراني، مرجع سابق ، ص 112.
[68] : سعيد بن سعيد العلوي، مرجع سابق، ص 83.
[69] : Henner Furtig, The Arab Authoritarian Regime between Reform and Persistence, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, 2007, p 3.