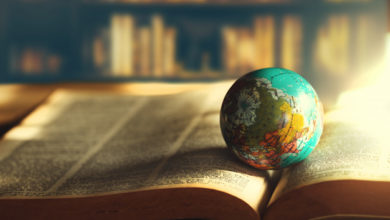المنهجية الجديدة في وظيفة النسق السياسي المغربي:مقاربة على ضوء نظرية الاختيار العقلاني
العدد الثالث “يونيو – حُزيران” لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
إعداد: عبد الإله الرمزي – باحث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة عبد المالك السعدي، طنجة – المغرب
‘ملاحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسق السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي- مقاربة على ضوء نظرية الاختيار العقلاني
ملخص:
“إن مفهوم المشروعية السياسية يقع أو يتوسط ما هو منتسب للماضي وما هو منفتح على المستقبل، لذلك أحببت أن أخصص هذه السطور المحدودة لمساءلة موارد هذه المشروعية التي تستند عليها ومن خلالها المؤسسة الملكية. لذا فهذه الورقة قد تكتسي صبغة ابستمولوجية ونقدية، تحاول استقراء مفهوم المسألة الاجتماعية من داخل نسق القيم السياسية، كما قد تلتبس طابعاً تجريدياً لا هو بمحايث أو ترسندنتالي. وهذا لا يعني الإغراق في التأمل النظري وإتلافاً للحلول العملية واليومية المباشرة الخاصة بمتطلبات الراهن الاجتماعي وتداعياته على الحقل السياسي المغربي، كما تدعو إليه تيمة الموضوع، وإنما هي محاولة لتفتيق معالم رؤيا نقدية لإشكالية الشرعنة الجديدة للمؤسسة الملكية.
يعدّ إذن سؤال شرعية النسق السياسي سؤالاً ذا خصيصة مرتحلة عبر ثنايا الأزمنة السياسية كما نعلم، وهو لا يستكين فقط إلى الأسس الميثولوجية المشكلة من الدين والعرف، ولا إلى لغة القوة/ السلطة بمفهوم الإكراه والغلبة. بل يحمل سؤال الشرعية السياسية إلى أن يكون فوق الزمن الديني والتقليدي”au de la du temps religieux/traditional” .
وبهذا، يصعب على النسق السياسي المغربي أن يستحضر الماضي التقليدي بشكلٍ مفصولٍ عن الراهن وتحديات المستقبل، خاصة إذا تعلق الأمر بملامسة إشكالية سياسيةproblématique politique ، فهل هناك وعي للفاعل السياسي المركزي/الملك بهذه الحقيقة السياسية؟ بمعنى آخر، هل تؤسس المؤسسة الملكية شرعيتها انطلاقاً من الراهن المجتمعي؟ أم أن “خطاب الشرعية وسؤال التبرير” يظل حبيس القاموس الديني والميثولوجي الذي هو من يعبّئها بمفاعيل النسق التقليدية، كما أفرد مشروعه الفيلسوف ميشال فوكو”.
مقدمة:
تطمح هذه الورقة لأن تشكل إسهاماً في بلورة البنية السياسية المغربية المستقبلية “لمشروع الدولة المجتمعي الديمقراطي الحداثي”.[1] وهي تنطلق وصولاً إلى هذا الهدف من حدين: أهمية الاختيار العقلاني[2] في تقعيد وضمان الوجود السياسي للنسق المغربي كي يلعب دوره الفعال على مسرح الفعل الاجتماعي.
أما الثاني فهو واقع البنية الاجتماعية – النفسية لهذا العقل السياسي المغربي في خصائصه وآلياته ودينامياته وبما يتوفر له من إمكانات وما يعانيه من معوقات وما يشهده من إكراهات.
فهي محاولة فكرية متواضعة في البحث والدراسة الموجزة، وجهد مأمول للفت النظر واستدعاء الاهتمام حول إشكالية تتصل عمودياً وأفقياً بالتساؤل المحوري الذي مفاده: ما هي دواعي ومصوغات تركيز آليات الشرعنة داخل المجال الاجتماعي من طرف النسق السياسي المغربي وتبني المقاربة العقلانية في تجديد موارد وأنساق مشروعيته وتعزيز متكآته في إطار قيم وأنماط مسرح الفعل الاجتماعي؟
ضمن هذه الدراسة ستتحدد أهمية المعيارية الاجتماعية حضوراً وغياباً، وحسبها كذلك أن تبقى محاولة لتأكيد علاقة المتغير /الاجتماعي بالثابت /السياسي، فلا يوجد فعل ينتمي إلى مضامين القاموس السوسيولوجي (مخرجات البنية السياسية) غير قاصد، إذ هو مسبوق بفكرٍ ووعيٍ سياسيين، إن الأمر يتعلق بإستراتيجية الفاعل السياسي المركزي (المؤسسة الملكية).
من هنا تتحدد أهمية وأهداف هذه الدراسة في مجموع نقاطٍ رئيسةٍ نعرضها بشكلٍ موجزٍ فيما يلي:
-1 كونه يبحث في تفكيك العلاقة التفاعلية الحاصلة ما بين كل من المتغيرين الرئيسيين، محددات الشرعنة الجديدة للمؤسسة الملكية، والتحديات الداخلية والتحولات الإقليمية/الدولية الجديدة -“مرحلة ربيع الديمقراطية العربي”- كمرحلةٍ انتقالية؛
-2 فهم وتحليل الأنساق والقيم الجديدة المتبناة من طرف هذه المؤسسة داخل فضاء الفعل الاجتماعي؛
-3 التوجه نحو فهم الأدوار الوظيفية الجديدة للمؤسسة الملكية المحتكرة للنشاط الاجتماعي ميدانياً (عن طريق سياسة إحداث اللجان) ، بما يعطي قناعاتٍ في أبعاد ترشيد المقدرات وتحديث البنى وعقلنة السياسة؛
– 4 إن الموضوع محاولةٌ جريئةٌ باتجاه بناء سيناريو تأليفي، يعطي توليفاتٍ مرجعيةٍ ومؤسسةٍ حول مستقبل النسق السياسي المغربي، وحول مدى أهمية القيم الناشئة والموارد البديلة للأنساق التقليدية والمرجعيات الكلاسيكية للمؤسسة الملكية التي استثنت في حيثيتها القداسة الآخذة في الانحسار والاندثار في ظل واقعٍ مجتمعيٍ يشهد العديد من المتناقضات والإشكالات؛
5- رصد مدى تأثير المشروعية الدينية للملكية في المغرب في التنمية السياسية، واستشراف موقعها داخل المشهد السياسي في ظل تجربة التحول الديمقراطي، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؛
6- إن موجة الديمقراطية التي تعيشها البلدان العربية طرحت تحدياتٍ أمام الأنظمة الوارثية التي تستمد جزءاً كبيراً من مصادر مشروعيتها من الدين، ممَا أدى إلى فتح نقاشاتٍ أكثر حدَةً هذه المرة، حول إمكان التحول الديمقراطي في ظلّ المشروعية الدينية لهذه الأنظمة.
لقد حرصت ألا تأتي هذه المحاولة نظرة فلسفية تجريدية، فبحثت عما يمكن أن يبرز ملامحها ويعضد طروحاتها، استقراءً واستدلالاً واستشهاداً بنماذج عملية واقعية، ضمن إطار الزمن السياسي الذي أجريت فيه. ثم أضفت إلى ذلك جهداً علمياً تطبيقياً، يبحث عن دلالات الحضور الميداني للمؤسسة الملكية في مسرح الأنساق المجتمعية وعوالم المعاش وحكامة الحياة اليومية، من خلال دراسة مسحية وصفية تحليلية “لاتجاهات النسق السياسي المغربي” إزاء “الإشكالية والمسألة الاجتماعية” التي صُنعت، فيما أرى، وفقاً لرؤيةٍ سياسيةٍ معينةٍ و “بعدٍ فكريٍ سياسي”، مستمدٍ منها ومرتكزٍ إليها في عملية إعادة الفعالية وتجديد أنماط الشرعنة.
كما اعتمدت طريقةً موضوعاتية اتبعتُ خلالها طرق اشتغال المؤسسة الملكية داخل الفضاء السوسيولوجي، وهو ما يبرهن بالفعل على أنني أسعى- بكل جهدٍ ممكن- لأكون مالكاً لناصية المنهج الذي سأعتمده ضمن هذه الورقة – بالإضافة إلى الاستئناس بمقترباتٍ منهجيةٍ أخرى – والذي ستمكنني من الخروج بخلاصاتٍ ونتائج جد مهمة.
لذلك، ونظراً لعدم استطاعة منهجٍ واحدٍ تفسير الظواهر السوسيو/سياسية التي تتدخل فيها عوامل متعددة تقتضي المزاوجة بين عدة مناهج علميةٍ (أو بالأحرى، الحديث عن مقترباتٍ منهجيةٍ في ظل هيمنة منهجٍ واحدٍ على جل مراحل هذه الدراسة) كان من البديهي، أن تتعدد المناهج المستعملة في هذه الدراسة بشكلٍ منطقيٍ ومتناغمٍ مع ما تتطلبه العُدة المعرفية لتقليب النظر العلمي في الموضوع المدروس، وإشكاليته المحورية طيلة مراحل البحث، دونما أي انزياحٍ معرفيٍ أو انعطافٍ منهجيٍ عن أرضيته التأسيسية ووجهته المنشودة موضوعاً و تحليلاً.
وعليه، فإن المنهج الذي سألتزم به سيكون متعدد الملامح و الجوانب؛ فإذا كان من الجائز أن يقدم الباحث بمقدمةٍ منهجيةٍ عامةٍ يشرح من خلالها و بها مجموعة القواعد التي وجهت بحثه، فإن هذا العمل عديم القيمة إن لم يُوضح طبيعة الصلة بين الحقيقة المُراد تحصيلها و المنهج؛ لأن المنهج يشكل بنية الشرح كما قال”هيجل”.[3] فهو بهذا المعنى، ليس شكليةً مجلوبةً من خارج بنية الدراسة، أو معرفةً منصبةً على مادتها من عليها، وإنما هو طريقة اقتضتها طبيعة موضوع الأطروحة ذاتها، لأن النسق الفكري و الشكل المقولاتي، والمنهج المستعمل من دون الموضوع خواءٌ و فراغ.
إن منهج هذه الدراسة هو في الحقيقة، جزءٌ لا يمكن انتزاعه منها، إذ كلما تطورت محاورها، تطور الإجراء معها، لذلك سأعتمد في دراستي هذه، توليفةً منهجيةً خاصةً احتكاماً لطبيعة الموضوع والأدوات التقنية الضرورية في المعالجة والتحليل، وستتشكل من:
– المنهج النسقي: وعبره سيعتمد الموضوع وحدةً متكاملة، بحيث سيفيد هذا المنهج في تفكيك العلاقة التفاعلية داخل العلبة السوداء من خلال ما أقر به “ديفيد إيستون”، حول المخرجات والمدخلات ثم الفعل ألاسترجاعي العكسي؛ فالمدخلات تمثلت بالأساس، في مجموع التحولات الجديدة المؤثرة على منظومة القيم المشكلة لمرجعيات وأسس النسق السياسي المغربي.
أما المخرجات، فستتمثل في النتائج العامة المحصل عليها، والتي تُمثل بدورها مجموع الملامح والأنساق الجديدة الداعمة للنظام السياسي، كما تتضمن مجموع البرامج والأجندات والتوجهات المستحدثة على مستوى نطاق مسرح الفعل الاجتماعي، أما الفعل ألاسترجاعي فيتصل بمضامين السيناريوهات المستقبلية حول الموضوع.
المنهج الوصفي: يظهر ذلك من خلال ما سنستعمله من تقنياتٍ مثل المسح، والاعتماد جزئياً على تقنية دراسة الحالة (حالة الإسقاطات)، كل ذلك سيكون حاصلاً ضمن عملية مركبة بين التفسير والتحليل، وهو ما سيساعد أكثر على بناء عمليةٍ تشخيصيةٍ لمجمل انعكاسات التحديات المجتمعية الجديدة على أسس النسق السياسي المغربي، من أجل فهمٍ أكثرٍ لكيفيات فعل آليات وقوى الفواعل المستجدة على الدولة.
– المقترب الدياليكتيكي والمقترب الاستدلالي، بحيث الأول يعتبر كل الأشياء والظواهر والحقائق الاقتصادية والإنسانية والسياسية دائماً في حالة ترابطٍ وتشابكٍ وتداخلٍ وبصورةٍ مستمرة، كما يعتبر في حالة تناقضٍ وصراعٍ وتفاعلٍ داخليٍ قوي، وهو ما سيظهر حسب أطروحتي هذه، في كل التحليلات الواردة، مع اعتبار المتغيرات والعناصر المصاحبة للتحولات الجارية واقعةً ضمن نسقٍ كلانيٍ هو إكراهات الواقع المجتمعي في ظل “ربيع الديمقراطية العربي”، وفي صورةٍ ترابطيةٍ تشابكية.
هذا ما سيساعدنا على إعطاء مقاربة جادةٍ حول الأسس المرجعية الجديدة للنظام السياسي.
فحسبها أن تأتي هذه الورقة مجاهدة فكرية لإثارة هذه “الإشكالية” وطرحها على ساحة الفعل السوسيو-الثقافي المغربي وفتح ملفها المغلق/ أو المغيب، والتفاكر بصوت مسموع حول إمكانية كشف أغوارها ونبش أسرارها. لا أدعي أني قد بلغتُ في ذلك الشأوَ الذي أطمح إليه والمدى الذي أسعى لبلوغ ما أبصره من أبعاده وآفاقه، وإنما حسبها أن تبقى إضاءة ومحاولة استطلاعية استقرائية ما تزال تستدعي كثيراً من الـتأسيس والتأصيل والنظر والاستقراء والاستنتاج والدليل على أهمية هذا المفهوم “المسألة الاجتماعية” والدور الذي يمكن أن يضطلع به، كأداة أساس وبعد رئيس، إن لم يكن البعد الاجتماعي / المحدد التنموي الإيوالية الوحيدة والنسق الوحيد، في عملية توسيع القاعدة الاجتماعية للملكية وتجديد موارد وأنساق مشروعيتها الشعبية.[4]
هكذا، سيتحرك هذا البحث طوال هذه الورقة ما بين نقاش المقومات الأساسية للنسق السياسي القادرة على التحكم في توجيه مستقبل الفاعل المركزي وصناعته، بدلاً من الاستمرار بالانفعال بتحديات المجال المجتمعي ومحاولة استيعاب صدماته، وبين واقع هذه المقومات، كما تبتدئ في الممارسة الفعلية والمسلكيات العملية بدل الاقتصار على توظيف المضامين الثيولوجية والاعتماد على حقل الدلالات الرمزية فقط.[5]
سيتركز تحليلنا إذن على البنى الاجتماعية الراهنة في تأثيرها على بنية العقل السياسي المغربي،[6] وأنماط السلوك والتفاعل والتوجهات الأخرى، بعيداً عن المنهج التاريخي – الذي يستمر تأثيره في الحاضر كماض مغلق –،[7] هذه الأنماط والمسلكيات التي تنتمي إلى مسرح الفعل الاجتماعي تمثل نوعاً من الإيديولوجية الضمنية التي تفعل في الخفاء بشكلٍ واع وداخل نطاق تأثير السياسات الصريحة، مولدة تفاعلاً جدلياً مستمراً ما بين الاجتماعي وبين الإيديولوجي الراهن داخل منظومة النسقية السياسية، محددة لمنتجاتٍ فوقية تنطلق من بناها التحتية (مطالب الرعايا في الإصلاح والتغيير)، وتهدف إلى تكثيف وخلق دينامية بنية العقل السياسي المركزي (المؤسسة الملكية) وخلق نوع من التماهي السياسي، يأخذ شكل الوعي بضرورة التدخل لتحويل محاور و أنماط البنية المجتمعية من واقعها الحالي المعوق إلى واقعٍ آخر وظيفي يشرعن من جديد للوجود السياسي لبنية العقل المركزي.
تستند إذن محاولتنا التحليلية إلى المعطيات التالية من خلال تتبع معالم التوجه الذهني للمؤسسة الملكية والممارسة العملية ضمن مستويين:
- المستوى الأول: التحول من الاعتماد الكلي والوحدوي على الذهنية التقليدية المثولوجية المشكلة للعقائد الإيمانية المتوارثة (مجال المقدس)،[8] إلى الذهنية القائمة على المعايير والقيم التي تؤسس لسياسة حكامة الحياة اليومية (الإطار المتغير).
- المستوى الثاني: التحول من عقلية نفوذ وهيمنة الفاعل المركزي (الملك) على مخرجات الفعل الاجتماعي إلى العقلية المؤسسية والمقاربة التشاركية.[9] بمعنى الانتقال من التوجه الذهني الاستبدادي والانفعال والتصلب إلى العقلانية العملية والعقلية الديمقراطية.[10]
المستوى الأول: اعتماد الاتجاه الثيوقراطي المحافظ: اللوثيان والأيديولوجيا كتسويغ للسياسة
تاريخياً، في البلدان المتأخرة بوجهٍ عام، ومنها الوطن العربي، لم تمارس السياسة، السياسة بالمعنى اليوناني للكلمة، أي كمجموعة من مسؤوليات وحقوق وواجبات ملقاة على عاتق عضوٍ حرٍ ومسؤول يشكل جزءاً لا يتجزأ من مجموعة بشرية متجمعة في مدينة – “Polis”.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول بصورة عامة، في المدينة الإسلامية كانت الإنسانوية مفتقدة، والتعددية مدانة، والانفصال بين السلطة والشعب قائماً.[11]
لكن على الرغم مما قد يكون في هذه التعميمات من مبالغة، ومهما يكن تقديرنا للأسباب التاريخية والاجتماعية التي تقف وراء هذه الظاهرة، سواء في الحاضر أو في الماضي، فلا يسعنا إلا أن نسجل أن الخطاب السياسي في الفكر العربي، قديمه وحديثه كان ولا يزال- في الأعم الأغلب- خطاباً غير مباشر، غير صريح وغير صائب في مبتغاه ومقصده.
وهكذا فعلاوة على اللجوء في الماضي خاصة، إلى ممارسة السياسة على الصعيد النظري بواسطة “الرمز” كإجراء الكلام على لسان الحيوانات، كما في كتاب “كليلة ودمنة”، أو من خلال الأمثال والحكم، كما في كتب “السياسة الملوكية” و “الآداب السلطانية”، فإن “الكلام” في السياسة لم يكن يتناول قضاياه مباشرة بل كان يلجأ في الغالب إلى طرحها من خلال قضايا تنتمي إلى “سياسة” الماضي أو إلى ميدان آخر غير ذي طابع سوسيو/سياسي مباشر. ف”الكلام” في الخلافة مثلاً، وهو الموضوع الذي تمحور حوله “الفكر السياسي الإسلامي”، كان دائماَ كلاماً في “سياسة” الماضي، على الرغم من أن دوافعه كانت من “الحاضر” دوماً. صحيح، أنه كان يهدف دائماً إلى “تقنين” الواقع القائم، وإضفاء المشروعية الدينية عليه (الفكر السياسي السني)، ولكنه لم يكن يفعل ذلك مباشرة، كما هو المفروض في كل خطاب سياسي جدير بهذا الإسم، بل كان يلجأ إلى الماضي السياسي يؤوله بالكيفية التي تجعل الحاضر شبيهاً له ونظيراً حتى يتأتى قياسه عليه.
فالملاحظ، استمرار هذا الفكر بكل مضمراته الإيديولوجية وآلياته التعبيرية في الخطاب السياسي الحديث الذي يمارس السياسة عادة من خلال طرح موضوع “نظام الحكم في الإسلام”،[12] قارئاً في الماضي رغباته وحاجاته الحاضرة، محاولاً تبني قضايا “غير” سياسية، أي غير ذات مفعول سياسي في الحاضر ضمن حقل القيم الاجتماعية. ومن ثم الابتعاد عن مجابهة الواقع مجابهة مباشرة، مما جعل خطاب النسق السياسي الحديث والمعاصر جملة وتفصيلاً خطاباً ضحلاً فقيراً من حيث مفاهيمه وآلياته.[13]
فالواقع يعكس أزمة النزوع نحو النموذج التقليدي أو الكاريزمي الذي ينفي بنية النموذج الديمقراطي الدستوري الذي يراد له أن يسود داخل منظومة القيم السياسية ومخرجات النسق السياسي، وهذه مشكلة كبرى تواجه العقل السياسي العربي عموماً والمغربي على وجه الخصوص،[14] بسبب محاولته الخروج من هذه الأزمة (أقصد أزمة فشل البنية السياسية في تبني البرامج الاجتماعية والانتخابية ومطالب الاحتجاجات)،[15] وكأنما يراد للمجتمع أن يلجأ لمنطق الكاريزما أو القيادة الملهمة القادرة على حلول هذه الأزمة (لاسيما بعد تعالي مطالب حركة 20 فبراير الداعية إلى تحكيم منطق التنمية والتغيير والتخلي عن القاموس الثيولوجي والمفهوم التيوقراطي للسلطة) وكأن الأمر مرتبط فقط بقدرة النموذج – القائد – السياسي. الشيء الذي يشنج العلاقات المجتمعية ويثير نوعاً من عدم الاستقرار السياسي بسبب تنامي السخط واليأس الاجتماعي (كما تبينه الخطاطة التالية).[16]
هذا التوجه التقليدي في المنهج والمنظور يقابله توجه واحد في الموضوع، حيث تدرج ممارسات جديدة ضمن العقلانية السياسية مع أنها ممارسات تبدو ظاهرياً على الأقل أنها لا تساير التعريف الكلاسيكي للعقلانية.[17]
وعليه، يتضح أمر المشروعية السياسية، وأزمتها، وضرورة انتقالها من المنظومة التقليدية إلى ما بعدها، من المقدس الإلهي إلى الدنيوي – الإنساني، ومن تفكك البنية المجتمعية – السياسية المعتمدة على الأس الاقتصادي إلى المجال الاجتماعي الثقافي – الإنساني (العوالم المعاشة ودوافع الأفراد في المجتمع وتوسيع نطاق الحرية).[18]
تحاول الدولة التغلب عليها من خلال تدخلها في الإقتصاد
محاولة حل الأزمة عبر الجهاز الإداري والدعاية
مخطط يوضح تلازم الأزمات وانبثاق أزمة المشروعية حسب “يوغن هابرماس Jurgen Habermas “[19] |
تقتضي المعالجة العميقة لعلاقة العقلانية المغربية بالسياسة حفراً عميقاً في التراث والتاريخ للتعرف على كيفية ممارسة العقلنة والعقلانية السياسية في الماضي، كما تقتضي حفراً في اللاوعي المغربي لمعرفة علاقة النسق السياسي المغربي بكل من الدين واللاوعي الجمعي.[20]
فالملك في النسق السياسي المغربي سلطان بمقتضى الحق الإلهي، وهو الأمر الذي أفضى إلى التوظيف المظهري لعناصر المشروعية التقليدية، عبر تقوية المنطق الإلهي والبركة والشرف والمقدس والتجذر التاريخي للملكية وحقها في احتكار السلطة وممارستها، فإن هذا لم يمنع من تبني الملكية في استراتيجية الدعم الذاتية آلياتٍ أخرى بغية تجييش الجماهير/الأمة، وتوطيد العلاقة بالمحكومين، هذه الآليات التي تكتسي أبعاد اجتماعية نفسية ورمزية بما يتلاءم مع الظاهرة السياسية إجمالاً (بل والظاهرة البشرية بشكل عام).
إن المؤسسة الملكية في مرتبة فـوق القوانين الوضعية، ولا تسـري عليها الاعتبارات الإنسانية في التعامل مع الاجتهاد البـشري المعرض بطبيعته للخطأ والصواب.[21] فهي ترفض الاقرار بهذه الطبيعة، إذ تعتبر نفسها متمتعة بطبيعة “فوق – الطبيعة”، تسبغها بصفة القداسة، وتحجبها عن الطبيعة الإنسانية الخطاءة/الدنسة، مما خول لها التموقع فوق الجميع والتحكم في الجميع، واحتكار السلطات الدينية والدنيوية، التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومن ثم الحلول في الحقل السياسي عبر ازدواجية “الملك / أمير المؤمنين، الذي له سلطة تحديد محتويات المفاهيم السياسية أياَ كانت طبيعتها وموضوعها، كما تجعله يفرض نفسه كمرجعية وحيدة لها الحق في إصدار المعاني والمفاهيم والقيم.[22] إنه: “كائن اسثتنائي لا يخطئ، فهو منزه ومعافى من الآثام أو الأخطاءL’imam un être exceptionnel infaillible, il est nécessairement indemne de tout péché ou erreur“.[23] إنه يشكل بحسب ما كتبه “وليام زارتمان William Zarttman” ما مفاده: “الملك يتمتع بدورٍ مزدوج، أولاً: كونه الحاكم الوريث للمغرب(…) وامتلاكه لألقابٍ عديدة: ملك – سلطان – خليفة – إمام – أمير – شريف يجعله في وضعية ثلاثية: “زعيم الإسلام في الأمة”، “رمز حماية البلاد” و”القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وثانياً: كونه زعيما سياسيا، يمارس مهمة ثلاثية في الحكومة: التشريع وأمر توجيه السلطة التنفيذية، ثم تفويض ومراجعة القضاء، كل هذه القوى مدونة في الدستور ومستمدة من التقاليد والتاريخ والتجارب السابقة ومن الممارسة أيضاً”.[24]
على هذا الأساس، لم تستطع المؤسسة الملكية في المغرب الخروج عن هذه الأصول في توظيف المعطى التاريخي بقوة ضمن منظومتها الرمزية – التبريرية، هذا المعطى القائم على كون الملك هو البطل المحرر والموحد، سليل الأمجاد وعلى أن الملكية تعيش من خلال قداسة الأجيال / السلطان.
المستوى الثاني: “من فلسفة الذات إلى السياسة المعقلنة: نحو العقلانية التواصلية من أجل صناعة القيم ضمن العالم المعاش”
إن تحليل النسق السياسي المغربي ماضياً وحاضراً، يستلزم التساؤل عن درجة عقلانية قراراته السياسية (المخرجات)،[25] وعن كيفية عقلنة ممارسته السياسية، وكذلك التساؤل عن أشكال التكثيف والنقل التي تعرفها الممارسة السياسية المغربية. فقد ظل المجال السياسي المغربي على صلة وطيدة بالمجال الديني، ولم يحقق استقلاليته النسبية بعد،[26] لذلك فإن كل فهم للممارسة السياسية للفاعل المركزي (الملك)، يفترض إجلاء علاقة الدين بالسياسة وتعبير السياسة عن مواقف دينية، أو التأويل الديني لمواقف سياسية. [27]
استناداً إلى هذا المعطى، يمكن قياس درجة عقلانية الممارسة السياسية المغربية، بدءاً بدراسة المؤسسة الملكية وتبيان مدى حضور لأوجه القرار العقلاني في أوصالها واختياراتها.
لكن استخدام هذا الاختيار العقلاني كرابط بين هياكل الفرص السياسية وأنماط السلوك الاجتماعية، يقود إلى مجموعة من المشاكل، منها النظر فقط للمسلكيات الاجتماعية (وهي المخرجات العملية للنسق السياسي التي وضح مفاصلها “دافيد ايستون David Easton,”)،[28] على أنها يمكن أن تؤثر في منظومة القيم المجتمعية.
وعلاوةً على ذلك فإن الحساب العقلاني غير حاسم في مواقف نقص المعلومات ودرجة عدم التأكد الكبيرة من حاجيات المواطن للسلع والخدمات الاجتماعية، هذه الانتقادات تشكل إعادة تقدير لبعض الآليات النفسية- الاجتماعية والتي هي أساس الاقترابات التقليدية للمؤسسة الملكية، وإن كان هذا مع اختلافٍ هامٍ حيث تُرى هذه الأحاسيس كمنتجاتٍ للبناء الاجتماعي، بدلاً من قوى تشمل الفاعلين بطريقة يخسرون فيها قوتهم (نشاط انعكاسي).
إن هذا العرض الذي جاء مسرفأً في إيجازه قصدت منه بجانب مقاصدنا المشار إليها في ثنايا مفاصل هذه الورقة أن أشير، أو على الأقل أن ألمح إلى أن مناقشة العقلانية داخل قيم النسق السياسي المغربي، تستند إلى اختيارات إيديولوجية، واختيارات حقل الأنساق الاجتماعية التي تدعم الاختيارات الايديولوجية، وأن مضمون العقلانية محمل بأبعاد إيديولوجية وفهم نوعي لقيم مسرح الفعل الاجتماعي وللتدبير الجيد للموارد والرشدانية.[29] وربما كانت هناك محاولة بناء ركائز التوصل إلى حد مشترك انتقالي لعناصر من الإيديولوجيات داخل الحقل السياسي المغربي، التي هي بحاجة إلى تصور مستقبلي للأهداف والمرامي المرحلية والمطردة، ولإدراك الأبعاد الداخلية والآفاق العالمية المؤثرة في اختيارات العقل السياسي المغربي. فهذا الحد المشترك يمثل بعداً هاماً لمضمون العقلانية المرغوبة، ما دامت العقلانية في روحها تدبراً في الاختيارات ووسائل إنجاز أهداف الاختيارات في الزمان والمكان، وبخاصة الزمان النسبي الذي يعني وجود أبعاد من الماضي في الحاضر، وميلاد المستقبل من الحاضر.
وعليه، فالأمر يتطلب بالضرورة إعادة اكتشاف المشروعية السياسية وتعريفها من جديد. يتطلب محاولة تعريف المشروعية بعيداً عما يتم ترديده من الولاء للحاكم أو النخبة الحاكمة إلى الولاء للدولة والطاعة للقوانين والتأييد للأهداف والقيم الكبرى. مصادر المشروعية تتجدد، وهي حالة سياسية تعكس موقفاً اجتماعياً ثقافياً. وما قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية،[30] وتداول السلطة إلا أحد تعبيرات أزمة المشروعية وليست الأزمة بأكملها، بل هي أكبر من كل ذلك.
جدول يوضح ميزات القانون ودوره وانعكاسه في المجتمع وكيفية شرعنته حسب “هامبرماس”[31] |
|||||||||||||||||||||||||
بناءاً على ماسبق ذكره، فإنه إذا كان التشخيص أقرب إلى السوداوية، فإن استشراق المستقبل كان مليئاً بالأمل في أن يتجاوز النسق السياسي المغربي كل المعوقات النفسية والذهنية والتاريخية، والإكراهات السوسيو/اقتصادية التي تحول بينه وبين إدراك التطور المنشود والتقدم المأمول. وذلك في أفق الدولة المستقرة ذات الاختيار العقلاني،[32] المحققة للعدالة والديمقراطية والتقدم والموفرة لحقوق المواطن الأساسية، وتلك هي اللبنات الأولى في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي؛ بحيث تصير المشروعية وظيفة لفعل تواصلي بين الحاكم والمحكومين، يمكن أن تفهم على أنها إضفاء الطابع المؤسسي للمعيار التداولي الاستطرادي للسلطة السياسية. إنه التحول من الاستعمال المألوف لمفهوم المشروعية، التي تتخذ شكلها من قوى غيبية أو معتمدة على التخويف والرعب، أو ولاء القناعة للظل الإلهي (المقدس)، إلى عوالم المجال العام لغرض تحقيق المتطلبات والأمل في مخرجات تتوافق مع إرادة المواطنين، وتعطي بأثر استرجاعي الاعتراف بالنظام.[33]
بذلك تتبين مديات الحاجة إلى معرفة أسس النظام السياسي المعاصر، لغرض الوقوف عند التأسيس لملامحه ومشروعيته، الأمر يتعلق بأسس الشرعنة الجديدة المنتمية لمسرح أنساق الفعل الاجتماعي، التي تشكل أهم صور هذا النظام السياسي (الديمقراطية) ومعيار لتحصيل مشروعيته.
قائمة المراجع
أولاً – المراجع باللغة العربية:
- الكتب:
أمارتيا سن: ” جعل التنمية آمنة لأجل الديمقراطية – مزايا الديمقراطية، كيف تعزز الديمقراطيات الرخاء والسلام؟-” نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى- يوليو 2009.
إيان كريب: “النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس”، ترجمة: محمد حسين غلوم، الكويت -عالم المعرفة، 1990.
جمال الدين الأفغاني: “الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني مع دراسة عن الأفغاني الحقيقة الكلية”، تحقيق ودراسة محمد عمارة، القاهرة – المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، الطبعة الأولى 1968.
حسن مصدق: “يورغن هامبرماس ومدرسة فرانكفورت- النظرية النقدية التواصلية- ” المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى 2005.
سعد حقي توفيق: “مبادئ العلاقات الدولية”، دار وائل، الأردن الطبعة: 3، 2006.
سلسلة الندوات: “العقلانية العربية والمشروع الحضاري”، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة الأولى الرباط 1992.
علي عبود المحمداوي: “الإشكالية السياسية للحداثة – من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل – هابرماس أنموذجاً”، منشورات الإختلاف، مطابع الدار العربية للعلوم – بيروت، الطبعة الأولى 1432 هـ – 2011 م.
كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية –شرح وتحليل –”، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2012.
محمد الطوزي: “الملكية والإسلام السياسي في المغرب”، ترجمة محمد خاتمي، خالد شكراوي نشر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة، مارس 2001.
ميشال مسلان: “علم الأديان – مساهمة في التأسيس –”، ترجمة: عز الدين عناية، المركز الثقافي العربي- بيروت الطبعة الأولى – 2009.
ياسين الحافظ: “الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة”، الآثار الكاملة، الطبعة الأولى، بيروت – دار الطليعة، 1979.
الأطروحات والرسائل الجامعية:
عبد الإله الرمزي: “المؤسسة الملكية في المغرب: من القيم التقليدية نحو العصرنة –دارسة سوسيو/ قانونية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، وحدة علوم سياسية & علاقات دولية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية: 2007 – 2008.
الكراعي محمد فاضل: “النظام السياسي المغربي وإشكالية المشروعية الحداثية على ضوء التحولات الاجتماعية المعاصرة، مقاربة سوسيو- سياسية”، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني-عين الشق، الدار البيضاء، 2006-2007.
هند عروب: “مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس – الرباط، 2006.
المقالات:
زين العابدين حمزاوي: “الأحزاب السياسية وأزمة الإنتقال الديمقراطي في المغرب”، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت – العدد 16، خريف 2007.
عبد العلي حامي الدين: “سؤال الإنتقال الديمقراطي بالمغرب – المعوقات الدستورية للإنتقال”، مجلة وجهة نظر، العدد 23 خريف 2004.
ثانياً – المراجع باللغة الإنجليزية:
Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science”, (New York: Alfred Knope, 1966).
Ritzer Gorge: “Contemporary Sociological Theory and its Classical Roots”,Mc GrawHill, 2003.
Ruth A. Wallace and Alison Wolf:”Contemporary Sociological Theory”, Chapter Six, Theories of rational choice, Prentice Hall, Inc, new Jersey, 1995.
ثالثاً – المراجع باللغة الفرنسية:
Mohamed Tozy : « Champ Politique et champ Religieux au Maroc : Croisement ou Hiérarchisation ? », Mémoire pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures en Sciences Politiques ; Casablanca –Avril 1980.
Palazzoli Claude : « Le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », Edition Sindibad, 1974. P : 20.
Stéphane Monney Mohandjo: « les Institutions Internationales, les pays du sud et la démocratie », Préface : Jean Pierre Colin, postface : Albert Bourgi, Imprimerie. Le journal de Tanger, 2012.
[1] إن الأمر يتعلق بمجهودات تنموية متعددة الأبعاد، تصب كلها في إطار التأهيل الاجتماعي بما يحفظ للمؤسسة الملكية توازنها السوسيو – سياسي، وحضورها الميداني القوي في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
[2] العقلانية كمصطلح يستخدم في علم الاجتماع يشير إلى أن العمليات المؤدية إلى زيادة الأفعال الاجتماعية تصبح مرتكزة أكثر على الفعالية الغائية أو الحسابات أكثر من تحركها بسبب الدوافع الأخلاقية والعواطف والتقاليد. وتعتبر جانب رئيسي من الحداثة والتي تتجلى خصوصاً في المجتمع الغربي كسلوكٍ ناتج عن السوق الرأسمالي في الإدارة الرشيدة في الدولة والبيروقراطية والتوسع في العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
وعلى هذا الأساس تسترشد نظرية الاختيار العقلاني بالافتراض الذي يقول أن البشر عقلانيون ويبنون أفعالهم علي ما يرون انه أكثر الوسائل فعالية لتحقيق أهدافهم. في عالم نادر الموارد، فان ذلك يعني الوزن المستمر لخيارات الوسائل في مقابل خيارات الغايات ثم الاختيار من بينها ومن هنا جاء المصطلح “الاختيار العقلاني”.
الفكرة الأساسية في نظرية الاختيار العقلاني (Rational Choice Theory) هي أن أنماط السلوك في المجتمع تعكس الاختيارات التي يقوم بها الأفراد في سعيهم لزيادة المنفعة والفائدة وتقليص الخسائر والتكلفة. بمعني آخر يتخذ الناس قراراتهم حول أفعالهم بمقارنة تكلفة وفائدة أنواع مختلفة من خيارات الفعل. نتيجة لذلك تنمو أنماط السلوك داخل المجتمع نتيجة لتلك الاختيارات. ويرى “James S. Coleman” أن نظرية الاختيار العقلاني تركز علي الفاعلين الذين ينظر إليهم على أن لهم مقاصد محددة وان أفعالهم تهدف إلي تحقيق أهداف وغايات معينة ضمن خيارات محددة. تهتم هذه النظرية بحقيقة أن الفاعلين يقومون بأفعالهم من أجل تحقيق أهداف تنسجم مع التسلسل الهرمي لخياراتهم. كما أن الفاعلين يسعون إلي تحقيق أكبر قدر من المنافع والفوائد. وعلي الرغم من أن نظرية الاختيار العقلاني بدأت بالتركيز علي مقاصد الفاعل لكنها تشير إلى نوعين من القيود علي فعل الفاعل: النوع الأول من القيود يتمثل في ندرة الموارد. الذين لهم وفرة في الموارد يستطيعون تحقيق أهدافهم بسهولة. أما الذين لهم موارد أقل أو من هم بدون موارد إطلاقاً يكون تحقيق الأهداف بالنسبة لهم صعباً أن لم يكن مستحيلاً. وعلى علاقة بندرة الموارد مسألة تكلفة الفرصة. ففي السعي من أجل تحقيق هدف معين قد ينظر الفاعلين إلي تكلفة إمكانية تفويت تحقيق الهدف الذي يليه في الترتيب من حيث الجاذبية. النوع الثاني من القيود يتمثل في المؤسسات الاجتماعية. هذا النوع من القيود يستمر طيلة حياة الفرد ويتمثل في مختلف القوانين والتشريعات الاجتماعية. يعمل هذا النوع من القيود علي تضييق الخيارات المتاحة للفاعلين وبالتالي مردودات أفعالهم. إضافة إلي ما تقدم هنالك قضيتان تكتسبان أهمية خاصة في نظرية الاختيار العقلاني. الأولى تتعلق بآلية التجميع حيث أن مجموعة من الأفعال الفردية تتحد لتكون منتج اجتماعي. القضية الثانية هي أهمية المعلومات في مسالة اتخاذ الخيارات العقلانية. فقد أصبح من المسلم به أن كمية ونوعية المعلومات المتاحة على درجةٍ عاليةٍ من التغير وأن هذا التغير يمارس تأثيراً عميقاً على خيارات الفاعلين.
لمزيد من التوضيح والتفصيل انظر،
-Ruth A. Wallace and Alison Wolf:”Contemporary Sociological Theory”, Chapter Six, Theories of rational choice, Prentice Hall, Inc, new Jersey, 1995, pp: 279-341.
-Ritzer Gorge:” Contemporary Sociological Theory and its Classical Roots”,Mc GrawHill,2003.pp: 167-168.
[3] هيجل: “علم ظهور العقل”، ترجمة: مصطفى صفوان، دار الطليعة للطّباعة والنّشر، بيروت – لبنان،1981 ، ص ص: 42 و50.
[4] هذا الطرح هو ما لخصه الملك متنبها إلى فكرة التحديث الشامل في خطاب العرش 30 يوليوز 2002 بقوله: “إن ديمقراطيتنا ستظل هشة، ما لم يتم تعزيزها بتنمية اقتصادية وتضامن اجتماعي”. وهو ما أكده المفكر الأمريكي “صامويل هانتغتون”، من كون عملية التنمية السياسية المتبعة من قبل الأنظمة السياسية، إذا لم ترافق بسياسات اجتماعية قادرة على استيعاب الاختناقات الاجتماعية، قد يؤدي إلى وجود تعبئة اجتماعية مرتفعة مترافقة مع نمو اقتصادي ضعيف، مما يؤدي إلى كبث اجتماعي، هذا الأخير قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، فالأرضية الاجتماعية مهمة جدا لتحصين عملية التحول الديمقراطي والدفع في اتجاه أخذه لمساراته الحقيقية والسليمة.
راجع في هذا الإطار رسالتنا تحت موضوع: “المؤسسة الملكية في المغرب: من القيم التقليدية نحو العصرنة –دارسة سوسيو/ قانونية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، وحدة علوم سياسية & علاقات دولية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية: 2007 – 2008، ص: 147 وما بعدها.
[5] بحيث أن السلطة التقليدية تقوم مستمدة شرعيتها في المجتمعات على أساس الاعتقاد في مبلغ القوة وقدسية العادات والأعراف السائدة. ويرتبط هذا النمط بالمجتمعات الشرقية، في حين عرفته أوروبا في العصور الوسطى (الإقطاع). إن المعتقدات التي سادت منذ زمن طويل وشكلت قواعد أضفت المشروعية على الحكام التقليديين وعززت هيمنتهم وتميز مكانتهم. يكون للقائد أو الزعيم في ظل هذا النمط من السلطة، شخصية مطلقة تصل إلى حد الاستبداد. ويدين له كل أعضاء المجتمع بالطاعة والولاء. تقترن المشروعية بالمكانة التي يحتلها أولئك الذين يشغلون المراكز الاجتماعية الممثلة للسلطة التقليدية. ويعتمد الزعيم أو القائد في إصدار الأوامر على المكانة الوراثية، وتعبر أوامره هذه على رغبات شخصية للقائد أو الزعيم. تتسم بالطابع التحكمي وإن بقي ذلك في إطار وحدود التقاليد والعادات المقبولة. ويرجع ولاء الأفراد وطاعتهم لاحترامهم للمكانة التقليدية/قبولهم وقناعتهم بمشروعية الذين يمارسون السلطة التقليدية. ويندرج في إطار هذا النمط ثلاثة أنماط فرعية:
- النمط الأبوي.
- النمط الرعوي القبلي العشائري.
- النمط الإقطاعي.
[6] أقر بأن الحديث عن العقل السياسي (خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعقل السياسي المغربي) يثير نوع من الإحراج على حد قول كل من “أرنست رينان” و”جيب و غرونباوم”، مرده الشعور بغموض المصطلح رغم شحنته الدفاعية، لذلك تجنبت استعماله ضمن مفاصل هذه الورقة كي لا أقع في الحديث عن ماهيات قبلية تابثة، وحاولت في المقابل تبني مصطلح آخر حظي باتفاق ضمني للمفكر ين والباحثين وهو مصطلح العقلانية والعقلنة، الذي يحقق انتقالاً من الحديث عن ماهيات قبلية إلى الحديث عن عمليات وفعاليات وأشكال تصريف مخرجات العقل السياسي.
[7] نشير ضمن هذا المستوى من التحليل، أن الواقع الاجتماعي ثلاثي الأبعاد –إذا اعتبرناه في كليته – هي الاقتصادي والسياسي والثقافي، وبالتالي تختلف درجة المعرفة العلمية لهذه الأبعاد الثلاثة. فإذا كانت معرفة البعد الاقتصادي أكثر أهمية، فقد أنتج علم الإقتصاد الأكاديمي أدوات تحليل للظواهر الاقتصادية لا بأس بها، وكذلك المادية التاريخية التي وضعت لنفسها هدفاً أبعد واقترحت من أجل ذلك منظومة مفاهيم تلقي ضوءاً على طابعٍ ومغزى الصراعات الاجتماعية التي تحدد وتحكم طبيعة النسق السياسي “القائم” أو “السائد”. فإن التحليل العلمي في مجال السياسة والسلطة لا يزال أقل تقدماً بلا شك. الأمر الذي ينعكس في الطابع التلفيقي للنظريات المقترحة في هذه المجالات، فلدينا المذهب الوظيفي في السياسة ومجموعة من العلوم الفرعية المستدرجة منه مثل الجيوسياسية وتحليل النظم… إلخ.
لذلك جاء تبنينا لنظرية الاختيار العقلاني الكفيلة بدراسة العلاقة العضوية بين السياسي (البناء الفوقي) والسوسيو/اقتصادي (البناء التحتي) والهادفة إلى إنماء مفاهيم تخص مجال السلطة والسياسة (أي ما يمكن تسميته نظرية أنماط السلطة) متماثلة من حيث القدرة التفسيرية لمنظومة المفاهيم الخاصة بنظرية أنماط الإنتاج الاجتماعي وتصريفها كمسلكيات ضمن نسق القيم السياسية.
[8] فالملاحظ، هو تبني النسق السياسي لمشروعية تقليدية تجمع بين التقاليد الدينية التي لا تقبل إلا التفسير الأحادي للتاريخ والمجتمع والآخرين وبين الزعامة الملهمة (الكاريزما)، مع عودة للخلافة الإسلامية. المشروعية السياسية التقليدية المستندة إلى تراث الخلافة حكمت العالم الإسلامي أكثر من (12) قرناً من الزمان، كان الوصول إلى السلطة فيها قائماً على القوة. إلا أن تأمين الولاء والطاعة كان دائماً يحتاج على أكثر من القوة؛ وهي الشرعية المستمدة المستندة على الرابطة الدينية والقدرة على تفسيرها في كل مرحلة.
[9] إن الأمر يتطلب تبني نظرية الوظيفية البنائية التي تزعمها “بارسونز” تحت اسم “نظرية التبادل Exchange Theory”، والتي ارتبطت منذ الخمسينيات باسم كل من “جورج هومانز” و”بيتر بلاو”. وقد انطوت نظرية التبادل على رفض “النظرية الكبرى”، وفي حالة “هومانز” على محاولة لبناء نظرية استنباطية انطلاقاً من المبادئ الأولية لعلم النفس السلوكي. وتدعي النظرية في منطلقها الأساسي أن البشر يمارسون سلوكاً يجلب لهم منافع ويُشبع لديهم حاجات. وهذا المستوى من التحليل يقابل مستوى وحدة الفعل الصغرى عند “بارسونز” في بداية تحليله لعملية إيجاد المؤسسات. وفكرة التبادل باعتبارها مصدراً من مصادر التضامن الاجتماعي أو وسيلة من وسائله فكرة راسخة في تقاليد الأنثربولوجيا الاجتماعية، وصورة المجتمع عند هذه النظرية تتلخص في أن نشاطات البشر المتبادلة ترمي إلى الحصول على الحد الأقصى للمنفعة، وهي تركز في ذلك على الإجراءات العقلانية التي يتبعها البشر في تقرير أفعالهم. وعلى الرغم من أن هذا التناول يرفض أي نظرية على شاكلة نظرية “بارسونز”، فقد ترعرع و نما في محيط “بارسونز” وركز أكثر ما ركز على فكرة المجتمع، على خلاف نظرية الاختيار العقلاني الحديثة.
راجع في هذا الصدد،
إيان كريب: “النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس”، ترجمة: محمد حسين غلوم، الكويت -عالم المعرفة، 1990، ص:100.
[10] فالأمر يقتضي التحول من السياسة القرارية إلى السياسة المعقلنة، بحيث تصير السياسة وفقاً لفلسفة التواصل، لا تعتمد على البعد القراري، أو المشورة والضغط التكنوقراطي الآلي المتطرف، كما هو الحال مع فلسفة الوعي، بل تستند إلى عقلنة للسياسة تعتمد على الرأي العام كمدخل علمي لقياس المشروعية السياسية من جانب، وفهم المطالب الموجهة للنظام السياسي من جهة أخرى، وذلك يأخذ بعداً تشاورياً نقاشياً توافقياً. وبذلك لا تتيح السياسة الجديدة مجالاً للنزعة القرارية التي ترتبط بالسياسي، والقسر التكنوقراطي الذي يرتبط بخبراء النظام السياسي، بمعزل عن الإرادة الشعبية –الإنسانية- الجمعية.
انظر بهذا الخصوص،
د. علي عبود المحمداوي: “الإشكالية السياسية للحداثة – من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل – هابرماس أنموذجاً”، منشورات الاختلاف، مطابع الدار العربية للعلوم – بيروت، الطبعة الأولى 1432 هـ – 2011 م، ص: 377.
[11] ياسين الحافظ: “الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة”، الآثار الكاملة، الطبعة الأولى، بيروت – دار الطليعة، 1979، ص ص: 237 – 238.
[12] إن الإسهام الفكري للمتربع على العرش / الملك كأمير للمؤمنين هو الذي رسم معالم الدولة في المغرب، وحدد الفلسفة التي تؤطر العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، ليبقى الدفاع “المبدئي” عن التداخل الحتمي بين الدين والسياسة في تصور المؤسسة الملكية كان هو المدخل الضروري لتعزيز مكانة المفاهيم السياسية المستندة إلى المرجعية الإسلامية وتوظيفها في حقل المنافسة السياسية وذلك بغية تحقيق هدفين أساسيين:
أولا: إيجاد أساس متين لإضفاء مشروعية تكتسي طابعا دينياً من خلال مفهوم البيعة الذي يعتبر “الأداة المقدسة لإضفاء المشروعية على الحكم في الإسلام”.
ثانيا: إعطاء صلاحيات واسعة للملك من خلال التركيز على مفهوم إمارة المؤمنين، الذي له الأسبقية على الملك الدستوري.
انظر رسالتنا لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق تحت عنوان: “المؤسسة الملكية في المغرب: من القيم التقليدية نحو العصرنة – دارسة سوسيو/ قانونية -“، مرجع سبق ذكره، ص: 92.
[13] هذا التنافر والتعارض في الخطاب بين حقلي السياسة والاجتماع، هو ما جعل صبغة الإسلام التي من شأنها رفع راية السلطنة والغلبة تتحول إلى صبغة خمول وضعة واستئناس لحكم الأجنبي.
من أجل الاستزادة راجع في هذا الصدد،
جمال الدين الأفغاني: “الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني مع دراسة عن الأفغاني الحقيقة الكلية”، تحقيق ودراسة محمد عمارة، القاهرة – المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، الطبعة الأولى 1968، ص: 327.
[14] إنها صورة ملك المغرب الذي يثبت قواعد اللعب السياسي، ويراقب حقل المساجلات، كما أنه يترك للاعبين آخرين فضاءات يُحددها بنفسه، والتي لا نعرف حدودها، وفي حالة ما إذا غامرنا بشكل خطير خارج الحدود، يلتقطنا من الأعلى كفاعل مركزي، فالملك “سيد المجال وأيضا سيد اللعبة”. إنه “بمثابة ذلك الظل الذي يتمسح به الكل، يجعل الملك مبتدئ الحلقة ومنتهاها، إذ يسود ويقرر ويراقب في إطلاق، دون أن يراقب أو يجادل، فاستمرار هالته المقدسة لا تضمن ديمومة حكمه فقط، بل إنها المصدر الضامن لاستمرارية الأمة المغربية بأسرها في استقلال وتوحد، والمصدر الحامي للملة والدين والدستور، فهو بذلك المانح – القابض الذي يعلو ولا يعلى عليه، الأول والآخر في الحياة السياسية”.
لمزيد من التفصيل انظر،
هند عروب: “مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس – الرباط، 2006، ص: 226.
[15] وذلك رغم صدور وثيقة دستورية سنة 2011، اعتبرت بحسب رأي الفاعل المركزي (الملك) أكثر من قانون أسمى للمملكة، بل شكلت بحسب هذا الأخير الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، بل وتعاقداً تاريخياً جديداً بين العرش والشعب وهو ما تجلى في المحاور العشرة الأساسية التالية:
- التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن؛
- دسترة الأمازيغية كلغةٍ رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية؛
- دسترة كافة الحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالمياً، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها؛
- الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة؛
- قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛
- تخويل المعارضة البرلمانية نظاماً خاصًا وآليات ناجعة، تعزيزاً لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعاً ومراقبة؛
- ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريساً لاستقلال القضاء؛
- دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحاً لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية؛
- تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد.
راجع في هذا الإطار،
كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية –شرح وتحليل –”، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2012، ص: 8 – 10.
[16] من محاضرات حول موضوع: “الدولة والروابط الاجتماعية”، مركز الاجتماعي، 1998 – 1999 www.lycée sud Médoc –
[17] العقلانية هي المذهب الفلسفي القائل بأولوية العقل التحليلي والبرهاني على جميع أشكال التصور والإدراك الأخرى.
غير أن المفهوم الذي نعتمده في معالجتنا لمفاصل هذه الورقة، ذو نكهة “فيبرية” يقصد به مجموع الطرائق التي تستخدمها الجماعة السياسية لتنظيم علاقتها بالوسط المحيط بغية إنجاز الفعالية المطلوبة والنتائج المأمولة. فالعقلانية تقتضي في أي مجال من المجالات الاجتماعية تسخير مجموعة وسائل لتحقيق جملة من الأهداف، إما في التنظيم الاقتصادي أو في تنظيم السلطة السياسية أو في التقنية أو في غيرها. وبذلك، فالعقلانية بهذا المعنى تقترب من مفهوم العقلنة لتصبح مصطلح أكثر إجرائية وأكثر واقعية لأنه غير مشحون بأية حمولة قبلية عن ماهية عقلية للإنسان أو بأي إحالات ميتافيزيقية، والعقلانية تشمل كل مناحي الحياة الاجتماعية، في التخطيط لها والسير بها نحو درجات أعلى من التقدم والمردودية وتقديم النتائج.
راجع بخصوص هذه المسألة،
سلسلة الندوات: “العقلانية العربية والمشروع الحضاري”، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة الأولى الرباط 1992، ص ص: 8 – 9.
[18] بحسب “أمارتيا سن” الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، ينظر إلى توسيع نطاق الحرية على أنه الغاية الرئيسية والوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية. فالتنمية تتألف من التخلص من أنواع متعددة من الحرمان من الحريات التي لا تترك للناس سوى اختيارات محدودة، وفرص ضئيلة لممارسة إرثهم المنطقي.
راجع، أمارتيا سن: ” جعل التنمية آمنة لأجل الديمقراطية – مزايا الديمقراطية، كيف تعزز الديمقراطيات الرخاء والسلام؟ -“ نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى- يوليو 2009، ص: 135.
[19] انظر، د. علي عبود المحمداوي: “الإشكالية السياسية للحداثة – من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل – هابرماس أنموذجاً”، مرجع سبق ذكره، ص ص: 274-275.
[20] ذلك ما أكده “كلود بالازولي Claude Palazzoli” في إحدى مقدماته الشهيرة بقوله أنه: “لفهم المغرب السياسي لا بد من العودة للتاريخ، وللإطار الذي تتم فيه اللعبة السياسية، لأن المغرب من دول العالم الثالث التي لم تحدث قطيعة مع الماضي، حيث يتمازج فيها الماضي بالحاضر…”.
Palazzoli Claude : « Le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », Edition Sindibad, 1974. P : 20.
[21] انظر، د. عبد العلي حامي الدين: “سؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب – المعوقات الدستورية للانتقال”، مجلة وجهة نظر، العدد 23 خريف 2004، ص: 18.
[22] راجع، محمد الطوزي: “الملكية والإسلام السياسي في المغرب”، ترجمة محمد خاتمي، خالد شكراوي نشر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة، مارس 2001، ص ص: 68-69.
[23] Mohamed Tozy : « Champ Politique et champ Religieux au Maroc : Croisement ou Hiérarchisation ? », Mémoire pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures en Sciences Politiques ; Casablanca –Avril 1980, p:76.
[24] انظر، هند عروب: “مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي”، مرجع سابق، ص: 198.
[25] يتم نهج السلوك العقلاني على أساس أنه الأكثر قدرة على جعل النظرية أصلح للتفسير، والسلوك العقلاني يعني بأن كل لاعب في السياسة يمتلك مجموعة من القيم والأهداف المحددة ويقرر سياسته طبقاً لذلك بدون أخطاء. ويجب أن يتم ذلك على أسس رياضية، ولهذا فإن الأمر يتعلق بــ”نظرية اللعبة” بحيث هي طريقة للتحليل وهي أيضاً دليل لاختيار أفضل طريق للعمل، فالنسق السياسي مطلوب منه أن يبحث عن أفضل الطرق للعمل في المواقف والتي تظهر نتائجها في مسرح الفعل الاجتماعي. وإن الهدف لذلك هو تحديد هذه الأفعال العقلانية التي تستطيع أن تقود وتؤدي إلى قرارات ووسائل للعمل الأكثر ملائمة من أجل تحقيق الهدف القيمي الأسمى الكفيل بتحقيق استقرار السلطة.
راجع بهذا الخصوص،
سعد حقي توفيق: “مبادئ العلاقات الدولية”، دار وائل، الأردن الطبعة 3، 2006، ص ص:125-126.
[26] فما تزال المؤسسة الملكية وفقاً لقواعد القاموس السوسيولوجي لها متكآت وركائز قائمة على التاريخ العريق وعلى البعد الديني_ الروحي، فمسألة الانتساب إلى العرق الشريف المتصل بالأصل النبوي حاضرة بقوة داخل منظومة القيم السياسية. وتأسيساً على هذا الطرح، تحتل الملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي، بحكم تواجدها على رأس المؤسسات الدستورية وفقًا لبراديغم إيواليات الشرعنة، وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري في النسق السياسي، وهو وضع كرسته مختلف الدساتير الستة (1962 – 1970 – 1972 – 1992 – 1996 – 2011).
راجع في هذا الصدد،
كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية –شرح وتحليل –”، مرجع سبق ذكره، ص ص: 57 – 58.
[27] ذلك أنه يستوجب المنهج السليم في التحليل السوسيولوجي الإنطلاق من معاينة المؤسسة الاجتماعية الدينية في بناها وفي حياتها الخاصة، وفي علاقتها التي تنسجها مع العالم الخارجي، وهو ما يحتم البدء من السوسيوغرافيا كما أشار إلى ذلك غابريال لوبرا، بناء على مناهج التحليل المورفولوجيا والبنيوي للأنماط والبنى الدينية.
راجع بخصوص هذه المسألة،
ميشال مسلان: “علم الأديان – مساهمة في التأسيس –”، ترجمة: عز الدين عناية، المركز الثقافي العربي- بيروت الطبعة الأولى – 2009، ص: 122.
[28] اعتبر ايستون النظام نسق أو مجموعة من المتغيرات المعتمدة على بعضها البعض والمتفاعلة فيما بينها. وركز على البيئة المحيطة بالنظام وتأثيراتها. وقال إن الحياة السياسية على أيّ مستوى يمكن النظر إليها كنظام للنشاط والسلوك السياسي الذي يمكن فصله للدراسة عن غيره من الأنظمة على الأقل للتحليل. نظر إلى العملية السياسية كنظام مستقل مكون من عدة عناصر: الهوية والكينونة، المدخلات والمخرجات، التمايز داخل النظام، تكامل النظام. وأكد على أن النظام غائي تهدف كل وظائفه لتحقيق غاياته.
Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science”, (New York: Alfred Knope, 1966), pp: 30 – 40.
[29] إن ما يقوم به النسق السياسي المغربي، اليوم من إجراءات ما هي إلا أنماط للدفاع الذاتي أمام صراع الشرعيات الحاد. يذكرنا هذا السلوك بمسألتين من طبيعة غائية واحدة:
- بإصلاحات الدولة العثمانية في آخر أيامها حينما بدأت تشعر ببداية تحلل شرعيتها.
- بعجز المجتمعات العربية وعلى مدار أكثر من عقدين عن ملء فراغ المشروعية الإيديولوجية الثورية بعد هزيمتها أمام المشروع الغربي الصهيوني. حيث تركت المجال أمام النظم السياسية للاحتماء بالمشروعية الملفقة والتي أهم ملامحها إعادة ترميم الدولة التسلطية متهاوية المشروعية من خلال تخويف الناس من منافسين على السلطة، أو/و تضخيم الإنجازات الوهمية وبيع الأحلام الوردية وافتعال الأزمات الخارجية والاحتماء بقوى خارجية.
Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science”,Op.Cit, pp: 30 – 40.
[30] ذلك أن المشاركة السياسية تعتبر إحدى آليات إضفاء المشروعية على النظام السياسي بحيث تقوي من مرتكزاته الشعبية وتحصر احتمالات الاختلال داخله، كما تعتبر من زاوية أخرى الآلية التي يتوصل المواطنون عن طريقها إلى تحقيق مطالبهم السياسية والاجتماعية. وقد “أصبحت تمثل موضوعاً محورياً من مواضيع علم الاجتماع السياسي، وذلك انطلاقاً من كونها تعبر في المقام الأول عن انشغال المواطن بالمسائل السياسية داخل نطاق مجتمعه، سواء كان هذا الانشغال عن طريق التأييد أو الرفض أو المقاومة أو التظاهر”.
انظر بخصوص هذا الموضوع،
زين العابدين حمزاوي: “الأحزاب السياسية وأزمة الانتقال الديمقراطي في المغرب”، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت – العدد 16، خريف 2007، ص: 122.
[31]في إطار الجانب المعقلن من الممارسة السياسية، تخضع شرعية المعايير مبدئيا لتطابقها مع مقتضيات التوافق الكوني [الكلي]، والذي يحدد وجهة نظر الأخلاق، وبذلك تتبين الأهمية البالغة لأخلاقيات النقاش، مما يبين مدى أثر البعد الأخلاقي النظري والتطبيقي في عملية التواصل والنقاش المعقلن للنظرية والبراكسيس السياسي.
انظر في هذا الإطار،
حسن مصدق: “يورغن هامبرماس ومدرسة فرانكفورت- النظرية النقدية التواصلية- “ المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى 2005، ص: 195.
[32] مفهوم استقرار النسق السياسي وفقاً لثنائية الاستقرار الدستوري من جهة، والاستقرار السوسيو/سياسي من جهة أخرى، هاته الثنائية تنبني على مبدأ التداول السليم للسلطة، بما من شأنه أن يجنب النسق السياسي الوقوع في أية أزمة محتملة، وينآى به عن الاضطرابات الاجتماعية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار السياسي.
راجع في هذا الصدد،
- Stéphane Monney Mohandjo: « les Institutions Internationales, les pays du sud et la démocratie », Préface : Jean Pierre Colin, postface : Albert Bourgi, Imprimerie. Le journal de Tanger, 2012, p : 151-175.
[33]نهج هذا الخيار يتجلى واضحاَ في مدى أهمية توظيف “تيمة” الفقر، بغية تكريس تمثل جديد حول الملك، لا يتحدد على مستوى الخطاب فقط، بل أيضاً في إشراف الملك شخصياً وبشكل فعلي على عمليات توزيع الهبات والتبرعات وتدشين المشاريع، والتي تتم في جو احتفالي وفق طقوس يتم ترتيبها بشكل بارع، يتم بثها للمواطنين عبر وسائل الإعلام، من خلال التركيز على تفاعل العاهل مع مواطنيه بـ”تلقائية”، بحيث يتم إشراك المواطن في إنزال رمزي منتج لانسجام عاطفي ووجداني يكتنزه لقـب “مـلك الفقراء”، “المـلك الإنسان”، “الملـك الأمل”، هاته المـبادرات والمشاريع الملكية يتم ترويجها بشكل جيد، عبر إشارات وحركات يتم تزكيتها وإعادة إنتاجها، كتقبيل المعاقين ومواساة المعوزين مما يسهل بالتالي عملية التماهي ويحقق التقارب بين الملك ورعاياه.
انظر، الكراعي محمد فاضل: “النظام السياسي المغربي وإشكالية المشروعية الحداثية على ضوء التحولات الاجتماعية المعاصرة، مقاربة سوسيو- سياسية”، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني-عين الشق، الدار البيضاء، 2006-2007، ص ص: 334 -335.
- عبد الإله الرمزي – باحث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة عبد المالك السعدي، طنجة – المغرب
- تحريرا في 1-6-2017