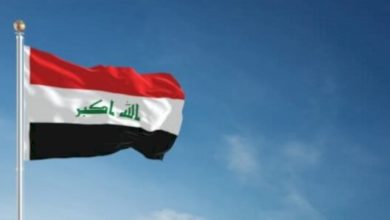الحضارة في العلاقات الدولية

اعداد : عمران طه عبدالرحمن عمران – باحث دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة- مصر.
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة :
يستخدم مفهوم الحضارات كثيراً في مجال العلاقات الدولية، لكن لم يتم تعريفه بعد على أنه مستوى للتحليل في العلاقات الدولية، ومع ذلك قد تكون مفاهيمه المختلفة مصدرًا ملهمًا لزيادة إثراء الجوانب المعرفية والمنهجية لدراسة العلاقات الدولية.
ويشير مستوى التحليل، في مجال العلاقات الدولية إلى اختيار ما إذا كان سيتم إجراء البحث على مستوى النظام الدولي أو مكوناته الفرعية، مثل المستوى المحلي والوطني.
تقارن هذه الورقة بين الأساليب المختلفة لوضع تصور وتفسير دور الحضارات في العلاقات الدولية بما إذا كان ينبغي النظر إلى اختلافات الحضارات كمصدر للصراع وما إذا كان يمكن أن تكون بمثابة وحدة لتحليل وشرح الواقع الدولي بشكل أفضل.
وفي هذا السياق يمكن تعريف الواقع الدولي بأنه جزء من العلاقات الدولية المجردة لغرض التحليل والمحدودة من خلال إطار يحدده سياق زماني ومكاني محدد.
لقد تطور نظام العلاقات الدولية بشكل مثير للإعجاب منذ إنشاء قسم السياسة الدولية في كلية ويلز في عام 1918/1919، وتمكن من التوصل إلى مجموعة متنوعة من المناهج النظرية، مثل الواقعية، والليبرالية، والماركسية، والفلسفة الليبرالية. والمدرسة الإنجليزية، البنائية، النظرية النقدية، النسوية، وما إلى ذلك. وتنظر كل نظرية من نظريات العلاقات الدولية هذه إلى العالم من خلال منظورها الوجودي والمعرفي المتميز وتحاول فهم أو شرح أو التنبؤ لبنية العلاقات الدولية. من الناحية الوجودية والمعرفية، كانت مسألة المستوى أو وحدة التحليل واحدة من المجالات الرئيسية للنقاش في مجال العلاقات الدولية.
المعالجة الكلاسيكية لهذه القضية في العلاقات الدولية هي مقالة جي. ديفيد سينجر ” مشكلة مستوى التحليل في العلاقات الدولية 1961 ، حيث يشير تصنيف سينجر إلى أنه يجب على المرء اختيار “المستوى الجزئي أو الكلي للتحليل”. وبذلك حدد مستويين لتحليل العلاقات الدولية: النظام الدولي والأنظمة الفرعية الوطنية[1]، وعلى النقيض من ذلك، هناك من يقترحون اعتبار الحضارات بمثابة وحدة أو مستوى بديل للتحليل، وبالتالي يحاولون وضع تصور للحضارات في العلاقات الدولية بطرقهم الخاصة.
بالمعنى التاريخي، يمكن اعتبار الحضارات بمثابة هويات اجتماعية مبنية على مجموعات واسعة النطاق مقارنة بوحدات الهوية الأخرى التي تمثل كيانات اجتماعية أصغر. فهي واسعة النطاق سواء من حيث الزمان أو المكان الذي تغطيه. وعلى هذا النحو، كما كتب بروديل، “إن الحضارات هي حقائق طويلة الأمد وقد أشار توينبي إلى نفس النقطة في “تعريف الحضارات على أنها مجتمعات، أوسع في المكان والزمان من الدول القومية أو أي مجتمعات سياسية أخرى لاحتضان البشرية جمعاء وتغطية كامل سطح الأرض الصالح للسكن والملاحة[2]
وفي تعريف أخر، تعرف الحضارات بأنها “هويات جماعية واسعة النطاق”. لذلك، يمكن اعتبارها وحدات تحليل ليس فقط لدراسة التاريخ، ولكن أيضًا في مجال العلاقات الدولية. حيث أن معظم الحضارات تاريخيًا كانت تشتمل على أنظمة دولية. كما أن مفهوم الحضارة غالبًا ما يكون مصحوبًا بمصطلح الثقافة، على الرغم من أنهما ليسا مترادفين، وأن الحضارة أيضًا تعادل التقدم والتطور[3].
ومع ذلك، يبقى سؤال مهم: كيفية التمييز أو تحديد ومقارنة الحضارات المتعددة بغرض تحليل وفهم وشرح العلاقات الدولية؟
إحدى الإجابات على هذا السؤال كانت في عام 1993 عندما طرح صامويل هنتنغتون حجة مثيرة للجدل ونوقشت على نطاق واسع مفادها أن المصدر الرئيسي للصراع في الفترة المقبلة لن يكون الإيديولوجيات أو المصالح الاقتصادية، بل الاختلافات الثقافية. وسوف تهيمن الصراعات الثقافية على جدول أعمال العالم الجديد. وعلى هذا النحو، ادعى أن الصراعات الكبرى ستحدث بين الحضارات، على الرغم من أن الدول القومية ستظل أقوى الجهات الفاعلة في السياسة الدولية. وبعبارة أخرى، فإن “صراع الحضارات” سوف يهيمن على جدول الأعمال العالمي حيث أن خطوط الصدع بين الحضارات سوف تحدد خطوط المعركة المستقبلية[4].
يعكس الافتراض الأساسي لهنتنغتون وجهة النظر القائلة بأن الحضارات تختلف عن بعضها البعض، وأن هناك “عدم توافق أساسي بين المعتقدات والقيم والأعراف الثقافية”، وأن هذه الاختلافات من شأنها أن تمهد الطريق للصراعات فيما بينها. وبعبارة أخرى، فقد اعتبر الاختلافات الحضارية مصدراً للصراع، ولكن ليس مصدراً للثراء في سياق حضارة إنسانية جماعية، أقرب إلى شعار الاتحاد الأوروبي الشهير “الوحدة في التنوع والتنوع في الوحدة”. لقد تم تحدي فرضيته “صراع الحضارات” من قبل العديد من العلماء الآخرين، بما في ذلك إيان هول وآنا خاكي[5]. ومع ذلك، فقد تم تفسير الهجمات في 11 سبتمبر 2001 والحروب اللاحقة في أفغانستان والعراق على أنها تأكيد لفرضية «صراع الحضارات»[6]، ولا تزال نظرية هنتنغتون مثيرة للجدل، لكنها لا تزال تحتل مكانة بارزة في خطابات العلاقات الدولية المعاصرة[7] وعندما نشر فرضية “صراع الحضارات” في شكل كتاب، عرّف هنتنغتون الحضارة بأنها “الكيان الثقافي الأوسع” وادعى أنه من خلال تجاهل الحضارات المحيطة، لا يمكن فهم الوحدات التي تشكلها بشكل كامل، ويعترف هنتنغتون بأن نقطة الضعف في هذا النهج هي حقيقة أن الحضارات ليس لها حدود مكانية وزمانية واضحة. ولذلك من الصعب تحديد واقع دولي واضح للأغراض المعرفية، ويرى هنتنغتون أن الغرب قد وحد العالم تقنيًا وسهل ظهور “نظام متعدد الحضارات”. وقد اتسم هذا النظام الجديد بـ “التفاعلات المكثفة والمستدامة ومتعددة الاتجاهات بين جميع الحضارات”. ومع ذلك، فهي، في نظره، لم تولد “حضارة عالمية”[8].
وفي الواقع، فإن هذه الملاحظة توضح أن النهج الحضاري فيه ضعف آخر. يبدو من الصعب فهم أو شرح العلاقات الدولية القائمة على حضارات متعددة بسبب حدودها غير الواضحة وتفاعلاتها المعقدة. وهذا يشكل تحديًا أمام استخدام الحضارة كوحدة للتحليل بدلاً من المفاهيم المحددة جيدًا والمستخدمة على نطاق واسع مثل المجتمع الدولي، والنظام الدولي، والمستوى المحلي، وما إلى ذلك. بالنظر إلى المقاربات التحليلية التي تتمحور حول الدول القومية، فإن نظرية هنتنغتون متسامية بطريقة مكانية لأنها تتجاوز الحدود الوطنية. وبعبارة أخرى، فهو يرى أن الحضارات عابرة للحدود الوطنية.
قد تكون ملاحظة هنتنغتون هذه صحيحة، لكن افتراضاته بأن الحضارات سوف تتصادم حتماً قد تكون استنتاجاً مبالغاً فيه ومتحيزاً، لا سيما عندما يتم انتقادها من خلال المفهوم البنائي للذاتية المتبادلة، والذي – في هذا السياق – يمكن أن يشار إليه باسم “الذاتية الحضارية المتبادلة”. ويمكن تفسيره على أنه الطريقة التي تبني بها الحضارات صورًا لبعضها البعض من خلال تفاعلاتها متعددة الأوجه. قد يُزعم أن نهج فرانسيس فوكوياما في التعامل مع الحضارات يشبه نهج هنتنغتون. حيث يرى فوكوياما، استنادًا إلى أمثلة سابقة لصدام الحضارات، أن “السلوك التوسعي والتنافسي للدول الأوروبية في القرن التاسع عشر كان يعتمد على الإيمان بشرعية القوة، خاصة عند تطبيقها على غير الأوروبيين، بهدف جلب مختلف المقاطعات البشرية إلى أوروبا الحضارة حتى مستوى مواقعها المتقدمة[9].
من خلال هذه الملاحظة، يبدو أن فوكوياما يؤكد على الشعور بالتفوق في الحضارة الغربية؛ وهذا يؤكد صحة المساعي الرامية إلى مواجهة الهيمنة الغربية في العلاقات الدولية من خلال الخروج بنظريات غير غربية في العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، يرى البعض أن «بصيرة هنتنغتون بشأن العواقب المتضاربة للمواجهات الحضارية في حقبة ما بعد الحرب الباردة لم تؤد فقط إلى تعميق عدم الرضا الصيني عن النظريات الغربية وتشويهاتها للثقافات الشرقية، ولكنها أعطت العلماء الصينيين أيضًا فرصة للتوصل إلى حل». وأحدثت زخم متجدد لإنشاء مدرسة صينية للعلاقات الدولية[10]. وبالتالي فإن الاستنتاج الذي خلصت إليه هذه الحجج هو أن النهج الحضاري، من خلال نقاط ضعفه، ربما مهد الطريق لمزيد من تجزئة العلاقات الدولية على نطاق عالمي.
وإذا نظرنا إلى تاريخ النهج الحضاري، نرى أن البعض يؤكد على الأهمية المستمرة والملاءمة لكتاب توينبي متعدد الأجزاء دراسة التاريخ . وهم يجادلون بأن النهج العام الذي يتبعه توينبي قد يعاني من بعض نقاط الضعف – ولكنه مع ذلك يسمح له “بإلقاء ضوء ساطع على العديد من الأسئلة التاريخية المهمة”. علاوة على ذلك، فإن “إيمانه بالقيمة المتساوية لجميع الحضارات يجعله جذابًا لأولئك الذين يرفضون المركزية الأوروبية ويقتنعون بشكل متزايد بالحاجة إلى النظر في التجربة الإنسانية الإجمالية منذ أقدم العصور وحتى الوقت الحاضر”.[11]
في دراسة التاريخ ، قدم توينبي روايات مختلفة عما حدث عندما واجهت الحضارات بعضها البعض وظل مقتنعا بأن الأفكار التي تنتقل عن طريق اللقاءات بين الحضارات يمكن أن تحدث تغييرات اجتماعية وسياسية كبيرة داخل الحضارات[12]، ويمكن بالفعل تفسير هذا البيان على أنه قوة لهذا المفهوم لأنه يساعد في تفسير التنمية البشرية من خلال التفاعلات والتبادلات الدولية.[13]ووفقًا لتوينبي، “لا يمكن أن يكون مجال الدراسة التاريخية الواضح عبارة عن دول قومية ضيقة الأفق”؛ وإنما يجب أن تكون حضارة، وبالتالي كيانًا يضم عدة مجتمعات، لكنه أقل من أن يغطي البشرية، وتعتبر الحضارة أيضًا من بين وحدات تحليل “تاريخ الجماعات والتجمعات”، والتي تشمل الأنظمة الاقتصادية والدول والطبقات والطبقات والحضارات بمعنى أن الحضارة مجموعة كبيرة واحدة بجانب كل تلك المذكورة أعلاه[14].
هناك قوة أخرى في تصور توينبي للحضارة وهي أن “توينبي يبدو أنه المؤرخ الذي ألزم نفسه ليس فقط بإحصاء وتعريف الحضارات، ولكن أيضًا بذكر المعايير التي يحددها بها”. ومن وجهة نظره، كان توينبي واعيًا لمشكلة انقسام الحضارات وبذل الجهود لمعالجتها.علاوة على ذلك، فإن النهج الحضاري له قيمة لأنه يأخذ في الاعتبار الحقائق الاجتماعية الأخرى. لأن الحضارات تمر بتغيرات مدفوعة بتنوعها الداخلي من اللقاءات بين الحضارات، وتختلف الحضارات عن الدول القومية من حيث حدودها الإقليمية، حيث عادة ما يكون للدول القومية حدود محددة بوضوح، في حين تميل الحضارات إلى تجاوز الحدود الوطنية. [15]
على الرغم من التحديات التي تصاحب ذلك، فإن النهج الحضاري لديه بلا شك القدرة على توسيع وإثراء دراسة العلاقات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام علماء العلاقات الدولية. كما أن مفهوم “السياسة الحضارية” يهدف إلى توسيع وتطوير مجال التحليل الحضاري في العلاقات الدولية نظريًا وتجريبيًا، حيث توفر السياسة الحضارية وسيلة مهمة للباحثين ذوي التوجهات النظرية وذوي التفكير التجريبي لاستكشاف كيف توصل الفاعلون الاجتماعيون والسياسيون إلى فهم وتغيير وبناء السياسة العالمية في ضوء الحضارات التعددية وعلاقاتها[16].
كما أن انخراط العلاقات الدولية مع الحضارات تزامن مع التغيرات الأساسية في النظام العالمي التي بشرت بإنهاء الاستعمار، والعولمة، ونهاية الحرب الباردة. وتعتبر الحضارة أكبر وأعلى ظاهرة اجتماعية وتاريخية وتتكون من ثقافات عديدة ومتنوعة ومتميزة داخل نفسها، كما أن ظهور الهويات الحضارية في العلاقات الدولية والتحليل الحضاري يحمل أهمية كبيرة لأن مفهوم الحضارة هو ناقل مهم للمعرفة والتفضيلات والسياسات المقابلة. ويعني هذا التنوع الجغرافي والاجتماعي أيضًا أن الحضارات تنطوي على بعض المكونات المميزة، وهي في حالة تفاعل مستمر داخل نفسها ومع بعضها البعض. كما أن التفاعلات بين الحضارات موجودة في كل مكان. وكثيرًا ما يُقال، على سبيل المثال، إن تقدم أوروبا نحو الحضارة “الحديثة” كان مدعومًا بالتبادلات مع الصين والهند والعالم الإسلامي[17].
كما أن التفاعلات بين الحضارات من الممكن أن تصبح ذات أهمية سياسية، وخاصة عندما تلعب دوراً في بناء الهويات. وفي هذه العملية، قد تكون الهوية الحضارية مفيدة في ترسيم حدود المجتمع من خلال اكتشاف وتسليط الضوء على الاختلافات بين الذات والآخر. ويمكن أن تكون مفيده أيضًا في تحديد موقع الذات على المستويات العالمية أو الإقليمية أو الفردية وتقييم الآخرين. وعلى عكس فرضية هنتنغتون حول “صراع الحضارات”، فإن هذا التفسير للنهج الحضاري قد يكون مفيدًا للمنظرين البنائيين لأنه يفسر بشكل أكبر تكوين الهوية الحضارية الذاتية في العلاقات الدولية، أما بالنسبة لنظريات العلاقات الدولية السائدة، فإنها تؤكد أيضاً على الأهمية التي توليها المدرسة الإنجليزية لأهمية العوامل الثقافية/الحضارية في العلاقات الدولية. حيث سلطت المدرسة الإنجليزية، منذ وقت مبكر، الضوء على أهمية القيم والعناصر الثقافية الحضارية في العلاقات الدولية. خاصة وأن نظام الدولة لن يأتي إلى الوجود دون درجة معينة من الوحدة الثقافية. وبالنسبة للمدرسة الإنجليزية، تعد الهوية والثقافة والحضارة والقيم جزءًا من ممارسة النظام الدولي. فالعلاقات الدولية لا تتكون من عوامل مادية فحسب، بل تتكون أيضًا من قوى فكرية.[18]
بالنسبة للمناقشات حول العلاقات الدولية غير الغربية، أو ما يسمى مفهوم العلاقات الدولية العالمية ، يمكن القول أن الأنظمة الدولية تحتاج إلى الدراسة ليس فقط على أساس التفاعلات السياسية الاستراتيجية، ولكن أيضًا على أساس التفاعلات الثقافية والحضارية. حيث أن العديد من مفاهيم العلاقات الدولية الحديثة، مثل “الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتوازن القوى، والإدارة الجماعية للأمن” تعتبر عادةً أفكارًا وممارسات أوروبية تقليدية – ولكنها في الواقع جاءت إلى حيز الوجود من نقاط أصل متعددة داخل أوروبا وخارجها. وبناءً على ذلك، ومن خلال تطبيق مثل هذا النطاق الموسع، يمكن للعلاقات الدولية أن توفر مجالًا أكبر للتاريخ والثقافة والأنظمة الاقتصادية والتفاعلات ومساهمات الحضارات والدول غير الغربية. خاصة وأن أفضل فهم للعلاقات الدولية هو أنها نتاج التفاعلات والتعلم المتبادل بين جميع الحضارات والدول، على الرغم من أن بعضها كان أقوى من البعض الآخر في مراحل مختلفة من التاريخ.[19]
يمكن فهم وشرح الاختلافات بين الشعوب من خلال الاعترف بوجود تعددية من الحضارات تتجاوز الثنائية “المتحضرة” و”غير المتحضرة”، والحداثة والتقاليد إلى “الحداثات المتعددة”، ووجود حضارات مختلفة تتفاعل باستمرار مع بعضها البعض، وتجاوز أوجه القصور الملحوظة في المناهج الحضارية الأوروبية[20].
إن الفهم السائد اليوم للعلاقات الدولية على أساس اعتبارها الحضارة الغربية المرجع الأعلى أو المثالي في السياسة العالمية، مثل هذا النهج ينتج تفسيرات مشوهة تتعارض مع التنوعات والاختلافات الثقافية أو العرقية، وتنتج تحليلًا ضيقًا أو إقليميًا للأولويات الغربية التي يتم تقديمها على أنها عالمية[21]
خلاصة القول، إن سمات النهج الحضاري المذكورة أعلاه تقدم منظورا أوسع وتواجه التحدي المتمثل في ترسيم الحدود الحضارية، وباستخدام الحضارة كوحدة تحليل في العلاقات الدولية، استنادًا إلى المفاهيم المختلفة للحضارة كما تمت مناقشتها، يمكن أن يساعد النهج الحضاري إلى حد ما في سد خطوط الصدع في العلاقات الدولية. كما أن تعدد الحضارات، والافتقار إلى حضارة عالمية يجعل من اعتبار الحضارة مستوى أو وحدة تحليل شاملة على الرغم من الانتقادات، كما أن النهج الحضاري للعلاقات الدولية قد يكون مفيدًا في فتح آفاق جديدة وتمكين العلماء والباحثين من توسيع مناهجهم الأنطولوجية والمعرفية. على وجه الخصوص، قد يكون التركيز بشكل أكبر في مجال العلاقات الدولية على دراسة الحضارات وتفاعلاتها بشكل متبادل مفيدًا لمقاربات العلاقات الدولية غير الغربية لتقديم حجة أقوى ضد دراسات العلاقات الدولية الغربية.
الهوامش:
[1] Yurdusev, A. Nuri. (1994). ‘The Concept of International System as a Unit of Analysis’, METU Studies in Development (Vol.21, No.1, 1994), 143-174
[2] Yurdusev, A. Nuri. (2003). ‘International Relations and The Philosophy of History’. Gordonsville: Palgrave Macmillan.
[3] Kuznetsov, Artur. ‘A New Model for Traditional Civilizations’. International Affairs (Moscow) 41, no. 4-5 (1995): 95-100.
[4] Huntington, Samuel P. (1993). ‘Clash of Civilizations?’. Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 (Summer, 1993), pp. 22-49. Council on Foreign Relations, https://www.jstor.org/stable/20045621
[5] Khakee, Anna (2018). Civilizations, Political Systems and Power Politics: A Critique of Huntington’s ‘Clash of Civilizations’. https://www.e-ir.info/2018/05/04/civilizations-political-systems-and-power-politics-a-critique-of-huntingtons-clash-of-civilizations/
[6] Kapustin, Boris. 2009. ‘Some Political Meanings of ‘Civilization.’’ Diogenes 56(2–3): 151–169.
[7] Bajpai, Ravi Dutt. (2018). ‘Civilizational Perspectives in International Relations and Contemporary China-India Relations’. https://www.e-ir.info/2018/04/26/civilizational-perspectives-in-international-relations-and-contemporary-china-india-relations/
[8] Huntington, Samuel P. (l996). ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’, Simon and Schuster, New York
[9] Fukuyama, Francis (1989). ‘The End of History”-‘, The National Interest, Summer 1989. https://www.jstor.org/stable/24027184
[10] Yeophantong, Pichamon. (2018). ‘Asian Perspectives on International Relations Theory’. https://www.e-ir.info/2018/01/23/asian-perspectives-on-international-relations-theory/
[11] Kumar, Krishan. (2014). ‘The Return of Civilization-and of Arnold Toynbee?’. Comparative Studies in Society and History 2014;56(4):815–843. 0010-4175/14, Society for the Comparative Study of Society and History. doi:10.1017/S0010417514000413
[12] Hall, Ian. (2018). ‘Clashing Civilizations: A Toynbeean Response to Huntington’ https://www.e-ir.info/2018/04/18/clashing-civilizations-a-toynbeean-response-to-huntington/
[13] Yurdusev, A. Nuri. (1993). ‘Level of Analysis and Unit of Analysis: A Case for Distinction’, Millennium: Journal of International Studies (Vol.22, No.1, Spring 1993), 77-88.
[14] Kroeber, A. L. (1953). ‘The Delimitation of Civilizations’. Journal of the History of Ideas, Vol. 14, No. 2 (Apr., 1953), pp. 264-275. University of Pennsylvania Press, https://www.jstor.org/stable/2707475
[15] Cox, Robert W. (1995). ‘Civilizations: Encounters and Transformations, Studies in Political Economy’, 47:1, 7-31, DOI: 10.1080/19187033.1995.11675358
[16] Bettiza, Gregorio. (2014). ‘Civilizational Analysis in International Relations: Mapping the Field and Advancing a ‘Civilizational Politics’ Line of Research’. International Studies Review, doi: 10.1111/misr.12100
[17] Arnason, Johann P. (2006). ‘Understanding Inter-civilizational Encounters. Thesis Eleven’ 86(1): 39–53. https://doi.org/10.1177/0725513606066239
[18] Yurdusev, A. Nuri. (1996), ‘The British School of International Relations: The Toynbeean Origins’, presented at the Millennium 25th Anniversary Conference, London School of Economics, London, 17-19 October 1996.
[19] Acharya, Amitav (2017). ‘Towards a Global International Relations?’. https://www.e-ir.info/2017/12/10/towards-a-global-international-relations
[20] Bhambra, Gurminder K. (2011). ‘Talking among Themselves? Weberian and Marxist Historical Sociologies as Dialogues without ‘Others’’. Millennium: Journal of International Studies 39(3) 667–681
[21] Hobson, John. (2013). ‘The Eurocentric Conception of World Politics Western International Theory’, 1760–2010. Chapter 1-Introduction. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139096829.001