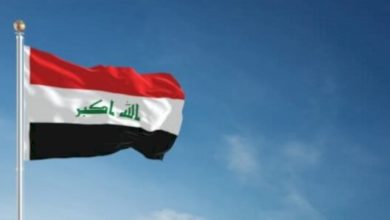الحكامة السياسية و التحول الديمقراطي بالمغرب من التضمين إلى التمكين

اعداد : د. عتيقة ربيع – باحثة في القانون العام ، كلية الحقوق بسطات – المغرب
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة :
عرف الوضع الدولي في الآونة الأخيرة، مجموعة من المتغيرات الاقتصادية و الأمنية و المغرب كفاعل في المنتظم الدولي مصنف في خانة الدول السائرة في طريق النمو لا محالة سيتفاعل مع هذه الأحداث العالمية سواء على المستوى التنموي أو على المستوى الديمقراطي.
ولا يخفى على المتتبع للشأن الوطني أن المغرب سيدرك تطورا ملموسا في حل مأسسة الإشكالات التنموية و التحول الديمقراطي انطلاقا من الإطار المرجعي للتصورات الملكية في هذا المجال باعتماد الوثيقة الدستورية 2011 ،كمرتكز أساسي للحكامة السياسية في صناعة القرار. و حتى نتمتع بتحول ديمقراطي كامل لابد من اعتماد منظومة الحكامة السياسية داخل القرار السياسي الذي يكون له دور في صناعة القرار، وهذا ما عرفه المجتمع المغربي خلال تعديل دستور 2011.
فنجاح هذا التحول يشترط قبل كل شيء وجود إرادة للتحول لدى المؤسسات السياسية، هذه الأخيرة التي تتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات السياسية و المؤسساتية تندرج في أطار رؤية شمولية ذات أبعاد يجتمع فيها الوطني و الجهوي و الإقليمي و المحلي على حد سواء،باعتبارها السبيل الوحيد و الكفيل بتمكين المجتمع المغربي من مواجه التحديات الحالية و المستقبلية.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن صلاح الحكامة السياسية هو ضمان ونجاح لحكمات الميادين الأخرى، فهي حجر الأساس لبناء مغرب ديمقراطي وحداثي، وهذا ما يبرز وبشكل جلي دورها في بناء مسلسل التحول الديمقراطي ببلادنا. فهي العقلنة و الترشيد و التقييم للسياسات العمومية في شتى المجالات.
ونظرا لاتساع مجالات الحكامة السياسية المتجلية في مظاهر عدة منها الدستور و المؤسسات و الهياكل الدستورية و القوانين، مرورا باحترام مبدأ فصل السلط وتكريس دولة الحق و القانون وصولا إلى احترام الحريات الأساسية الفردية و الجماعية للمواطنين وإشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني وجمعيات و مقاولات ونقابات وغيرها في اتخاذ القرار , سنتناول بالتحليل و الملامسة الانتخابات كبوابة للتحول الديمقراطي ( المحور الأول ) إضافة إلى البرلمان الممثل الأسمى للإرادة العامة، والذي تعتبر تقوية دوره مدخلا أساسيا لكل تحول ديمقراطي منشود، وذلك خلال تحوله من برلمان باختصاصات رمزية إلى سلطة تشريعية ( المحور الثاني ).
المحور الأول : الانتخابات كبوابة للتحول الديمقراطي.
عرف المحيط الدولي العديد من المتغيرات تجسدت بالأساس في المد الديمقراطي و تعميم ثقافة حقوق الإنسان، فالانتخابات بجميع أشكالها، تعد آلية أساسية لتكريس مبدأ المشاركة السياسية لعموم المواطنين في تدبير شؤونهم العامة،وترجمة لمبدأ المقاربة التشاركية المتجسدة في حكم الشعب بنفسه لنفسه،والأداة التي تعطي للديمقراطية مضمونها وبعدها السياسي و الوسيلة القانونية لتشكيل المؤسسة التمثيلية في المجتمع الديمقراطي، و التي تفتح المجال أمام التداول السلمي للحكم و التعاقب على السلطة،لذلك توجد علاقة جدلية بين الانتخابات و الديمقراطية.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل الانتخابات الديمقراطية دعامة أساسية لتحقيق التحول الديمقراطي؟
فغالبا ما تستخدم عبارة التحول الديمقراطي في الأدبيات السياسية لوصف تلك الصيرورة التاريخية التي تتميز بتحول السلطة من نمط التدبير السلطوي،بشكل سلمي وتدريجي نحو بناء تجربة جديدة تعتمد منظومة حكم أكثر ديمقراطية، عبر إحداث تغيرات فعلية على مستوى المؤسسات و القوانين و العلاقات بين الحاكمين و المحكومين و توسيع فضاءات المشاركة وتجويد آليات إدارة الحكم،و ضمان الحقوق و الحريات,
فمن خلال قراءة مواقف أغلبية الفاعلين في الحقل السياسي الرسمي وغير الرسمي في موضوع محددات الانتخابات كدعامة للتحول الديمقراطي يمكن رصد أهم تطورات مسار التحول الديمقراطي و الحكامة السياسية بالمغرب، من خلال نقطة أساسية تتعلق بشفافية ونزاهة الانتخابات.
الانتخابات الشفافة و النزيهة.
يمكن القول أن تعامل المغرب السياسي مع المسألة الانتخابية يعكس-ولو جزئيا-طبيعة النظام السياسي المغربي،وحدود التغيير بل وإمكانيات تجاوز اختلالات تفعيل المدى الانتخابي و إكساب النظام برمته “شرعية ديمقراطية” ضمن خصوصية ما يصفه الملك محمد السادس ب”تمايز المسارات التاريخية و المرجعيات الحضارية و الثقافية”،ووجاهة النهج الذي يقيم علاقة جدلية بين الخصوصية و العالمية من جهة ،وبين الديمقراطية و التنمية من جهة أخرى,
ذلك أن الواقع السياسي العربي حمل بين ثناياه تجارب مختلفة اتسمت بتفعيل أساليب لم تستحضر استراتيجيا القيمة الانتخابية للتعامل مع الشأن و المجتمع العربي.
لكون الاهتمام بإجراء الانتخابات في جو من الشفافية و النزاهة و الديمقراطية ،و تكافئ الفرص بين مختلف أشكال الطيف السياسي يعد الشغل الشاغل للرأي العام ليس على المستوى الوطني وحسب ،ولكن على المستوى الدولي أيضا. الشيء الذي تداركته الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية من خلال الفصل 11 ، وذلك بربط التمثيل الديمقراطي بنزاهة الانتخابات و شفافيتها,وكذا الفصل 71 خاصة بعدما أصبح النظام الانتخابي يندرج ضمن مجال القانون المكفول للسلطة التشريعية .
لذلك فإن العمليات الانتخابية في معظمها تتسم بالتوتر المفضي إلى العنف و العنف المضاد مما يؤدي إلى التشكيك في سلامتها ونزاهتها.
وللتقليل من ذلك الشك أصبح إجراء أي عملية انتخابية يتطلب حضور مراقبين دوليين ووطنيين لضمان سلامتها، و اطمئنان الهيئات و المنظمات السياسية الوطنية، وكل المتنافسين على مرورها في جو سليم وشفاف. وهذا ما تمت ملاحظته من خلال الاستحقاقات الأخيرة التي عرفها المغرب.
وبالتالي فأن الديمقراطية بدون انتخابات هي مجرد ثراء فقهي و مفاهيم مجردة وشعارات فارغة تستهدف الممارسة الديماغوجية و التضليل الفكري و السياسي، كما هو حاصل الآن في ظل الأزمة التي باتت تعرفها السياسة بشتى تلاوينها سواء بداخل الأنساق السياسية للدول أو على مستوى حقل العلاقات الدولية المعاصرة.
إن البعد البراديغماتي لمفهوم التحول الديمقراطي يتجلى في كونه يحيل إلى جمل من التحولات المرحلية المتعاقبة القابلة للتحديد في الزمن تحديدا نسبيا و التي تسمح بالانتقال من النظام السلطوي،الذي تتأسس فيه العلاقة بين الحكام و المحكومين على القوة بدل الإقناع إلى النظام الديمقراطي الذي تشكل فيه الانتخابات لحظة أساسية في تخويل الشعب مقاليد السيادة عبر الاختيار الحر لحكامهم أو بالأحرى لممثليهم في الحكم وتدبير الأمور وفق تطلعاتهم المستقبلية
وبالتالي فإن الشعب المغربي آمن بالتغيير السلمي ضمن الاستمرارية، ذلك أن التفاعل الإيجابي مع مسلسل الإصلاح بدءا من التصويت على الدستور ، ثم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لما بعد دستور 2011 ،رغم دعوات المقاطعة التي كانت أطرافها تتحرك بحرية في الدعاية و التواصل مع المواطنين،ما يؤكد وعي حقيقي لدى الأمة بطبيعة النظام الملكي و استعداده للانخراط في التغيير إلى جانب القوى الحية و بالتوافق معها بعيدا عن دواعي التصادم و الصراعات التي لا جدوى و لا فائدة منها.
والمأمول من العمليات الانتخابية المقبلة أن تكون أكثر ديمقراطية و شفافية، و أن تعرف نسب مشاركة عالية، رغم ما يعرفه العالم والمغرب من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وبناء عليه يمكن القول أن الانتخابات مهما كانت نزيهة ليست هي الديمقراطية بعينها،وإسناد السلطة عن طريق الانتخاب لا يعني أن النظام أصبح ديمقراطيا، فلكي يتحقق ذلك يجب أن يكون مبنيا على مجموعة من المبادئ و الأسس تجعله يحقق تمثيلا حقيقيا لإرادة الشعب من خلال هيئات تمثيلية تعكس مختلف مكوناته، وبحكامة سياسية لاعتبارها طريقة لتدبير و تسيير دواليب الحكم ومنهاج لتوطين علاقة المواطن بالأحزاب كمحدد للعملية الانتخابية و كمشارك و مساهم فبها.
وهذا دون إغفال دور البرلمان الذي يعد مدخلا لا غنى عنه لكل تحول ديمقراطي منشود.
إذن ماهي الإصلاحات التي حملها الدستور للمؤسسة البرلمانية ؟ وما هي الصعوبات التي تواجهها ؟
المحور الثاني: الارتقاء بالبرلمان كسلطة جوهرية للتشريع .
لقد ظل البرلمان المغربي ، خلال الخمسينية المنصرمة،بحكم وظائفه التمثيلية و التشريعية و الرقابية و الدبلوماسية،مؤسسة في قلب المعادلات المعقدة لموازين القوى بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع، ومعترك صراع المصالح و النفوذ، كما كان حلبة للمواجهات و المراجعات بين القوى السياسية التواقة للإصلاح و نظيراتها الممانعة أو الرافضة له. إذ صاحبه قصور في الاضطلاع بأدواره التشريعية و الرقابية ذات الصلة بمكافحة الفساد و تعزيز حكم القانون و ترسيخ حكامة تدبير الشأن العام . فهل أصبح كل هذا متجاوزا في ظل الإصلاح الدستوري الجديد؟ أم لازالت هناك عراقيل تحول دون تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية الممكنة و الحرية و الديمقراطية؟
تتجلى مظاهر نزوع النظام الدستوري المغربي نحو ملكية برلمانية ثنائية من خلال تقوية دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية، و يمكن إبراز هذه التقوية من خلال استعادة البرلمان لوظيفة التمثيل الأسمى للأمة، واحتكار البرلمان للسلطة التشريعية، ثم كذلك من خلال مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.
أ- استعادة البرلمان لوظيفة التمثيل الأسمى للأمة.
إن التمثيل السياسي للأمة يشكل أرضية المعادلة الدستورية وفق آلية التعاقد الانتخابي بين المواطنين و ممثلي الأمة وتجاوز إطارات اللجن و المجالس الاستشارية الخارج عن المؤسسة البرلمانية و التي تتم في مجالات التعليم و القضاء و البيئة و الثقافة الأمازيغية و الجهوية المتقدمة و الحقوق الاقتصادية وغيرها.
لقد جعل دستور 2011 البرلمان ،يستعيد وظيفة التمثيل الأسمى للأمة،عبر تكريس صفة “الممثل الأسمى للدولة” للملك كرئيس للدولة، وتخويل السيادة للأمة، التي تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها،حيث ظلت الدساتير السابقة تتحدث عن أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء،وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
وجاء الدستور ليؤكد أساسا مشروعية التمثيل الديمقراطي من خلال تعزيز و تقوية الديمقراطية حتى يتطابق مع المعايير المعترف بها دوليا.
ذلك أن عناصر و تمظهرات الحكامة السياسية في خاصية التمثيلية، يضمن :
– العمل على بناء مسلسل انتخابي حر ومضبوط، لضمان تمثيلية عادلة لجميع القطاعات الاجتماعية.
– وضع مساطر برلمانية عادلة تتضمن إعطاء جميع البرلمانيين بما فيهم أحزاب المعارضة الأقلية، و العنصر النسوي و المجموعات الأخرى المهمشة فرصا للتعبير عن آرائهم، وفتح المجال أمامهم للمساهمة الكاملة في العمل البرلماني، وتمثيليهم داخل هياكل الحكامة البرلمانية.
– ضمان حماية كاملة لمجموع البرلمانيين أثناء ممارستهم لمهامهم بما في ذلك نظام الحصانة و المزايا الضرورية لحماية وظائف البرلمان و أعضائه ضد أي تعسف.
– السهر على أن يكون العمل البرلماني منظم بكيفية حيادية نزيهة و ليس تابعا لجهة ما.
– اتخاذ تدابير خصوصية إذا كان ذلك ضروريا لإحداث هياكل،وتشجيع مشاركة المرأة في المسلسل السياسي و مساواة الجنسين في المجتمع.
ب : احتكار البرلمان للسلطة التشريعية.
لقد اعترف دستور 2011 للبرلمان كمؤسسة تمارس سلطة وليس فقط مؤسسة تمارس وظيفة من خلال التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان من خلال التصويت على القانون و مراقبة عمل الحكومة و تقييم السياسات العمومية .
وفي هذا الصدد يمكن إبراز أهم صلاحيات البرلمان في مجال التشريع في ما يلي:
– امتداد مجال القانون ليشمل 30 ميدانا،من بينها :العفو العام و الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير،وفي فصول أخرى من هذا الدستور، نظام الأسرة و الحالة المدنية،التعمير و إعداد التراب،نظام النقل,نظام الجمارك.التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم…
– تخصيص يوم واحد على الأقل لسهر على دراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة
– منح أغلبية أعضاء كل من المجلسين حق الاعتراض على المسطرة المتعلقة بالاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة إثر بت المجلس المعروض عليه النص،بتصويت و احد، في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك.
وفضلا عن تحسين صلاحيات البرلمان في مجال التشريع،منح دستور 2011 صلاحيات جديدة للمؤسسة التشريعية في المجالين الدبلوماسي و التأسيسي و الرقابي.
ج: المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان وصلاحياته في المجال الرقابي.
إن جوهر التحول المتعلق بمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة يتجلى في دعم احتفاظ المشرع الدستوري،في وثيقة 29 يوليوز 2011،بصيغة “مسؤولية الحكومة أمام الملك”حيث اختفت هذه الفقرة التي ظلت حاضرة في الدساتير الخمسة السابقة(1962-1970-1972-1992-1996)،و التي كانت تنص على أن الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام مجلس النواب .
ولعل تأكيد الفصل 88،في فقرته الأخيرة، على أنه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم،لصالح البرنامج الحكومي”،تجعل من تقنية التنصيب البرلماني ترجمة لهذه المسؤولية السياسية و تجسيدا لمفهوم الحكومة المنتخبة الوارد في خطاب 9 مارس 2011.
فبعد أن كانت مختلف الدساتير السابقة تخصص للباب المتعلق بالعلاقات بين البرلمان و الحكومة ثلاث فصول،خصص الدستور الجديد سبعة فصول للعلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية(الباب السادس من الفصل 100 إلى الفصل 106)،رغبة منه في تحقيق حكامة ديمقراطية-تشاركية-سياسية،وضمان فعالية القوانين و السياسات العمومية باعتبارها جسر في طريق بناء تحول ديمقراطي،فقد أقر تقنيات جديدة تسمح للبرلمان بمراقبة الحكومة.ويمكن سرد هذه التقنيات كما يلي
- الأسئلة: استمرار تخصيص جلسة أسبوعية في مجلسي البرلمان لأسئلة النواب و المستشارين وجواب الوزراء عليها في مدة لا تتجاوز عشرين يوما.
وعموما فآلية الأسئلة الأسبوعية،أبانت عن محدودية تأثيراتها السياسية،حيث لا يصل الأمر فيها إلى مستوى إثارة المسؤولية السياسية كما هو الشأن في ملتمس الرقابة.
غير أن هذه الآلية يمكن أن تحيا من جديد،احتراما لروح الدستور الجديد و إيمانا في بناء مغرب ديمقراطي.
- طلب الثقة: فهذا الإجراء تضمنه الدساتير السابقة،بهدف التأكيد من مواصلة الأغلبية البرلمانية،دعمها للعمل الحكومي،”يمكن لرئيس الحكومة أن يربط،لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت بمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة،أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”
- ملتبس الرقابة(الفصل 105 من الدستور الجديد لسنة 2011)
- لجان تقصي الحقائق(الفصل 67 من الدستور الجديد لسنة 2011)
- تقييم السياسات العمومية(الفصل70 من الدستور الجديد 2011)
- الطعن في دستورية القوانين العادية(الفصل 132 من الدستور الجديد 2011)
- مناقشة مشروع القانون المالي و قانون التصفية(الفصل 75 من الدستور الجديد 2011).
وعليه فإن النظام البرلماني المغربي ينبني على الفصل المرن للسلط المتحكم إلى آليتي التوازن و التعاون بين السلط . إذ تتجلى الآلية الأولى في مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، وفي نفس الآلية التعاونية تساهم الحكومة في عملية التشريع من خلال التقدم بمشاريع قوانين إلى البرلمان فيما يخص مقتضيات المجال التنظيمي.
د: المعارضة البرلمانية و النظام خاص بها.
لقد ساد الاعتقاد، لمدة طويلة في الدراسات الدستورية و السياسية حول ظاهرة الأحزاب و التجربة البرلمانية المغربية،أن موضوع المعارضة هو موضوع سياسي بامتياز، إذ تأثر بالثقافة الدستورية الفرنسية التي لم تعر اهتماما بتيمة المعارضة البرلمانية،إلا ابتداء من أواسط سبعينات القرن الماضي،انصب اهتمام الفقه المغربي أساسا بموقع المعارضة ووظيفتها داخل نسق سياسي جرب خيارات الصراع و الاستثنائية و التوافق حيث حدد الدكتور محمد معتصم الوظائف العملية للمعارضة في النسق السياسي المغربي في “إضفاء مشروعية عصرية على اللعبة البرلمانية و أن المعارضة قد عوضت عدم كفاحيتها الاجتماعية وجنبت الحكم توترات فعلية بتطرق لفظي،كما أنها تقوم بوظيفة المدافع عن حقوق الشعب المقوية في النهاية للنظام السياسي”.لكي ينهي حلقات علاقته بالمعارضة،قبل حدث الاستخلاف بالتناوب التوافقي.
فمسألة استقرار المكونات الحزبية المشكلة للمعارضة لمدة طويلة، وغياب إمكانية التداول على المجال الحكومي، قد جعلت المعارضة البرلمانية لصيقة بأحزاب معينة، لدرجة أدت إلى الخلط بين الدور أو الوظيفة وبين الايدولوجيا.
ليأتي الدستور الجديد معلنا عن ميلاد فاعل دستوري جديد هو المعارضة بنظام قانوني خاص بها، محدثا بذلك توازنا برلمانيا، ليس خارجيا، أي في علاقته بالسلطة التنفيذية،بل توازنا داخليا بين مكوناته المطالبة بالتموقع وفق ثنائية الأغلبية و المعارضة.
ومن بين أهم المقتضايات الجديدة في الدستور المغربي الجديد،و التي تستهدف النهوض بالعمل البرلماني و العمل على تطويره وعقلنته و مأسسته تلك المتعلقة بالمعارضة البرلمانية،حيث خصها الدستور بمكانة متميزة ،وخولها العديد من الحقوق،كما جعل منها شريكا أساسيا في صناعة التشريع و الرقابة على العمل الحكومي إلى جانب الأغلبية البرلمانية.وهذا ما يبدوا حاليا من خلال الفصل 10 من الدستور،و الذي ينص على تمتيع المعارضة مجموعة من الحقوق من بينها:
– حرية الرأي و التعبير و الاجتماع.
– الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون.
– المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع،لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.
– المساهمة في تأطير و تمثيل المواطنات و المواطنين…
فلقد أصبحت المعارضة البرلمانية تتمتع بوضعية دستورية متميزة،حيث بإمكانها بقوة الدستور أن تشارك في التشريع كما في الرقابة على العمل الحكومي،وهذا الأمر فيه رفع للحيف و التهميش الذي كان يمس المعارضة في ظل الدساتير السابقة.
فالوسائل و الآليات التي كان منصوصا عليها في الدساتير السابقة،لم تكن لتمكن المعارضة من القيام بمهامها، وذلك بالنظر للشروط المعقدة و النصاب القانوني الكبير المتعلق بأهم آليات الرقابة كتكوين لجان نيابية لتقصي الحقائق،أو الطعن في دستورية القوانين العادية،وكذلك رئاسة إحدى اللجان البرلمانية الدائمة كلجنة العدل و التشريع.
فمن خلال المقتضيات الدستورية السابقة الذكر، تأكد بأن دستور 2011، شكل قطيعة مع الدساتير السابقة على عدة مستويات ،من بين أهمها ما يتعلق بالرقابة البرلمانية على العمل الحكومي و دور المعارضة في إطار النظام البرلماني المغربي الجديد.
وهذا سيشكل لا محالة طفرة نوعية في الحياة السياسية الدستورية المغربية إذا ما تم العمل أيضا على تمديد فكرة المعارضة من مستوى البرلمانية إلى المجالس الجهوية، التي أصبحت تتوفر على صلاحيات تقريرية واختصاصات واسعة،أسوة بالعديد من التجارب المقارنة التي بدأت في التفكير في نقل حقوق المعارضة،إلى الجماعات الترابية أو التي نصت في أنظمتها الخاصة بالمعارضة ، بكون هذا الحق غير محصور في فضاء البرلمان،بل يمكن أن يمتد إلى المجالس الجمعاتية، وكنموذج على ذلك “نظام الحق في المعارضة ” في التجربة البرتغالية.
و بالرغم من الانتقال من منظومة برلمانية رقابية تقليدية إلى منظومة تقييمية حديثة، فإن البرلمان المغربي يبقى بعيدا جدا عن أي اهتمام بمجال التقييم، فأمام غياب قدرات مستقلة في الخبرة و التحليل،فإن هيمنة الجهاز التنفيذي تصبح مضاعفة بفعل التبعية المطلقة للبرلمان تجاه الحكومة،في ميدان الوصول إلى المعلومة الضرورية قصد ممارسة اختصاصاته فضلا عن محدودية الآليات الرقابية لبرلمان مغربي عانى بشكل مزدوج، من إطاره البرلماني المعقلن المستوحى من هندسة الجمهورية الفرنسية،الخامسة من جهة،ومن وضع تمثيلي أدنى في سياق نمط سلطوي من جهة أخرى.
بالإضافة إلى مشكل البيروقراطية(بمفهومها السلبي)،وكذا مشكل القرار، وبنيته و ماهيته، إذ من الصعوبة الوصول لهذه المحددات،و الباحثون في علم السياسة-عموما-يجعلون من منطلقهم البحثي،السؤال عن من يتخذ القرار؟وما الذي تقرر فعلا؟وكل ما يتعلق ببنية القرار و العمل السياسي.
ناهيك عن عقبة مهمة،تتعلق بالخطاب المصاحب للسياسات العمومية،ومدى اعتمادها كمادة خام للتحليل و التقييم،وقياس ما تم الإعلان عنه،مع ما تم تحقيقه في الميدان.
ومما سبق يمكن القول أن مجموع الإجراءات الدستورية التي تضمنتها وثيقة دستور 2011،و الرهانات التي رفعتها،يمكن أن تكسب المؤسسة البرلمانية هوية خاصة،تميزها عن المؤسسات البرلمانية السابقة،و يمكن أن تساعد كذالك على إعادة قدر من الاحترام لها وحيز من القيمة لوظائفها التمثيلية و التشريعية و الرقابية،إذا ما تم توفير الإرادة لدى البرلمانيين للقيام بهذا الدور وممارسة الاختصاصات الموكولة لهم، وهذا لن يتم إلا إذا تم ربط مهمة المراقبة بالمردودية الانتخابية،وهي نتائج لا يمكن تحقيقها ،إلا إذا تم تحسيس الرأي العام الوطني بأهمية المراقبة و الشفافية وحسن التدبير وربط هذه المهام و إنعكاساتها على مستوى حياتهم المعيشية، مع وعي المواطن بأهمية كفاءة العنصر البشري المختار لتمثيله داخل البرلمان.
ختاما
نستشف أن المغرب في حاجة لولوج عهد جديد تكون ميزته إقامة ديمقراطية حقيقية لا تنحصر في ترديد الشعارات وكتابة بعض المبادئ في الدستور، وإنما ديمقراطية تتبلور من خلالها سيادة الشعب ودولة المؤسسات .
إن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لا يتوقف عند إدخال بعض الإصلاحات على النص الدستوري،بل لابد من استكمال بناء الصرح الدستوري و تحقيق توازن مرن بين السلطات ونشر الثقافة الديمقراطية في كل مفاصل الدولة و المجتمع.
وبالتالي ينبغي أن يكون عملية مستمرة وسيرورة ذات اتجاه تقدمي لا يتوقف عند المرحلة الانتقالية، يتم من خلال استيعاب الديمقراطية كنظام للحكم ودمجها في الثقافة و الحياة السياسية الوطنية وانعكاسها على السلوك الفردي و الجماعي باعتبارها منظومة من القيم وليس توافقا سياسيا فرضته الضرورة أو قواعد اللعبة السياسية، ولا يتم ذلك إلا من خلال توافق تعاقدي متجدد وبناء على دستور ديمقراطي. فمنظومة الحكامة السياسية أصبحت واجبة الاعتماد لتحقيق تحول ديمقراطي بالارتقاء من مرحلة لأخرى، على جميع المستويات.
فاعتماد منظومتها يمكن لا محال المؤسسات – وخاصة البرلمانية منها – من أن تنظم عملها بشبكة محكمة من الضوابط و التوازنات و المقاييس العقلانية المتناسقة والخاضعة للمراقبة والمحاسبة. ذلك أن المؤسسات مهما بلغ شأنها تسمح في إطارها بالعمل على أساس الكفاءة، مما يعكس مباشرة على واجباتها تجاه المواطنين الممثلة لهم ، حتى تعيد مسألة الثقة في صفوفهم وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات بكل حرية وأريحية لاستكمال مشور مسلسل التحول الديمقراطي السلس ببلادنا.