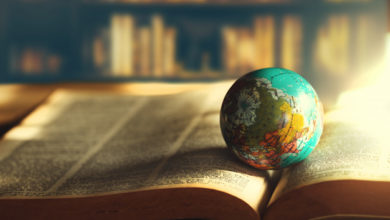أثر البعد الجيوبولتيكى على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل 2011 – 2025
The impact of the geopolitical dimension on Egypt's foreign policy towards Turkey and Israel 2011 - 2025

إعداد: أحمد محمد فتحى , أميرة سمير عيسوى , إيمان خالد السعيد , بدر محمد مسعد , شهد محمود البنا , مريم محمد إبراهيم – إشراف : د. أحمد صبرى الحمراوى – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص
يتناول موضوع أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية منظور شامل يدمج بين المحددات الداخلية والخارجية، مع التركيز على البعد الجيوسياسي في تشكيل توجهات مصر الإقليمية، وذلك من خلال دراسة حالتين هما تركيا وإسرائيل خلال الفترة من2011 حتى2025، حيث يتناول أهم مفاهيم السياسة الخارجية ومحدداتها، موضحًا كيف تؤثر العوامل الداخلية كالنظام السياسي، والاقتصاد، والاستقرار الأمني، إلى جانب العوامل الخارجية مثل التحالفات الدولية والتفاعلات الإقليمية، في صياغة القرار الخارجي المصري. كما يسلط الضوء على أدوات السياسة الخارجية التي تستخدمها مصر لتحقيق أهدافها، بما في ذلك الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، والتعاون الاقتصادي والعسكري، والقوة الناعمة. ثم ينتقل إلى دراسة أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا، مبرزًا التحولات التي طرأت بعد عام 2013، حيث شهدت العلاقات توترًا كبيرًا بفعل التغيرات السياسية في البلدين، إلى جانب تأثيرات البيئة الإقليمية مثل الصراعات في ليبيا وسوريا، والعلاقات مع الفاعلين الدوليين. ثم يتناول أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة المصرية تجاه إسرائيل، ويرصد كيف توازن القاهرة بين التزاماتها الأمنية والسياسية، وبين الرأي العام الداخلي والمحددات الإقليمية، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال هذه الفترة. ونستنتج أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بمرونة عالية، حيث تتفاعل بشكل ديناميكي مع المتغيرات المحيطة، وتسعى إلى الحفاظ على دور إقليمي مؤثر ومتوازن في بيئة دولية معقدة.
Abstract
The topic addresses the impact of the geopolitical dimension on Egypt’s foreign policy from a comprehensive perspective that integrates both internal and external determinants, with a focus on how geopolitics shape Egypt’s regional orientations. This is explored through two case studies: Turkey and Israel, during the period from 2011 to 2025. The study begins by examining the key concepts and determinants of foreign policy, explaining how internal factors such as the political system, the economy, and security stability, along with external factors like international alliances and regional interactions, influence the formulation of Egypt’s foreign policy decisions. It also highlights the tools used by Egypt to achieve its foreign policy objectives, including official and unofficial diplomacy, economic and military cooperation, and soft power. The research then moves on to analyze the impact of geopolitics on Egypt’s foreign policy towards Turkey, highlighting the major shifts that occurred after 2013, as relations became tense due to political changes in both countries, in addition to the influence of regional developments such as conflicts in Libya and Syria, and interactions with international actors. The study then examines the effect of the geopolitical dimension on Egypt’s policy towards Israel, observing how Cairo balances its security and political commitments with domestic public opinion and regional considerations, especially in light of the developments surrounding the Palestinian issue during this period. The study concludes that Egypt’s foreign policy is characterized by high flexibility, as it dynamically adapts to surrounding changes and seeks to maintain an influential and balanced regional role in a complex international environment.
مقدمة
تُعد السياسة الخارجية لأي دولة انعكاساً لتفاعلاتها مع محيطها الجغرافي والسياسي، وتُبنى توجهاتها في الأساس على عدد من المحددات الداخلية والخارجية من بينها الموقع الجغرافي، والقدرات الاقتصادية والعسكرية، والتوازنات الإقليمية والدولية.
كما يمثّل البعد الجيوبولتيكى أحد أهم المحددات المؤثرة في صياغة السياسات الخارجية للدول خاصة تلك التي تحتل مواقع استراتيجية في خرائط التفاعلات الإقليمية والدولية. وتأتي مصر في طليعة هذه الدول، نظرًا لما يتمتع به موقعها من أهمية جغرافية واستراتيجية؛ حيث تشكّل نقطة التقاء بين ثلاث قارات، وتقع فى قلب العالم العربي، وتطل على ممرات مائية حيوية، وتتحكم فى أحد الممرات المائية الهامة وهى قناة السويس، مما يجعلها طرفًا فاعلًا فى توازنات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن حدودها مع دول ذات ثقل إقليمي مثل إسرائيل، وقربها الجغرافي من تركيا، يجعل من البعد الجيوبولتيكي عاملًا حاسمًا في صياغة سياستها الخارجية.
شهدت مصر والمنطقة العربية منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، نتيجة للثورات الشعبية وما تبعها من تغيرات في أنظمة الحكم، وصعود فاعلين جدد، وتصاعد التحديات الإقليمية من خلال احتدام التنافس بين قوى إقليمية طامحة إلى إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط وفي مقدمتها تركيا وإسرائيل، وقد ألقت هذه التحولات بظلالها على السياسة الخارجية المصرية فى الدائرة الشرق أوسطية خاصة تجاه تركيا التي اتسمت علاقتها بمصر بالتحولات المستمرة في ظل تباين الأيديولوجيات وتنافس الأدوار الإقليمية، وكذلك تجاه إسرائيل والتى اتسمت علاقاتهما بالحساسية والتغير وفقاً لمستجدات البيئة الأمنية والسياسية على الرغم من معاهدة السلام التى تربط الدولتين منذ عام 1979.
ووفقاً لما تقدم تسعى الدراسة إلى التركيز على أهمية البعد الجيوبوليتكي كعامل مؤثر في تشكيل السياسة الخارجية للدول، وتتخذ من السياسة الخارجية المصرية تجاه كلا من تركيا وإسرائيل في الفترة 2011-2025 نموذجًا للتحليل من خلال تحليل تطور العلاقات المصرية مع تركيا وإسرائيل باستخدام كلا من المنهج الاستقرائي والتاريخي؛ للإجابة على التساؤل الرئيسى حول تأثير الجيوبوليتك في رسم السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا وإسرائيل خلال الفترة من 2011 وحتى 2025.
أولاً: مشكلة البحث
تعتبر منطقة الشرق الأوسط من المناطق الحيوية فى العالم لما لها من أهمية جيوسياسية واقتصادية هامة، كما تعتبر إحدى دوائر السياسة الخارجية المصرية التى تنبثق من كون مصر دولة شرق أوسطية لها مصالح جيوسياسية واقتصادية وسياسية فى هذه المنطقة؛ وارتباطا بما تقدم تتمحور المشكلة البحثية فى تساؤل رئيسى قوامه ما أثر البعد الجيوبولتيكى على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل فى الفترة من 2011 وحتى 2025؟
ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية لعل أبرزها ما يلى: ما محددات السياسة الخارجية المصرية؟
- ما أدوات السياسة الخارجية المصرية؟
- ما محددات القوة الإقليمية المصرية؟
- ما الأثر الجيوبولتيكي لمصر على سياستها الخارجية تجاه تركيا؟
- ما أثر المتغيرات الداخلية المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا؟
- ما دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا؟
- ما الأثر الجيوبولتيكى لمصر على سياستها الخارجية تجاه إسرائيل؟
- ما أثر المتغيرات الداخلية المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل؟
- ما دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل؟
ثانيا: أهمية الدراسة
1-الأهمية العلمية
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إضافة للدراسات الأكاديمية المعنية بحقلي الجيوبولتيك والسياسة الخارجية عن طريق فهم العلاقة بين المتغيرات الداخلية والسياسية الخارجية، وتسليط الضوء على تأثير الأبعاد الجيوبوليتكية على السياسات الخارجية المصرية والتركية والإسرائيلية، وملاحظة تغيرات السياسة الخارجية المصرية وأدواتها خلال الفترة من 2011-2025.
2-الأهمية العملية
يمكن الاستفادة من هذه الدراسة من خلال وضع أحدث مستجدات الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط أمام صناع قرار السياسة الخارجية المصرية وبحث أهم الأدوات التى اعتمدت عليها السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا وإسرائيل للاستفادة منها مستقبلا فى الأوضاع المشابهة، كما تهدف الدراسة إلى توعية مؤسسات صنع القرار فى الدولة بأهمية الأبعاد الجيوبوليتكية للسياسة الخارجية وكذلك التحديات الجغرافية التى تواجه الدولة.
ثالثاً: هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات بما فى ذلك التساؤل الرئيسى المعنى بأثر البعد الجيوبولتيكى على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل فى الفترة من 2011 وحتى 2025 وما يصاحبه من تساؤلات فرعية هدفها التعريف بالجيوبولتيك والسياسة الخارجية ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك دراسة العلاقة بين جيوبولتيك كلا من الدول الثلاث وسياسة هذه الدول الخارجية، بالإضافة إلى التطرق إلى الجذور التاريخية للعلاقات المصرية مع كلا من تركيا وإسرائيل، و أثر المتغيرات الداخلية المصرية على سياسة مصر الخارجية تجاه كلا من تركيا وإسرائيل، مع التطرق إلى دور المتغيرات الإقليمية والدولية ودورها فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه كلا من الدولتين المعنيتين بالدراسة وصولا إلى الوضع الراهن.
رابعاً: منهج الدراسة
المنهج الاستقرائي: والذى يقوم على ملاحظة الواقع ووصفه فى ضوء المعلومات المتاحة، واختبار الواقع المحدد زمانا ومكانا وتتبع الأحداث بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية وذلك من خلال دراسة أثر البعد الجيوبولتيكى على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل فى الفترة من 2011-2025.([1])
المنهج التاريخى: يتم استخدامه لدراسة الجذور التاريخية للعلاقات بين مصر وكلا من تركيا وإسرائيل، واستخدام المعلومات التاريخية فى إطار العلاقات بين مصر وكلا من تركيا وإسرائيل لتفسير الظاهرة السياسية محل الدراسة وتفسير تطور السياسة الخارجية المصرية تجاه كلتا البلدين([2]).
مدخل المصلحة الوطنية: تعتمد الدراسة على مدخل المصلحة الوطنية لدراسة أهداف المصلحة الوطنية المصرية وتأثيرها على سياسات الدولة الخارجية، حيث يسهم هذا المدخل فى تفسير توجه مصر نحو إعادة توظيف موقعها الجيوبولتيكى فى علاقاتها مع كلا من تركيا وإسرائيل بغية تحقيق أهدافها ومصلحتها الوطنية([3]).
المدخل الجيوبولتيكى: يمكن استخدامه لتفسير أهمية الموقع الجغرافى لمصر على سياساتها الخارجية، وذلك من منطلق أنه يقوم على وصف الوضع الجغرافي للدول الثلاث وتفسير المحددات الجيوبوليتكية المؤثرة على السياسة الخارجية لكلا من مصر وتركيا وإسرائيل، وكذلك تفسير التنافس الجيوسياسي بين الدول محل الدراسة على منطقة الشرق الأوسط([4]).
خامساً: الإطار الزمنى للدراسة
تركز الدراسة على أثر البعد الجيوبولتيكى على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل منذ عام 2011 لما مثله من حدث هام أدى إلى تغيرات داخلية فى مصر متمثلا فى ثورة 25 يناير مع إمكانية التطرق لفترات ما قبل هذا التاريخ إلى 2025.
سادساً: الإطار المكانى للدراسة
تركز هذه الدراسة على منطقة الشرق الأوسط متمثلة فى ثلاث دول هى مصر الدولة المعنية بالدراسة وتركيا وإسرائيل بسبب كونهما قوتان إقليميتان كانتا تسعيان إلى الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011.
سابعاً: الإطار المفاهيمى
أولاً: الجيوبولتيك
تعد الأفكار الجيوبوليتيكية قديمة جدًا، حيث بدأت تظهر ملامحها مع نشوء الدول، ولاحظ المفكرون تأثير الجغرافيا على السياسة. هيرودوت كان من أوائل من أشار إلى أن سياسة الدولة تتأثر بجغرافيتها، وتبعه أرسطو الذي ربط بين المناخ والسيادة، معتبرًا أن الإقليم المعتدل الذي تعيش فيه اليونان ساعدها على التفوق. أما التطور الفعلي للجيوبوليتيك فبدأ في القرن التاسع عشر مع فريدريك راتزل، الذي اعتبر الدولة كائنًا حيًا ينمو ويحتاج للتوسع مع زيادة سكانه وطموحاته، متأثرًا بأفكار داروين في التطور. حسب راتزل، حدود الدول غير ثابتة ويجب أن تظل قابلة للتوسع لتجنب الضعف والانهيار أمام الدول الأقوى. يعتبر الجيوبوليتيك “معرفة علمية تتضمن مجموعة من المفاهيم، والتي تنطلق من المعطيات الفيزيائية والبشرية الصادرة عن الفواعل السياسية، وتهدف للسيطرة على مجال جغرافي معين”. وكثيراً ما يتداخل مع مضمون علم الجغرافيا السياسية. وعليه فالجغرافيا السياسية تدرس الإمكانات الجغرافية المتاحة للدولة أي تدرس كيان الدولة الجغرافي كما هو في الواقع، أما الجيوبولتيك فتعنى بالبحث عن الإحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة حتى لو كان ما وراء الحدود أي ترسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولة مستقبلاً[5]
ثانياً: السياسة الخارجية
يمكن تعريف السياسة الخارجيةforeign policy بأنها “برنامج عمل الدولة في المجال الخارجي، الذي يتضمن الأهداف الخارجية التي تسعي الدولة الي تحقيقها والتي تعكس مصالحها الوطنية فضلاً عن الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.” وهكذا يمكن القول بأن عملية رسم السياسة الخارجية للدول تنطوي على عنصرين رئيسيين هما: تحديد الاهداف الخارجية، واختيار الوسائل او الأدوات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف بأكبر قدر ممكن من الفعالية.([6])
ثالثا: مفهوم الشرق الأوسط
ترجع نشأة مفهوم الشرق الأوسط إلى الدراسات الغربية التي تبنت هذا المفهوم بما يخدم أهدافها الاستراتيجية والسياسية بالمنطقة، وقد تم استعماله لأول مرة من قبل الضابط البحري الأمريكي ألفريد ماهان عام 1902 ثم أعقبه بعد ذلك العديد من العلماء، إلا أنه كمفهوم جغرافي لم يتم الاستقرار على المنطقة التي يشملها ولطالما ما اتسمت بالمطاطية والتغير حسب تخطيطات واستراتيجيات الدول الكبرى، بل وظهرت العديد من المصطلحات المشابهة والتي يصعب وضع تعريف محدد لها مثل الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق الأوسط الكبير، إلا أن أغلب التعريفات اتفقت على أن الأردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان تمثل دول القلب، وأضافت بعض الدراسات الأخرى إسرائيل وباكستان وتركيا وإيران وأفغانستان، فيم تضم تعريفات أخري دول المغرب العربي ودول خليجية عربية.([7])
خريطة رقم (1)المصدر: https://www.un.org/geospatial/content/middle-east
ثامنا: دراسات سابقة
اعتمدت هذه الدراسة على عدة دراسات سابقة تنوعت مابين كتب، ورسائل علمية بهدف الإلمام بجميع جوانب الدراسة، والحصول على المعلومات الكافية واللازمة. فتم الاعتماد على دراسات متنوعة منها ما يتعلق بتأثير البعد الجيوبولتيكي على السياسة الخارجية؛ وذلك لأهميته البالغة وتأثيره الكبير على سياسات الدول الخارجية، ودراسات أخرى تهتم بالعلاقات المصرية التركية، وبالمثل العلاقات المصرية الإسرائيلية.
تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة محاور:
الأول؛ دراسات متعلقة بأثر البعد الجيوبوليتيكي على السياسة الخارجية.
1-ياسمين أحمد توفيق الضوي، “سياسة المحاور الجيوبوليتيكية الروسية في الشرق الأوسط خلال الفترة من 2000 حتى 2023: إيران وتركيا كنموذجين”([8]).
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي استعادت بها روسيا نفوذها الجيوبوليتيكي في الشرق الأوسط من خلال تبني سياسة محاور مع دول محورية كإيران وتركيا، وتحديد أبرز المحددات التي دفعت موسكو لهذا التوجه، إلى جانب استعراض التحديات التي واجهتها تلك السياسة، خاصة في ضوء المتغيرات الدولية عقب الحرب الروسية الأوكرانية. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي في تتبع الظاهرة وتحليلها، كما استعانت بالمدخل الجيوبوليتيكي كإطار نظري لفهم سلوك الدولة الروسية من حيث إدراكها لأهمية الموقع الجغرافي والتحولات الإقليمية والدولية. وقُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسية: تناول الأول المحددات الجيوسياسية لسياسة المحاور الروسية، بينما ركز الثاني على أهمية إيران وتركيا كركائز استراتيجية في هذه السياسة، أما المبحث الثالث فناقش التحديات التي واجهت المحورين الروسي الإيراني والروسي التركي خاصة بعد عام 2022. وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية للبحث الحالي حول أثر البعد الجيوبوليتيكي على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا وإسرائيل، حيث تسهم في فهم طبيعة التفاعلات الجيوبوليتيكية في المنطقة وتبرز أهمية تركيا كمحور إقليمي مؤثر في تشكيل السياسات الخارجية، مما يدعم الإطار التحليلي المستخدم في هذا البحث ويوفر خلفية نظرية وتطبيقية لفهم ديناميكيات التحالفات والصراعات في الإقليم.
التعليق على الدراسة: تُعد دراسة ياسمين أحمد توفيق الضوي من الدراسات المهمة التي ترتبط بموضوع البحث، إذ تناولت الأبعاد الجيوبوليتيكية في السياسة الروسية بالشرق الأوسط، وسلطت الضوء على تفاعلات الفواعل الإقليميين مثل تركيا وإيران في ضوء استراتيجية روسية توسعية. وقد استفادت الدراسة من المنهج الاستقرائي والجيوبوليتيكي، وهما منهجان يتفقان مع الإطار المنهجي لبحثنا. كما أن معالجتها لفكرة إعادة تشكيل النفوذ في المنطقة تقدم خلفية تحليلية يمكن البناء عليها في بحثنا الذي يركز على أثر البعد الجيوبوليتيكي على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا وإسرائيل. ورغم اختلاف زوايا المعالجة، حيث ركزت الدراسة على الفاعل الروسي بينما نركز نحن على السياسة المصرية، فإنها توفر أساسًا نظريًا وتحليليًا داعمًا يُثري مناقشة التفاعلات الإقليمية خلال الفترة من 2011 حتى 2025.
2-فيرونيكا حليم فرنسيس، جيوبوليتيك السياسة الخارجية الروسية: دراسة في أثر الجيوبوليتيك في علاقة روسيا بدول الجوار”([9]).
تركزت الدراسة على توضيح كيف يشكل الجيوبوليتيك إطارًا مرجعيًا حاسمًا في صياغة السياسة الخارجية الروسية، حيث أن الموقع الجغرافي لروسيا كقوة أوراسية يفرض عليها تبني سلوك خارجي يوازن بين حماية مصالحها وضمان نفوذها الإقليمي. أبرزت الدراسة أهمية المنافذ البحرية والحدود في تحديد أولويات روسيا الأمنية، مشيرة إلى أن ندرة المنافذ الدافئة تُحفز سياسات توسعية كما في أوكرانيا والقرم. كما أوضحت الدراسة أن امتلاك روسيا لموارد الطاقة يعزز من قوتها التفاوضية، لا سيما مع أوروبا. واعتبرت أن وجود الناتو والقواعد الأمريكية قرب حدودها يمثل تهديدًا مباشرًا يدفعها لتبني سياسات أمنية حادة واستباقية. واعتمدت الدراسة على تحليل العلاقات بين الجغرافيا السياسية، والحدود، والديمغرافيا، والانتماءات العرقية والتحالفات، مؤكدة أن الجيوبوليتيك يُعد خريطة ذهنية لصانع القرار الروسي تحدد له مجالات النفوذ والتهديد.
التعليق على الدراسة: رغم قوة الدراسة من الناحية النظرية والربط التاريخي، إلا أنها أغفلت تناول تأثير التغيرات السياسية الداخلية الروسية بعد عام 2000، كما لم تتوسع في تحليل التوجهات البحرية الروسية الحديثة بالقطب الشمالي أو التنافس الجيوبوليتيكي مع الصين، مكتفية بالإشارة إليه في إطار التعاون. تضيف دراستنا على الأدبيات الجيوبوليتيكية من خلال تقديم نموذج تطبيقي لدولة متوسطة القوى تتعامل مع تحديات إقليمية معقدة في سياق مختلف عن الدراسة الروسية التي ركزت على مجال أوراسي ذي طابع توسعي. يُظهر الموضوع كيف تستخدم مصر موقعها الجغرافي الحيوي – خاصة تحكمها في قناة السويس وارتباطها بنزاع الغاز في شرق المتوسط – كأداة للتأثير في علاقاتها الإقليمية. كما يُبرز البحث أهمية تفاعل العوامل الداخلية في تفعيل الأبعاد الجيوبوليتيكية تجاه قوى إقليمية فاعلة كإسرائيل وتركيا. بذلك، يُعد هذا البحث مكملًا مهمًا للدراسة الروسية، ويعزز من إمكانية تعميم مدخل الجيوبوليتيك على مناطق وسياقات متنوعة عالميًا.
3- عمر كامل حسن، “النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن المائي العربي: دراسة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك”([10]) تعرض تلك الدراسه كيف أن الموقع الجغرافي يحدد خيارات الدولة السياسية؛ فإذا كانت الدولة تتحكم في موقع استراتيجي (مثل مضيق، أو نهر، أو حدود)، يصبح لها وزن سياسي خارجي فعلى سبيل المثال: الدول التى تتحكم في مصادر المياه أو الملاحة يصبح لديها أوراق ضغط سياسية. كما ركزت الدراسة على الموارد الطبيعية كأساس لصياغة السياسة الخارجية فكلما كانت الدولة تملك أو تتحكم في موارد (مياه – بترول – غاز – أراضي زراعية)، كلما استطاعت التفاوض أو التساوم مع دول أخرى فى موقع قوة، كما ذكر أن نقص الموارد يجعل الدول تعتمد سياسة هجومية أو تحالفية لحمايتها. قامت الدراسة أيضا بتوضيح دور العوامل الجيوبوليتيكية التى من الممكن أن تخلق دوافع الصراع أو التعاون وتوضيح إذا ما كانت الخريطة السياسية تحتوى على توزيع الأنهار المشتركة أو الحدود البحرية التى قد تسبب مشاكل وتجعل السياسية الخارجية عدائية أو دفاعية ووضحت أن الجيوبوليتيك يعمل كأنّه خريطة طريق لصانع القرار السياسي حيث يحدد العدو، الصديق، ممرات التجارة، وأماكن التهديد.
التعليق على الدراسة لم تقم بالربط بين الجيوبوليتيك والتغيرات السياسية الحديثة، وهذا ما ستتناوله دراستنا حيث ستقوم بالربط بين الجيوبولتيك والتغيرات الداخلية والإقليمية المعاصرة فى الثلاث دول محل الدراسة، فسنقوم بدراسة أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية بعد 2011 وقيام الثورة المصرية وصعود قوى إقليمية جديدة (تركيا، قطر، إيران…) وتقديم تحليل للعوامل الداخلية المؤثرة على تفعيل الجيوبوليتيك مثل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية من ثورات ومظاهرات واضطرابات، ودراسة كذلك قضية ترسيم الحدود البحرية والصراع على الغاز الطبيعي فى منطقة شرق المتوسط (الصراع المصري-التركي-اليوناني).
4–صباح جاسم محمد الجنابي، أثر المتغير الجيوبوليتيكي في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان.([11])هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر المتغير الجيوبوليتيكي في تشكيل السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان، وذلك في إطار التنافس الإقليمي والدولي بمنطقة آسيا-الباسيفيك، مع التركيز على موقع تايوان في هذا التنافس. وقد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن المتغير الجيوبوليتيكي يُعدُّ من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأهمية الاستراتيجية للدول، إذ تؤدي المساحة والموقع الجغرافي دوراً محورياً في قياس قوة الدولة وتأثيرها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية. وبما أن العلاقة بين البيئة الجغرافية والسلوك السياسي تُعد نقطة ارتكاز رئيسية في الدراسات الجيوبوليتيكية، فإن هذا المتغير يسهم في توجيه صانع القرار نحو نمط من الحكم والتفاعل الاستراتيجي يرتبط بالبعد الجغرافي للدولة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لفهم العلاقة بين المتغير الجيوبوليتيكي والسلوك السياسي الصيني، مع الاستعانة بالمدخل الجيوبوليتيكي كإطار نظري لتفسير إدراك الصين لأهمية موقعها وموقع تايوان، في ضوء طموحاتها الإقليمية والدولية. وتوزعت الدراسة على ثلاثة فصول رئيسية : تناول الأول السياسة الخارجية الصينية : مبادئها – و اهدافها – وآليات صنعها . الفصل الثاني : المحددات الاساسية في السياسة الخارجية الصينية . الفصل الثالث : اهمية تايوان في السياسة الخارجية الصينية و مستقبلها . وتبرز أهمية هذه الدراسة في ارتباطها بالتحولات الجيوبوليتيكية في منطقة آسيا-الباسيفيك، خاصة ما يتعلق بجهود الصين لتعزيز نفوذها الإقليمي واستعادة ما تعتبره أجزاءً من سيادتها، وفي مقدمتها تايوان. كما تُظهر النتائج أن استعادة تايوان تُعد هدفاً استراتيجياً للصين لتعزيز مكانتها الإقليمية وتأمين طرق التجارة والطاقة، وهو ما يجعل مضيق تايوان نقطة ارتكاز حاسمة في حسابات الأمن القومي الصيني.
التعليق على الدراسة : تُعد دراسة “أثر المتغير الجيوبوليتيكي في تشكيل السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان” من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة، حيث تسلط الضوء على تأثير المتغير الجيوبوليتيكي في تحديد السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان في سياق التنافس الإقليمي والدولي بمنطقة آسيا-الباسيفيك. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والجيوبوليتيكي، وهما من المناهج التي تتماشى مع الإطار البحثي لعملنا، ما يتيح لنا إمكانية الاستفادة من الأدوات النظرية نفسها. كما تناولت الدراسة بشكل معمق أهمية موقع تايوان بالنسبة للأمن القومي الصيني، وهو موضوع يتقاطع مع أهداف بحثنا الذي يركز على أثر الأبعاد الجيوبوليتيكية في السياسة الخارجية المصرية، خاصة تجاه تركيا وإسرائيل. على الرغم من أن الدراسة تناولت السياسة الصينية في منطقة تختلف عن سياقنا الإقليمي، حيث ركزت على دور الصين في آسيا-الباسيفيك، بينما نركز نحن على السياسة الخارجية المصرية في الشرق الأوسط، فإن التحليل الجيوبوليتيكي في الدراسة يقدم أطرًا نظرية وتطبيقية يمكن أن تثري مناقشتنا للسياسات الخارجية في مناطقنا الجغرافية المختلفة. وبذلك، تُعد هذه الدراسة مرجعًا قيمًا لفهم كيف يمكن للعوامل الجغرافية أن تؤثر في السياسات الخارجية، مما يساهم في دعم وتحليل التفاعلات الإقليمية.
5-آية رجب أبو اليزيد-أحمد حسام علوانى-إيمان أحمد قمر-محمد المغازى الخواجة-يوسف أحمد حطاب، “جيوبوليتيك القوى الإقليمية المعاصرة فى الشرق الأوسط (إيران وإسرائيل نموذجا)”([12]) تناولت هذه الدراسة محاولة كلا من إيران وإسرائيل باعتبارهما قوتان إقليميتان فى منطقة الشرق الأوسط بسط نفوذيهما على المنطقة من منطلق جيوبولتيكي، فعرضت الدراسة استخدام إيران لأدوات القوة الناعمة عن طريق نشر الفكر الشيعي فى دول منطقة الشرق الأوسط كالعراق فى عهد صدام حسين، وكذلك تشجيعها لثورات الربيع العربي ونأخذ هنا الثورة المصرية عام2011 كمثال بحكم دراستنا التى تبدأ عند هذه الفترة الزمنية، فقد أيدت إيران كقوة إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط ثورة 25يناير وما تلاها من صعود جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم وذلك للتوافق الأيديولوجي مع مبادئ الثورة الإسلامية وحكم المرشد الأعلى فى إيران. وتبعا لذلك تناولت هذه الدراسة محددات القوة الإيرانية وتأثيرها على الفكر الإيرانى التوسعي فى المنطقة والراغب فى بسط الهيمنة والنفوذ والتمدد على حساب دول الجوار. تناولت الدراسة كذلك الأهداف الجيوبوليتكية الإسرائيلية الساعية للتوسع على حساب الدول المجاورة من منطلق سياسي يشمل الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، ومنطلق أيديولوجي يستهدف إنشاء دولة يهودية نقية على حساب الشعب الفلسطيني، وتستخدم إسرائيل فى سبيل تحقيق أهدافها القوة الناعمة كاستمالة شعوب العالم، وكذلك القوة الصلبة عن طريق التدخل العسكري. شملت الدراسة كذلك موقف كلتا الدولتين من قضايا الشرق الأوسط ومحددات القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لكلتا الدولتين مع التطرق للقوة النووية لكلتا الدولتين.
التعليق على الدراسة: تعتبر دراسة “جيوبوليتيك القوى الإقليمية المعاصرة فى الشرق الأوسط (إيران وإسرائيل نموذجا)” إحدى الدراسات الهامة فى حقل الجيوبولتيك، وقامت بدراسة الفكر الجيوبولتيكى المحرك لكلا من إيران وإسرائيل ومحددات قوتهما المستخدمة فى تنفيذ سياستيهما على أرض الواقع، مستندة على ذلك بالمنهجين الاستقرائي والمدخل الجيوبولتيكي. تعتبر هذه الدراسة مرجع علمي هام لدراستنا المعنونة “أثر البعد الجيوبولتيكي على سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل فى الفترة من 2011-2025، وستقوم دراستنا على تفسير السياسة الخارجية المصرية تجاه كلا من تركيا وإسرائيل من منطلق جيوبوليتكي، فستكون مصر هى محور دراستنا.
6-Michal Romanczuk “Geopolitical Determinants in the Foreign Policy of the Russian Federation”([13])
تتناول هذه الدراسة أثر العوامل الجيوبولتيكية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير الموقع الجغرافي، والهوية الحضارية، والعقيدة الإمبراطورية في رسم السياسات الروسية، خاصة تجاه دول الفضاء السوفيتي السابق. استخدم الباحث المنهج التحليلي التاريخي ومنهج تحليل الخطاب الفكري والسياسي، وقسّم الدراسة إلى محاور تناولت تطور الفكر الجيوبولتيكي الروسي، ومفاهيم مثل الأوراسية، والأطلنطية، و”جزيرة روسيا”، بالإضافة إلى استعراض عقيدة “الطريق الثالث” التي تبناها فلاديمير بوتين لإعادة تموضع روسيا عالميًا. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها توضح كيف تُستخدم الجيوبولتيكا كأداة لإعادة بناء الدور الإقليمي والدولي للدولة، وهو ما يفيد في دراسة الحالة المصرية وتحليل سياستها الخارجية تجاه تركيا وإسرائيل في ضوء موقعها الجغرافي وتوازنات الإقليم من 2011 حتى 2025.
التعليق على الدراسة: يمكن الاستفادة من الدراسة عن طريق اسهامها فى توضيح أثر البعد الجيوبولتيكي في توجهات السياسة الخارجية الروسية، حيث ركزت على العلاقة بين الهوية الجيوبولتيكية والفكر السياسي الروسي، وأوضحت كيف تسهم الاتجاهات الفكرية مثل الأوراسية والأطلنطية في تشكيل الاستراتيجية الروسية في التعامل مع العالم. وعلى الرغم من أهمية الدراسة من حيث تناولها الأطر النظرية والفكرية المرتبطة بالجيوبولتيكا، فإنها لا تتناول بشكل مباشر التفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط أو أثر هذه المحددات على علاقات روسيا بدول بعينها، مما يجعل الاستفادة منها في هذا السياق تقتصر على الجانب المفاهيمي والنظري الذي يساعد في فهم آليات بناء السياسات الخارجية في ضوء البعد الجغرافي والهوياتي.
الثانى؛ دراسات تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا.
1-يحيى السيد إبراهيم محمد، “العوامل المؤثرة فى سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا فى عهد رئاسة عبدالفتاح السيسى”([14]) أسهمت تلك الدراسة فى تحليل السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا من خلال التركيز مباشرةً على العلاقات المصرية–التركية بعد 2013، بما يشمل توتر العلاقات عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وأثر بعض القضايا الإقليمية على العلاقات بين الدولتين كالقضية الليبية، وكذلك قضية ترسيم الحدود البحرية، والتحالفات الإقليمية، والأزمة الاقتصادية المصرية وتأثيرها على السياسة الخارجية. كما ركزت هذه الدراسة كذلك على العوامل الفردية كشخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى وتأثيرها على عملية صنع القرار الخارجى المصرى فى الملف التركي، فعرضت الدراسة كيف أن السياسة الخارجية المصرية تحت إدارة الرئيس السيسى كانت تولى اهتماما بالاستقرار السياسى فى الدولة المصرية قبل أي اعتبارات أخرى.
التعليق على الدراسة تتوقف الدراسة تقريبًا عند 2023–2024 فتحتاج أن تتناول التقارب المصري–التركي بشكل أوسع في 2024–2025، وتركيز أوسع على التحولات الجيوبوليتكية في المنطقة حيث دراسة كيفية تأثير اكتشافات الغاز في شرق المتوسط على العلاقات بين الدولتين وأيضا تأثير التحالف المصرى مع قبرص واليونان على العلاقات مع تركيا وإسرائيل وبحاجة إلى استخدام أمثلة حديثة لدعم التحليل مثل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع تركيا مؤخرًا، ومشاركات مصر في قمة منتدى غاز شرق المتوسط وتحركاتها السياسية بالمنطقة، وهذا ما سوف نتناوله فى دراستنا.
2-مشعل محمد السرحان، “أثر المتغيرات الإقليمية على العلاقات المصرية التركية (2011-2017)”([15]) تسهم تلك الدراسة فى فهم الخلفية الزمنية والسياسية وتشرح كيف أثرت أحداث مثل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وما نجم عنهما من تغير النظام السياسي في مصر على العلاقات المصرية التركية ومنها سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. وأوضحت الدراسة كيف أن الصراعات الإقليمية مثل الحرب في سوريا، والأزمة الليبية، وقضية شرق المتوسط شكلت بيئة ضاغطة أدت إلى تأزم أو انفراج في بعض مراحل العلاقات بين مصر وتركيا. وأبرزت الدراسة أيضا موقف دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات) ودعم الولايات المتحدة وتقلباتها التى كان لها تأثير مباشر على تموضع مصر وتركيا إقليميًا.
التعليق على الدراسة: أنها توقفت عند 2017 فبالتالى لم تتطرق إلى توضيح السياسة التركية الخارجية بعد 2020 حيث التقارب مع مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التركية، ولم تذكر المصالحة المصرية–التركية التي بدأت منذ 2021 وكيف أن الجغرافيا تدفع مصر لموازنة علاقاتها بحيث تضمن استقرار حدودها، وتأمين مجالها الحيوي في البحرين الأحمر والمتوسط وسياسة مصر الخارجية لا تتشكل فقط كرد فعل للأحداث، ولكن لضمان “أمن النظام” في الداخل والذى يشمل تأمين الحدود، منع التدخل الخارجي، تحييد جماعات الإسلام السياسي، وهذا عامل مشترك مهم لعلاقاتها بكل من تركيا وإسرائيل، وهذا ما ستتناوله دراستنا.
3-بنان عاطف حسين السحيمات، ” العلاقات التركية-المصرية 2012-2019″([16]) تناولت هذه الدراسة طبيعة العلاقات بين مصر وتركيا خلال فترة اتسمت بالتحولات الإقليمية الحادة بعد ثورات الربيع العربي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وسعت لفهم أثر التغيرات السياسية والإقليمية على مسار العلاقات الثنائية. وتوصلت إلى أن التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، إضافة إلى حتمية الجغرافيا في شرق المتوسط، يجعلان استمرار التفاعل بينهما أمرًا لا يمكن تجاهله، رغم التوترات السياسية. كما بيّنت الدراسة أن التمدد التركي في المنطقة ساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية، ما انعكس بدوره على علاقتها بمصر. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها توفر إطارًا تحليليًا دقيقًا لفهم جذور التوتر والتقارب في العلاقات المصرية التركية، وتُعد مرجعًا أساسيًا لدراسة تأثير البعد الجيوبولتيكي في توجيه السياسة الخارجية المصرية خلال هذه المرحلة.
التعليق على الدراسة: قدّمت دراسة بنان السحيمات (2021) معالجة معمقة لطبيعة العلاقات المصرية التركية خلال الفترة من 2012 إلى 2019، مما ساعد على فهم السياق التاريخي والسياسي للعلاقة بين البلدين، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية بعد 2011. وقد افيستفادت منها دراستنا فى تحليل محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا خلال تلك المرحلة، لا سيّما في ضوء التوترات السياسية والاستقطاب الإقليمي. ومع ذلك، تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في عدة جوانب، أبرزها أن تركيزها انصبّ على توصيف وتحليل العلاقة الثنائية فقط، بينما تتناول دراستنا أثر البعد الجيوبولتيكي بشكل أوسع، ويشمل أيضًا العلاقة مع إسرائيل. كما أن المنهج المستخدم في الدراسة هو وصفي تحليلي، بينما تستخدم دراستنا منهجًا تحليليًا تفسيريًا يعتمد على الربط بين المعطيات الجيوبولتيكية وتوجهات السياسة الخارجية.
4-Mohamed Khaled Abdelsalam Omar Saad, “EGYPTIAN-TURKISH RELATIONS BETWEEN 2013 AND 2024: A MULTI-LEVEL ANALYSIS OF FOREIGN POLICY CHANGE”([17])
تتناول هذه الدراسة تطور العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة من منتصف 2013 وحتى أوائل 2024، من خلال إطار نظري يعتمد على تحليل متعدد المستويات لتغير السياسة الخارجية. وتركز الدراسة على الجوانب السياسية والاقتصادية في العلاقة بين البلدين، كما تدمج بين العوامل الداخلية مثل النظام السياسي والقيادة، والعوامل الخارجية كالبيئة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى البُعدين الفكري والمادي. تُجادل الدراسة بأن بوادر التحول نحو تحسين العلاقات بدأت قبل عام 2021، بخلاف ما تفترضه معظم الدراسات الأخرى التي تعتبر الفترة بين 2013 و2020 مرحلة واحدة تتسم بالصراع. وتُقسّم الدراسة تطور العلاقات إلى ثلاث مراحل: المواجهة الثنائية، التنافس الإقليمي، مرحلة التطبيع. كما تؤكد الدراسة أن في المرحلة الأولى كانت العوامل الداخلية هي الأكثر تأثيرًا، بينما أصبح للعوامل الإقليمية والدولية الدور الأكبر في المرحلتين الثانية والثالثة. في النهاية، تهدف الدراسة إلى تقديم فهم أعمق للسياسات الخارجية المصرية تجاه تركيا، وتُعدّ مساهمة مهمة في تحليل العلاقات بين البلدين.
التعليق على الدراسة: تُعد هذه الدراسة مساهمة متميزة في فهم تطور العلاقات المصرية-التركية خلال العقد الماضي، حيث تعتمد على إطار تحليلي متعدد المستويات يجمع بين العوامل الداخلية والخارجية، والقيادة، والديناميكيات الفردية، إلى جانب الأبعاد الفكرية والمادية. من أبرز نقاط القوة في الدراسة تقسيمها للعلاقات الثنائية إلى ثلاث مراحل واضحة: المواجهة الثنائية، التنافس الإقليمي، والتطبيع. هذا التقسيم يُبرز التحول التدريجي في السياسات والتفاعلات بين البلدين، ويُظهر كيف انتقلت العلاقات من التوتر الشديد إلى التعاون المتدرج. تُسلط الدراسة الضوء أيضًا على تأثير التغيرات الداخلية في كل من مصر وتركيا، لا سيما في المرحلة الأولى، حيث لعبت التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية دورًا محوريًا. وفي المراحل التالية، برزت العوامل الإقليمية والدولية – مثل الأزمة الليبية والأحداث في غزة – كعناصر دافعة نحو إعادة التقارب بين البلدين. اللافت للنظر أن الدراسة تقدم منظورًا مصريًا معمقًا في تحليل العلاقات الثنائية، ما يُعزز فهمنا للدوافع السياسية المصرية تجاه تركيا، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. بشكل عام، تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا متماسكًا، يمكن البناء عليه في الدراسة المعنية، حين يتم تناول العلاقات الثنائية أو التحولات في السياسات الخارجية، مما يجعلها مرجعًا هامًا في هذا المجال.
الثالث؛ دراسات تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
1-صالح النعامى، “العلاقات المصرية -الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير”([18]) تسهم تلك الدراسة فى تحليل العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث تقدم الدراسة تحليل دقيق لمسار العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ 2011 وحتى 2017 تقريبًا بما تشمله من محددات وسمات وبيئة، كما توضح الدراسة العلاقات المصرية الإسرائيلية فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء الفترة الانتقالية بعد خلع الرئيس مبارك وحتى انتخاب الرئيس مرسى وصولا لفترة حكم الرئيس السيسى وما صاحبها من عمليات إرهابية فى سيناء.
التعليق على الدراسة: تضيف دراستنا على هذه الدراسة زيادة المدة الزمنية حتى 2025 حيث أن الدراسة تتوقف تقريبًا عند 2017 فنحتاج إلى تغطية ما حدث لاحقًا، مثل تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019 وتأثيره على العلاقات المصرية-الإسرائيلية، بجانب تركيز دراستنا بصورة أعمق على البُعد الجيوبوليتكي لمصر وتأثيره على سياستها الخارجية تجاه كلا من تركيا وإسرائيل.
2-إبراهيم محمد سيف، “سياسية مصر الخارجية والقضية الفلسطينية من الحكم الملكى إلى “الربيع العربى (2013-1917)”([19]) تسهم تلك الدراسة فى توضيح تطور سياسية مصر الخارجية تجاة القضية الفلسطينية من 1917 وحتى 2013، فذكرت أحداث البراق وثورة فلسطين عام 1936 وقرار التقسيم وحرب 1948 وما بعدها وذكرت مشاريع الهدنة والتسوية السلمية وتطرقت للحقبة الناصرية كما انها تناولت فترة السادات وما تبعها من أحداث ومنها حرب أكتوبر 1973 وما بعد الحرب وحقبة مبارك وما شملتها من الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 والعملية السلمية واتفاقية أسلو والانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000-2004 وموقف مصر من الحرب على غزة 2008 (عملية الرصاص المصبوب) بالإضافة إلى ذكر القضية الفلسطينية فى المظاهرات والحركات الشعبية المصرية والموقف المصرى من المصالحة الفلسطينية و الدور المصرى فى صفقة تبادل الأسرى.
التعليق على الدراسة: وقفت هذه الدراسة عند العام 2013، حيث لم تتطرق إلى التطورات الجيوسياسية المرتبطة باتفاقيات الغاز والتحالفات الإقليمية (مصر، اليونان، قبرص، إسرائيل) وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والتحالفات العسكرية البحرية، وكيف أثرت هذه التحالفات على علاقات مصر مع كلا من إسرائيل وتركيا، وكذلك دراسة تأثير معاهدات السلام والتطبيع مثل الاتفاقيات الابراهيمية وتأثيرها غير المباشر على الدور المصري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى علاقات مصر مع إسرائيل.
3-أحمد نائل خراز، “العلاقات الأمنية المصرية – الإسرائيلية (1978–2016)”([20]) تناولت هذه الدراسة تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل من منظور تاريخي وأمني، حيث ركّزت على المراحل التي مرت بها هذه العلاقة منذ الحروب العربية الإسرائيلية وحتى ما بعد ثورة يناير، مع تحليل تأثير اتفاقية كامب ديفيد والربيع العربي على مسار العلاقة، خاصة في الجوانب العسكرية والاستخباراتية. استخدم الباحث المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم، إلى جانب توظيف نظريات العلاقات الدولية كالنظرية الواقعية والوظيفية، مما أتاح فهماً متعدد الأبعاد لطبيعة العلاقة ومحدداتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن اتفاقية السلام لم تحقق لمصر مكاسب اقتصادية ملموسة، وأسهمت في تراجع دورها الإقليمي وزيادة نفوذ جماعات المصالح.
التعليق على الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديمها تحليلاً معمقًا لتأثير التحولات السياسية على العلاقات الثنائية، وهو ما يمكن الاستفادة منه فى دراستنا التى تستهدف تحليل أثر البعد الجيوبولتيكي في توجيه السياسة الخارجية المصرية تجاه كل من تركيا وإسرائيل، مع اختلاف واضح في نطاق التحليل، حيث تغطى دراستنا فترة زمنية أطول (حتى 2025) مما يمنحها فرصة الاتصال بالتطورات الجارية، وتتبنى رؤية تفسيرية أكثر شمولًا للبعد الجيوبولتيكي في إطار المقارنة بين حالتي تركيا وإسرائيل.
ثامناً: تقسيم الدراسة
تقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالى:
- الفصل الأول: محددات السياسة الخارجية المصرية وأدواتها.
- المبحث الأول: محددات السياسة الخارجية المصرية.
- المبحث الثانى: أدوات السياسة الخارجية المصرية.
- المبحث الثالث: محددات القوة الإقليمية المصرية.
- الفصل الثانى: أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا فى الفترة من 2011 إلى 2025.
- المبحث الأول: الأثر الجيوبولتيكي لمصر على سياستها الخارجية تجاه تركيا.
- المبحث الثانى: أثر المتغيرات الداخلية المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا.
- المبحث الثالث: دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا.
- الفصل الثالث: أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل فى الفترة من 2011 إلى 2025.
- المبحث الأول: الأثر الجيوبولتيكى لمصر على سياستها الخارجية تجاه إسرائيل.
- المبحث الثانى: أثر المتغيرات الداخلية المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
- المبحث الثالث: دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
- الخاتمة: وتتضمن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
الفصل الأول : فصل تمهيدي
تميزت السياسة الخارجية المصرية على مدار تاريخها الطويل بالمواقف الراسخة المدافعة عن المصلحة الوطنية المصرية والقضايا الإنسانية فى العالم أجمع. فحتى عندما تراجعت السياسات الخارجية المصرية فى الفترة من 2011-2013 نتيجة للأوضاع الداخلية غير المستقرة؛ إلا أنها لم تنتكس ولم تفقد أهدافها السامية الرامية للحفاظ على المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي المصري، وعادت بقوة مرة أخرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دشن لدبلوماسية رئاسية جديدة بدءا من القائه كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2014 وحتى الأن.
المبحث الأول: محددات السياسة الخارجية المصرية
تُعتبر السياسة الخارجية المصرية من العوامل الأساسية في تشكيل العلاقات الدولية وتحقيق مصالح الدولة المصرية على الساحة العالمية. تتأثر محددات هذه السياسة بمجموعة من العوامل المتنوعة، التي تشمل الأمن القومي، الاستقلالية، والمصالح الاقتصادية والسياسية. كما يعكس الاهتمام المصري بالقضايا الإقليمية والدولية التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز دورها كقوة إقليمية فاعلة.
وتعتمد تلك المحددات على ما يلي :
- تسعى السياسة الخارجية المصرية إلى تجنب الانخراط في المعارك الفرعية والتركيز على التحديات الرئيسية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في هذا السياق يُعد الإرهاب تهديدًا حقيقيًا للأمن المصري والإقليمي، وهو معركة مباشرة تخوضها الحكومة المصرية. تعزز مصر التعاون الأمني مع الدول الأخرى وتشارك في تحالفات إقليمية وعالمية لمكافحة الإرهاب من أجل مواجهة هذا التهديد. علاوة على ذلك، تواجه مصر تحديات جديدة تتمثل في “حروب الجيل الرابع”، التي تسعى الكيانات الأجنبية من خلالها إلى استهداف العنصر البشري وتقويض الهوية والثقافة المصرية. ومن خلال نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية، تعمل مصر على التصدي لهذه المعركة المباشرة. تسلط هذه الأمثلة الضوء على أولويات السياسة الخارجية المصرية في التركيز على التهديدات الرئيسية التي تواجهها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي([21]).
- تتمثل إحدى المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية المصرية في تجنب الشعاراتية والاندفاع غير المبرر، والتركيز على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى التفكير العميق والتحليل الدقيق للحقائق والظروف المحيطة. تتجسّد السياسة الخارجية المصرية في العمل بشجاعة واستمرارية، من خلال مواجهة التحديات والمخاطر بروح مسؤولة، دون تهور أو تردد، ويقوم هذا النهج على اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة وبيانات موثوقة، بما يضمن تحقيق توازن فعّال بين الشجاعة والتفكير العقلاني. ويُعد هذا التوازن أحد المحددات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، بما يمكّن الدولة من التحرك بثقة وفاعلية في الساحة الإقليمية والدولية.
- تُعد مواجهة التمدد التركي والإيراني في المنطقة من المحددات الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية. ويُقصد بالتوسع، في هذا السياق، التوسع السياسي والعسكري لدولة ما على حساب دول أخرى ضمن نطاق جغرافي معين. وقد برز في السنوات الأخيرة اتساع النفوذ الإيراني الإقليمي، الذي يعتمد على استراتيجية “الحرب بالوكالة” من خلال دعم الميليشيات المسلحة. وفي هذا الإطار، شهدت المنطقة محاولات إيرانية للتقارب مع مصر وإبداء رغبة في استئناف العلاقات الثنائية، إلا أن القاهرة تعاملت بتحفّظ مع هذه المبادرات، انطلاقًا من إدراكها لطبيعة المشروع الإيراني ذي الطابع التوسعي، والذي يستند إلى أيديولوجية قومية تستدعي الإرث الفارسي. كما أن تحكم طهران في ميليشيات وجماعات مسلحة ذات وجود فعلي في عدد من دول المنطقة يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، ما يدفع مصر إلى اتخاذ موقف حذر يعكس التزامها بالحفاظ على استقرارها الداخلي وأمنها القومي([22]).
ترتكز السياسة الخارجية التركية في المرحلة الراهنة على مبدأ “تصفير المشكلات” وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، بما في ذلك تطبيع العلاقات داخل الإقليم. وفي هذا الإطار، اتخذت أنقرة عددًا من الإجراءات التي أسهمت في إعادة تطبيع العلاقات مع مصر، بعد قطيعة استمرت لأكثر من عقد من الزمن. ويأتي هذا التحول في ظل تغيّر واضح في محددات السياسة الخارجية التركية، التي كانت في السابق تتسم بدعم الحركات الإرهابية في مصر والمنطقة، واحتضانها تحت شعارات مرتبطة بمفهوم الدولة القومية. كما ارتبطت تلك المرحلة بالانتشار العسكري التركي في عدد من المناطق الإقليمية، خاصة على الحدود الغربية لمصر في ليبيا، وهو ما شكّل مصدر قلق بالغ للقاهرة نظراً لتأثيره المباشر على الأمن القومي المصري. وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ في العلاقات بين البلدين، إلا أن السياسة الخارجية المصرية لا تزال تتسم بالحذر والتحفظ تجاه الطموحات التوسعية التركية، انطلاقًا من التزامها الثابت بحماية مصالحها الوطنية ومواجهة أي تهديد محتمل لاستقرارها الإقليمي. - تشكل القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية في محددات السياسة الخارجية المصرية، إذ تحتل موقعًا ثابتًا في أولويات الدولة منذ بدايات الصراع العربي–الإسرائيلي في النصف الأول من القرن العشرين وحتى عام 2024. وتتمثل المواقف المصرية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وتضطلع مصر بدور فاعل في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حرصت على تعزيز الحوار والعمل على التهدئة والتوصل إلى حلول سلمية دائمة. وقد أسهمت القاهرة تاريخيًا في العديد من الاتفاقيات والمفاوضات، مثل اتفاقية أوسلو ومعاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية عام 1979. وتواصل مصر حتى اليوم جهودها الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، بما يعكس التزامها الثابت بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة([23]).
- ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبدأ عدم ترك الساحة الإقليمية والدولية فارغة أمام تدخلات أطراف أخرى تسعى إلى ملء هذا الفراغ وتحقيق نفوذ استراتيجي على حساب المصالح العربية. ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تعزيز حضورها الفاعل في محيطها الإقليمي من خلال تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لعدد من الدول العربية، إذ تبرز جهودها في دعم الشعب الفلسطيني عبر المساهمة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، إلى جانب تقديم العون لتونس ولبنان والسودان وجيبوتي. وعلى الرغم من التحديات الأمنية. تواصل مصر المبادرة في القضايا الجيوسياسية الإقليمية والدولية، حيث قامت بتنظيم عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول، مع السعي لإيجاد حلول دبلوماسية وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية. على سبيل المثال، نظمت مصر العديد من اللقاءات والمحادثات الثنائية، أبرزها قمة السلام التي عُقدت في القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى توافق يحترم المبادئ الدولية والإنسانية المتعلقة بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في قطاع غزة. كما تم التأكيد على ضرورة وصول المعونات الإنسانية إلى القطاع، والدفع نحو استئناف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. وقد شهدت القمة مشاركة واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استجابت 31 دولة وثلاث منظمات لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وهذا يعكس أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضمان عدم ترك أي فراغ في الساحة الإقليمية والدولية، مما يسمح لأي أطراف أخرى بالتوغل فيها([24]).
- تسعى مصر إلى تعزيز التعاون العربي المشترك على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، من خلال العمل على دراسة وتطوير آليات وتوقيتات إقامة وتأسيس جيش عربي مشترك. وفي إطار هذه الجهود، تنفذ مصر سلسلة من المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة مع الدول العربية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في العديد من المجالات الثنائية. ويُظهر هذا التعاون التناغم المتزايد بين الدول العربية، والذي تجسد بوضوح في تمثيلها الموحد في المحافل والمناسبات العسكرية، مثل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الجديدة في 3 يوليو، مما يعكس التزام مصر بتعزيز العمل العربي المشترك في المجال العسكري. في هذا السياق، شاركت مصر في مناورات عسكرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في السابع من يونيو 2021. كما أطلقت مصر مناورات عسكرية تحت اسم “هرقل 2″، التي شهدت مشاركة كل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، بالإضافة إلى دول أخرى شاركت بصفة مراقب. تمثل هذه الأنشطة العسكرية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العسكري بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في إطار تحالفات إقليمية وعربية، مما يساهم في تعزيز أولويات السياسة الخارجية المصرية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير الشراكات العسكرية في المنطقة([25]).
- تلعب القاهرة دورًا محوريًا في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والتنمية والثقافة مع الدول الأفريقية. فقد وضع الرئيس السيسي استراتيجية شاملة تضم عدة عناصر متكاملة تهدف إلى إعادة تمركز مصر بقوتها وثقلها الاستراتيجي في أفريقيا، بما يتماشى مع محددات السياسة الخارجية المصرية التي تركز على تحسين وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية. وفي هذا السياق، لم يكن من المفاجئ أن تلقى رؤية مصر تجاوبًا إيجابيًا من الدول الأفريقية، التي تفاعلت مع طروحاتها بشأن مستقبل القارة من خلال مخططات طموحة وواقعية تواكب آمال وتطلعات شعوبها. تؤكد مصر دائمًا في جميع الفعاليات الإقليمية على استعدادها الكامل لتسخير إمكانياتها ومواردها لدعم عجلة التنمية الأفريقية وتحقيق نتائج ملموسة تلبي احتياجات الشعوب الأفريقية. ومن بين الأولويات المصرية في هذا السياق، مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل الخبرات الفنية والعلمية إلى الدول الأفريقية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية([26]). نتج عن هذه الجهود المكثفة التي بدأت منذ عام 2013، أن تولت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخها. هذا التتويج يعكس بوضوح أهمية القارة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
ختاماً، يمكننا التأكيد على مكانة منطقة الشرق الاوسط بالنسبة لمصر كأحد دوائر سياساتها الخارجية الهامة، ومحددات السياسة الخارجية المصرية التى تتمثل فى تعزيز التعاون مع جميع الشركاء فى المنطقة، والحفاظ على الأمن القومي المصري، فقد تبنت مصر دورًا استراتيجيًا في هذه المنطقة على مر العصور، نظرًا لمكانتها التاريخية والجغرافية.
المبحث الثانى: أدوات السياسة الخارجية المصرية
شهدت السياسة الخارجية المصرية تحولات عميقة على مستوى التوجهات والأولويات والأدوات المستخدمة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، بما يعكس استجابة الدولة للتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية. وقد اعتمدت مصر على مجموعة متكاملة من الأدوات التي تداخل فيها السياسي بالدبلوماسي، والأمني بالعسكري، والاقتصادي بالتنموي، بما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على ثوابتها القومية، وفي مقدمتها الأمن القومي، والسيادة الوطنية، والاستقرار الإقليمي. وتتوزع أدوات السياسة الخارجية المصرية على عدة محاور رئيسية، كما يلي:
أولاً: الأداة الدبلوماسية
تُعد الدبلوماسية من أقدم أدوات تنفيذ السياسات الخارجية، حيث تُعرّف بأنها “إدارة العلاقات الدولية عن طريق التفاوض”، وهي أداة محورية تعتمد عليها الدول لتحقيق مصالحها في البيئة الدولية دون اللجوء إلى القوة. وقد برز هذا الدور بشكل واضح في السياسة الخارجية المصرية بعد عام 2011، حيث كثّفت مصر من اعتمادها على الأداة الدبلوماسية، سواء في صورتها الثنائية أو متعددة الأطراف، لإعادة تموضعها الإقليمي والدولي.([27])
حرصت مصر من خلال الدبلوماسية الرسمية والثنائية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس استخدام الأداة الدبلوماسية كوسيلة للتفاوض المستمر من أجل ضمان الدعم الدولي لقضايا الأمن القومي المصري. كما تجلى توظيف الدبلوماسية التفاوضية في اضطلاع مصر بدور الوسيط في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، وهو ما يُعد مثالًا نموذجيًا على استخدام الدبلوماسية كأداة للتأثير على مجريات الأحداث الإقليمية من خلال إدارة ملفات التهدئة ووقف إطلاق النار.
في السياق ذاته، فعّلت مصر دبلوماسيتها متعددة الأطراف عبر المؤسسات الإقليمية والدولية مثل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة، بما يعكس اتساع نطاق التفاوض الدبلوماسي المصري ليشمل قضايا أمنية وتنموية محورية كأزمة سد النهضة، والأمن الإقليمي في ليبيا واليمن والسودان. ومن ثم، فإن اعتماد مصر على الأداة الدبلوماسية لا يقتصر فقط على التفاعل الثنائي، بل يتعداه ليشمل أطرًا متعددة الأطراف تهدف إلى بناء توافقات دولية وإقليمية تصب في خدمة مصالحها الحيوية. ([28])
ثانياً: الأداة الاقتصادية
تُعرف الأداة الاقتصادية بأنها توظيف القدرات والإمكانيات الاقتصادية للدولة بهدف التأثير على توجهات ومواقف الدول الأخرى بما يخدم تحقيق الأهداف الخارجية. وتُمارَس هذه الأداة عبر وسائل متعددة مثل المنح، القروض، الحظر، والاتفاقيات الاقتصادية، وهي من أبرز أدوات القوة الناعمة التي توظفها الدول لتعزيز مصالحها دون استخدام الوسائل الصلبة.([29] )
وفي السياق المصري بعد 2011، برز استخدام الأداة الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية من خلال ما يُعرف بالدبلوماسية التنموية، حيث ارتبطت السياسة الخارجية المصرية بصورة وثيقة بالأولويات التنموية الداخلية. وقد سعت الدولة إلى تفعيل دبلوماسيتها الاقتصادية عبر الترويج للفرص الاستثمارية، والمشاركة النشطة في المنتديات الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة، والغاز، والبنية التحتية. يعكس هذا التوجه استخدام الاقتصاد كوسيلة للتأثير غير المباشر على الفواعل الخارجية، عبر خلق شبكات مصالح متبادلة تعزز من وزن مصر الإقليمي والدولي. وتجلى ذلك في استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIz)) والتي مثلت أداة مزدوجة تجمع بين الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. كما عززت مصر من موقعها كمركز إقليمي للطاقة، بالشراكة مع إسرائيل وقبرص، في إطار سياسة اقتصادية خارجية تسعى لترسيخ دور مصر كمصدر وممر للطاقة نحو أوروبا.
إلى جانب ذلك، شكلت المساعدات الاقتصادية من دول الخليج والولايات المتحدة عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الداخلي، ومنحت مصر هامشًا أوسع في اتخاذ قراراتها الخارجية دون الارتهان لضغوط خارجية مباشرة. وعليه، يتضح أن الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية المصرية لم تكن مجرد وسيلة للربح الاقتصادي، بل أداة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة وتحقيق أهدافها الخارجية في بيئة إقليمية ودولية شديدة التنافسية.([30])
ثالثاً: الأداة الدعائية
تُعد الدعاية الدولية إحدى أدوات السياسة الخارجية القائمة على الاتصال السياسي، إذ تُستخدم لنقل الرسائل وتوجيهها إلى جمهور خارجي بغرض التأثير عليه أو كسب تأييده لمواقف الدولة. وهي أداة مركزية ضمن أدوات “القوة الناعمة”، إذ تهدف إلى تشكيل الصورة الذهنية للدولة والتأثير في الإدراك الجمعي الخارجي لصالحها، دون اللجوء إلى وسائل الإكراه أو الضغوط المادية المباشرة.[31]
وقد أولت مصر بعد عام 2011 اهتمامًا ملحوظًا بتفعيل الأداة الدعائية ضمن سياستها الخارجية، في إطار استراتيجية أوسع لتوظيف أدوات القوة الناعمة. فقد اعتمدت على مؤسسات دينية وثقافية مثل الأزهر الشريف، باعتباره رمزًا للوسطية الدينية ومظلة إسلامية عالمية، لتأكيد خطاب الدولة حول التسامح ومكافحة الفكر المتطرف، مما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في ملفات مكافحة الإرهاب.([32]) كما لعب الإعلام الرسمي، والدراما الوطنية، دورًا محوريًا في تصدير خطاب سياسي يعكس أولويات النظام السياسي، مثل السيادة والاستقرار والتنمية، موجّهًا بشكل مدروس إلى الجماهير الإقليمية والدولية. وسعت وزارة الخارجية، في هذا السياق، إلى تقديم صورة ذهنية إيجابية عن الدولة، من خلال تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والبنية التحتية ومجالات حقوق الإنسان، بما يخدم إعادة رسم صورة مصر عالميًا كدولة مستقرة وفاعلة في محيطها.([33])
ومن ثم، فإن الأداة الدعائية لم تُستخدم بمعزل عن باقي أدوات السياسة الخارجية، بل جاءت كجزء تكاملي يُسهم في بناء رواية وطنية مصرية حديثة يتم تسويقها خارجيًا لتعزيز المكانة الدولية والدفاع عن المصالح القومية في أوقات التحول والتغير الإقليمي.
رابعاً: الأداة العسكرية
تُعد الأداة العسكرية (أو الاستراتيجية) أحد أكثر أدوات السياسة الخارجية حساسية وخطورة، حيث تقوم على استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لحماية المصالح الوطنية، وهي غالبًا ما تُستخدم كخيار أخير عندما تفشل الأدوات الأخرى في تحقيق الأهداف المرجوة. وتُوصف بأنها “فن الإكراه” في العلاقات الدولية، لما لها من قدرة مباشرة على فرض الإرادة السياسية على الأطراف الأخرى أو ردعهم.([34])
ورغم ذلك، لم تُفرط مصر بعد 2011 في استخدام الأداة العسكرية، بل وظّفتها بشكل محدود ومحسوب، وفق نهج حذر يوازن بين متطلبات الأمن القومي وأولويات الاستقرار. وقد جاء هذا في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتصاعد التهديدات غير التقليدية، خصوصًا من التنظيمات الإرهابية والميليشيات العابرة للحدود.([35])
فعلى المستوى القريب، عززت مصر من اعتمادها على التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، ضمن ترتيبات مرنة ناتجة عن إعادة تفسير بنود اتفاقية كامب ديفيد، بما سمح بزيادة حجم وانتشار القوات المصرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها التنظيمات المسلحة مثل “ولاية سيناء”. أما خارج الحدود، فقد مارست مصر استخدامًا محدودًا للقوة العسكرية، كما تجلى في الضربات الجوية التي استهدفت مواقع إرهابية في ليبيا، ردًا على تهديدات مباشرة للأمن القومي المصري. كما شاركت في تحالفات عسكرية إقليمية مثل “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، ومناورات إقليمية مشتركة أبرزها مناورات “هرقل” التي جمعت قواتها مع السعودية، الإمارات، اليونان، وقبرص، في إطار سياسة ردع إقليمي متكاملة.([36])
وتدل هذه الممارسات على تحول نوعي في أدوات السياسة الخارجية المصرية، حيث لم تعد الأداة العسكرية حكرًا على الأزمات الكبرى، بل أضحت وسيلة ردع نشطة تُستخدم للحفاظ على توازنات القوة الإقليمية، ولتعزيز مكانة مصر كفاعل إقليمي قادر على التدخل وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة.
خامساً: التحالفات الإقليمية والتوازن الاستراتيجي
أدركت مصر أهمية تنويع التحالفات في عالم متغير، لذا اتجهت إلى تبني سياسة “التوازن الاستراتيجي”، فوسعت علاقاتها نحو قوى جديدة كروسيا والصين، ووقعت صفقات تسليح كبرى، أبرزها صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار مع روسيا. كما عززت مصر من تحالفاتها في شرق المتوسط لمواجهة التمدد التركي، عبر التعاون مع اليونان وقبرص، وتحالفات عربية واسعة مع السعودية والإمارات. وبهذا، أضحت مصر تمارس سياسة موازنة إقليمية، لا تترك فراغًا لقوى منافسة مثل تركيا أو إيران، وتحافظ على مكانتها باعتبارها مركزًا للثقل العربي.( [37])
سادساً: رعاية المواطن في الداخل والخارج
وضعت الدولة المصرية المواطن في صميم سياستها الخارجية، حيث تمثل السفارات والقنصليات أذرعًا فاعلة للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج. وتشمل هذه الأداة التواصل السياسي والإعلامي مع المواطنين، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وتعزيز جودة الخدمات القنصلية، وربطهم بالمبادرات الوطنية، والاستفادة من الكفاءات المصرية في الخارج لدعم خطة التنمية. وقد انعكس ذلك في ازدياد الاهتمام بالجاليات، واعتبارهم امتدادًا استراتيجيًا للقوة الناعمة المصرية في الخارج.([38])
في النهاية تظهر السياسة الخارجية المصرية بعد 2011 كسياسة مرنة ومركبة، تزاوج بين الأدوات التقليدية والمعاصرة، وتتسم بالانفتاح والتوازن. فالدولة لم تعد تكتفي برد الفعل، بل باتت تبادر في ملفات المنطقة، وتُفعّل أدواتها بذكاء استراتيجي يُراعي تغير موازين القوى، ويخدم مصالحها القومية دون التفريط في الثوابت. وتمثل أدوات السياسة الخارجية المصرية اليوم انعكاسًا لتطور العقيدة الاستراتيجية للدولة، التي تسعى للربط بين الأمن والاستقرار من جهة، والتنمية والتأثير الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
المبحث الثالث: محددات القوة الإقليمية المصرية
تمتلك مصر عدة محددات تجعل منها قوة إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتؤثر على سياستها الخارجية والأدوات المرتبطة بها التى تمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة ومصالحها الحيوية وحماية أمنها القومي فى الدائرة الشرق أوسطية.
أولاً: المحددات الجغرافية
أعطى الموقع الجغرافى لمصر مكانة جيوسياسية من خلال امتلاكها موقع استراتيجي حيث تقع مصر في شمال شرق أفريقيا وتشغل موقعاً استراتيجياً بين القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا وأوروبا)، مما يجعلها نقطة تقاطع وتواجه لعدة طرق برية وبحرية وجوية وامتلاكها لنهر النيل حيث ان مصر تمتد على طول نهر النيل، وهذا يجعلها تمتلك مصدراً غنياً بالمياه والأراضي الزراعية، وتعتبر زراعة أراضي النيل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية و تمتلك مصر قناة السويس وهي قناة ملاحية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتعتبر هذه القناة ممراً هاماً للتجارة العالمية وتسهم في رفع الاقتصاد المصرى و تمتلك مصر سواحل بحرية طويلة تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتعتبر هذه السواحل مقصداً للسياحة . وتتميز مصر بتنوع جغرافي ومناخي، حيث تمتد من الصحراء الكبرى في الغرب إلى البحر الأحمر في الشرق، ومن الجبال في سيناء إلى الأراضي الزراعية الخصبة على ضفاف النيل. هذا التنوع يسمح لمصر بأن تكون مصدراً للموارد الطبيعية المتنوعة والثروات الحيوانية والنباتية المتنوعة. وبالتالى فإن موقع مصر الجغرافي يساعد في تعزيز الاقتصاد والتجارة والسياحة وتوفير الموارد الطبيعية ، ويجعلها دولة ذات أهمية استراتيجية في المنطقة والعالم. وبهذا الموقع الجغرافي المميز مكنها من لعب دور مهم في صياغة السياسات الإقليمية والدولية في فترات الحرب والسلام، ومنحها مكانة متفردة في العالم بملتقاه الأسيوي والإفريقي، وجعلها من اللاعبين الكبار بمنطقة الشرق الأوسط منذ عقود طويلة، هذا الموقع المتفرد حفز كثير من العلماء والمفكرين على شرحه وبيان أهميته وخصائصه وأثره وتأثيره على مصر في الداخل والخارج، من هذا المنطلق تبوأت مصر مكانتها الإقليمية والدولية المتميزة، والتي أتاحت لها القيام بدور مؤثر وفاعل؛ لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه([39]). وبالنظر إلى الدبلوماسية التي انتهجتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، نجد أنها تقدم نموذجًا متميزًا كنقطة اتصال دولية بين مختلف مناطق العالم، ويعود ذلك بالأساس إلى امتلاك مصر لمقومات العمق الاستراتيجي، الذي يتجلى بوضوح في موقعها الجغرافي الفريد، لتصبح مصر نقطة التقاء حقيقية يمكن من خلالها ربط العالم شرقًا وغربًا فما تؤديه مصر كنقطة اتصال من شأنه أن يخفف من حدة المنافسة الإقليمية، حيث أتاح المجال لتعدد مراكز القيادة داخل الأقاليم التي تنتمي إليها، وهو ما يتجلى في تحركات الدبلوماسية المصرية نحو بناء قيادة إقليمية متعددة الأطراف، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع العديد من دول الشرق الأوسط في مجالات متنوعة. ويُعد هذا التوجه عاملًا رئيسًا في إبراز قوى جديدة قادرة على لعب أدوار فاعلة في قيادة المنطقة، بما يعزز من فرص التكامل تحت مظلة قيادة جماعية، تتماشى مع التحولات الجارية في النظام الدولي، الذي لم يعد قادرًا على الاستمرار في إطار محدود ومركزي.
فيمكن القول إن الدور المصري بات محوريًا في رسم ملامح مرحلة جديدة من النظام العالمي، من خلال تجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، وتفعيل مفهوم العمق الاستراتيجي، الذي يسهم في تقويض نظرية الجزر المنعزلة التي سادت في العقود الماضية، والتي لم تعد مناسبة لطبيعة الأزمات العالمية الحالية، التي تتسم بالتعقيد والتشابك. وبهذا، تتحول مصر من كونها مجرد دولة قائد في محيطها الجغرافي، إلى مركز دولي تلتقي عنده مصالح العالم من الشرق إلى الغرب بفضل موقعها الجغرافي([40]).
ثانياً: المحددات العسكرية.
يعد الجيش المصري هو جيش دفاعي وليس عدائياً. يمتد تاريخ الجيش المصري إلى نحو ستة آلاف عام إلى عصر الدولة الحديثة الذى ظهر فيه الاهتمام بالجيش برا وبحرا. ثم بدأ الصراع العربي الإسرائيلي الذى يعد فصلا جديدا فى تاريخ القوات المسلحة مرورا بحرب فلسطين 1948، ومعركة السويس 1956، وحرب الاستنزاف 1968، وحرب أكتوبر 1973، ومؤخرا العملية الشاملة فى سيناء 2018 للقضاء على الجماعات التكفيرية فى شمال سيناء.
يحتل الجيش المصرى المرتبة الـ12 عالميا ، وهو الأول على الشرق الأوسط وعربيا، وقد تكلفت القوات المسلحة بناء الدولة المصرية المعاصرة، ولعل الأحداث المتتالية التى شهدتها مصر منذ العقد السابق أبرز دليل على إخلاص الجيش فى الحفاظ على حدود مصر وأمنها القومى مهما تكلف الأمر، والانحياز للشعب، أيضا إصراره على النهوض بالبلاد عقب التدهور الاقتصادى والحالة المزرية التى آلت إليها الأوضاع ما دفع القوات المسلحة لأن تصبح فى طليعة الصفوف كى تقدم العون للدولة المصرية وتمنحها فرصة لإعادة البناء، وعودة الاستثمار محليا وأجنبيا ما يؤثر بالإيجاب فى الاقتصاد المصرى ومن ثم الاحتياطى الأجنبى.([41])
وتطورت المهام الرئيسية للجيش من الدفاع والحماية فقط إلى البناء والدفاع معا رافعا شعار “يد تبنى ويد تحمل السلاح”. ودوره الأساسى هو الدفاع عن حدود الوطن لكنه لا ينفصل بتاتا عن دوره التنموى فى البلاد لاسيما فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التى ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بما يضمن أمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة وتحول دور مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات الاستراتيجية بدعم من البنية العسكرية فقد سعت الدولة المصرية الجادة لاستعادة الدور الريادي لمصر والمشاركة في إعادة تشكيل النظام الدولي، لامتلاك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية المؤهلة للقيام بذلك([42]).
وفقا لتصنيف غلوبال فاير باور لعام 2025 يحتل الجيش المصري المرتبة الـ19 عالميا، مما يجعله الأقوى عربيا وأفريقيا ويمتلك الجيش المصري مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، تشمل طائرات ودبابات حديثة ونظام دفاع جوي متطور. تمتلك القوات الجوية المصرية أسطولا كبيرا من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات إف 16 ( F-16) الأميركية الصنع، وطائرات رافال الفرنسية وتعد F-16 العمود الفقري للقوات الجوية المصرية، مع أكثر من 200 من هذه الطائرات في مخزونها، وهي مقاتلة متعددة المهام وأما طائرة رافال فهي مقاتلة حديثة مجهزة بإلكترونيات طيران وأنظمة أسلحة متطورة يأتي هذا فضلا عن عدد كبير من طائرات الشحن إضافة إلى الطائرات المخصصة للتدريب. وتشغل مصر مجموعة متنوعة من الطائرات المروحية بما في ذلك مروحيات أباتشي (AH-64 Apache) الأميركية الصنع وهي طائرة هليكوبتر هجومية ذات مقعدين مجهزة بأجهزة استشعار وأنظمة أسلحة متطورة، وفقا ما أفاد به موقع ديفينس أرابيك كما تمتلك مصر طائرة هليكوبتر كي إيه 52 (KA52) وهي أيضا طائرة هليكوبتر هجومية روسية ذات مقعدين مزودة بأجهزة إلكترونية حديثة خاصة بالطيران وأنظمة متقدمة. تمتلك مصر أيضا أسطولا من الطائرات المسيرة أبرزها طائرات وينغ لونغ وهي طائرات هجومية واستطلاعية صينية متقدمة حيث اشترت مصر طائرات مسيرة صينية الصنع من نوع وينغ لونغ بطرازاتها المختلفة، وفق ما أفاد به موقع ديفينس أرابيك وذكر موقع تايم آيرو سبيس أن مصر أعلنت في نوفمبر 2018 أنها ستشتري 32 طائرة مسيرة من طراز Wing Loong 1Dتتميز النسخة D1 بزيادة طول جناحيها – من 14 مترًا إلى 17.8 مترًا – مع وزن أقصى أعلى للإقلاع، ومضاعفة الحمولة إلى 400 كجم([43].) كما تمتلك مصر طائرات CH-4 وCH-5 الصينية والتي تستخدم في مهام الاستطلاع والهجوم، تتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة وحمل أسلحة متنوعة ومحليا ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة كشفت عن تصنيع طائرات نووت والتي كشفت عنها في معرض EDEX 2021 وهي طائرة استطلاع مصرية من دون طيار، تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والكلية الفنية العسكرية وتستطيع حمل حمولة تصل إلى 50 كجم. وتمتلك مصر أنواعا متعددة من الدبابات بما في ذلك دبابات أبرامز إم 1 إيه 1 الأميركية (M1A1 Abrams) وتي 90 إم إس الروسية (T-90MS).الدبابة أبرامز من أكثر الدبابات تقدما في الجيش المصري وهي مجهزة بأنظمة دروع وأسلحة متطورة، بما في ذلك مدفع أملس من عيار 120 ملم وجهاز تحديد المدى بالليزر وأما دبابة تي 90 إم إس فهي مجهزة بأنظمة متطورة للتحكم في النيران ومدفع 125 ملم.
تعد القوات البحرية المصرية من أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستمر في تحديث وتطوير قدراتها البحرية.ووفقا لموقع وور باور إيجيبت تتألف البحرية المصرية من 146 قطعة بحرية متنوعة، تشمل حاملات مروحيات، غواصات، سفن قتالية سطحية، وسفن متخصصة في مكافحة الألغام. وتمتلك مصر حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال” الفرنسية، وهما “جمال عبد الناصر” و”أنور السادات”. تبلغ حمولة كل منهما 21,300 طن، وتستوعب ما يصل إلى 16 مروحية متوسطة، و70 مركبة قتالية، بالإضافة إلى مئات الجنود. دخلت هذه السفن الخدمة في البحرية المصرية عام 2016. ويتكون أسطول الغواصات المصري من ثماني غواصات، منها أربع غواصات حديثة من طراز “تايب 209/1400” الألمانية، المزودة بأنابيب طوربيد عيار 21 بوصة، وقادرة على إطلاق صواريخ “هاربون” المضادة للسفن. بالإضافة إلى ذلك تضم البحرية المصرية أربع غواصات من طراز روميو الصينية التى تم تحديثها لتشمل أنظمة تسليح متقدمة. وتعزز البحرية المصرية قدراتها السطحية بامتلاكها فرقاطات حديثة، منها أربع فرقاطات من طراز “ميكو A-200” الألمانية، التي تتميز بتقنيات التخفي والتسليح المتقدم. كما تمتلك مصر فرقاطتين من طراز “فريم” الإيطالية، وهما “الجلاء” و”برنيس”، المزودتين بأنظمة تسليح متطورة، بما في ذلك خلايا إطلاق عمودية وصواريخ مضادة للسفن. وتمتلك مصر مخزونا كبيرا من الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك البنادق والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الصاروخية وتشمل أسلحتها المشاة رشاش المعادي AK-47 المصري الصنع، و FN FAL البلجيكي الصنع، ومدفع رشاش PKM الروسي الصنع. واستثمرت مصر في أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوية الروسية إس 300 (S-300) وهي أنظمة قادرة على اعتراض صواريخ العدو وطائراته على مسافات طويلة، وتعتبر من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في العالم بالإضافة إلى ذلك طورت مصر نظام الدفاع الصاروخي الخاص بها، وهو نظام الدفاع الجوي المصري (EADS) وهو عبارة عن شبكة من الرادارات ومراكز القيادة والتحكم وقاذفات الصواريخ المصممة لحماية المجال الجوي المصري.([44]) وتضم البحرية المصرية 23 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام، مما يعكس اهتمامها بالحفاظ على سلامة الممرات البحرية وتأمينها وتواصل القوات البحرية المصرية مساعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، من خلال تحديث أسطولها البحري وتزويده بأحدث التقنيات والمعدات([45]).
ثالثا: المحددات السياسية
- طبيعة النظام السياسي
يعتبر النظام السياسي أحد المحددات السياسية لقوة الدولة، تعد جمهورية مصر العربية دولة ذات نظام جمهوري ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات([46]). قامت بعض الدراسات فى دراستها للنظام السياسي المصري على اتجاهات مختلفة كان أبرزها: الاتجاه الذى ركز على دور الجيش المصري فى عملية الحكم، والاتجاه الذى اهتم بالشخصية الكاريزمية للحاكم وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار واستقرار النظام السياسي، ولدينا اتجاه آخر اهتم بدراسة الجانب الرعوى للنظام السياسي وإحلال الولاءات الشخصية للقبيلة أو العائلة أو الجماعة محل الولاء للوطن وتجلى ذلك بوضوح فى فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي([47]).
2- نظام الحكم
يتكون نظام الحكم فى مصر من ثلاث سلطات وهم السلطة التشريعية والممثلة فى مجلس النواب الذى يتولى سلطة التشريع و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية و إقرار كلا من السياسة العامة والموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام الدستور([48])، والسلطة التنفيذية الممثلة فى كلا من رئيس الدولة الذى يعتبر رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة التى تشارك رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور([49])، والسلطة القضائية و تعتبر مستقلة فى حد ذاتها. يعتبر نظام الحكم فى مصر نظاما مختلطا قائما على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات أكثر خاصة فى مجال التشريع دون الإخلال بقاعدة الفصل بين السلطات([50]).
3- أسس النظام السياسي
تتعدد جهات صنع السياسة العامة فى الدولة ما بين المؤسسات الرسمية المتمثلة فى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين المؤسسات غير الرسمية الممثلة فى الأحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأى العام، وذلك وفقا لطبيعة نظام الحكم السائد فى الدولة([51]). تنقسم مؤسسات صنع القرار فى مصر إلى المؤسسات الرسمية وهى السلطات الثلاث التشريعة والتنفيذية والقضائية السابق الحديث عنها، والمؤسسات غير الرسمية المتمثلة فى الأحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأى العام التى سنتناولها بالحديث.
تغلب على الحياة الحزبية فى مصر سمة التعددية؛ حيث تجاوز عدد الأحزاب السياسية التسعين حزبا بعد ثورة يناير 2011، لكنها لا تملك القوة المطلوبة للمشاركة بفاعلية فى النظام السياسي، مما أدى إلى تراجع الحياة الحزبية فى مصر. أما جماعات المصالح فتتمثل فى النقابات العمالية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرهم، لكن دورهم فى الحياة السياسية لا يعتبر ذا تأثير كبير بسبب تركزهم فى مناطق دون غيرها، بالإضافة إلى أن كل فئة منهم تسعى لخدمة أهدافها الخاصة دون الاهتمام بالصالح العام. أما بالنسبة للرأى العام وأجهزة الإعلام فقد كفل الدستور المصري حرية الصحافة والإعلام، بجانب إدراك القيادة السياسية لأهمية دور وسائل الإعلام بوجه عام وفى المجال السياسي بشكل خاص مما نتج عنه إصدار قانون تنظيم الإعلام رقم (80) لعام 2018([52]). تعتبر هذه المؤسسات فاعل رئيسي فى الحياة السياسية المصرية، إلا أنه حدثت بعض التغيرات الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011؛ حيث ظهر فاعلون جدد على الساحة السياسة الداخلية فى مصر مثل المؤسسة العسكرية التى استطاعت الابتعاد بمصر عن حافة الانزلاق، وبعض قوى المعارضة متمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطني، والشارع المصري الذى أثبت دوره فى اختيار القيادة السياسية أو إزاحتها عن سدة الحكم([53]).
رابعاً: المحددات الاقتصادية
يعد الاقتصاد أحد العوامل الهامة فى تحديد قوة الدولة، وتملك مصر مقومات وموارد طبيعية وبشرية هائلة تمكنها من الصعود بمستواها الاقتصادي لتصبح قوة اقتصادية إقليمية، منها على سبيل المثال التربة الخصبة والمياه العذبة والمناخ المعتدل اللازمين للزراعة، توافر المعادن كالحديد والألومنيوم والنحاس و المواد البترولية اللازمين للصناعة، توافر الموانئ البرية والبحرية والجوية المختلفة بجانب وجود شبكة طرق قوية ووقوع مصر فى قلب شبكة التجارة العالمية و تحكمها فى قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم اللازمين للتجارة، وأيضا وجود الأماكن السياحية والأثرية والتنوع التاريخي الذى يسهم فى زيادة الدخل القومى عن طريق القطاع السياحي، بالإضافة إلى وفرة الأيدى العاملة([54]) .
أولا الزراعة: ساعدت الموارد الطبيعية التى تتحلى بها مصر وكذلك وفرة الأيدى العاملة، بجانب اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي عن طريق مشاريع الاستصلاح الزراعى وغيرها إلى تحسين إنتاجية هذا القطاع وزيادة الصادرات الزراعية.
ثانياً الصناعة: تتمتع مصر بقاعدة صناعية هائلة تقدر بحوالى 150 منطقة صناعية فى كافة أنحاء الجمهورية، وحقق القطاع الصناعي مؤشرات إيجابية فى الآونة الأخيرة وذلك من خلال جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الهام وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص.
ثالثاً التجارة: تحسنت مؤشرات الميزان التجاري نسبيا لتصبح لصالح مصر من خلال الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة بهدف تصدير المنتجات الزراعية والصناعية للخارج، بجانب المقومات السابق الحديث عنها والتى تملكها مصر.
رابعاً السياحة: يعتبر القطاع السياحي أحد أبرز المشاركين فى الدخل القومي المصري عن طريق ضخ العملات الأجنبية فى خزينة الدولة، حقق هذا القطاع نموا غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة محققا مركز متقدم فى مؤشر السياحة والسفر العالمي([55]) .
يتضح مما سبق أن محددات السياسة الخارجية المصرية متعددة ومتنوعة ما بين العوامل الجغرافية متمثلة فى موقعها المتميز بين قارات العالم الثلاث القديمة وما تمتلكه من موارد طبيعية حباها الله عز وجل بها مثل نهر النيل، وعوامل عسكرية تتمثل فى قوة الجيش المصرى وتجهيزاته وموارده العسكرية، وعوامل اقتصادية يمكن اجمالها فى الموارد الطبيعية والبشرية، وعوامل سياسية وهى: طبيعه النظام السياسي السائد فى الدولة وهو النظام الجمهورى الديمقراطي، وطبيعة نظام الحكم وهو النظام المختلط، وأسس النظام السياسى حيث تتعدد عملية صنع القرار ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. ووظفت مصر تلك المحددات بطريقة تخدم أهدافها ومصالحها الاستراتيجية وتجعلها تلعب دور هام ومركزى بين الدول.
إجمالاً، يتضح أن مصر تمتلك مجموعة من المحددات المتنوعة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات ويجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والطاقة، والقدرات العسكرية التي تؤهلها للدفاع عن أمنها والمساهمة في التنمية الداخلية والتأثير الإقليمي. كما أن النظام السياسي يوفر لها مرونة في التعامل مع التحولات، رغم بعض التحديات الداخلية، في حين تدعم مواردها الطبيعية والبشرية المتنوعة، والقطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة بناء اقتصاد قوي ومتكامل. وقد مكّنها كل ذلك من تعزيز مكانتها الإقليمية والمساهمة في تشكيل توازنات النظامين الإقليمي والدولي بما يحفظ مصالحها الحيوية.
ويمكن القول أن السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2011 قد مرت بمراحل دقيقة ومعقدة، لكنها نجحت في الحفاظ على توازن استراتيجي بين متطلبات الأمن القومي ومتطلبات الحفاظ على الدور الإقليمي. استطاعت مصر أن تطور سياسة خارجية مرنة تعتمد على مزيج من الأدوات التقليدية والحديثة، مما مكّنها من التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ركزت هذه السياسة على تعزيز الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الثوابت القومية وتوسيع نطاق التعاون مع القوى الإقليمية والعالمية، دون التنازل عن المصالح الوطنية.
يتضح مما سبق، أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مزيج متكامل من المحددات الجغرافية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب أدوات متنوعة مثل الدبلوماسية والاقتصاد والإعلام، وهو ما منحها قدرة على التحرك بمرونة في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. كما أن هذه السياسة لم تكن معزولة عن محيطها، بل تفاعلت مع متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، كالصراعات في الجوار، وتبدّل التحالفات، وتغير أولويات القوى الكبرى، مما استدعى تبني نهج واقعي وبراغماتي يوازن بين المصالح الوطنية ومتطلبات التكيف مع هذه التحديات، وهو ما مكّن مصر من الحفاظ على مكانتها الإقليمية وتعزيز أمنها القومي في آنٍ واحد.
الفصل الثانى
أثر البعد الجيوبولتيكى على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا فى الفترة من 2011 إلى 2025.
حاولت كلا من تركيا وإيران وإسرائيل بعد ثورات الربيع العربي أن يفرضوا سيطرتهم على منطقة الشرق الأوسط باعتبارهم قوى إقليمية كلا بطريقتها الخاصة، فحاولت إيران أن تنشر الفكر الشيعي بجعله يتمدد لدول الخليج العربي، وأرادت تركيا بسط هيمنتها على الدول العربية التى كانت تابعة للدولة العثمانية قديما محاولة فى ذلك تطبيق سياسة العثمانية الجديدة التى اتبعها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله لسدة الحكم؛ عن طريق التقارب مع الدول المشابهة أيديولوجيا لها مثل مصر فى فترة حكم حزب الحرية والعدالة، أما إسرائيل التى تعتبر قوة إقليمية بالمساعدات الأمريكية فكانت تطمع لتصبح المسيطر الأوحد على المنطقة، ولكن استطاعت مصر التصدى لجميع هذه المحاولات بحزم.
المبحث الأول: الأثر الجيوبولتيكي لمصر على سياستها الخارجية تجاه تركيا.
يترتب على وقوع تركيا فى الدائرة الشرق أوسطية للسياسة الخارجية المصرية حتمية وجود علاقات بين الدولتين بغض النظر عن ماهيتها، وما يعزز من وجود هذه العلاقات المتبادلة؛ الروابط التاريخية التى تجمع الدولتين منذ وقوع مصر فى قبضة الدولة العثمانية بعد معركة الريدانية 1517 ولأكثر من أربعة قرون حتى تفكك الإمبراطورية الكبيرة بعد الحرب العالمية الأولى، بل ولفترة سابقة على ذلك.
أولاً: لمحة تاريخية على العلاقات المصرية التركية.
تكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، إذ ظلت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة لمدة ثلاثة قرون، الأمر الذى ترتب عليه تأسيس علاقات بين البلدين ذات روابط وأبعاد دينية وثقافية وتاريخية تتسم بالقوة والمتانة إلى حد كبير. ترجع جذورها إلى العصر العباسي الأول، وقد مرت بمراحل تاريخية متعددة اتسمت بالتقارب والتفاعل السياسي والعسكري والثقافي، وأحيانًا بالتنافس والصراع، وذلك تبعًا للمتغيرات الإقليمية والدولية.([56]) فمع قيام الدولة العباسية، بدأ النفوذ التركي يتغلغل في بنية الدولة الإسلامية، لا سيما بعد اعتماد الخلفاء العباسيين على العنصر التركي في الجيش والإدارة. وتولى عدد من القادة الأتراك حكم مصر نيابة عن الخلافة وبلغ هذا النفوذ ذروته حين أسس القائد التركي أحمد بن طولون أول دولة مستقلة في مصر تحت مظلة الشرعية العباسية سنة 868م، والتي عُرفت بالدولة الطولونية.
جاء بعد ذلك الدولة الفاطمية لتؤسس عاصمة لدولتهم وهى القاهرة، بعد سقوط الدولة الفاطمية، أعاد صلاح الدين الأيوبي الاعتراف بالخلافة العباسية، وعزز هذا الاعتراف من العلاقة الرمزية بين مصر وبغداد. ومع سقوط بغداد على يد المغول عام 1258م، لجأ العباسيون إلى القاهرة، حيث أعاد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس إحياء الخلافة العباسية بشكل صوري. ومن ثم أصبحت القاهرة مركزًا دينيًا وروحيًا للعالم الإسلامي، مما عزز من الروابط المعنوية بين مصر والعنصر التركي، لا سيما أن المماليك أنفسهم كانوا من أصول تركية وقوقازية.([57])
دخلت مصر تحت الحكم العثماني بعد معركة مرج دابق سنة 1516، واستسلام المماليك في القاهرة عام 1517. ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر ولاية عثمانية، واستمرت علاقتها بالخلافة العثمانية لما يقرب من أربعة قرون. وشهدت هذه الفترة استقرارًا نسبيًا في العلاقات بين مصر وتركيا، وتكاملًا إداريًا وثقافيًا، على الرغم من بعض التوترات بين حكام مصر المحليين (مثل محمد علي باشا لاحقًا) والباب العالي في إسطنبول.([58])
مع بداية القرن العشرين وسقوط الدولة العثمانية، تباعدت العلاقات بين مصر وتركيا في ظل اختلاف التوجهات السياسية. تم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين في عشرينيات القرن الماضي، ثم تطورت العلاقات تدريجيًا، لتشهد محطات من التعاون والتوتر وكان بداية التوتر حين طرد جمال عبد الناصر السفير التركي مرتان. وتوترت العلاقات التركية العربية بشكل عام منذ انضمام تركيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسى ﻋﺎم 1952، وفي مصر بشكل خاص، حيث نظرت ﺗﺮﻛﯿﺎ إﻟﻰ القومية العربية ونظام ناصر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻠﯿﻔﺎً ﻟﻼﺗﺤﺎد السوفيتي الذي يهدد نفوذها في المنطقة([59]).
شهدت فترة السبعينات ﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ – العرﺑﯿﺔ بشكل عام خصوصا بعد حرب أكتوبر 1973، حيث أعلنت ترﻛﯿﺎ وقتها بأنها لن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄي استخدام عسكرى للقوات الترﻛﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ مساعدة إسراﺋﯿﻞ؛ كما أقرت تركيا وقتها ﺤﻖ الشعب الفلسطينى ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟته. شهدت العلاقة المصرية التركية تحسنا ملحوظا، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركى لمصر في أكتوبر 1996، وهى الزيارة التى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية والتي نجحت في تكوين مجموعة الثمانية النامية، والتي عقدت للمرة الأولى في اسطنبول في يونيو 1997 وتقاربت مصر وتركيا سياسيا حيث قامت مصر بدور الوساطة بين تركيا وسوريا، ونجحت مصر في نزع فتيل الحرب التى كانت على وشك الوقوع بين الطرفين.([60])
تعددت الزيارات الرسمية بين مصر وتركيا، وزار الرئيس الأسبق حسني مبارك تركيا في فبراير 2004، وتبعها بزيارة أخرى عام 2007. وزار رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان مصر في يناير 2009 للتشاور بشأن أحداث غزة، كما شارك الرئيس التركي عبدالله جول في قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ في يوليو 2009، عقب زيارة مبارك لتركيا في منتصف فبراير من نفس العام كما شهدت العلاقات تحسن على المستوي الاقتصادي، ففي عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر للإسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. كانت تركيا أول المعترفين والمؤيدين لمطالب الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير 2011، ووقف أردوغان يردد هتافات ميدان التحرير في البرلمان التركي.([61])
وكان الرئيس التركي عبد الله جول من أوائل الزائرين لمصر، بعد الثورة، وقد تم استقباله من قبل المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكرى. حضر الرئيس السابق محمد مرسى في سبتمبر من عام 2012 أعمال المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وفي نوفمبر من نفس العام زار رجب طيب أردوغان القاهرة، وأعلنت رئاسة الجمهورية عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا وصل عددهم إلى 27 اتفاقية، وفي زيارة جول الرسمية في فبراير 2013 تم الاتفاق على توسيع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات التركية وشهدت هذه الفترة تقارب كبير في العلاقات، ، كما تم تعزيز التعاون العسكري من خلال زيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع([62]). ولكن وصلت حالة التوتر لذروتها عندما تم إعلان أن السفير التركي في مصر ”غير مرغوب فيه”، ومن ثم تقليل التمثيل الدبلوماسي، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013 بعد رفض تركيا لـ 30 يونيو. ووصف أردوغان ما حدث بمصر بـ”الانقلاب” كما وصف جول فض اعتصامي رابعة والنهضة بـ ”المجزرة” مؤكدًا أن هذا الأمر ”غير مقبول”، معربًا عن خشيته من تحول الوضع في مصر إلى نزاع مماثل لما يحدث في سوريا.([63])
ثانياً: أثر الموقع الجيبولتيكى لمصر على السياسية الخارجية تجاه تركيا (2011-2025).
تتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد من نوعه، حيث تشرف على قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم، وتحدها من الغرب دولة ليبيا، ومن الشرق قطاغ غزة وإسرائيل، وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ويجعلها هذا الموقع لاعباً محورياً فى التوازنات الإقليمية، خاصة فى ظل التنافس على موارد الطاقة فى شرق المتوسط والتدخلات الإقليمية فى ليبيا.
شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تحولات جذرية في بنيتها الجيوسياسية، نتيجة لتداعيات “الربيع العربي” وتزايد التنافس الإقليمي والدولي. في هذا السياق، برزت مصر وتركيا كقوتين إقليميتين تسعيان لتعزيز نفوذهما، مما أدى إلى تباين في مواقفهما تجاه العديد من القضايا الإقليمية؛ من أبرزها النزاع في شرق البحر المتوسط، مما أدى إلى توترات بين مصر وتركيا، خاصة بعد توقيع أنقرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في 2019. كما أن الأزمة الليبية أضافت بعدًا آخر للتوتر، حيث دعمت مصر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بينما دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني.
وسوف يتم تحليل تأثير البعد الجيوبوليتيكي لمصر على سياستها الخارجية تجاه تركيا خلال الفترة من 2011 إلى 2025، مع التركيز على قضيتي شرق المتوسط وليبيا، من خلال استعراض المواقف والسياسات المتبعة من قبل البلدين، وتقييم مدى تأثير هذه القضايا على العلاقات الثنائية([64])
- قضية شرق المتوسط.
لقد أصبح شرق البحر الأبيض المتوسط محورا متزايد الأهمية للسياسة الخارجية والأمنية التركية، ولكن التشابك بين القضايا الجديدة مثل سياسات الطاقة وحقوق السيادة مع المشاكل القديمة مثل قبرص خلق تحديات كبيرة لأنقرة، مما دفعها للصدام مع مصر بحكم الموقع الجغرافي وبالإضافة إلى الاختلاف الأيديولوجي بين الدولتين بعد 2013.
لقد أبرزت عمليات استكشاف واكتشاف موارد الغاز الطبيعي البحرية على مدى العقد الماضي من قِبل الدول المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط: إسرائيل وجمهورية قبرص ومصر قضيتين رئيسيتين: أولاً، ضرورة ترسيم الحدود البحرية، وهي خطوة تجنبتها هذه الدول في الماضي خشية المساس بنشاط الصيد؛ وثانياً، ضرورة نقل الغاز المستخرج من هذه الحقول الجديدة إلى المستخدمين النهائيين في أوروبا عبر خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال. إلا أن تركيا، نتيجةً لعلاقاتها المتوترة مع الدول الثلاث، ليست طرفاً في هذا التعاون الإقليمي الجديد. بل إن استبعادها من العملية الأوسع نطاقاً، قد أدى ذلك إلى ظهور عقبات رئيسية جديدة. ومن هنا نستنتج أن شرق البحر المتوسط منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة نظرًا لما تحتويه من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المكتشف حديثًا، خاصة منذ عام 2009، مع اكتشاف حقل “تمار” في إسرائيل، ثم حقل “ظهر” العملاق في مصر عام 2015([65]).
نتج عن ذلك الصراع حول ترسيم الحدود البحرية، فلطالما كانت لتركيا نزاعات حول الحدود البحرية مع جيرانها، وتعود أصول هذه الأزمة إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت جمهورية قبرص في وضع الأساس لاستكشاف الغاز البحري. وقد انزعجت أنقرة من تصرفات القبارصة اليونانيين فيما يتعلق بترسيم المناطق البحرية، والتي ادعت تركيا والقبارصة الأتراك أنها تضر بحل النزاع القبرصي الأوسع. وعلى الرغم من هذه الاعتراضات، وقعت جمهورية قبرص اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر في عام 2003، وجادلت أنقرة بأن اتفاقية ترسيم الحدود لم تأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك أو تركيا نفسها، التي ينبغي أن يكون لها منطقة اقتصادية خالصة كاملة (EEZ) تمتد من جرفها القاري.
مع اكتشافات جديدة في العقد الثاني من الألفية الثانية، بدأت الآثار الجيوسياسية للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط تتصاعد، حيث اكتشفت إسرائيل حقول غاز طبيعي بحرية هامة في عامي 2009 (تمار) و2010 (ليفياثان)، مما دفعها إلى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع القبارصة اليونانيين في عام 2010. كان ذلك العام مهمًا أيضًا للعلاقات التركية الإسرائيلية، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أعقاب حادثة مافي مرمرة، في عام 2011، اكتُشف حقل بحري رئيسي آخر، يُعرف باسم “أفروديت”، قبالة السواحل الجنوبية لقبرص. أعقب ذلك اكتشاف حقل “ظهر” للغاز، أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن عام 2015 قبالة سواحل مصر. ساهمت هذه الاكتشافات في زيادة اهتمام شركات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرسم مسارات تصدير محتملة للغاز المُنتَج.([66])
بعد تصاعد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط نتيجة للأنشطة التركية في التنقيب عن الغاز، شهدت العلاقات المصرية التركية تحولًا ملحوظًا، حيث سعت مصر إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية لمواجهة ما اعتبرته “سياسات استفزازية” من جانب تركيا فقامت في أغسطس 2020، بتوقيع اتفاقية مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، مما أثار استياء تركيا التي اعتبرت الاتفاقية باطلة وانتهاكًا لحقوقها في المنطقة. وفي أكتوبر 2020 عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في نيقوسيا، حيث تم التأكيد على مواجهة “السياسات الاستفزازية والتصعيدية” في منطقة شرق البحر المتوسط، في إشارة واضحة إلى تركيا.([67]) ولكن في مارس 2021، أبدت تركيا استعدادها للتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية بشرط تحسن العلاقات بين البلدين، حيث في يوليو 2023 أعلنت مصر وتركيا عن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد قطيعة دامت عشر سنوات، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، وعلى الرغم من التوترات السياسية استمر التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ومن هنا نستنج أنه على الرغم من التوترات السياسية التي نشأت بسبب قضية شرق البحر المتوسط، إلا أن مصر وتركيا أظهرتا رغبة مشتركة في تحسين العلاقات الثنائية، مما قد يؤدي إلى تعاون أكبر في المستقبل.([68])
- الأزمة الليبية.
تُعد الأزمة الليبية أزمة متعددة المستويات عابرة للحدود الوطنية، فهي صراع على الحكم تتقاطع فيه الصراعات القبلية مع مصالح المليشيات المسلحة، إلى جانب تقاطعه مع منطقة الساحل الإفريقي التي تنشط فيها مختلف تنظيمات الجريمة المنظمة، وتنتشر على أراضيها عدة حركات إرهابية ذات طابع محلي وإقليمي ودولي، فليبيا دولة مفككة من الناحية الجغرافية تشتمل على ثلاثة أقاليم (برقة وفزان وطرابلس) قائمة على مصالح وولاءات قبلية وجهوية، حيث يبرز النفط كأحد محفزات عدم الاستقرار القائمة أساساً على عدم الاتفاق على كيفية توزيع مخصصاته على أبناء البلاد كافة، وهو ما بات يلقي بظلاله على دول الجوار كمصر والجزائر ودول حوض المتوسط.
شكل التدخل العسكري التركي في ليبيا بداية عام 2020 الحدث الأبرز في تطورات الأزمة الليبية في العقد الذي تلى سقوط نظام معمر القذافي كونه جاء بطلب من الحكومة المؤقتة بقيادة فايز السراج، وهو التدخل الذي أثار الكثير من ردود الفعل والجدل من القوى الكبرى حول طبيعة وهوية التدخل العسكري التركي، فضلاً عن إمكانية إثارة جدلية التدخل ومدى نجاح الحل العسكري وتأثيره على موازين القوى، إلى جانب سُؤال مستقبل الدولة الوطنية في ظل التضارب المصلحي للدول المتدخلة إقليمياً ودولياً، وتعدد الولاء٥ات والانتماءات بالنسبة للقبائل الليبية.
كان استقرار ليبيا مسألة أمن قومي مصري حيث صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو أن مصر لها حق مشروع في التدخل في ليبيا وأمر الجيش المصري بالاستعداد للقيام بذلك، كما أعلن السيسي أن خط الجبهة الذي يقع غرب سرت والجفرة في وسط ليبيا، هو “خط أحمر” داعياً إلى التزام القوى المتصارعة بالخطوط التي وصلت إليها، والبدء في محادثات لوقف إطلاق النار.([69]) يعد تهديد السيسي محاولة للحفاظ على النفوذ وتأمين المصالح المصرية بعد تغير ميزان القوى في ليبيا منذ سقوط القذافي في 2011، غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية، وانقسمت البلاد إلى حكومتين متنازعتين: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة المؤقتة في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وقد دعمت مصر والإمارات وروسيا قوات المشير خليفة حفتر في محاولة للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل 2019، بينما تدخلت تركيا في يناير 2020 نيابة عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، مما أدى إلى وقف تقدم قوات حفتر وقد أدى الدعم العسكري التركي للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني إلى عكس التيار وانسحاب قوات حفتر من جبهة طرابلس في أوائل يونيو بعد هزائم متتالية أشهرها كان في مدينة ترهونة جنوب طرابلس، منهيةً بذلك جهود 13 شهرًا للسيطرة على العاصمة وكان السيسي قد اجتمع مع قادة من شرق ليبيا بمن فيهم حفتر لإعلان وقف أحادي لإطلاق النار في 6 يونيو. إن تأكيد السيسي في 20 يونيو على أن التدخل المصري سيكون مشروعًا يستند إلى الادعاء بأنه سيفرض وقفًا لإطلاق النار رفضت حكومة الوفاق البيان بشكل قاطع واعتبرته “إعلان حرب”، بينما أدى ثبات الموقف التركي من عملية وقف إطلاق إلى انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة والعودة إلى تمركزات عام 2015. يعد سبب اهتمام مصر الأساسي بليبيا هو حماية أمنها على الحدود، فمصر لا تثق بحكومة الوفاق الوطني وترى في التدخل التركي تهديداً جدّياً وذلك لأسباب سياسية واقتصادية متنوعة ودعم مصر لقوات خليفة حفتر نابعٌ من أملها بأن يتمكن حفتر من بسط الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة وبعيدًا عن المخاوف الأمنية لحماية حدودها، فإن هدف مصر هو ردع تركيا عن مواصلة التقدم شرقا والجلوس على طاولة المفاوضات.([70])
وبعد اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، شهدت العلاقات المصرية التركية تحولًا ملحوظًا، حيث تأثرت السياسة الخارجية المصرية بشكل كبير بمواقف تركيا من الصراع الليبي ففي عام 2019، وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، تضمنت التعاون الأمني والعسكري، مما أثار قلقًا بالغًا لدى مصر. في يناير 2020، صدق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وهو ما اعتبرته مصر تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. في رد فعل سريع، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري دون تحديدها علنًا وأعلنت مصر رفضها القاطع للتدخل العسكري التركي في ليبيا، واعتبرت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني “باطلة”. كما حذرت من أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك([71]) وفي يونيو 2020، أعلنت مصر عن “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها للجيش الوطني الليبي، ورغم ذلك، قوبل الإعلان برفض من حكومة الوفاق الوطني، التي اعتبرت ليبيا ليست في حاجة إلى مبادرات جديدة. كما اعتبرت تركيا أن هذه المبادرة محاولة لإنقاذ حفتر بعد تراجعه عسكريًا وأدت الأزمة الليبية إلى توتر العلاقات بين مصر وتركيا، حيث علقت مصر الجلسات الاستكشافية مع تركيا بعد جولات منها، وذلك بسبب خلافات بين البلدين بشأن الملف الليبي. وقد غذت القاهرة وأنقرة ذلك التوتر بتبادل سحب السفراء والاكتفاء بالتمثيل على مستوى القائم بالأعمال([72]) وبالرغم من محاولات تركيا تحسين علاقاتها مع مصر، إلا أن الملف الليبي لا يزال يشكل نقطة خلاف أساسية بين البلدين. تستمر مصر في التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، في حين ترى تركيا أن وجودها في ليبيا جاء بناءً على اتفاقيات شرعية مع حكومة الوفاق الوطني هذا التباين في المواقف يجعل من الصعب التوصل إلى توافق بين البلدين في المستقبل القريب.([73])
تعد العلاقات المصرية التركية ذات أهمية خاصة نابعة من التاريخ والموقع الجغرافي، وشهدت مراحل من التقارب والتفاعل وأخرى من التنافس والصراع، وفقًا للمتغيرات الإقليمية والدولية. لعب الموقع الجيوبوليتيكي لمصر دورًا محوريًا في تحديد سياستها تجاه تركيا، خاصة في قضيتي شرق المتوسط والأزمة الليبية. ورغم التوترات الحادة وقطع العلاقات الدبلوماسية خلال العقد الماضي، فإن المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية دفعت البلدين نحو إعادة بناء الثقة والتعاون، بما يمهد لإمكانية فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ظل تغيرات دولية متسارعة.
وفي الإطار ذاته، تكشف نتائج المبحث أن العلاقات المصرية التركية بين 2011 و2025 مرت بمرحلة توتر حاد نتيجة الصدام السياسي بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، حيث رأت القاهرة في التدخلات التركية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في ليبيا وشرق المتوسط. وبدلاً من الدخول في مواجهة مفتوحة، تبنت مصر سياسة براغماتية عبر تعزيز تحالفاتها مع اليونان وقبرص، وتثبيت حدودها البحرية عبر اتفاقيات دولية، مع رسم خطوط حمراء واضحة للتدخل التركي في محيطها، مثل إعلان «خط سرت – الجفرة» في ليبيا، مستفيدة بذلك من أدوات الشرعية الدولية والدعم الأوروبي.
المبحث الثانى: أثر المتغيرات الداخلية المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا.
شهدت مصر عبر تاريخها سلسلة من الثورات والتحولات السياسية التي تركت آثارًا عميقة على بنية الدولة والمجتمع. ومن أبرز هذه المحطات: ثورة عام 1919، التي اندلعت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى مطالبةً بالاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال البريطاني؛ وثورة 23 يوليو 1952، التي قادها مجموعة من ضباط الجيش بقيادة جمال عبد الناصر، وأسفرت عن الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية، كما أعقبتها إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة. وفي عام 2011، جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير ضمن موجة “الربيع العربي”، حيث خرجت الجماهير للمطالبة بإنهاء نظام الرئيس حسني مبارك، وأعقبها إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية. غير أن السنوات التالية اتسمت باضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية ملحوظة. وفي 30 يونيو 2013، شهدت البلاد موجة احتجاجات جماهيرية أخرى أدت إلى إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، وتولّى المستشار عدلي منصور لفترة رئاسية مؤقتة، أعقبها تشكيل حكومة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وتعد هذه الثورات محطات مهمة في تاريخ مصر وشهدت تغييرات كبيرة سواء داخل البلاد أو خارجها عن طريق علاقاتها الخارجية. وفى هذا الفصل يتم التركيز على النتائج المترتبة على كلا من ثورتي 25 يناير2011 و 30 يونيو 2013 اللتان انعكستا على السياسة الخارجية لمصر و خاصة تجاه تركيا، و كيف كانت التغيرات السياسية في مصر ذات أثر على مدى التقارب أو التباعد بين الدولتين.
أولا: العوامل السياسية.
أثر ثورة 25 يناير2011 على العلاقات المصرية التركية.
شهدت مصر في الخامس والعشرين من يناير عام 2011انطلاق حركة احتجاجية شعبية واسعة النطاق، مثّلت تحولًا مفصليًا في تاريخها السياسي المعاصر. حيث أدت إلى إعلان الرئيس مبارك تنحيه عن الحكم في 11 فبراير2011 بعدما لبث فى السلطة ما يقارب الثلاثة عقود، ونقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مثلت ثورة يناير تعبيرًا عن إرادة جماعية ضمت مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء وعمال ومثقفين، وشكّلت لحظة تاريخية لكسر حاجز الخوف وتأكيد المطالبة بالعدالة والحرية والديمقراطية. وعلى الرغم من أن الثورة فتحت الباب أمام مرحلة من التحول الديمقراطي، إلا أن ما أعقبها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية عرقل مسار هذا التحول، وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار. ومع ذلك، تظل الثورة حدثًا محوريًا في تاريخ مصر المعاصر، بما حملته من آمال للتغيير، وما أفرزته من دروس حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع([74]).
شهدت الفترة التي أعقبت ثورات الربيع العربي فى 2011 تغيرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط و التي ألقت بظلالها على العلاقات المصرية التركية لما تتمتع به الدولتين من أهمية تاريخية و جيوسياسية و ثقل دولي و إقليمي، واجهت السياسة الخارجية التركية تحديات كبيرة نتيجة التطورات التي صاحبت اندلاع الربيع العربي في 2011خاصة و أنها وضعت الدبلوماسية التركية بين اختيارين أولهم مساندة الجماهير التي انتفضت لإسقاط أنظمتها السياسية و محاولة إرساء الديموقراطية، و إما الحفاظ على تحالفاتها و علاقاتها الوثيقة مع هذه الأنظمة، و قد شكل ذلك تحديا كبيرا لمبدأ السياسة الخارجية التركية الأساسي و هو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى([75]). على الرغم من التذبذب الذي شهده الموقف التركي تجاه الثورة التونسية و الليبية إلا أن الحال كان مختلف فيما يتعلق بالثورة المصرية، فقد ظهر لتركيا موقفًا واضحًا تجاه الثورة المصرية منذ اندلاعها، و قد ظهر ذلك بوضوح من خلال التصريحات الرسمية للمسئولين الأتراك خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير، كان أبرزها الخطاب الشهير الذي وجهه أردوغان لحسني مبارك في الأيام الأولى للثورة المصرية يطالبه بالإستماع لرغبة شعبه، كما أضاف أردوغان أن التمسك بالسلطة ضد رغبة الشعب يعد عملا غير عاقل ولا أخلاقي، و أكد أن الديموقراطية لا تأتي بالراديكالية و الفوضى، كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه ردود الأفعال الدولية تتسم الحذر فيما يخص الثورة المصرية، و ذلك ما يؤكد أن العلاقات بين مصر و تركيا قبل ثورة 25 يناير كان باطنها التوتر خاصة مع تزايد الدور التركي في الشرق الأوسط و الانتقادات التي وجهتها تركيا لمصر فيها يتعلق بقضية غزة([76]).
أعلنت تركيا صراحة انحيازها إلى صف الثورة المصرية، وتم تأكيد هذا الموقف بزيارة الرئيس التركي آنذاك عبد الله جول في 3 مارس 2011 إلى مقر السفارة التركية بالقاهرة، ليكون أول رئيس يزور مصر بعد تنحي مبارك، حيث التقى بالمشير حسين طنطاوي، وأكد دعم تركيا للاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية، خاصة من خلال دعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى تجربة تركيا في التحول الديمقراطي، ومؤكدًا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وفي 12 سبتمبر 2011، قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى مصر برفقة وفد يضم 208 من رجال الأعمال الأتراك، والتقى بالمشير طنطاوي وشيخ الأزهر، وذلك في إطار دعم الثورات العربية. وفي ديسمبر من نفس العام، أُجريت مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية المصرية والتركية، استمرت لعدة أيام في ميناء إكساز الحربي والمياه الإقليمية التركية، بمشاركة عدد من القطع البحرية من الجانبين([77]).
أجريت الانتخابات المصرية في 16 و17 يونيو 2012، وأسفرت نتائجها عن فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، بفارق ضئيل على منافسه أحمد شفيق. تولّى مرسي منصب الرئاسة في ظل حالة من الفوضى والاضطرابات، وفي وقت كانت فيه تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية. وقد وجد الطرفان في بعضهما دعمًا متبادلاً؛ إذ مثّل وصول مرسي إلى الحكم فرصة لتركيا لإعادة تشكيل خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، وسعت أنقرة إلى تعزيز دورها الإقليمي من خلال شراكة مع مصر. من جانب آخر، كان الإخوان المسلمون بحاجة إلى حليف قوي، وقد شكّل النموذج التركي بقيادة رجب طيب أردوغان مصدر إلهام للحركات الإسلامية في المنطقة، واعتُبر نموذجًا يسعى الإخوان إلى تطبيقه منذ بداية توليهم السلطة. وقد مثّلت تركيا أحد أبرز الداعمين للإخوان في ظل بيئة إقليمية غير مرحّبة بالثورات، ما عزز أهمية هذا التحالف بين الطرفين.
عند دراسة العلاقات المصرية–التركية خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، تبرز أهمية التطرق إلى طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين في تلك المرحلة، باعتبارها محورًا أساسيًا لفهم مسار التقارب أو التباعد بين الجانبين.
العلاقات السياسية بين مصر وتركيا إبان فترة حكم الاخوان المسلمين.
شهدت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا تحسنًا ملحوظًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا، حيث شهدت نقلة نوعية تمثلت في تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين. وتؤكد هذه الزيارات أن العلاقات بين البلدين ذات طابع تاريخي، لم تصل إلى مرحلة القطيعة رغم ما شهدته من توترات ناتجة عن تطورات داخلية أو إقليمية، خاصة في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وقد ساهم العدوان الإسرائيلي على غزة في خريف عام 2012 في تعزيز فرص التقارب الإقليمي بين مصر وتركيا، لاسيما في ظل الموقف المصري المتغير تجاه القضية، تحت قيادة الرئيس محمد مرسي، مقارنة بموقف النظام السابق)[78].(
أثر ثورة 30 يونيو 2013 على العلاقات المصرية التركية.
في عام 2013، تصاعدت حدة الخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وباقي فئات المجتمع المصري غير المنتمية للجماعة من جهة أخرى، كما تزايدت التوترات بين الجماعة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك القضاء والإعلام والشرطة والجيش. وقد برز ذلك من خلال الحراك الشعبي الذي قادته حركة “تمرد” بجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وردّت الجماعات الإسلامية بتأسيس حركة “تجرد” لجمع توقيعات مضادة، إلا أن “تمرد” تفوقت في عدد التوقيعات)[79](. تصاعدت المطالب الشعبية بتدخل القوات المسلحة، حذّر وقتها وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسى من أن تدخل الجيش قد يُنظر إليه كانقلاب يعيد البلاد إلى الوراء، ورفض تدخل الجيش فى الحياة السياسية، ولكن تغير هذا الموقف تحت وطأة الضغوط الشعبية. وفى 30 يونيو 2013، خرجت مظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية لتولى مرسي الحكم، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما نظم أنصار جماعة الإخوان مظاهرات مضادة في مناطق عدة، أبرزها رابعة العدوية والنهضة. وفي 3 يوليو 2013، عقدت القوات المسلحة اجتماعًا مع قوى سياسية ودينية ومجتمعية، خرج بعده الفريق السيسي ببيان أعلن فيه تعطيل العمل بدستور 2012، وتشكيل لجنة لمراجعته، وتسليم السلطة مؤقتًا إلى المحكمة الدستورية العليا، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءة لإدارة المرحلة المقبلة.
تجلّت أسباب احتجاج المصريين على حكومة جماعة الإخوان المسلمين وحالة الغضب الشعبي المتصاعدة في عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ما اعتُبر محاولة من الجماعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، فيما عُرف بعملية “أخونة المؤسسات”، وهو ما قوبل برفض واسع من مختلف فئات المجتمع المصري. كما شهدت البلاد خلال فترة حكم الإخوان أزمات متكررة، تمثلت في تدهور العلاقات الدبلوماسية، وتصاعد أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، فضلًا عن تفاقم الأزمات الاقتصادية ونقص الوقود وغاز الطهي والمياه والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. إلى جانب ذلك، تدهورت الأوضاع الأمنية، حيث سُجلت حوادث خطيرة من بينها مقتل 16 جنديًا من قوات حرس الحدود في سيناء، واختطاف 7 من عناصر الأمن المصري. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تآكل الثقة بحكومة الإخوان، وأدت إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وعزله من منصبه.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أبرز الداعمين لاستمرار حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأعلن تأييده لبقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي في السلطة. وعقب أحداث يوليو 2013 التي شهدت عزل مرسي، عبّر أردوغان عن رفضه لما جرى، واعتبره انقلابًا على الشرعية الدستورية والحكم القائم آنذاك، والذي وصفه بالحكم الإسلامي. وتزامنًا مع تلك التطورات، بدأت الحكومة التركية في إطلاق تصريحات ناقدة، حيث أعرب أردوغان عن موقفه المناهض لتدخل الجيش في العملية السياسية، وذهب إلى حد اتهام إسرائيل بلعب دور في دعم الحراك الذي أدى إلى عزل الرئيس مرسي. أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع عدد من القادة المحليين في حزب العدالة والتنمية، حيث أشار إلى امتلاكه “توثيقًا” يدعم اتهامه لإسرائيل، دون أن يوضح طبيعة هذا التوثيق. وقد شكلت هذه التصريحات نقطة تحول في مسار العلاقات بين مصر وتركيا، إذ قامت أنقرة بسحب سفيرها من القاهرة، ورغم إعادته في وقت لاحق من نفس العام، إلا أن الجانب المصري صرّح بأن وجود السفير التركي لن يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين. وباستمرار تدهور العلاقات، استدعت مصر السفير التركي واعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه، ما ترتب عليه مغادرته البلاد، وردّت تركيا بالمثل، الأمر الذي أدى إلى قطيعة دبلوماسية بين الطرفين)[80](. في عام 2014، أعلنت أنقرة استقبالها لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية قد صنّفت الجماعة كمنظمة إرهابية. وقد تزايد تدفّق المعارضين المصريين إلى تركيا، خاصة بعد تعرض دولة قطر لضغوط خليجية على خلفية استضافتها لثلاثة من المعارضين المصريين، الأمر الذي أدى إلى ترحيلهم، لتُصبح أنقرة الوجهة التالية لهم. وأدى هذا المناخ السياسي إلى نشوء عدد من القنوات الإعلامية التي تبنّت خطابًا معارضًا للنظام المصري.
التقارب المصري التركي في عام2021.
سبق ذكر أن العلاقات بين تركيا ومصر تدهورت بشكل كبير في أعقاب ثورة 2013 التي أطاحت بمحمد مرسي، ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتراف بشرعية النظام الجديد بقيادة عبد الفتاح السيسي وظل متحدياً على الرغم من الاعتراف الغربي بالزعيم الجديد، كذلك فقد منع موقف أردوغان النقدي من السيسي عدة محاولات للتقارب مع القاهرة خلال العقد الماضي، و على الرغم من ذلك، فإن العديد من الأحداث الحاسمة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وفاة مرسي في عام 2019، واتفاقية العلا لعام 2021، وبداية حقبة ما بعد الانتفاضات العربية اقتضت نهجاً مختلفاً. في منتصف عام 2020، شرعت تركيا في محاولات للتقارب مع مصر استنادًا إلى المصالح المتبادلة في ملفي شرق المتوسط وليبيا. ومن منظور أنقرة، كانت الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية لمصر ملائمة لهذه الخطوة، مما أتاح لتركيا الاقتراب من القاهرة من موقع قوة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أقر فيه ضمنيًا بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تصب في مصلحة مصر، رغم المعارضة العلنية من جانب القاهرة لهذه الاتفاقية. كما أكد الرئيس التركي أن النهج القائم على المصالح من شأنه أن يعود بالفائدة على كل من تركيا ومصر في الملفين الليبي وشرقي البحر المتوسط، مما يجعل من الممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، ويعزز التعاون في القضايا الإقليمية والثنائية بما يخدم في النهاية مصلحة مصر. قدمت اتفاقية العلا لعام 2021، التي أنهت النزاع بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، إلى جانب تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، ديناميكيات جديدة في المنطقة، حيث اتجهت القوى الإقليمية نحو تعزيز التواصل، وتهدئة التوترات، وزيادة التفاعلات الاقتصادية. وقد أسهم هذا المناخ الإقليمي الجديد في تسهيل عملية التقارب بين تركيا ومصر، وعزّز التحول في السياسة الخارجية التركية نحو الدبلوماسية بعد فترة من النهج الحازم والعسكري. علاوة على ذلك، أعربت الحكومة التركية عن قلقها من احتمال استغلال المعارضة السياسية الداخلية لقضايا السياسة الخارجية قبيل الانتخابات المقررة في مايو 2023. ونتيجة لذلك، أولت أنقرة أولوية لإغلاق الملفات الإشكالية وفتح فصول جديدة مع الدول التي تربطها بها علاقات معقدة أو غير مستقرة، في عملية اتسمت بالبطء لكنها كانت ثابتة. وفي هذا السياق، شهد عام2021 الانطلاقة الرسمية لعملية التقارب بين أنقرة والقاهرة. ولتهيئة بيئة بنّاءة لهذه المحادثات، عدّلت وسائل الإعلام التركية من خطابها تجاه الحكومة المصرية، كما طالب مسؤول تركي المعارضة المصرية المقيمة في تركيا بالتكيف مع هذا التوجه([81]).
محاولات التقارب بعد عام2021 .
في أبريل 2022أظهر كافوس أوغلو تفاؤلاً بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك ليقترح إمكانية عقد اجتماع على المستوى الوزاري، وبالفعل بعد شهرين قام وزير الخزانة والمالية التركي “نور الدين النبطي” بأول زيارة رفيعة المستوى لوزير تركي إلى مصر منذ تسع سنوات. على الرغم من التقدم البطيء لكن المطرد، واجهت عملية التقارب بين تركيا ومصر عقبة جديدة في أكتوبر 2022، فوفقًا لمسؤولين أتراك، استخدمت السلطات المصرية اتفاقية الطاقة بين تركيا وليبيا كذريعة لتعليق عملية التطبيع الهشة. ومع ذلك، أسهم اللقاء القصير والمصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022 في إعادة مسار التطبيع إلى طبيعته. وعقب هذا اللقاء، أصدرت الحكومتان بيانات صحفية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مجالات مثل الاستثمار والتجارة والأمن الإقليمي. كما أعادت الحكومة التركية فتح سفارتها في القاهرة بعد عامين من الإغلاق. اكتسبت عملية التطبيع بين تركيا ومصر زخمًا جديدًا لسببين رئيسيين: الأزمات الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر، والزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير. فمن المنظور التركي، يُشير الانهيار الاقتصادي في مصر، إلى جانب التوتر في علاقاتها مع داعميها الماليين التقليديين مثل المملكة العربية السعودية، إلى حاجة القاهرة لتعزيز تفاعلاتها الاقتصادية والمالية والتجارية مع دول أخرى قدر الإمكان، بهدف التخفيف من حدة الأزمة ومنع احتمالية حدوث انفجار اجتماعي، لا سيما في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024. أما فيما يتعلق بتركيا، فقد أسهم الزلزال المدمر في زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على الحكومة، حيث قُدّرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 104 مليارات دولار. وقد جاء هذا التطور قبل أقل من شهرين من الانتخابات الحاسمة، التي يواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، للمرة الأولى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، جبهة معارضة موحدة([82]).
ثانيا: العوامل الاقتصادية.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية تطورًا ملحوظًا في مطلع القرن الحادي والعشرين، خاصة في مجالات نقل الغاز الطبيعي وإنشاء شبكة لنقل الكهرباء شملت تركيا وسوريا والأردن ومصر. وقد مثّل صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا لحظة فارقة، تزامنت مع بروز شرائح واسعة من رجال الأعمال الجدد من الطبقتين المتوسطة والصغيرة، ممن ارتبطت مصالحهم الاقتصادية بالانفتاح على أسواق الشرق الأوسط، نظرًا لصعوبة تسويق منتجاتهم ذات الميزة النسبية المحدودة في الأسواق الغربية.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
شهدت الاستثمارات التركية في مصر نموًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد الشركات التركية العاملة في السوق المصرية نحو 290 شركة بحلول أواخر عام 2009. وفي إطار استجابة الحكومة المصرية لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية المتنامية، تم تخصيص منطقة صناعية خاصة للمستثمرين الأتراك خلال المنتدى الاقتصادي المصري–التركي عام 2011، الذي حضره ما يقارب 500 من رجال الأعمال من الجانبين بهدف دفع التعاون الاقتصادي وافتتاح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلع بلاده إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار خلال عامين، على أن يصل إلى عشرة مليارات خلال أربع سنوات، مؤكدًا التزام الجانبين بإزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال. وقد سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2011 ما قيمته 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 50% عن عام 2010، في حين بلغت الواردات المصرية من تركيا نحو 2.7 مليار دولار في العام ذاته. وفي سياق متصل، التقى وزير الكهرباء والطاقة المصري، المهندس محمود بلبع، في عام 2012، بالسفير التركي لدى القاهرة حسن عوني بوصطالي ووفد من رجال الأعمال الأتراك، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة، وتم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال تبادل الخبرات ودعم الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع([83]).
أعلنت تركيا استعدادها لتقديم الدعم الفني لمصر فيما يتعلق بالتعامل مع السوق الأوروبية المشتركة، إلى جانب نقل خبراتها في هذا المجال. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والتركي لدراسة سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتحديد الاحتياجات المتبادلة، وآليات رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقد شهد المسار الاقتصادي بين مصر وتركيا تصاعدًا ملحوظًا منذ عام 2005، بلغ ذروته في عام 2010 بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي نيهات أورجون إلى القاهرة، برفقة وفد يضم 100 من رجال الأعمال الأتراك. كما كانت بورصتا مصر وتركيا على وشك توقيع اتفاق لربط البورصتين، وكان من المقرر تفعيله رسميًا في عام 2012، إلا أن تطورات الأوضاع السياسية في البلدين حالت دون تنفيذ المشروع، مما أدى إلى تجميده([84]).
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فى فترة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013.
أدت أزمة تقاسم موارد الغاز في شرق المتوسط إلى سنوات من التوتر بين أنقرة والقاهرة، لم تُظهر خلالها أي من العاصمتين مرونة تجاه الأخرى. إلا أن تعثّر أنقرة في التنقيب داخل الجرف القاري لكل من اليونان وقبرص دفعها إلى السعي نحو تحسين علاقاتها مع مصر، بعد أن جرّبت التصعيد والمواجهة الإعلامية دون جدوى.
أدت اكتشافات الغاز في العقد الأخير إلى تحولات في خريطة إمدادات الطاقة الإقليمية، وشهدت المنطقة نشوء تحالفات بين دول لم تكن على وفاق، مثل التعاون القائم بين مصر وإسرائيل. وترى دول كاليونان وقبرص أن استغلال الغاز يمثل فرصة للتخلي عن الوقود الأحفوري الملوث، في حين تسعى مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة ودفع عجلة الاقتصاد، مع تطلعات لتصدير الغاز إلى جنوب أوروبا وتقليل اعتمادها على روسيا. في المقابل، اعترضت تركيا على استبعادها من ترتيبات التعاون الإقليمي، وردت بإرسال سفن حربية لتهديد عمليات الحفر التي تقوم بها شركات دولية، وباشرت بنفسها أنشطة تنقيب في المنطقة. وسعيًا لإضفاء الطابع القانوني على أنشطتها، شرعت دول شرق المتوسط في ترسيم حدودها البحرية، ووقّعت مصر وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود في عام 2013. أما تركيا، فقد كثفت أنشطتها في غرب جزيرة قبرص الخاضعة لسيطرتها، والتي لا تحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة نفسها. وتتهم حكومة جمهورية قبرص تركيا بانتهاك حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما ترد تركيا بأن عملياتها تتم ضمن جرفها القاري ووفقًا للقانون الدولي من وجهة نظرها([85]).
شكّل ملف ترسيم الحدود البحرية أحد أبرز الأوراق التي وظّفتها مصر في إطار التنافس الإقليمي مع تركيا، حيث وقّعت مصر اتفاقًا ثنائيًا مع قبرص في عام 2013 عُرف بـ”الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون”، وصادق عليه الرئيس المصري في عام 2014. وتبرز أهمية ترسيم الحدود البحرية في تمكين الدول من الاستفادة من الثروات الطبيعية الكائنة في مناطقها الاقتصادية الخالصة، إذ لا يحق لأي دولة التنقيب أو استخراج الموارد دون ترسيم قانوني للحدود مع الدول المجاورة. وقد قوبل الاتفاق المصري القبرصي برفض تركي، بدعوى أنه ينتقص من مساحة حدودها البحرية في مناطق يُعتقد بوجود حقول غاز فيها، لصالح قبرص. في المقابل، أكدت مصر أن الاتفاق يدخل ضمن حقوقها السيادية. وتأتي أهمية الاتفاق بالنسبة لكل من مصر واليونان وقبرص من كونه يمنحها غطاءً قانونيًا للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، والتصدي لما تعتبره تجاوزًا تركيًا لحقوق قبرص. ومع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الثلاثية، أخذ النزاع بُعدًا قانونيًا، فيما وجدت تركيا نفسها خارج الترتيبات الإقليمية، فلجأت إلى التعاون مع “حكومة شمال قبرص”، التي لا تحظى باعتراف دولي سوى من قبل أنقرة نفسها. في ذلك السياق استغلت تركيا منصاتها الإعلامية وجماعة الاخوان الذين كانت قد ضمتهم تركيا وانشأت لهم قنوات اعلامية في الترويج أن الجانب المصري قد تنازل عن حقوقه لقبرص وأنه كان من الأفضل لمصر إبرام الإتفاق مع تركيا بدلا من قبرص واليونان، بعد الاتفاق أجرت مصر عمليات التنقيب في مياهها الإقليمية مما أسفر عن اكتشاف حقل ظهر المصري والذي يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
في هذا السياق، وجدت تركيا نفسها في حالة عزلة إقليمية في شرق المتوسط، نتيجة لصراعات تاريخية مع عدد من الدول الساحلية في المنطقة، وعلى رأسها اليونان وقبرص. وقد اتّسمت تحركات أنقرة خلال السنوات الأخيرة بسياسات تصعيدية، من أبرزها اعتراض السفن التي كانت تقوم بأعمال تنقيب عن الغاز والبترول قبالة السواحل القبرصية واليونانية، ما دفع اليونان إلى اللجوء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتنديد بما اعتبرته انتهاكًا لسيادتها. وفي محاولة للخروج من هذه العزلة، سعت تركيا إلى بناء تحالفات جديدة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية، عُرفت باسم “مذكرة التفاهم الليبية-التركية”. وقد نصت الاتفاقية على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وربطهما بخط أنابيب يمتد من طرابلس إلى تركيا، كما منحت أنقرة حق التدخل العسكري لحماية حكومة الوفاق. وقد أثار هذا التحرك ردود فعل إقليمية، تمثلت أولًا في طرد اليونان للسفير الليبي التابع لحكومة الوفاق، ثم في إجراء مصر مناورات بحرية واسعة النطاق على سواحلها الشمالية([86]).
ثالثا: الرأي العام والاعلام.
شهدت العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة من 2013 إلى 2023 تقلبات ملحوظة بين مراحل من التوتر والانفراج. فقد اتسمت هذه العلاقات بالتقارب والتعاون خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث لقي الدعم التركي آنذاك ترحيبًا رسميًا، على الرغم من الانتقادات المتفرقة التي كانت ترد في بعض وسائل الإعلام. إلا أن هذه العلاقات سرعان ما تدهورت بشكل حاد عقب عزل مرسي في 2013، وهو ما قوبل برفض تركي رسمي، خاصة في ظل استضافة أنقرة لعدد كبير من المعارضين المصريين، الذين تعرضوا لحملات أمنية موسعة في الداخل المصري. وقد عبّرت تركيا، في أكثر من مناسبة، عن دعمها لمسار التحول الديمقراطي الذي أعقب ثورة يناير 2011.
تصاعد الهجوم الإعلامي المصري على تركيا من 2013 إلى 2021.
شهدت العلاقات المصرية التركية قطيعة كاملة بسبب رفض تركيا الاعتراف بثورة 30 يونيو، ترتب على ذلك تصاعد لهجة الخطاب السياسي والإعلامي التركي ضد النظام الجديد، ما جعل وسائل الإعلام المصري تدير حملة رد شرسة على النظام التركي، فتصفه تارة بالإرهاب، وتارة بالفساد، وتارة أخرى بالاستبداد والديكتاتورية. فنشرت عدة صحف مصرية كالأهرام والجمهورية مقالات وتقارير تدعم الموقف المصري، وبالمثل وسائل الإعلام المرئية.
انخراط الإعلام المصري في التمهيد لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.
شهدت المعالجات الإعلامية المصرية للملف التركي تغيرات جذرية بعد إعلان تركيا في مارس 2021 استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وزادت وتيرة التهدئة من جانب الإعلام المصرى مع زيارة وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، القاهرة في 5 و6 مايو 2021، في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وإجراء محادثات “استكشافية” مع مسؤولين مصريين، بقيادة نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا، لبحث التقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين. احتفت الصحف القومية المصرية بهذه الخطورة ووصفتها بأنها تأتي في إطار العلاقات التاريخ الطويلة بين الدولتين([87]).
في ضوء ما سبق، يتبين أن المتغيرات الداخلية بأنواعها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية قد شكلت عاملاً حاسماً في توجيه ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا. فقد لعب كلا من الاستقرار الداخلي، والرأي العام، والحالة الاقتصادية دوراً مركزياً في إعادة رسم مسار العلاقات بين الدولتين، بما يعكس طبيعة التفاعل بين الداخل والخارج في صنع القرار السياسي، خاصة فى حالة قوتين إقليميتين مثل مصر وتركيا. ومن ثم، فإن فهم السياسة الخارجية المصرية لا يكتمل دون تحليل دقيق للبعد الداخلي، الذي يظل محركاً رئيسياً لتحولات الموقف الرسمي إزاء التغيرات الإقليمية والدولية.
المبحث الثالث: دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا.
كان للمتغيرات الإقليمية والدولية فى منطقة الشرق الأوسط كبير الأثر على توجهات السياسة الخارجية المصرية خاصة إزاء تركيا فى الفترة من 2011-2025. لا يمكن كذلك إهمال دور المتغيرات الداخلية سابقة الذكر فى تشكيل تلك التوجهات، فكان للاختلاف الأيديولوجي بين النظامين المصري والتركي كبير الأثر على القضايا الإقليمية بين الدولتين مثل: قضية غاز شرق المتوسط، والقضية الليبية، والتدخل التركي فى الصومال.
- قضية غاز شرق المتوسط.
يعتبر حوض شرق البحر المتوسط ثانى أكبر احتياطي الغاز الطبيعي فى العالم والذى يضم دول: اليونان، قبرص، تركيا، سوريا، لبنان، إسرائيل، فلسطين، مصر، والجزء الشمالي الشرقي من دولة ليبيا([88]). قامت دول شرق البحر المتوسط بتقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لأحكام وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وذلك بعد اكتشافات الطاقة الهائلة فى المنطقة مثل: اكتشاف حقل تمار (Tamar) وليفايثان (Leviathan) الإسرائيليين عامى 2009 و 2010 على التوالى وحقل أفروديت (Aphrodite) عام2011 ثم حقل كاليبسو (Calypso) عام 2018 فى المياه القبرصية وحقل ظهر (Zohr) المصري عام 2015 والذى عد وقتها أهم اكتشاف لحقل غاز على الإطلاق([89]). وقد أقرت الاتفاقية وجوب تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة وفقا لأحكام القانون الدولي بما يعطى الدول المتفقة فيما بينهم الحق فى استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية كالغاز الطبيعي والمعادن من خلال الدولة نفسها أو شركة تنقيب أجنبية مثلما فعلت مصر عندما أعطت حق التنقيب فى المنطقة لشركة إينى الإيطالية([90]). يتم أولا تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها “منطقة متميزة من البحر، تتاخم المياه الإقليمية للدولة وتمتد إلى ما يزيد على مائتي ميل بحري من خط الأساس العادى.”([91]) كان من الصعب بمكان أن تحدد كل دولة من دول شرق المتوسط منطقتها الاقتصادية الخالصة على حدى بسبب ضيق سواحل البحر المتوسط؛ حيث لا يسمح اتساعه بحصول كل دولة على الحدود القانونية لها من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتى أقرتها اتفاقية قانون البحار 1982 بمائتى ميل بحرى كما ذكرنا سابقا، لذلك لجأت دول الجوار الساحلية لتوقيع معاهدات ترسيم الحدود البحرية بينهم؛ فكانت أولى هذه المعاهدات بين مصر وقبرص عام 2003 والتى استندت بشكل كامل لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([92])، لحقتها فى هذا السياق اتفاقية أخرى خاصة بتقاسم مكامن الهيدروكربون بين كلا من مصر وقبرص فى ديسمبر 2013 وقام الرئيس المصري وقتها عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليها فى سبتمبر 2014 نيابة عن البرلمان المحلول([93]). تلاها مفاوضات مصرية يونانية على ترسيم الحدود البحرية بين كلتا الدولتين عام 2005 لكن لم تفلح كالمفاوضات مع قبرص بسبب الصراع اليوناني التركي الذى رأته مصر يمثل حجر عثرة فى توقيع الاتفاقية مع اليونان وقتها، ولأن مصر وقتها تحت قيادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت تسير بسياسة خارجية متوازنة فأوضحت موقفها بأن يتم حل الصراع اليوناني التركي أولا ثم التوقيع على الاتفاقية([94]).
قامت السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا فى فترة ما بعد 2013 وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى على التصدى للسياسات التركية فى شرق المتوسط بحكم كونه مجال حيوي للدولة المصرية، ورفض الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبى، والتدخل فى الأزمة السورية، وذلك يرجع للاختلاف الأيديولوجي الواضح بين الدولتين والذى تمثل فى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ورفضه الاعتراف بثورة الثلاثين من يونيو([95])، ومن هذا المنطلق قامت مصر بتوطيد العلاقات مع كلا من قبرص واليونان من خلال إعلان عدة قمم بين الدول الثلاث فى الفترة من 2014-2019 وصل عددها لسبع قمم أقيمت فى القاهرة، نيقوسيا، أثينا على التوالى([96]). تمخض عن هذه القمم عدة نتائج لعل أبرزها:
- الاتفاق على ترسيم الحدود بين كلا من مصر واليونان والذى تم فى أغسطس 2020.
- إنشاء منتدى شرق المتوسط عام ([97]2019 ( والذى جمع كلا من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين المحتلة وإسرائيل كأعضاء مؤسسين للمنتدى فى يناير 2019 ومقره القاهرة.
الجدير بالذكر أن القمة الثلاثية الخامسة والتى أقيمت فى قبرص فى نوفمبر 2017 أوضحت تفاهم قادة الدول الثلاث فى عدة قضايا إقليمية لعل أبرزها وأخطرها تجاه تركيا، اتفاق الدول الثلاث على حل القضية القبرصية وتوحيد الجزيرة المشطورة إلى نصفين؛ نصف شمالي واقع تحت السيطرة التركية منذ 1974 وإعلانها دولة مستقلة تحت مسمى جمهورية شمال قبرص التركية التى لم تلق أي اعتراف دولي سوى الاعتراف التركي، وآخر جنوبي يحظى بعضوية الاتحاد الأوروبى منذ 2004 واعتراف دولي ساحق([98])، مما جعل تركيا تؤكد على اعتراضها على تلك القمم الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وكذلك المناورات البحرية (ميدوزا5) التى أجرتها الدول الثلاث قرب سواحل رودس، وعدم اعترافها بالاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص. ولم تكتف الدولة التركية بذلك، بل قامت بالرد على المناورات البحرية (ميدوزا5) بأخرى فى شرق المتوسط باشتراك قوات أمريكية وإنجليزية وبلغارية و رومانية([99])، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية وغير الرسمية التركية الرافضة للاتفاقيات الثلاثية، وقيام تركيا أيضا من خلال بعض البوارج التابعة لها باعتراض سفينة تابعة لشركة إينى الإيطالية فى فبراير 2018 فى المنطقة الاقتصادية القبرصية مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التى تمنع التعرض للسفن المدنية([100])، تمثل الخوف التركي فى زعزعة موقف تركيا الدولي خاصة أنها تسعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتهديد مصالحها الاقتصادية والسياسية فى منطقة شرق المتوسط، مما حفز تركيا لتوقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين فى نوفمبر 2019 كرد فعل على ما سبق.
- القضية الليبية
جاء التدخل التركي فى الأزمة الليبية منذ اندلاع الثورة فى ليبيا عام 2011 وحتى الآن نتيجة لسياسة العثمانية الجديدة التى تعتبر أحد أسس السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الدول العربية التى كانت خاضعة لنفوذ الدولة العثمانية قديما، بجانب رغبة تركيا فى تضخيم مكانتها الإقليمية وتعزيز نفوذها من خلال محاولتها فى إيجاد موطئ قدم لها فى منطقة الشرق الأوسط.
اختارت تركيا فى بداية قيام الثورة الليبية على نظام معمر القذافى عام 2011 مبدأ التدخل السلمي من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية فى ليبيا، ولكن تغير الموقف التركي من التدخل السلمي إلى التدخل العسكري بطلب من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لدعمها فى مواجهة الجيش الوطنى بقيادة خليفة حفتر الذى كان يحاول الحفاظ على تماسك ليبيا بقدر المستطاع، وبالفعل تم توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية فى نوڤمبر 2019، ومن هنا بدأ التدخل العسكري التركي فعليا فى الأراضي الليبية المجاورة لمصر. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية الأمنية شملت كذلك ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين بهدف حصول تركيا على ثروات النفط والغاز الطبيعي الموجودة فى المنطقة بعد أن تم استبعادها من منتدى غاز شرق المتوسط([101]). شمل التدخل العسكري إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضى الليبية بهدف حماية المصالح الاقتصادية التركية، وإرسال الأسلحة والمرتزقة الأجانب للقتال بجانب قوات السراج، أثر هذا التدخل كثيرا على الأوضاع الداخلية الليبية من ناحية تفاقم حدة الأزمة، بالإضافة إلى تأثيره الخارجي الكبير خاصة على دول الجوار كمصر التى تعتبر ليبيا مجالا حيويا لها لوجود حدود طويلة بينهما على خط طول 25 شرقا([102]).
مثل التدخل العسكري التركي فى ليبيا تهديدا صريحا وواضحا للأمن القومي المصري الذى يعد ليبيا عمقا استراتيجيا له، فكانت الأزمة الليبية إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية نظرا لأهميتها الجيوسياسية. استندت مبادئ السياسة الخارجية المصرية على ضمان وحدة وسيادة الأراضي الليبية وعدم التدخل فى الشؤؤن الداخلية الليبية، بالإضافة إلى أحد مبادئ الدبلوماسية الرئاسية وهو مبدأ “الخط الأحمر” الذى أقره الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى هادفا به حماية الأمن القومي المصري من خلال تأمين العمق الاستراتيجي المصري فى سرت والجفرة الليبيتين([103]).
كان لمصر دوافعها القوية والمنطقية لحماية أمنها القومي من خلال سياسة “الخط الأحمر” ومنها([104]):
- حماية الدولة المصرية من خطر تدفق الإرهاب العابر للحدود، وذلك بسبب إرسال تركيا لعدد هائل من شحنات الأسلحة والمتفجرات للموانئ الليبية، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية من إسطنبول إلى طرابلس ومصراته تهدف إلى نقل العناصر الإرهابية للقتال فى صف حكومة الوفاق الوطني.
- الحفاظ على الاستقرار السياسي المصري والأمن الداخلى عن طريق تجنب صعود جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم فى ليبيا.
- محاولة الحفاظ على حدود غربية آمنة نسبيا ومنع محاولات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الداخل المصري.
- الحفاظ على دور مصر كقوة إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.
- جولات أردوغان.
قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الخرطوم فى 25 ديسمبر 2017 كأول رئيس تركي يزور السودان والتقى مع نظيره فى المنصب والأيديولوجية عمر البشير لتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الدولتين انتهت بحصول تركيا على حق إدارة جزيرة سواكن فى البحر الأحمر مما يتيح لها التواجد العسكري هناك، جاء ذلك بعدما عقدت القاهرة فى 11 ديسمبر 2017 مؤتمر هو الأول من نوعه بعنوان “الدول المشاطئة للبحر الأحمر” من منطلق كون البحر الأحمر مجالا حيويا مصريا هاما وأحد أهم طرق الملاحة البحرية الدولية والمدخل الجنوبى لقناة السويس، ثم ذهب أردوغان إلى تونس موقعا هناك مع الحكومة التونسية اتفاقيات تعاون استخباراتية وأمنية بهدف مكافحة الإرهاب، وأخيرا اختتم جولته بدولة تشاد، وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة الرئيس السيسى لتشاد فى إطار جولته الأفريقية فى أغسطس 2017 وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين القاهرة ونجامينا، هادفا أردوغان بذلك تعزيز الوجود الإقليمي التركي فى القارة الأفريقية وتحديدا فى مناطق النفوذ المصرية([105]).
- القاعدة العسكرية التركية فى الصومال.
قامت تركيا فى سبتمبر 2017 بافتتاح أول قاعدة عسكرية لها فى الصومال على مساحة 400كم مربع، وبتكلفة تبلغ 50 مليون دولار تقريبا، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز نفوذها فى إفريقيا أسوة بالقوى الدولية كروسيا والصين والقوى الإقليمية كمصر وإسرائيل، وكذلك بهدف تطويق مصر والتدخل فى عمقها الاستراتيجي عند باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي التى تمثل امتدادا حيويا لها([106]). قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات ثنائية أمنية مع الصومال مرة أخرى فى فبراير 2024، ومن قبلها إثيوبيا التى وقعت مع إقليم أرض الصومال فى يناير 2024 اتفاقية تهدف لحصول أديس أبابا على منفذ بحري تجارى وقاعدة عسكرية فى ميناء بربرة مقابل الاعتراف بدولة أرض الصومال، وجاء الرد المصري فى أغسطس من نفس العام بتوقيع اتفاقية دفاعية مع الصومال وإرسال معدات عسكرية وأفراد من الجيش المصري إلى الصومال([107])
تحولت السياسة الخارجية التركية تجاه مصر تحولا جذريا من القطيعة إلى التودد بناء على عدة أسباب منها السياسية والاقتصادية والثقافية، ولكن كان أبرزها الدعم المصري السريع لتركيا وقت وقوع زلزال فبراير 2023، حيث سارعت مصر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أنقرة على الرغم من العلاقات السياسية المتوترة بينهما، لكن جاء هذا الدعم تطبيقا للسياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم القضايا الإنسانية، وكان من مظاهر الدعم المصري لتركيا أيضا زيارة وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري فى فبراير 2023 بهدف إظهار التضامن المصري لتركيا. كانت اللبنة الأولى على طريق هذا التحول هو اللقاء بين الزعيمين المصري والتركي على هامش مونديال قطر لكرة القدم عام 2022، ثم توالت اللقاءات بينهما على هامش قمة العشرين فى الهند، وصولا إلى زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024 وقد نتج عن هذه الزيارة تأسيس المجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية، كما كانت عودة التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء بين البلدين فى يوليو 2023 خطوة قوية على طريق التعاون بين القوتين الإقليميتين[108].
ختاما، تنطلق السياسة الخارجية المصرية من السعى للحفاظ على مصالحها الحيوية فى منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من التراجع الذى أصابها فى الفترة من 2011-2013 إلا أنها لم تتأثر كثيرا بل وعادت بقوة لممارسة دورها فى حماية الدولة المصرية من الهيمنة التركية. واستطاعت مصر بقيادتها الحكيمة التصدى لمحاولات التطويق والسياسات الاستفزازية التركية بحكمة وهدوء دون اللجوء إلى الأداة العسكرية، فكانت السياسة الخارجية المصرية عامة وتجاه تركيا خاصة سياسة نشطة محددة الأهداف.
يتضح من إجمال ما تم مناقشته حول تأثير البعد الجيوبولتيكي، والمتغيرات الداخلية، والمتغيرات الإقليمية والدولية على العلاقات المصرية التركية بين عامي 2011 -2025 أن هذه العوامل تفاعلت بشكل متكامل في تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا. حيث لعب البعد الجيوبولتيكي دورًا حاسمًا في تحديد ملامح السياسة الخارجية المصرية، خاصة تجاه قضية شرق المتوسط والأزمة الليبية، بينما أثرت المتغيرات الداخلية مثل التغيرات السياسية على مواقف مصر تجاه التدخلات التركية. من جهة أخرى، كانت المتغيرات الإقليمية والدولية، مثل التطورات في علاقات مصر مع اليونان وقبرص وموجة التطبيع العربي، عوامل أساسية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. وقد تمكنت مصر من توظيف أدوات القانون الدولي لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، لا سيما في ملف الحدود البحرية، مما يعكس مرونة وذكاء في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية لضمان أمنها واستقرارها وتعزيز مكانتها الإقليمية، فى إطار مبدأ المكسب للجميع الذى حكم السياسة الخارجية المصرية منذ تولى الرئيس السيسي سدة الحكم.
الفصل الثالث
أثر البعد الجيوبولتيكي على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل فى الفترة من 2011 إلى 2025.
فرض موقع مصر الجغرافي عليها جاراً جديداً ذو طبيعة توسعية كان عليها التعامل معه بحذر وذكاء، فرضت العلاقة مع إسرائيل، بوصفها طرفاً فاعلاً في منطقة الشرق الأوسط والمشتركة بحدود سياسية وتاريخ من المعارك الدامية ومعاهدات السلام مع مصر تحدياً جديداً على السياسة الخارجية المصرية تمثل فى محاولة خلق فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال حل الدولتين، لذا يسعى هذا الفصل إلى تحليل كيف أثر البعد الجيوبوليتـيكي على مسار السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، مع التركيز على الفترة من 2011 حتى 2025 لما اتسمت به من تقلبات وتحولات عميقة على المستويين الداخلي والإقليمي.
المبحث الأول: الأثر الجيوبوليتيكي لمصر على سياستها الخارجية تجاه إسرائيل.
يعتبر مفهوم الجيوبولتيك من المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، حيث يشير إلى تأثير العوامل الجغرافية على السياسة والعلاقات بين الدول. يُعَرَّف الجيوبولتيك بأنه دراسة العلاقة بين المكان والقوة السياسية، وكيفية تأثير الجغرافيا على قرارات السياسات الداخلية والخارجية للدول. ويُفهم من هذا أن الدولة ليست مجرد كيان ثابت، بل هي كائن حي يتأثر بالبيئة الجغرافية ويعمل على النمو والتوسع وفقًا لمصالحه الاستراتيجية. يبرز هذا المفهوم بشكل خاص في السياسة المصرية تجاه إسرائيل، حيث أن الجغرافيا تُعتبر عاملاً محوريًا في تشكيل المواقف السياسية لمصر في الصراع العربي الإسرائيلي. على الرغم من التحديات التي تطرحها الحدود الجغرافية والمصالح الأمنية، تبقى العلاقة مع إسرائيل مسألة استراتيجية تتداخل فيها الأبعاد الجيوبولتيكية بشكل كبير. في هذا السياق، تُظهر الحرب عام 1948 وتحولاتها في السياسة المصرية تجاه إسرائيل أن الجغرافيا لا تقتصر على البُعد العسكري فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية التي تُؤثر في التفاعلات الإقليمية والدولية.
الأبعاد الجغرافية لحرب 1948 ودورها في تشكيل السياسة المصرية.
تعد الحركة الصهيونية أحد الأسباب الجغرافية الرئيسية التي أشعلت حرب 1948، حيث سعت لإقامة دولة يهودية في فلسطين، وهي فكرة نمت في سياق معاداة السامية في أوروبا. كانت فلسطين بالنسبة لليهود أرضًا تاريخية مقدسة، وهو ما جعل من الضروري بالنسبة لهم إنشاء دولة فيها. بعد الهولوكوست، أصبح إنشاء الدولة اليهودية أكثر إلحاحًا، مما زاد من التوترات في المنطقة وجعل العرب يعتبرون هذا التوجه تهديدًا لوجودهم في الأرض التي يقطنوها([109]). ويعد الهدف الجيوبولتيكي الأعلى لإسرائيل هو إقامة “إسرائيل الكبرى” ذات هوية يهودية نقية كقوة إقليمية مهيمنة في الشرق الأوسط. لتحقيق ذلك، تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها الجيوبولتيكي، والسيطرة على مصادر المياه، وفرض شرعيتها على الأراضي المحتلة مع إخلائها من السكان العرب. يتم تنفيذ هذا عبر استراتيجيات الردع العسكري، والاستيطان، وتهويد الأراضي، بالإضافة إلى تعزيز سيطرتها السياسية، والاقتصادية والثقافية في المنطقة مع الاعتماد على الذات عسكريًا واقتصاديًا([110]). أثار التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة قلقًا عميقًا لدى مصر وسائر الدول العربية، إذ تنظر مصر إلى هذه الأراضي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة أمنها القومي. وترى أن إقامة دولة يهودية قد تتيح لإسرائيل فرصة تعزيز نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة، الأمر الذي يُعد تهديدًا للتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط. أسفرت حرب 1948 عن تغييرات جغرافية وسياسية كبيرة في المنطقة. أدت الحرب إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية جسيمة، حيث قُتل العديد من الجنود والمدنيين في المجازر مثل مجزرة دير ياسين، التي راح ضحيتها 245 شخصًا. كما أسفرت الحرب عن تهجير أكثر من 900,000 فلسطيني من أراضيهم، مما خلق أزمة لاجئين ضخمة وما يزال هذا الموضوع يمثل نقطة خلاف مستمرة بين العرب واليهود. من الناحية الجغرافية، تغيرت خريطة المنطقة بشكل جذري بعد الحرب، حيث فرضت إسرائيل سيطرتها على معظم الأراضي التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية وفقًا لخطة الأمم المتحدة للتقسيم، مما غير التوازن الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحرب عن الانقسامات في العالم العربي، حيث كانت الدول العربية غير منسقة بشكل فعال في مواجهة إسرائيل، وهو ما أضعف الموقف العربي بشكل عام([111]).
أثر المصالح الإسرائيلية والأوروبية على العدوان الثلاثي على مصر 1956.
شكّل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حدثاً محورياً في تاريخ المنطقة، حيث تعاونت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل للهجوم على مصر بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لمصالح القوى الاستعمارية. سعت بريطانيا وفرنسا إلى حماية نفوذهما الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، بينما شاركت إسرائيل لأسباب أمنية تتعلق بموقف عبد الناصر العدائي تجاهها، ودعمه للمقاومة الفلسطينية، وإغلاقه مضيق تيران، ما شكّل خنقًا اقتصاديًا لها. حيث تم تنسيق خطة الهجوم عبر اتفاقية “سيفر”، وبدأت بهجوم إسرائيلي على سيناء، تبعته محاولة تدخل بريطاني-فرنسي بذريعة فرض الانسحاب من قناة السويس، بينما الهدف الحقيقي كان إسقاط نظام ناصر وإنهاء المد القومي العربي.
ولا يمكن فهم دوافع إسرائيل إلى المشاركة في العدوان دون التطرق إلى البُعد الجغرافي والاستراتيجي لمصر. فمصر، بموقعها المحوري عند ملتقى القارات الثلاث، وبسيطرتها على قناة السويس التي تُعد من أهم الشرايين الملاحية في العالم، تمثل عقدة استراتيجية لأي قوة إقليمية أو دولية تطمح للهيمنة على الشرق الأوسط. ومن منظور إسرائيلي، فإن سيناء تمثل عمقًا استراتيجيًا حاسمًا على حدودها الجنوبية، إذ تفصلها عن الأراضي المصرية مساحات صحراوية شاسعة، توفر لها – إذا ما كانت خالية من الوجود العسكري المصري – مجالًا آمنًا لمناورة قواتها، وإبعاد ساحة القتال عن المراكز السكانية الإسرائيلية. ولذلك، سعت إسرائيل من خلال مشاركتها في العدوان إلى ضرب القوة العسكرية المصرية المتمركزة في سيناء، وضمان حرية الملاحة في خليج العقبة، وردع مصر عن الاستمرار في دعم حركات المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تأكيد قدرتها على المبادرة عسكريًا وسياسيًا، بالتوازي مع القوى الكبرى.
وبذلك، فإن العدوان الثلاثي لم يكن مجرد رد فعل على تأميم القناة، بل كان أيضًا تجسيدًا لصراع مركّب، تداخلت فيه أطماع استعمارية أوروبية مع مصالح أمنية إسرائيلية([112]) .
أثر حرب 1967 على التحولات الجغرافية والاستراتيجية في الشرق الأوسط.
مثّلت حرب يونيو 1967 محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي–الإسرائيلي، ليس فقط لما خلفته من نتائج ميدانية فادحة على الدول العربية، بل أيضًا لما كشفت عنه من أبعاد استراتيجية كانت حاسمة في اتخاذ القرار المصري بالمشاركة في الحرب. فقد تداخلت الاعتبارات الجغرافية والعسكرية والسياسية بشكل معقد، وأسهمت في تشكيل مشهد إقليمي جديد أعاد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.
شهدت منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات خلال النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين، الأمر الذي مهّد الطريق نحو اندلاع حرب عام 1967. وقد تنوعت أسباب هذه الحرب بين اعتبارات سياسية وعسكرية وجغرافية، حيث ساهمت عدة وقائع في إشعال فتيل الصراع. فاندلعت الأزمة عام 1966 عندما هاجمت إسرائيل قرية السموع بالأردن، متذرعة بوجود فدائيين فلسطينيين. ثم تصاعد التوتر أوائل عام 1967 باتهام إسرائيل لسوريا بدعم الفدائيين، ووقع اشتباك جوي بين الطرفين. ردت مصر بإعلان التعبئة العامة دعمًا لسوريا، ثم أغلقت مضايق تيران في مايو من نفس العام، ما اعتبرته إسرائيل تهديدًا مباشراً. وكانت مصر منهكة عسكريًا بسبب تورطها في حرب اليمن، مما أضعف جاهزيتها لأي حرب.
وعلى الجانب المصري، لم يكن قرار التصعيد مجرد استجابة لتحالفات سياسية أو التزامات قومية، بل جاء أيضًا انطلاقًا من إدراك عميق لأهمية البعد الجغرافي في المعادلة الاستراتيجية. فقد شكّلت أراضي سيناء وقطاع غزة أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي الحساس، بل أيضًا لما تحتويه من موارد طبيعية حيوية، مثل المياه والمعادن. كانت هذه المناطق بمثابة حاجز دفاع طبيعي يقي مصر من أي تمدد عسكري إسرائيلي محتمل نحو أراضيها. كما أن سيطرة إسرائيل على مضايق تيران – التي تُعد منفذًا استراتيجيًا للملاحة في البحر الأحمر – مثلت تهديدًا مباشرًا للسيادة المصرية على أهم الممرات المائية، وأضعفت من قدرتها على التحكم في حركة التجارة البحرية. وبالتالي، فإن فقدان السيطرة على هذه المناطق كان يعني فتح الباب أمام توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر، فضلًا عن إحداث خلل في موازين القوى الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
بعد الحرب، أصبحت إسرائيل تسيطر على أراضٍ استراتيجية شملت سيناء، الجولان، الضفة الغربية، وغزة. هذه السيطرة الجغرافية أعطت إسرائيل عمقًا دفاعيًا كبيرًا وتحكمًا في المناطق الحيوية مثل منابع المياه، خاصة في نهر الأردن. لكن على الجانب الآخر، كانت هذه السيطرة الجغرافية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن مصر والدول العربية المجاورة، مما دفعهم إلى البحث عن حلول لاستعادة هذه الأراضي. ومن الناحية الجيوبولتيكية، أدى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة، حيث أضعف الموقف العربي وزاد من تعقيد العلاقات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط([113]) .
حرب 1973 واستعادة التوازن الجيوسياسي في المنطقة.
من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، كانت إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة بعد حرب 1967، مثل سيناء وقطاع غزة والقدس الشرقية، مما جعلها قوة إقليمية مهيمنة في المنطقة. كما أن احتلال مرتفعات الجولان ونهر الأردن وفر لإسرائيل تفوقًا استراتيجيًا بوجود مناطق دفاعية قوية، وهذا أدى إلى زيادة التوترات مع الدول العربية التي كانت تسعى لاستعادة أراضيها والحفاظ على أمنها القومي. من جهة أخرى، كان الهدف الجيوبولتيكي للعرب هو تحرير هذه الأراضي واستعادة توازن القوى في المنطقة، خصوصًا مصر التي كانت ترى أن استعادة سيناء يشكل جزءًا أساسيًا من أمنها الجغرافي. هذا الصراع الجغرافي أدى إلى حالة من الجمود السياسي بين الدول الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) وتفاقم التوترات العسكرية في المنطقة.
عودة سيناء وإعادة رسم الحدود.
تُعد عودة سيناء إلى السيادة المصرية حدثًا بالغ الأهمية في التاريخ الجغرافي والجيوبوليتيكي لمصر والمنطقة. فشبه جزيرة سيناء تُشكل موقعًا استراتيجيًا فريدًا يربط بين قارات آسيا وأفريقيا، وتُعدّ همزة وصل بين المشرق والمغرب العربي، فضلًا عن إشرافها الحيوي على مضيقَي تيران وقناة السويس، ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا عسكريًا واقتصاديًا بالغ الحساسية. لذا، فإن استعادتها لم تكن مجرد استرداد لأرض محتلة، بل كانت استعادة لكامل التوازن الجغرافي المصري، وتأمينًا لحدود الدولة ومصالحها الحيوية.
اتخذت مصر خيار التفاوض بعد حرب أكتوبر 1973 من منطلق إدراكها لميزان القوى الإقليمي والدولي، وسعيًا لترسيخ وضع جغرافي أكثر أمنًا واستقرارًا. وقد مثّل مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر 1978 نقطة التحول الجيوبوليتيكية الكبرى، حيث أسفر عن تفاهمات استراتيجية بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، هدفت إلى إنهاء حالة الحرب وإعادة ترسيم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط. وقد أكدت وثيقة “إطار السلام” على مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن كإطار مرجعي لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، ما عكس توجهًا نحو تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية بدلًا من الصدامات العسكرية. لم تكن معاهدة السلام الموقعة في مارس 1979 مجرد وثيقة سياسية، بل خريطة جديدة أعادت لمصر عمقها الجغرافي في سيناء. وقد تم تنفيذ الاتفاق على مراحل، وهو ما يُظهر البعد التخطيطي والاستراتيجي للانسحاب، حيث بدأت باستعادة العريش ووُجهت الأنظار تدريجيًا نحو عمق سيناء، إلى أن تحقق الانسحاب الكامل في أبريل 1982، الذي اعتُبر إعلانًا رسميًا لعودة سيناء إلى الحضن الوطني، في مشهد حمل دلالات السيادة والاستقرار الجغرافي. أما قضية طابا، فقد أكدت على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لكل شبر من أراضيها، حيث تمسكت مصر بموقعها الجغرافي وحدودها المعترف بها دوليًا، ولجأت إلى التحكيم الدولي وفقًا لنصوص معاهدة السلام. وانتصار مصر في هذا الملف في 1988، ورفع العلم على طابا في مارس 1989، لم يكن فقط لحظة سيادية، بل كان تثبيتًا لمبدأ الحسم القانوني في النزاعات الجغرافية، ورسالة بأن الحفاظ على الأرض لا يتوقف عند الحروب، بل يشمل أيضًا أدوات الجيوبوليتيكا الحديثة، وعلى رأسها القانون الدولي والدبلوماسية. بذلك، شكّل استرداد سيناء بأكملها، بما في ذلك طابا، إعادة تكوين للخرائط السياسية والاستراتيجية للمنطقة، وأعاد لمصر دورها المحوري كمركز توازن إقليمي وجغرافي يمتلك أدوات الصراع والتفاوض في آنٍ واحد([114]) .
الأهمية الجيوبولتيكية للشرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
يرتكز مشروع “الشرق الأوسط الكبير” على الأهمية الجيوبوليتيكية للمنطقة، ويُعد مشروعًا صهيونيًا خططت له إسرائيل، وتبنّته الولايات المتحدة للترويج له دوليًا وفرضه على العالم العربي.
ظهر المصطلح لأول مرة مع المؤرخ اليهودي البريطاني برنارد لويس، الذي دعا لتفكيك الدول العربية على أسس طائفية وعرقية بهدف إعادة إخضاعها لسيطرة استعمارية جديدة، وشكّل تصوره الأساس الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي سرًا عام 1983. رُوّج للمشروع على أنه يسعى للديمقراطية والتنمية، لكن هدفه الحقيقي كان تفكيك الدول العربية، تغيير أنظمتها، فرض الهيمنة الأمريكية، ودمج إسرائيل في المنطقة، مع طمس الهوية العربية والإسلامية.
استخدمت الولايات المتحدة أدوات متعددة لتنفيذ المشروع، منها السياسية كدعم حركات التمرد والثورات، والدعوة لتغيير الأنظمة بالقوة، والعسكرية من خلال غزو دول مثل العراق وأفغانستان، وبناء قواعد عسكرية. كما استخدمت أدوات إعلامية لتلميع صورتها، وقنوات فضائية لنشر أفكارها، وأدوات فكرية لتشويه صورة الإسلام، وتحطيم الثقة في صلاحية الدين كمنهج للحكم. واجه المشروع مقاومة قوية من عدة أطراف، أبرزها الحركات الإسلامية مثل حركة حماس التي رفضت الاعتراف بإسرائيل، وحزب الله الذي عارض المشروع واعتبره استعمارًا جديدًا. كما واجه رفضًا شعبيًا واسعًا داخل المجتمعات الإسلامية، واعتراضًا من قوى دولية مثل روسيا التي سعت للحد من التوسع الأمريكي في المنطقة.
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير يعكس رؤية جيوسياسية عميقة تسعى للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط عبر إعادة تشكيلها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لتسهيل دمج إسرائيل في المحيط الإقليمي وضمان المصالح الأمريكية في ظل الصراعات العالمية على الطاقة والنفوذ([115]) .
طوفان الأقصى والتحديات الجغرافية والسياسية لمصر في ظل التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي.
من منظور جغرافي–جيوبوليتيكي، تتأثر العلاقة بين مصر وإسرائيل تأثرًا بالغًا بتطورات الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وخصوصًا ما حدث في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023. هذا الهجوم غير المسبوق، الذي جاء في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، أثبت أن الصراع لا يزال قادرًا على قلب موازين الأمن والسياسة في المنطقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على مصر بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها التاريخي بالقضية الفلسطينية.
تمثل سيناء خط الدفاع الجغرافي الأول لمصر تجاه قطاع غزة، وهو ما يجعل القاهرة معنية أمنيًا بكل تصعيد يحدث في القطاع، لا سيما إذا ما نتج عنه تحركات مسلحة، أو محاولات تهريب، أو تدفقات لاجئين، وهو ما يعزز من ضرورة تأمين الحدود وضبط المجال الأمني في شمال سيناء. ولأن مصر تتشارك حدودًا مع غزة من جهة، ومع إسرائيل من جهة أخرى، فهي تمثل طرفًا محوريًا في تهدئة النزاعات وحماية استقرار الإقليم. في المقابل، تشكّل تداعيات العملية ضغوطًا على مصر دبلوماسيًا، حيث أنها تلعب دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا سيما حماس، ما يتطلب منها الحفاظ على توازن دقيق بين مواقفها السياسية الثابتة تجاه حقوق الفلسطينيين، وبين علاقتها الأمنية والسياسية مع إسرائيل والولايات المتحدة. كما أن استمرار العنف في غزة وما يقابله من ردود فعل إسرائيلية عنيفة يضع مصر في موقع الحذر الجيوسياسي، نظرًا لاحتمالات تفاقم الأوضاع وتوسّع رقعة المواجهة إقليميًا، خاصة إذا ما تسببت الحرب في تهديد الملاحة في قناة السويس أو أي من المصالح الحيوية في البحر الأحمر. كما أن أي تدهور في وضع السلطة الفلسطينية مقابل تصاعد نفوذ حماس، يضع مصر أمام تحدي جديد، إذ أن القاهرة تحتفظ بعلاقة استراتيجية مع السلطة وتؤمن بضرورة استمرارها كطرف شرعي في أي تسوية مستقبلية. وبالتالي، فإن ما حدث يعيد خلط أوراق المشهد السياسي الفلسطيني، ويزيد من تعقيد معادلة “من يتحدث باسم الفلسطينيين”، الأمر الذي يعقّد من جهود الوساطة المصرية.
على الجانب الجيوسياسي الأوسع، فإن العملية العسكرية أثرت أيضًا على مفاوضات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية كالسعودية. ويهم مصر استقرار تلك العلاقات في إطار إقليمي يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية. ولكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد الاستيطان والاعتداءات على المقدسات الإسلامية، يجعل أي انفتاح عربي على إسرائيل مرهونًا بتقدّم ملموس في ملف الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكّل أرضية تقارب في الرؤية المصرية مع بعض الدول الإقليمية. بالتالي، فإن عملية “طوفان الأقصى” تمثل نقطة تحوّل في التوازنات الجيواستراتيجية، وتفرض على مصر إعادة تقييم أدواتها في التعامل مع أطراف الصراع، كما تستدعي تنسيقًا أمنيًا ودبلوماسيًا أكثر حساسية لضمان استقرار حدودها، ودورها الإقليمي كوسيط مؤثر، وحامي لمصالحه الحيوية في بيئة شرق أوسطية مضطربة([116]).
يتضح أن الجيوبولتيك يعكس تفاعل القوى السياسية مع البيئة الجغرافية المحيطة بها، حيث تلعب الجغرافيا دورًا محوريًا في تشكيل السياسات الاستراتيجية للدول. فبالنسبة للسياسة المصرية تجاه إسرائيل، كان الموقع الجغرافي لمصر أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تحديد استراتيجياتها السياسية والعسكرية. تطورت هذه السياسة استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهتها مصر على مدار السنوات. من خلال هذه التطورات، تبين أن السياسة المصرية اتسمت بالمرونة والتوازن بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، وهو ما تجسد في اتفاقية كامب ديفيد والعلاقات التي نشأت عنها. وايضاً أن الجغرافيا لا تؤثر فقط على الحدود المادية للدولة، بل تساهم في تشكيل التوجهات السياسية والتكتيك الدبلوماسي، مما يبرز أن العلاقة بين الجغرافيا والسياسة تتجاوز الحدود التقليدية لتشمل جميع القوى المؤثرة في مسار الدولة.
المبحث الثاني: أثر المتغيرات الداخلية المصرية علي السياسية الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
شهدت السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل منذ عام 2011 تحولات جوهرية، تأثرت بصورة مباشرة بالتغيرات العميقة التي طرأت على الداخل المصري، سياسيًا ومجتمعيًا. فقد مثلت ثورة 25 يناير 2011 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الحراك الشعبي والسياسي، أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبروز قوى سياسية وشعبية جديدة أعادت تشكيل المشهد العام للدولة. تبع ذلك صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم عبر الانتخابات الرئاسية لعام 2012، حيث تبنت رؤية أيديولوجية خاصة انعكست على إدارة الدولة داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ما يخص العلاقة مع إسرائيل. إلا أن فشل الجماعة في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، وتزايد الرفض الشعبي لها، مهّد الطريق لثورة 30 يونيو 2013، التي مثلت نقطة تحول جديدة في السياسة المصرية، تبعها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014. وعليه، شهدت السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل تغيرات واضحة في كل مرحلة، إذ انتقلت من الحذر والتوازن المرتبط بالإرادة الشعبية بعد الثورة، إلى التذبذب والتناقض خلال فترة حكم مرسي، ثم إلى نهج استراتيجي منضبط في عهد السيسي يركز على الأمن القومي والتوازنات الإقليمية. ومن هنا تبرز أهمية تحليل هذه المراحل المختلفة لفهم كيف أثرت المتغيرات السياسية الداخلية في توجهات مصر الخارجية، وبشكل خاص تجاه إسرائيل، في ضوء التحديات الإقليمية والداخلية المستمرة.
أولاً: المتغيرات السياسية الداخلية.
شهدت مصر تحولات سياسية داخلية عميقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بدأت بإنهاء نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتفكيك نمط السلطة المركزية، مما أتاح بروز قوى سياسية وشعبية جديدة سعت لإعادة تشكيل النظام السياسي. أعقب ذلك فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي مثلت تحولًا في بنية السلطة لكنها اتسمت بالاضطراب والانقسام، وانتهت بعزل الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات 30 يونيو 2013. تلا ذلك صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد ترسيخ هيبة الدولة المركزية بقيادة المؤسسة العسكرية، مع تركيز على الاستقرار السياسي ومحاربة الإرهاب وإعادة ضبط المشهد السياسي والإعلامي. وقد انعكست هذه المتغيرات على جميع مناحي الحياة السياسية في مصر، بما في ذلك إدارة السياسة الخارجية، التي أصبحت أكثر تحفظًا ومرتبطة برؤية أمنية واستراتيجية تهدف إلى استعادة الدور الإقليمي مع الحفاظ على التوازنات الدولية. وانطلاقا من ذلك سيتم تناول مراحل التحول السياسي الداخلي من خلال:
- ثورة 25 يناير 2011.
شهدت ثورة 25 يناير 2011 حدثاً مفصلياً في تاريخ مصر المعاصر، حيث تمثلّت في لحظة فارقة أنهت نظاماً سياسياً امتد منذ ثورة 23 يوليو 1952، وفتحت الباب أمام تغييرات سياسية واجتماعية واسعة. وقد طرحت الثورة تساؤلات عميقة حول طبيعة النظام السياسي والعلاقات الخارجية لمصر، لا سيّما في ما يتعلق بعلاقاتها مع إسرائيل. إذ مثّلت الثورة لحظة فارقة في إعادة تقييم هذه العلاقة من منطلقات جديدة ترتبط بالإرادة الشعبية والمصالح القومية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة العلاقة المصرية-الإسرائيلية بعد الثورة في ضوء التحولات الداخلية والإقليمية، لفهم كيف أثرت الثورة على هذه العلاقة، وما إذا كانت قد أفضت إلى تغيير جوهري في مسارها.([117])وقد ترتب علي هذه الثورة تحولات واضحة أثرت علي توجهات الدولة. تتمثل في:
- انتقال من سياسة خارجية محدودة إلى توجه أكثر انفتاحًا قبل ثورة يناير.
تميزت السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك، خاصة في عقده الأخير، بالجمود والانغلاق، حيث تمحورت العلاقات الخارجية حول الغرب فقط، وتم إهمال محاور إقليمية ودولية مهمة، مثل القارة الإفريقية ودول حوض النيل. هذا القصور انعكس على العلاقة مع إسرائيل أيضًا، حيث سادت علاقة “سلام بارد” تعتمد على التنسيق الأمني فقط دون تطوير سياسي أو شعبي، وتم تهميش القضية الفلسطينية تدريجيًا. الثورة جاءت لتعيد إحياء هذه الملفات، وفرضت على الدولة التفكير في إعادة صياغة علاقاتها الخارجية بناءً على مصلحة قومية شاملة، ومنها ملف العلاقات مع إسرائيل.([118])
- تغير في بيئة اتخاذ القرار السياسي.
خضعت العلاقة مع إسرائيل لتوازنات جديدة بين المؤسسة العسكرية، والرأي العام، والتيارات السياسية. وهو ما يعني أن سياسة مصر تجاه إسرائيل أصبحت أكثر حذرًا وتوازنًا، تراعي التزامات الدولة من جهة، والمزاج الشعبي الرافض للتطبيع من جهة أخرى.([119])
- الحفاظ على اتفاقية السلام مع تعديل في الأسلوب.
رغم الضغوط الشعبية والسياسية، حرصت الدولة المصرية على استمرار اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لكنها أعادت ضبط العلاقة بشكل لا يغضب الداخل ولا يهدد المصالح الاستراتيجية. هذا التوازن كان واضحًا في استمرار التنسيق الأمني، مع غياب اللقاءات الرسمية البارزة أو مظاهر التطبيع الاقتصادي والثقافي.([120])
- الانتخابات الرئاسية 2012 ووصول جماعة الإخوان إلى الحكم
مثّلت انتخابات الرئاسة عام 2012 لحظة فارقة في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير، كونها أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، وجرت وسط مطالب بتسليم السلطة من المجلس العسكري لحكم مدني. انتهت الجولة الثانية منها بفوز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الذي أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. ومع توليه الحكم، دخلت مصر مرحلة مليئة بالتحديات، في ظل تطلعات لتحقيق أهداف الثورة، لكن سرعان ما ظهرت إخفاقات كبيرة داخليًا وخارجيًا. فقد ركزت جماعة الإخوان على مشروعها الديني والسياسي، مما أضعف المصالح الوطنية وأدى لتراجع الدور المصري في ملفات استراتيجية مثل سد النهضة وأمن سيناء وحلايب وشلاتين. كما زاد الانقسام السياسي والمجتمعي، وتنامى نفوذ الجماعات المتشددة بفعل قرارات العفو، مما ساهم في تدهور الأمن والاقتصاد، وعمّق التوترات الداخلية، وتسبب في عزلة سياسية نسبية وفقدان مصر لمكانتها الإقليمية والدولية..([121])
السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي (2012-2013).
اتسمت سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بالاختلاف عن النهج التقليدي، حيث سيطرت الاعتبارات الأيديولوجية والدينية على حساب الرؤية الاستراتيجية المعتادة. سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على توجيه السياسة الخارجية بما يخدم مشروعها الفكري، مما أدى إلى تهميش دور المؤسسات السيادية كوزارة الخارجية والمخابرات العامة، واستبدالهما بشبكات ولاء حزبية وتنظيمية. ونتيجة لذلك، تم تغليب المعايير الأخلاقية وفقًا لرؤية الجماعة على حساب المصلحة الوطنية، مما أضعف كفاءة الدولة في إدارة ملفاتها الخارجية، خاصة وسط التغيرات الإقليمية بعد ثورات الربيع العربي.
خلال تلك الفترة، تراجعت مكانة مصر إقليميًا، وغابت عن المبادرات الكبرى، وتدهورت علاقاتها ببعض دول الخليج، وتأثرت قدرتها على التأثير في قضايا مثل الأزمة السورية وسد النهضة. كما أدى تركيز الجماعة على البعد الديني إلى تحالفات مثيرة للجدل، مثل التقارب مع إيران، ودعم المعارضة السورية بما يتماشى مع الإسلام السياسي لا مع سياسات مصر التقليدية. أدى ذلك إلى تراجع دور وزارة الخارجية، وربط القرارات الخارجية بمصالح الجماعة، ما ساهم في تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للنظام حتى الإطاحة به في 2013([122])
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي باعتبارها نموذجًا لتلك التحولات، إذ اتسمت تلك السياسة بالتذبذب والتناقض بين الخطاب الأيديولوجي والممارسات الواقعية. فعلى الرغم من أن مرسي كان منتميًا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي طالما تبنّت خطابًا رافضًا لإسرائيل ومعاهدة السلام معها، إلا أن فترة حكمه لم تشهد أي خطوات فعلية للمساس بتلك المعاهدة. بل على العكس، استمر التعاون الأمني مع إسرائيل، لا سيما في سيناء، التي شهدت اضطرابات أمنية وازديادًا في النشاط الإرهابي عقب الثورة، ما استدعى تنسيقًا مشتركًا لضبط الأوضاع. وبالرغم من التصريحات العدائية السابقة التي أدلى بها مرسي قبل توليه الحكم، والتي أثارت قلقًا لدى إسرائيل والمجتمع الدولي، إلا أنه اضطر لاحقًا لتقديم توضيحات وتراجعات في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن معارضته موجهة ضد “الاحتلال الإسرائيلي” وليس ضد الديانة اليهودية أو الشعب اليهودي. كما حاول مرسي استخدام القضية الفلسطينية كأداة لتحسين موقعه الإقليمي والداخلي، من خلال دعم حركة حماس وإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، دون أن يصل ذلك إلى حد القطيعة أو التصعيد السياسي المباشر مع تل أبيب. كشف هذا التباين بين الخطاب والممارسة عن الطبيعة المعقدة للسياسة الخارجية المصرية آنذاك، والتي كانت خاضعة لتوازنات دقيقة بين أيديولوجية الجماعة الحاكمة ومتطلبات الدولة، لا سيما في ظل اعتماد مصر على المساعدات الأمريكية وحرص المؤسسة العسكرية على استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل. وبذلك يمكن القول إن العلاقات بين مصر وإسرائيل في عهد مرسي اتسمت بالتوتر السياسي والرمزي، لكنها في الوقت ذاته حافظت على جوهرها الأمني والاستراتيجي بفعل اعتبارات الواقع أكثر من تأثير الخطاب الأيديولوجي.([123])
- ثورة 30 يونيو 2013 والانتخابات الرئاسية 2014: نقطة تحول في السياسة المصرية.
شهدت مصر في عام 2013 مرحلة فاصلة في تاريخها السياسي، حيث عكست ثورة 30 يونيو بداية لتحول جذري في مسار الدولة بعد حكم الرئيس محمد مرسي الذي دام لعام واحد فقط. فبعد فترة حكم كانت مليئة بالصراعات السياسية والاقتصادية، وظهور تهديدات خطيرة كيانية، جاءت الثورة بمثابة رد فعل شعبي ضد حكم مرسي، الذي تم تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الداخلية. وقد دفعت هذه الظروف إلى دعوات واسعة للتغيير، حيث أطلقت حركة تمرد حملة لسحب الثقة من مرسي، مستقطبة أكثر من عشرين مليون توقيع، وتوجت بتظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013.
أدى الضغط الشعبي والسياسي إلى تدخل الجيش المصري في الثالث من يوليو 2013، ليعلن عن خارطة طريق لتغيير النظام. وقد أسفرت هذه التطورات عن فترة انتقالية تولاها المستشار عدلي منصور، وأعقب ذلك تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 2014. في هذه الانتخابات، تنافس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي، ليحقق السيسي فوزًا حاسمًا ويصبح الرئيس الجديد لمصر، مؤكدًا على بداية مرحلة جديدة تتسم بالتحديات الكبرى، خصوصًا في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي خلفها حكم مرسي.
تحولات السياسة الخارجية في عهد السيسي
بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، دخلت البلاد مرحلة جديدة في سياستها الخارجية تميزت بالنشاط والفاعلية، بهدف تصحيح المسار الذي تأثر قبل 2013. عملت القيادة على استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، من خلال تحركات خارجية بعيدة عن تأثيرات الأنظمة السابقة.
شهدت الفترة التالية للانتخابات الرئاسية تحركًا واسعًا لإعادة بناء علاقات مصر الدولية، واستعادة الثقة في القيادة المصرية وتوضيح موقفها من قضايا المنطقة والعالم. وركزت السياسة الخارجية على ملفات استراتيجية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات مع إفريقيا، خاصة دول حوض النيل في ظل تحدي سد النهضة، وتوطيد العلاقات العربية، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب.
ورغم العقبات التي واجهت السياسة الخارجية، مثل تعثر مفاوضات سد النهضة وبعض التحديات في الملفات العربية، إلا أن مصر حققت نجاحات ملحوظة. ففي 2016 حصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وترأست لجنة مكافحة الإرهاب، وفي 2019 ترأست الاتحاد الإفريقي، ما عكس تطورًا ملحوظًا في علاقاتها الافريقية.([124])
شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية تحولًا نوعيًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حيث تبنّت القاهرة نهجًا استراتيجيًا يركّز على إعادة التموضع الإقليمي وتكريس دور مصر كمحور أساسي في معادلة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت فتورًا خلال فترة المجلس العسكري وعهد مرسي – تجلى أبرزها في واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011 – فإن صعود السيسي إلى سدة الحكم مثّل نقطة انعطاف حاسمة أعادت تشكيل هذه العلاقات ضمن أطر أكثر انفتاحًا وتعاونًا. هناك تحركات عديدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين العلاقات مع إسرائيل أبرزها:([125])
- تعزيز التعاون الأمني في سيناء.
من أبرز جوانب السياسة الخارجية السيسي تجاه إسرائيل كان تعزيز التعاون الأمني، خاصة في منطقة سيناء، التي شهدت تصاعدًا في نشاط الجماعات المسلحة. في إطار محاربة الإرهاب في سيناء، سمحت إسرائيل لمصر بتوسيع وجودها العسكري في مناطق معينة من شمال سيناء، بما يتجاوز ما نص عليه الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، حيث تم نشر القوات المصرية في مناطق “المنطقة (ب)” و”المنطقة (ج)”، باستخدام أسلحة ثقيلة ومدرعات وطلعات جوية. هذا التعاون كان ضروريًا بالنسبة للجانب المصري في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، وتم في إطار سري بعيدًا عن الأضواء لتجنب ردود الفعل المحلية.
- تأييد السيسي لحل الدولتين وعلاقته بالقدس الشرقية.
في خطاب السيسي الأول بعد توليه الرئاسة في 2014، أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مؤيدًا حل الدولتين وضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هذا الموقف كان يختلف عن بعض التيارات السياسية التي دعمت السيسي والتي كانت ترفض الاعتراف بإسرائيل. ورغم دعم السيسي لحل الدولتين، فقد استطاع موازنة هذا الموقف مع تعزيز علاقات مصر مع إسرائيل، حيث استغل الفراغ الأيديولوجي بين مؤيديه وركز على العلاقة الأمنية والاقتصادية. أثناء الحرب على غزة (الجرف الصامد) في 2014، جرت مفاوضات غير رسمية بين مصر وإسرائيل بهدف الوصول إلى تهدئة. رفضت إسرائيل الوساطات الدولية، وفضلت التعاون مع مصر كوسيط حصري لإدارة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة، مما عزز دور السيسي في المنطقة كمفاوض رئيسي وأظهر استعداد مصر للعب دور قيادي في حل النزاعات الإقليمية.
- التعاون مع إسرائيل في ملف مياه النيل (سد النهضة).
مع تصاعد أزمة “سد النهضة” الإثيوبي وتداعياته على حصة مصر من مياه النيل، بدأت القاهرة تسعى للحصول على دعم إسرائيلي في هذا الملف. تعتبر إسرائيل قوة دافعة في العديد من القضايا الإفريقية، وقد أبدت استعدادها لدعم مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن المياه. بالتالي، أصبح التعاون بين مصر وإسرائيل في هذا الملف جزءًا من استراتيجيات السيسي للحفاظ على حصة مصر من المياه وضمان مصالحها في منطقة حوض النيل.
في النهاية تعتبر سياسة السيسي تجاه إسرائيل مزيجًا من البراغماتية الأمنية والتوجهات الدبلوماسية التي تواكب التغيرات الإقليمية والدولية. ورغم وجود قضايا خلافية مع إسرائيل، فإن مصر تحت قيادة السيسي استطاعت تطوير علاقاتها مع تل أبيب بشكل استراتيجي، حيث ركزت على الأمن الإقليمي والتعاون في ملفات حساسة مثل القضية الفلسطينية، الأزمة في غزة، والتحديات المائية. العلاقات المصرية – الإسرائيلية باتت أكثر تنوعًا، حيث لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل تشمل أيضًا أبعادًا سياسية واقتصادية.
ثانيا: المتغيرات الاقتصادية.
بعد ثورة 25 يناير 2011، واجه الاقتصاد المصري سلسلة من التحديات الاقتصادية العميقة التي أثرت بشكل مباشر على قدرة البلاد على التعافي والاستقرار. حيث شهدت البلاد تباطؤًا حادًا في الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في قطاع السياحة الذي يعتبر من أبرز مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني. كما أدت الاحتجاجات والإضرابات العمالية إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل، مما زاد الضغوط على الموازنة العامة. تزايد العجز المالي بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع النفقات العامة الموجهة للاستجابة للمطالب الاجتماعية في مقابل تراجع الإيرادات العامة، سواء من الضرائب أو من القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأزمة. كما تراجعت الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ما انعكس في خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف العالمية، وزيادة تكلفة الاقتراض الخارجي. تزامن ذلك مع ضغوط على ميزان المدفوعات، حيث تأثرت عوائد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي وتدهور قيمة الجنيه المصري.
استمر الوضع الاقتصادي في التدهور بعد ثورة 30 يونيو 2013، نتيجة للأزمات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها البلاد، حيث شهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة، وتراجعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة في الدين العام وعجز الموازنة. كما تفاقمت مشكلات تدهور الخدمات الأساسية التي أثرت بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين. ([126])
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في 2014، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة بهدف معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية. شملت هذه الإصلاحات رفع الدعم عن الوقود والطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الجنيه المصري في 2016. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، إلا أن العديد من التحديات الاقتصادية ظلت قائمة، مثل التضخم المرتفع، وزيادة الديون الداخلية والخارجية، ومعاناة الفئات الأكثر فقرًا من الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تطلبت هذه الإصلاحات وقتًا طويلًا حتى بدأت تؤتي ثمارها في بعض الجوانب الاقتصادية. نتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، سعت الحكومة المصرية إلى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. من ضمن هذه الاستراتيجيات كان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والدولية. في هذا السياق، قامت مصر بتوسيع وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، حيث تعد هذه العلاقات جزءًا من الجهود المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي والتعاون في عدة مجالات، منها الطاقة، التجارة، والاستثمار، بهدف تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة. ومن أبرز أوجه هذا التعاون هو إحياء وتوسيع نطاق العمل بـ”المناطق الصناعية المؤهلة” (QIZ)، والتي تأسست بموجب بروتوكول أُبرم عام 2004 كملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد شهدت هذه المناطق – المنتشرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وقناة السويس والصعيد – نمواً ملحوظاً، حيث باتت تضم أكثر من 700 شركة وتشكل نحو 45% من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. ويُعد هذا التعاون أحد أشكال الاستخدام الذكي للترتيبات الاقتصادية الثلاثية بما يحقق لمصر مكاسب تجارية واستثمارية مع الحفاظ على مستوى منخفض من التطبيع الشعبي.([127])
فقد اتخذ التعاون منحى استراتيجياً فى مجال الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز الكبرى في كل من مصر وإسرائيل، وتحوُّل مصر إلى دولة مستوردة للغاز. وعلى الرغم من الجدل السياسي الذي يحيط بهذه الخطوة، بدأت القاهرة في تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب قديمة أُعيد توجيه استخدامها، فضلاً عن مقترحات بتحويل الغاز الإسرائيلي إلى مسال في محطات دمياط وإدكو المصرية تمهيداً لتصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعزّز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.([128])
بناءً عليه، يمكن القول إن البُعد الاقتصادي بات يشكّل عنصراً محورياً في السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، مدفوعاً بضغوط الواقع الاقتصادي الداخلي وأهداف التنمية الوطنية، مع الحرص على ضبط الإيقاع السياسي بما لا يصطدم بالرفض الشعبي أو الاعتبارات التاريخية الحساسة.
ثالثاً: العوامل الاجتماعية.
تلعب العوامل الاجتماعية دور مهم إلى تشكيل السياسة الخارجية لأي دولة، وتزيد أهميتها عند وجود جذور أو تاريخ صراعي مثل العلاقة بين مصر وإسرائيل ويعتبر كل من الرأي العام ووسائل الإعلام من أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة في شكل السياسة الخارجية لأي دولة، وعليه سنتناول فيما يلي كل من الرأي العام والإعلام بشيء من التفصيل.
- الرأي العام.
يمثّل الرأي العام المصري أحد أبرز العوامل الاجتماعية التي تؤثر على اتجاهات السياسة الخارجية تجاه إسرائيل، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث شهدت مصر انفتاحًا أكبر في التعبير الشعبي وازديادًا في الحراك المجتمعي. وأظهرت الدراسة أن الرأي العام المصري ظلّ محافظًا بدرجة كبيرة تجاه العلاقات مع إسرائيل، وهو ما انعكس في مواقف سياسية متحفظة وتردد في خطوات التطبيع. وبيّنت نتائج الاستطلاع أن الشباب المصري يميل عمومًا إلى رفض التطبيع الكامل، متأثرًا بالعامل القومي والديني والانحياز التاريخي للقضية الفلسطينية. هذا الرفض الشعبي لا يمكن تجاهله من قبل صانع القرار، بل يُؤخذ في الاعتبار كعامل ضغط غير مباشر يُقيد نطاق الانفتاح السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، خشية إثارة غضب الشارع أو المساس بالشرعية الشعبية للقيادة السياسية.([129])
- الإعلام.
يُعد الإعلام أحد أبرز أدوات التأثير في السياسة الخارجية، لما له من قدرة على تشكيل تصورات الرأي العام وصناع القرار معًا. فالعلاقة بين الإعلام والسياسة لم تعد علاقة تبعية، بل أصبحت علاقة تكامل وتأثير متبادل، حيث يُسهم الإعلام في صياغة الرؤية العامة للدولة وتوجيه رسائلها داخليًا وخارجيًا. وفي السياق المصري، اعتمدت الدولة بشكل متزايد على الإعلام لتحقيق أهدافها الخارجية والتأثير على المواقف الدولية تجاهها، فضلًا عن حشد الدعم الشعبي للسياسات المتبعة. إذ تلجأ الدولة لاستخدام الإعلام في تبسيط الرسائل الموجهة للرأي العام، وتحفيز المشاعر الوطنية، وبناء سردية تخدم المصالح القومية. ومن هذا المنطلق، يبرز دور الإعلام كأداة محورية ضمن أدوات السياسة الخارجية المصرية، خاصة في ذات الحساسية العالية كالعلاقة مع إسرائيل، والتي تتطلب توازنًا دقيقًا بين المصالح الاستراتيجية وردود الفعل الشعبية. ([130])
بعد عام 2011، ومع تصاعد دور الإعلام الجديد في مصر، أصبح تأثيره على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل ملموسًا بشكل خاص، نظرًا لحساسية العلاقة بين البلدين في الوعي الجمعي المصري. فقد أتاح الإعلام الجديد للمواطنين التعبير العلني عن مواقفهم تجاه التطبيع، وهو ما خلق ضغطًا غير مباشر على صانع القرار، خاصة في اللحظات التي شهدت توترًا أو تقاربًا بين القاهرة وتل أبيب. ساهمت التغطيات الإعلامية المكثفة، وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحويل بعض الأحداث المرتبطة بإسرائيل إلى قضايا رأي عام، أجبرت الدولة على اتخاذ مواقف أكثر حذرًا أو حتى تعديل بعض السياسات لتفادي الصدام مع المزاج الشعبي. وبهذا، أصبح الإعلام الجديد وسيطًا فاعلًا في إعادة تشكيل حدود الحركة السياسية المصرية تجاه إسرائيل، في توازن دائم بين المصالح الاستراتيجية ورد الفعل الشعبي المتأثر بالإعلام الرقمي.([131])
رابعاً: العوامل الأمنية.
تشكل العوامل الأمنية أحد المحاور الأساسية التي تؤثر بعمق في تشكيل وتوجيه السياسة الخارجية للدول، ومصر ليست استثناءً من هذه القاعدة. فمنذ عام 2011، واجهت الدولة المصرية جملة من التحديات الأمنية التي أعادت صياغة أولوياتها الخارجية، تمثلت في تصاعد التهديدات الإرهابية، وغياب الاستقرار الداخلي، وتنامي مظاهر الانفلات الأمني في بعض المناطق الحيوية كسيناء. وقد انعكست هذه التحديات بشكل واضح على توجهات السياسة الخارجية المصرية، التي اتجهت نحو تبنّي مقاربة براغماتية تقوم على التوفيق بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات إعادة التموضع في البيئة الإقليمية والدولية، في ظل حالة سيولة سياسية غير مسبوقة. في هذا السياق، تبرز الظاهرة الإرهابية بوصفها أحد أبرز المتغيرات الأمنية الداخلية التي أثّرت على الدولة المصرية في الفترة المستهدفة. فبعد ثورة يناير 2011، تصاعدت الهجمات التي استهدفت بشكل مباشر القوات المسلحة والشرطة، وامتدت لاحقًا إلى مؤسسات الدولة الحيوية ودور العبادة، بما في ذلك الكنائس، ما عكس تحوّل الإرهاب إلى تهديد وجودي يمسّ تماسك الدولة وبنيتها. وقد تضاعفت خطورة هذه الظاهرة بعد عزل النظام السياسي في عام 2013، حيث باتت التنظيمات المسلحة أكثر نشاطًا وعنفًا، خاصة في شمال سيناء.)[132](
وفي ضوء ما سبق، يمكن الوقوف على أبرز تأثيرات ظاهرة الإرهاب على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل من خلال عدة قرارات)[133](
- تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل.
أدى تصاعد العمليات الإرهابية في سيناء بعد 2013 إلى دفع مصر نحو مزيد من المرونة في علاقتها الأمنية مع إسرائيل، ما أسفر عن تفعيل التنسيق بين الجانبين خاصة في ما يخص مراقبة الحدود وتبادل المعلومات. وقد وافقت إسرائيل على نشر قوات مصرية إضافية في سيناء، رغم مخالفته لاتفاقية كامب ديفيد، استجابة للحاجة المشتركة لمواجهة التهديد الإرهابي.
- توظيف ملف الإرهاب دبلوماسيًا.
استخدمت مصر ملف مكافحة الإرهاب لإعادة ضبط علاقاتها الخارجية، بما في ذلك مع إسرائيل. فصورت نفسها كدولة مواجهة أمام الإرهاب العابر للحدود، ما عزز من دعم قوى إقليمية ودولية – منها إسرائيل – لدورها في حفظ الاستقرار الإقليمي، دون أن ينعكس ذلك في شكل تطبيع شعبي.
وفي ضوء ما سبق، نجد أن السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل تأثرت بشكل كبير بالمتغيرات السياسية الداخلية التي مرت بها مصر على مدار العقدين الماضيين. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، حافظت مصر على موقف مرن وواقعي في تعاملها مع إسرائيل، مستفيدة من مكانتها الإقليمية والتاريخية. تباينت السياسات حسب تطور الأوضاع السياسية الداخلية، من التوتر بعد ثورة 25 يناير إلى التهدئة في ظل النظام الحالي، مع التركيز على الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية.
المبحث الثالث: دور المتغيرات الإقليمية والدولية فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
تعد السياسة الخارجية لأي دولة انعكاسًا مباشرا لمصالحها الوطنية، وتعبيرا عن تفاعلها مع بيئتها الإقليمية والدولية. وتمثل السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل نموذجًا بالغ التعقيد والتنوع، إذ تجتمع فيه الأبعاد التاريخية، والدينية، والاستراتيجية، والاقتصادية، ضمن سياق إقليمي متغير، ونظام دولي دائم التحول. فمنذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، دخلت العلاقات المصرية الإسرائيلية في مراحل متباينة بين الحرب والسلام، والصدام والتعاون، والمقاطعة والتطبيع، وهو ما جعل من هذه العلاقة محط أنظار الباحثين وصانعي القرار على حد سواء. فرغم السلام الرسمي، بقيت العلاقة بين الدولتين محكومة بعدد من المحددات والمتغيرات التي تؤثر على قرارات السياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأمن في سيناء، والتنافس الإقليمي، إلى جانب التأثير المباشر للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الأخرى.
تتداخل في تشكيل السياسة المصرية تجاه إسرائيل متغيرات إقليمية مثل الدور المتقلب لحركة حماس في غزة، وملف المصالحة الفلسطينية، والتوترات في الإقليم العربي، مع متغيرات دولية تشمل طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، والتغير في ميزان القوى العالمية، وموجة التطبيع العربي الأخيرة، والتي قلصت إلى حد ما الدور المصري التقليدي كوسيط رئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي. وفي ضوء هذه المعطيات، أصبحت السياسة الخارجية المصرية تسير وفق مقاربة واقعية برغماتية، تهدف إلى حماية الأمن القومي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانة مصر الدولية، دون التفريط في ثوابتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.
شهدت العلاقة المصرية الإسرائيلية عدة محطات مؤثرة، أبرزها:
- الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، والثانية عام 2000، حيث أعادت الانتفاضات الزخم إلى القضية الفلسطينية، وشهدت مصر ضغوطًا شعبية وإعلامية لإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، لكنها حافظت على المسار الدبلوماسي([134]).
- الحروب على غزة 2008، 2012، 2014، ،2021 لعبت مصر دورا حاسمًا في التوسط لوقف إطلاق النار في كل جولة تقريبًا، وأكدت مكانتها كوسيط إقليمي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية([135]).
- مبادرات التطبيع العربي عام 2020 الممثلة فى اتفاقيات إبراهام (الاتفاقية الإبراهيمية) مثلت هذه الاتفاقيات تحديًا للريادة المصرية التقليدية في ملف السلام، إلا أن القاهرة سعت إلى استيعاب هذه المتغيرات وتعزيز دورها الإقليمي عبر التنسيق مع القوى الجديدة)[136](.
- التعاون الاستراتيجي المشترك فى ملف الطاقة من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يمثل أحد أوجه التعاون المصري الإسرائيلي في إطار المصالح الاقتصادية، دون أن ينعكس على الصعيد الشعبي)[137](.
تجسد السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل حالة دقيقة من التوازن الحذر بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات المصالح الاقتصادية والدبلوماسية. فمصر، بوصفها دولة محورية في الشرق الأوسط، تسعى إلى تأمين حدودها ومقدراتها الاستراتيجية، دون التفريط في دورها الإقليمي أو التأثير على موقفها التقليدي من القضية الفلسطينية. ومن هنا، ينبثق تعاملها مع إسرائيل كمعادلة ذات أبعاد متعددة، يتداخل فيها المحور الأمني مع الاقتصادي والسياسي.
- المصالح الأمنية
يمثل الملف الأمني أحد أهم محددات العلاقة المصرية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بـضبط الحدود في شمال سيناء، حيث تنشط الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن القومي المصري. تعزز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، لا سيما في منطقة الشريط الحدودى مع قطاع غزة فى عام 2013 وذلك بموجب تفاهمات ضمنية تتجاوز بعض القيود المفروضة في اتفاقية السلام، مقابل السماح للقوات المصرية بزيادة وجودها في المناطق الحدودية. كما أن أمن قناة السويس، بوصفها شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية ولمصر، يشكل هاجسًا مستمرا، ما يجعل الحفاظ على استقرار الحدود مع إسرائيل هدفًا مصريًا ثابتا. وتولي مصر أهمية كبرى لأي تصعيد عسكري في غزة قد يمتد إلى حدودها أو يهدد الملاحة الدولية)[138](.
- المصالح الاقتصادية
رغم أن التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل ظل محدودًا على المستوى الشعبي، فإن المصالح الاقتصادية بين البلدين تطورت بشكل ملحوظ في بعض الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروعات الغاز الطبيعي. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت إسرائيل مصدرا رئيسيًا للغاز المصدر إلى مصر بغرض إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، فكانت أولى صادرات الطاقة الإسرائيلية إلى مصر فى يناير 2020 عبر أنبوب غاز شرق المتوسط([139])
يعد الدور المصري كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة من أبرز أبعاد السياسة الخارجية المصرية، ويمنح أهمية استراتيجية لمصر لعدة أسباب: أولًا لأنه يرسخ مكانة مصر الإقليمية كـضامن للتهدئة، وقناة تواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس، التي تصعب على أطراف دولية أخرى التعامل المباشر معها، ثانيًا لأنه يمنح مصر أدوات ضغط دبلوماسية في علاقتها مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال دورها في تثبيت الهدن، رعاية اتفاقات وقف إطلاق النار، والإشراف على ملفات إعادة الإعمار في غزة. وقد أكدت مصر هذا الدور في جولات التصعيد الكبرى (2008، 2012، 2014، 2021)، حيث كانت القاهرة هي الطرف الرئيسي في احتواء التصعيد والتوصل إلى التفاهمات بين الطرفين([140]).
عملية الطوفان الأقصى وتأثيرها على السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل.
قامت حركة حماس ممثلة فى جناحها العسكري كتائب القسام بالهجوم على إسرائيل فى صبيحة السابع من أكتوبر 2023 فى عملية عسكرية أطلق عليها طوفان الأقصى، مما تبع ذلك ردا إسرائيليا فى اليوم التالى؛ الثامن من أكتوبر، بادئا الجيش الإسرائيلي بذلك الحرب الخامسة على قطاع غزة. كان لهذا الحدث الجلل كبير الأثر على توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل وفلسطين على حد السواء، فقد كانت مصر داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية منذ بدايتها كما ذكرنا سابقا داعية لمبدأ حل الدولتين، ومنذ تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تم وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية لكونها إحدى محددات الأمن القومي المصري على حدوده الشمالية الشرقية، وجاء اتفاق إنهاء الانقسام الذى تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية عام 2017 خير مثال على ذلك([141]).
بذلت مصر الجهود المضنية منذ بدأ العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة فى محاولة منها لتهدئة الأوضاع، واحتواء الصراع المهدد للمنطقة بأسرها، فنظمت مصر على إثر ذلك قمة القاهرة للسلام فى 21 أكتوبر 2023 لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الخطيرة التى يعانى منها المدنيين العزل فى القطاع، وكذلك محاولة تدويل القضية الفلسطينية من منطلق الصراع الجاري بين حركة حماس وإسرائيل للحد من تمدد الصراع إلى دول الجوار مما قد يؤدى إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى بلقان جديدة، خاصة فى ظل مساندة الأذرع الإيرانية الأخرى فى الصراع مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين فى اليمن لحركة حماس. توالت المطالبات الإسرائيلية بتهجير السكان المدنيين فى قطاع غزة إلى سيناء، وانتهجت من أجل ذلك نهجا عسكريا هادفا إلى تهجير السكان من الشمال إلى الجنوب حتى الوصول إلى حصارهم فى رقعة صغيرة على الحدود المصرية الفلسطينية، وردا على ذلك قامت مصر بتوضيح موقفها القاطع والواضح فى رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية([142]).
وبالانتقال إلى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، يتضح أن السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل بين عامي 2011 و2025 قد تأثرت بشكل ملموس بهذه التحولات، التي فرضت على صانع القرار المصري تبني نهج أكثر واقعية وبراغماتية. فمع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حدة الصراعات، خاصة في فلسطين وسوريا وليبيا، سعت مصر إلى الحفاظ على توازن دقيق يضمن أمنها القومي واستقرارها الداخلي، وفي الوقت نفسه يُبقي على دورها التقليدي في القضايا المركزية للمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
في هذا السياق، لعبت مصر دور الوسيط الفاعل في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا سيما خلال جولات التصعيد الكبرى في غزة، ما عزز من حضورها الإقليمي والدولي كقوة توازن. كما أن تزايد التهديدات في سيناء، وتطورات ملف الطاقة في شرق المتوسط، فرضت على مصر توظيف علاقاتها مع إسرائيل كجزء من استراتيجيتها لتحقيق أمن الطاقة والاستقرار الحدودي.
خاتمة الدراسة
بعد تناول الجوانب المختلفة لتأثير البعد الجيوبولتيكي على السياسة الخارجية المصرية تجاه كلاً من تركيا وإسرائيل خلال الفترة من 2011 إلى 2025، يمكن القول إن التحليل قد قدّم رؤية شاملة ومترابطة لمحددات وتفاعلات السياسة المصرية في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. وقد تنوعت محاور الدراسة بين الإطار النظري والتحليلي، مرورًا بتفكيك أبعاد العلاقات الثنائية مع الطرفين، وصولًا إلى إبراز الأثر المتبادل بين الخصائص الجغرافية والعوامل الاستراتيجية التي توجه سلوك الدولة. وتبعًا لذلك، يتضح الدور الحيوي الذي تلعبه الاعتبارات الجيوبولتيكية في صياغة السياسات الخارجية، خاصة في المراحل التي تشهد تحولات بنيوية في الإقليم، وهو ما عكسته بوضوح التجربة المصرية خلال هذه المرحلة.
في ضوء ما سبق ننتقل لاستعراض النتائج الرئيسية التي وصل إليها البحث، فيتضح أن البعد الجيوبولتيكي لمصر كان له تأثير حاسم في رسم سياستها الخارجية تجاه كلاً من إسرائيل وتركيا، حيث فرضت الاعتبارات الجغرافية والأمنية نفسها على صانع القرار المصري. فقد شكل القرب الجغرافي ومناطق التماس الحيوية دوافع للتعاون الحذر مع إسرائيل، في مقابل التوجس من الطموحات الإقليمية لتركيا، خاصة في شرق المتوسط وليبيا. وبذلك، لم يكن البعد الجيوبولتيكي مجرد إطار نظري، بل مكونًا عمليًا وفعّالًا في تحديد أولويات التحرك المصري الخارجي وضبط تفاعلاته مع محيطه الإقليمي.
يتبين أن السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2011 قد مرت بمراحل دقيقة ومعقدة، لكنها نجحت في الحفاظ على توازن استراتيجي بين متطلبات الأمن القومي ومتطلبات الحفاظ على الدور الإقليمي. استطاعت مصر أن تطور سياسة خارجية مرنة تعتمد على مزيج من الأدوات التقليدية والحديثة، مما مكّنها من التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. هذه السياسة ركزت على تعزيز الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الثوابت القومية وتوسيع نطاق التعاون مع القوى العالمية والإقليمية، دون التنازل عن المصالح الوطنية.
تتمثل قوة مصر الإقليمية في مجموعة من المحددات الجغرافية، العسكرية، السياسية، والاقتصادية التي تسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية. الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يعزز دورها كمركز هام للتجارة والطاقة بين ثلاث قارات. من الناحية العسكرية، تمتلك مصر جيشًا قويًا يساهم في استقرارها الداخلي وتأثيرها الإقليمي. سياسيًا، يتيح لها النظام المؤسسي المرن التفاعل مع التحديات الداخلية والدولية.
تعتبر العلاقات المصرية التركية ذات أهمية خاصة نابعة من التاريخ والموقع الجغرافي، وشهدت مراحل من التقارب والتفاعل وأخرى من التنافس والصراع، وفقًا للمتغيرات الإقليمية والدولية. لعب الموقع الجيوبوليتيكي لمصر دورًا محوريًا في تحديد سياستها تجاه تركيا، خاصة في قضيتي شرق المتوسط والأزمة الليبية. ورغم التوترات الحادة وقطع العلاقات الدبلوماسية خلال العقد الماضي، فإن المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية دفعت البلدين نحو إعادة بناء الثقة والتعاون، بما يمهد لإمكانية فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ظل تغيرات دولية متسارعة.
وفي الإطار ذاته، تكشف نتائج الدراسة أن العلاقات المصرية التركية بين 2011 و2025 مرت بمرحلة توتر حاد نتيجة الصدام السياسي بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، حيث رأت القاهرة في التدخلات التركية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في ليبيا وشرق المتوسط. بدلاً من الدخول في مواجهة مفتوحة، تبنت مصر سياسة براغماتية عبر تعزيز تحالفاتها مع اليونان وقبرص، وتثبيت حدودها البحرية عبر اتفاقيات دولية، مع رسم خطوط حمراء واضحة للتدخل التركي في محيطها، مثل إعلان «خط سرت – الجفرة» في ليبيا، مستفيدة بذلك من أدوات الشرعية الدولية والدعم الأوروبي.
في السياق الإقليمي، أظهرت مصر ذكاءً استراتيجيًا في التعامل مع موجة التطبيع العربي الأخيرة التي بدأت باتفاقيات إبراهام عام 2020، حيث امتنعت القاهرة عن اتخاذ مواقف رافضة أو تصعيدية، بل عملت على استيعاب هذه المتغيرات، وتعزيز تحالفاتها التقليدية مع دول مثل الأردن وفلسطين، مع الحفاظ على شراكات جديدة تخدم مصالحها، خاصة في ملفات الطاقة. فقد برز منتدى غاز شرق المتوسط كأحد أهم المنصات التي جمعت مصر وإسرائيل معًا، حيث شكّل التعاون في مجال الغاز الطبيعي مصدرًا مهمًا للدخل القومي المصري، وعزّز دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما مكّنها من لعب دور جديد على الساحة الدولية، بعيدًا عن الصراع السياسي المباشر.
كذلك أظهرت السياسة المصرية مرونة واضحة في التعامل مع المتغيرات الدولية، إذ تمكّنت من توظيف أدوات القانون الدولي بذكاء، لا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية، بما ضَمِنَ حقوقها في موارد غاز شرق المتوسط. هذا التحرك لم يكن فقط دفاعيًا لحماية المصالح الوطنية، بل كان أيضًا هجومياً بمعنى السعي إلى تعزيز تحالفات جديدة، خاصة مع قبرص واليونان، لتحجيم النفوذ التركي وتحقيق مكاسب استراتيجية طويلة المدى.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، يتضح أن الجيوبولتيك كان له دور بارز في تشكيل توجهات مصر الخارجية. فقد ساهم الموقع الجغرافي في رسم الاستراتيجيات السياسية والعسكرية المصرية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهتها البلاد. وتُظهر السياسة المصرية مرونة واضحة في التوفيق بين المصالح الأمنية والاقتصادية، كما تجلى في اتفاقية كامب ديفيد وما تبعها من علاقات. ويؤكد ذلك أن الجغرافيا لا تقتصر على الحدود، بل تؤثر بعمق في التوجهات السياسية والدبلوماسية للدولة.
تأثرت السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل بالمتغيرات السياسية الداخلية التي شهدتها مصر خلال العقدين الماضيين، حيث انعكس تغير طبيعة النظام السياسي على طبيعة العلاقة بين البلدين. فبعد ثورة 25 يناير 2011، سادت حالة من التوتر وعدم الاستقرار انعكست على العلاقات مع إسرائيل، نتيجة تصاعد دور القوى الشعبية وتغير أولويات النظام. أما في ظل النظام الحالي، فقد عادت العلاقات إلى مسار أكثر هدوءًا وواقعية، مع التركيز على الحفاظ على الأمن القومي المصري والمصالح الاستراتيجية، ما يعكس تأثر السياسة الخارجية باستقرار النظام السياسي الداخلي وتوجهاته.
وبالانتقال إلى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، يتضح أن السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل بين عامي 2011 و2025 قد تأثرت بشكل ملموس بهذه التحولات، التي فرضت على صانع القرار المصري تبني نهج أكثر واقعية وبراغماتية. فمع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حدة الصراعات، خاصة في فلسطين وسوريا وليبيا، سعت مصر إلى الحفاظ على توازن دقيق يضمن أمنها القومي واستقرارها الداخلي، وفي الوقت نفسه يُبقي على دورها التقليدي في القضايا المركزية للمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
في هذا السياق، لعبت مصر دور الوسيط الفاعل في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا سيما خلال جولات التصعيد الكبرى في غزة، ما عزز من حضورها الإقليمي والدولي كقوة توازن. كما أن تزايد التهديدات في سيناء، وتطورات ملف الطاقة في شرق المتوسط، فرضتا على مصر توظيف علاقاتها مع إسرائيل كجزء من استراتيجيتها لتحقيق أمن الطاقة والاستقرار الحدودي.
أما على المستوى الدولي، فقد ساهمت العلاقة مع القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ترسيخ موقع مصر كطرف موثوق به في المعادلات الإقليمية، وذلك بفضل قدرتها على ضبط إيقاع الصراع ومنع انفلات الأوضاع. وفي ظل صعود قوى إقليمية منافسة مثل تركيا وإيران، وجدت مصر نفسها مطالبة بالحفاظ على دورها القيادي في المنطقة عبر تفعيل أدوات دبلوماسية مرنة، تستند إلى مزيج من الشراكات الاستراتيجية، والتهدئة، والانفتاح المدروس على محاور متعددة.
وبذلك، يمكن القول إن السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2011 إلى 2025 لم تكن مجرد استجابة للأحداث، بل تعبيرًا عن رؤية استراتيجية متكاملة، استطاعت من خلالها مصر أن توظف أبعادها الجيوبوليتكية، وتستوعب متغيراتها الداخلية، وتتكيف مع التحولات الإقليمية والدولية، بما يخدم أمنها القومي ويعزز مكانتها في محيطها الحيوي.
قائمة المراجع
أولاً: مراجع باللغة العربية
أ-الوثائق الرسمية والقوانين.
دستور مصر المعدل 2019، جمهورية مصر العربية.
ب-كتب
– صالح النعامى، العلاقات المصرية- الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، 2017.
– طه بدوي، وآخرون، النظم السياسية والسياسات والعلاقات الخارجية الدولية، د.ط، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، 2013.
– عبد القادر رزيق، مشروع الشرق الأوسط الكبير: الحقائق والأهداف والتداعيات، ط 1، ديوان المطبوعات الجامعية، 2005.
– علي الدين هلال، النظام السياسي المصري بعد ثورتين (2014-2017)، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، ط1، القاهرة، 2019.
– عمر كامل حسن، النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن المائي العربي: دراسة فى الجغرافية السياسية والجيوبولتيك، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
-قدرى محمود إسماعيل، التحليل الجيوبوليتيكى لعلاقات القوى الدولية د.ط ، دار فاروس العلمية، الاسكندرية2021.
– محمد سعادى، سيادة الدولة على البحر فى القانون الدولي العام، ط١، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010
ج-رسائل العلمية.
– إبراهيم محمد سيف، سياسة مصر الخارجية والقضية الفلسطينية من الحكم الملكي إلى الربيع العربي (1917_2013)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا-جامعة بيرزيت، 2015.
– أحمد نائل خراز، العلاقات الأمنية المصرية-الإسرائيلية (1978-2016)، رسالة ماجستير، الكلية المتوسطة للدراسات الأمنية-جامعة القدس، 2016.
– بنان عاطف حسين السحيمات، العلاقات التركية-المصرية 2012-2019، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة مؤتة، 2021.
-خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية (دراسة حالة)، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، الأردن، يناير 2007.
-فيرونيكا حليم فرنسيس، جيوبولتيك السياسة الخارجية الروسية: دراسة فى أثر الجيوبولتيك فى علاقة روسيا بدول الجوار، رسالة ماجيستير، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية-جامعة الإسكندرية، 2019.
– مشعل محمد السرحان، أثر المتغيرات الإقليمية على العلاقات المصرية التركية (2011-2017)، رسالة ماجيستير- جامعة آل البيت، الأردن، 2018.
-يحيى السيد إبراهيم محمد، العوامل المؤثرة فى سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا فى عهد رئاسة عبد الفتاح السيسى، رسالة ماجيستير- جامعة اسطنبول، تركيا، 2024.
د-مجلات علمية.
-ابتهال السيد، العلاقات المصرية التركية بعد ثورة 25 يناير2011، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية-جامعة قناة السويس، مجلد(11) ع2 الجزء الأول، أكتوبر 2020.
– إبراهيم سعود حميد أبوستيت، ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المقابلة وفقا لأحكام القانون الدولي العام، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية-جامعة مدينة السادات، مجلد (10) ع3، سبتمبر 2024.
– أحمد على جلال، أثر التدخل التركي فى المنطقة العربية على الأمن القومي العربي: دراسة حالة الفترة من 2011-2021، مجلة كلية السياسة والاقتصادـ جامعة بنى سويف، عدد (22)، إبريل 2024.
– أحمد قيس جاسم، نغم سلام إبراهيم، السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية 1977-1990، مجلة الآداب- جامعة بغداد، ملحق (1) ع137، بغداد، 2021.
– أحمد ناجى قمحة، القوة الاستراتيجية للدور المصري توازن الاستجابة فى التعامل مع اطروحات التهجير: بين الالتزام بالثوابت والتكيف مع المتغيرات، مجلة السياسة الدولية، مجلد (60) ع240، إبريل 2025.
– إسماعيل محمد إسماعيل حسن، الانعكاسات الاقتصادية لتعيين الحدود البحرية المصرية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية- جامعة قناة السويس، مجلد(13)ع3، يوليو 2022.
– أميرة سمير، محددات اتجاهات الشباب المصرى نحو معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، المجلة المصرية لبحوث الرأى العام, 14(2), 2015
-آية رجب أبو اليزيد-أحمد حسام علوانى-إيمان أحمد قمر-محمد المغازى الخواجة-يوسف أحمد حطاب، “جيوبوليتيك القوى الإقليمية المعاصرة فى الشرق الأوسط (إيران وإسرائيل نموذجا)”، دراسة بحثية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2024.
– رفيق جلال إبراهيم أبو سيد، المتغيرات الجيوبولتيكية الإقليمية المؤثرة على الأمن القومي المصري (الشرق الاوسط)، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، عدد23، بنى سويف، يوليو 2024.
– رنيم علي جمال الدين الغنام، الصراعات الدولية والإقليمية على الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط (2009_2019)، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية، مجلد (7) ع 14، يوليو 2022.
– ريهام مصطفى، “مصر قوة إقليمية كبرى في النظام العالمي الجديد.” آفاق مستقبلية، العدد 5، يناير 2025، ص 379–382. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء المصري.
– سعد حسين محمد شريف، رانيا عبد الرحمن الديربي عبد العال، رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وتأثيرها على سياستها الخارجية خلال الفترة(2011-2019). المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 13(3)، 2022.
– سلوى السعيد فراج، رشا عطوة عبد الحكيم، انعكاس صراعات الغاز الجديدة على الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد 12، 2021.
– صلاح سمير، العلاقات المصرية الإسرائيلية علي ضوء المتغيرات السياسية المصرية ، وضرورة إعادة النظر في معاهدة السلام. مجــلة الدراسات الاستراتيجــية والعسكرية، العـدد الثاني، 2018.
-طارق فهمي، الدوائر المقترحة للسياسة الخارجية المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، الأمن القومي والاستراتيجية, 1(1)، 2023.
– على حسن يوسف فتاح، دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فى صنع السياسات العامة، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة زاخو، مجلد (6)ع4، إقليم كردستان- العراق، 2018.
-مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، تداعيات وانعكاسات للتدخل التركي فى ليبيا على الأمن القومى المصري من الفترة (2011-2020)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية-جامعة قناة السويس، مجلد (12) ع3، يوليو 2021.
– مصطفى اللباد، مصر وإسرائيل: بين الضرورات الأمنية وحدود التطبيع، مجلة رؤى استراتيجية، مركز الأهرام، العدد 7، 2016
– مهاب حسني النحال، المتغيرات الداخلية والخارجية وتأثيرها على السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحولات الاستراتيجية فى المنطقة العربية بعد 2011، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد9، 2020.
– ياسمين أحمد توفيق الضوي، سياسة المحاور الجيوبولتيكية الروسية بالشرق الأوسط خلال الفترة من 2000-2023، (إيران وتركيا كنموذجين)، المجلة العلمية لطلبة الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، مجلد (10)ع 19، جامعة الإسكندرية، يناير 2025.
ج-مواقع إلكترونية.
-أحمد عسكر، تداعيات تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال، موقع مجلة السياسة الدولية، https://www.siyassa.org.eg/News/15281 4.aspx
-أحمد فؤاد أنور، الجمهورية الجديدة: محددات السياسة الخارجية المصرية، موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 22 سبتمبر 2021، https://ecss.com.eg/16803/
-أحمد نصر صلاح أحمد، ورحمة أيمن رجب الجزار. “أثر المتغيرات المحلية على مكانة مصر الإقليمية 2011–2022م.” المركز الديمقراطي العربي، برلين- ألمانيا 7 يوليو 2023.
-أسباب، “فرص تدخل مصر العسكري في ليبيا”، أسباب، يوليو 2020، https://www.asbab.com/
-إعادة العلاقات التركية المصرية: خلفياتها وأبعادها المحتملة.” قاسيون للدراسات، 12 يوليو 2023. https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/78132-2023-07-12-14-14-23
-الهيئة العامة للاستعلامات، انتصارات أكتوبر، 22 نوفمبر 2023، ، https://beta.sis.gov.eg/ar
-بسبب موقفها من أزمة ليبيا.. مصر تعلق الجلسات الاستكشافية مع تركيا.” التلفزيون العربي، 30 أكتوبر 2022. https://www.alaraby.com/news/ ٍ
-بوابة الأهرام، “العلاقات المصرية – التركية.. ثبات على المبادئ من أجل دول الجوار واستقرار الشرق الأوسط”، https://gate.ahram.org.eg/News/4702189.aspx
-تسليح الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي”، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 19 نوفمبر 2023، https://sis.gov.eg/Story/279284/
-توفيق بوستي، “التدخل التركي في ليبيا: الدوافع والتداعيات”، المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية، 12 يناير 2024، https://mediterraneancss.uk/2024/01/12/turkish_-intervention_-in_-libya
-دينا سليمان كمال، (2020، 27 فبراير)، الإعلام وتأثيره والسياسة الخارجية، المركز الديمقراطي العربي، برلين-ألمانيا، تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2025، متاح علي: https://www.democraticac.de/”p=64961
-زياد عقل، تغيرات فى الخريطة السياسية المصرية، موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://acpss.ahram.org.eg/News/5334.aspx
-شيرين شلبي، العلاقات السياسية بين مصر والخلافة العباسية (القاهرة: جامعة عين شمس، 2020)، https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/169426.
-شيماء فرحان، العلاقات التركية المصرية بعد عام2011، المركز الديمقراطي العربى، برلين-ألمانيا، 2020، https://democraticac.de/?p=6550 تاريخ الاطلاع إبريل 2025
-صباح جاسم محمد الجنابي، أثر المتغير الجيوبوليتيكي فى السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان، المركز الديموقراطي العربى للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا.
“-عام من الصمت الدبلوماسي.. ما علاقة الأزمة الليبية بتوقف المباحثات المصرية التركية؟” الجزيرة نت، 1 نوفمبر 2022. https://www.aljazeera.net/politics/2022/11/1/
-طلال عوكل، الانتفاضة: الدوافع والتداعيات والآفاق، موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، https://www.palestine-studies.org/ar/node/1635810 .
-عبد المنعم المشاط، السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، موقع دار المنظومة، https://search.mandumah.com/Record/704264 ، تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
-قطاعات الاقتصاد المصري، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، https://www.sis.gov.eg/section
-قمة القاهرة للسلام 2023, الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك الى مصر, 21 أكتوبر 2023, https://sis.gov.eg/Story/264766?lang=ar
-محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، مدونة محمد إلهامي، 10 ديسمبر 2017، https://melhamy.blogspot.com/2017/12/blog-post_10.html
-محـمد يحيى إمبابي عبد الخالق، البيئة المحيطة بالنظام السياسي المصري : الفرص والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية، دراسة بحثية، المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، يوليو 2023.
-محمود سامح، السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط: دراسة حالة تركيا 2013-2024، المركز الديموقراطي العربي، برلين- ألمانيا، 2024 متاح على https://democraticac.de/?p=100123
-محمود سامح همام، عودة العلاقات المصرية الإيرانية بين الحذر والترقب، موقع مصر الأن، سبتمبر 2023، https://misralan.net/archives/236886
-مصر..انطلاق المناورات العسكرية “هرقل 2” بمشاركة دولية، موقع الجزيرة، 21 أغسطس 2022.
-مصر تتدخل عسكريا فى الصومال وأثيوبيا تحذر، موقع مركز تقدم للدراسات، https://www.arabprogress.org/
“-مصر واليونان تقطعان الطريق على تركيا بـ«تعيين الحدود البحرية».” الشرق الأوسط، 6 أغسطس 2020. https://aawsat.com/home/article/2434061
-مصر وتركيا”، بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تعديل 15 فبراير 2024، https://www.sis.gov.eg/Story/270980/مصر-و-تركيا?lang=ar
-معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. (2022). التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وإسرائيل، تم الاسترجاع من https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
-منى سليمان، التحالف المصري-اليوناني ـالقبرصي وتغيير موازين الشرق الأوسط، موقع مجلة السياسة الدولية، https://www.siyassa.org.eg/News/15423/
-منى سليمان، دوافع جولة أردوغان الإفريقية فى نهاية 2017 وتأثيراتها فى الأمن القومي العربي، موقع مجلة السياسة الدولية https://www.siyassa.org.eg/News/15467/
-منى سليمان، لماذا تعترض تركيا على التنقيب المصري-القبرصي عن غاز شرق المتوسط؟، -موقع مجلة السياسة الدوليةhttps://www.siyassa.org.eg/News/15553/.aspx
-مهاب عادل حسن، التداعيات الجيوبوليتيكية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في ضوء عملية “طوفان الأقصى”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الخميس 1 مايو 2025
-ميسرة السيد، دور الجيوش فى التنمية: الجيش المصري نموذجا (2012-2022)، موقع مجلة السياسة الدولية، 15/11/20202، https://www.siyassa.org.eg/News/18434.aspx
-مى سيد محمود محمد، السياسة الخارجية التركية تجاه الأزمة الليبية 2011-2020، موقع المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، https://democraticac.de/?p=82827
-نهى الشريف. (2021، 18 أكتوبر). السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي.. سنوات الازدهار الحقيقية. مجلة السياسة الدولية. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2025، متاح على https://www.siyassa.org.eg/News/18156.a’px
-هيثم حسنين. (2016، 2 نوفمبر). التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وإسرائيل (المرصد السياسي، 2721). معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2025، من https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
-وزارة الخارجية المصرية. (2023). السياسة الخارجية المصرية: محددات وأولويات، https://www.mfa.gov.eg/ar/ForeignPolicies/”eterminantsAndPrioritiesOfForeignPolicy
-وزير خارجية تركيا: نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر وبخاصة الاقتصادية” ، الأهرام ، 13-4-2023
-وليد محمد صديق، الأزمات الناتجة عن تغير الدور المصري عقب 25 يناير و أثره على العلاقات الخارجية، المؤتمر السنوي السادس عشر-جامعة عين شمس، 2011، موقع دار المنظومة https://search.mandumah.com/Record/113336 ، تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
-ياسمين السيد أحمد عبدالسلام، اثر المتغيرات الإقليمية علي السياسة الخارجية الإسرائيلية 2011-2016، دراسة بحثية، موقع المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، متاح على https://democraticac.de/?p=34868
-يوسف حسين، تركيا: التاريخ السياسي الحديث و المعاصر(1923-2018)، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، 2021.
ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية
A: Scientific theses.
-Saad, Mohamed Khaled Abdelsalam Omar, Egyptian-Turkish relations between2013 and 2024: A multi-level analysis of foreign policy change, Thesis for Master, School of social sciences, Middle east technical university, Turkey, July 2024.
B: Other resources
-Ali Bakir, Egypt-Turkey normalization: Ankara`s perspective, Atlantic Council, 2023
-Gamal M. Selim, (2022), Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: thedynamics of continuity and change, British Journal of Middle Eastern Studies.
-Khalil Al-Anani, Egpt-Turkey Relations: Challenges and Future Prospects, Arab Center Washington DC, 2022.
– Lavie, Limor & Yefet, Bosmat. (2022). The Relationship between the State and the New Media in Egypt: A Dynamic of Openness, Adaptation, and Narrowing. Contemporary Review of the Middle East.
-Romanczuk, Michel, Geopolitical determinants in the foreign policy of the Russian federation, Athenaeum, polish political science study, 2019.
-Segell, G. (2013, ’December 12). Mohamed Morsi, Egypt “ND Israel. E-International Relations
-Abdel Ghafar, A. (2022, November). Egyptian foreign policy during the Sisi era. Middle East Council on Global Affairs. https://mecouncil.org/publication/egyptian-foreign-policy-during-the-sisi-era/
– Peter Hahn , “The Suez Crisis (1956)” , Origins: Current Events in Historical Perspective, October 2021
https://origins.osu.edu/milestones/suez-crisis-1956
-Selina Kaur Rai, What Were the Causes and Consequences of the 1948 Arab-Israeli War?, University of Leicester, 11/2013
https://www.e-ir.info/2014/01/15/what-were-the-causes
-Soliman, M. (2016, July 29). Sisi’” new approach to Egypt-Israel relations. The Washington Institute for Near East Policy. Retrieved April 25, 2025, from https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/sisis-new-approach-egypt-israel-relations
[1] )رفيق جلال إبراهيم أبو سيد، المتغيرات الجيوبولتيكية الإقليمية المؤثرة على الأمن القومي المصري (الشرق الاوسط)، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، عدد23، بنى سويف، يوليو 2024.
[2] )خالد عبدالقادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية (دراسة حالة)، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، الأردن، يناير 2007.
[3]) ياسمين السيد أحمد عبدالسلام، اثر المتغيرات الإقليمية علي السياسة الخارجية الإسرائيلية 2011-2016، دراسة بحثية، موقع المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، متاح على https://democraticac.de/?p=34868
[4] )ياسمين أحمد توفيق الضوي، سياسة المحاور الجيوبولتيكية الروسية بالشرق الأوسط خلال الفترة من 2000-2023، ( إيران وتركيا كنموذجين)، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، مجلد (10)ع 19، جامعة الإسكندرية، يناير 2025.
[5](قدرى محمود إسماعيل، التحليل الجيوبوليتيكى لعلاقات القوى الدولية، د.ط ، دار فاروس العلمية، الاسكندرية 2021 ص 23 -26.
[6])طه بدوي، وأخرون، النظم السياسية والسياسات والعلاقات الخارجية الدولية، د.ط، دار التعليم الجامعي،الاسكندرية،2013، ص329
[7])عبدالقادر رزيق، مشروع الشرق الأوسط الكبير: الحقائق والأهداف والتداعيات، ط 1، ديوان المطبوعات الجامعية، 2005، ص 36-41.
[8]) ياسمين أحمد توفيق الضوى، سياسة المحاور الجيوبولتيكية الروسية فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 2000حتى 2023: إيران وتركيا كنموذجين، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الإسكندرية، مجلد (10) ع9، 2025.
[9]) فيرونيكا حليم فرنسيس، جيوبولتيك السياسة الخارجية الروسية: دراسة فى أثر الجيوبولتيك فى علاقة روسيا بدول الجوار، رسالة ماجيستير، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية-جامعة الإسكندرية، 2019.
[10] )عمر كامل حسن، النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن المائي العربي: دراسة فى الجغرافية السياسية والجيوبولتيك، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
[11] )صباح جاسم محمد الجنابي، أثر المتغير الجيوبوليتيكي فى السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان، المركز الديموقراطي العربى للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا.
[12])آية رجب أبو اليزيد-أحمد حسام علوانى-إيمان أحمد قمر-محمد المغازى الخواجة-يوسف أحمد حطاب، “جيوبوليتيك القوى الإقليمية المعاصرة فى الشرق الأوسط (إيران وإسرائيل نموذجا)”، دراسة بحثية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2024.
[13] (Romanczuk, Michel, Geopolitical determinants in the foreign policy of the Russian federation, Athenaeum, polish political science study, 2019.
[14] ) يحيى السيد إبراهيم محمد، العوامل المؤثرة فى سياسة مصر الخارجية تجاه تركيا فى عهد رئاسة عبدالفتاح السيسى، رسالة ماجيستير- جامعة اسطنبول، تركيا، 2024.
[15] ) مشعل محمد السرحان، أثر المتغيرات الإقليمية على العلاقات المصرية التركية (2011-2017)، رسالة ماجيستير- جامعة آل البيت، الأردن، 2018.
[16])بنان عاطف حسين السحيمات، العلاقات التركية-المصرية 2012-2019، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة مؤتة، 2021.
1)Saad, Mohamed Khaled Abdelsalam Omar, Egyptian-Turkish relations between2013 and 2024: A multi-level analysis of foreign policy change, Thesis for Master, School of social sciences, Middle east technical university, Turkey, July 2024.
[18] ) صالح النعامى، العلاقات المصرية- الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، 2017.
[19])إبراهيم محمد سيف، سياسة مصر الخارجية والقضية الفلسطينية من الحكم الملكي إلى الربيع العربى (1917_2013)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا-جامعة بيرزيت، 2015.
[20])أحمد نائل خراز، العلاقات الأمنية المصرية-الإسرائيلية (1978-2016)، رسالة ماجستير، الكلية المتوسطة للدراسات الأمنية-جامعة القدس، 2016.
[21] )أحمد فؤاد أنور، الجمهورية الجديدة: محددات السياسة الخارجية المصرية، موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 22 سبتمبر 2021، https://ecss.com.eg/16803/ تم التصفح إبريل 2025.
[22]) محمود سامح همام، عودة العلاقات المصرية الإيرانية بين الحذر والترقب، موقع مصر الأن، سبتمبر 2023، https://misralan.net/archives/236886 ، تم التصفح إبريل 2025.
[23]) أحمد قيس جاسم، نغم سلام إبراهيم، السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية 1977-1990، مجلة الآداب- جامعة بغداد، ملحق(1) ع137، بغداد، 2021.
[24]) قمة القاهرة للسلام 2023, الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك الى مصر, 21 أكتوبر 2023, https://sis.gov.eg/Story/264766?lang=ar، تم التصفح إبريل 2025.
[25] ) مصر..انطلاق المناورات العسكرية “هرقل 2” بمشاركة دولية، موقع الجزيرة، 21 أغسطس 2022.
[26] ) مصر وقارة أفريقيا، الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك إلى مصر، 26يونيو 2022،
[27] ) طه بدوي، وآخرون، النظم السياسية والسياسات والعلاقات الخارجية الدولية، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، 2013 ص 336.
[28] (Gamal M. Selim, (2022), Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: thedynamics of continuity and change, British Journal of Middle Eastern Studies.
[29] ) طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 337.
[30] ) معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. (2022). التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وإسرائيل. تاريخ الاطلاع: 20/4/2025، تم الاسترجاع من https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
[31]) طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 339.
[32]) وزارة الخارجية المصرية. (2023). السياسة الخارجية المصرية: محددات وأولويات، تاريخ الاطلاع: 22/4/2025 https://www.mfa.gov.eg/ar/ForeignPolicies/”eterminantsAndPrioritiesOfForeignPolicy
[33]) طارق فهمي، الدوائر المقترحة للسياسة الخارجية المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، الأمن القومي والاستراتيجية, 1(1)، 2023، ص 7-16.
[34]) طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 240.
[35]) طارق فهمي، مرجع سبق ذكره.
[36]) وزارة الخارجية المصرية، مرجع سبق ذكره.
[37]) محمود سامح، السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط: دراسة حالة تركيا 2013-2024، المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، 2024 تاريخ الاطلاع 22/4/2025، متاح على https://democraticac.de/?p=100123
[38]) وزارة الخارجية المصرية، مرجع سبق ذكره.
[39]) أحمد نصر صلاح أحمد، ورحمة أيمن رجب الجزار. “أثر المتغيرات المحلية على مكانة مصر الإقليمية 2011–2022م.” المركز الديمقراطي العربي، برلين- ألمانيا 7 يوليو 2023
[40]) نفس المرجع السابق
[41]) ميسرة السيد، دور الجيوش فى التنمية: الجيش المصري نموذجا (2012-2022)، موقع مجلة السياسة الدولية، 15/11/20202، https://www.siyassa.org.eg/News/18434.aspx. تم التصفح إبريل 2025.
[42]) ريهام مصطفى، “مصر قوة إقليمية كبرى في النظام العالمي الجديد.” آفاق مستقبلية، العدد 5، يناير 2025، ص 379–382. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء المصري.
[43] ) ميسرة السيد، موقع سبق ذكره .
[44]) “تسليح الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي“، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 19 نوفمبر 2023، https://sis.gov.eg/Story/279284/
[45] ) نفس المرجع السابق
[46])دستور مصر المعدل 2019، مادة (1),(5)، إبريل 2019، ص6-7.
[47])علي الدين هلال، النظام السياسي المصري بعد ثورتين (2014-2017)، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، ط1، القاهرة، 2019، ص9-10
[48])دستور مصر المعدل، مرجع سبق ذكره، مادة (101)، ص 41
[49])نفس المرجع السابق، مادة (139) (150)، ص55-59.
[50])محمد العجاتي، النظام السياسي المصري ما بين البرلماني والرئاسي، تقرير غير حكومي، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2012، ص 5.
[51])على حسن يوسف فتاح، دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فى صنع السياسات العامة، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة زاخو، مجلد (6)ع4، إقليم كردستان- العراق، 2018، ص1057.
[52] ) محـمد يحيى إمبابي عبد الخالق، البيئة المحيطة بالنظام السياسي المصري : الفرص والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية، دراسة بحثية، المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، يوليو 2023.
[53] ) زياد عقل، تغيرات فى الخريطة السياسية المصرية، موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://acpss.ahram.org.eg/News/5334.aspx تم التصفح إبريل 2025.
[54]) محمد يحيى إمبابى عبد الخالق، مرجع سبق ذكره.
[55]) قطاعات الاقتصاد المصري، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، https://www.sis.gov.eg/section ،، تم الدخول إبريل 2025.
[56] )“مصر وتركيا“، بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تعديل 15 فبراير 2024، تسجيل دخول 28 إبريل https://www.sis.gov.eg/Story/270980/مصر-و-تركيا?lang=ar.
[57]) شيرين شلبي، العلاقات السياسية بين مصر والخلافة العباسية (القاهرة: جامعة عين شمس، 2020)،تسجيل دخول 28 إبريل https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/169426.
[58]) محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، مدونة محمد إلهامي، 10 ديسمبر 2017، تسجيل دخول 28 إبريل https://melhamy.blogspot.com/2017/12/blog-post_10.html.
[59])الهيئة العامة للاستعلامات، “مصر وتركيا”، https://www.sis.gov.eg/Story/270980.
[60]) بوابة الأهرام، “العلاقات المصرية – التركية.. ثبات على المبادئ من أجل دول الجوار واستقرار الشرق الأوسط”، https://gate.ahram.org.eg/News/4702189.aspx.
[61])الهيئة العامة للاستعلامات، “مصر وتركيا”، https://www.sis.gov.eg/Story/270980.
[62])نفس المرجع السابق.
[63])بوابة الأهرام، “العلاقات المصرية – التركية.. ثبات على المبادئ من أجل دول الجوار واستقرار الشرق الأوسط”، https://gate.ahram.org.eg/News/4702189.aspx.
[64]( Abdel Ghafar, A. (2022, November). Egyptian foreign policy during the Sisi era. Middle East Council on Global Affairs. https://mecouncil.org/publication/egyptian-foreign-policy-during-the-sisi-era/
[65]( Meliha Benli Altunışık, “Turkey’s Eastern Mediterranean Quagmire,” Middle East Institute, February 18, 2020, https://www.mei.edu/publications/turkeys-eastern-mediterranean-quagmire.
[66])Alistair Taylor, Mirette Mabrouk, and Rauf Mammadov, “Energy and Geopolitics in the Eastern Mediterranean,” Middle East Institute, podcast audio, June 19, 2019, https://www.mei.edu/multimedia/podcast/energy-and-geopolitics-eastern-mediterranean
[67] )”مصر واليونان تقطعان الطريق على تركيا بـ«تعيين الحدود البحرية».” الشرق الأوسط، 6 أغسطس 2020. https://aawsat.com/home/article/2434061
[68]) إعادة العلاقات التركية المصرية: خلفياتها وأبعادها المحتملة.” قاسيون للدراسات، 12 يوليو 2023. https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/78132-2023-07-12-14-14-23
[69]) توفيق بوستي، “التدخل التركي في ليبيا: الدوافع والتداعيات”، المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية، 12 يناير 2024، https://mediterraneancss.uk/2024/01/12/turkish_-intervention_-in_-libya
[70]) أسباب، “فرص تدخل مصر العسكري في ليبيا”، أسباب، يوليو 2020، https://www.asbab.com/
[71])محمد القايدي، الأزمة الليبية: الفواعل المحركة للصراع والمسارات المستقبلية، موقع مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، https://mediterraneancss.uk/2023/09/11/libyan-crisis/، تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
[72])مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، تداعيات وانعكاسات التدخل التركي فى ليبيا على الأمن القومى المصري من الفترة (2011-2020)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية-جامعة قناة السويس، مجلد (12) ع3، يوليو 2021، ص89-90.
[73])نفس المرجع السابق، ص93.
[74])ابتهال السيد، العلاقات المصرية التركية بعد ثورة 25 يناير2011، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية-جامعة قناة السويس، مجلد(11) ع2 الجزء الأول، أكتوبر 2020، ص11.
[75])وليد محمد صديق، الأزمات الناتجة عن تغير الدور المصري عقب 25 يناير و أثره على العلاقات الخارجية، المؤتمر السنوي السادس عشر-جامعة عين شمس، 2011، موقع دار المنظومة، https://search.mandumah.com/Record/113336 ، تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
[76])نفس المرجع السابق
[77])عبد المنعم المشاط، السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، موقع دار المنظومة، https://search.mandumah.com/Record/704264 ، تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
[78](ابتهال السيد، مرجع سبق ذكره، ص22.
[79] (شيماء فرحان، العلاقات التركية المصرية بعد عام2011، المركز الديمقراطي العربى، برلين-ألمانيا، 2020، https://democraticac.de/?p=6550 تاريخ الاطلاع إبريل 2025.
[80] (نفس المرجع السابق
[81] (Khalil Al-Anani, Egypt-Turkey Relations: Challenges and Future Prospects, Arab Center Washington DC, 2022.
[82] (Ali Bakir, Egypt-Turkey normalization: Ankara`s perspective, Atlantic Council, 2023.
[83] ) يوسف حسين، تركيا: التاريخ السياسي الحديث و المعاصر(1923-2018)، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، 2021.
[84]) نفس المرجع السابق
[85]) سلوى السعيد فراج ، رشا عطوة عبد الحكيم ، انعكاس صراعات الغاز الجديدة على الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط ، مجلة كلية السياسة والاقتصاد ، العدد 12 ، 2021.
[86]) رنيم علي جمال الدين الغنام ، الصراعات الدولية والإقليمية على الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط (2009_2019)، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية، مجلد (7) ع 14، يوليو 2022.
[87]) وزير خارجية تركيا: نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر وبخاصة الاقتصادية” ، الأهرام ، 13-4-2023.
[88]) رنيم على جمال الدين الغنام، مرجع سبق ذكره، ص571.
[89]) نفس المرجع السابق، ص 577.
[90])إسماعيل محمد إسماعيل حسن، الانعكاسات الاقتصادية لتعيين الحدود البحرية المصرية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية- جامعة قناة السويس، مجلد(13)ع3، يوليو 2022، ص24-26.
[91])محمد سعادى، سيادة الدولة على البحر فى القانون الدولي العام، ط١، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص169.
[92])إبراهيم سعود حميد أبوستيت، ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المقابلة وفقا لأحكام القانون الدولي العام، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية-جامعة مدينة السادات، مجلد(10) ع3، سبتمبر 2024، ص 896-897.
[93])إسماعيل محمد إسماعيل حسن، مرجع سبق ذكره، ص30.
[94])نفس المرجع السابق، ص31-32
[95]) رنيم على جمال الدين الغنام، مرجع سبق ذكره، ص605-606.
[96])نفس المرجع السابق، ص605.
[97])منى سليمان، التحالف المصري-اليوناني ـالقبرصي وتغيير موازين الشرق الأوسط، موقع مجلة السياسة الدولية، https://www.siyassa.org.eg/News/15423/ ، تم التصفح إبريل 2025.
[98])رنيم على جمال الدين الغنام، مرجع سبق ذكره، ص582.
[99])منى سليمان، مرجع سبق ذكره.
[100])منى سليمان، لماذا تعترض تركيا على التنقيب المصري-القبرصي عن غاز شرق المتوسط؟، موقع مجلة السياسة الدوليةhttps://www.siyassa.org.eg/News/15553/.aspx ، تم التصفح إبريل 2025.
[101]) مى سيد محمود محمد، السياسة الخارجية التركية تجاه الأزمة الليبية 2011-2020، موقع المركز الديموقراطي العربي، برلين-ألمانيا، https://democraticac.de/?p=82827 ، تم التصفح إبريل 2025.
[102]) نفس المرجع السابق
[103]) مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، تداعيات وانعكاسات للتدخل التركي فى ليبيا على الأمن القومى المصري من الفترة (2011-2020)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية-جامعة قناة السويس، مجلد (12) ع3، يوليو 2021، ص 88-91.
[104])أحمد على جلال، أثر التدخل التركي فى المنطقة العربية على الأمن القومي العربي: دراسة حالة الفترة من 2011-2021، مجلة كلية السياسة والاقتصادـ جامعة بنى سويف، عدد (22)، إبريل 2024، ص28-34.
[105]) منى سليمان، دوافع جولة أردوغان الإفريقية فى نهاية 2017 وتأثيراتها فى الأمن القومي العربي، موقع مجلة السياسة الدولية https://www.siyassa.org.eg/News/15467/ ، تم التصفح إبريل 2025.
[106])أحمد عسكر، تداعيات تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال، موقع مجلة السياسة الدولية، https://www.siyassa.org.eg/News/15281 4.aspx ، تم التصفح مايو 2025.
[107])مصر تتدخل عسكريا فى الصومال وأثيوبيا تحذر، موقع مركز تقدم للدراسات، https://www.arabprogress.org/ ، تم التصفح مايو 2025.
[108])كرم سعيد، تحركات مكثفة..دوافع التقارب المصري التركي، موقع مجلة السياسة الدولية، https://www.siyassa.org.eg/News/21778.aspx
[109]( Selina Kaur Rai, What Were the Causes and Consequences of the 1948 Arab-Israeli War?, University of Leicester, 11/2013 https://www.e-ir.info/2014/01/15/what-were-the-causes
[110]) آيه رجب أبو اليزيد – أحمد حسام علواني – إيمان أحمد قمر – محمد المغازي الخواجة – يوسف السيد الحطاب، “جيوبولتيك القوى الإقليمية المعاصرة في الشرق الأوسط..(إيران وإسرائيل نموذجاً)”، دراسة بحثية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2024
[111]( Selina Kaur Rai, Op.cit
[112] (Peter Hahn , “The Suez Crisis (1956)” , Origins: Current Events in Historical Perspective, October 2021
https://origins.osu.edu/milestones/suez-crisis-1956.
[113])الهيئة العامة للاستعلامات، انتصارات أكتوبر، 22 نوفمبر 2023، ، https://beta.sis.gov.eg/ar
[114]) نفس المرجع السابق
[115] ) آيه رجب أبو اليزيد – أحمد حسام علواني – إيمان أحمد قمر – محمد المغازي الخواجة – يوسف السيد الحطاب، مرجع سبق ذكره.
[116] )مهاب عادل حسن، التداعيات الجيوبوليتيكية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في ضوء عملية “طوفان الأقصى”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخميس 1 مايو 2025
[117]) صالح النعامي ، العلاقات المصرية-الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، 2017، ص 35.
[118])مهاب حسني النحال، المتغيرات الداخلية والخارجية وتأثيرها على السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحولات الاستراتيجية فى المنطقة العربية بعد 2011، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد9، 2020 ص 1-40.
[119]) صالح النعامي، مرجع سبق ذكره، ص 37.
[120]) صلاح سمير، (2018)، العلاقات المصرية الإسرائيلية علي ضوء المتغيرات السياسية المصرية ، وضرورة إعادة النظر في معاهدة السلام. مجــلة الدراسات الاستراتيجــية والعسكرية، العـدد الثاني، ص13.
[121]) نفس المرجع السابق.
[122])نفس المرجع السابق.
[123]( Segell, G. (2013, ’December 12). Mohamed Morsi, Egypt “ND Israel. E-International Relations
[124]) نهى الشريف. (2021، 18 أكتوبر). السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي.. سنوات الازدهار الحقيقية. مجلة السياسة الدولية. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2025، متاح على https://www.siyassa.org.eg/News/18156.a’px
[125]( Soliman, M. (2016, July 29). Sisi’” new approach to Egypt-Israel relations. The Washington Institute for Near East Policy. Retrieved April 25, 2025, from https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/sisis-new-approach-egypt-israel-relations
[126]) المركز المصري للدراسات الاقتصادية. (2011، مايو). الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير: التحديات الحالية ورؤية مستقبلية (آراء في السياسة الاقتصادية، العدد 27).
[127] ) هيثم حسنين. (2016، 2 نوفمبر). التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وإسرائيل (المرصد السياسي، 2721). معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2025، من https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
[128] ) نفس المرجع السابق.
[129])أميرة سمير، محددات اتجاهات الشباب المصرى نحو معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، المجلة المصرية لبحوث الرأى العام, 14(2), 2015، ص 365-412.
[130]) دينا سليمان كمال، (2020، 27 فبراير)، الإعلام وتأثيره والسياسة الخارجية، المركز الديمقراطي العربي، برلين-ألمانيا،تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2025،متاح علي: https://www.democraticac.de/”p=64961
(2Lavie, Limor & Yefet, Bosmat. (2022). The Relationship between the State and the New Media in Egypt: A Dynamic of Openness, Adaptation, and Narrowing. Contemporary Review of the Middle East.
[132] ( مهاب حسني، مرجع سبق ذكره.
[133] ( سعد حسين محمد شريف، رانيا عبد الرحمن الديربي عبد العال، رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وتأثيرها على سياستها الخارجية خلال الفترة(2011-2019). المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 13(3)، 2022، ص 90-139
[134]( طلال عوكل، الانتفاضة: الدوافع والتداعيات والآفاق، موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، https://www.palestine-studies.org/ar/node/1635810 ، تم التصفح إبريل 2025.
[135] (محمود محارب، الحرب الإسرائيلية على غزة، مجلة سياسات عربية، مجلد (2) ع10، سبتمبر 2014.
[136])Singh, Michael, Axis of Abraham: Arab-Israeli Normalization could remake the middle east, The Washington institute for near east policy, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/axis-abraham-arab-israeli-normalization-could-remake-middle-east
[137] (رنيم على جمال الدين الغنام، مرجع سبق ذكره، ص 609_611.
[138](مصطفى اللباد، مصر وإسرائيل: بين الضرورات الأمنية وحدود التطبيع ، مجلة رؤى استراتيجية، مركز الأهرام، العدد 7، 2016 .
[139])إسماعيل محمد إسماعيل حسن، مرجع سبق ذكره، ص36.
[140])هانى رسلان، الدور المصري فى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: من الوساطة إلى الضغط، مركز الأهرام للدراسات السياسية، 2015.
[141])أحمد ناجى قمحة، القوة الاستراتيجية للدور المصري توازن الاستجابة فى التعامل مع أطروحات التهجير: بين الالتزام بالثوابت والتكيف مع المتغيرات، مجلة السياسة الدولية، مجلد (60) ع240، إبريل 2025 .
[142] )نفس المرجع السابق