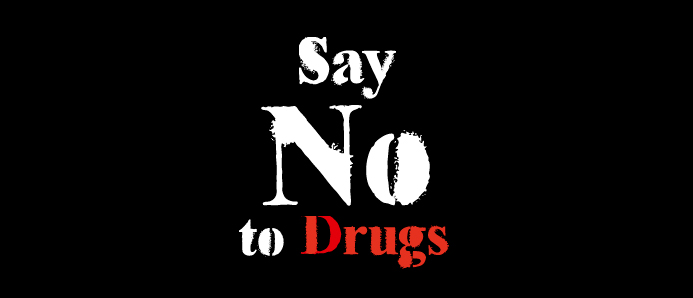الرقابة على استعمال الحق في التقاضي في ضوء مبدأ حسن النية: دراسة مقارنة
Judicial Control over the Exercise of the Right to Litigation in Light of the Principle of Good Faith: A Comparative Study

اعداد : أمير أحمد فتوح حجي – طالب – الجامعة الأردنية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
| ملخص |
| هدفت الدراسة إلى بيان دور حسن النية كمعيار لتمييز الاستعمال المشروع او مناقضته في التقاضي، من خلال استعراض نظرية إساءة استعمال الحق في التشريع الأردني وأحكام المقاضاة الكيدية في التشريع الفلسطيني، وفق المنهج المقارن لبيان أوجه التمايز من حيث نطاق الولاية القضائية المشمولة بالرقابة القضائية، وتوصلت الدراسة إلى أن المقاضاة الكيدية تقتصر على دعاوى محددة، اوردتها المادة (30) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944، ويشترط لقيامها توافر القصد السيئ والتوقع غير المعقول، بينما تمثل نظرية إساءة استعمال الحق في التشريع الأردني اطارا رقابيا يشمل كافة الدعاوى وجميع أوجه الاستعمال غير المشروع في التقاضي استنادًا إلى المادتين (61) و(66) من القانون المدني، و خلصت الدراسة إلى أن حسن النية يمثل أداة فاعلة لتحقيق الرقابة القضائية، سواء بالاستناد الى المعيار الشخصي أو الموضوعي، مع ترجيح للأخير لما يتمتع به من عدالة وواقعية بالقياس على سلوك الشخص المعتاد، ولما اعترى المعيار الشخصي من صعوبات توجب الغور في كنة المتقاضي ونواياه الاجرائية، وتناولت الدراسة ،مبررات التقاطع بين حسن النية مع الغلط بالقانون في مجال التقاضي، كما اوضحت حقيقة مبدأ “لا يعذر احد لجهله بالقانون وامكانية الدفع فيه من المكلفين العاديين ضمن نطاق الدعاوى المدينة حصرا شريطة عدم تعارضه مع القواعد الامرة.
الكلمات المفتاحية: الحق بالتقاضي، المسؤولية التعسفية، مبدأ حسن النية، الغلط الشائع، لا يعذر أحد لجهله بالقانون |
| Abstract |
| The study aimed to clarify the role of good faith as a criterion for distinguishing between legitimate and illegitimate litigation, through examining the doctrine of abuse of rights under Jordanian legislation and the provisions governing vexatious litigation in Palestinian legislation. Adopting a comparative approach, the study explored the similarities and differences in terms of the scope of claims subject to judicial review.
The study concluded that vexatious litigation is confined to specific claims enumerated under Article (30) of the Civil Wrongs Law No. 36 of 1944, which requires the presence of bad intent and unreasonable anticipation. In contrast, the doctrine of abuse of rights under Jordanian legislation constitutes a broader framework of judicial oversight encompassing all claims and every form of unlawful use of litigation, pursuant to Articles (61) and (66) of the Civil Code. Furthermore, the study found that good faith serves as an effective tool for judicial review, whether based on a subjective or an objective standard, with preference given to the latter due to its fairness and practicality, measured against the conduct of a reasonable person. This preference is reinforced by the inherent difficulties of the subjective standard, which necessitates delving into the litigant’s mindset and procedural intentions. The study also examined the overlap between the concept of good faith and legal error, noting that ignorance of the law may, in limited circumstances, be excused for ordinary litigants in civil claims exclusively, provided that such ignorance does not conflict with mandatory legal provisions. Keywords: Right of Access to Justice; Abusive Liability; Principle of Good Faith; Common Mistake; Ignorance of the Law Excuses No One. |
- 1. المقدمة
بادئ الامر؛ لم يرد لدى الفقه العربي، كلمة إساءة أو تعسف في استعمال الحق، وهو تعبير وافد من فقهاء القانون الغربي المحدثين، وورد في بعض كتب الأصول كلمة “الاستعمال المذموم” تعبيرا عن التعسف أو اساءة استعمال الحق بالمعنى المراد اليوم، ويبقى المدلول واحد (الدريني، 1998، ص44) ولقد اقرت الشريعة الإسلامية مبدأ إساءة استعمال الحق، على انه نظرية عامة، وعني الفقه الإسلامي في تنظيمها على وجه يقال” انه تنظيم فاق في دقته واحكامه أحدث ما اسفرت عنه مذاهب الفقه الغربي. (الزرقا، 1987، ص11)
وتتميز نظرية التعسف بخصوصيتها التي تتميز بها عما سواها من صور المسؤولية الشخصية، فهي بمثابة المبدأ العام الذي يمكن تطبيقه على التصرفات والأعمال القانونية عموما (السرحان، وخاطر، 2023، ص347) ويبرز في هذا السياق دور حسن النية، فكل ما يقتضيه حسن النية تقره العدالة، وكل مبدأ تقره العدالة يتماثل مع مقتضى حسن النية، مما دعا لتبرير نظرية التعسف، استنادا الى مبدأ حسن النية (بكر، 2025، ص11 (فانتفاء التعسف، أحد مظاهر حسن النية. (السويطي، 2018، ص108)
أ. مرتكزات نظرية إساءة استعمال الحق
يرى جانب من شراح الفقه ؛ ان نظرية إساءة استعمال الحق طريقة استثنائية منحها الشارع لمن يقع ضحية استعمال غير مشروع ليست ثمة طريقة أخرى لأبطاله، فلا سبيل للنظرية ما دام هناك سبيل اخر لرفع الضرر سواء بنص قانوني او قيد خاص او سواهما (القوتلي، 1963، ص866) ومرد الاستثناء، أن الفعل لا يجوز ان يكون مشروعا من جهة وغير مشروع من الجهة الأخرى، وهو ما عبر عنه الفقيه الفرنسي paniolo بقوله ” ينتهي الحق عندما يبد التعسف ” (يوسف، 2025، ص59) فالحق والتعسف لا يجتمعان فإذا وجد الحق ارتفع التعسف، وان وجد التعسف انتفى الحق (أمين، 1991، ص19) غير هذا التصور للفقيه ” paniolo يثير اشكالا ، يتمثل في تعارضه مع الدور الوقائي للنظرية يقوم على مبدأ سد الذرائع ويهدف الى درء أي استعمال غير مشروع للحق (الدريني، 1999، ص170 ) وهي مرتكز النظرية فهي ترد على فعل مشروع بالاصل لذاته ثم ينقلب غير مشروع لانحراف في غرضه أو نتيجته (كيرة، 1969، ص759) ومن ثم فهي تسعى الى إرساء التوازن بين مصلحتي الفرد والجماعة، على نحو يضفي على الحق صفة اجتماعية عامة لتصبح النظرية بمثابة دستور لمباشرة الحقوق في ضوء تطور قواعد العدالة، بما يتيح للنزعة الأخلاقية في التشريع إحاطة مصلحتي الفرد والجماعة معا “(الدريني، 1977، ص33)
ويعرف التعسف / إساءة الاستعمال “مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون به شرعا بحسب الأصل، (الدريني، 1999، ص80) ويستعمل الفقه ؛ لفظي التعسف والإساءة في استعمال الحقوق الإجرائية بمعنى واحد مترادف، حيث تعتبر الإساءة احدى مظاهر التعسف في ممارسة الحق والواجب الاجرائي (قطب، 2006، ص83) وعبرت محكمة التمييز الاردنية عن ذات الاتجاه ” ان اساءة استعمال الحق هو الإساءة التي تقع نتيجة استعمال الحق الخاص بصاحبه دون غيره، والإساءة في استعمال الحق تكون بتجاوز حدود الحق المرسومة قانون وبالتالي يكون الاعتداء والتجاوزعلى هذا الحق مضموناً مُطلقا”(تمييز حقوق رقم 2363 لسنة 2023) ويمكن تعريف إساءة استعمال الحق” ابراء الحق؛ من الاستعمال غير المشروع له.
ب. دور النظرية برقابة الاستعمال غير المشروع بالتقاضي
مع تطور نظرية التعسف بالتشريع الأردني، أصبح من مظاهرها، إساءة استعمال حق التقاضي والذي يتميز بطابع خاص، يتمثل في إتيان المدعي صاحب الحق الإجرائي، سلوكا ماديا يتمثل في رفع دعوى ليس له فيها مصلحة مشروعة”( محكمة استئناف عمان قرارها رقم 8214 /2020) والاصل في ذلك ؛ ان قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان سندا للمادة 61 من القانون المدني الاردني نقلاً عن المادة 91 من مجلة الأحكام العدلية المستمدة من فقه الشريعة الإسلامية، تعد من الناحية الموضوعية قاعدة دستورية تتضمن مبدأ من مبادئ الدستور وما يقتضيه من ضوابط تلزم صاحب الحق حتى ولو كان دستورياً محصناً وقانونياً صاحب رخصة مصانة بأن يستعمل حقه الدستوري أو رخصتـــه القانونية استعمالاً مشروعا.(تمييز حقوق رقم 7041- لسنة 2022 )
ومن المقرر بالفقه والقضاء الأردني؛ أن الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق، يقوم على الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية..”( تمييز حقوق914، لسنة 2020 ) وقوام هذه المسؤولية يعبرعنه بالفعل الضار” وهو الجزاء الذي يترتب على الشخص نتيجة الاخلال بالتزام قانوني، يتمثل بعدم الإضرار بالغير بمختلف صور الاضرار( الجبوري، ص 319) ويكون الاضرار غير المشروع مصدرا للمسؤولية في حدود النصوص القانونية التي تحكمه ( السرحان، 2023 واخرون، ص342) ولا يكفي للقول بثبوت المسؤولية التقصيرية، عن هذا الاضرار” مجرد تحقق الانحراف او التعدي في سلوك شخص معين، بل يجب ان يكون هذا الانحراف نجم عن وعي وأدراك ( دواس، 2012، ص 24 ) ويمكن القول” ان التعدي ركن المسؤولية التقصيرية وهو مباشرة الفعل الضار دون الدخول في كنة نفسية الفاعل أو التحري عن مدى وجود القصد لديه أو عدم وجوده، ومن ثم فأن التعدي بهذا المعنى لا يقابل الخطأ بالمعنى القانوني وهو الإخلال بواجب قانوني مقترنا بقصد الإضرار أو إمكان توقع الضرر منه على الأقل، بينما يتضمن التعدي مفهوما اشمل يتسع لكل العمد أو الخطأ. (بكر، 2025، ص 38)
لما كان المشرع الأردني قد اسس المسؤولية المدنية عن الفعل الضار على فكرة الإضرار، ويعني احداث الضرر بفعل غير مشروع او على نحو يخالف القانون (السرحان، 2023، ص 353 ) ولقد استقر قضاء التمييز” ان الاضرار مناط المسؤولية المدنية ولو صدر عن غير مميز ويستلزم الفعل الذي ينشأ عنه الضرر وعلاقة السببية بينهما ( تمييز حقوق رقم 654 لسنة 1999 ) غير ان محكمة التمييز وفي اطار معالجته لمظاهر الاستعمال غير المشروع بالتقاضي، اتجهت الى إرساء قاعدة مستحدثة مؤداها قيام المسؤولية عن إساءة استعمال هذا الحق، على أساس المسؤولية التقصيرية، وبذلك لم يقتصر قضاء التمييز على مفهوم الاضرار ذو الطبيعة المادية والذي لا يستند الى أي عنصر شخصي يكمن في إرادة محدث الضرر او مستوى ادراكه وتمييزه بل قرر وجوب التعويض دون قيد او شرط، سندا لقاعدة ” أن فعل المباشر يعد علة الضرر دون ان يقترن الضمان فيه بالتعمد او التعدي (الجبوري، 2023، ص332 )
ويبرر القضاء الأردني هذا التحول في المسؤولية عن إساءة استعمال الحق بالتقاضي” استنادا الى المادة 61 من القانون المدني تضمنت قاعدة عامة ان كل من يستعمل حقه وفقا للأصول، والاسس المقررة في القانون ولم يكن في استعماله لحقه متعسفا او مسيئا فانه لا يضمن الضرر الذي يلحق بالغير وبمعنى اخر فأن الأصل هو عدم ضمان الاضرار في حال استعمال الحق استعمالا مشروعا، اما حال توافر احدى معايير التعسف، فتنتقل المسؤولية من دائرة المشروعية الى دائرة عدم المشروعية ويقع عبئ اثبات التعدي والتعسف في استعمال الحق على عاتق المدعي” ( تمييز حقوق رقم 6147 لسنة 2022) وعليه فان ثبوت الضرر في هذه الحالة ، مشروط بتوافر الخطأ التقصيري باعتباره مظهر من مظاهر الاستعمال التعسفي للحق بالتقاضي ، وهو ما يمثل مناط الحكم بالتعويض ويمكن القول ان هذا التوجه القضائي يمثل تطورا في مفهوم إساءة استعمال الحق ، فلم يعد مناط المسؤولية المدنية مرتبطا بمجرد وقوع الضرر بصرف النظر عن أهلية فاعله وإنما أُقام القضاء قرينة ، مفادها ثبوت الخطأ بمعناه القانوني ، والماثل في الانحراف عن الاستعمال المشروع لحق التقاضي.
وإذا كان ما تقدم بيانه يشكل مبررا للتحول القضائي في قواعد المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني التي تقوم على أساس المسؤولية الموضوعية طبقا للمادة 256 من القانون المدني ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) الى الإخذ بعلة التسبب التي تشترط أن يكون الفاعل ذو ادراك وتمييز، وقوامها مفهوم التعدي بمعناه الواسع بالفقه الإسلامي والذي يلتقي مع مفهوم الخطأ بالفقه الغربي، بما يصور الخطأ في القانون الأردني كمرادف للتعدي في الفقه الإسلامي (المذكرة الايضاحية، 2019، ص 279 ) ويرى اتجاه بالفقه ؛ ان هذا النهج الذي سلكه المشرع الأردني هو النهج الاسلم والأكثر تلبية لموجبات التطور والحداثة التشريعية، التي تساهم في حماية مصلحة المضرور (عسقلان، 2008، ص 143) وفي المقابل يرى اتجاه اخر ؛ أن المشرع الأردني وقع في حالة تناقض تشريعي، لان الإضرار هو بذاته عمل غير مشروع وهو ما يتعارض بالأصل مع المادة 257 من القانون المدني الاردني 1-يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب2-فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد، أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر”. ومن ثم فالقول بعدم اشتراط التعدي في حالة المباشرة تتعارض مع القاعدة الفقهية” أن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفق المادة 61 من ذات القانون وعليه لا يكون الشخص مسؤولا إلا إذا أتى فعلا تجاوز حدود حقه وبذلك فلا يترتب على الشخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله إذا كان الفعل الذي أتاه جائزا من الناحية القانونية، وهذا ما يميز مفهوم التعدي عن مفهوم الخطأ والذي يتطلب إضافة إلى الركن المادي وهو الإخلال بواجب قانوني” توافر قصد الإضرار بينما لم يتطلب التعدي قصد الاضرار( بكر، 2025 ص 36) والواقع؛ ان الأضرار بالتسبب قد يتحقق بالفعل أو عدم الفعل أو التقصير والإهمال وهو الإخلال بالتزام قانوني وعليه فإن قيام المباشرة أو التسبيب بشروطها يكفي لإضفاء عدم المشروعية على الأضرار فتقوم مسؤولية فاعله( تمييز حقوق رقم 6275 لسنة 2022 ) غير ان التسبب ليس علة مستقلة عن الضرر، وانما يلزم ان يقترن بصفة الاعتداء ليكون موجبا للضمان. (دواس، 2012، ص 140)
ويمكن القول؛ أن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية، مختلف جوهريا عن نظرية اساءة استعمال الحق فألاولى؛ تنطلق من فعل غير مشروع في ذاته سواء كان تعديا او خطأ تقصيري، بينما تقوم نظرية إساءة استعمال الحق على فعل مشروع بذاته، غير ان استعماله هو من يقرر حقيقة انحرافه عن اصله المشروع، وهو ما يجعل التعدي قاصرا على استيعاب حالات الاستعمال غير المشروع في مجال التقاضي، سيما وان نظرية إساءة استعمال الحق لا تقوم بالأصل على معيار التعدي بطريق التسبب (الدريني، 1998 ص64 ) ويشاطر الأستاذ مصطفى الزرقا ” ما ذهب اليه الدكتور الدريني ” في استقلال نظرية إساءة استعمال الحق عن موضوع الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية ( الزرقا، مصطفى 1980 ص 19) والواقع؛ ان هذه النظرية رقابية بالأصل على استعمال الحق او المنفعة المبتغاة من استعماله، وبالتالي تتجاوز نطاق المسؤولية التقصيرية، فلا تنحصر وظيفتها الرقابية، في مجرد المسائلة عن الاخلال بالتزام قانوني او اهمال يقتضي التعويض. ويسندنا بهذا المعنى” قول الدكتور فتحي الدريني” ان محاولة إدراج التعسف في نطاق المسؤولية التقصيرية لا ضرورة له بعد إفراد التعسف ضمن نظرية عامة في التقنيات العربية وبنصوص عامة ليس ثمة حاجة تدعو إلى مثل هذا الاصطناع بعد تبين أن فكرة الخطأ التقصيري تقصر عن ان تتسع لاستيعاب جميع حالات التعسف” (الدريني، فتحي، 1998 ص 287)
والواقع ان إقرار التعدي كضابط لثبوت الفعل التعسفي يعتريه التعارض، لأنه ينتقل بالمسؤولية التعسفية إلى نطاق الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية، في حين انها ليست نطاقها الصحيح ( دواس، 1991 ص 212 ) ومرد التناقض ان الاشكالية التي تثيرها فكرة إساءة استعمال الحق، مشكلة أولية سابقة على مشكلة المسؤولية لا يتصور حلها سوى في مضمون الحق وجوهره ( كيرة، 1969 ص 766 ) كما ان فكرة المسؤولية التعسفية، يبرز دورها الرقابي بتحري غاية استعمال الحق وهو ما يستلزم مشروعية الفعل اللازم للاستعمال بالأصل(محمد، 2025 ص 30) لكن التعدي عمل بدون حق ولا جواز شرعي، واقتران التعدي باساءة الاستعمال لوجوب الضمان ،يعني بالمفهوم المخالف انتفاء الضمان عند عدم التعدي أي في كل مرة يكون العمل فيها جائز شرعا سندا للقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان (الدريني 1998 ص 60،) ويكشف الواقع ان كل من يستعمل حقا او يأتي عملا مضرا بالغير ولا يجني من ورائه أية فائدة أو نفع؛ لهو كمن نوى وقصد الإضرار على حد سواء (القواتلي، 1966، ص 852 ) و تتجلى هنا ؛ فكرة المسؤولية التعسفية وهي مسؤولية مطلقة غير مشروطة بالخطأ او التعدي بطريق التسبب ، ثم اذا كان مبرر الاخذ بالمفهوم المتطور لفكرة التعدي يقوم على العوامل النفسية كما في تعمد الإضرار أو الإهمال أو عدم التبصر فإن بعض هذه الحالات يتحقق فيها معنى التعسف لمجرد حدوث واقعة الضرر على قدر من الجسامة دون نظر إلى العناصر الذاتية من الدوافع والبواعث أو الإهمال والتقصير في اتخاذ الحيطة، كما في حالة تفاوت المصلحة كمعيار لثبوت إساءة استعمال الحق” ويبرز هذا المعيار قبل وقوع الفعل ذاته، لمجرد توقع الضرر ورجحان احتماله، فتعمل النظرية كآلية وقائية تحول دون وقوعه، وهو ما يخرج عن نطاق قاعدة التعدي بالتسبب وكذلك عن حدود المسؤولية التقصيرية (الدريني، 1977، ص 29).
ويبرز هذا التداخل في موقف المشرع الأردني نهوض ضابطان لقياس الاستعمال غير المشروع بالتقاضي، أحدهما شخصي ويتمثل بكون الفعل متعمدا بأن توافرت لدى المعتدي نية الاضرار بالغير قاصدا الفعل وما نجم عنه من نتيجة ضارة بالغير (دواس 2012 ص 33( والأخر معيار موضوعي ينصب على التعدي ويقاس بعناية الرجل المعتاد (بكر 2025، ص 38 )
ويتحقق الضمان عنه بثبوت الإهمال أو التقصير او الانحراف عن مقتضى الاستعمال المشروع ، بما يقتضي تبصرا في التصرف ببذل عناية الرجل الحريص واما السلوك المعتاد بين الناس فلا يعد تعديا ولا يرتب الضمان على ما ينشأ من ضرر لكونه مأذون شرعا( الجبوري، 2023 ص 337 )
ويرشدنا هذا التعارض التشريعي بين مفهومي الاضرار والتعدي كمعيار للاستعمال غير المشروع بالتقاضي ” ان محكمة التمييز الأردنية اخذت في ثبوت التعدي بالمعيار الموضوعي؛ مغايرة للمعيار الشائع بقياس قصد الاضرار في نظرية إساءة استعمال الحق وهو المعيار الذاتي او الشخصي(الدريني، 1998 ص 226 ) وفي هذا المعنى تقول محكمة التمييز “ان مجرد إحداث الضرر تسببا لا يكفي لقيام العمل غير المشروع أو الإضرار للمساءلة فاعله بالتعدي، بل يجب ان ينجم عن الفعل ضرر ومعيار التعدي هنا معيار موضوعي يتمثل في السلوك المعتاد بين الناس بحيث يعد أي انحراف عليه تعديا يوجب الضمان” وأما السلوك الموافق للشخص المعتاد او المألوف بين الناس فليس من التعدي ولا يوجب ضمان ما ينشأ عنه لكونه مأذون فيه شرعا…. والتعدي أو الإضرار بالتسبب يكون بالفعل، أو عدم الفعل، أو بالتقصير او الإهمال وهو إخلال بالتزام قانوني وعليه فإن قيام شروط المباشرة أو التسبب، يكفي لإطفاء عدم المشروعية على الإضرار فتقوم مسؤوليته فاعلية.”( تمييز حقوق رقم 6257 لسنة 2022 ) وفي قول قضائي اخر للمحكمة ” إذا ارتكب الشخص دون وجه حق فعلا افضى الى الضرر وكان فعله هذا قد خالف ما يجب على الإنسان الحريص أن يفعله كان مسؤولا عن تعويض الضرر دون النظر إلى ما إذا كان قاصدا الإضرار أم لا بل دون النظر إلى مدى إدراكه وتمييزه لأفعاله ونتائجها ” فالتعدي عمل غير مشروع وعدم مشروعيته موضوعية تقاس بمعيار موضوعي لا علاقة له بإرادة الإنسان ودوافعه ( تمييز حقوق رقم 5534 لسنة 2021 ) لكن قضاء التمييز ” تناول وفي معرض تحديد معايير ثبوت اساءة استعمال الحق وفق المادة 66 من القانون المدني الأردني ، معيار تمحض قصد الإضرار ” بتسميته تعديا، فيكون استعمال الحق غير مشروع إذا كان لا يقصد صاحبه سوى إلحاق الضرر بالغير وهو في هذه الحالة يكون سيئ النية ويتحقق ثبوت المعيار و قوامه توافر نية الإضرار بالغير لدى صاحب الحق او مستعمله ويقاس سلوكه بمعيار ذاتي ( تمييز حقوق 853 لسنة 2021 )
وتتضح أهمية معيار قصد الاضرار بنظرية إساءة استعمال الحق، باعتباره الاكثر شيوعا في محال التقاضي، مما يقتضي ضبطه وفق معيار واضح لا سيما وان مفهوم التعدي وفق هذا المعيار؛ تضمن قاعدتان للمسؤولية، الأولى؛ أفصحت عنها المادة 256 من القانون المدني وتعد اساس نهوض المسؤولية في التشريع الأردني واما الثانية فقد تضمنتها المادة 257 من ذات القانون، وتتضمن التعدي بالتسبب، وتمثل استثناء عن الاصل المقرر بالمادة 256 من القانون المدني، والتي اوجبت الالتزام بعدم الاضرار بالغير وبنهوض المسؤولية حتى على غير ذي أهلية وادراك ( قريب من المعنى، دواس 2012 ص25 ) ومرد الامر؛ ان المباشرة علة مستقلة ومسوغ كاف بذاته لقيام المسؤولية، فلا يجوز اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد (علي، شرح المجلة، ص 93) غير ان معالجة المشرع الأردني لإساءة استعمال الحق بالتقاضي، بالاستناد الى معيار قصد الاضرار وقياسه بمفهوم التعدي؛ افضى الى تدافع تشريعي لا مبرر له، فقياس التعدي ثابت بمعيار موضوعي، بينما معيار قصد الاضرار ذاتي شخصي يستند الى نية الفاعل وارادته؛ مما قد يفضي الى اجتهادات متعارضة في تصور الاستعمال غير المشروع بالتقاضي تعديا وفق المعيار الموضوعي، او اضرارا وفق المعيار الشخصي، بما يجعل نطاق الاستعمال التعسفي مرجوحا بين الغاية
الوقائية لنظرية إساءة استعمال الحق ومنع الاضرار أو وسيلة احتياطية لاحقة لوقوع الاضرار ،مما يغني عن نظرية إساءة استعمال الحق ، الاكتفاء بقواعد المسؤولية التقصيرية. (بكر، 2025، ص 36)
ونخلص مما تقدم إلى أن النظام القانوني يسعى بطبيعته إلى إزالة ما يعتريه من عوارض ومعالجتها على أسس منطقية سواء تعلق الأمر بعوارض تجهيل القانون أو بتعارض قواعده عند التطبيق العملي، شأنه في ذلك كشأن معالجة العوارض التي قد تطرأ على إجراءات التقاضي (الزعبي، 2025، ص 607). وتتجلى مظاهر هذا التجهيل في التباين بين معيار قصد الاضرار كما ورد بالمادة (66) من القانون المدني الأردني، والذي تقوم على ضابط ذاتي أو شخصي يكشف عن القصد التعسفي في استعمال الحق الإجرائي، وبين ما أورده المشرع الأردني في المادة (257) من ذات القانون من تصور تشريعي يرتكز على فكرة التعدي، غير أن افتراض التعدي بوصفه مرادفا لقصد الإضرار لا يستقيم مع حقيقة نظرية إساءة استعمال الحق، التي استقى المشرع الاردني معاييرها من الفقه الإسلامي، بما ينسجم مع طبيعة المسؤولية المدنية في التشريع الأردني، حيث يمثل فعل الإضرار فيها اساس المسؤولية المدنية ، ومناط التعويض (المذكرة الإيضاحية، 2019، ص 284).
ومن جهة أخرى، قضت محكمة التمييز الأردنية، في ثبوت إساءة استعمال الحق بالتقاضي، بانتفاء المصلحة المشروعة، حيث قررت ان مناط قبول الدعوى يتمثل بالمصلحة الشخصية والمباشرة سندا للمادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية (تمييز حقوق رقم 6275 لسنة 2022) ويترتب على ذلك؛ التساؤل حول طبيعة المصلحة التي يؤدي انتفاؤها إلى ثبوت إساءة استعمال حق التقاضي؟
لا شك؛ ان المصلحة تمثل ” الفائدة او المنفعة العملية المشروعة التي تعود على رافع الدعوى (طلبا كانت او دفع) من الحكم له بطلباته او دفوعه كلا او جزءا ( الزعبي، عوض، 2020 ص 279 ) ولقد استعرضت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي؛ اوصاف المصلحة على نحو اوسع ” وجاء بالمادة 3/1 منه ” تسـتظهر الدائـرة وجـود مصلحـة للطالـب مـن جلـب نفـع أو دفـع ضرر، وتـرد مـا لا مصلحـة فيـه، سـواء أكان ً الطلـب أصليـا ً أم عارضـا. (نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية/موقع قضاء/الجمعية العلمية القضائية السعودية/مركز قضاء للبحوث والدراسات متوفر على الموقع الإلكترونيsa.org.qadha@m) ويبرز بذات اللائحة الحالات المتعلقة بالمصلحة التي تبرر قبول الحق الاجرائي بالدعوى لكنها لا تعني بالضرورة ثبوت الاستعمال الكيدي او الاضرار بالخصم بانتفائها. وسندنا بالقول ” ان المصلحة المقصودة لثبوت الاستعمال غير المشروع ضمن معايير إساءة استعمال الحق، تعرف بالمادة 66 من القانون المدني الاردني (بالمصلحة غير المشروعة) والتي لا تنهض إذا كان تحقيقها يخالف حكما من احكام القانون فحسب، بل يتصل بهذا الامر إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام او الآداب( المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني، 2019 ص 220)
ويبرز هنا تساؤل آخر: هل المصلحة التي أوجب المشرع الأردني توافرها لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع، وفقا للمادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تعكس مضمون المصلحة غير المشروعة الوارد في المادة (66) من القانون المدني، والتي تعد أحد معايير إساءة استعمال الحق؟ ولتوضيح هذا التمييز، نستعرض نقاط التشابه والاختلاف بينهما في الجدول التالي.
| المصلحة المشروعة لثبوت الحق الاجرائي | المصلحة غير المشروعة لثبوت إساءة استعمال حق التقاضي | |
| التعريف | هي المصلحة الشخصية والمباشرة التي يبتغيها المدعي قانونا، وتعد شرطا لازما لقبول أي دعوى، أو طلب، أو دفع أو طعن، (أبو الوفا، 2015، ص165). | لا تقوم على الفائدة الفردية المباشرة، فالمصلحة التي نصبتها المذكرة الإيضاحية معيارا لثبوت إساءة استعمال الحق، ليست مصلحة شخصية مجردة وإنما مصلحة عمومية تقدير مشروعيتها مرهون بما يعارضها من مصالح أخرى قد تكون أرجح أو مساوية أو مرجوحة، فإذا استعمل صاحب الحق، حقه استعمالًا مشروعًا بالأصل لكنه تعارض مع مصلحة أرجح في نظر القانون يعد مسيئا طبقا للنظرية (الدريني، 1998، ص37). |
| الطبيعة | ذات طبيعة إجرائية، وتمثل شرطًا وجوبيا لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع، وتستند المصلحة الى مركز قانوني أو مصلحة قانونية وتهدف للاعتراف بهذا الحق وحمايته بواسطة المطالبة القضائية (الزعبي 2025، ص 334) | ذات طبيعة موضوعية، وتمثل معيارا لتحديد إساءة استعمال الحق بالتقاضي، ولا تعد شرطا لقبول الدعوى او انتفائها، وانما ضابطا لثبوت الضرر غير المشروع بتمايز الاستعمال بين المشروعية والمناقضة (عبد الغني، 2016 ص 66) |
| العلاقة بسوء النية | تتحقق المصلحة بمجرد ثبوت منفعة مشروعة للمتقاضي” او بتأمينه من ضرر محتمل دون ضرورة للغور في نية المتقاضي الإجرائية عند مباشرة الادعاء. | يتحقق ثبوتها بعدم مشروعية الغاية من استعمال الحق، ولو كان استعماله مشروعا بالأصل في ذاته، ويعد سوء النية معيارا كاشفا على قصد الاضرار وثبوت المصلحة غير المشروعة. |
| التمييز بين المصلحة في الحق والدعوى | تتعلق المصلحة بالحق في الدعوى، وتعد مناط قبولها وباعثا في ثبوت الحق في التمسك فيها وهي ليست شرطًا لقبول الدعوى فقط، بل لقبول اي طلب أو دفع أو طعن (أبو الوفا، 2015، ص165). | تتعلق المصلحة بالحق الموضوعي ذاته، وقد تكون مادية أو أدبية يحميها القانون فاذا استعملت بالتعارض مع مصلحة أرجح منها اعتبر الاستعمال تعسفيا ولو لم يقع ضرر بسبب هذا الاستعمال، فهي مصلحة تفترض حتى قبل الاعتداء الحق(محمود، سيد، 2005 ص199). |
| نتيجة عدم تحقق شرط المصلحة | يؤدي انتفاء المصلحة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لغياب السند الإجرائي أو الدليل على ثبوت المصلحة القانونية، دون افتراض قانوني يرتب ثبوت إساءة الاستعمال او تحقق الكيد الاجرائي لمجرد عدم ثبوت المصلحة (الزعبي، 2025 ص 336). | يؤدي انتفاؤها الى ثبوت مشروعية استعمال الحق وغياب مظاهر الاستعمال التعسفي بالحق الاجرائي استنادًا إلى المواد (61-66) من القانون المدني الأردني (تمييز حقوق رقم 6275 لسنة 2022). |
| أثر القضاء في التثبت من المصلحة خلال التقاضي | يتمثل دور القضاء بالتحقق من وجود المصلحة كقرينة شكلية لقبول الدعوى او انتفاء الحق بالادعاء فيها، ويجوز للمحكمة او المتقاضين اثارة الدفع حول المصلحة، في اية مرحلة من مراحل الدعوى لتعقلها بالنظام العام. (الصاوي، 2010، ص 195) | يتمثل دور القضاء بأعمال رقابة وقائية على مشروعية استعمال الحق ومن ثم تقرير التعويض عند ثبوت الإساءة، بناء على ادعاء المتضرر بثبوت المصلحة غير المشروعة لكن المحكمة لا تبحث في ثبوت عدم مشروعية المصلحة من تلقاء ذاتها وانما بناء على طلب المتضرر (عبد الغني، ص91). |
ولم تتبنى مجلة الاحكام العدلية في التشريع الفلسطيني، نظرية إساءة استعمال الحق بصورة واضحة، غير ان قواعدها استوعبت في نصوص متفرقة الأسس التي نشئت خلالها النظرية ومن ابرز ما تضمنته قواعدها الفقهية ” لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطرت أو غلبت ” وهي معايير موضوعية لا تستند إلى شخص المسيئ بل كيفية استعماله للحق ومن ثم يمكن للقضاء الرجوع الى هذه القواعد، للتحري في مدى توافر الاستعمال التعسفي”(عبد المحسن، وخالد، 2020، ص13 وما بعدها) والثابت ان قواعد المسؤولية عن الفعل الضار في مجلة الاحكام العدلية كالمادة (22)”الضرر لا يزال بمثله ” والمادة (31)” الاضطرار لا يبطل حق الغير” لا تتعارض مع المادة 71 من قانون المخالفات المدنية باعتباره قانون خاص، تتقدم احكامه على قواعد المجلة، مع بقاء العمل بقواعد المجلة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المخالفات المدنية التي نظمها هذا القانون (دواس، 2012، ص44) وتجسد هذه القواعد في مجملها معايير نظرية إساءة استعمال الحق بالفقه الإسلامي ، الذي يعد الوعاء الاصيل للقانون المدني الأردني، ولقد اكدت مذكرته الإيضاحية، أن مبدأ إساءة استعمال الحق، أسس على قواعد الفقه الإسلامي، وليس مقصورا على الحقوق الناشئة عن الالتزامات، بل يمتد إلى الحقوق العينية وإلى روابط الأحوال الشخصية وإلى القانون التجاري وقانون المرافعات ويشمل القانون العام أيضا (القضاة، 2015، ص50) وقد استند القضاء الأردني الى المادة (61) من القانون المدني، المقتبسة بالمعنى والنص من المادة (91) من مجلة الأحكام العدلية، كقرينة على ثبوت النظرية في رقابة إساءة استعمال الحق بالتقاضي، الأمر الذي يؤكد أن المجلة لم تخل من تطبيقات النظرية بصورتها الحديثة في مواضع متعددة، وإن اختلفت صياغتها، لكن النتيجة تبقى واحدة .(عبد المحسن، وخالد، 2020، ص11 ) ويعزز هذا الا تجاه ما ورد في المادة 132/2 من قانون البينات الفلسطيني” نصت صراحة ” يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها.
ويمكن القول ان المشرع الفلسطيني، قد تفرد بالتصدي لإساءة استعمال الحق في التقاضي، عبر الية رقابية تمثلت في أحكام المقاضاة الكيدية، ويقصد بها ” إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة، جزائية كانت أو إفلاسيه أو إجراءات تصفية، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات” أ- أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته. ب- انتهت في مصلحة ذلك الشخص، إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته: ويشترط في ذلك ألا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص، لمجرد كونه قد قدم معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت هي إقامة الإجراءات” (المادة 30 قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944) وبذلك تستعمل دعوى المقاضاة الكيدية بالمخالفات المدنية واجبة الاثبات (دواس، ص21) وتعد من صور المسؤولية، التي تستوجب توافر سوء النية لإثباتها (نصرة، 2023، ص62). ويمثل القصد السيئ أساساً لقبول دعوى المقاضاة الكيدية، ولا تتحقق بدونه ولم يرد ضمن التعريفات الواردة بالمادة 2 من ذات القانون، تبيانا لمفهوم القصد السيئ، الا ان الفقرة الأولى من المادة 1 “منه” بينت انه ؛ ينطبق القانون التفسيري على هذا القانون، ومع مراعاة ذلك القانون يفسر هذا القانون وفقاً لمبادئ تفسير القوانين المعمول بها في إنكلترا، ويفترض أن العبارات والألفاظ المستعملة فيه قد استعملت بنفس المعنى المخصص لها في شرائع إنكلترا، بالقدر الذي يتفق فيه ذلك ومدلولها وباستثناء المواضع التي ورد فيها نص صريح بخلاف ذلك، وتفسر تلك العبارات والألفاظ وفقاً لتلك الشرائع (المادة 1 فقرة 2 قانون المخالفات المدينة رقم 36 لسنة 1944 ) ويرى اتجاه من الشراح ؛ ضرورة الرجوع إلى الألفاظ الواردة في قانون
المخالفات المدنية وفق شرائع إنجلترا وما صدر من اراء الفقه واحكام القضاء، بوصفها المصدر الأصيل لهذا القانون بما يضمن تطبيقه تطبيقا سليما (نصرة، 2023، ص20)
والواقع انه ليس من الضرورة استخلاص مفهوم القصد السيئ، من القضاء الإنجليزي فلكل مجتمع بيئته التشريعية المتغيرة في تصور مفهوم القصد السيئ، الذي يبرز بالتقاضي ولا يتطابق بالضرورة مع قوانين الدول الأخرى سيما الإجرائية منها. وهو ما يمكن استخلاصه في قول النقض الفلسطيني، بالتعبير عن القصد السيئ باصطلاح سوء النية الشائع (نقض حقوق رقم 1209-2022) ويعني مفهوم القصد السيئ وفق الاصطلاح الفقهي ” تحقق العلم بتلك الواقعة او ذلك الحادث او الظرف على وجه الحقيقة واليقين، والواقع ان الطبيعة الذاتية لوصف حسن النية او سوئها تكون متحققة عند تحقق العلم او الجهل الفعلي بالواقعة او التصرف المعول عليه تشريعيا في ترتيب الحكم المطلوب (الجبوري، 2006، ص36-37) ومن أبرز مظاهر حسن النية في الخصومة القضائية ؛ الامتناع عن اللجوء إلى أساليب الغش أو الكيد الإجرائي التي قد تُضلل القاضي وتعيق كشف الحقيقة، ويفترض هذا الالتزام على جميع الخصوم، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، ويشكل أي إخلال به معيارًا واضحًا لبروز سوء النية، ومظهرا للاستعمال التعسفي بالحق الإجرائي.” (قطب، 2006، ص72).
وتتمثل مظاهر القصد السيئ ؛ كما عبر عنها قضاء النقض الفلسطيني بالقول ” ان من يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر نجم عند تقديم شكوى ضده بجرم معين وصدر بحقه حكم نهائي اكتسب صيرورة الامر المقضي به عليه ان يثبت للمحكمة ان من قدم الشكوى كان سيء النية وبدر منه خطأ ينحدر بشكواه الى مستوى الاجراء الكيدي حتى يعتبر متعمدا متعديا ويلزم التعويض وفق مفهوم المادة 30 من قانون المخالفات المدنية ويكون كافة عناصر دعواه متوافرة (نقض حقوق رقم، 641 لسنة 2021) وفي قول قضائي اخر” لما كان اللجوء الى القضاء حق دستوري مفتوح للجميع ولا يجوز معاقبة من يلجا بتقديم شكوى للقضاء الا اذا كانت المقاضاة كيدية وسببها الكيد بالخصم واختلاق الادلة بقصد الاطاحة به والتي تسمى والحالة هذه المقاضاة الكيدية الموجبة للتعويض، ( استئناف حقوق رقم 17 لسنة 2017 ) وفي رفض قبول المقاضاة الكيدية ” قررت المحكمة ان الشكوى المقدمة من المستأنف عليه ضد المستأنف هي شكوى الاعتداء على ملك الغير والتعدي على المزروعات وقررت المحكمة براءته ليس لان المستأنف عليه افترى على المستأنف وانما كونه شريكا على الشيوع مع المشتكي وهذه الحالة لا ينطبق عليها مفهوم المقاضاة الكيدية. (استئناف حقوق رقم، 17 لسنة 2017)
كما اشترطت المادة 30 من قانون المخالفات المدنية اقتران القصد السيئ بالسبب غير المعقول لقبول دعوى المقاضاة الكيدية، ويرتبط مفهوم السبب أو التوقع غير المعقول بالمدعي، بحيث يتعين عليه إثبات أن المدعى عليه كان من الواجب أن يتوقع تضرره نتيجة فعله أو تركه، وإلا فلا ثمة واجب حيطة تجاهه (نصرة، 2023، ص71).ويؤكد القضاء الفلسطيني” أن من أهم شروط قبول دعوى المقاضاة الكيدية أن تكون الإجراءات المتخذة من المدعى عليه خاسرة، ومنسوبة إلى سوء نية وسوء قصد للإيقاع بالمشتكى عليه، ودون سبب معقول لهذه الاجراءات (استئناف حقوق رقم 309 لسنة 2016) كما قرر القضاء في حالات أخرى عدم قبول دعوى المقاضاة ” إذا ثبت أن التبليغ عن الجريمة أو تقديم الشكوى تم بدافع معقول أو دون سوء نية (استئناف حقوق رقم 111 لسنة 2016 ) وفي موضع قضائي اخر يعكس تبرير السبب المعقول ” تقول محكمة النقض الفلسطينية ” تبين من خلال الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الشكوى الجزائية ان الطاعن المشتكى عليه عند اجابته
على تلك التهمة صرح انه لا علاقة له في هذه التهمة ويوجد شخص اخر له علاقة بالموضوع بما يشير الى ان ما قام به المطعون عليه ” المشتكي بالشكوى الجزائية قام على سبب معقول او مرجح وغير قائم على سوء النية وبالتالي لا تندرج تحت تعريف المقاضاة الكيدية (نقض حقوق رقم 1863 لسنة 2019) بما يعكس ارتباط التوقع المعقول بسلوك المتقاضي وفي تقدير الاستعمال المشروع أو إساءة الاستعمال من القضاء .
لكن القضاء الفلسطيني لم يستقر بخصوص نطاق المخالفات المدنية المشمولة بدعوى المقاضاة الكيدية” وتقول محكمة النقض ” إن الدعوى الحقوقية المقامة بشأنها التعويض ليست من ضمن الدعاوى الواردة حصرا بالمقاضاة الكيدية التي أوردتها المادة 30 من قانون المخالفات المدنية فهي ليست دعوى جزائية ولا إفلاسيه ولا إجراءات تصفية “( نقض حقوق، رقم 1618 لسنة 2019، ) وفي المقابل رأت محكمة استئناف القدس، ان مبرر عدم قبول دعوى المقاضاة، ثبوت الجهالة بمبلغ التعويض المدعى به وليس لعدم اختصاصها او ولايتها القضائية للفصل بالدعوى (استئناف حقوق ام الله رقم، 121 لسنة 2018 ) وبناء عليه، لم يحسم القضاء الفلسطيني الجدل بشأن الدعاوى المدنية وما إذا كانت تقع ضمن الحالات المشمولة بالمادة 30 من قانون المخالفات المدنية، إلا أن تطبيق احكام المقاضاة الكيدية على هذه الدعاوى تبرره قواعد العدالة، كما يمكن الاستعانة ، بقواعد مجلة الأحكام العدلية كبديل احتياطي لمواجهة أي قصور تشريعي، لم تتضمنه المادة 30 مخالفات المذكورة.
ومما لا ريب فيه؛ دعوى المقاضاة الكيدية تتسم بطبيعة مركبة، فهي تجمع بين دعوى المسؤولية ودعوى التعويض في آن واحد، وقد جسدت محكمة استئناف نابلس هذا التوجه بقولها ” وحيث ثبت لمحكمتنا سوء النية والكيدية، فإن للمستأنف المدعي الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الشكوى المقدمة من المستأنف ضده، إذ أساءت المقاضاة إلى مكانته وسمعته” (استئناف حقوق رقم 133 لسنة 2023).
وبالمقارنة، تتيح هذه الدعوى للخصوم إثبات الكيد الإجرائي وتعويض المتضرر، كما تمكن القضاء من ممارسة سلطته الرقابية على استعمال الحق في التقاضي، ما يجعلها متقاربة في المفهوم مع نظرية إساءة استعمال الحق في التشريع الأردني، مع تفاوتها في تصور الرقابة العامة على استعمال الحق في التقاضي على النحو الآتي:
| المعيار | دعوى المقاضاة الكيدية
في القضاء الفلسطيني |
إساءة استعمال الحق في التقاضي
بالقضاء الأردني |
| النطاق | نظرية رقابية استثنائية، تقتصر على مخالفات العمدية حددت على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944، وتمثل مظهراً رقابياً في القضاء الفلسطيني، ولا تشمل جميع الدعاوى أو الحقوق القضائية. | نظرية عامة، تمتد إلى جميع الحقوق القضائية وأنواع الدعاوى، وتفرض رقابة وقائية، على كل استعمال غير مشروع للحقوق الإجرائية في مجال التقاضي. |
| شروط القبول | يشترط ثبوت القصد السيئ والتوقع غير المعقول لقبول دعوى المقاضاة الكيدية. | يكفي ثبوت المصلحة غير المشروعة، دون اشتراط ثبوت القصد سيئ أو الضرر المباشر ويكفي عدم التناسب بين المصلحة والضرر لإثبات إساءة الاستعمال، وثبوت الحق بالادعاء بالتعويض. |
| مرحلة التحقق | يستخلص القضاء، ثبوت المقاضاة الكيدية من نتيجة للحكم القضائي، حيث يعد الحكم قرينة كاشفة على ثبوت الكيد الاجرائي أو عدمه. | تتحقق الرقابة القضائية طيلة مراحل استعمال الحق الإجرائي، أي قبل صدور الحكم وتترصد المحكمة إساءة الاستعمال وبروز الإساءة بما يقتضي نقضها، ويعود استعمال الحق مبرئا من المناقضة غير المشروعة. |
| القرينة القضائية | تقوم القرينة القضائية في دعوى المقاضاة الكيدية على أن حق التقاضي مكفول دستوريا وأن الأصل مشروعية الاستعمال استنادا إلى قاعدة ” الجواز الشرعي ينافي الضمان” مما يشكل قرينة لصالح المتقاضي على مشروعية الاستعمال، ولا تنهدم هذه القرينة إلا بثبوت الكيد الاجرائي بتحقق عنصري التوقع غير المعقول، وسوء النية ، فلا يسال المتقاضي عن الأضرار الناشئة عن دعواه إلا إذا ثبت أن لجوءه للقضاء تحققت فيه شروط المقاضاة الكيدية . | أما القرينة القضائية في دعوى إساءة استعمال الحق، فهي تقوم على معيار موضوعي لا يكتفي بإثبات النية فقط، بل يركز على طبيعة الفعل ذاته وفيما إذا كان مشمولا، بحالات التعسف الحصرية الواردة في المادة 66 من القانون المدني، كتعمد قصد الإضرار،أو غياب المصلحة المشروعة، أو تجاوز حدود الاستعمال المألوف ،وهنا يفترض القضاء إمكانية قيام الإساءة متى توافرت هذه المؤشرات الموضوعية، حتى لو لم يثبت قصد الكيد الاجرائي صراحة. |
| الأساس القانوني للمسؤولية | تقوم دعوى المقاضاة الكيدية، على اساس قواعد المسؤولية التقصيرية، ويشترط لقيامها ثبوت الإضرار العمدي المتمثل في ارتكاب مخالفات مدنية عمدية تستند إلى إخلال بالتزام قانوني يمثل مفهوم الخطأ قانونا. | تقوم المسؤولية عن إساءة استعمال الحق على قواعد المسؤولية الموضوعية التعسفية، ويكفي تحقق الضرر غير المشروع، دون الحاجة إلى إثبات الخطأ بمفهومه القانوني الشائع كشرطً لثبوت الاستعمال التعسفي، ومشروعية الادعاء بالتعويض.
|
1.1 أهمية الدراسة
ترتكز الأهمية، باستعراض رؤية المشرعان الأردني والفلسطيني، في تصور التقاضي ضمن مفاهيم الحق او الحرية او الرخص العامة ودورها في تمكين المتقاضي من مباشرة التقاضي كحق مكفول، في ضوء تناقض هذه المفاهيم مع نظرية إساءة استعمال الحق التي تقوم بالأصل في ظل فكرة الحق، ويبرز دور حسن النية، كضابط بتمايز الاستعمال المشروع او مناقضته بالاستعمال التعسفي.
1.2 اشكالية الدراسة:
تتمحور؛ حول قدرة مظاهر الرقابية القضائية في التصدي للاستعمال غير المشروع للحق في التقاضي، خصوصا عند التعبير عن التقاضي، استنادا الى مفاهيم الرخص أو الحريات العامة، رغم تعارض هذه التعابير مع نظرية إساءة استعمال الحق التي تنطلق من فكرة الحق ذاته، ويبرز في هذا السياق التساؤل حول دور النية الإجرائية في تعزيز الرقابة القضائية و ثبوت الاستعمال التعسفي للحق، رغم الجدل القائم حول حقيقة النية أهي التزام قانوني أم قاعدة أخلاقية أم مبدأ عام، ويتقاطع هذا الجدل مع قاعدة افتراض حسن النية بالتقاضي، في ظل قصور تشريعي عن تنظيمها صراحة، حيث يعد حسن النية مفهوم نسبي يتغير باختلاف الوقائع القانونية ويتداخل مع مفاهيم أخرى؛ كالغلط القانوني أو يتعارض معها كمبدأ لا يعذر أحد لجهله بالقانون وتثير هذه المسائل، اشكالية حول طبيعة العلاقة بين هذه المفاهيم مع حسن النية وتأثيرها على اطراف التقاضي، وهل تمثل هذه المفاهيم مردافا لحسن النية، بما يبرر التحلل من المسؤولية ام تؤدي الى ثبوت الاضرار وتحقق المسؤولية المدنية.
- التساؤلات الفرعية:
- ما مفهوم الحق، وما هي إشكالات اطلاقه بتعابير الحرية، او الرخص العامة؟
- هل يتصور ثبوت الحق في التقاضي، بمفاهيم الحريات العامة او الرخص العامة؟
- هل تناولت مجلة الاحكام العدلية والتشريعات الفلسطينية نظرية إساءة استعمال الحق؟
- ما هو الأساس القانوني للمسؤولية عن اساءة استعمال حق التقاضي بالتشريع الفلسطيني؟
- ما هو الأساس القانوني للمسؤولية عن إساءة استعمال الحق بالتقاضي بالتشريع الاردني
- ما هو المقصود بحسن النية في الخصومة القضائية وما هي معاييره.؟
- هل تمثل معايير قياس النية، ضابطا عادلا لتمييز التقاضي المشروع او إساءة استعماله؟
- ما هي ضوابط حسن النية بالتقاضي، وهل يعد التزاما تشريعي، ام قاعدة أخلاقية، ام مبدأ عاما؟
- هل يعكس مفهوم الغلط، القانوني، حقيقة حسن النية بالتقاضي؟
- ما هو مبدأ لا يعذر أحد لجهله بالقانون؟ وهل يساوي بين كافة المخاطبين، ويسري على كافة القواعد القانونية؟ وهل يمكن الدفع بالجهل بالقانون كعذر قضائي يبرر التحلل من إساءة استعمال حق التقاضي؟
1.4 منهجية البحث
بغرض الإلمام بكافة جوانب الدراسة ومعالجة الإشكالية الرئيسية، والإجابة على جميع تساؤلات الدراسة انصرفت الى اتباع عدة مناهج بحثية كالآتي:
1-المنهج التحليلي: بتحليل مفهوم الحق بالتقاضي وعلاقته بحسن النية، كمعيار لثبوت التقاضي المشروع او مناقضته، بتحري حقيقة النية الحسنة او سوءتها بين معيارين أولاهما، شخصي يركز على الإرادة الباطنة، ويتأسس الاخر بضابط موضوعي من خلال مظهر خارجي بالقياس مع السلوك المعتاد للأشخاص.
2-المنهج المقارن: لمعالجة مواطن القصور في القانون الفلسطيني بخصوص مظاهر الرقابة القضائية، من خلال دراسة أحكام المقاضاة الكيدية المقررة بالمادة 30 من قانون المخالفات المدنية النافذ رقم 36 لسنة 1944 وإبراز دور النية الإجرائية كشرط لثبوت الاستعمال غير المشروع، من خلال مقارنتها مع التشريع الاردني، الذي اعتمد نظرية إساءة استعمال الحق كمظهر رقابي مستحدث في مجال التقاضي، حيث يبرز دور النية الإجرائية خلال هذه الرقابة كضابط بتحقق الاستعمال التعسفي ، مع ابراز اوجه الاختلاف بين النظريتين من حيث الولاية القضائية ونطاق التطبيق على الدعاوى المثارة او المفصولة لدى القضاء، كما تستعين الدراسة، لغايات المقارنة بالقوانين المصرية التي تصدت لإساءة استعمال حق التقاضي، وابرزت دور حسن النية في استعماله، نظرا لما يتميز به القانون المصري وثرائه على المستوى العربي.
- ماهية الحق في التقاضي
يرتكز الحق في التقاضي على مبادئ دستورية وقوانين إجرائية (الصاوي، 2021، ص685) تكفل للأشخاص وطنيين كانوا ام أجانب استعمال التقاضي بلا عوارض او قيود (الزعبي، 2025، ص 318) ويعد هذا الحق؛ احد أبرز مظاهر العدالة القانونية، ثم إذا منع أو تقيد صاحب الحق من استعمال التقاضي فقد حرم أصل الحق في ذاته (قطب، 2006، ص 48).
وترتبط فكرة التقاضي ارتباطا وثيقا بفكرة الحق ذاته، الا ان فكرة الحق سابقة على”التقاضي ،ذلك ان الحقوق تتجسد ابتداء في الحقوق الطبيعية المستمدة من القواعد والمبادئ القانونية العامة والعرفية كما لو كانت توجبه من الطبيعة ويفرضها العقل، وهذه القواعد تفرض على المشرع ذاته احترامها، حيث تعد مصدرا قضائيا وقانونيا منصوص عليه في الحقوق / القوانين الوضعية وهي معيار لكون القواعد عادلة أو غير عادلة (القوتلي، 1963، ص 137) وبناء على ذلك، يعد الحق اساس القانون وليس القانون أساس الحق وليس للقانون من غاية ، سوى حماية هذا الحق (الدريني، 1977، ص 40)
2.1 مفهوم الحق وطبيعته بالتقاضي
يتمثل التقاضي في لجوء الشخص الى قاضيه الطبيعي، حين تتعرض أي من حقوقه او حرياته او مصالحه المشروعة للاعتداء او التهديد (الهاجري، 2013، ص202) فالتقاضي حق مكفول ومضمون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وينظم القانون إجراءاته (نقض حقوق رقم، 406 لسنة 2023)، وتتمثل آية التقاضي في الترضية الرضائية التي يسعى المتقاضون بمباشرتها لمواجهة الأضرار التي أصابتهم جراء العدوان على حقوقهم (الصاوي، 2021، ص 679) ويعد التقاضي من الحقوق المختلطة من حيث الإطلاق والتقييد، فهو يرمي الى تحقيق الصالح العام والخاص معا (يوسف، 2025، ص 12).
مما يبرز رقابة تكفل استعماله فتضفي حماية القانون على الاستعمال المشروع وحده وتمنع الاستعمال التعسفي وتتصدى لما قد يسببه للغير من ضرر أو تمنعه أصلا من المضي فيه (محمد، 2023 ص 45) ونستعرض مفهوم الحق، وطبائع الفقه في تقريره، ثم نبين صلته بالتقاضي، كوسيلة يقرها الحق ويكفل استعمالها على الوجه المشروع.
2.1.1 تعريف الحق
يتدرج اصطلاح الحق في مظاهر متنوعة، ومفاهيم متنوعة تبعا لطبيعته، ومبرر نشوئه وما تعاقب بتحليل مضمونه من طبائع فقهية، تفضي بإبراز تعريف جامع لكافة المقومات التي يتألف منها الحق، بأن يكون مانعا لكل ما لا يجوز أن يدخل فيه مما هو خارج عنه (القوتلي، 1963، ص 111) ولئن كان من الصعوبة تعريف كافة ظواهر الحق وعناصر تكوينها، لما تتصف به من تجريد، غير ان هذا لم يقف دون المحاولة في تحليل الحق وتصور تعريف جامع يبرز جوهره مع تمييزه عما اختلط به من الحريات أو الرخص العامة (الدريني، 1977، ص 19)
البند الأول: الحق مصلحة يحميها القانون ” فالمصلحة هي جوهر الحق، وهي التي ترمي الإرادة الى تحقيقها (الهاجري، 2013، ص194) ويتلخص دور الارادة في خدمة الحق، أي في خدمة مصلحة من المصالح (حسن، 1969، ص 433) غير ان هذا التصور يثير عدة إشكاليات؛ اذ يشترط بعض الفقه لاعتبار المصلحة ان حقا معتبر قانونا، ان تقترن بدعوى تمثلها فهي وسيلة الحق قانونا(محمد، 2021، ص 21) وهذا لا يستقيم قانونا ؛ فكيف تكون الحقوق مصلحة تحمي الحقوق، وبهذا نعرف الشيء بنفسه (القوتلي، 1963، ص162) كما ان المصلحة وسيلة الحق فلا يتصور ان تتقدم الوسيلة على الغاية، والدعوى عنصر بالحق تالية لوجوده، فأنى يستدل على الحق بوسيلته (أبورحمة، 2018، ص 12) فضلا عن ذلك ، فالمصلحة قد توجد، ويتخلف الحق(أمين، 2008، ص 2) ويتضح ذلك ، بإدخال الحريات والحقوق العامة في مضمون الحق، فالإباحة تمثل مصلحة يحميها القانون ولا تفترض حقا بالمعنى الدقيق فهي لا تتمتع بخاصية الحق بالاستئثار، فمثلا الدولة قد تفرض رسوما جمركية على البضائع الأجنبة، حماية للمنتج الوطني وهي مصلحة معتبرة للتجار ولم يقل أحد بان لهم حقا”(الدريني، 1977، ص 56) ومع ذلك ؛ يبرز تصور الحق بالمصلحة المحمية؛ الصلة الوثيقة بنظرية إساءة استعمال الحق ، حيث يؤدي انعدام المصلحة المشروعة الى اعتبار الاستعمال عبثا غير مشروع (الدريني، 1977، ص 62).
البند الثاني:” الحق قدرة ارادية” يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم (حسن، 1969، ص 431) فالإرادة هي جوهر الحق ومبعث ثبوته، وتنحصر سلطة القانون في الاعتراف بهذا الحق(أبورحمة، 2018، ص 9) غير ان هذا المفهوم تعترضه ملاحظات فقهية، حيث استثنى الاشخاص المعنوية رغم ثبوت الحق لهم أيضا (المادة 51 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976) كما لا يقتصر ثبوت الحق في إرادة مهيمنة، فعديم الاهلية يستعمل حقه بالملكية ولا إرادة لديه عندما يقيم في منزله (محمد، 2021، ص 19) وبهذا ينبغي التمييز بين الحق في ذاته وشرط مباشرته (الشرقاوي، 1970، ص 15) ولا يعني هذا تصور مطلق الحق دون الإرادة ولا يعني بالمحصلة هدر الإرادة ككل، فالإرادة شرط لمباشرة الحق لكن ليست معيار الحق في ذاته او منشئ وجوده (الدريني، 1977، ص 54).
البند الثالث ” الحق استئثار بقيمة معينة ” يعني اختصاص بشيء يقره القانون ويحميه (محمد، 2021، ص 25) ويستند صاحب الحق في ذلك على عنصر جوهري، يتمثل بالاختصاص الواسع بالتملك ، شريطة ان يعبر هذا الاختصاص عن حالة قانونية ليحظى بإقرار القانون (الدريني، 1977، ص 58) ويرتبط هذا التصور للحق ، ارتباطا وثيقا بنظرية إساءة استعمال الحق، فالعلاقة بين ذي الحق وما يقتضيه من مصلحة يحميها القانون، تبقى قائمة متى الت الى مصلحة مشروعة فلا يحمي القانون صلة قائمة بين الفرد وبين مصلحة غير مشروعة (الدريني، 1977، ص 62) ومن ثم فان شرط المشروعية ركن بالحق فلا يجوز لاحد ، ان يدعي حقا يقوم على مصلحة غير مشروعة (رمضان، 2013، ص 235)
وبالفقه العربي وطبائع الفقه الإسلامي؛ يستقيم مفهوم الحق بالاستعمال المشروع وينقلب بمناقضته بالاستعمال التعسفي، فعرفه الاستاذ مصطفى الزرقا” بانه اختصاص يقر به الشرع سلطة وتكليفا (الزرقا، 1999، ص19) وعرفه الدكتور الدريني” اختصاص يقربه الشرع سلطة على شيء او اقتضاء أداء معين من اخر تحقيقا لمصلحة معينة (الدريني، 1977، ص 128) وينظر الى تعريف الدريني، بانه أشمل ما قيل في مفهوم الحق في عصرنا هذا حيث جمع عناصر الحق من جهة الكسب وهو إقرار الشرع سلطة على شيء، وكذا من جهة الانتفاع في تحقيق مصلحة معينة وبهذا يكون قد فاق تعريف الاستاذ الزرقاء من جهة الانتفاع (ابن عيسى ومحمد، 2021، ص 93) كما يرتبط” التعريف بفكرة التعسف باعتبارها ملازمة ومكملة لفكرة الحق، تقر الحق وتبرر استعماله المشروع، كما وتقيده بالحدود التي لا تدفع به الى تحقيق غاية غير هادفة (المباحي وعباس، 2022، ص 90) .
ويمكن تعريف الحق؛ اختصاص يقر بالمبادئ العامة، او التشريع او القضاء، وقوامه غاية مشروعة.
2.2 الطبيعة القانونية للحق في التقاضي
ينظر الى التقاضي مكنة أو سلطة أو رخصة، يقرها القانون للأشخاص، بغية الحصول على الحماية القضائية (الصاوي، 2021، ص 682) فهو الحق في طرح الادعاء أيا كانت قيمة أو مدى صحته، وسواء ترتب في سورة أحكام تقريرية أم إنشائية إم الزامية (عبد الغني، 2016، ص 15) ويتجسد هذا الحق في المطالبة القضائية ، وهي الإجراء الذي تقدم به الدعوى الى القضاء (قطب، 2006، ص 47) ويذهب اتجاه بالفقه ” الى ان الدعوى مرآة الحق في التقاضي فلا يتصور وجود دعوى بدون حق كما لا يتصور وجود حق بدون دعوى فلكل حق دعوى تكفل حمايته (الصاوي، 2010، ص 198) غير ان الفقهاء يجمعون، ورغم الصلة الوثيقة بينهما ، على ان الدعوى لا تخلتلط بمفهوم الحق ذاته ،وليست سوى وسيلة الحماية القضائية لذلك الحق (الزعبي، 2025، ص 316).
2.2.1 طبائع الفقه باستعمال التقاضي
يثير الفقه إشكالية حول الطبيعة القانونية للتقاضي؛ وهل يعد من الحقوق الاساسية، أم يعتبر حرية أو رخصة عامة يباشرها الأفراد في نطاق ما يقرره القانون؟ وينعكس هذا الجدل على علاقة التقاضي بنظرية إساءة استعمال الحق؛ إذ يذهب اتجاه إلى أن حق التقاضي، شأنه شأن سائر الحقوق قد ينحرف عن غايته إذا استعمل على نحو كيدي أو تعسفي، مما يستوجب إخضاعه لرقابة هذه النظرية، بينما يرى اتجاه آخر أن أحكام المسؤولية التقصيرية تكفل وحدها الرقابة على ممارسة الحريات والرخص العامة والتعويض عن أضرارها دون حاجة إلى استدعاء فكرة التعسف في استعمال الحق (حسن، 1969، ص 441).
أولاً: التقاضي من الحريات العامة
ويعني مكنة الشخص باستعماله، في الوقت الذي يشاء حرا فيمن يشاء على قدم المساواة مع الآخرين، وتتمثل هذه الحرية؛ بتمتع الأشخاص بمراكز قانونية متساوية تمكنهم من ذات الحقوق المقررة من السلطات العامة، دون استئثار لاحدهم على الاخر(حسن، 1969، ص 440) ويذهب قول بالفقه ؛ الى ان التقاضي لا يقتصر على الأشخاص الذين توافرت بهم شروط قبول الدعوى ابتداء، لعدم تصور ثبوت هذا الشرط الا بعرض الدعوى على القضاء (الصعب، 2010، ص 59) غير ان الحق ؛ قد يوجد بدون دعوى تحميه كما هو الحال في الالتزامات الطبيعية فالحقوق التي تقابل الالتزامات الطبيعية ليس لصاحبها ان يطالب بها امام القضاء(الصاوي، 2010) والوقع؛ ان الفرع لا يجوز ان يتقدم على الاصل، فالدعوى او الطلب او الدفع، احدى صور التقاضي فلا يمكن تجزئتها على نحو مستقل عنه او يبرر تقدمها عليه.(عبد الحميد، 2021، ص 63)
ثانياً: التقاضي من الحقوق
تقوم فكرة الحق على مسوغ اختصاصي (حسن، 1969، ص 439) يتمثل في سلطة معينة تعبر عن مضمون الحق وتشرع بأداء او امتناع، لتحقيق مصلحة معينة يقرها القانون، ثم يبرر ما قد ينجم عن استعمالها المشروع من ضرر (الدريني، 1977، ص194) ويمثل ذلك جوهر فكرة التقاضي الذي يباشر بقواعد عامة تمثل احكام النظام العام لا يجوز التنازل عنها ويطرح كل شرط يبرر اسقاطها او ابطالها (الزعبي، 2025، ص 319) فلا ينقضي حق التقاضي بمرور الزمن ويبقى الحق في مباشرته قائما طوال حياة الشخص، ويقصد بعدم سريان مرور الزمن هو عدم تقادم مطلق الحق بالتقاضي لكن وحال تجسده بادعاء محدد فلا شك ان الحق بالادعاء يقع ضمن مدد التقادم المقررة قانونا (عبدالغني، 2016، ص 45) ولا يتصور ذلك بالدعوى؛ التي قد تكون رخصة لصاحبها تبرر استعمالها أو الامتناع عن استعمالها وقد تكون حرية بمعنى أن خسارتها لا تؤدي إلى مسؤولية مستعمل الدعوى طالما لم يتعسف باستعمالها” وهي بذلك تقبل الحوالة، والتنازل والانقضاء” (أحمد، 2006، ص172) ولان التقاضي حق فلا تجوز مباشرته سوى بوسيلة اقتضاؤه عن طريق الادعاء باللجوء الى القضاء (قطب، 2006، ص 47) كما تتصور المصلحة المشروعة اقتداء بالحق وليس بالحرية او الرخص العامة (محمد، 2021، ص 67) والحقيقة ؛ ان الحرية أو الرخص العامة لا تلتبس بالحق وهي من الوضوح بحيث لا تحمل على النظر أو الخلاف لأن من أبيح له أن يملك لا يعتبر بمقتضى الإباحة مالكا وإن كانت الأخيرة طريقه إلى الملكية لكنها ليست بذاتها حقا (الدريني، 1977، ص 200)
ولذك؛ لم يعد الفكر القانوني يجيز للشخص استعمال الحق كيفما شاء، بل يتقيد بحدود الاستعمال المشروع، وهوما يتمثل في مفهوم الحق الحق الذي ينشئ مشروعية لا تبرر الغلو باستعماله ” لأن” الغلو في العدل غلو في الظلم (الصاوي، 2021، ص 684).
2.2.2 طبائع القضاء باستعمال التقاضي بين الحقوق والحريات العامة.
البند الأول” قول النقض الفلسطيني” لما كان من المستقر عليه ان حق اللجوء الى القضاء من الحقوق الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي بأن اعتبر مراجعة المحاكم امر متاح ومشروع لجميع المواطنين وذلك لصيانة حقوقهم فهو بذلك رخصة منحها القانون الأساسي للمواطنين ولا يترتب على استعمال الرخصة بشكل مشروع ضمان أي ضرر للخصم. (نقض حقوق رقم، 641 لسنة 2021)
وفي قول قضائي مغاير” صحيح ان حق التقاضي حق مضمون كفله القانون وهو حق بلا منازعة فيه اذ نصت المادة 30/ 1 ” من القانون الاساسي بأن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي”(نقض حقوق رقم، 24 لسنة 2023)
يرى الباحث؛ من مناقضة الحكم القضائي، طرح الخيارات بمنطوقه، بما يتعارض مع صراحة النص الدال عليه ولقد اقرت المادة 30/1 من القانون الأساسي الفلسطيني، التقاضي باعتباره حق صريح. كما ان الرخص اعذار تقوم مشروعيتها، لغاية التوسعة طبقا لقاعدة” الامر إذا ضاق اتسع ” ومبررها، وقوع المشقة في فعل او أمر يقتضي ايجاد رخصة له وتوسعة الضيق لإزالة المشقة، وهكذا تجوز الاشياء غير الجائزة قياسا والمغايرة للقواعد العامة. (المادة 18 مجلة الاحكام العدلية)
البند الثاني” قول قضاء التمييز الأردني “ أن حق اللجوء إلى القضاء رخصة منحت للمواطنين وأنه لا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض الخصم، عما لحقه من ضرر في حال خسران الدعوى، إذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية (تمييز حقوق رقم 5544- لسنة 2022)، وفي قول قضائي اخر” وفقا لنص المادة 10 من الدستور فإن حق اللجوء إلى القضاء رخصة ممنوحة لكافة وقد كفل الدستور هذا الحق ولا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويضا للخصم عما لحقه من ضرر”(تمييز حقوق رقم 9764- لسنة 2024)
يرى الباحث” ادراج التقاضي، ضمن مفاهيم الحريات او الرخص العامة بالقضاء الاردني، يتعارض مع دور نظرية التعسف الرقابية بالتشريع الاردني، والتي تتأسس في فكرة الحق، ويرشدنا لهذا التقدير؛ قرار محكمة التمييز الاردنية” اوجبت المادة 66 من القانون المدني الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع وحددت حالات الاستعمال غير المشروع للحق. وإنَّ هذه المادة تختص بإساءة استعمال الحق الذي هُوَ يختلف عن الرخصة أو الحق العام، إذ إنّ الأخير يكون مسموحاً للجميع استعماله، كاستعمال الطريق العام، وإن حدث ضرر نتيجة استعمال هذه الرخصة أو الحق العام، فان البحث لا يكون على أساس إساءة استعمال الحق وإنَّما على أساس المسؤولية عن الفعل الضار. (تمييز حقوق، رقم 2363 لسنة -2023)
- الأساس المشروع لاستعمال التقاضي بحسن النية
يعد مبدأ حسن النية والعدالة من أبرز ملامح النزعة الأخلاقية في القوانين المدنية العربية (بكر، 2025، ص 10) فهو معيار لقياس احترام المخاطب للقانون (خاطر، 2017، ص 41) والمستقر؛ حسن النية مفترض بالتقاضي (تمييز حقوق رقم 6863- لسنة 2024) فلا يترتب على إتيان الرخصة بالتقاضي تعويض ما قد يلحق المتضرر نتيجة استعمالها الا اذا ثبت ان استعمال هذه الرخصة كان بسوء نية” (تمييز حقوق رقم 7138-لسنة 2024)،” والقول خلاف ذلك يجعل من الحق الذي يسميه القانون الأساسي “الحق في التقاضي حق مشروع ومضمون ومكفول مجرد شعار ويكون كل من ممارس هذا الحق مناط بالادعاء عليه بالتعويض”( نقض حقوق رقم، 406 لسنة 2023) وبالمقابل يتوجب مراعاة حسن النية في التقاضي، وعدم الإقدام على مباشرته بغاية الأضرار بالخصم الاخر باستقدام وسائل كيدية كالغش او إساءة الاستعمال او الخطأ ومن تعابير الخطأ عدم اطلاق الحرية للأهواء والتجاوزات الإجرائية دون قيود خاصة … والانحراف به عن غايته وهي تحقيق مصلحة مشروعة (تمييز حقوق رقم 6275-لسنة 2022) وهو ما يقتضي الالتزام في مبدأ الخصومة الشريفة خلال التقاضي (الشوابكه، 2021، ص 16)
3.1 مرتكزات حسن النية وضوابطه في التقاضي
جرت محاولات لتعريف مبدأ حسن النية باستخدام تعابير عامة، مثل الأمانة والنزاهة والاستقامة والشرف بالتعامل مع الغير نظرا لاختلاط مبدأ حسن النية بتلك المفاهيم (بكر، 2025، ص19) الا ان اتجاه اخر من الشراح رفض هذه التعابير لكونها لا تكفي للتعبير عن معناه القانوني” فعرفه ؛ انه الالتزام بالعمل وفقا لنصوص القانون (أمين، 2008، ص 169) ويتفق الباحث مع تعريفه ” بالالتزام بأحكام ومقاصد القانون في التصرفات الذي يلزمه القيام بأجراء او تصرف معين (محمد، 2021، ص 50) ويرتكز” حسن النية الاجرائي في السلوك، الذي يعبر عن الالتزام بالأحكام والمبادئ التي يفرضها القانون الاجرائي على كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ التي تصدر من الخصوم أو من القاضي واعوانه (سلامة، 2022، ص 284).
3.1.1 الأساس القانوني
يرتكز التشريع الأردني، على افتراض حسن النية بالتقاضي، بالإحالة للقواعد العامة بالقانون المدني والتي تتقاطع مع احكام الفقه الإسلامي وقواعد العدالة، ويستعين بها القضاء، حال شغور القاعدة القانونية بدلالة الفقرتان 2-3 من المادة” 2 من ذات القانون، وقد استقر القضاء الأردني” إن مبدأ حسن النية هو المبدأ العام الذي يسود جميع العلاقات القانونية وهو من الأحكام الكلية” (تمييز حقوق رقم 6517-2024) كما اقر القضاء الفلسطيني” ان مبدأ حسن النية مفترض بالمعاملات والعقود كونه من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية ويطبقه القضاء من خلال مظاهره ومن خلال النظم القانونية التي تلتقي معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق وانتفاء الغش باعتبارها من مظاهر سوء النية ” (استئناف حقوق رقم، 292 لسنة 2016)،ومن منظور الفقه الإسلامي” النيات والمقاصد معتبرة في التصرفات، وأن الباعث يؤثر فيها من حيث الصحة والبطلان وهو ما يمنح سلطة واسعة للقضاء في رقابة استعمال الحقوق (الدريني، 1998، ص476) واما القانون المدني المصري” فيفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على العكس (المادة 961/3 القانون المدني المصري ) وهو بهذا المعنى قرينة ثابتة تبرء الشخص من عبئ الاثبات (الصاوي، 2021، ص 687).
ومما لا ريب فيه، ان مبدأ حسن النية ينطبق على كافة الحقوق والالتزامات والعقود والاعمال القانونية (الجبوري، 2006، ص 62).
3.1.2 معايير قياس حسن النية
مما لاشك به؛ لا يزال الاختلاف قائما في تحديد مفهوم حسن النية ( خاطر , 2017 ص 35 ) فرغم الإقرار بحسن النية كمبدأ عام يحكم العلاقات القانونية، على المستوى الوطني في إطار القانون العام والخاص، لم يستقر على تعريف محدد له، ولم يتم تثبيته في التنظيم القانوني أو في اجتهادات القضاء، ويعود السبب الأبرز لكون حسن النية يعبر عن مفهوم واسع مرن وغامض في ذات الوقت، ويتميز بطابع نسبي في تصوره لكل واقعة قانونية، فلا يستقيم أن يحيطه مفهوم مانع، بل قد يكون الاستقرار على تعريف محدد له أمرا محالا (لعجال، 2022، ص178)، كما لم تستقر النظم التشريعية في تبيان وظائف حسن النية، بدلالة معيار محدد، فهي من جهة معيارية ترتبط بالنية الحقيقة، ومن جهة أخرى تتداخل مع مفاهيم عامة وتتقاطع معها كنظرية إساءة استعمال الحق (الباب فتح، 2022، ص213) ولذا ترك القانون تقرير حسن النية للقضاء (خاطر، 2017، ص42) ويعتمد القضاء على استثبات حقيقة النية، باتباع معيارين: الأول شخصي ذو طبيعة ذاتية ينطلق من المسؤولية الأخلاقية، ويتأسس بالاعتداء على الاخلاق بالأصل (السويطي، 2018) والثاني موضوعي” يركن لمظهر النية الخارجي، ويقاس بأفعال وإجراءات او وقائع بالنظر الى الظروف المحيطة بأواسط الناس، بلا تغول بالظروف الداخلية للشخص. (خاطر، 2017، ص58)
البند الأول: المعيار الشخصي
عني به جهل الشخص بواقعة معينة او الاعتقاد الخاطئ بالعلم فيها، او معرفة حقيقة امرها (خاطر، 2017، ص45) وأي قدر من الشك كاف لاستبعاد حسن النية(بكر، 2025، ص11) ويفترض حسن النية بالخصومة القضائية، بالامتناع عن استخدام الغش وأساليب المكر والاحتيال التي تؤدي إلى تضليل القاضي ويعيق الوصول الى الحقيقة (قطب، ص72) ويقع سوء النية بالمباشرة بالإجراء أو الطلب أو الدفع أو الدفاع، بقصد تعسفي ينحدر لمستوى الاضرار بلا غاية هادفة (الصاوي، 2021، ص 692) او بإثارة الادعاء كيديا او بإبداء الدفع الكيدي، رغم العلم بعدم جديتهما او اقترانهما بمصلحة مشروعة، وألا غاية من اثارتهما سوى قصد مضارة الغير(عبد الغني، ص77-78) ويقوم القضاء بتحري العمل الإيجابي المتعمد، من المتقاضي ذاته، وكذلك العمل الاجرائي ضد الخصم الاخر، والذي يقتضي العزم منه وليس رغما عنه. (عز العرب، ص280)
ومن مظاهر ثبوت سوء النية بالقضاء المصري طبقا للمعيار الشخصي “قيام المطعون ضده بالقيام بالطعن بالتزوير على الشيك رغم علمه بصحة توقيعه، وثبت من تقرير قسم الأبحاث صحة ذلك الشيك وقضي بإدانته بالحبس فاستأنف ولم يحضر فتايد عليه قرار الحبس ولخشيته من التنفيذ قام بالسداد بالمعارضة بالوفاء الأمر الذي ينبئ أنه سيء النية ولم يقصد من ذلك سوى الإضرار بخصمه والكيد والمماطلة والإساءة في استعمال حق التقاضي”(نقض مدني، رقم 523 لسنة 75 قضائية) .
أما في القضاء الفلسطيني فيتمثل ثبوت سوء النية بالمعيار الشخصي ” بخصوص السبب المتضمن خطأ المحكمة بعدم مراعاة قواعد العدالة وأحكام المحاكمة حيث أن المشتري حسن النية، وثبت له أن الأرض باسم من قام بالشراء منهم وان السندات الصادرة عن دائرة الأراضي لا يطعن بها إلا بالتزوير…”وحيث أن السند الذي تم الاستناد اليه وليد إجراءات جرمية، فلا يعتد بحسن النية في إكمال البيع، وعلى” حسن النية” أن يعود على البائع بالأضرار التي لحقت له جراء البيع والثمن، الذي قام بدفعه، وبهذا فإن ما توصلت له محكمة، بعدم الأخذ بمبدأ حسن النية، يكون متفقا مع القانون مستوجبا رد السبب( نقض حقوق رقم، 1476 لسنة 2022)
البند الثاني: المعيار الموضوعي
نظرا لصعوبة المعيار الذاتي في تحري حقيقة النية، لما يستلزمه من الغور في ذات المتقاضي للوصول إلى حقيقة نيته من استعمال الحق الاجرائي، لم يترد الفقه في استبعاده واللجوء الى المعيار الموضوعي الذي لا يستلزم من القاضي البحث في غور الخصم لمعرفة حقيقة نيته (الجبوري، ص48) ويقوم هذا المعيار على قياس سلوك المتقاضي بأواسط الأشخاص من حيث اليقظة والتبصر(بكر، 2025، ص162) دون النظر الى الطبيعة الذاتية للشخص، وانما بمقارنته بالوضع الظاهر الذي يمثل السلوك المعتاد للكافة، ويفترض تطابق الظاهر مع الباطن(خاطر، 2017، ص59) ويتطابق مع القاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه”( المادة 68، مجلة الاحكام العدلية “) ومن مظاهر تطبيق المعيار الموضوعي في القضاء الاردني ” بأن اللجوء الى القضاء وإن كان على خصم غير صحيح، يعد استعمالا مشروعا للحق ولا تنزع عنه صفة الشرعية إلا إذا توافر قصد التعدي، بأن يعلم من يقيم الدعوى أنه يقيمها على خصم غير صحيح فينتفي عندئذ الجواز الشرعي، اذ تحققت إحدى موجبات انتفائه وفقا للمادة 66 من ذات القانون.( حكم رقم 3774 لسنة 2023، محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية) ويجري قياس التعدي بالقضاء الأردني” بمعيار موضوعي، يتمثل بالسلوك المعتاد بين الناس بحيث يعد أي انحراف عنه، او خروج علبه تعد يوجب الضمان، واما السلوك المعتاد المألوف بين الناس فلا يعد من التعدي ولا يوجب ضمان ما ينشأ عنه من انحراف لكونه مأذون فيه شرعا ( تمييز حقوق رقم 5534-2021 )
3.1.3 ضوابط حسن النية بالتقاضي
يتأتى؛ اختلاف الفلسفة الخاصة، بين المبدأ العام من جهة والنص القانوني من جهة أخري، باختلاف ماهية كل منهما عن الآخر، فاذا كان النص القانوني يحدد الحل ويلزم القاضي به، فإن المبدأ العام يضع امام القاضي اطر الحل الممكن دون أن يلزمه بحل قانوني معين. (الخطيب، 2019، ص192)
أولاً: حسن النية “التزام قانوني”
يمثل حسن النية التزاما وقائيا حمائي، فلا يعد علاجا تشريعيا لمشكلة قانونية قائمة، بل يفرض بغية الوقاية من الضرر(بكر، 2025، ص16) وبالاطلاع على القانون المدني الفرنسي بالمرسوم رقم 31 / 2016 تاريخ 10 /02 /2016 المعدل لقانون العقود (شندي، 2017، ص448)، فقد تقرر” ان مجمل الأعمال التفاوضية في مشروع العلاقة المستقبلية محكوم جبرا بمبدأ حسن النية سواء بسواء من حيث الطرح والمداولات او المتابعة (الخطيب، ص207-208) وجاء في المادة” 1104 من القانون المدني الفرنسي ” ان العقود يجب التفاوض حولها وتكوينها وتنفيذها بحسن نية ويعد هذا الحكم من النظام العام ”
ويفصح النص؛ ان اي اخلال بحسن النية يمثل انتهاكا لالتزام قانوني يبرر الحق بالمطالبة بالبطلان والتعويض (التونسي، 2024 ص5) لكن هذا التعديل لم يفصح حقيقة هذا البطلان ونطاقه وهل يعد بطلانا مطلقا، يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ام بطلانا نسبيا لا تجوز اثارته سوى من المتضرر (الخطيب، 2019، ص87) الا ان؛ ادراج حسن النية ضمن متعلقات النظام العام ذي الطبيعة المتغيرة، اتاح حلولا أوسع للقضاء الفرنسي بدلالة قضائية غير مكتوبة، الى جانب مفهوم النظام العام بمفهومه المقنن (الخطيب، ص94) كما ان المشرع الفرنسي لم يحدد طبيعة المسؤولية التي ينشأ عنها البطلان ونطاق الالتزام بالتعويض عنه، كما لم يحسم الفقه الفرنسي هذه المسألة، لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن المسؤولية المترتبة على القطع التعسفي للمفاوضات بسوء نية تُعد مسؤولية غير تعاقدية تقصيرية ” ويبرر هذا الاتجاه طبيعة العلاقة السببية بين المتفاوضان، واختلاف مفهوم الخطأ في ممارسة الحق في التفاوض عن الخطأ المتمثل في قطع التفاوض ذاته، فضلاً عن أن ترتيب نتائج على إخلال بعقد لم يبرم أصلا يعد مساسا بمبدأ الحرية التعاقدية، ومن ثم فإن هذا الالتزام يجد أساسه في قواعد نظرية التعسف في استعمال الحق كما استقرت بالفقه والقضاء الفرنسي (الحياري، 2022، ص 218).
وبدلالة الحداثة، قرر نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 2023 ” افتراض حسن النية التزام قانوني طيلة مراحل العلاقة التفاوضية، سندا للمادة 41 منه- إذا تم التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض الالتزام بإبرام هذا العقد ومع ذلك يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض 2 – يعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض أو تعمد الإدلاء ببيان جوهري مؤثرا بالعقد “، ونص بالفقرة الثانية من المادة 41/1 ” لا ترتب المفاوضات التزاما بالشروع في إتمام العقد، ما لم يكن قطع المفاوضة او العدول عنها او عدم الجدية في المفاوضة مقرونا بسوء النية.” لا ريب؛ ان هذا النص يمنح القاضي صلاحية أوسع بتحري حقيقة النية؛ خلال النظر بالنزاعات الناجمة عن إساءة استعمال الحق بالتفاوض ويتيح التمييز بين الاستعمال المشروع او مناقضته بالكيد التفاوضي، مثل عدم الجدية او إخفاء بيانات جوهرية ( قريب من ذات المعنى، محمد 2023 ص 85 ) كما تؤكد الفقرة الثانية من المادة 41″ من ذات القانون، ان حسن النية مفترض بالعلاقة التفاوضية ما لم يثبت العكس، وهو ما يتماشى مع مضمون ” القاعدة الفقهية “الأصل في الصفات العارضة العدم (المادة 9 مجلة الاحكام العدلية) وتماثلها قاعدة “البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الاصل (المادة 78، القانون المدني الاردني )
ثانياً: حسن النية “قاعدة قانونية ذات طبيعة أخلاقية”
توفر الأخلاق ركيزة أساسية في تكون القاعدة القانونية، وتنقلب حال تجردها من قيم الاخلاق الى قاعدة جوفاء لا تحمي نظاما قانونيا ولا تحل نزاعا (بكر، 2025، ص18) ويمثل الاعتراف بالقاعدة الأخلاقية، قرينة بالإقرار بحسن النية كالتزام قانوني، بالإضافة لكونها التزام اخلاقي(خاطر، 2017، ص39) ويعد هذا التصور لحسن النية؛ مسوغ مشروع في مواجهة الغش والخديعة وهي من مظاهر سوء النية التي تعتري القيم الأخلاقية، والمستقر “ان قاعدة الغش يبطل التصرفات قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً …”كما أنه يجوز إثبات الغش بكافة
طرق الإثبات” (نقض مدني، مصر رقم 989 لسنة 80 قضائية ) ومن جهة أخرى ؛ تفترض القيم الأخلاقية بالمتقاضي سلوكا نزيها وصادقا في المطالبة بحقه أو الدفاع عنه، أو الحصول على ثماره أمام القضاء، وهي طبائع حسن النية ومسوغ ارتباطها بالقاعدة القانونية (عز العرب، ص 279) ومن المستقر بالفقه الإسلامي، أساس نظرية التعسف، هو مقتضيات العدالة وقواعد الأخلاق. (الدريني، 1998، ص111)
ثالثاً: حسن النية “مبدأ قانوني”
يقول اتجاه بالفقه “حسن النية مبدأ قانوني، يتساوى مع المبادئ القانونية الراسخة كمبدأ إساءة استعمال الحق(خاطر، 2017، ص42) والواقع ان المبدأ العام؛ قاعدة أخلاقية بالأساس استقرت بالإرادة الجماعية فتحولت الى قاعدة قانونية(الباب فتح، 2022، ص192) بلغت مبلغها من الرسوخ في مظاهر الالتزام بقواعد القانون المقنن، واستقرت جزأ لا يتجزأ من النظم القانونية المعاصرة (بكر، 2025، ص19) غير أن القاعدة القانونية تختلف عن المبدأ العام، فالأولى تعد مجرد تطبيق للمبادئ العامة وتستهدف استخلاص الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني وثم الدفع لتحقيق العدالة وفقا لمفهوم النظام العام، اما المبدأ العام فهو تكريس لإرادة جمعية يكونها التشريع أو العرف، فمبادئ القانون خلاصة الأسس التي تقوم عليها حضارة المجتمع أو هي التعبير القانوني للنظام التشريعي السائد، بما يمنح حلولا أوسع للقضاء بتحري القصد الاجرائي من استعمال التقاضي (عز العرب، ص 278) ولا يعني هذا التوسع هدر القواعد القانونية المقننة، او ارادة أطراف التقاضي وانما تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة (خاطر، 2017، ص80) وفي هذا المعنى يقول النقض الفلسطيني …لا يمكن لعمل غير قانوني قد يكون مجرما ان تضفي عليه الحماية ولا يقبل من المشتري الثاني ان يتمسك بحسن النية، لأن حسن نية المشتري، لا تنفي سوء نية البائع..”( نقض حقوق، رقم 560 لسنة 2019 )
3.2 تمييز حسن النية عن الجهل بالقانون والغلط في سياق التقاضي.
تبرز إشكالية الجهل بالقانون، كأثر تكليف قانوني يثير تعلقه بفعل المكلف مشكلة الجهل بالقانون بالمعنى الدقيق (الجمال، 1974، ص67-68) والواقع ان مبدأ العلم بالقانون كمبرر لنهوض المسؤولية ودفع الاعتذار بالجهل فيه، يتأتى بفرض العلم بالقاعدة القانونية بما تتضمنه من التزام في مضمونها، ينطوي أيضا على معنى الالتزام بالعلم بها من وقت نفاذها. (كيرة، ص317) غير انه ينبغي التمييز بين المساواة في القاعدة القانونية والمساواة امام القاعدة القانونية، فلا يستقيم ان تكون المساواة الأولى مطلقة والا لامكن تبرير تعدد القواعد القانونية واختلاف مجالاتها وبالنتيجة الاكتفاء بقاعدة مطلقة ومجردة تنطبق على الجميع دون استثناء (العياري 2017 ص 94)
3.2.1 مبررات مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون
يقرر مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، في ثبوت التزام يقع على عاتق الأشخاص، مفاده افتراض العلم به(ياسين، وسنابة، 2021، ص55) وهي نتيجة منطقية لكون القانون تعبير عن إرادة الأفراد داخل المجتمع فلا مناص من تمثيلهم له تمثيلا يؤدي إلى افتراض العلم بأحكامه (الجمال، ص11) ويتأسس المبدأ على قرينة علم الكافة بالقانون، ويقول د حسن كيره ” تأسيس مبدأ امتناع الاعتذار بالجهل في القانون على أساس وجود قرينة علم الكافة بها، غير مقبول فالقرائن القانونية تقوم على حمل الأمر المشكوك فيه، محمل الغالب والمألوف في العمل بشأنه وليس الغالب في العمل ولا المألوف فيه
هو علم الأفراد بالقواعد القانونية، بل الغالب هو جهلهم بها(كيرة، ص316) كما لا يجوز ان يقتصر المبدأ على فريق ويعفى الآخر منه بذريعة الجهل به بالاعتماد على فكرة القرينة ( عبد المقصود، 2021، ص4750) بما يبرر التحلل من قواعده ويفقد التشريع صفة العموم، فيسري على الذين تحقق لهم العلم بأحكامه، دون الاخرين. (سيد، 2022، ص1350) ويرشدنا ذلك لاستبعاد، القرينة كمعيار على توافر العلم بالقانون. بل يتأتى العلم بنشره والتبليغ فيه على وجه العموم.
ويثور التساؤل هل يمكن التذرع بالجهل بالقانون للتحلل من المسؤولية عن إساءة استعمال الحق في التقاضي، من قبل العاملين بالحقل القانوني؟
بداية؛ يفترض مبدأ المساواة، عمومية التكليف امام القانون، فيخضع المكلف بالحقل القانوني، لما يخضع له كافة المكلفين العاديين، لكنه فوق ذلك يقف موقف صاحب المهنة، فيخضع لما تفرضه مهنته من واجبات عليه (الجمال، ص82) وفي إطار المواجهة ؛ فأن القاضي أو المحامي أو غيرهم ممن يعملون في الحقل القانوني يواجهون نوعا اخر من الالتزامات، لا تقع في إطار فكرة التكليف وإنما في إطار فكرة الوظيفة أو العمل القضائي(عبيات، 2023، ص81) والثابت؛ ان مسؤولية القاضي بوجوب العلم بالقانون مفترضة ولا يقبل منه الاعتذار بالجهل به، فاذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها تقوم مسؤوليته على وجه الاستثناء وتهدف الى جبر الضرر الواقع على المتقاضين سواء كان خطأ القاضي تعمدا او اهمالا، و تمثل هذه المسؤولية في ذات الوقت تأمينا للقضاة، من إسراف الخصوم في رفع الدعاوى الكيدية فلا يتهيبون الحكم وقول القانون فلا تجوز مخاصمتهم ومطالبتهم بالتعويض عما يقع من أخطاء في أداء الوظيفة أو بسببها (إبراهيم، 2004 ص28) سوى عن طريق دعوى المخاصمة وهي نظام استثنائي، خاص برجال القضاء، لا يجوز مخالفته لتعلقه بقواعد إجرائية امرة تهدف إلى ضمان حصانة للقضاة، باستثناء حالات محددة تبرر مخاصمتهم، ومنها عدم الاعتذار بالجهل بالقانون او كما يعرف بالجهل الفاضح بالقانون(سليمان، 2023، ص32-23) وهنا يبرز التمييز بين جهل المخاطب العادي وجهل القاضي، فجهل الأول يقتصر على التزامه في ضوء فكرة التكليف العام الواقع على الكافة ويقتصر، ببذل العناية في العلم بالأحكام التكليفية التي يكون العلم بها ممكنا تمشيا مع موقفه من القانون كمكلف بأحكامه، لكن جهل القاضي جهل بما يلزم لمباشرة وظيفته، وهو قول القانون في النزاع المطروح عليه فلا يبرر، ويقتضي من القاضي التزاما بتحقيق نتيجة بقول القانون بالعلم به (الجمال،ص40) وقد اكدت محكمة النقض الفلسطينية هذا الاتجاه عند تعريف الخطأ القضائي ” بأنه الخطأ الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من اهمال في اداء الواجب وما كان ليقع به القاضي لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي او هو الاهمال المفرط الفاحش او الجهل بالمبادئ الاساسية للقانون”( نقض حقوق رقم، 4 لسنة 2024)
3.2.2 نطاق تطبيق مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون
يقرر مبدأ الالتزام بالعلم بقواعد القانون، حكما يبرر هذا الأساس القانوني، ويبرر بالنتيجة عدم جواز الاعتذار بجهله على كافة القواعد القانونية بصرف النظر عن مصدرها التشريعي (عبد المقصود، ص4753) فلا يقتصر نطاق المبدأ على القواعد التشريعية وحدها، بل يشمل القواعد العرفية والقواعد الدينية المطبقة، في مسائل الأحوال الشخصية إضافة إلى القواعد المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية (كيرة، ص317-318)
ويرى اتجاه بالفقه ” ان نطاق مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون يقتصر على القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، دون القواعد المكملة التي يجوز التمسك بالجهل بها، ويترك تقديرها لقول القضاء قانونا(السرحان، وخاطر، 2023، ص143) غير ان هذا التمييز لا يقوم على أسس مسوغ قانونا، فما دامت القاعدة القانونية ملزمة، فلا ينبغي الاحتجاج بجهلها للإفلات من الخضوع لحكمها، والاصل ان صفة الالزام متوافرة بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة على السواء(كيرة، ص319) لكن لقواعد المكملة تطبق عند عدم وجود اتفاق يخالفها، وبالتالي فان الاتفاق على استبعادها، لا يعد عذرا يبرر التمسك فيه وانما يفضي الى سقوط موجبات تطبيقها بالأصل (الجمال، ص81) وبزوال هذا المانع؛ تتساوى في وجه الإلزام مع القواعد الآمرة امام مبدأ الجهل بالقانون ليس عذرا (بكر، 2025، ص84-85)
ويثور التساؤل حول مدى إمكانية تمسك المتقاضين بالجهل بالقانون، كعذر لتبرير إساءة استعمال الحق في التقاضي؟
استقر قضاء التمييز الأردني ” ان الجهل بالقانون لا يعد عذرا(تمييز جزاء رقم 3110-2003) وأورد قضاء التمييز في حكم اخر” بخصوص الركن المعنوي وقوامه العلم والإرادة فإن علم الجاني بالقانون مفترض إذ لا يعتد بالجهل في القانون ” أما بخصوص الإرادة فأن المستقر عليه أن النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من خلال الظروف والوقائع المحيطة بالدعوى(تمييز جزاء رقم 129-2023) ويظهر الحكم استثناءا، يبرر الاعتذار بالجهل بالقانون في مفهومه المطلق وهي نتيجة منطقية تتأتى لمفهوم القانون ذاته، وتحديد ما ينشئ عن الاخلال به من اثار، لا تتعلق بأي حال مع مشكلة الجهل بالقانون بل تتقاطع مع مبدأ ” الغلط الشائع يولد حقوقا (الجمال، ص55) ويعزز هذا الاستنتاج، ما قضى به قضاء التمييز الاردني ” أن الجهل في القانون لا يعد عذراً وأن طرق الطعن ومددها حددها القانون وهي من مقتضيات النظام العام (تمييز حقوق رقم 4795-2023 وتمييز حقوق رقم 483 لسنة 2022؛ تمييز حقوق رقم , 3592لسنة 2024، تمييز حقوق رقم -2338 لسنة 2014 )، وبمفهوم المخالفة، يمكن الاعتذار بالجهل بالقانون في المسائل التي لا تتعلق بالنظام العام، مما يتيح للمتقاضي أحيانًا درء مسؤوليته عن الاستعمال غير المشروع، متى أثبت أن جهله بإجراءات التقاضي لم يكن بقصد مضارة الغير واعتراه جهل مبرر .
أما القضاء الفلسطيني، فقد قررت محكمة النقض” أن العبارة التي خطها رئيس القلم معفاة من الرسوم كونها عمالية ليس من شأنها إسعاف الطاعن كمبرر لعدم دفع الرسوم المقررة قانونا، ولما كانت العبرة بدفع الرسوم لحكم القانون وليس بما ورد في تأشيرة رئيس قلم المحكمة باعتبار الطعن معفي من الرسوم ولما كان الجهل بالقانون لا يشكل عذرا قانونيا من هذا الجانب الأمر الذي يجعل هذا الطعن مستوجبا عدم القبول. (نقض فلسطيني، رقم316 لسنة 2016)
كما يثور التساؤل حول طبيعة العلاقة بين الجهل بالقانون والغلط فيه، وفيما اذا كان يترتب على كل منهما آثار قانونية متغايرة في مجال التقاضي؟
بداية ؛ قيل في تعريف الغلط ” حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع، بأن تكون هناك واقعة غير صحيحة يتوهم الشخص صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها (علاوي،2016، ص14)، ويرى اتجاه اخر” حسن النية هو الغلط المبرر والمشروع (ياسين، وسنابة، 2021، ص54) ويتصور الغلط في غياب الحقيقة وحلول تصور خاطئ تقوم به المسؤولية المدنية فيكون خطأ عمدي او غير عمدي(السيوطي، ص19) ولقد “جعل القضاء من المقارنة بين الخطأ العمدي
وغير العمدي معيار التعسف باستعمال الحق في الدعوى، ولما كان هذا التمايز ليس بالأمر اليسير بين الخطأين فقد ذهب الاجتهاد القضائي الى انه يجب اخذ أهمية الضرر، في الاعتبار الى جانب خطا المتقاضي.( تمييز حقوق -قرار رقم 2363-لسنة 2023)
وبمنظور اخر؛ يعني التذرع بالجهل بالقانون محاولة المكلف التنصل او الامتناع عن سريان القاعدة القانونية عليه بدعوى تعارضها مع مصالحه (كيرة، ص318) والواقع ان فكرتي الجهل بالقانون والغلط، تختلفان في مجالهما وفي معيارهما وفي أثارهما؛ فالأولى تقتصر على أحكام التكليف وحدها، بينما يمتد الغلط الى جميع احكام القانون، كما ويقوم الجهل بالقانون على معيار موضوعي يتضمن إمكانية العلم أو استحالته، فلا يعد عذرا، الا اذا كان العلم به مستحيلا، أما الغلط، فمعياره شخصي يتمثل بالجهل الفعلي ويتمثل أثره في إبطال التصرف القانوني الذي داخله الغلط. (الجمال، ص60) ومن المقرر أنه إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري في القانون حمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولا هذا الغلط، جاز له طلب إبطاله (السرحان، وخاطر، 2023، ص144)، غير ان ذلك لا يعد استثناء أو خروجا على مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون (بكر، 2025، ص85) وانما، هو اعفاء من حكم قاعدة قانونية او الخضوع لقواعدها بمنع سريانها عليه وهو مناط الغلط قانونا (كيرة، ص321) والاصل؛ أن الاعتداد في الغلط في الواقع، يتضمن بالنتيجة اعتدادا بالغلط في القانون الذي أدى إلى خلقه، مما يحد من دائرة تأثير مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، (الجمال، ص16)
وباستقراء ما سبق ؛ لا يعد الغلط عذرا متى تعارض مع مقتضى حسن النية، وفقا للمادة( 156/2 من القانون المدني الأردني) “ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضيه حسن النية” فمن تقرر له الحق في التصرف القانوني بسبب الغلط الجوهري، لا يجوز له اساءة استعمال هذا الحق، فاذا تعاقد شخص لشراء شيء، على أنه أثري ثم تبين له، خلاف ما اتفق عليه، فلا يجوز التمسك، بفسخ العقد للغلط الجوهري رغم توافر شروط الغلط، إذا عرض البائع عليه ذات الشيء الأثري الذي كان يريد شراءه، لان الفسخ هنا يتعارض مع ما يقتضي به حسن النية في المعاملات المالية” (الجبوري 2023 ص 144)
ومن الجدير قوله ؛ في مجال الصلح والاقرار القضائي أجاز المشرع الأردني بالمادة 50/2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتقابلها المادة 121/ 2 من قانون البينات والاثبات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 ” الرجوع عن الإقرار القضائي اذا كان نتيجة لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك” وهي استثناء عن القاعدة العامة بان الاقرار حجة قاطعة على المقر تمنع الرجوع عنه أو تعديله أو إضافة واقعة تغير دلالته، ويتصور هذا الاستثناء في حالة صدور الإقرار عن خطأ بالواقع، كما لو أقر الوارث بدين على مورثه وهو يجهل أن هناك مخالصة بهذا الدين فإذا تبينت المخالصة لاحقا جاز له، أن يرجع عن إقراره بسبب هذا الخطأ في الوقائع (المنصور، 2024، ص335) ويستخلص مما سبق، ان كل غلط بالقانون يتضمن في جوهره نوعا من الجهل بأحكامه غير ان التمسك بالغلط بالقانون لا يعني استبعاد تطبيق القانون ذاته او اقصاء احكامه. (عثمان، والسيوطي، 2016، ص220)
- الخاتمة
تناولت الدراسة: ماهية الحق بالتقاضي ومظاهر الرقابة القضائية على استعماله، ودلالة اطلاقه بين مفاهيم الحريات والرخص العامة، ثم بيان حقيقة حسن النية بالتقاضي، ودوره بتمايز الاستعمال المشروع أو مناقضته بالاستعمال التعسفي، وقد توصل الباحث الى عدة نتائج وتوصيات خلال الدراسة على النحو الاتي:
4.1 النتائج:
- الحق، مفهوم متعدد التعابير، لا يقع تصوره في مفهوم جامع، ويمكن تصوره بكافة الاعمال القضائية.
- لم تسقر الآراء الفقهية حول حقيقة التقاضي وهل يعد حقا ام يقع ضمن الحريات والرخص العامة، ولم تستقر الاحكام القضائية، بالتعبير عن التقاضي بمفهوم محدد، بل ادرجت تعابير الحق، او الحرية والرخص العامة، لتبرير استعمال الحق في التقاضي.
- لم تفصح مجلة الاحكام العدلية “باعتبارها القانون المدني النافذ في فلسطين عن الأخذ بنظرية إساءة استعمال الحق، لكن قواعد المجلة تمثل معايير النظرية بالفقه الإسلامي.
- تعد المقاضاة الكيدية الأساس القانوني للرقابة القضائية على إساءة استعمال الحق في التقاضي في فلسطين، ولقد نظمت احكامها طبقا للمادة 30 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لعام 1944، وتعديلاته لسنة 1947 ” النافذ في فلسطين.
- نظم المشرع الاردني نظرية إساءة استعمال الحق، بالمادتين 61 و66 من القانون المدني، واستقر القضاء الأردني بتطبيق نظرية إساءة استعمال الحق كمظهر رقابي على استعمال التقاضي. ولقد عبر القضاء الأردني عن تعبيري الإساءة والتعسف كمرادفين لذات المعنى بالتقاضي.
- لم تستقر التشريعات المقارنة، حول مفهوم جامع لحسن النية، والمستقر في التشريعات المقارنة، حسن النية مفترضً في التقاضي، ويقع على عاتق من يدعي عكس ذلك إثبات ادعائه بكافة وسائل الإثبات.
- يجري قياس النية الاجرائية بالتقاضي من خلال معياران شخصي، او موضوعي. ويعد المعيار الموضوعي أكثر عدالة في تحري حقيقة النية الإجرائية وتمايز الاستعمال غير المشروع.
- لم تحدد التشريعات المقارنة ضوابط مبدأ حسن النية وطبائعه الفقهية، وهل هو مبدأ قانوني، أم قاعدة أخلاقية، أم التزام قانوني. ورغم ذلك أعلن المشرعان الفرنسي والسعودي أن حسن النية، يمثل التزامًا قانونيًا يمتد طوال مراحل إبرام المفاوضات التعاقدية وحتى إتمامها، ويترتب على إساءة استعماله بطلان الالتزام وقيام الحق في التعويض.
- الغلط وصف يعتري التصرفات عموما، ويبرر التمسك بحسن النية كدافع لانتفاء المسؤولية المدنية، لكنه لا يقر، إذا تعارض مع مقتضى حسن النية.
- مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون لا يسري على جميع القواعد والأشخاص في نطاق التقاضي، ويمكن الدفع به كمبرر للتحلل من المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي فيما يخص القواعد المكملة، وفي حدود الدعاوى المدنية فقط. أما القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الآمرة فلا يقبل فيها الاعتذار بالجهل بالقانون، كما لا يجوز الاحتجاج بهذا المبدأ، سواء بالنسبة للقواعد الامرة أو المكملة، من جانب المشتغلين بالقانون كالقضاة وأعضاء النيابة والمحامين.”
4.2 التوصيات
- توحيد منطوق الاحكام القضائية، بالتعبير عن استعمال التقاضي بالحق، وليس بالحريات أو الرخص العامة.
- اقرار نظرية إساءة استعمال الحق في القضاء الفلسطيني كمظهر رقابي على التقاضي المشروع أو كدليل على مناقضته بالاستعمال التعسفي خلال مراحل استعماله، ويستدل على مشروعية تطبيق النظرية من خلال تنظيمها في مجلة الأحكام العدلية، لاسيما عبر قواعدها العامة.
- إقرار حسن النية، التزاما قانونيا بالقوانين الإجرائية، يرتب الاخلال بمقتضياته، ثبوت المناقضة والاستعمال التعسفي بالتقاضي ووجوب الجزاء المدني.
- إقرار قانون مدني فلسطيني، والاهتداء في قواعد القانون المدني الأردني المتعلقة بالمسؤولية الموضوعية وفكرة التعويض كلما وقع الاضرار بصرف النظر عن فاعله، مالم يبرره، جواز شرعي، والاقتداء بنظام المعاملات المدنية السعودي لعام 2023، لما تميزبه من حداثة تشريعية، تمثلت بالجمع بين أصول الفقه الإسلامي وحداثة التطورات التشريعية في الفقه الغربي. كما وردت الإشارة اليه بالدراسة بخصوص حسن النية كالتزام قانوني طيلة مراحل التفاوض العقدي.
- تبرير الاعتذار بالجهل بالقانون بالقواعد الإجرائية المكملة خلال التقاضي، كمسوغ لانتفاء سوء النية او القصد التعسفي.
- إجراء تعديلات على قانوني السلطة القضائية في كل من الأردن وفلسطين، بهدف منح القضاة صلاحيات أوسع تسهم في إطلاق الفكر القضائي، وتمكينهم من مواجهة ظاهرة إساءة استعمال الحقوق القضائية التي تتسم بعدم المحدودية، وثم تكرار الطعون والدعاوى المتعاقبة، بما يحقق حماية فعالة للعدالة ويمنع استغلال النظام القضائي.
- إعلان المسؤولية الناجمة عن إساءة استعمال حق التقاضي، مسؤولية تعسفية، تقع ضمن نظرية إساءة استعمال الحق بشكل مستقل، مما يخرجها من نطاق الخطأ في المسؤولية التقصيرية. ومرد ذلك. قدرة نظرية التعسف على احاطة كافة اضرار التقاضي غير المشروع بواسطة معاييرها العامة، بلا ضرورة لثبوت الخطأ التقصيري بمفهومه القانوني الشائع، وانما تستند الى مأل الفعل او نتيجته بثبوت أحد معايير النظرية بلا خطأ مقصود ويتماشى ذلك مع حقيقة النظرية التي اقرت بشكل مستقل بالقانون المدني الأردني، ولا تقع بالأصل ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية من حيث طبيعتها ومعاييرها في ثبوت المسؤولية.
- الغاء العمل بقانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 وتعديلاته لعام 1947 لارتباطه مفاهيمه ببنية تشريعية غائرة بالاختلاف مع التشريعات الفلسطينية المستحدثة، والاكتفاء بقواعد المجلة الى حين إقرار قانوني مدني جديد؛ لما تتسم به قواعد المجلة من شمول اعم لارتباطها بشكل رئيس بالقوانين المدنية العربية بما يمكنها من مواكبة التغيرات التشريعية، رغم تنوع الإشكاليات القانونية، وفعاليتها في معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها بالإضافة الى ان القاعدة العامة بالمادة 91 من المجلة ” الجواز الشرعي ينافي الضمان: اثبتت فاعليتها في مواجهة كل فعل او تصرف قانوني يخرج عن نطاق المشروعية، ويستوجب حسب المفهوم المخالف، للقاعدة ؛ فرض الجزاء المدني.
قائمة المراجع
- احمد أبو الوفا (2015)، المرافعات المدنية والتجارية، بمقتضى قانون المرافعات، المدنية والتجارية الجديد رقم 13 لسنة 1968 وقانون الاثبات رقم 35 لسنة 1968، مكتبة الوفاء القانونية للنشر.
- احمد السيد الصاوي، (2010)، الوسيط في شرح قانون المرافعات، معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، دار الجامعة الجديدة للنشر
- احمد سمير محمد ياسين، ومروي عبد الجليلسنابة، (2021)، مبدأ حس النية، في قانون المرافعات المدنية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الدراسات المستدامة، السنة الثالثة، عدد 3، ملحق 1
- احمد، إبراهيم الحيارى، (2022) تعديلات القانون المدني الفرنسي، المتعلقة بالعقد، دراسة مقارنة بالقانون المدني البحريني، مجلة هيئة التشريع والرأي، العدد الحادي عشر، القانونية.
- امين دواس (2008)، المسؤولية عن قطع المفاوضات دون سبب جدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية والشرعية، 5(1).
- امين دواس، (1991)، معايير التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن.
- امين دواس، (2012)، مجلة الاحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، حقوق الطبع محفوظة للمعهد القضائي الفلسطيني، الطبعة الأولى.
- انيس منصور المنصور، (2024)، شرح احكام قانون البينات الأردني، وفقا لأخر التعديلات، معزز بأحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الطبعة الرابعة، حقوق الطبع محفوظة، للمؤلف.
- جلال، محمد إبراهيم، (2004)، المسؤولية المدنية للقضاة “مخاصمة القضاة ” محاولة لدراسة قضائية، مجلة حقوق حلوة للدراسات القانونية والاتصادية، ع(11)
- جميل الشرقاوي، (1970)، دروس في أصول القانون، الكتاب الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة
- حسن كيره، (1969)، المدخل الى القانون، القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة للحق، منشاة المعارف بالإسكندرية.
- داليا مجدي عبد الغني، (2016)، المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي دار الجامعة الجديدة.
- داود سليمان ابن عيسى، والرقيب لافيمحمد، (2021)، نظرية التعسف: تاريخها واشكالية المفهوم، والعلاقة بالتعدي، دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 10(11)، ص 93
- روزين طالب محمود السويطي، (2018)، مبدأ حسن النية في إبرام العقد وفقا لأحكام مشروع القانون المدني الفلسطيني بالمقارنة مع مجلة الأحكام العدلية، رسالة ماجستير جامعة القدس فلسطين.
- سعد علي احمد رمضان، (2013)، إساءة استعمال الحق في التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الامارتي، الناشر، القيادة العامة للشرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة، 22(85)، ص 235.
- سلامة عبد المحسن، وعبد يحيى إبراهيمخالد، (2020)، التعسف في توجيه اليمين الحاسمة في قانون البينات الفلسطيني، دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية القانون، 34(83).
- سليم أحمد، (2023)، المسؤولية التقصيرية في فلسطين في ضوء قانون الأخطاء المدنية الإنجليزي، الطبعة الأولى، حقوق النشر محفوظة للمؤلف
- سيد احمد محمود (2005)، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر،
- السيد عز الدين ياسر احمد عبد الحميد محمد، (2021)، المسؤولية المدنية عن أساءة، استعمال حق التقاضي “دراسة مقارنة “رسالة دكتوراة جامعة المنصورة، مصر.
- الشيماء محمد سليمان، (2023)، الخطأ المدني للقاضي، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث.
- عباس أحمد قطب، (2006)، إساءة استعمال الحق في التقاضي بين النظام الإسلامي والأنظمة القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر مصر
- عبد الله عبد الحي الصاوي، (2021)، الحق في التقاضي وتحقيق السلام الاجتماعي، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، ع( 38).
- عبد الله عبد العزيز الصعب، (2010)، التعسف باستعمال الحق في مجال الإجراءات المدنية دراسة تأصيلية مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية الرياض
- عثمان التكروري، أحمد طالب السيوطي، (2016)، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي، في ضوء احكام مجلة الاحكام العدلية، وقانون المخالفات المدنية، بالمقارنة مع مشروع القانون المدني الفلسطيني، والقانون المدني المصري، والقانون المدني الأردني، الطبعة الأولى، المكتبة الاكاديمية، فلسطين الخليل.
- العجيلي محمد حسن علاوي، (2016)، الغلط في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، ط1، دار السنهوري للنشر والتوزيع.
- عدنان إبراهيم السرحان، ونوري حمدخاطر، (2023)، القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، دراسة مقارنة، ط9، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان.
- عدنان القوتلي، (1963)، الوجيز في الحقوق المدنية الجزء الأول المدخل للعلوم القانونية، القسم الأول، المبادئ العامة للعلوم القانونية، الطبعة السابعة، مطابع دار الفكر بدمشق.
- عصمت عبد المجيد بكر،(2025)، دور حسن النية بالقوانين المدنية العربية، الجزء الأول، في نظرية العقد، العقود المدنية المسماة، مع المقارنة بالفقه الإسلامي، المركز الأكاديمي للنشر، الإسكندرية
- علي حمود الهاجري، (2013)، إساءة استعمال حق التقاضي في التشريعات المصرية والكويتية، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية كلية الحقوق، 22(37)، ص 194
- عوض احمد الزعبي، (2025) الوسيط، في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التنظيم القضائي، الاختصاص، التقاضي، الاحكام، وطرق الطعن، الجزء الاول، الاحكام، طرق الطعن، الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،
- عوض احمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدينة، الطبعة الرابعة، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، سنة
- فتحي الدريني، (1977) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية
- فتحي الدريني، (1998)، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة للطباعة والتوزيع.
- فضل ماهر عسقلان، (2008)، المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس ” فسطين.
- كمال العياري، (2017)، اتصال القضاء في المادة المدينة، الطبعة الأولى، جميع حقوق النشر والطبع محفوظة.
- محمد المرجاح (2023)، شرح نظام المعاملات المدنية السعودي الجزء الأول، المادة الأولى، وحتى المادة 306، الأحكام العامة ونطاق التطبيق والأشخاص الطبيعية والاعتبارية والحقوق الشخصية ومصادر الالتزام وآثار الالتزام وانقضاء الالتزام، متوفر على الموقع الإلكتروني almirjah.org
- محمد بارق يوسف، (2025)، التعسف باستعمال حق التقاضي، دراسة قانونية مقارنة، المركز الأكاديمي للنشر، ومكتبة الدراسات العربية للنشر والتوزيع
- محمد خليل محمد أبو رحمة، (2018)، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين.
- محمد ربيع أنور الباب فتح (2022)، أثر مبدأ حسن النية في إنهاء عقود المدة دراسة تحليلية مقارنة، كلية الحقوق جامعة عين شمس المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية.
- محمد شعيب محمد عبد المقصود، (2021)، الاعتذار بجهل القانون بين الاطلاق والتقييد، دراسة مقارنة، “المجلة القانونية ” مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية. جامعة القاهرة. مجلد 9، عدد14، ص 4750
- محمد عرفان الخطيب، (2019)، الجديد في ركائز العملية التعاقدية، في التشريع المدني الفرنسي، دراسة نقدية تأصيليه مقارنة، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، 11(3).
- محمد عرفان الخطيب، (2019)، المبادئ المؤطر لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد دراسة نقدية تأصيلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية السنة السابعة العدد 2، العدد التسلسلي26
- محمد مصطفى التونسي، وزهير حرح، (2024)، دور القضاء الفرنسي في اصلاح قانون العقود” المرحلة السابقة على التعاقد والالتزام بالأعلام، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، 4(3).
- مدني لعجال، (2022)، مبدا حسن النية وجزاء الاخلال به بالقانون المدني الجزائري، مجلة الفكر القانوني، والسياسي، 6(2).
- مصطفى احمد الزرقا، (1987)، صياغة قانونية، لنظرية التعسف باستعمال الحق في قانون إسلامي. مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها الطبعة الثانية، دار البشير للنشر والتوزيع.
- مصطفى أحمد الزرقا، (1999)، المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق.
- مصطفى أحمد الزرقاء، (1980)، سيارة قانونية لنظرية التعسف استعمال الحق في قانون الإسلامي مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها، دار البشير للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان.
- مصطفى سلامة عز العرب سلامة (2022)، مبدأ الامانة الإجرائية امام القضاء المدني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، 4(3).
- مصطفى مجدي الجمال، (1974) الجهل بالأحكام المدنية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، 16 (1)، ص 67-68.
- نصيف المباحي، وعلي عبد الرضا عباس، (2022)، مباني نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، عدد 46.
- نوري احمد خاطر، (2017)، وظائف حسن النية في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، رقم 5 لسنة 1985 -دراسة مقارنة مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد1، السنة الخامسة، ص 41.
- وعد غالب الشوابكة (2021)، التعنت الاجرائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- وليد عيسى عبيات، (2023)، التعويض عن الخطأ القضائي دراسة مقارنة بين القانون على مصري والفلسطيني، الطبعة الأولى، دار دجلة، للنشر عمان
- ياسين محمد الجبوري، (2006)، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، اثار الحقوق الشخصية، احكام الالتزامات، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع
- ياسين محمد الجبوري، (2023)، النظرية العامة للالتزامات والحقوق الشخصية الجزء الأول مصادر الالتزام الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
- يوسف سحر سيد، (2022)، مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، المجلة القانونية، جامعة القاهرة كلية الحقوق، فرع الخرطوم 11 (5).
- يوسف شندي، (2017)، دور القضاء الفرنسي في الإصلاحات التشريعية الحديثة في مجال العقود “المرحلة السابقة على التعاقد والالتزام بالأعلام، القانون، الكويتية العالمية، 2(2).
القوانين
مجلة الاحكام العدلية.
قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944
القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
قانون البينات والاثبات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001
القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 2016
نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 2023