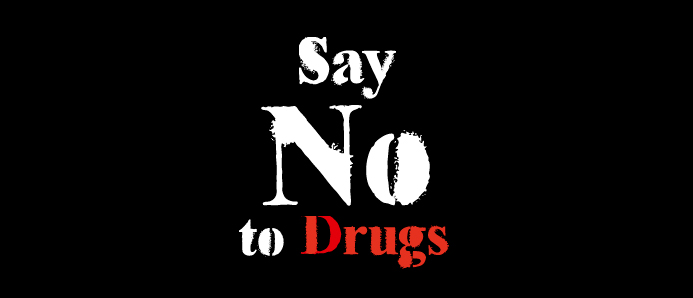اللجوء في القانون الدولي العام
The concept of asylum in public international law

اعداد : د. رلى عاصم الناشف – الجامعة الأردنية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
| ملخص |
| تتناول هذه الدراسة موضوع اللجوء في القانون الدولي العام من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تصاعد أزمات اللجوء على الساحة الدولية، وبشكل خاص في المنطقة العربية التي أصبحت من أكبر مناطق استقبال اللاجئين نتيجة الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والصراعات السياسية.
يهدف البحث إلى تحليل المنظومة القانونية الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، وبيان كيفية التداخل والتكامل بين القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في هذا المجال، مع التركيز على واقع اللاجئين في الدول العربية التي تواجه تحديات قانونية وتشريعية في التعامل مع ظاهرة اللجوء. تنبع أهمية هذا البحث من الحاجة الملحّة إلى دراسة موضوع اللجوء من زاوية شمولية تجمع بين مختلف الفروع القانونية ذات الصلة، في وقت لا تزال فيه الدراسات العربية غالبًا تتناول اللجوء من منظور أحادي، إما باتجاه اتفاقية 1951 فقط أو من خلال معالجة جانبه الإنساني دون التوسع في الأطر القانونية الأخرى. وتكمن جدة البحث وإسهامه الجديد في كونه: – يقدم معالجة قانونية متكاملة لمسألة اللجوء من خلال الربط بين ثلاث منظومات قانونية أساسية، وهو ما يميز هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة التي عالجت اللجوء بشكل منفصل في إطار كل منظومة. – يُركز على التطبيق العملي في السياق العربي من خلال دراسة حالة اللاجئين السوريين في الأردن كنموذج تطبيقي يوضح الفجوة بين النصوص القانونية والواقع. – يقدم توصيات قانونية تهدف إلى تحفيز الدول العربية على تطوير تشريعات محلية متوافقة مع المعايير الدولية. الكلمات المفتاحية: اللجوء، القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان، عدم الإعادة القسرية |
| Abstract |
| This research addresses the issue of refugee protection in public international law from the perspective of human rights and international humanitarian law, in light of the increasing refugee crises globally, particularly in the Arab region. The Arab world has become one of the largest host areas for refugees due to civil wars, armed conflicts, and political instability.
The main objective of this study is to analyze the international legal framework related to refugee protection, and to highlight the intersections and complementarities between public international law, international human rights law, and international humanitarian law. The research focuses on the specific context of Arab countries, where legal and legislative challenges complicate the handling of refugee issues. The importance of this research stems from the urgent need to study the refugee issue through a comprehensive approach that combines various relevant legal systems. Most previous studies in the Arab context have typically examined refugee law from a single legal angle, usually focusing only on the 1951 Refugee Convention or addressing the humanitarian aspects without a deep legal analysis. The novelty of this research lies in : – Providing an integrated legal analysis of the refugee issue by linking three fundamental legal systems, distinguishing this study from previous research which addressed each system separately. – Focusing on practical application in the Arab region, using the case of Syrian refugees in Jordan as a practical model to demonstrate the gap between legal texts and actual practices. – Offering legal recommendations aimed at encouraging Arab state to develop national legislations compatible with international standards. Keywords: asylum, public international law, international humanitarian law, human rights, non-refoulement |
- المقدمة:
تُعدّ قضايا اللجوء من أبرز القضايا الإنسانية والقانونية التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية خلال العقود الأخيرة، ولا سيّما في المنطقة العربية التي باتت مسرحًا لأزمات سياسية وحروب أهلية ونزاعات مسلحة أدّت إلى موجات لجوء غير مسبوقة. فقد أصبح اللجوء ظاهرة معقدة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع القانونية، وتفرض على المجتمع الدولي تحديات تتجاوز حدود الاتفاقيات التقليدية.
لقد تطورت الحماية الدولية للاجئين تاريخيًا منذ اتفاقية فيينا لعام 1815، مرورًا باتفاقيات اللاجئين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وصولًا إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها. ومع ذلك، فإن الحماية القانونية للاجئ لم تقتصر على اتفاقية 1951 وحدها، بل أصبحت اليوم ترتبط أيضًا بمنظومتين قانونيتين أساسيتين هما: القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما يطرح تساؤلات حول مدى تكامل هذه القواعد في تحقيق الحماية الكاملة للاجئين، خاصة في سياقات النزاعات المسلحة.
في العالم العربي، تتفاقم إشكاليات اللجوء بسبب غياب تشريعات وطنية واضحة في معظم الدول، وعدم وجود اتفاقية عربية إقليمية ملزمة تنظم أوضاع اللاجئين وفق المعايير الدولية. يضاف إلى ذلك أن بعض الدول العربية لم تنضم إلى اتفاقية 1951 أو البروتوكول الملحق بها، مما يخلق فراغًا قانونيًا ينعكس سلبًا على حماية اللاجئين ويجعلهم في كثير من الأحيان عرضة لانتهاكات حقوقهم الأساسية، مثل الإعادة القسرية أو الحرمان من التعليم والعمل والصحة.
من هنا تنبع أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة موضوع اللجوء في إطار القانون الدولي العام، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال تحليل الأطر القانونية ذات الصلة، ومناقشة التحديات القانونية التي تعيق حماية اللاجئين، مع التركيز على واقع اللاجئين في الدول العربية، وإبراز أوجه القصور في التشريعات المحلية والدولية. كما يتناول البحث دراسة تطبيقية لحالة اللاجئين السوريين في الأردن كنموذج عملي لتقييم فعالية الحماية القانونية الدولية في الواقع العربي.
1.1.المنهجية:
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي في دراسة الإطار القانوني الدولي المتعلق بحماية اللاجئين، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، بالإضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تتقاطع مع قضية اللجوء. كما يستخدم البحث المنهج المقارن للمقارنة بين المعايير القانونية الدولية والوضع القانوني في الدول العربية، بهدف الكشف عن أوجه التوافق والاختلاف، وتسليط الضوء على الثغرات القانونية التي تعيق توفير حماية فعالة للاجئين في المنطقة. ويعتمد البحث أيضًا على المنهج التطبيقي من خلال دراسة حالة اللاجئين السوريين في الأردن كنموذج عملي يوضح الفجوة بين الالتزامات القانونية الدولية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. ويستند البحث إلى تحليل الوثائق والتقارير الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، فضلًا عن الدراسات الأكاديمية السابقة، لبناء رؤية شاملة ومتكاملة حول الأبعاد القانونية والإنسانية لقضية اللجوء في الدول العربية. يتيح هذا الأسلوب
المنهجي دراسة المشكلة من مختلف جوانبها القانونية والعملية، والخروج بتوصيات علمية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير منظومة الحماية القانونية للاجئين في العالم العربي.
1.2.أسئلة البحث:
- ما هو الإطار القانوني الدولي الذي ينظم حماية اللاجئين وفق القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني؟
- كيف تتداخل هذه الأنظمة القانونية الثلاثة (الدولي العام، حقوق الإنسان، القانون الإنساني) في مسألة حماية اللاجئين، وهل يوجد تكامل بينها أم تضارب؟
- ما هي أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه حماية اللاجئين في الدول العربية؟
- لماذا تفتقر معظم الدول العربية إلى تشريعات وطنية متكاملة تنظم وضع اللاجئ رغم استضافتها لأعداد كبيرة منهم؟
- ما هي الحلول القانونية المقترحة لتعزيز حماية اللاجئين في الدول العربية بما يتوافق مع المعايير الدولية؟
1.3.فرضيات البحث:
- إن حماية اللاجئين تكون أكثر فعالية عندما يتم تفسير وتطبيق قواعد القانون الدولي العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل تكاملي، لا بشكل منفصل.
- غياب التشريعات الوطنية المتكاملة الخاصة باللاجئين في الدول العربية يؤدي إلى وجود ثغرات قانونية تعيق توفير الحماية اللازمة للاجئين.
- هناك فجوة واضحة بين الالتزامات الدولية للدول العربية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع، نتيجة الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية.
- صياغة إطار قانوني عربي موحد لحماية اللاجئين يمكن أن يسهم في معالجة الإشكاليات القائمة ويساعد على تحقيق حماية أكثر فعالية واتساقًا مع القانون الدولي.
1.4. الإطار القانوني لحماية اللاجئين
توضح الدراسة أن اتفاقية 1951 والبروتوكول لعام 1967 يشكلان حجر الأساس في حماية اللاجئين، وإن بقي تعريف اللاجئ فيها محدودًا مقارنة بالواقع المعاصر. أما القانون الدولي الإنساني، فقد منح اللاجئين حماية ضمنية باعتبارهم مدنيين، دون تقديم تعريف مستقل لهم، مع حظر النقل القسري والإعادة إلى أماكن الخطر بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. وبالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو يوفر الحماية الأوسع والأكثر شمولًا للاجئين كأفراد في جميع الأوقات، لكنه يعاني من ضعف في آليات الإنفاذ أمام تذرّع الدول بالسيادة والمصلحة الوطنية.
- مفهوم اللجوء في القانون الدولي
برزت أزمة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتغيرات الكبيرة التي شهدها العالم، حيث أدرك المجتمع الدولي أن مشكلة اللاجئين التي نشأت نتيجة لهذه الحرب لم تكن مجرد مشكلة مؤقتة. ومع استمرار الأزمات السياسية والصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، أصبح اللجوء الطويل الأمد هو السائد، بدلاً من اللجوء المؤقت، مما فرض الحاجة إلى وضع إطار قانوني دولي لمعالجة هذه الأزمة. ومن أبرز هذه الإتفاقيات، اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، والتي تم تعديلها لاحقاً بواسطة البروتوكول الملحق بها لعام 1967
2.1 اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1951
بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 429 لعام 1950، عُقد مؤتمر المفوضين المتعلق باللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في جنيف، والذي أسفر عن صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، والتي فتحت باب التوقيع عليها في 28 يوليو 1951 وبدأت سريانها في 22 أبريل 1954.
تعتبر اتفاقية 1951 أساسًا للـقانون الدولي للاجئين، إذ إنها أول اتفاقية دولية ملزمة للدول الأعضاء، حيث تناولت بشكل شامل جميع النواحي القانونية المتعلقة باللاجئين، وحقوقهم، وواجبات الدول في حماية هؤلاء الأشخاص. كما أدرجت الاتفاقية العديد من المبادئ الأساسية، مثل مبدأ التعاون الدولي بين الدول في التعامل مع أزمة اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية (الذي يمنع إرجاع اللاجئ إلى دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد (Jaravani, 2013, p. 3).
تتكون الاتفاقية من ديباجة و (46) مادة، موزعة على (7) فصول. وقد أكدت الديباجة على مبدأ عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والحريات الأساسية، وذلك من خلال الإشارة إلى وثيقتين أساسيتين في حق اللجوء هما ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تمهد الديباجة الطريق لإبرام اتفاقيات دولية أخرى، استنادًا إلى التعاون الدولي الضروري لحل مشكلة اللجوء باعتبارها قضية عالمية.
تضمن الفصل الأول من الاتفاقية “أحكامًا عامة” تتعلق بتحديد مصطلح اللاجئ والحقوق المترتبة على هذه الصفة وشروط منحها، بالإضافة إلى معاملة الحكومات للاجئين بما يعادل معاملة الأجانب. أما الفصل الثاني فقد تناول القوانين الواجبة التطبيق على النواحي القانونية للاجئين وتحديد الوضع القانوني لهم. وركز الفصل الثالث على تنظيم عمل اللاجئين سواء كان بأجر أو بدون أجر، وكذلك المهن الحرة. كما خصص الفصل الرابع لرعاية اللاجئين وحقهم في الاحتياجات الأساسية مثل التعليم، السكن، والمستلزمات الطبية. أما الفصل الخامس فقد تناول مجموعة من التدابير الإدارية التي يجب على الدول احترامها، مثل وثائق السفر، بطاقات الهوية، حظر الطرد أو الرد، والتجنيس. وتناول الفصل السادس مجموعة من الأحكام التنفيذية والانتقالية، مثل التعاون المشترك بين منظمة الأمم المتحدة والحكومات. في حين تم تخصيص الفصل السابع للأحكام الختامية التي تتعلق بكيفية الانضمام والتصديق والتوقيع والتحفظات التي قد تبديها الدول على الاتفاقية، إضافة إلى كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء (حسن، 2016، ص 23-24).
وقد حددت اتفاقية 1951 المهام التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن أبرزها: تقديم المساعدات الغذائية، الاحتياجات الصحية، ومتطلبات العيش للاجئين، إلى جانب مساعدة فئات أخرى مثل النازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة لأزمة اللاجئين عبر إعادة توطينهم في دول أخرى أو العودة الطوعية إلى بلدانهم، مع ضمان عدم إعادتهم قسرًا إلى بلدانهم التي يتعرضون فيها للاضطهاد والخطر. كما تعمل المفوضية على الترويج لعقد اتفاقيات دولية وإقليمية بشأن وضع اللاجئين، ومراقبة مدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية التي تشكل في مجموعها القانون الدولي للاجئين (يونس، 2017، ص 15-16).
ومع ذلك، تعرضت هذه الاتفاقية لعدد من الانتقادات، حيث قُيدت بقيود زمنية وجغرافية كانت تقتصر على توفير الحماية للاجئين الأوروبيين بشكل أساسي. كما أن نصوصها أصبحت غير ملائمة للأوضاع الحالية، إذ تواجه صعوبة في التطبيق بسبب غياب الآلية اللازمة لمراقبة تنفيذ الحكومات لهذه الاتفاقية. وللتخفيف من هذه الانتقادات، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطوير آليات جديدة وآراء قانونية للتعامل مع أزمة اللاجئين وتطوراتها، وذلك في ظل التغييرات السياسية، النزاعات الداخلية، والكوارث الطبيعية، التي تؤدي إلى تغير صفة طالبي اللجوء وظهور فئات أخرى من اللاجئين لم تتمكن الاتفاقية من معالجتها. وقد كان تزايد انتهاكات حقوق الإنسان هو السبب في ظهور الحاجة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية اللاجئين، خاصة أن الدول المستقبلة للاجئين تسعى لتحقيق التوازن بين تنفيذ التزاماتها في حماية حقوق الإنسان من جهة، والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية من جهة أخرى (عباس، 2015، ص 8).
2.2 بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين
تم اعتماد البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين لعام 1967 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1186) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2198) لعام 1966، وقد تم التوقيع عليه في سنة 1967. جاء البروتوكول بهدف توسيع نطاق الحماية للاجئين، ليشمل الحالات التي تتجاوز القيود الزمنية والجغرافية التي كانت مفروضة في إتفاقية 1951، (حسن، 2016، ص 67) والتي كانت تقتصر في البداية على اللاجئين الأوروبيين فقط. وتعود الحاجة لهذا التعديل إلى تدفق موجات من اللاجئين من القارة الإفريقية، ولا سيما بعد حرب التحرير الجزائرية. ونتيجة للقيود الزمنية والجغرافية في تعريف اللاجئ، لم يتمتع هؤلاء اللاجئون بأي حماية دولية.
ورغم أن البروتوكول تبنى نفس النهج الذي تبنته الإتفاقية في بيان مفهوم اللاجئ، إلا أنه يُعتبر وثيقة دولية مستقلة، إذ سمح للدول أن تكون طرفًا فيه حتى وإن لم تكن طرفًا في الإتفاقية الأصلية (الرشيدي، 2017، ص 76).
يتكون البروتوكول من ديباجة وأحد عشر مادة، حيث تطرقت الديباجة إلى الأسباب والدوافع التي دفعت إلى عقد البروتوكول، والإشارة إلى ظهور فئات جديدة من اللاجئين لم تشملهم إتفاقية 1951 بسبب حصر نطاق تطبيقها على اللاجئين الأوروبيين اعتبارًا من 1 يناير 1951.
أما المادة الأولى من البروتوكول، فقد نصت على إزالة القيود الزمنية والجغرافية التي كانت واردة في الإتفاقية، بحيث تشمل الحماية جميع اللاجئين الذين تتوفر فيهم صفة اللاجئ دون النظر إلى هذين القيدين. وبالتالي، لم تعد مشكلة اللجوء مقتصرة على القارة الأوروبية، بل أصبحت مشكلة عابرة للقارات، ولتيسير مهمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، أشارت المادة الثانية إلى ضرورة التعاون بين السلطات الوطنية للدول المتعاقدة مع الأمم المتحدة. فيما تناولت المادة الثالثة إلزام الدول المتعاقدة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بما يتم اعتماده من تشريعات لتطبيق البروتوكول. أما المادة الرابعة فقد نصت على كيفية تسوية المنازعات بين الأطراف، بإحالتها إلى محكمة العدل الدولية. فيما أشارت المادة الخامسة إلى كيفية الانضمام إلى البروتوكول (حسن، 2016، ص 69).
كما نصت المادة (6/أ) من البروتوكول على مساواة الدول الاتحادية وغير الاتحادية في الالتزامات بحماية اللاجئين، حيث تسري عليهما ذات الأحكام دون تمييز. بينما المادة (6/ب) تناولت كيفية تطبيق البروتوكول في حالة الدولة الاتحادية، وذلك بإتخاذ إجراءات تشريعية من خلال إحالة مواد البروتوكول إلى السلطات المختصة مع توصية إيجابية. وفرضت المادة (6/ج) على الدولة الاتحادية ضرورة إبلاغ دولة اتحادية أخرى بكل الأحكام القانونية والممارسات التي تم اتباعها لتطبيق الاتفاقية أو بروتوكولها (النعيمي، 2018، ص 174).
أما بقية مواد البروتوكول فقد تضمنت أحكامًا عامة بشأن التحفظات والإعلانات، وبيان موعد بدء نفاذ البروتوكول وكيفية الانسحاب منه، وضرورة إيداع نسخة من البروتوكول في محفوظات الأمم المتحدة. وبذلك يُعتبر بروتوكول 1967 واحدًا من أهم الوثائق الدولية التي كان لها أثر كبير ومباشر في تنظيم حماية حالات اللجوء التي ظهرت بعد اعتماد الإتفاقية.
2.3. الإتفاقيات الإقليمية الخاصة بتنظيم حماية اللاجئين الأخرى
لم تعد أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 قادرة على تغطية حالات اللجوء الجديدة التي ظهرت في الوقت الحاضر، وذلك لعدم استنادها إلى الاضطهاد كسبب رئيسي للجوء، ولتجاهلها الأسباب الجديدة التي أدت إلى موجات لجوء متعددة. نتيجة لهذا القصور الواضح، تم إقصاء ملايين اللاجئين من الحماية الدولية التي توفرها الإتفاقية والبروتوكول، مما أدى إلى ظهور محاولات إقليمية جديدة لعقد عدة اتفاقيات تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للاجئين (الشيب، 2017، ص 232).. ومن أبرز هذه المحاولات:
2.4 إتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969
سعت الدول الأفريقية إلى وضع نظام قانوني يحكم جميع الجوانب المتعلقة بظاهرة اللجوء، وضرورة تناسبه مع المشاكل التي تعاني منها الدول الأفريقية المتمثلة بالحروب والثورات التي تسعى الشعوب من خلالها إلى التحرر من السيطرة الأجنبية. ويُعد العمل الأهم لمنظمة الوحدة الإفريقية قيامها بعقد إتفاقية إقليمية إفريقية متممة لإتفاقية 1951 حيث منحت هذه الإتفاقية الدول المضيفة حق الفصل في طلبات اللجوء واكتساب صفة اللاجئ من عدمها (بو معزة، 2016، ص 13)، وإعتبار منح هذه الصفة عملاً إنسانياً ودياً، يتمثل في قيام الدول الأعضاء بإستقبال اللاجئين وحمايتهم دون إلتزام قانوني فعلي بذلك (بو معزة، 2016، ص 15).
وقامت هذه الإتفاقية بإستبعاد المعيار النفسي المتمثل بتوافر الخو ف من الإضطهاد أو عدم توافره، واستبداله بعناصر أكثر، موضوعية، متمثلة بالظروف التي تحيط بالشخص طالب اللجوء التي تجبره على ترك دولته الأصلية، كالإحتلال الخارجي أو الهيمنة الأجنبية (الرشيدي، 2017، ص 76).. فضلاً عن الأحداث التي تخلّ بالنظام العام وتعمل على تقويض الأمن والسلام في الدولة، وانتشار الجريمة بسبب عدم فعالية الوسائل المستخدمة في ردع الجريمة والمعاقبة عليها. كالحروب الأهلية أو الإضطرابات الداخلية في الدولة، أو أعمال العنف التي تطال الأفراد فتجعلهم لا يتمتعون بأية حماية من الدولة، كونها غير قادرة على ذلك (حدادين، 2018، ص 44).
وفي عام 1994، قامت منظمة الوحدة الأفريقية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإصدار وثيقة أديس أبابا الخاصة باللجوء والتشريد القسري للسكان في إفريقيا. تضمنت الوثيقة توصيات تتعلق بالأسباب الأساسية لتدفق اللاجئين والنزوح القسري، وكذلك الدعم المالي اللازم لمساعدة اللاجئين (خضراوي والبسكري، 2014، ص 44). وطبقا لهذه الوثيقة، يتعين على الدول الأعضاء بذل الجهد لضمان استقبال اللاجئين ومعاملتهم دون تمييز، وتوفير عودتهم الآمنة (Ahimbisibwe, 2016, p. 742).
- تعريف اللاجئ
اللجوء في اللغة يأتي من (لجأ) الى الشيء أو المكان، يقال لجأ إلى فلان، إستند اليه وإعتضد به، ولجأ عنه أي عدل عنه الى غيره. وجمع اللاجئ لاجئون، ” وهو الذي هرب من بلده لأمر سياسي، أو غيره، ولجأ إلى بلاد دون سواها (أنيس وآخرون، 1990، ص 815).
أما الملجأ فجمعه ملاجئ، وهو مكان محصن يلوذ إليه الشخص الذي إضطر للهرب، ليبحث عن الحماية والطمأنينة.
أما تعريف اللاجئ من الناحية الاصطلاحية، فيجب الرجوع إلى المواثيق الدولية التي اختلفت في تعريفه بإختلاف الزاوية التي تقصدها بأحكامها، فقد ينطبق وصف اللاجئ على فرد معين وفقاً لوثيقة دولية معينة، بينما لا ينطبق نفس الوصف على الفرد ذاته وفقاً لوثيقة أخرى. ووفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951( The convention relating to the status of refugees 1951) اللاجئ هو كل شخص، يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951، خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للإضطهاد، لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وغير قادر، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد ” (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، المادة 1/2/1)
ويشار إلى أن الإتفاقية المذكورة أعلاه حددت الشخص الذي تنطبق عليه صفة لاجئ وفق ما جاء آنفاً على أنه ضحية أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951 في أوروبا، وذلك لكون هذه الإتفاقية جاءت على خلفية ما سببته الحرب العالمية الثانية من ويلات ودمار وتشتت للشعوب والدول التي خاضت غمارها، حيث صيغت في وقتها لإمتصاص آثار الحرب. لذلك جاء التعريف الوارد فيها مقيد بقيدين أحدهما زمني والآخر جغرافي ما ترتب على ذلك من تفرقة تعسفية، من حيث أن الشخص الذي يعاني من نفس الظروف نتيجة أحداث وقعت بعد 1 كانون الثاني 1951، أو أحداث خارج أوروبا، لا يمكن إعتباره لاجئاً. وقد أنتقد القيد الزمني، لأن تحديد زمن معين للجوء يعتبر قصوراً قانونياً، ما فرض تجاوز تحديد هذه الفترة القانونية لمن
يطلق عليهم بـ” اللاجئين” في البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1967، والذي أعتبر اللاجئ كل من يستوفي باقي الشروط المذكورة في التعريف الوارد في الإتفاقية بعيداً عن تحديد نطاق تاريخي (يونس، 2017، ص 15-16).
وفي فترة لاحقة أسفرت الإجتماعات الإقليمية الخاصة بوضع الحلول وتطوير الآليات لمعالجة مشكلة اللاجئين في البلدان الإفريقية إلى إعتماد إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين سنة 1969، التي تم بموجبها وضع تعريف للاجئ في المادة (1/1) منها، مشابه لتعريف اللاجئ الوارد في الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951. لكنها أضافت في المادة (2/1) منها توسعاً في أسباب اللجوء يتفق مع الظروف السياسية آنذاك، حيث نصت على ما يلي: ” ينطبق مصطلح لاجئ كذلك على كل شخص يجد نفسه مضطراً، بسبب عدوان أو إحتلال خارجي أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من بلد منشئه الأصلي، أو البلد الذي يحمل جنسيته، أو في أراضي أي منهما بالكامل، إلى أن يترك محل إقامته المعتادة ليبحث عن ملجأ له في مكان آخر خارج بلد منشئه الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته ” (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين، 1969، المادة 1/2) .
وورد تعريف اللاجئ أيضا في مبادئ بانكوك، التي تم إقرارها من قبل اللجنة القانونية الإستشارية لدول آسيا وإفريقيا للعام 1966 ، وفقاً للمادة (1) منها، فإنّ اللاجئ ” هو الشخص الذي يغادر دولته التي هو من رعاياها أو يمتلك جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يريد العودة إليها أو التمتع بحمايتها لذات الأسباب التي وردت في إتفاقية الأمم المتحدة 1951 (العافر & عسول، 2016، ص 17-18) أي أنّ اللاجئ هو الأجنبي الهارب خارج بلده الأصل، الذي لم يستفد من الحماية في دولته، لذلك يطلب الحماية الدولية من السلطات المختصة في دول أخرى (Goodwin-Gill & McAdam, 2009, p. 1) . ويتبين من التعريف أعلاه أنّه يتعلق بالأشخاص الذين حرموا من حماية دولهم، ولا يشمل جميع ما إستدعى إضافة مبادئ جديدة بقرار من اللجنة في أكرا 1970، تبنّت تعريفاً واسعاً يتناسب مع الظروف التي كانت تسود في الدول الآسيوية والأفريقية، بالإضافة إلى إنها أول وثيقة تناولت حق العودة للاجئ إلى دولته الأصلية، وحق اللاجئ في طلب التعويض من الدولة التي لجأ منها (أمر الله، 1998، ص 97) .
ومن جانب آخر أدت الحروب والصراعات السياسية في دول أمريكا اللاتينية الى هروب الكثير من البشر، الأمر الذي فرض إصدار إعلان قرطاجنة ( كارتا جينا) 1984، المتعلق بحماية اللاجئين في أمريكا اللاتينية، الذي تبنى وضع تعريف موسع للاجئ، وردت فيه أسباب أخرى للجوء، متأثراً بتعريف اللاجئ الوارد في إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية. حيث عرف اللاجئ بأنّه كل شخص فرّ من بلده، لأن حياته أو أمنه أو حريته قد تعرضت للتهديد من جراء العنف العام أو العدوان الأجنبي أو الانتهاكات لحقوق الإنسان، أوغيرها من الظروف التي أضرت بشكل خطير بالنظام العام (Barnett, 2002, p. 248) .
اما الإتفاقية العربية الخاصة بوضع اللاجئين في الدول العربية للعام 1994، فقد أضافت سبباً آخرا لأسباب اللجوء في تعريفها للاجئ، وهو( الكوارث الطبيعية)، وبذلك تبنت تعريفاً أوسع وأشمل من التعريف الوارد في إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، 1994، المادة 2/1) .
كما وضعت “وكالة” الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”(الأونروا) تعريفاً للاجئ الفلسطيني مشوباً بالنقص، لكونها حددت من هو الشخص المؤهل للإستفادة من الحماية التي تفرضها وكالة الأونروا، بدلاً من تحديد من هو اللاجئ. بالإضافة إلى تحديد سبب وحيد لحالة اللجوء في فلسطين على الرغم من وجود أسباب أخرى، متمثلاً بفقدان المسكن أو وسائل معيشة الشخص نتيجة حرب سنة 1948 (خضراوي & بسكري، 2015، ص 49) .
3.1 وفي إطار التعاريف أعلاه فإن الباحثة، تقترح التعريف الآتي للاجئ:
اللاجئ هو أي فرد اضطر إلى مغادرة بلده الأصلي بسبب الاضطهاد، الصراعات، أو المخاطر التي تهدد حياته أو حريته، ولم يعد قادرًا على التمتع بالحماية في وطنه، مما يجعله بحاجة إلى حماية دولية تكفل له حقوقه الأساسية وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية. وترى الباحثة أن مفهوم اللاجئ يتجاوز التعريف القانوني الضيق الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1951، ليشمل أيضًا الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، حيث لا يُعتبر اللاجئ مجرد حالة قانونية، بل هو فرد يحمل تجربة إنسانية معقدة تتطلب استجابات شاملة تشمل الحماية، الإدماج، وضمان العيش الكريم في المجتمع المضيف.
3.2 تعريف اللاجئ في القانون الدولي الإنساني:
يقصد باللجوء في القانون الدولي هروب الضحايا من الأخطار المحدقة بسبب النزاعات المسلحة إلى أماكن وهيئات تتوفر لهم فيها الحماية، وأول الأماكن التي يلجأ الضحايا إليها هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باعتبارها المفوضة من طرف اتفاقية جنيف بحماية أكثر الأفراد ضعفا، سواء كانوا أسرى حرب أو مدنيين يتعرضون للهجوم، كما تقوم بتقصي المفقودين ولم شملهم مع عائلاتهم والإشراف على إعادة الأسرى إلى أوطانهم، وتذكير جميع أطراف النزاع بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقيات جنيف.
ويتميز القانون الدولي الإنساني بغموضه في تعريف اللاجئ فقد اكتفى بالنص على إدراجه ضمن الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة أو حماية ضحايا النزاعات المسلحة. حيث نص القانون السابق ذكره على وجوب أن يحظى ضحايا النزاع المسلح، سواء كانوا نازحين أم لا، بالاحترام والحماية من الآثار الناجمة عن الحروب وأن تتوفر لهم المساعدة، ونظرا لأن كثيرا من اللاجئين يجدون أنفسهم وسط صراع مسلح دولي أو داخلي، فإن قانون اللاجئين يكون مرتبطا في كثير من الأحيان ارتباطا وثيقا بالقانون الإنساني (مبرك، 2012، ص 12) .
إذا ما أردنا البحث في قواعد القانون الدولي الإنساني عن تعريف للاجئ، فلابد من التطرق إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال، والتي نجد على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقية لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
3.3 تحديد المقصود باللاجئ في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949:
اهتمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بحماية المدنيين وبتعداد الفئات التي تحميها دون إعطاء أو إيجاد تعريف للشخص المدني، وقد ورد في المادة الرابعة من الاتفاقية أنه:” الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، بأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف نزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها” وبالتالي أدرجت الاتفاقية تعريف اللاجئ ضمن الأشخاص المدنيين ولم تتضمن تعريفا دقيقا للاجئين(مبرك، 2012، ص 12-13).
وتتضمن المادة 44 من القسم الثاني للباب الثالث المتعلق بوضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم، النص على عدم جواز معاملة الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمتعون بحماية أية حكومة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية للدولة عند تطبيق تدابير المراقبة، وبالتالي فقد اعتمدت الاتفاقية معايير لتحديد فئات اللاجئين.
أولها: معيار عدم التمتع بحماية أية حكومة، والذي ورد لأول مرة في اتفاقية جنيف الرابعة. ثانيا: كما اعتمدت الاتفاقية معيار الوقوع تحت سلطة أحد أطراف النزاع حتى يتمكن من الحماية التي تمنحها الاتفاقية. وبالتالي فالاتفاقية الرابعة اعتمدت معيارين أساسيين للشخص المدني لكنها لم تشر صراحة إلى اللاجئين، أي اعتبرتهم ضمن الأشخاص المدنيين، والحماية الممنوحة لهم باعتبارهم تحت سلطة دولة طرف في النزاع أو لانعدام حماية أية دولة (مبرك، 2012، ص 13) .
كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة على “عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض للاضطهاد بسبب آراءه السياسية أو عقائده الدينية”. كما نصت الفقرة 1 من المادة 49 من نفس المعاهدة على حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم إلى أراضي دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت الدعاوى”.
من الملاحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة لم تقدم تعريفًا واضحًا ومحددًا للاجئين في إطار القانون الدولي الإنساني، بل اكتفت بالإشارة إلى بعض الأعمال المحظورة التي تؤدي إلى تهجير السكان المدنيين قسرًا، بالإضافة إلى ذكر الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والتي تُعد مخالفة للقانون الإنساني الدولي (بلمديوني، 2017، ص 164).
فاللاجئون، الذين يضطرون إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود الدولية بحثًا عن الأمان، لم يتم تعريفهم صراحة في الاتفاقية، رغم أن نزوحهم غالبًا ما يكون ناتجًا عن الخوف من انتهاكات أطراف النزاع المسلح. ومع ذلك، أشارت المادة 45، الفقرة الرابعة، إلى اللاجئ باعتباره الشخص الذي فرّ من وطنه خوفًا من التعذيب أو الاضطهاد على يد حكومة بلاده، إما بسبب معارضته لسياساتها الداخلية أو نتيجة الاضطهاد الديني. غير أن هذه المادة لم تعالج ظاهرة اللجوء الجماعي، التي تحدث عادة أثناء النزاعات المسلحة عندما يخشى السكان من الانتهاكات الجماعية التي قد ترتكبها أطراف الصراع (بلمديوني، 2017، ص 162).
وبما أن اتفاقية جنيف الرابعة تهدف أساسًا إلى حماية المدنيين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، فقد اعترفت ضمنيًا بأن اللاجئ هو مدني بحاجة إلى الحماية، لكنها لم تضع إطارًا قانونيًا شاملاً لتعريفه، بل اقتصرت على الإشارة إلى بعض الأسباب التي قد تدفع الأفراد إلى الهروب من أوطانهم بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا.
3.4 تحديد المقصود باللاجئ في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977
انعقد بروتوكول جنيف الأول لعام 1977، المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، حيث تضمن تعريف الشخص المدني دون أن ينص صراحة على تعريف اللاجئ، بل اكتفى بإدراجه ضمن فئة المدنيين. فقد نصت المادة 50، الفقرة 1، على أن المدنيين هم “كل الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة، وفقًا لما ورد في المادة 4، الفقرة (أ) من الاتفاقية الثالثة (مبرك، 2012، ص 14) .
كما أكدت المادة 43 من البروتوكول ذاته على ضرورة حماية الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت انتماءهم لدولة الإقامة أو كانوا لاجئين، وذلك دون أي تمييز. أما المادة 85، فقد شددت على عدم جواز ترحيل السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح عن أراضيهم لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح (بلمديوني، 2017، ص 162).
يتضح مما سبق أن اللاجئ يندرج ضمن فئة المدنيين، وبالتالي تنطبق عليه شروط الحماية الواردة في المواد المذكورة، مما يرسّخ مكانته كضحية للنزاعات المسلحة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. وبذلك، فإن البروتوكول الأول لعام 1977، الملحق باتفاقيات جنيف، يؤكد أن اللاجئ يتمتع بحماية خاصة في سياق النزاعات المسلحة (مبرك، 2012، ص 14).
وقد اعتمد البروتوكول النهج ذاته الذي تبنته اتفاقية جنيف الرابعة، حيث لم يقدّم تعريفًا مستقلًا للاجئ، بل اعتبره ضمن الأشخاص المدنيين، مع تخصيص حماية قانونية تتناسب مع وضعه الإنساني.
- اللاجئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
حماية اللاجئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين
تندرج حقوق اللاجئين ضمن إطار حقوق الإنسان في بعدها الدولي، حيث تتميز بكونها عالمية، غير قابلة للتجزئة، مترابطة، ويعتمد كل منها على الآخر. وتشمل هذه الحقوق أبعادًا سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وثقافية تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وحياته من خلال فرض التزامات سلبية وإيجابية على الدول. كما تحدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحد الأدنى من الشروط التي تكفل للأفراد العيش الكريم، الشعور بالطمأنينة، والتخلص من الخوف، وتسعى إلى تحقيق التحسين المستمر لهذه الشروط (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2014).
قد يكون اللاجئون مشمولين بحماية ثلاثة أنظمة قانونية في آنٍ واحد، مما يوفر لهم ضمانات حماية متزامنة. فعلى سبيل المثال، أثناء النزاعات المسلحة، يمكن للأفراد أن يكونوا مدنيين ولاجئين في الوقت ذاته. وفي هذه الحالة، يتمتع اللاجئون بحماية مزدوجة بموجب كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، حيث يمكن تطبيقهما معًا أو بالتتابع (البهجي، 2013، ص 234-235) . علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحماية في جميع الأوقات وبغض النظر عن الظروف، حتى في غياب القوانين الأخرى.
وعلى خلاف الأجانب، يتمتع المواطنون بوضع قانوني أفضل، حيث يكفل لهم النظام القانوني حقوقًا ومزايا أوسع، بينما قد تُحجب بعض الحقوق عن غير المواطنين، ويظل تمتع الأجنبي ببعض الحقوق محدودًا مقارنةً بالمواطنين. غير أن القانون الدولي يتيح لغير المواطنين، وفي مقدمتهم اللاجئون، التمتع بحقوق معينة. ومن هنا، يبرز التحدي في تحقيق التوازن بين الحد الأدنى للحقوق التي يمكن للدولة المضيفة منحها للاجئ، والحد الأقصى الذي يضمن عدم تعرضه لتمييز أو غبن ظاهر.
وتكفل عدة اتفاقيات دولية حقوق اللاجئين، سواء المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، أو الثقافية، ومن أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1984، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4.1 حقوق اللاجئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
يتمتع اللاجئ، بوصفه إنسانًا، بكامل حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، حيث تُطبق هذه الحقوق على الجميع دون قيود زمنية أو مكانية، وفي جميع الظروف، باستثناء بعض الحقوق التي تُميز بين المواطن والأجنبي، والتي ترتبط بسيادة الدولة، (إعلان وبرنامج عمل فيينا، 1993) مثل الحقوق المتعلقة بالمشاركة السياسية والتوظيف. وفي هذا السياق، نصت المادة 3/2 من ميثاق الأمم المتحدة على أن من بين أهداف المنظمة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد والتشجيع على ذلك دون قيود (العشاوي، 2009، ص 18) . وتُطبق هذه الحقوق على أي شخص خاضع لولاية أي دولة طرف، مما يعني أن الأفراد الذين لم يصلوا بعد إلى إجراءات اللجوء يظلون مشمولين بهذه الحقوق وفقًا للقواعد العرفية ذات الصلة.
كما تعزز الاتفاقيات الدولية المتخصصة حقوق اللاجئين من خلال التأكيد على وجوب الالتزام بها واحترامها، فضلاً عن سد أي نقص أو قصور في بعضها البعض. وتجدر الإشارة إلى أن عدم مصادقة دولة ما على اتفاقية معينة لا يعفيها من الالتزام بمبادئها، إذ إن هذه الاتفاقيات تقوم على التكامل فيما بينها، مما يعني أن التخلي عن التزامات في اتفاقية ما قد يُرتب مسؤولية الدولة بموجب اتفاقية أخرى (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 22).
يتمتع الأفراد بالحماية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو الحرب، حيث تشمل هذه الحماية جميع الفئات التي تدخل في نطاقها، بما في ذلك اللاجئون وعديمو الجنسية، الذين يستفيدون من جميع الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان دون أي شكل من أشكال التمييز. ويعود ذلك إلى أن صكوك حقوق الإنسان تغطي نطاقًا واسعًا من الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية، حيث أدى انتشار المفاهيم الحقوقية إلى الاعتراف باللاجئ كشخصية قانونية مستقلة، وهو ما انعكس في المواثيق والاتفاقيات الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة 7).
أصبح للاجئ مركز قانوني يحكم وجوده على إقليم دولة أجنبية، ويُميزه عن المواطن، الذي ينتمي للدولة بحكم حمله لجنسيتها. ورغم أن اللاجئ يُعد أجنبيًا على أرض الدولة المضيفة، إلا أنه يتمتع بوضع خاص يختلف عن الأجنبي العادي، نظرًا لكونه فاقدًا للحماية الوطنية، إما بسبب رفض بلده الأصلي توفير الحماية له، أو لرفضه هو نفسه سلطات بلاده. وبالتالي، يسعى اللاجئون إلى الاستفادة من الحماية الدولية لتعويض هذا الغياب للحماية الوطنية.
من خلال الحماية الدولية، يُعد اللاجئ أجنبيًا يختلف عن الأجنبي العادي الذي دخل البلد في ظروف غير تلك التي أحاطت بدخول اللاجئ، طالبًا الحماية. وهذا يميز وضعه عن الأجنبي العادي، حيث إن طلب الحماية الذي يقدم عليه اللاجئ يترتب عليه حقوق قد تفوق أحيانًا ما يتمتع به الأجنبي العادي. وقد ضمنت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام 1967 حقوقًا للاجئين تساوي ما يتمتع به الأجانب بصفة عامة (اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، 1951، المواد 13، 15، 16، 18، 19، 20، 22، 26). ويُعد اللاجئ في هذا السياق تحت حماية قانونية قوية تسعى لضمان حقوقه الأساسية التي قد تُنتهك إذا لم يتم توفير الحماية له من خلال دولة الملجأ، سواء كان ذلك طواعية أو قسرًا (أمر الله، 1998، ص 155).
إن مبدأ عدم التمييز في مجال حقوق الإنسان أوسع نطاقًا من حظر التمييز الوارد في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، التي حصرته في العرق، والدين، وبلد المنشأ (اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، 1951، المادة 3) . بينما في قانون حقوق الإنسان، يُمكن أن تشمل أسباب التمييز العديد من العوامل الأخرى (برنامج التعليم الذاتي، رقم 5). وبالتالي، يُعامل اللاجئ بوصفه إنسانًا معاملة تتسم بالمساواة وفقًا للقواعد الحقوقية الدولية التي تضمنتها الشرائع والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (الرشيدي، 2003، ص 361).
وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، تم الإقرار بهذه الحقوق من خلال مجموعة من المواثيق (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المواد 3، 6، 8، 9، 13، 14، 15، 18، 19، 20), والتي تأكدت بعد ثمانية عشر عامًا في المواد من 6 إلى 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تتضمن نصًا مفصلاً بشأنها (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 19). كما ارتبطت مضامين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما حققته الدول الأوروبية من تقدم في مجال الديمقراطية والممارسة السياسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 1950، المادة 10).
الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، الذي يُعد على منوال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يُؤكد على حرية الرأي والتعبير، إلا أنه لم يتطرق إلى القيود المحتملة على هذه الحقوق (ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، 2000، المادة 11).
من جهة أخرى، أشار الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان في المادتين 4 و8 إلى حقوق الإنسان الأساسية، كما أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تناولت هذه الحقوق بشكل تفصيلي في مضمونها (الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1969، المواد 4، 5، 6، 8، 12، 13، 15، 16).
إلى جانب هذه الصكوك الإقليمية، توجد أيضًا معاهدات أخرى تضمن حماية حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء.
وعلى الرغم من أن بعض الحقوق قد تكون مقتصرة بشكل صريح على المواطنين، مما يجعلها استثناءً وليس قاعدة، فإنه من الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها اللاجئون وطالبو اللجوء تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تشمل هذه الحقوق: الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو الإساءة المعاملة، والحق في الحرية، والحق في حرية التنقل، والحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في الاشتراك في الجمعيات، والمساواة أمام القانون، وكذلك الحق في الحصول على جنسية، بينما تُقيد المادة 25 من العهد الدولي حق المشاركة في الشؤون العامة، التصويت، والانتخاب، وتقلد الوظائف العامة على المواطنين فقط.
كما يُقدم الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق الأساسية للأفراد غير المواطنين الذين يقيمون في بلد معين. وتشمل هذه الحقوق الواردة في المواد 5 إلى 10 من الإعلان: الحق في الحياة والأمن الشخصي، وعدم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام المحاكم، والحق في حرية الفكر والرأي والتعبير والدين، والحق في مغادرة البلد، والحق في الاجتماع السلمي، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة، والحق في عدم الطرد التعسفي أو المخالف للقانون (الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأجانب، 1985، المادة 5).
4.2 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئ
يُعدّ إعمال الحقوق المكرسة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هدفاً مشتركاً لجميع الدول الأطراف، كما تؤكد على ذلك المواد 2(1)، 11(2)(ب)، 22، و23 من العهد (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 2016).
وبما أن هذه الدول هي أعضاء في الأمم المتحدة، فقد تعهدت بالتعاون لتحقيق هذا الهدف. من الضروري المساعدة والتعاون الدوليين بشكل خاص لتمكين الدول التي تواجه تدفقاً مفاجئاً للاجئين والمهاجرين من الامتثال لالتزاماتها الأساسية.
يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حماية حق اللاجئين وطالبي اللجوء في الحصول على شروط عمل عادلة وتفضيلية، وتشكيل نقابات عمالية، والضمان الاجتماعي، وتحقيق مستوى معيشي كاف، والحصول على التعليم. كما تجيز المادة 2(3) من العهد الدولي للبلدان ذات الإمكانيات المحدودة تخفيض الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين، مع اعتبار ذلك استثناءً لضمانات حقوق الإنسان، التي تشمل اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وكذلك العمال المهاجرين وضحايا عمليات الاتجار بالبشر الدولية، حتى في الحالات التي يكون فيها وضعهم في البلد المعني غير قانوني.
تتمتع حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء أيضاً بالحماية من خلال معاهدات أخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تُعد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري معاهدة مميزة تضمن تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بنطاق واسع من الحقوق (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 5).
تتناول الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها عددًا من التوجيهات الموجهة إلى الدول الأطراف بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين، مع ترك مجال واسع للدول لاتخاذ التقدير المناسب. في هذا المجال، تتكامل هذه الاتفاقية مع العهد الدولي، ولا يمكن الفصل بينهما. ترتبط الحقوق المنصوص عليها في العهد بإمكانية تدرج تطبيقها وعدم تأجيلها، مع الالتزام الفوري، ويشمل ذلك اللاجئين والمهاجرين (إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 2016، الفقرة 4)، حيث تمس هذه الحقوق النظام الحياتي للإنسان.
أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل أو أي نوع آخر من المعاملة التفضيلية على أساس الجنسية أو الوضع القانوني ينبغي أن يكون وفقاً للقانون ويهدف إلى تحقيق هدف مشروع. وبالتالي، يجب اعتبار أي تفرقة في المعاملة لا تستوفي هذه الشروط تمييزًا غير قانوني ومحظوراً بموجب المادة 2(2) من العهد.
4.3 حالة اللجوء السوري: تحليل قانوني وواقعي
تشكل أزمة اللاجئين السوريين إحدى أبرز وأعقد أزمات اللجوء في العصر الحديث، سواء من حيث العدد أو من حيث التحديات القانونية والسياسية المرتبطة بها. فقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 5.5 مليون لاجئ منذ عام 2011، موزعين بشكل رئيسي في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، إضافة إلى موجات لاحقة اتجهت نحو أوروبا (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.) .
ورغم وضوح الأسباب التي دفعت إلى هذه الهجرة الجماعية، والتي شملت النزاع المسلح، الهجمات ضد المدنيين، استخدام الأسلحة المحظورة، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن الاستجابة الدولية اتسمت بالتفاوت الشديد. فقد تعاملت بعض الدول المجاورة مع السوريين كـ”ضيوف” دون منحهم صفة اللاجئ القانونية، كما هو الحال في لبنان والأردن، وهو ما أدى إلى إخضاعهم لقوانين الإقامة الوطنية، وغياب ضمانات عدم الإعادة القسرية (الشيب، 2017).
من الناحية القانونية، ورغم انطباق اتفاقية 1951 والبروتوكول المعدل لعام 1967 على حالة السوريين، إلا أن العراقيل السياسية والأمنية حالت دون تطبيقها فعليًا في العديد من الدول المستقبلة. كما فشلت المؤسسات الأممية، كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في فرض التزامات قانونية على الدول المستقبلة، حيث تقتصر صلاحياتها على التنسيق وتقديم الدعم الفني (Goodwin-Gill & McAdam, 2009, p. 1)
وبالنظر إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنح المدنيين الحماية أثناء النزاعات المسلحة، كان يفترض اعتبار السوريين لاجئين بحكم القانون وفق مبدأ الحماية التكميلية، إلا أن ذلك بقي إجراءً نظريًا دون تنفيذ عملي. بالمقابل، استندت الدول الأوروبية إلى مبدأ السيادة و”تقدير المخاطر الأمنية” للحد من استقبال السوريين، مع فرض قيود مشددة تتعارض أحيانًا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية (Barnett, n.d., p. 248) .
تعكس هذه الحالة التداخل السلبي بين الأطر القانونية الثلاثة: حيث أخفقت قوانين حقوق الإنسان في فرض إلزام قانوني فعال، وعجز القانون الدولي الإنساني عن حماية الفارين من النزاعات إذا لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين، بينما بقي القانون الدولي للاجئين غير قادر على فرض التزامات تقاسم أعباء ملزمة على الدول المستقبلة (Ahimbisibwe, 2016, p. 742).
أخيرًا، أظهرت أزمة اللاجئين السوريين غياب التنسيق المؤسسي بين المنظمات الدولية المعنية، وتكرار الحلول المؤقتة بدل المعالجة البنيوية للأزمة، في ظل غياب إرادة سياسية دولية لإنشاء نظام حماية جماعي عادل.
4.4 الثغرات في آليات التنفيذ
أوضحت الدراسة غياب إلزام دولي حقيقي لاستقبال اللاجئين أو تقاسم أعبائهم، حيث تبقى قرارات الاستقبال خاضعة للسيادة المطلقة للدول. وتقتصر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دور إشرافي دون صلاحيات تنفيذية أو قضائية، مع غياب نظام جزاءات فعلي أو محكمة دولية مختصة. كما يؤدي التداخل غير المنظم بين الأطر الثلاثة إلى ثغرات في الحماية.
- النتائج:
أظهرت الدراسة أن تعدد الأطر القانونية الدولية المعنية بحماية اللاجئين، والمتمثلة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لم ينتج عنه منظومة حماية فعالة ومتكاملة، بل أدى إلى تفكك الجهود وتكرار الأدوار بين المؤسسات الدولية. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أهمها:
- أولًا، إن غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات الأممية المعنية باللاجئين، وعدم وجود مرجعية قانونية واحدة واضحة، ساهما في إضعاف فاعلية الحماية القانونية الدولية. إذ بقيت اتفاقية 1951 والبروتوكول الملحق بها قاصرتين عن معالجة المستجدات المعاصرة في أسباب اللجوء، مثل اللجوء بسبب التغيرات المناخية أو الأوضاع الاقتصادية، وهو ما ظهر جليًا في حالة اللاجئين السوريين.
- ثانيًا، كشفت حالة اللاجئين السوريين عن إخفاق المنظومة الدولية في توفير حماية فعالة في الأزمات الممتدة، حيث خضعت مسألة حماية السوريين للاجتهادات السيادية للدول، دون إلزام قانوني ملزم بإعادة التوطين أو تقاسم الأعباء. وأثبتت هذه الحالة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، رغم كونه قاعدة عرفية دولية، ظل حبرًا على ورق في كثير من الحالات الواقعية.
- ثالثًا، أبرز البحث أن القانون الدولي الإنساني، رغم اعترافه باللاجئين ضمنيًا كمدنيين بحاجة إلى الحماية، إلا أنه بقي قاصرًا عن منحهم وضعًا قانونيًا مستقلًا يفرض التزامات واضحة على الدول المستقبلة، حيث ينطبق هذا القانون فقط في زمن النزاعات المسلحة، دون ضمان حماية طويلة الأمد للمدنيين الفارين.
- رابعًا، أثبتت الدراسة أن حقوق الإنسان، رغم طابعها العالمي وشموليتها النظرية، ظلت عاجزة عن فرض التزامات فعلية في مواجهة اعتبارات السيادة الوطنية، وهو ما مكّن العديد من الدول من تقييد دخول اللاجئين وممارسة سياسات تمييزية تحت مبررات أمنية.
- خامسًا، بيّن البحث ضعف الجانب الإحصائي والتحليلي في كثير من الأدبيات القانونية السابقة، حيث تُغفل هذه الأدبيات تقديم معطيات رقمية حقيقية عن توزيع اللاجئين، أو نسب الحماية الممنوحة لهم، ما يعكس قصورًا في ربط التحليل القانوني بالواقع العملي، وهي فجوة حاولت هذه الدراسة معالجتها جزئيًا عبر إدراج معطيات عن اللاجئين السوريين.
وأخيرًا، خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر جذريًا في المنظومة القانونية الدولية لحماية اللاجئين، من خلال تحديث المفاهيم، وتطوير آليات التنسيق، وخلق نظام ملزم وعادل لتقاسم أعباء اللجوء، مع إيلاء أهمية خاصة للوضع في الدول العربية التي تتحمل أعباء استثنائية دون أن تتمتع بحماية إقليمية فعالة.
- التوصيات:
في ضوء النتائج المستخلصة، توصي الدراسة بجملة من التدابير المقترحة على المستويات الدولية، الإقليمية، والوطنية لتعزيز حماية اللاجئين وضمان فعالية الإطار القانوني الدولي في الواقع العملي:
- أولًا، ضرورة مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول 1967 من خلال إصدار ملاحق تفسيرية جديدة أو اتفاقية مكمّلة، تأخذ بعين الاعتبار المستجدات العالمية، مثل اللجوء البيئي والاقتصادي، وتعيد تعريف مفهوم اللاجئ بصورة أوسع، مع التركيز على الحماية الفعلية وليس الصفة القانونية الشكلية فقط.
- ثانيًا، تدعو الدراسة إلى إنشاء آلية دولية ملزمة لتوزيع أعباء اللاجئين بين الدول، تقوم على مبدأ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء العادل، بما يخفف الضغط عن الدول المستضيفة، لا سيما الدول النامية والدول العربية، مع ضمان أن تكون هذه الآلية تحت إشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة، وأن تكون ملزمة قانونيًا للدول.
- ثالثًا، تعزيز ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بمنحها صلاحيات رقابية وتنفيذية أكثر صرامة، بحيث لا تقتصر مهامها على تقديم التوصيات والمساعدات الإنسانية، بل يكون لها دور في مراقبة مدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، مع إمكانية فرض جزاءات قانونية على المخالفات الصريحة، خاصة في حالات الإعادة القسرية.
- رابعًا، توصي الدراسة الدول العربية بشكل خاص بوضع اتفاقية إقليمية عربية موحدة لحماية اللاجئين، في ظل غياب التزامات إقليمية قانونية واضحة في العالم العربي، مع تحديد تعريف موحد للاجئ يتناسب مع الخصوصيات السياسية والاجتماعية، وضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية ضمن التشريعات الوطنية.
- خامسًا، ضرورة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية في الدول المستضيفة مع مبادئ القانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بحيث يتم إدماج الحماية القانونية للاجئين في القوانين الداخلية بشكل صريح وملزم، مع تدريب الهيئات القضائية والإدارية في هذه الدول على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.
- سادسًا، توصي الدراسة بإنشاء نظام معلومات إحصائي دولي موحّد يرصد أوضاع اللاجئين في مختلف الدول، مع إلزام الدول بتقديم بيانات دقيقة وشفافة حول أعداد اللاجئين، أوضاعهم القانونية، ونسب حصولهم على الحماية، بما يُسهم في سد الفجوة بين التحليل القانوني والمعطيات الواقعية.
- سابعًا، تدعو الدراسة إلى إدماج منظمات المجتمع المدني ومراكز البحث القانونية في عملية تقييم أوضاع اللاجئين، وتطوير الحلول المقترحة، بما يُعزز الرقابة المجتمعية ويضمن استجابة قانونية واقعية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للاجئين.
- ثامنًا، تشجيع الدراسات القانونية المقارنة التي تبحث في النماذج الإقليمية الناجحة في إدارة أزمات اللجوء، ومحاولة الاستفادة منها في صياغة اتفاقيات إقليمية ودولية جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع اللاجئين السوريين كنموذج واقعي مستمر.
وأخيرًا، توصي الدراسة المجتمع الدولي بإعطاء أولوية لحماية اللاجئين في أوقات الأزمات الممتدة، واعتبار هذه الحماية التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يخضع للتقدير السياسي أو الاعتبارات الأمنية للدول، بما يُعزز فعالية المنظومة القانونية الدولية ويُعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والإنسانية في حماية الفئات الأشد ضعفًا.
لائحة المراجع
المراجع باللغة العربية:
- العافر، أ.، & عسول، ج. (2016). النظام الدولي لحماية اللاجئين في القانون الدولي العام (رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقرة بومرداس)
- خضراوي، ع.، & بسكري، م. (2015). المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين (ط. 1). مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ص49
- مبرك، م. (2012). وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة (مذكرة ماجستير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر).
- إيناس محمد البهجي، الأسس الدولية لحق اللجوء الإنساني والسياسي بين الدول، المركز القانوني للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2013، ص 234-235
- أنيس، إ. وآخرون. (1990). المعجم الوسيط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- برهان أمر الله، (1998). حق اللجوء السياسي: دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي. دار النهضة العربية، القاهرة، ص97
- بلال حميد بديوي حسن ، (2016)، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين (المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انموذجاً)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط.
- بلمبروك يونس ، حماية حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، 2017
- بلمديوني محمد، (2017) وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد (17) ، ص164.
- حمد الرشيدي، (2003) حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط ا ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،
- خضراوي، ع.، & البسكري، م. (2014). الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين (ط. 1). مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندري
- سامر هيثم حدادين، (2018) حماية طالب اللجوء مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع .
- الشيب، س. ن. ه. (2017). مسألة اللاجئين بين الحل القانوني والواقع السياسي: اللاجئون الفلسطينيون والسوريون نموذجاً. مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، العدد (1)، ص23
- عباس، م. م. (2015). سياسة أستراليا اتجاه طالبي اللجوء والاتفاقيات الدولية. بحث مقدم إلى معهد الخدمة الخارجية، ص
- العشاوي، ع. (2009). حقوق الإنسان في القانون الدولي (ط. 1). دار الخلدونية، الجزائر، ص18
- فاطمة زهرة بو معزة، (2016) الحماية الدولية للاجئين رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، الجزائر .
- النعيمي، ز. ع. (2018). المركز القانوني للاجئين وحمايتهم في نطاق القواعد الدولية الاتفاقية. مجلة الرافدين للحقوق، 18(64)، 174
- هالة أحمد الرشيدي، (2017) الإطار القانوني للجوء والالتزامات الدولية تجاه اللاجئين ،مجلة السياسة الدولية، العدد 207، السنة 53، ص76 .
المراجع الأجنبية:
- Jaravani, M. (2013). Does the 1951 UN Convention Relating to the Status of Refugees adequately protect refugees from refoulement? (Master’s dissertation). University of Cape Town, p.
- Ahimbisibwe, F. (2016). The legal status of refugee protection and state obligations in Uganda. Mbarara University of Science & Technology, p. 742
- United Nations High Commissioner for Refugees. (n.d.). The State of the World’s Refugees. UNHCR Publications.
- Goodwin-Gill, G., & McAdam, J. (2009). The refugee in international law (3rd ed.). Oxford University Press, p. 1
- Barnett, L. (n.d.). Refugee protection and international law. [op. cit.], p. 248
الاتفاقيات الدولية:
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969.
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين سنة 195
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية سنة 199
- اتفاقية جنيف لعام 1951
- اتفاقية حقوق الطفل في توفير الحماية للأطفال اللاجئي
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقي
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
- الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأجانب (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144/40 لعام 1985).
- إعلان نيويورك (2016)، الفقرة 6، بشأن اللاجئين والمهاجرين. حقوق الإنسان، العهد الدولي، اتفاقية مناهضة التعذيب
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (2014). العدالة الانتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. منشورات الأمم المتحدة، نيويورك – جنيف
- ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.