الدستور المغربي وسؤال المرجعيات
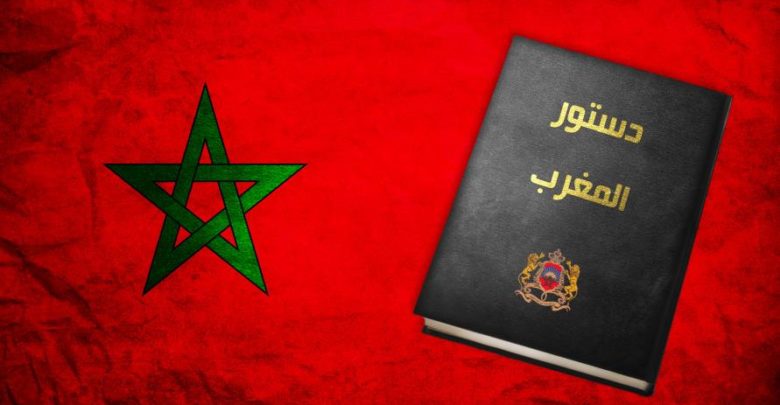
اعداد : صلاح الدين ياسين، باحث في العلوم السياسية والفلسفة، جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء – المغرب
- المركز الديمقراطي العربي
تقديم:
منذ اللحظة الدستورية الأولى التي عرفها المغرب سنة 1962، لطالما ظلت الدساتير المغربية خاضعة من حيث مضمونها ومرجعياتها السياسية – في علاقة بإشكاليتنا المتصلة بجدلية التقليدانية والتحديث – لموازين القوى السياسية السائدة، كما ينبه إلى ذلك بعض الباحثين، فيما يخص علاقة الملكية بخصومها السياسيين وضغط الشارع، وهو ما يتجلى سواء في الدساتير الخمسة الأولى (المحور الأول)، أو دستور 2011 الذي عده الكثير من المختصين لحظة فارقة في التاريخ السياسي الحديث للمغرب (المحور الثاني):
المحور الأول: الدساتير الخمسة الأولى (1962- 1970 – 1972 – 1992 – 1996)
أ- من حيث طابع الازدواجية على مستوى النص:
إن الدستور المغربي هو خليط من المفاهيم والقيم والمبادئ الفلسفية الغربية، وأخرى تنتمي إلى دائرة القانون الإسلامي[1]. ويرتكز دستور 1962 على المرجعية التقليدية والموروث السياسي المغربي، من خلال إحالته إلى إمارة المؤمنين في فصله التاسع عشر. ومع ذلك فإنه لم يبلور نظاما تقليدانيا صرفا، إذ اقتبس العديد من مقتضيات دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة[2]. وتكمن أهمية دستور سنة 1962 في كون أن الدساتير الأربعة اللاحقة عليه (دساتير 1970، و1972، و1992، و1996)، لم تُحدث إلا تغييرات شكلية وطفيفة، دون المساس بجوهر أول دستور اعتمده المغرب المستقل.[3]
ويذهب عبد الله العروي إلى أن الدستور الملكي المغربي يحتمل قراءتين: شرعية، وديمقراطية. إذ يرى أن كل كلمة أساسية فيه قد تُؤَول تأويلين (سيادة، حكومة، قانون، انتخاب… إلخ). وعلى هذا الأساس، يمكن لأي امرئ أن يُعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خلافة، أو بصيغة ديمقرطية حتى تَحسب أنه دستور دولة اسكندنافية، وهو ما يُعد نتاجا لإرث مزدوج: تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية.[4]
وتأسيسا على ذلك، ينطلق التأويل السلفي من المادة التي تقول: الدولة المغربية دولة إسلامية. فيترجم الألفاظ والعبارات والمفاهيم إلى المتعارف لدى الفقهاء الأصوليين، والنتيجة كالتالي: الملك إمام، الخزينة بيت مال، التشريع اجتهاد، البرلمان شورى، التصويت نصيحة… إلخ[5] أما التأويل الديمقراطي فيستند إلى البند القائل: السيادة للشعب، ثم يستنتج ويتابع الاستنتاج إلى غايته القصوى.[6]
ب- عن الحضور البارز للمرجعية التقليدية:
يرى محمد معتصم في أطروحته بأن الملك الدستوري لا يعدو كونه امتدادا استراتيجيا للملك كأمير للمؤمنين. فثمة ما فوق الدستور، وهو أمير المؤمنين الذي يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأصله الشريف والعلوي المقدس. إذ نجد بأن أغلب صلاحيات الملك الدستوري تجد أساسها في بعض صلاحيات أمير المؤمنين، لا في دستور الجمهورية الخامسة الذي أضفى عليها فقط لبوسا عصريا، ذلك أن وظيفة الدستور ليست إلا تجديد العهد المقدس بين الملك وشعبه.[7]
كما ينطوي الفصل 19 على طابع تقليداني ملحوظ، لا يقتصر على لقب أمير المؤمنين، بقدر ما ينصرف إلى ألقاب أخرى، من قبيل “رمز”، و”حامي”، و”ضامن”، لما تتضمنه من إيحاءات سياسية ودينية ورمزية قوية. فإذا وقفنا على لفظ “الضمان” لوحده، فإنه ينطوي في السياق المغربي، على بعد رمزي – ديني مُعَبر، إذ يشير عبد اللطيف المنوني إلى أن “الضامن هو الذي يتوسط لدى الله أو قديس لإنقاذ شخص أو جماعة…”[8]
وبالرغم من عدم التنصيص الدستوري الصريح على سمو السيادة الملكية على التمثيل البرلماني، فإن اعتبار الملك رمزا لوحدة الأمة، يجعله يمثل أحياءها وأمواتها، ومن سيُخلقون من الرعايا، هذا في حين لا يمثل عضو البرلمان إلا دائرة انتخابية متغيرة[9]. وهكذا فإن مقتضى “الممثل الأسمى للأمة” يمكن اعتباره ابتكارا دستوريا للحد من الآثار المحتملة للمادة الثانية من الدستور، التي تؤكد على مبدأ السيادة الشعبية[10]. كما أن تنصيص الفصل 23 من الدستور على أن شخص الملك مقدس لا تُنتهك حرمته، ما هو إلا امتداد لشرفاوية وعصمة الإمام. أما الحكومة المنبثقة عنه دستوريا، فإن وزراءها، وحتى النواب البرلمانيين، ليسوا إلا مُعينين أو مساعدين، وفق تصور الماوردي لأمير المؤمنين.[11]
ومن الناحية العملية، برز توظيف الفصل 19، والحضور اللافت للمرجعية التقليدية في سياقات مختلفة، لعل أبرزها إعلان حالة الاستثناء (1965 – 1970) من طرف الملك الحسن الثاني، وهو ما نظر إليه بعض المراقبين كاستراتيجية دفاعية نهجتها المؤسسة الملكية ضد المعارضة العلمانية. هذا دون إغفال تجليات أخرى لتوظيف المرجعية الدينية في الحياة السياسية خلال تلك الفترة، من قبيل إحياء طقس التماس الشفاعة من أمير المؤمنين (طلب العفو والشفاعة من طرف أعيان مدينة مراكش عقب أحداث سنة 1984…).[12]
ج- قراءات فقهية في الدساتير الخمسة الأولى:
يميز محمد معتصم بين قراءات متباينة للدستور المغربي، أولاها ما يسميه ب “خطاب المركزية الأوروبية”، الذي يَعتبر الدستور المغربي قائما على مرجعية غربية خالصة، بوصفه مجرد استنساخ لدستور الجمهورية الخامسة بفرنسا، متجاهلا مصادره المغربية والعربية – الإسلامية[13]. فيما ينزع فريق آخر من الفقه الدستوري إلى القول بأن الدستور المغربي لا يعدو كونه قانونا خليفيا، متميز جوهريا عن القانون الدستوري الغربي، وسابق عليه، ومتصدر له في منظومة القانون الدستوري المغربي.[14]
أما خطاب الثنائية الذي يتبناه فريق من الفقه الدستوري، فهو يركز على المكونات الإسلامية للنظام الدستوري المغربي، مع البحث في صراعها أو تفاعلها مع تأثير المرجعية الغربية. وبرأي C. Palazzoli، فإن هذه الثنائية هي التي تميز النظام السياسي المغربي عن العالَم الثالث، من خلال عدم إحداث قطيعة مع الماضي المتصل بالحاضر، في شكل تقليد سلطاني، وأعراف بربرية، وتأثير غربي.[15]
كما يُورد عبد اللطيف أكنوش تمييزا بين الطابق العلوي الذي يتمتع بسيادة مطلقة، ويظل غير قابل للمراجعة الدستورية، وهو الذي يحيل إلى القانون الخلافي والموروث السياسي للمخزن السلطاني (إمارة المؤمنين، البيعة، الدين الإسلامي…)، والطابق السفلي بما هو مجموعة من القواعد والتقنيات القانونية المتصلة بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان، والذي لا يتمتع سوى بسيادة نسبية، وهو ما عبر عنه الملك الحسن الثاني: “إن مبدأ فصل السلط لا يكون إلا على مستوى البرلمان والحكومة. فهو في مرتبة دون الملك”.[16]
ويرى مصطفى السحيمي – كذلك – أنه لا يمكن وضع الحريات إلى جانب المَلَكية في كفة واحدة ضمن الكتلة الدستورية المتمتعة بالحُرمة والسمو. فالملكية والدين هما وحدهما يقعان في قمة الكتلة الدستورية، وتتلوهما الحريات، أيْ “الكتلة الديمقراطية” التي تكتسي أهميتها النسبية في المحافظة على الطابع الليبرالي للنظام. أما الكتلة الثالثة، فرغم سموها الدستوري المبدئي، فإنها غير مستقرة، وتضم البرلمان واختصاصاته وتشكيله وعلاقته بالحكومة، ناهيك بمسألة السلطة التنظيمية. أما خالد الناصري فقد ميز بين القانون الشكلي المُستَمَد من الدستورانية الغربية، الغير مُطَبق دائما بحذافيره، والقانون غير الشكلي السائد عمليا، والذي يتطور خارج الدستور المدون.[17]
المحور الثاني: دستور 2011 وسؤال المرجعيات
أ- سياق وظروف إعداد الدستور:
لقد جاء دستور 2011 تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس 2011، والذي أعلن من خلاله عن إطلاق “إصلاح دستوري شامل”. وتبعا لذلك، جرى تعيين لجنة من طرف الملك تَرَأسها الجامعي عبد اللطيف المنوني، كُلفت بوضع وتحرير مشروع الدستور، الذي اعتُمد بعد الموافقة عليه باستفتاء شعبي بتاريخ فاتح يوليو 2011. وقد نُظر إلى هذا الإصلاح الدستوري كاستباق لتداعيات موجة “الربيع العربي” على المغرب، في سياق مظاهرات حركة 20 فبراير التي رفعت جملة من المطالب الإصلاحية، لعل من أبرزها توسيع الحريات وإقامة ملكية برلمانية.[18]
وتأسيسا على ما سبق، فإنه بالرغم من عدم الاستجابة لمطلب حركة 20 فبراير، والتي نادت بخلق جمعية تأسيسية منتَخَبة لوضع الدستور، وهو ما ترجمه الاحتفاظ بتقنية الاستفتاء الشعبي، فإنه تم استبعاد أسلوب المنحة غير الديمقراطي الذي جرى اعتماده في الدساتير السابقة، من خلال تبني مقاربة تشاركية وتشاورية، عبر الانفتاح على مكونات المجتمعين المدني والسياسي على السواء.[19]
وعطفا على ذلك، فإن تركيبة اللجنة التي جرى تكليفها بوضع مشروع الدستور، تنم عن مدى الحرص على استحضار المرجعية الحديثة. فقد تألفت تلك اللجنة من 18 عضوا، أغلبهم أساتذة جامعيين مختصين في القانون العام، ناهيك بشخصيات حقوقية تتمتع بصلات قوية في أوساط المنظمات الدولية، مثل عمر عزيمان، وإدريس اليزمي، وأمينة بوعياش. وفي المقابل، يلاحَظ غياب الشخصيات الدينية عن تركيبة اللجنة ما خلا رجاء مكاوي عضو المجلس العلمي الأعلى، والتي تُعد أول امرأة تُلقي درسا دينيا أمام الملك في العام 2003.[20]
ب- مظاهر حضور المرجعية الحديثة في دستور 2011:
يرى محمد ضريف بأن الدساتير الخمسة الأولى ابتداءً من دستور 1962، وانتهاءً بدستور 1996، والتي أطرت ما يمكن تسميته ب “الملكية الأولى”، قد امتازت بتغليب المرجعية التقليدية على المرجعية الحديثة، في حين أن دستور 2011 الذي يؤطر تجربة الملكية الثانية، يتسم بتغليب المرجعية الحديثة.[21]
ويتمثل المظهر الأول، بحسب ضريف، في إسناد دستور 2011 مشروعية التمثيل الديمقراطي للبرلمان. فبعد أن كانت الدساتير السابقة على دستور 2011، باستثناء دستور 1962، تؤسس لصنفين من التمثيلية: تمثيلية دنيا تعود لممثلي الأمة في البرلمان، وتمثيلية عليا تستند إلى المشروعية الدينية والتاريخية للملك، من خلال الفصل 19 الذي يَعتبره ممثلا أسمى للأمة، فإن دستور 2011 حذف هذا المقتضى الأخير. هذا بالإضافة إلى التكريس الدستوري للملكية المواطنة، من طريق التخلي عن اعتبار الملك شخصا مقدسا، كما ورد في الفصل 23 من الدساتير السابقة، فقد نُقل عن الملك قوله بأن “القداسة لله وأنه مجرد مواطن”.
كما يحيل ضريف إلى مظهر آخر، ألا وهو تحويل القضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، خلافا للدساتير الخمسة المؤطرة للملكية الأولى، التي كانت تُدرج القضاء ضمن وظائف إمارة المؤمنين، وهو ما كان يشدد عليه الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس قبل اعتماد دستور 2011. إذ قطع الأخير مع التصور التقليدي للفصل بين السلطات عند جون لوك، الذي لم يكن يعتبر القضاء سلطة مستقلة، بقدر ما كان يُدرجه ضمن سلطة التاج أو الملك، على عكس التصور الحديث لمونتيسكيو حول الفصل بين السلطات، والذي عبر عنه الدستور المغربي الحالي.[22]
وإلى جانب ذلك، يمكن رصد مؤشرات قوية لحضور المرجعية الحديثة في تصدير الدستور، وفي البابين الأول والثاني منه مثل: الفردانية، الحرية، الديمقراطية، سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية… إلخ.[23] كما قطع دستور 2011 مع التصور اليعقوبي الكلاسيكي للدولة، ذلك أن التوجه الحديث لوظيفة الدولة يحيل إلى استيعابها لكل المواطنين، وهو ما كرسه هذا الدستور من خلال تفصيله للهوية المغربية بمختلف مكوناتها وروافدها، وعدم الاكتفاء بالمكون العربي الإسلامي.[24]
ومن جهة أخرى، يُعد تمييز دستور 2011 بين الأدوار الدينية، والأدوار السياسية للملك، تكريسا للمرجعية الحديثة، من خلال الاعتراف بوجود فضاءين: سياسي، وديني، لكل منهما فاعلوه وقواعده[25]. هذا على عكس الدساتير السابقة التي لم تكن تفصل بين صفة الملك كأمير للمؤمنين، وصفته كرئيس للدولة، من خلال الفصل 19 الذي كان يعد “دستورا داخل الدستور”، وهو ما وجد طريقه إلى الممارسة العملية، حين خاطب الملك الحسن الثاني أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي سنة 1981 – عقب الإعلان عن عزمهم الانسحاب من البرلمان – بوصفه أميرا للمؤمنين، واعتَبَر خروجهم من البرلمان بمنزلة خروج عن “الجماعة”.[26]
وإضافة إلى ما سبق، فإن من بين مظاهر حضور المرجعية الحديثة – فيما يتعلق بالسلطة التأسيسية الفرعية المكلفة بمراجعة وتعديل الدستور- توسيع المواد غير القابلة للمراجعة الدستورية، لتشمل، إضافة إلى النظام الملكي للدولة، والدين الإسلامي المنصوص عليهما في الدستور السابق، الأحكام المتعلقة بالاختيار الديمقراطي للأمة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.[27]
ج- إرث التقليدانية في دستور 2011:
بالرغم من الحضور البارز للمرجعية الحديثة في دستور 2011، فإنه لا تخفى – في المقابل – مظاهر الاستمرارية ذات الصلة بالمرجعية التقليدية، وفي مقدمتها إسناد دستور 2011 للمؤسسة الملكية مهاما استراتيجية كأعلى سلطة دينية في البلد، من خلال التنصيص على إمارة المؤمنين في فصله الحادي والأربعين، وهو ما عوض جانبا أساسيا من مقتضيات الفصل 19 في الدساتير السابقة. هذا ناهيك بدسترة المجلس العلمي الأعلى، بما يدل عليه ذلك من الاعتراف بالعلماء كمكون حيوي من مكونات المجتمع المغربي، دون إغفال دسترة حضور العلماء ضمن تركيبة مجموعة من المؤسسات الدستورية، مثل المحكمة الدستورية، ومجلس الوصاية.[28]
وفضلا عن ذلك، يُطرح تساؤل بخصوص حدود الفصل بين صفة الملك كأمير للمؤمنين، وصفته كرئيس للدولة. إذ ذهب بعض الباحثين إلى أن الفصل 19 من الدساتير السابقة لم يتم إلغاء مضمونه، بقدر ما جرى تقسيمه إلى فصلَيْن. فالمفاهيم التي ينطوي عليها الفصل 41، وكذلك الفصل 42 من دستور 2011، حمالة معان، إذ يكفي الوقوف عند عبارات من قبيل: الممثل الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، لينفتح المجال على كل تأويل.[29]
ويجادل بعض الباحثين بأن مبدأ فصل السلط الذي نص عليه دستور 2011 تَحده بعض الحدود. فعلى سبيل المثال، يمكن للملك أن يخترق مجال التشريع من خلال الخُطَب الملكية، وأهمها الخطاب الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان، وهو ما ينطوي على فكرة الإيحاء التشريعي، أيْ الإيحاء للبرلمان بالتشريع في مجال ما. ويسري ذلك أيضا على المهام التشريعية للسلطة التنفيذية (مجال التنظيم)، بما أنها تكون حاضرة في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.[30]
وعطفا على ذلك، يُعد التراجع عن دسترة حرية الضمير والمعتقد، مؤشرا على ثقل حضور المرجعية التقليدية. فوفق شهادات من أعضاء في اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، فإن الصيغة الأولية من مشروع الدستور كانت تنص على “حرية الضمير”، كبديل عن مقتضى “حرية العبادة” الذي تضمنته الدساتير السابقة. وقد كان من شأن إقرار ذلك المقتضى أن يعطي مساحة أوسع لممارسة الحريات الفردية، والاعتراف بشرعية وجود اتجاهات فلسفية وروحية مختلفة لا تقتصر على أتباع الديانات السماوية، لولا أن ذلك المستجد الدستوري جرى التراجع عنه في الصيغة النهائية للمشروع تحت ضغط القوى المحافظة.[31]
وكما يرى سعيد خمري، فإننا قد نجد أحيانا مقتضى دستوريا واحدا يجيب على تطلعات تيارين اجتماعيين متناقضين، كما هو حال الفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير الدستور، التي نصت على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، لكنها ترهن هذا السمو بأن تكون الاتفاقيات في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة. فبالنسبة إلى الحقوقيين والحداثيين، فهم يتمسكون بمسألة السمو من حيث المبدأ، وبالنسبة إلى ذوي المرجعية المحافظة، فإن شرط الالتزام ب “الهوية الوطنية الراسخة”، يُعتبر صمام أمان لهم من كل اجتياح محتمل لعالَمية حقوق الإنسان على الخصوصية المغربية.[32]
خلاصة:
لقد عرجت الدراسة، إذًا، على مختلف الدساتير التي عرفها المغرب، ابتداء من دستور 1962، وانتهاء بدستور 2011، الذي أفرد حيزا واسعا لمقتضيات تنهل من المرجعية الحديثة، دون أن يقطع مع الثوابت الدينية والتاريخية التي تندرج في خانة التقليد. ومن هنا، يمكن أن نخلص إلى استمرار العلاقة الجدلية والتلازمية بين المرجعيتين التقليدية والحديثة، لاعتبارات تتعلق بمصادر مشروعية نظام الحكم، وثقل الإرث التاريخي لبلاد المخزن، الممزوج بتأثير تجربة التحديث السياسي الأوروبية، وانعكاساتها على الحقل السياسي المغربي، التي تمتد بجذورها إلى عهد الحماية الفرنسية. ومن زاوية سوسيولوجية، يمكن النظر إلى العلاقة الجدلية بين المرجعيتين التقليدية والحديثة، كامتداد للطابع المركب للمجتمع المغربي، الحائر بين تبني قيم الحداثة والتمسك بالتقليد.
1 Boujrada, K, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en science politique, Université du Québec à Montréal, 2008, p: 8.
2 زين الدين، محمد، “الأنظمة السياسية المقارنة”، الطبعة الأولى، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2018، ص: 129.
3 Boujrada, K, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, op. cit, p: 12.
4 العروي، عبد الله، “من ديوان السياسة”، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2010، ص: 117- 118.
7 معتصم، محمد، “النظام السياسي الدستوري المغربي”، الطبعة الأولى، الدار البيضاء: مؤسسة إيزيس للنشر، 1992، ص: 32.
10 Boujrada, K, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, op. cit, p: 10.
11 معتصم، محمد، “النظام السياسي الدستوري المغربي”، مرجع سابق، ص: 77.
12 El ayadi, Bourquia et Darif, Etat monarchie et religion, les cahiers bleus, (3), 2005, p: 16- 17- 18.
13 معتصم، محمد، “النظام السياسي الدستوري المغربي”، مرجع سابق، ص: 15.
16 أكنوش، عبد اللطيف، “السلطة والمؤسسات السياسية في مغرب الأمس واليوم”، الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، 1988، ص: 172.
17 معتصم، محمد، “النظام السياسي الدستوري المغربي”، مرجع سابق، ص: 81.
18 Tourabi, A, Réforme constitutionnelle au Maroc: une évolution au temps des révolutions, Arab Reform Initiative, 2011, p: 1.
19 زين الدين، محمد، الأنظمة السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص: 176.
20 Tourabi, A, Réforme constitutionnelle au Maroc: une évolution au temps des révolutions, op. cit, p: 4.
11 ضريف، محمد، “الأنظمة الدستورية”، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ص: 18 – 19.
23 غوردو، عبد العزيز، “إمارة المؤمنين: التاريخ السياسي والثقافة الدستورية”، دار ناشري للنشر الإلكتروني، 2016، ص: 104 – 105.
24 زين الدين، محمد، الأنظمة السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص: 182.
25 خمري، سعيد، الملكية الدستورية بالمغرب: مسير البناء الديمقراطي (1956-2020)، منشورات المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، ص: 203.
26 ضريف، محمد، “الأنظمة الدستورية”، مرجع سابق، ص: 20.
27 خمري، سعيد، الملكية الدستورية بالمغرب: مسير البناء الديمقراطي (1956-2020)، مرجع سابق، ص: 208.
28 زين الدين، محمد، الأنظمة السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص: 198 – 199 – 200.
29 غوردو، عبد العزيز، “إمارة المؤمنين: التاريخ السياسي والثقافة الدستورية”، مرجع سابق، ص: 103
31 Tourabi, A, Réforme constitutionnelle au Maroc: une évolution au temps des révolutions, op. cit, p: 12.
32 خمري، سعيد، الملكية الدستورية بالمغرب: مسير البناء الديمقراطي (1956-2020)، مرجع سابق، ص: 190.




