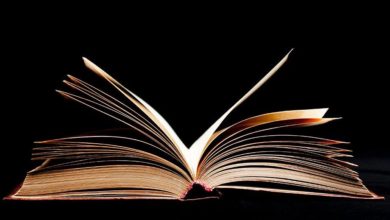نظرية الحروب الدولية الجديدة بوصفها نظرية مدى متوسط: اشتباك “ميرتوني” لفهم “فوضى” أيامنا الخانقة وظروفنا العسيرة

اعداد : محمد مكي الطاهر – المركز الديمقراطي العربي
مستخلص :
في حقل دراسات الصراع والعلاقات الدولية، الذي يشهد تحولات متسارعة وتحديات مفاهيمية عميقة، يصبح تحديد الموقع المنهجي للنظريات الجديدة أمراً حيوياً لتقييم مساهمتها وقوتها التفسيرية. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل مقدر لـ “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) بوصفها نظرية مدى متوسط (Middle-Range Theory) بالمعنى الذي أسس له عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ك. ميرتون. ينطلق المقال من إشكالية الاستقطاب التاريخي في العلوم الاجتماعية بين “النظريات الكبرى” المجردة و”التجريبية” الوصفية، ويُظهر كيف أن نظريات المدى المتوسط تقدم جسراً منهجياً ضرورياً للتقدم العلمي التراكمي. من خلال تحليل بنيوي لـ NIWT وفرضياتها الست، يُبرهن المقال على أنها تمتلك جميع الخصائص الجوهرية لنظرية المدى المتوسط: فهي تركز على فئة محددة من الظواهر (الحروب المعاصرة في عصر ما بعد الحرب الباردة)، وتقدم فرضيات سببية قابلة للاختبار، وتعمل كجسر بين الملاحظة التجريبية والتعميم النظري. علاوة على ذلك، يقارن المقال بين NIWT ونظريات أخرى في نفس المستوى (مثل نظرية “الحروب الجديدة” للأكاديمية البريطانية ماري هنريتا كالدور)، ليُظهر كيف أن NIWT تقدم نموذجاً تفسيرياً أكثر تكاملاً وعمقاً من خلال ربطها الواعي بالبنى التاريخية والاقتصادية الأوسع، دون أن تفقد صرامتها كنظرية مدى متوسط. ويخلص المقال إلى أن فهم NIWT كنظرية مدى متوسط نقدية لا يحدد موقعها فحسب، بل يكشف عن مصدر قوتها في تفسير تعقيدات الصراع في أيامنا.
مقدمة: أزمة التفسير والحاجة إلى جسر منهجي
أزمة التفسير في حقل دراسات الصراع
يشهد عالمنا المعاصر أنماطاً من الصراع المسلح تتحدى بشكل متزايد الأطر التفسيرية التي ورثناها عن القرن العشرين. فالحروب في السودان، وسوريا، وليبيا، واليمن، وغيرها، ليست مجرد حروب أهلية تقليدية، وليست حروباً بين الدول بالمعنى الكلاسيكي. إنها ظواهر هجينة ومعقدة، تتداخل فيها المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويبرز فيها دور الفاعلين من غير الدول (Byman & Pollack, 2001)، وتُغذى باقتصاديات حرب عابرة للحدود، وتُشن فيها معارك على الوعي والمعلومات لا تقل ضراوة عن المعارك على الأرض، وهو ما يُعرف بالاستراتيجيات الهجينة في هذه الحروب، التي تُستخدم فيها أدوات مثل التضليل الإعلامي (Mumford, 2013). هذا الواقع الجديد خلق “أزمة تفسير” حقيقية في حقل دراسات الصراع. في قلب هذه الأزمة، تكمن إشكالية منهجية أعمق، طالما أرّقت العلوم الاجتماعية: وهي الفجوة الهائلة بين النظريات الكبرى الشاملة (Grand Theories) التي تسعى لتفسير كل شيء ولكنها تظل مجردة وبعيدة عن الواقع التجريبي، وبين الدراسات التجريبية الوصفية (Abstracted Empiricism) التي تغرق في تفاصيل حالة معينة دون أن تساهم في بناء معرفة نظرية تراكمية. هذا الاستقطاب، الذي حذر منه عالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون قبل أكثر من سبعين عاماً، لا يزال يمثل العائق الأكبر أمام تطور فهمنا العلمي للظواهر الاجتماعية المعقدة كالحرب (Merton, 1968).
الحجة المركزية للمقالة
من هذا المنطلق، تأتي هذه المقالة لتقدم حجة مركزية: إن “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT)، التي تم تطويرها من قبل الباحث كإطار شامل لفهم صراعات عصرنا، يجب أن تُفهم وتُقيّم في المقام الأول بوصفها نظرية مدى متوسط (Middle-Range Theory). إن تحديد هذا الموقع المنهجي ليس مجرد تمرين أكاديمي في التصنيف، بل هو مفتاح لفهم مصدر قوة النظرية، ونطاق صلاحيتها، وطبيعة مساهمتها الفكرية. إنها ليست “نظرية كبرى” جديدة تسعى لتفسير النظام العالمي بأكمله، بل إطار تحليلي متواضع في نطاقه ولكنه صارم في منهجه. إن فهمها يتطلب وضعها في سياق الحوارات النظرية المعاصرة في حقل العلاقات الدولية، والتي شهدت تحولاً من التركيز على النظريات الكبرى إلى الاهتمام بالنماذج التي تجمع بين التحليل النقدي للواقع والبنى الكبرى (Katzenstein & Sil, 2008). NIWT تمثل هذا التوجه بوعيها النقدي بالبنى الكبرى للعولمة والتبعية دون أن تسقط في فخ التجريد المفرط.
أهداف المقال
يهدف هذا المقال إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- إعادة استكشاف مشروع ميرتون المنهجي: مراجعة مقدرة لمفهوم “نظرية المدى المتوسط” ليس كتعريف جامد، بل كمشروع فكري يهدف إلى بناء جسر بين النظرية والواقع، وتشجيع التراكم العلمي.
- تحليل NIWT من منظور المدى المتوسط: تفكيك بنية “نظرية الحروب الدولية الجديدة” وفرضياتها الست لإظهار كيف أنها تجسد، في تصميمها، جميع الخصائص الأساسية لنظرية المدى المتوسط.
- إثبات التفوق التفسيري ضمن مستواها: البرهنة على أن NIWT، كنظرية مدى متوسط، تقدم نموذجاً تفسيرياً أكثر قوة وتكاملاً من النظريات المنافسة لها في نفس المستوى، وذلك لقدرتها الفريدة على الربط بين الآليات السببية الملموسة والبنى التاريخية الأوسع.
الفصل الأول: مشروع روبرت ك. ميرتون المنهجي: ما وراء الاستقطاب العقيم
التشخيص: شلل النظرية بين التجريد المطلق والتجريبية العمياء
قبل أن نتمكن من تقييم NIWT كنظرية مدى متوسط، من الضروري أن نفهم بعمق ماذا كان يعني روبرت ك. ميرتون بهذا المفهوم. لم تكن دعوته مجرد اقتراح تقني، بل كانت ثورة منهجية تهدف إلى إنقاذ علم الاجتماع من مسارين كانا يقودانه إلى طريق مسدود (Merton, 1968).
- قطب “النظريات الكبرى الشاملة”: تمثل هذا القطب في أعمال منظّرين مثل تالكوت بارسونز، الذين حاولوا بناء أنظمة مفاهيمية ضخمة قادرة على تفسير البنية الاجتماعية بأكملها. ورغم عمقها الفلسفي، كانت هذه النظريات، في نظر ميرتون، “عقيمة” من الناحية العلمية. كانت مشكلتها الأساسية هي انفصالها عن الواقع التجريبي، حيث لا يمكن للباحث أن يأخذ نظرية بارسونز ويشتق منها فرضية واضحة ومحددة ليختبرها في الميدان (Hedström & Udehn, 2009).
- قطب “التجريبية المجردة”: على الطرف الآخر، كان هناك هوس متزايد بالتقنيات الإحصائية وجمع البيانات. كانت مشكلة هذا التيار، كما رآها ميرتون، هي غياب النظرية. كانت البيانات تُجمع وتُعرض دون إطار نظري يفسرها أو يربطها بظواهر أخرى، لتصبح مجرد “وصف” للواقع، لا “تفسير” له (Merton, 1968).
تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين روبرت ك. ميرتون (1910-2003)، عالم الاجتماع وفيلسوف العلوم الاجتماعية الذي طور نظرية المدى المتوسط، وبين روبرت سي. ميرتون (مواليد 1944)، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والذي ركزت أبحاثه على النماذج الرياضية للتحليل المالي وإدارة المخاطر. هذا التوضيح يعزز دقة تحليلنا هنا ويمنع الخلط بين المساهمتين.
العلاج: وصفة “نظريات المدى المتوسط”
كانت وصفة ميرتون العلاجية هي التركيز على بناء وتطوير “نظريات المدى المتوسط”. هذه النظريات، هي نظريات متواضعة في طموحها ولكنها صارمة في منهجها. هي لا تحاول تفسير “المجتمع” ككل، بل تفسر “ظواهر اجتماعية محددة” يمكن دراستها. تمتلك هذه النظريات ثلاث فضائل أساسية تجعلها محرك التقدم العلمي:
- التحديد (Specificity): هي واضحة ومحددة في نطاقها، مما يجعلها قابلة للتطبيق (Merton, 1968).
- القابلية للاختبار (Testability): يمكن ترجمتها إلى فرضيات يمكن للباحثين اختبارها باستخدام بيانات حقيقية (Popper, 2002).
- التراكمية (Cumulativeness): يمكن للنتائج التجريبية أن تؤكد النظرية، أو تدحضها، أو تعدلها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي حقيقي (Merton, 1968).
أمثلة كلاسيكية في علم الاجتماع
لإيضاح المفهوم، قدم ميرتون أمثلة كلاسيكية لنظريات المدى المتوسط. نظرية الانحراف لديه، على سبيل المثال، لا تفسر كل السلوك البشري، بل تفسر فقط لماذا قد يلجأ الأفراد إلى سلوك منحرف عندما يكون هناك فجوة بين الأهداف الثقافية المقبولة (مثل الثراء) والوسائل المشروعة المتاحة لتحقيقها (Merton, 1938). كما أن نظرية الجماعات المرجعية تفسر كيف أن سلوكنا يتأثر ليس فقط بالجماعات التي ننتمي إليها، بل أيضاً بالجماعات التي نطمح للانتماء إليها (Merton & Rossi, 1950). هذه النظريات تركز على آليات محددة داخل البنى الاجتماعية وتعتمد على ملاحظات يمكن التحقق منها.
إن مشروع ميرتون كان دعوة للباحثين للتخلي عن الطموحات الفلسفية الكبرى والتركيز على العمل المنهجي الصبور لبناء معرفة علمية حقيقية، لبنة فوق لبنة. إن هذه النظريات ليست غايات نهائية، بل هي “برنامج بحثي” يوفر إطاراً يجمع بين الفرضيات الجزئية لظاهرة معينة ويوجه البحث المستقبلي، تماماً كما أن نظرية الجراثيم للأمراض أو نظرية الغازات الحركية ليست تفسيراً لكل شيء (Merton, 1968). علاوة على ذلك، تتميز نظريات المدى المتوسط بقدرتها على العمل كجسر بين مستويات التحليل المختلفة، وخاصة بين التحليل الجزئي (Micro) والتحليل الكلي (Macro). على سبيل المثال، تربط نظرية الانحراف السلوك الفردي (الجزئي) بالبنية الاجتماعية الكبرى (الكلي) (Vold et al., 2002). هذا الترابط هو ما يمنحها القدرة على تقديم فهم عميق وشامل دون الوقوع في فخ التجريد. إن نظرية NIWT، كما سيتبين لاحقاً، تقوم بعمل مشابه من خلال ربطها للديناميكيات المحلية للصراع بالبنى الأوسع للعولمة والنظام الدولي.
الفصل الثاني: تحليل بنية “نظرية الحروب الدولية الجديدة” من منظور المدى المتوسط
الآن، وبعد أن وضعنا الأساس المنهجي لمشروع ميرتون، يمكننا أن نطبق هذه العدسة التحليلية على “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) لنرى ما إذا كانت تتوافق مع خصائص نظرية المدى المتوسط. إن التحليل الدقيق لبنية NIWT يُظهر أنها ليست فقط تتوافق مع هذه الخصائص، بل هي تجسيد مثالي لها في حقل دراسات الصراع.
تحديد النطاق: التركيز على فئة محددة من الظواهر
أول وأهم خاصية لنظرية المدى المتوسط هي أنها لا تدعي تفسير كل شيء. NIWT تلتزم بهذا المبدأ بصرامة. هدفها ليس تفسير “الحرب” بشكل عام، ولا “كل” الصراعات في التاريخ. نطاقها محدد بوضوح: تفسير فئة معينة من الصراعات المسلحة التي أصبحت سائدة في حقبة ما بعد الحرب الباردة. هي نفسها تطلق على هذه الفئة اسم “الحروب الدولية الجديدة”، وتحدد خصائصها كظواهر تتسم بضعف الدولة، وتأثير العولمة، ودور الفاعلين من غير الدول، والاعتماد على اقتصاديات حرب عابرة للحدود. هذا التحديد الدقيق للنطاق هو ما يمنح NIWT قوتها التحليلية.
القابلية للاختبار: الفرضيات الست كآليات سببية
الخاصية الثانية لنظرية المدى المتوسط هي قدرتها على توليد فرضيات قابلة للاختبار. NIWT مصممة بالكامل لتحقيق هذا الهدف (Popper, 2002). المفاهيم المركزية (ضعف الدولة، العولمة، إلخ) ليست مجرد أوصاف، بل هي متغيرات تحليلية يمكن قياسها وملاحظة العلاقة بينها.
الفرضيات الست المترابطة لـ NIWT هي جوهر النظرية (الطاهر، 2025أ). كل فرضية هي ادعاء سببي واضح يربط بين متغيرين أو أكثر:
- ضعف الدولة كنقطة انطلاق: كلما زاد ضعف الدولة، زادت احتمالية نشأة وتمدد NIW.
- العولمة كعامل تمكين: العولمة تسهل حركة الفاعلين، الأفكار، السلاح، والتمويل، مما يمكن ويغذي NIW.
- تآكل السيادة كشرط للتوسع: تآكل السيادة يسهل التدخلات الخارجية ويؤدي إلى تدويل الصراع.
- مركزية الفاعلين من غير الدول: صعود الفاعلين من غير الدول وارتباطهم الشبكي يعقد ويديم NIW.
- الاستراتيجيات الهجينة كنمط سائد: استخدام الاستراتيجيات الهجينة هو النمط السائد للقتال في NIW، مما يزيد من صعوبة حسم الصراع.
- اقتصاديات الحرب كعامل استدامة: اقتصاديات الحرب العابرة للحدود توفر التمويل وتخلق مصالح في استمرارية الصراع.
إن بنية NIWT القائمة على هذه الفرضيات السببية الواضحة تجعلها نظرية علمية بالمعنى الدقيق، قابلة للتأكيد أو التعديل أو حتى الدحض بناءً على الأدلة التجريبية. هذه القابلية للتزييف هي ما يميزها منهجياً عن النظريات الكبرى التي لا يمكن إثبات خطئها (Merton, 1968).
الجسر بين الواقع والنظرية: العلاقة الجدلية
NIWT تجسد العلاقة الجدلية التي دعا إليها ميرتون بين النظرية والبحث. لم تنشأ النظرية من تأمل فلسفي مجرد، بل من ملاحظات تجريبية لواقع الصراعات في السودان وسوريا وليبيا وغيرها. هي محاولة لتنظير وفهم هذه الظواهر الملموسة. بعد صياغة مفاهيمها وفرضياتها، تعود NIWT لتوجيه البحث التجريبي. فهي تقدم للباحثين “خريطة طريق” لما يجب أن يبحثوا عنه عند تحليل صراع معاصر (Gerring, 2007). بهذه الطريقة، تعمل NIWT كجسر حقيقي بين الفوضى الظاهرية للأحداث على الأرض وبين الحاجة إلى تفسير نظري منظم.
الطموح التراكمي: NIWT كبرنامج بحثي
أخيراً، NIWT ليست نظرية مغلقة أو نهائية، بل تفتح الباب أمام التراكم المعرفي. يمكن للباحثين أخذ فرضياتها واختبارها في حالات دراسية جديدة (مثل صراعات منطقة الساحل الأفريقي). كما يمكن للأبحاث المستقبلية أن تطور وتعمق مفاهيم NIWT، مثل “اقتصاديات الحرب”، أو أن تتكامل مع نظريات مدى متوسط أخرى لفهم أعمق لجوانب محددة من الصراع، مثل دور الإعلام في حروب المعلومات (الطاهر، 2025ب). بهذا المعنى، فإن NIWT ليست نهاية المطاف، بل هي بداية برنامج بحثي (Research Program) واسع وطموح، تماماً كما أراد ميرتون لنظريات المدى المتوسط أن تكون (Merton, 1968). إن هذا المنهج يتناسب تماماً مع المناخ الفكري لما بعد الوضعية الذي ساد في دراسات العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة (Wæver, 1996)، والذي شكك في قدرة النظريات الشاملة على فهم تعقيد الواقع، وبحث عن أطر أكثر مرونة وقابلة للتطوير.
الجدول التالي يلخص كيف تجسد NIWT الخصائص المنهجية الميرتونية:
| الخاصية الميرتونية | تجسيدها في نظرية الحروب الدولية الجديدة (NIWT) |
| التحديد (Specificity) | لا تدعي تفسير “الحرب” بشكل عام، بل تركز على فئة محددة من الصراعات التي ظهرت بعد الحرب الباردة، والتي تتميز بخصائص معينة (ضعف الدولة، العولمة، فاعلون من غير الدول). |
| القابلية للاختبار (Testability) | تقوم على ست فرضيات سببية مترابطة قابلة للتحقق تجريبياً. فمثلاً، يمكن اختبار العلاقة بين ضعف الدولة واندلاع الصراع. |
| التراكمية (Cumulativeness) | تعمل كبرنامج بحثي مفتوح، يمكن تطبيق فرضياته على حالات جديدة (مثل صراعات الساحل) وتطوير مفاهيمه عبر أبحاث مستقبلية. |
الفصل الثالث: موقع NIWT التنافسي: مقارنة مع نظريات المدى المتوسط الأخرى
لكي نثبت قوة NIWT كنظرية مدى متوسط، لا يكفي أن نُظهر أنها تمتلك الخصائص المطلوبة. يجب أيضاً أن نُظهر كيف أنها تقدم مساهمة فريدة ومتفوقة مقارنة بالنظريات الأخرى التي تعمل في نفس المستوى التحليلي. المنافس الرئيسي هنا هو نظرية “الحروب الجديدة” لماري كالدور.
نظرية “الحروب الجديدة” لكالدور: مساهمة ونقد
تُعد نظرية كالدور، التي ظهرت في أواخر التسعينيات، مثالاً مهماً على نظرية مدى متوسط حاولت تفسير صراعات ما بعد الحرب الباردة. لقد نجحت في تحديد خصائص مهمة لهذه الصراعات، مثل: التركيز على سياسات الهوية، استهداف المدنيين، دور اقتصاديات الحرب غير المشروعة، وتآكل احتكار الدولة للعنف (Kaldor, 2012). ومع ذلك، واجهت نظرية كالدور انتقادات منهجية وجوهرية أضعفت من قوتها التفسيرية. أولاً، وُجّه لها نقد بأن خصائص “الحروب الجديدة” ليست جديدة من الناحية التاريخية، حيث كانت موجودة في صراعات سابقة (Kalyvas, 2001). وثانياً، واجهت كالدور نقداً لخلطها بين “طبيعة” الحرب و”طابعها”. فطبيعة الحرب، بحسب كلاوزفيتز، ثابتة (العنف، الاحتمالية، والهدف العقلاني)، بينما يتغير طابعها بمرور الزمن (الجهات الفاعلة، الأهداف، الوسائل) (Malešević, 2010). وفي محاولتها للرد على هذه الانتقادات التجريبية، قامت كالدور بالتحول من اعتبار نظريتها وصفاً للواقع إلى اعتبارها “نموذجاً مثالياً” (Ideal Type) (Kaldor, 2013)، وهو ما يضعف من قدرتها على أن تكون نظرية علمية قابلة للاختبار التجريبي (Newman, 2004).
التفوق التفسيري لـ NIWT: من الوصف إلى التفسير المتكامل
على الرغم من أهمية نظرية كالدور، إلا أن NIWT تتجاوزها في عدة نقاط جوهرية، مما يجعلها نظرية مدى متوسط أكثر قوة وتكاملاً. إن هذا التفوق لا يقتصر على المنافسة، بل يمثل خطوة منهجية في عملية البناء التراكمي للمعرفة، حيث تأخذ NIWT أفضل ما في النظريات السابقة (كالدور) وتدمجه في إطار أكثر تماسكاً ووعياً.
- أ. التكامل الدولي مقابل التركيز الداخلي:
تميل نظرية كالدور إلى التركيز بشكل كبير على الديناميكيات الداخلية للصراع. في المقابل، تضع NIWT “التفاعل بين الداخلي والخارجي” في قلب تحليلها (الطاهر، 2025أ). NIWT ترى أن “الحرب بالوكالة” و”التدخل الخارجي” ليسا مجرد عوامل إضافية، بل هما آليات سببية أساسية تشكل طبيعة الصراع وتديمه. - ب. الصرامة السببية مقابل الوصف:
تقدم كالدور وصفاً غنياً لخصائص الحروب الجديدة، لكنها أقل وضوحاً في تحديد الآليات السببية الدقيقة التي تربط بين هذه الخصائص. NIWT، من خلال فرضياتها الست المترابطة، تقدم نموذجاً سببياً أكثر تماسكاً. هي لا تقول فقط “هناك ضعف في الدولة وهناك فاعلون من غير الدول”، بل تشرح كيف أن ضعف الدولة يخلق الفراغ الذي يمكن للفاعلين من غير الدول أن يملأوه، وكيف أن العولمة تسهل هذه العملية. - ج. العمق النقدي مقابل التفسير الليبرالي:
وهذا هو نقطة التفوق الأهم. بينما يمكن وصف نظرية كالدور بأنها “ليبرالية” في جوهرها، حيث تركز على “فشل الحوكمة” و”الجريمة”، فإن NIWT هي نظرية مدى متوسط “نقدية”. هي تفهم أن “ضعف الدولة” ليس مجرد سوء إدارة، بل قد يكون نتيجة لعلاقات هيمنة تاريخية وبنى عالمية. وتفهم أن “اقتصاديات الحرب” ليست مجرد جريمة، بل هي مرتبطة بشبكات رأس المال العالمي، وهذا ما يمنحها قدرة تفسيرية تتجاوز مجرد وصف الأعراض لتصل إلى تشخيص الجذور البنيوية.
| محور المقارنة | نظرية “الحروب الجديدة” لماري كالدور | نظرية الحروب الدولية الجديدة (NIWT) |
| طبيعة النظرية | نموذج مثالي (Ideal Type) | إطار سببي قابل للاختبار |
| نطاق التركيز | الديناميكيات الداخلية للصراعات (الجشع، المظالم، الهوية) (Kaldor, 2012) | التفاعل بين الديناميكيات الداخلية والبنى الدولية (الطاهر، 2025أ) |
| الآليات السببية | أقل وضوحاً، تركز على الوصف أكثر من التفسير | نموذج سببي متماسك يربط بين المتغيرات بوضوح |
| العلاقة بالبعد الدولي | تعتبر التدخل الخارجي عاملاً مُضافاً أو مُعقِّداً (Kaldor, 2012) | تعتبر التدخل الخارجي (الحرب بالوكالة) آلية سببية أساسية |
| العمق النقدي | تفسير ليبرالي يركز على “فشل الحوكمة” و”الجريمة” | تفسير نقدي يربط الصراعات ببنى الهيمنة والتبعية التاريخية |
الفصل الرابع: تطبيق النظرية: البرهان العملي من قلب الصراعات
إن قوة أي نظرية لا تكمن في تماسكها المنطقي فحسب، بل في قدرتها على تفسير وفهم الظواهر المعقدة في العالم الحقيقي. هذا الفصل هو المحك التجريبي لـ “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT)، حيث ننتقل من التجريد النظري إلى التطبيق العملي. سنقوم هنا بتطبيق الفرضيات الست لـ NIWT بشكل منهجي على دراسات الحالة الرئيسية (السودان، اليمن، سوريا، ليبيا، ومنطقة الساحل)، لنُظهر كيف أن هذه الفرضيات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتفاعل لتشكل شبكة سببية متكاملة تفسر نشأة واستدامة هذه الحروب.
حالة السودان: التشريح الكامل لـ “حرب دولية جديدة”
تعتبر الحرب في السودان التي اندلعت في أبريل 2023 مثالاً تطبيقياً مثالياً وكاملاً لـ NIWT، حيث تتجلى فيها جميع الفرضيات الست بوضوح صارخ.
- الفرضية 1 (ضعف الدولة): لم تكن الحرب مجرد صراع مفاجئ، بل هي نتيجة حتمية لسنوات من ضعف الدولة البنيوي. تمثل هذا الضعف في فشل الفترة الانتقالية في بناء مؤسسات قوية ودامجة، وتفكك احتكار الدولة للعنف مع صعود “الدعم السريع” كجيش موازٍ، وتدهور اقتصادي حاد (مجلة الدراسات الأفريقية، 2023). هذا الفراغ الأمني والسياسي هو الذي سمح باندلاع الصراع بهذا الشكل المدمر (الطاهر، 2023).
- الفرضية 2 (العولمة كعامل تمكين): لعبت العولمة دوراً حاسماً في تغذية الصراع. تم تجنيد مقاتلين من دول مجاورة، وتدفق السلاح المتطور عبر شبكات عابرة للحدود، واستُخدمت منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف في “الحرب على العقول” لنشر السرديات الزائفة وتشويه الحقائق (الطاهر، 2025ب).
- الفرضية 3 (تآكل السيادة): تآكلت سيادة السودان بشكل كبير، حيث أصبحت حدوده مع تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى مسارات مفتوحة لتدفق المرتزقة والسلاح، وأصبحت قراراته السيادية خاضعة لضغوط وتدخلات القوى الإقليمية والدولية (The Washington Institute, 2023).
- الفرضية 4 (مركزية الفاعلين من غير الدول): “الدعم السريع” ليست مجرد ميليشيا عادية، بل هي فاعل من غير دولة يمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، وأجندة سياسية خاصة، وشبكة علاقات دولية. هي تتحدى الدولة وتتنافس معها على الشرعية والسيطرة، مما يجسد هذه الفرضية بشكل كامل.
- الفرضية 5 (الاستراتيجيات الهجينة): يجمع الصراع في السودان بين القتال التقليدي في المدن، وحرب العصابات، واستهداف البنية التحتية، والحرب المعلوماتية الشرسة، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، مما يجعله مثالاً واضحاً للحرب الهجينة.
- الفرضية 6 (اقتصاديات الحرب): يؤكد تحليل الصراع من منظور NIWT على أن دوافع القتال لا تقتصر على السياسة فقط، بل تتداخل مع اقتصاديات الحرب. السيطرة على مناجم الذهب في دارفور، على سبيل المثال، توفر تمويلاً مستداماً لـ “مليشيا الدعم السريع”، مما يجعل الصراع أكثر تعقيداً واستمرارية (أفروبوليسي، 2025).
إن فهم الصراع في السودان من خلال عدسة NIWT المتكاملة يوضح أنه ليس “حرباً أهلية”، بل “حرب دولية جديدة” تُشن بالوكالة على الدولة السودانية. هذا الفهم له تداعيات مباشرة على السياسات المستقبلية، حيث أن أي حل يجب أن يتجاوز المصالحة الداخلية ليشمل معالجة التمويل الخارجي، وشبكات السلاح، والتدخلات الإقليمية.
حالة اليمن ومنطقة الساحل: امتداد وتنوع تطبيقات NIWT
إن النموذج التفسيري لـ NIWT يمتد ليشمل صراعات أخرى معاصرة، مع تباين في درجة وضوح كل فرضية.
- اليمن: حرب الوكالة وتفكك الدولة
- تطبيق الفرضيات: في اليمن، تتجلى بوضوح فرضيات ضعف الدولة (انهيار الحكومة المركزية)، وتآكل السيادة (مع التدخلات الإقليمية)، ومركزية الفاعلين من غير الدول (الحوثيون، القاعدة، المجلس الانتقالي الجنوبي). الحرب بالوكالة بين القوى الإقليمية هي المحرك الأساسي للصراع (Bipartisan Policy Center, 2019). بينما تظهر فرضيات اقتصاديات الحرب (السيطرة على الموانئ والضرائب) والاستراتيجيات الهجينة (استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة) بشكل واضح أيضاً.
- منطقة الساحل الأفريقي: الهيمنة واقتصاديات الموارد
- تطبيق الفرضيات: في منطقة الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، تبرز NIWT بشكل خاص في تفسير الصراعات. هنا، يمكن فهم
ضعف الدولة ليس كفشل في الحوكمة فقط، بل كجزء من بنية أوسع للهيمنة والتبعية الناتجة عن الاستعمار الجديد. اقتصاديات الحرب (السيطرة على الموارد الطبيعية والتهريب) هي المحرك الرئيسي. و
الفرضية الرابعة (الفاعلون من غير الدول) تتجلى في الجماعات الإرهابية والشركات العسكرية الخاصة (مثل فاغنر). NIWT توضح كيف أن التنافس بين القوى الكبرى على الموارد يؤدي إلى حروب بالوكالة تُشن تحت ستار “مكافحة الإرهاب”، وهو ما يمنحها عمقاً تفسيرياً فريداً.
- تطبيق الفرضيات: في منطقة الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، تبرز NIWT بشكل خاص في تفسير الصراعات. هنا، يمكن فهم
- سوريا وليبيا: تفكك الدولة وتعدد الفاعلين
- تطبيق الفرضيات: في كل من سوريا وليبيا، كان انهيار الدولة (الفرضية 1) هو الشرارة التي أطلقت العنان لجميع ديناميكيات NIWT الأخرى.
تعدد الفاعلين من غير الدول (الفرضية 4) وصل إلى ذروته، مع وجود عشرات الميليشيات والجماعات الإرهابية والشركات العسكرية الخاصة.
الحرب بالوكالة (جزء من الفرضية 3 و 4) كانت واضحة، مع دعم دول متعددة لأطراف مختلفة.
اقتصاديات الحرب (الفرضية 6) لعبت دوراً حاسماً في تمويل هذه الجماعات (تهريب النفط في سوريا وليبيا).
- تطبيق الفرضيات: في كل من سوريا وليبيا، كان انهيار الدولة (الفرضية 1) هو الشرارة التي أطلقت العنان لجميع ديناميكيات NIWT الأخرى.
إن NIWT توفر العدسة التحليلية اللازمة لتجاوز التبسيط الصحفي أو السياسي لهذه الصراعات المعقدة (الطاهر، 2024). إنها تحول “القصة” إلى “ظاهرة قابلة للدراسة”، مما يسمح بفهم الأبعاد الخفية للصراع مثل التمويل الخارجي وتأثيره على استدامته.
الخاتمة: NIWT كنموذج للتقدم العلمي في دراسات الصراع
لقد أثبت هذا المقال أن “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) ليست مجرد مجموعة من الأفكار حول الصراع، بل هي نظرية مدى متوسط متكاملة وقوية بالمعنى المنهجي الدقيق الذي أراده روبرت ك. ميرتون. هي تلتزم بمبادئ التحديد، والقابلية للاختبار، والتراكمية، وتعمل كجسر حيوي بين الواقع التجريبي المعقد والتجريد النظري الضروري. إن تحديد موقع NIWT في هذا المستوى التحليلي يكشف عن مصدر قوتها. هي تتجنب التجريد المفرط للنظريات الكبرى، وتتجاوز الوصف السطحي للدراسات التجريبية. ومن خلال مقارنتها بنظريات أخرى في نفس مستواها، مثل نظرية “الحروب الجديدة” لكالدور، يتضح تفوقها في تقديم نموذج سببي أكثر تكاملاً، وفي ربط الآليات الملموسة بالبنى التاريخية الأوسع، مما يمنحها عمقاً نقدياً فريداً.
إن فهم NIWT كنظرية مدى متوسط ليس تقليلاً من شأنها، بل هو على العكس تماماً، تأكيد على طموحها العلمي. فهي تمثل نموذجاً لكيفية بناء نظريات جادة في أيامنا هذه: نظريات تنطلق من الواقع، وتستخدم أدوات منهجية صارمة، وتقدم تفسيرات سببية قابلة للاختبار، وتحافظ على وعي نقدي بالبنى الكبرى التي تشكل عالمنا. إنها محاولة جادة ليس فقط لفهم الحروب المعاصرة، بل أيضاً للمساهمة في التقدم التراكمي للمعرفة في العلوم الاجتماعية. إنها تمثل خطوة إلى الأمام في البناء المعرفي الذي لا يكتفي بالوصف، بل يسعى للتفسير، ولا يكتفي بالتفسير، بل يقدم إطاراً قابلاً للتطوير والاختبار.
قائمة المصادر والمراجع
- أفروبوليسي. (2025، 17 أغسطس). الاقتصاد السياسي للحرب في السودان.
- الطاهر، محمد مكي. (2023). الجيوش غير النظامية في السودان: حالات من إقليم دارفور. دار المصورات للطباعة والنشر.
- الطاهر، محمد مكي. (2024). التدفق الإخباري الأمريكي في حرب غزة والسودان – الجزء الأول – روايات الفوضى. دار نرتقي للنشر والتوزيع.
- الطاهر، محمد مكي. (2025أ، 18 يوليو). الحروب المعاصرة: منظور جديد من السودان لفهم الصراعات في عالم متغير. أفروبوليسي.
- الطاهر، محمد مكي. (2025ب). الحرب على العقول: التضليل الإعلامي والسرديات الزائفة في الحروب الدولية الجديدة. (قيد النشر).
- مجلة الدراسات الأفريقية. (2023). الصراع في السودان: الأسباب والتداعيات والمآلات المستقبلية.
- Bipartisan Policy Center. (2019). A Case Study of the Stabilizing Fragile States Project: Yemen.
- Byman, D. L., & Pollack, K. M. (2001). Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In. International Security, 25(4), 107–146.
- Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University Press.
- Hedström, P., & Udehn, L. (2009). Analytical Sociology and Theories of the Middle Range.
- Kaldor, M. (2012). New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Polity Press.
- Kaldor, M. (2013). In defence of new wars. Stability: International Journal of Security & Development, 2(1).
- Kalyvas, S. N. (2001). New and Old Civil Wars. A Valid Distinction? World Politics, 54(1), 99-122.
- Katzenstein, P. J., & Sil, R. (2008). Rethinking Asian Security: A Case for Analytical Eclecticism.
- Malešević, S. (2010). The Sociology of War and Violence. Cambridge University Press.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672–682.
- Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. Free Press.
- Merton, R. K., & Rossi, A. S. (1950). Contributions to the Theory of Reference Group Behavior.
- Mumford, A. (2013). Proxy Warfare. Polity Press.
- Newman, E. (2004). The New Wars Debate: A Historical Perspective Is Needed. Security Dialogue, 35(2), 173–186.
- Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery.
- The Washington Institute. (2023, June 29). Sudan’s Descent: Foreign Meddling and the Regionalization of Conflict.
- Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B. (2002). Theoretical Criminology. Oxford University Press.
- Wæver, O. (1996). The rise and fall of the inter-paradigm debate.