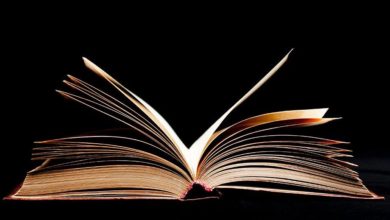هل هي أزمة للطب أم أزمة ضد الطب؟

ميشيل فوكو – ترجمة للمحاضرة التي ألقاها “مشيل فوكو” تحت عنون “هل هي أزمة الطب أو أنها أزمة ضد الطب؟”،
Michel Foucault, Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine ?», trad. D. Reynié), Revista centroamericana de Ciencas de la Salud, n° 3, janvier-avril 1976, pp. 197-209. (Première conférence sur l’histoire de la médecine, Institut de médecine sociale, université d’État de Rio de Janeiro, Centro biomedico, octobre 1974
ترجمة: أسامة صبري – جامعة ابن زهر- المغرب
- المركز الديمقراطي العربي
أود أن أشير في بداية هذه الندوة إلى المسألة التي صارت موضوع مناقشة في العالم: «هل يجب أن نتحدث عن أزمة الطب أم أزمة ضد الطب؟». ولهذا الغرض بالذات، سوف أستدعي خلال هذا الموضوع كتاب إيفان إليتش (Evan Illich)[1] المعنون بـ «عداء الطب: في مصادرة الصحة»، وذلك بالنظر إلى الإشعاع الواسع الذي حققه، وسيستمر في تحقيقه خلال الأشهر القادمة، والذي يُنبه الرأي العام العالمي إلى المشكلة الراهنة في اشتغال مؤسسات المعرفة ومؤسسات السلطة الطبية. لكني، ومن أجل تحليل هذه الظاهرة سوف أنطلق من حقبة زمنية بعيد نوعًا ما. يتعلق الأمر بسنوات 1945-1940، وبالضبط سنة 1942 الفترة الذي تم فيها إصدار مخطط بيفيردج[2] حيث هيأ لبروز نموذج جديد لتنظيم الصحة قُبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
يحمل تاريخ هذا المخطط قيمة رمزية. فخلال سنة 1942-في أوج الحرب العالمية التي راح ضحيتها 40 مليون شخص-لم يتم تعزيز الحق في الحياة فقط، بل ثمة حق آخر مختلف وأكثر أهمية وتعقيداً، ألا وهو الحق في الصحة. ففي الوقت الذي سببت فيه الحرب العالمية اختلالات كبرى، انبرى المجتمع لمهمة معلنة، ليس فقط ضمان الحق في الحياة بل وأيضاً الحياة بصحة جيدة.
بغض النظر عن هذه القيمة الرمزية، إلا أن لهذا التاريخ (1942) أهمية كبيرة تردنا إلى أسباب مختلفة:
- أولا: يشير مخطط “بيفيردج” إلى تحمل الدولة أعباء الرعاية الصحية للأفراد. وبإمكاننا القول أن هذا الأمر ليس جديداً؛ ذلك أنه ومنذ القرن الثامن عشر، كانت واحدة من وظائف الدولة، والتي لا تحمل صبغة أساسية رغم أهميتها، هي ضمان الصحة الجسدية لمواطنيها. أعتقد أنه ومنذ ذلك الحين وإلى غاية منتصف القرن العشرين فإن ضمان الصحة بالنسبة للدولة يعني أساساً احتكار القدرة البدنية الوطنية، وقدراتها على الإنتاج ومقدرتها العسكرية. وصولاً إلى تلك الفترة، كان لطب الدولة أهداف وإن لم تكن عرقية فهي على الأقل قومية. ومع مخطط بيفيردج، تحولت الصحة لأن تصير موضوعاً لانشغال الدولة، ليس من أجلها ولكن من أجل الأفراد. وفقاً لهذا الأساس صار حق الإنسان في علاج جسده موضوعاً تدخل للدولة. وبالنتيجة تُعكس مفاهيم الإشكالية: حيث مفهوم الدولة في خدمة الفرد السليم قد تم استبداله بمفهوم الفرد السليم في خدمة الدولة.
- ثانياً: لا يتعلق الأمر فقط بتغيير عكسي طال هذا الحق بقدر ما يتعلق هنا بما يمكن أن نطلق عليه “أخلاق الجسد. خلال القرن التاسع عشر، ظهرت في جميع دول العالم أدبيات مهمة حول الصحة وضرورة تأمين الأفراد لصحتهم، وصحة أسرهم، الخ. يحتل مفهوم النظافة الصحية والصحة العامة مكانة مركزية في جميع هذه التوجهات/التوصيات الأخلاقية للصحة. كما ركّزت العديد من المنشورات على النظافة كشرط أساسي لصحة سليمة والتي تسمح بالعمل بغية أن يعيش الأطفال ويؤدوا بدورهم العمل الاجتماعي والإنتاج. بهذا المعنى، فالنظافة مسألة ضرورية من أجل ضمان صحة سليمة للفرد نفسه ولكن أيضًا للأفراد الآخرين المحيطين به. وبانطلاق النصف الثاني من القرن العشرين ظهر مفهوم آخر. لم يعد بالإمكان الحديث عن ضرورة النظافة والصحة العامة بغية التمتع بصحة سليمة، بل الحق في أن يكون المرء مريضاً في الوقت الذي يريد أن يكون فيه كذلك وفي الوقت الذي يجب على المرء أن يكون فيه مريضاً. لقد غدا هنالك الحق في التوقف عن الشغل، وصار ذو أهمية أكثر من الواجب السابق للنظافة الذي ميّز العلاقة الأخلاقية للأفراد بأجسادهم.
- ثالثاً: تزامناً مع صدور مخطط بيفيردج دخل قطاع الصحة إلى الحقل الماكرو اقتصادي. إذ أن النفقات الموجهة للصحة أو الانقطاع عن الشغل، والحاجة إلى تغطية هذه المخاطر، لم تعد المشاكل التي يمكن أن تُحل ببساطة بواسطة التأمينات الخاصة. فمنذ تلك اللحظة، صارت الصحة أو مشكلة الصحة هي مجموع الشروط التي تُيسر تأمين صحة الأفراد والتي صارت مدرة للمداخيل التي، وعبر أهميتها، وجدت مكانها على مستوى بنود ميزانية الدولة، أيّا كان نظام التمويل. وهكذا، دخلت الصحة وقتئذ لتندمج في الحسابات الماكرو-اقتصادية. فعبر الصحة وعلم الأمراض وعبر الطريقة التي يتم بها تأمين مستلزمات الصحة، يمكننا أن نقول أن الأمر يتعلق بعملية تحقيق نمط من إعادة التوزيع اقتصادية. إن واحدة من وظائف السياسة التمويلية بالنسبة للعديد من الدول منذ بداية هذا القرن كان هو تأمين -عبر نظام الضرائب- أرباحٍ من المداخيل أو الممتلكات. ذلك أن عملية التوزيع هذه لا تتبع نظام الضرائب بل نظام التغطية الاقتصادية للصحة والأمراض والتي تضمن للجميع نفس فرص الولوج والحصول على العلاج والتطبيب. لقد أرادوا بهذا أن يصححوا جزئياً التفاوتات على مستوى المداخيل. لقد بدأ الجسد والصحة والمرض في تشكيل أسسهم المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية؛ وفي ذات الآن، تم تحويلهم ليكونوا أداةً لتنشئة الأفراد.
- رابعاً: صارت الصحة موضوعاً لصراع سياسي واضح. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية والانتخابات التي حقق فيها العمال الإنجليز نصراً كبيراً سنة 1945، لم يكن ثمة أي حزب سياسي ولا أي حملة انتخابية في أي بلد متقدم، لم تطرح مشكلة الصحة وإمكانية ضمان وتمويل هذا النوع من النفقات من طرف الدولة. أظهرت الانتخابات البريطانية لسنة 1945 كما هو الأمر بالنسبة للانتخابات الفرنسية التي عرفت فوز الكونفيدرالية العامة للشغل، أهمية الصراع السياسي من أجل الصحة.
إذا أخذنا بعين الاعتبار النقطة المرجعية الرمزية لمخطط بيفيردج، فإننا نلاحظ أنه وفي خضم العشرية 1940-1950 قد تم تشكل حق جديد، أخلاق جديدة، اقتصاد جديد وسياسة جديدة للجسد. لقد تعود المؤرخون على السرد بكثير من الحذر ما يفكر به وما يقوله الناس والتطور التاريخي لتمثلاتهم ونظرياتهم، ولتاريخ الحس الإنساني. غير أنه من المفيد أن نُؤكد على أنهم لطالما أهملوا الفصل الأساسي المتعلق بتاريخ الجسد البشري. في نظري، فإن الفترة المرجعية لتاريخ جسد الإنسان في العالم الغربي الحداثي تتأطر في سنوات 1940-1950 والتي تسجل بروز حق جديد وأخلاق جديدة لهذه السياسة الجديدة ولاقتصاد الجسد هذا. فمنذ ذلك الحين صار جسد الفرد واحداً من الأهداف الأساسية لتدخل الدولة، واحدة من الأشياء التي من واجب الدولة أن تتحملها.
يمكن أن نقوم بمقارنة تاريخية على سيبل الدعابة. ففي الوقت الذي تبلورت فيه الإمبراطورية الرومانية خلال عهد قسطنطين، انكبت الدولة وللمرة الأولى في تاريخ العالم المتوسطي، على مهمة علاج الروح. لم يكن واجب الدولة المسيحية فقط هو تأدية الوظائف التقليدية للإمبراطورية، ولكن أيضاً أن تمكن للأرواح بأن تحوز الخلاص وإرغامها إذا اقتضى الأمر. وهكذا أصبحت الروح هدفاً من أهداف تدخل الدولة. في كل الثيوقراطيات الكبرى، منذ قسطنطين إلى غاية الثيوقراطيات المختلطة للقرن الثامن عشر أسست أنظمة سياسية تجعل من خلاص الأرواح من أهدفها.
يمكن أن نقول على أن ما يُتداولُ، هو في الواقع قد تم إعداده منذ القرن الثامن عشر. لا يتعلق بثيوقراطية ولكنه يعبر عما أسميه السيطرة على الجسد (somatocratie[3]). إننا نعيش في ظل نظام تُعد فيه معالجة الجسد، الصحة الجسدية، العلاقة بين المرض والصحة واحدة من أهداف تدخل الدولة. يمثل هذا تحديداً ولادة ما سميّته بالسيطرة على الجسد (somatocratie) التي تعيش الأزمة منذ البداية والتي أقترح أن أحللها. هذه بالذات اللحظة التي تحمّل فيها الطب وظائفه الحديثة، بفضل إضفاء طابع التأميم عليه.
لقد كانت التكنولوجيا الطبية تُعاني ندرة التطورات؛ إلا أن اكتشاف المضادات الحيوية، أي إمكانية المحاربة الفعالة لأول مرة للأمراض المزمنة هي في الواقع معا متزامنة مع ميلاد كبرى أنظمة الضمان الاجتماعي، فأحدث هذا التقدم التكنولوجي المذهل تغييراً سياسياً وقانونياً واجتماعياً في مجال الطب.
ظهرت في الأثناء، أزمة مع بروز متزامن لظاهرتين: فمن جهة، التطور التكنولوجي الذي يستند إلى التقدم الرأسمالي في المكافحة ضد الأمراض. من جهة أخرى، نمط الاشتغال الاقتصادي والسياسي الجديد للطب. لم تنجح هاتين الظاهرتان في تحسين رفاهية صحية كما انتظرناها، بل بالأحرى أنتجت ركوداً غريباً للفوائد والإمكانات التي يمكن أن تجنى من الطب والصحة العمومية. إنها واحدة من جوانب الأزمة التي أهدف إلى تحليلها عبر الإشارة إلى بعض الآثار التي خلّفتها. وهذا لكي أظهر أن هذا التطور المعاصر للطب، تأميمه، وتنشئته الاجتماعية، التي أعطاها مخطط بيفيردج كفكرة عامة، هي في الأصل فكرة قديمة.
في الواقع، لا يجب علينا أن نظن أن الطب كان يعاني إلى يومنا هذا كنشاط فردي أو تعاقدي بين المريض وطبيبه، بما جعله لم يتحمل المهام الاجتماعية إلا حديثاً. بل على العكس، أوَدُّ أن أظهر أن الطب، وعلى الأقل منذ القرن الثامن عشر، مثّل نشاطاً اجتماعياً. والقصد من ذلك أن الطب الاجتماعي لم يكن موجوداً، ذلك لأن الطب- بالأساس- اجتماعيٌّ. لطالما كان الطب ممارسة اجتماعية، فالأمر الذي لم يكن موجوداً هو الطب غير الاجتماعي والطب الفرداني والإكلينيكي ذي العلاقة الأحادية والذي شكّل وهماً مبرراً لـشكل من أشكال الممارسة الاجتماعية للطب الذي هو في الأصل ممارسة مهنية.
إذا كان الطب اجتماعياً في الواقع، فإن الأزمة الحالية ليست في حقيقتها ذات راهنية. إذ أن جذورها التاريخية يجب أن يتم التنقيب عنها في الممارسة الاجتماعية للطب. وتبعا لذلك، فأنا لن أطرح المشكل داخل المفاهيم التي اختارها ايفان إليتش: الطب أو ضد الطب؛ وحول ما إذا كان علينا أن نحافظ على الطب أم لا؟ ليس الإشكال هنا أن ننظر في ما إذا كنا بحاجة إلى الطب الفرداني أو الطب الاجتماعي؟ ولكنها تتعلق بمساءلة نموذج تطور الطب منذ القرن الثامن عشر، أي منذ بروز ما يمكن أن نسميه “إقلاع” الطب. تصاحب هذا الإقلاع الصحي للعالم المتقدم بانفتاح تقني وابستمولوجي للطب ذو أهمية كبيرة وسلسلة كاملة من الممارسات الاجتماعية. إن هذه الأشكال الخاصة للإقلاع هي بالتحديد التي تقود حالياً نحو الأزمة. إن السؤال إذن الذي يطرح نفسه ضمن الاتجاهات التالية 1-ما هو هذا النموذج من التقدم؟2-إلى أي حد يمكن تصحيحه؟3-إلى أي حد يمكن توظيفه داخل مجتمعات لم يعرف أفرادها نفس النموذج للتقدم الاقتصادي والسياسي للمجتمعات الأوربية والأمريكية؟ وإجمالاً، ما هو هذا النموذج من التنمية؟ هل يمكن أن يتم تنقيحه أو تطبيقه في أماكن أخرى؟
أريد الآن أن أستعرض بعضاً من جوانب الأزمة الراهنة:
أبتغي في المقام الأول أن أشير إلى المسافة بين عملية الطب وآثاره الإيجابية، أو بين العلمية والفعالية الطبية. نحن لسنا في حاجة لانتظار إليتش أو أنصار معارضة الطب، كي نعرف أن واحدة من قدرات الطب هي القتل. الطب يقتل وطالما فعل ذلك ولايزال، وهو دائماً على وعي بهذه المسألة. المهم في هذا السياق، أنه وبالوصول إلى عهدنا الراهن، فإن الآثار السلبية للطب ظلت تُسجل تحت مسمى الجهل الطبي. ما يعني أن الطب يُميتُ بسبب الجهل الطبي أو لأن الطب نفسه كان مُتجاهلاً؛ ومن تم لم يكن الأمر يتعلق بعلم حقيقي، ولكن بالأحرى ما يشبه تركيباً موسيقياً ركيكاً لمعرفة ما تم تأسيسها وفحصها بشكل رديء. يُقاس إذن “خُبث” الطب بما يتناسب مع طبيعته غير العلمية. ما ظهر خلال بداية القرن العشرون، لا يجعل من الطب خطيراً بسبب جهله، بل بالمعرفة التي يمتلكها ولأنه وعلى نحو أدق هو عِلم.
يكشف إليتش وأولئك الذين يُلهمهم، عن سلسلة من الوقائع حول هذا الموضوع، إلا أنني لست مُتيقناً في إذا ما كانوا قد صاغوها بشكل جيد. وهكذا، يجب أن نترك جانباً مختلف النتائج المذهلة الصالحة للاستخدام من قِبَل الصحفيين؛ ومن تم فأنا لن أتحدث عن الانخفاض الكبير في الوفيات أثناء إضراب الأطباء في إسرائيل، كما أنني لن أستعرض وقائع حقيقية لن تسمح لنا الصياغة الإحصائية إزاءها باكتشاف أو تعريف ما هو قيد التساؤل. وهذا ما يظهر في الواقع، فبالنسبة للبحث المنجز من طرف المعاهد الوطنية للصحة فإن 150000 شخص قد عولجوا سنة 1970، جراء مضاعفات امتصاص الأدوية. تُثير هذه المعطيات الإحصائية الاعجاب ولكنها لا تمثل حجة إلى الحد الذي لا تتطرق فيه قط إلى الطريقة التي تُدار بها هذه الأدوية وتستهلك … إلخ. كما أنني لا أحلل هاهنا، البحث المشهور لـ روبرت تايلي( Robert Talley)[4]، الذي بيّن فيه خلال سنة 1967 أن 30000 شخصاً من أمريكا الشمالية توفوا في المستشفيات بسبب تسمم دوائي. وعلى الرغم من ذلك، فإن كل هذا لا يحمل دلالات كبرى، ولا يمكن أن يمثل أساساً لتحليل كافِ. يتطلب الأمر أن نعرف عوامل أخرى، على سبيل المثال، متعلقة بالطريقة التي تُدار بها هذه الأدوية، سواء ما إذا كانت ناجمة عن خطأ الطبيب أو العاملين في المستشفى أو من طرف المريض نفسه. كما أنني أتوقف عند الاحصائيات المتعلقة بالعمليات الجراحية، وبالأخص تلك المرتبطة باستئصال الرحم التي أجريت بكاليفورنيا والتي نبهت إلى أنه من أصل 5000 حالة، فإن 14 بالمئة من التدخلات الجراحية لم تكن ذات جدوى، وأن ربع المريضات قد توفين شابات، وأن 40 بالمئة فقط من الحالات استطعن أن يعبّرن عن ضرورة إجراء العملية.
مثلت كل هذه الوقائع المادة التي جُمعت من طرف إليتش أعطت مكانة هامة لانعدام المهارة أو جهل الأطباء دون أن تتم مساءلة الطب ودرجة العِلميّة في حد ذاتها. وعلى العكس، ما يبدو أكثر أهمية ويطرح مشكلاً حقيقياً، وهو ما يمكن أن نطلق عليه ليس الآثار غير المرغوبة، وإنما الآثار الجانبية الإيجابية المتعلقة بالطب (I’iatrogénie positive): ذلك أن الآثار الرجعية للأدوية ليست ناجمة عن أخطاء في التشخيص أو سوء تدبير هذه الموارد بل عن فعل التدخل الطبي نفسه، وأسسه العقلانية. خلال الوقت الراهن، تثير الأدوات المتاحة للأطباء وللطب عموماُ وبالأخص فعاليتها بعض الانعكاسات؛ بعضها مضرة وأخرى لا يمكن التحكم بها والتي ترغم النوع الإنساني على الانخراط في مسار خطير، وفي حقل من الاحتمالات ومن الأخطار التي لا يمكن معها قياس مدى دقتها.
إننا نعلم على سبيل المثال، أن علاج المضاد الحيوي- المعركة التي حققت النجاح الكبير ضد العوامل المعدية[5]-، قاد إلى انخفاض عام في معدل حساسية الجسم. إجمالاً، يدل هذا الأمر إلى أي مدى يعرف الجسم كيف يدافع ويحمي نفسه بشكل طبيعي، ولكن من جهة أخرى، فهو أكثر هشاشة وأكثر عرضة إذا لم يتصل مع المحفزات التي تثير الاستجابات الدفاعية.
يمكننا بصفة عامة التأكيد أنه عبر آثار الأدوية نفسها-آثار العلاج الإيجابية، نتج عنها خلل حتى لا نقول “تخريب” للنظام الطبيعي ليس للفرد فقط وإنما أيضاً للنوع البشري بأكمله. إن الحماية البكتيرية والفيروسية، والتي تمثل في نفس الوقت خطراً وحماية للجسم تتعرض لتغيير نتيجة للتدخل العلاجي وتكون عرضة للهجمات التي كان الجسم محمياً ضدها.
إننا نجهل في النهاية إلى أي حد سيقود إليه هذا التلاعب الجيني الذي تخضع إليه المقومات الوراثية للخلايا الحية، سواء على العُصيات أو على الفيروسات. تقنياً، لقد صار بالإمكان تطوير عناصر معادية لجسم الانسان الذي لا يملك أية وسائل للدفاع. كما أنه بات من الممكن أن نضع سلاحاً بيولوجياً خالصاً موجهاً ضد الانسان والجنس البشري دون أن نطور في نفس الوقت وسائل للدفاع. وبناء على ما سبق فإن المختبرات الأمريكية طالبت بأن تمنع التعديلات الوراثية والتي تنجز في الوقت الراهن.
هكذا إذن نكون قد دخلنا بعداً جديداً لما يمكن أن نطلق عليه بالخطر الدوائي. نقصد بالخطر الطبي صعوبة فك الارتباط بين الآثار الإيجابية والسلبية للطب، وهو الذي ليس بالأمر الجديد بما أنه يعود للفترة التي كان فيها التأثير الإيجابي للدواء مصاحباً لتبعات سلبية وضارة. ثمة الكثير من الأمثلة التي ميزت تاريخ الطب الحديث منذ القرن الـثامن عشر. خلال هذا الوقت، استطاع الطب أن يكتسب، لأول مرة ما يكفيه من السلطة لجعل بعض المرضى يغادرون المستشفى. وإلى غاية أواسط القرن الثامن عشر، لم يكن ثمة شخص بإمكانه أن يغادر المستشفى، وبالتالي فقد كُنّا نلج هذه المؤسسة لكي نفارق الحياة فيها. لم تسمح التقنية الطبية للقرن الثامن عشر، للفرد المعالَج أن يغادر هذه المؤسسة على قيد الحياة، لقد كان المستشفى يمثل آنذاك بمثابة معزل أو دير يأتي إليه الناس هرباً من الأشباح، إنه بمثابة الفخ الحقيقي.
كما أن اكتشاف مواد التخدير وتقنية التخدير العامة، خلال سنوات 1844-1847 يُعَدُّ مثالاُ آخر للتقدم الطبي المصاحب بمعدل كبير للوفيات. انطلاقاً من اللحظة التي استطعنا فيها تنويم المريض قد صار بإمكاننا إجراء عملية جراحية. لقد كان جراحو تلك الفترة، مندفعين بحماس لهذه المهمة، إلا أنها لم تكن مُدعومة بالأدوات الصحية المعقمة. وفي الواقع، فإن الأدوات المعقمة بدورها لم تدخل حيز الممارسة الطبية إلا خلال 1870، أي بعد نهاية الحرب الفرنسية –البروسية، ومع النجاح النسبي الذي حققه الأطباء الألمان صار التخدير ممارسة متعارف عليها في جميع بلدان العالم.
لقد تلاشت حواجز الألم وصار بإمكاننا القيام بأية عملية جراحية منذ الوقت الذي أمكننا فيه تخدير الأفراد، إلا أنه وفي ظل غياب أدوات معقمة، فما من شك أن كل عملية لا تمثل خطراً فحسب، ولكن تؤدي بشكل عام إلى وفاة الشخص. وهكذا، فخلال حرب 1870، أنجز (Guérin)[6] أحد أشهر الجراحين الفرنسيين، عمليات بتر الأعضاء للعديد من الجرحى، إلا أنه تمكن من إنقاذ واحد منهم: مات الآخرون جميعاً. إنه مثال نوعي للطريقة التي لطالما اشتغل بها الطب، ابتداءً من هفواته ومن واقع أنه لم يحدث ثمة تقدم كبير طبي ما لم يدفع ثمنه من خلال تبعات سلبية متنوعة.
أخذت هذه الظاهرة التي تميز تاريخ الطب الحديث، خلال العشريات الأخيرة، بعداً جديداً بالشكل الذي يجعل الخطر الطبي لا يتعلق إلا بالفرد المُعالَج. وعلى النقيض من ذلك، كان بالإمكان أن نغير من نسله المباشر ما يعني أن قدرة عمل سلبية للدواء كانت تقتصر على الأسرة أو النسل. وفي الوقت الراهن ومع التقنيات المتاحة للطب، فإن إمكانية تعديل البنيات الوراثية للخلايا لا تستهدف فقط الفرد أو نسله، ولكن الجنس البشري بأكمله؛ بهذا المعنى صار مجموع ظواهر الحياة ضمن حيز حقل التدخل الطبي. كما أننا لا نعرف بعد ما إذا كان الانسان قادراً على صناعة كائن حي طبيعي على النحو الذي يجعل من مجمل تاريخ الحياة ومستقبل الحياة خاضعين للتغيرات.
يظهر هاهنا إذن بعد جديد للإمكانات الطبية والذي سأسميه مسألة البيو-تاريخ[7]. فالطبيب وعالم الأحياء لم يشتغلوا قبل الآن على مستوى الفرد والنسل. ولكنهم قد بدأوا للتو بالاشتغال على مستوى الحياة نفسها وعلى مستوى أحداثها الأساسية. لقد وجدنا الآن أنفسنا في البيو-تاريخ وهو بعد جد مهم…
بتنا نعرف منذ أفكار داروين أن الحياة تتطور. وبأن تطور الكائنات الحية كان محددا- ضمن نطاق معين- بحوادث يمكن أن تكون ذات طبيعة تاريخية. يدرك داروين، على سبيل المثال، أن النسيج في إنجلترا كممارسة اقتصادية قانونية خالصة غيرت من طبيعة النباتات والحيوانات بانجلترا، إنها إذن قوانين عامة للحياة والتي تربط نفسها مع الحدث التاريخي. كما نكتشف واقعة جديدة في أيامنا هذه: إن تاريخ الإنسان والحياة يتشاركان بشكل عميق. فتاريخ الإنسان لا يكمل الحياة فقط، كما أنه لا يضطلع بإعادة إنتاجها، ولكنّه يستعيدها في نقطة معينة مُنتجاً عبر سيرورتها عددا من التبعات الأساسية. إنّها واحدة من الأخطار الكبرى للطب الراهن بل وواحدة من الأسباب التي يمكن أن تفسر القلق الذي نتبادله فيما يتعلق بآثار التدخل الطبي من الأطباء إلى المرضى ومن التقنيين إلى السكّان.
إن سلسلة من الظواهر، مثل الرفض الجذري للطب بهدف موائمة ما هو غير التقني مع الطبيعة-والذي يعتبر موضوعاً قابلاً للمقارنة بالألفية أو بالمخاوف من نهاية الجنس البشري-تمثل بشكل غير واضح في وعي الأفراد الصدى والرد عن هذا القلق التقني الذي بات يشعر به علماء الأحياء والأطباء في ما يتعلق بآثار ممارساتهم الخاصة ومعرفتهم الخاصة. إن المعرفة خطيرة، ليس فقط بسبب آثارها الفورية على الفرد أو مجموعة من الأفراد ولكن على مستوى التاريخ أيضاً ومن تم فيمكننا أن نقول أنها واحدة من السمات الأساسية للأزمة الحالية.
يمكن أيضاً أن نرصد ميزة ثانية وسوف أطلق عليها ظاهرة إضفاء الطابع الطبي غير المحدد. كثيراً ما نؤكد أن الطب خلال القرن العشرين بدأ في الاشتغال خارج حقله التقليدي تبعاً لمتطلبات المريض، الألم، أعراضه وقلقه، مما يشجع التدخل الطبي وتجعل من حقل نشاطه المحدد بمجموعة من المواضيع التي يشار إليها بالأمراض والتي تمنح صفة طبية للطلب. على هذا المنوال إذن يتم تعريف المجال الخاص للطب.
وإذا كان هذا هو المجال الحصري للطب، فما من شك أن ثمة أسباب مختلفة قد جعلت الطب الراهن قد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. في المقام الأول، يستجيب الطب إلى داع آخر غير مرتبط بطلب المريض، والذي لا يُستدعى إلا في حالات محدودة. في الكثير من الأحيان، يفرض الطب على الفرد، سواء أكان معتلاً أم لا باعتباره فعلاً سلطوي. وسوف أسرد في هذا الخصوص العديد من الأمثلة. فاليوم لا يمكن أن نوظف شخصاً دون أن نستشير الطب الذي يفحص الفرد بشكل سلطوي. كما أن ثمة سياسة نسقية وملزمة للمسح، وتوطين الأمراض داخل السكان، وهو أمر لا يتصل بأي حال بطلب يتقدم به المريض. على ذات الطريقة، ففي عديد من الدول إذا كان ثمة شخص مُتهم بارتكاب جريمة، أي أنها تعتبر جريمة خطيرة بما يكفي لأن يُحاكم أمام المحاكم، فإنه مطالب لأن يخضع لفحص نفسي. وفي فرنسا فإنه يظل أمراً إلزامياً على جميع الأفراد الموجودين تحت تصرف العدالة، حتى ولو كانت محكمة جنائية. تكون هذه إذن بعض الأمثلة على نمط من التدخل الطبي الذي لم يطلبه المريض.
في المقام الثاني، فإن الموضوعات التي تكون مجال التدخل الطبي لا تنحصر فقط في الأمراض. سوف أستعرض هاهنا مثالين. فمنذ مستهل القرن العشرين، ارتبطت الجنسانية والسلوك الجنسي والانحرافات أو الشذوذ الجنسي (ارتبطت) كلها بالتدخل الطبي دون أن يقول طبيب ما على الأقل ما لم يكن ساذجاً: إن الشذوذ الجنسي هو مرض. إن التدخل المنهجي لطبيب لمثليين جنسيين في أوروبا الشرقية يتميز بإضفاء الطابع الطبي لشيء لا يمثل مرضاً للمثلي الجنسي ولا الطبيب.
بشكل عام، يمكن أن نقول بأن الصحة قد تحولت لتصير موضوعاً للتدخل الطبي. إذ أن كل ما يضمن صحة الفرد، كمياه الصرف الصحي، وشروط الحياة في نظام حضري أصبح الآن حقلاً للتدخل الطبي ولم يعد تعباً لذلك مرتبطاً حصراً بالأمراض.
في الواقع، لقد بات التدخل السلطوي للطب في حقول أوسع من الفردي والجماعي سمة مميزة. إذ أصبح الطبيب الآن يتمتع بسلطة مسنودة بوظائف تستطيع الذهاب إلى ما وراء الأمراض ومتطلبات المريض.
إذا كان رجال القانون في القرنين السابع عشر والثامن عشر، قد ابتكروا نظاماً اجتماعياً تتم إدارته عبر قوانين مُدوّنة فبإمكاننا القول إن أطباء القرن العشرين على وشك ابتداع مجتمع المعايير وليس مجتمع القانون. فلم تعد القوانين هي التي تنظم المجتمع، بقدر ما صار التمييز بين ما هو طبيعي أو غير طبيعي كمجهود مستمر في استعادة نظام الحياة الطبيعية. وهنا تكمن واحدة من سمات الطب الحديث، على الرغم من أنه يمكن بسهولة إثبات قِدَم الظاهرة المرتبطة بالإقلاع الطبي، فمنذ القرن الثامن عشر لم يتوقف الطب عن الانشغال بما لا يخصه، أي ما لا يتصل بجوانب الأمراض والمرضى. وكانت هذه بالتحديد بوابة الخروج من المأزق المعرفي في نهاية القرن الثامن عشر.
تركزت إلى غاية سنوات 1750-1720 أنشطة الأطباء على تلبية المرضى ومواجهة الأمراض. لقد كان هذا هو الحال منذ العصور الوسطى والتي تمكن القول إن النتائج العلمية والعلاجية كانت دون المستوى وبالتالي لم يتم تحرير الطب من الركود العلمي والعلاجي الذي ميز هذه الفترة. وانطلاقاً من هذه اللحظة توقف الطب على أن يكون إكلينيكياً وبدأ ينظر للجوانب الأخرى عن المنفصلة عن المرضى، حيث جعل يبدأ في أن يكون اجتماعياً.
هناك أربع سيرورات كبرى ميزّت مجال الطب في القرن الـثامن عشر:
- بروز سلطة طبية والتي لم تكن سلطة فقط للمعرفة. فالسلطة الطبية إنما هي سلطة اجتماعية […] والتي يمكن أن تأخذ شكل قرارات تخص المدينة، الحي، مؤسسة ما أو قانون، وهو مظهر مما يسميه الألمـان طب الدولة[8].
- بروز حقل تدخل طبي منفصل عن المرض: الهواء، الماء، الانشاءات، الميادين، قنوات الصرف، فمنذ القرن الثامن عشر، صارت مثل هذه الثيمات موضوعاً للطب.
- ميلاد جهاز تطبيب جماعي، أي المستشفى. إذ أنه قبل القرن الثامن عشر لم يكن المستشفى مؤسسة للرعاية الطبية. بل لمساعدة الفقراء الذين ينتظرون الموت.
- ميلاد آليات الإدارة الطبية: سجل المعطيات ومعاهد لمقارنة الاحصائيات…
استطاع الطب والطب الإكلينيكي أن يكتسبا أبعاداً جديدة كلياً وذلك بفضل المستشفى وأدواره الاجتماعية، إلى الحد الذي تحول فيه الطب من أن يكون مجرد ممارسة فردية ليصير ممارسة اجتماعية، ما فتح إمكانيات علم التشريح المرضي، وتوسع طب المستشفى مع التقدم الذي صار يرمز إليه بأعلام مثل (Bichat) ( Laennec) (Bayle) إلخ … وتبعاً لذلك، انكب الطب على مجالات أخرى لا تتعلق بالأمراض. لكن ما ميّز الفترة الحالية هي الماضية والذي بات يشتغل خارج حدوده التقليدية المحددة من طرف المريض والأمراض؛ لم تعد له حدود يمكن أن تكون خارجية بالنسبة إليه.
في الواقع، إذا كان الطب في القرن التاسع عشر، قد تجاوز حدوده الكلاسيكية، فإن ثمة جوانب أخرى التي لم يتم إضفاء الطابع الطبي عليها. يمكن أن نتصور وجود ممارسة جسدية، النظافة، الأخلاق الجنسية، إلخ … والتي لا يمكن التحكم فيها أو تنظيمها بواسطة الطب، فالثورة الفرنسية مثلاً: كانت تتصور سلسلة من مشاريع لأخلاق الجسد ونظافته والتي لا يجب أن توضع تحت إشراف الأطباء بأي حال من الأحوال. لقد تخيلنا نوعاً من النظام السياسي “السعيد” الذي في خضمه تتكيف إدارة الجسد الإنساني والنظافة والطعام والتحكم في النشاط الجنسي وفق وعي جمعي تلقائي. كما نجد النموذج المثالي للتنظيم غير الطبي للجسم والسلوك طوال القرن التاسع عشر، على سبيل المثال في كتابات Raspail[9].
في خضم الوضعية الراهنة، فالأمر الذي يبعث على الشر يتعلق باللحظة الذي نريد فيها الاستعانة بمجال سبق الاعتقاد بأنه يقع خارج المجال الطبي؛ إذ سُرعان ما ننتبه إلى أنه قد تم إخفاء الطابع الطبي عليه. وفي الوقت الذي قد نعترض على مواطن ضعف الطب، سلبياته وآثاره الضارة، فإن هذا يتم باسم معرفة طبية متكاملة، أكثر انتشاراً ودقة.
أريد هنا أن أثير مثالاً في هذا الخصوص: يثير إليتش وتلامذته الانتباه إلى كون الطب العلاجي الذي يتدخل في الاستجابة وإخفاء الأعراض الظاهرة للمرض، إنّما هو طب سيء. بالمقابل، فهم يقدمون علماً دون نزعة طبية، كالنظافة، الغذاء، نمط الحياة، شروط الحياة، شروط الشغل والسكن، فما هي النظافة الآن؟ إن لم تكن سوى مجموعة القواعد الراسخة المتصلة بالمعرفة البيولوجية والطبية في الوقت الذي تفهم فيه السلطة الطبية بالمعنى الدقيق الذي صيغت عليه؟ لا يمكن للطب المُضاد أن يواجه الطب إلا من خلال الوقائع أو المشاريع التي تأخذ شكلاً من أشكال الطب.
أريد أن أثير أيضاً مثالاً آخر مستقى من الطب النفسي. ويمكن أن نؤكد أن التحليل النفسي مثل الشكل الأول لـلطب النفسي المُضاد (Antipsychiatrie). ففي نهاية القرن التاسع عشر تشكل مشروع يتعلق بنزع الطابع العلاجي الدوائي لمختلف الظواهر والأعراض النفسية الكبرى والتي كانت تُعتبر بمثابة أمراض إن الحركة المضادة للطب النفسي وبالأخص التحليل النفسي، تسعى للتحرر من سيطرة الأطباء النفسيين، ليس فقط في ما يتعلق بالهستيريا أو الاضطراب العصبي كما حاوله فرويد؛ بل أيضاً مجموع السلوك اليومي والذي صار بجوره موضوعاً للتحليل النفسي. فاليوم بالرغم من أننا قد نعارض التحليل النفسي بـالطب النفسي المُضاد ـ(antipsychiatrie) فإن الأمر ما يزال يتعلق بنشاط وبخطاب ذي صياغة طبية تمت صياغته وفق تصور طبي أو على قاعدة معرفة طبية. فلم يعد بالإمكان الخروج من الطب، فكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تعتمد على المعرفة الطبية.
ولأختم، سوف أدرج مثالاً آخر مستقى من مجال الجريمة والمقدرات النفسية في مسألة الجنح. فالمسألة المطروحة في القوانين الجنائية للقرن التاسع عشر، تتجه إلى تحديد ما إذا كان الفرد مريضاً نفسياً مذنباً. فحسب القانون الفرنسي لا يمكن أن يكون المرء مذنباً ومجنوناً. فالشخص المجنون ليس جانحاً، وهكذا فإن الفعل المرتكب ليس جريمة بقدر ما هو عرَض لا يمكن بموجبه إدانته.
اليوم، وعلى الرغم من ذلك فإن الشخص الذي يعتبر مذنباً و يجب أن يُدان فهو يخضع للفحص كما لو كان مجنوناً، وفي نهاية المطاف فإننا وبطريقة ما تتم إدانته دائماً كما لو كان مجنوناً. وهذا يبين، على الأقل في فرنسا، أنه لا يتم استدعاء الخبير في الطب النفسي لتحديد ما إذا كان الفرد هو المسؤول عن ارتكاب الجريمة بقدر ما يقتصر الاختبار على فحص ما إذا كان الفرد يمثل خطراً أم لا.
على ماذا يحيل هذا المفهوم: الخطر؟. إنه يحيل على أمرين؛ الأول حيث الطب النفسي يعتبر أن الفاعل ليس خطيراً أي أنه ليس مريضاً ولا تظهر عليه أي علامات مرضية، ما يعني أن هذا الفرد ليس خطيراً وليس ثمة حاجة لإدانته. الأمر الثاني حيث الطبيب يؤكد أن شخصاً ما خطير على اعتبار أنه قد عاش طفولة محبطة ومن تم ضَعفت أناه الأعلى وأيضاً لكونه لم يمتلك معنى معين للواقع… إلخ. في هذه الحالة فإن الفرد الذي “أضفِيَ عليه الطابع المَرضي” يمكننا من هذه اللحظة أن نسجنه. وهكذا فنحن نسجنه فقط لأنه مريض. وعلى هذا الأساس تم التخلي تماماً على الثنائية القديمة التي كانت تصنف الفرد بأنه مجرم أو مريض وفقاً لمصطلحات القانون المدني. والآن فإنه ليس ثمة سوى إمكانيتين: أن تكون مريضاً قليلاً ومجرماً بشكل حقيقي أو أن تكون مريضاً تماماً ومجرماً أقل. القصد من هذا أن الفاعل الجنائي لا يستطيع الهروب من أن يضفى عليه الطابع المرضي عليه، مؤخراً في فرنسا كتب سجين سابق كتاباً يشرح فيه أنه إذا كان لصاً فإن ذلك بسبب أن والدته لم تحبه في الماضي، أو نتيجة لضعف ضميره الأخلاقي أو معاناته مثلا من الاضطرابات ولكن فقط بسبب أنه خلق لأن يكون لصا ولأن يمارس السرقة.
إن التفوق الذي يقترن بعلم الأمراض، أضحى شكلاً عاماً لتنظيم المجتمع، إذ لم يعد للطب مجال خارجي، يتحدث فيتش عن “الوضع التجاري المغلق[10]” لوصف الوضع في بروسيا سنة 1819. فالصحة والطب كان ينظر إليهما بمثابة مشاكل اقتصادية، كما أن الطب قد طوّر نفسه لأسباب اقتصادية. يمكننا التأكيد في ما يتصل بالمجتمع الحديث الذي نعيش فيه أننا في “دول طبية مفتوحة” حيث يكاد التطبيب لا يعرف حدوداً. ومن تم يمكن تفسير بعض المقاومات الشعبية للتطبيب باستحضار هذه السيطرة المستمرة والدائمة للطب في الحياة اليومية.
لكي أنهي، أود أيضاً أن أعرض سمة أخرى للطب الحديث، أو ما يمكن أن نطلق عليه الاقتصاد السياسي للطب. هنا مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بظاهرة حديثة على اعتبار أن الطب والصحة منذ القرن الثامن عشر كانا يُعتبران ظواهر اقتصادية. لا يجب أن ننسى أن أول وأكبر وباء ضرب فرنسا في القرن الثامن عشر والذي يسهل الحصول وتجميع معطيات، لم يكن في حقيقة الأمر وباءً بشرياً لكنه وباء حيواني. فالارتفاع الكارثي للوفيات في بعض القطعان جنوب فرنسا هو ما ساهم بقوة في تشكيل المجتمع الملكي للطب. فالأكاديمية الفرنسية للطب قد شهدت ولدتها إثر وباء حيواني وليس وباء صحي بشري. وهذا ما يوضح بأن المشاكل الاقتصادية هي التي حفزت بداية تنظيم الطب.
ويمكن بنفس الطريقة أن نؤكد أن علم الأعصاب للطبيب (Duchesne de Boulogne) ولد تبعاً لحوادث السكك الحديدية وحوادث الشغل طرأت قبيل سنة 1860، في الوقت الذي طرحت فيه مشكلة التأمينات وفقدان القدرة على الشغل والمسؤولية المدنية للمشغلين فالمسألة الاقتصادية تظل حاضرة في تاريخ الطب.
المفارقة في الوضعية الحالية تتمثل في كون الطب مرتبط بالمشاكل الاقتصادية الكبرى من جانب مغاير مختلف عما كان. ففي السابق، كنا نطلب من الطب في الواقع أن يمكن من مجتمع أفراد أقوياء، أي قادرون على العمل، وضمان صيانة قوة العمل تطوير مردوديته. فعدنا الآن، إلى الطب كأداة للصيانة والتجديد لقوة العمل بغية اشتغال المجتمع الحديث.
يلتقي، في عصرنا الراهن، الطب والاقتصاد عبر طريق آخر، ليس فقط لأنه قادر على إعادة قوة العمل، ولكن أيضاً لأنه بات بإمكانه أن ينتج مباشرة ثروة في الحدود الذي تمثل فيه الصحة رغبة في نظر البعض وامتيازاً للأخرين. لقد أصبحت موضوعاً للاستهلاك والذي يمكن إنتاجه من طرف المختبرات الدوائية، من طرف الأطباء…إلخ والذي تستهلك –من طرف الأخرين -مرضى حقيقيين أو مفترضين، ما اكسَبَهُ أهمية اقتصادية عبر إدماجه في السوق. وهكذا فإن الجسد الإنساني قد دخل السوق بشكل مزدوج أولاً: عبر الأجر، حيث يبيع الرجل جهد العمل. وثانياً عبر وسيط الصحة. ونتيجة لذلك، فإن الجسد الإنساني يدمج من جديد في السوق الاقتصادية بمجرد أن صار معرضا للمرض أو الصحة، السعادة أو الألم، الراحة وأيضاً عندما موضوعاً للرغبة أو الإحساس.
وانطلاقاً من اللحظة التي أدمج فيها الجسد الإنساني في السوق، عبر استهلاك الصحة، ظهرت ظواهر مختلفة آثارت اختلالات وظيفية في نظام الصحة والطب الحديث. وعلى عكس ما ننتظره، فإن إدماج الجسد الإنساني في نظام الاستهلاك والسوق لم يرفع من مستوى الصحة. إن إدماج الصحة في نظام اقتصادي يمكن حسابه وقياسه يشير إلى أن مستوى الصحة لايؤثر على المجتمع بنفس القدر الذي يؤثر به مستوى المعيشة. فمستوى الحياة يعرف بمدى القدرة على استهلاك الأفراد؛ إذا كان ارتفاع معدل الاستهلاك يؤدي إلى الرفع من مستوى الحياة، وبشكل عكسي، لا يطور الاستهلاك الطبي مستوى الصحة. درس الاقتصاديون وقائع مختلفة من هذا النوع، شارلز لوفينزون ([11]Charles Levinson) في دراسة حول إنتاج الصحة، يبين أن الرفع بنسبة 1 بالمئة من استهلاكية الخدمات الطبية يؤدي إلى خفض نسبة الوفيات بنسبة0,1 بالمئة. يمكن اعتبار هذا التشويه عادياً، إلا أنه لا يظهر سوى في إطار نموذج خالص وخيالي. وانطلاقاً من اللحظة التي سمحت بتوطين الاستهلاك الطبي على مستوى الواقع، نكتشف أن متغيرات الواقع وخصوصاً الاستهلاك الغذائي، التربية، المداخيل الأسرية هي عوامل تُؤثر في معدلات الوفيات كما في الاستهلاك الطبي. وهكذا فإن زيادة المداخيل التي يمكن تكون لها تبعات سلبية على معدل الوفيات، هي أكثر فعالية بشكل مضاعف من استهلاك الأدوية. ونعني بهذا، أن المداخيل تزداد بنفس درجة تطور استهلاك الخدمات الطبية. فالفائدة التي تمثلها الزيادة في الاستهلاك الطبي سيتم إلغائها عبر الزيادة الطفيفة للمداخيل، وعلى نحو مماثل تؤثر التربية في مستوى الحياة بضعف نسبة أكثر من الاستهلاك الطبي. ويتبع ذلك، أن تستلزم رغبة العيش أطول مدة، مستوى جيد من التربية أفضل من الاستهلاك الطبي.
إذن، إذا كان الاستهلاك الطبي يمثل واحداً من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في معدلات الوفيات، نلاحظ أن هذا العامل هو أكثر ضعفاُ من بين المتغيرات الأخرى. تبين الاحصائيات لسنة 1970 أنه وعلى الرغم من الزيادة المستقرة للاستهلاك الطبي، فإن معدل الوفيات كواحد من المؤشرات المهمة للصحة لم ينخفض وبات في ارتفاع كبير عند الرجال كما النساء.
وتبعاً لذلك، فإن مستوى الاستهلاك الطبي وكذا مستوى الحياة لا تجمعهم علاقة مباشرة مما يكشف عن برادوكس اقتصادي حيث يمكن نمو الاستهلاك من أي ظاهرة إيجابية من حيث الصحة أو الوفيات.
إن هذا الدمج للصحة في الاقتصاد السياسي قد كشفَ عن برادوكس(paradoxe) آخر: فالتحويلات الاجتماعية التي نأملها في أنظمة الحماية الاجتماعية لا تؤدي وظيفتها المعهودة. وأكثر من ذي قبل فإن التفاوتات على مستوى الاستهلاك الخدمات الطبية صارت في الواقع مهمة. فالأغنياء ما يزالون يلجؤون أكثر من الفقراء إلى الخدمات الطبية، وهذا هو الحال الآن في فرنسا، والنتيجة هي أن المستهلكين الصغار الذي هم الفقراء يؤدون عبر مساهماتهم الاستهلاك الفائق للأغنياء عبر صناديق الحماية الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإن الأبحاث العلمية والشطر الأكبر من التجهيزات الاستشفائية الأكثر كلفة يتم تمويلها من طرف التأمين الاجتماعي (Sécurité Sociale) في حين أن القطاعات الخاصة أكثر مردودية لكونها تستعمل تجهيزات تقنية أقل تعقيداً. وهو ما نسميه في فرنسا بالفنادق الاستشفائية. بمعنى العلاج لفترة وجيزة، مثل العمليات الصغيرة التي تنتمي للقطاع الخاص المدعوم عن طريق التمويل الجماعي والاجتماعي للأمراض.
نرى من تم أن المساواة من حيث الاستهلاك الطبي التي ننتظرها من الحماية الاجتماعية تبدو مشوهة لصالح نظام يسعى في كل مرة إلى إعادة تشكيل التفاوتات الكبرى للمرض والموت. والآن فإن الحق في المساواة في الصحة للجميع يندمج في آليات تحول إلى عدم مساواة.
يواجه الأطباء المشكل التالي: من المستفيد من التمويل الاجتماعي للطب، الأرباح المستخلصة من الصحة؟ يبدو وكأنهم الأطباء. ولكن في الواقع لا يسير الأمر هكذا. ذلك أن الأجور التي يتقاضاها الأطباء، مهما كانت مهمة في بعض البلدان فإنها لا تمثل في نفس الوقت سوى جزء صغير من العائدات الاقتصادية للمرض والصحة. بينما تُعد شركات الأدوية الكبرى، الأكثر تحقيقاً للربح. تُدعم صناعة الأدوية عن طريف مؤسسات الضمان الاجتماعي والتي تتحصل على تمويلاتها من المساهمين الذين يتوجب عليهم حماية أنفسهم من الأمراض. إذا لم تكن هذه الوضعية بعد مترسخة في وعي المستهلكين للرعاية الصحية، أي المُؤمن عليهم فإنها معروفة تماماً للأطباء. لقد بات هؤلاء المهنيون يدركون دورهم في الوساطة بين الصناعة الدوائية وطلبات الزبون؛ بصيغة أخرى، بين موزعين للأدوية والعلاج. إننا نعيش وضعية حيث وصلت الأحداث ذروتها. وهي بالذات نفس الأحداث التي ميزت التطور الطبي منذ القرن الثامن عشر عندما ظهر الاقتصاد السياسي للصحة وعندما بدأت عمليات آليات البيو-تاريخية؛ من تم فإن الأزمة الحالية للطب ليست سوى سلسلة من الظواهر الإضافية المتفاقمة التي تعدل بعض جوانب الاتجاه ولكنها لا تبتكر هذا الاتجاه.
لا يجب اعتبار الوضع الحالي في سياق الطب أو ضد الطب، سواء في توقف أو عدم توقف التكاليف، العودة أو عدم العودة إلى نوع من النظافة الطبيعية… هذه البدائل ليس لها معنى. وبدلاً من ذلك فما قد يكون له معنى فهة محاولة فهم طبيعة التقدم الصحي والطبي في هذه المجتمعات من النمط الأوروبي اعتباراً من القرن الثامن عشر، ومن تم يجب البحث عن نبحث في الظروف التي يمكن ان يتم تطبيقها بفاعلية في هذه المجتمعات؛ أي بدون النتائج السلبية التي نعرفها.
لذلك أعتقد أن ثمة فائدة أساسية في إعادة استكشاف تاريخ الطب وهي معرفة التاريخ الوظيفي لهذا التخصص منذ القرن الثامن عشر بدلاً من التطرق للأزمة الطبية الحالية والتي هي تم تلَقّيها على نحو خاطئ. كما يهدف إلى فهم النموذج التاريخي لعمل هذا الاختصاص لمعرفة حدود وإمكانية تعديله. إنه إذن نفس المشكل المطروح بالنسبة للاقتصاديين المعاصرين والذين يدرسون الإقلاع الاقتصادي في أروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر لتحديد ما إذا كان بإمكانهم تكييف هذا النمط التنموي للمجتمعات التي لم تصل بعد لمرحلة الصناعية.
سيكون من الواجب أن نُكون قادرين على الحياد والثقة إزاء التأكيد أنه لا ينبغي رفض النموذج الطبي الحالي أو قبوله كما هو؛ بل ينبغي أن نفهم وندرك أن الطب هو جزء من نظام تاريخي متواصل وليس علماً خالصاً بقدر ما هو جزء من نظام اقتصادي ونسق للسُّلطة والمجتمع لتحديد إلى أي مدى يمكن تصحيح هذا النموذج.
[1]Ivan Illich, Nemesis, The Expropriation of Health, patheon, Londres, 1982
للاستزادة:
– Sir William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, (London :Majestry’s stationery office), November 1942.
[3] مصطلح يشير إلى الهيمنة أو السيطرة المفرطة للجسد أو الجسم على الأمور الاجتماعية والسياسية والثقافية. يتم تكوين المصطلح من الجذامين اليونانيتين “سوما” التي تعني “جسد”، و”كراسيا” التي تعني “حكم” أو “سيطرة”. يستخدم المصطلح لوصف حالة تمكن فيها الجسد أو المظهر الخارجي من تحديد أو تحكم في القوى والقيم الاجتماعية والثقافية، وغالبًا ما يترتب على ذلك استنساخ أو اعتماد معايير الجمال الجسدي أو القوام الفسيولوجي كمعيار أساسي للقبول أو النجاح في المجتمع. (المترجـم)
[4] Robert C. Talley MD (1967) Evaluation of Atypical Mycobacteria in an Outpatient Clinic, Archives of Environmental Health: An International Journal, 14:2, 292-298, DOI: 10.1080/00039896.1967.10664734
[5]يستخدم ميشيل فوكو تعبيرAgent Infectieux للإشارة إلى الفيروسات والفطريات التي تدخل جسد الانسان.
[6]ألفونس غيران هو جراح فرنسي ولد في الــ9 من غشت سنة 1816 وتوفي في 21 فبراير 1895 في باريس. قاد العمليات الجراحية الأولى في مستشفى سان لويس منذ سنوات الأربعينيات من القرن التاسع عشر. (المترجم)
[7] يعد مفهوم البيو-تاريخ واحداً من المفاهيم الأساسية في فكر ميشيل فوكو وهو مفهوم مركب يرتبط بالتحليل النظري والبحث الاجتماعي للعوامل البيولوجية وتأثيرها على مسارات التاريخ والمجتمع. (المترجم)
[8] في مقابل الاصطلاح الألماني: (Staatsmedizin)
[9]Raspail (F.-V.), Histoire naturelle de la santé et de la maladie, suivie du formulaire pour une nouvelle méthode de traitement hygiénique et curatif, Paris, A. Levavasseur, 1843, 2 vol.
[10] Fichte (J. G.), Der geschlossne Handelsstaat, Tübingen, Coota, 1800 (L’État commercial fermé, trad. D. Schulthess, Lausanne, L’Âge d’homme, coll. «Raison dialectique», 1980).
[11]اقتصادي ونقابي كندي