دراسة لتاريخ اليونان االثقافي والفكري والسياسي عند المؤرخين المسلمين: اليعقوبي، المسعودي، الطبري
Study of The Greek History :cultural,intellectual and political aspects by Muslims historian Almasidi‘Al Tabari and Al Tabari and Al-Yaqoobi
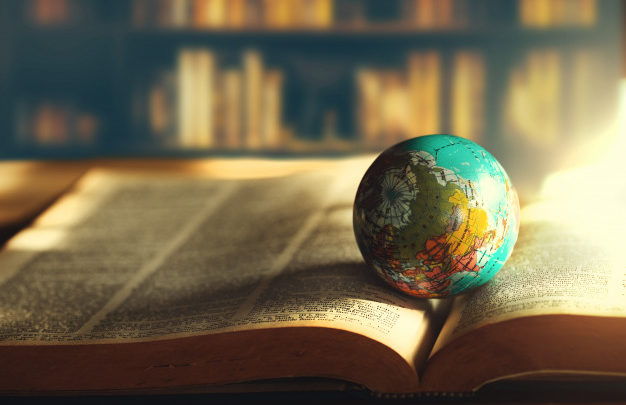
اعداد : ردينة بشارات – جامعة النجاح الوطنية
- المركز الديمقراطي العربي
المقدمة:
تعود بنا الدراسة الى فترة القرن الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين، حيث تناول المؤرخون المسلمون في مصادرهم الأساسية حول التاريخ اليوناني من النواحي الفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية بشكل اساسي ،وتهدف الدراسة الى قراءة وتحليل لتاريخ اليونان عند كل من اليعقوبي (ت292ه/905م)،في كتابة تاريخ اليعقوبي، والطبري (ت310ه/922م)، في كاتبة تاريخ الرسل والملوك، والمسعودي (ت346/957م)،في كتابة مروج الذهب ومعادن الجوهر.
وتكمن اهمية البحث في اعتماده على مصادر أساسية ،تحتوي معلومات رئيسية عن الحياة اليونانية من خلال المحاور الرئيسية الاتية من الجوانب السياسية والعسكرية والثقافية والفكرية، برغم من قله المعلومات وصعوبة ايضاح الفكرة الاساسية لبعض الجوانب ،وحتى لم تتطرق مصادر الدراسة في الحديث عن الجوانب الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية والدينية.اقتضت الدراسة ان يكون البحث في فصلين الفصل الأول تناول دراسة المصادر الاساسية التاريخية التي ارتكز عليه البحث بشكل أساسي، وتضمنت هيكليه للمادة العلمية التي اوردتها وترجمة لحياة المؤرخين الثلاثة.
في حين تناول الفصل الثاني تطور للحياة السياسية عند اليونان،من حيث نشأة للبلاد اليونان والأصول التي ينتمون اليها ،وأنسابهم،وانفرد اليعقوبي في الحديث عن اهم العلوم الفلسفة والحكمة في المجتمع اليوناني، بأسلوب سلسل واضح واتباع الأسلوب الوصفي، وخاصة العلوم التي تعتمد على الجانب العقلي والتحليلي المثبتة بالحجة والبرهان كما أظهرت العلل والمسببات بهدف الوصول الى حقائق الأمور والأشياء.
وتناول الفصل الثاني توليه الإسكندر المقدوني لعرش اليونان من بعد والدة فيليب، الذي لمعت في عهده مدينة مقدونيا، وعرف بحنكته القتالية وحب السيطرة والاستيلاء على العالم المجاورة له ،وتعلم عن والدة اسرار القتال وفنون القيادة الحربية، الذي جعلة قائدا ناجحا حيث جمع بين الفلسفة والقيادة ،وطبية البيئية المقدونية وذكره المؤرخين بعدد من التسميات ،الاسكندر الاكبر، الاسكندر الثالث، كما شاع اسمة عند العرب بالإسكندر المقدوني او بذو القرنيين.
وشملت توسعاته اصطداما بالإمبراطورية الفارسية التي جاورته، من الشرق وهذه الإمبراطورية الشاسعة التي امتدت من مصر والبحر المتوسط من البحر ،وصولا الى الهند واسيا الصغرى وشملت سياسية التوسيعية اسيا الصغرى وصولا الى سوريا ومصر كما استولى جميع المدن التي تقع على الساحل الساحلي ،وشملت غزواته بلاد الشام وبابل وصولا الى فلسطين. وقد ساعد على هذا التطور الى الانفتاح مع العالم الخارجي وجعلته مركز الاشعاع الفكري والفني والحضاري.
ويعول نجاح سلطته السلطوية اعتماده على الفلاسفة والحكماء واخذ مشورتهم في امور الإمبراطورية. ولنهاية كانت بلاد اليونان كباقي الإمبراطوريات تحمل اسم الملك لقب اسوة بغرهم من الإمبراطوريات الاخرى فكان جميع من خلف الاسكندر المقدوني يحمل لقب بطليمس، الأول والثاني وهكذا.
الفصل الأول :دراسة في المصادر
– اليعقوبي[1] هو أحمد بن إسحاق (أبو يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح[2] لقب بالإخباري[3]، بسبب اشتغاله بالكتابة والتدوين واهتمامه بالأخبار[4]، ولقب بالأصفهاني نسبة إلى مدينة أصفهان التي يعتقد أن أصلهُ منها، وأطلق عليه البعض لقب المصري [5] والذي يبدو أنه أخذه عن جده واضح بسبب اشتغاله عام(162هـ /778م) والياً على مصر في عهد الخليفة أبي عبد الله المهدي (ت 158-169هـ / 775- 785م)[6]، إلا أن اللقب الذي غلب عليه هو اليعقوبي [7]، وهو لقب أخذه عن أبيه إسحاق المكنى بأبي يعقوب، ويبدو أن انتشار شهرة أحمد العلمية، وبروز دور عائلته في مجال الإدارة أدت إلى تغليب هذا الاسم عليه[8].
ولد اليعقوبي في بغداد[9]، ونشأ وترعرع فيها، إلا أنه غادرها مبكراً عام(260هـ / 873م) إلى أرمينية، وخراسان [10]، وهو مؤرخ جغرافي ذو شهرة واسعة، كثير الأسفار، زار في رحلاته بلاد الهند[11]، وأرمينية، وإيران ومصر، وبلاد المغرب، ودوَّن مشاهدته في كُتبه[12].
ولم تذكر المصادر أي معلومات مفصلة عن أسرة اليعقوبي، إلا أنها أوردت معلومات متفرقة عن جده الأعلى واضح، فذكر بعضها أنه كان مولى للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور(136-158هـ/ 754-775م)[13]، وألحقته أحياناً بالخليفة نفسه[14]، وأشارت أخرى إلى أنه كان مولى للخليفة المهدي[15]، وفي الوقت الذي أطلق بعضها عليه اسم واضح بن عبد الله المنصوري الخصي[16]، إلا أن جميع هذه المصادر لم تحدد أصله، واختلفت الدراسات الحديثة في تحديده أيضاً، إذ أشار بعضها إلى أنه فارسي من مدينة أصفهان [17]، وتشكك بعضها الآخر بين الفارسي والأرمني[18].
واعتنق واضح المذهب الشيعي، ودفع حياته ثمناً لذلك، إذ قام عام 169هـ/785م بتهريب إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى المغرب[19]، مما دفع الخليفة الهادي إلى أن يأمر بقتله[20]. وتشير بعض المصادر إلى أن مقتل واضح يعود أيضاً لتخلفه عن بيعة الرشيد[21]. وقيل إن الخليفة الرشيد هو الذي أصدر الأمر بذلك[22].
واختلف المؤرخون في سنة وفاته، فقال الحموي: سنة (284هـ\ 897م[23])، ولكن كتاب مشاكلة الناس لزمانهم يتضمن حديثاً لليعقوبي عن فترة الخليفة أحمد بن محمد المعتضد بالله (279-289هـ/892-903م)[24]. ويشير البلدان إلى أن اليعقوبي ضمنه مجموعة من الأشعار نظمها ليلة عيد الفطر في سقوط الدولة الطولونية عام (292هـ\ 904م)[25].
كما صنف كتباً تاريخية وجغرافية عديدة منها :التاريخ والبلدان، وأسماء الأمم السالفة، ومشاكلة الناس لزمانهم [26]، والمسالك والممالك[27]، وفتوح المغرب[28].
ويتألف كتاب التاريخ موضوع الدراسة عند اليعقوبي من جزأين، الأول يبدأ بالخليقة مستعرضا سيرة الأنبياء والرسل، وتاريخ الفرس والعرب قبل الإسلام، إضافة إلى تاريخ الأشوريين والبابليين والهنود والصينيين واليونان والمصريين والبربر والزنوج والترك[29]. وقد خصص الجزء الثاني للتاريخ الإسلامي، مبتدئاً بمولد الرسول (ص) وغزواته حتى وفاته، ثم تتبع تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى أحمد المعتمد على الله(256-279هـ/ 870-892م)[30].
اتخذ اليعقوبي نظرة نقدية إلى مصادره في القسم الأول التي استعان بها في إيراد المادة عن بلاد اليونان[31]، واستعمل في كثير من الأحيان صيغة يزعم النسابون دون ذكر أسمائهم [32]، في حين أظهر في مقدمة الجزء الثاني أهم المصادر التي استعان بها، ويبين انه رجع إلى “ما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء والرواة وأصحاب السير والأخبار والتأريخات” ووجد أنهم “اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم وفي السنين والأعمار” فحاول أن يمحصها وان يأخذ جميع المقالات والروايات، وان يؤلف بينها لكتابة تاريخيه. وهو يرى ضرورة لإعطاء الأسانيد، وذلك لان النظرة إلى الأسانيد التاريخية الهامة استقرت قبله، ولذا فانه يكتفي بذكر مصادره الأساسية في مقدمة القسم الثاني[33].
وقد عبَّر اليعقوبي في تاريخه عن فكرة التاريخ العالمي، وقدم ملخصا متسلسلاً له، وأبرز مراحل تاريخ الأمة الإسلامية في مختلف المجالات السياسة والثقافية المختلفة، فقد استعرض التاريخ الإسلامي حسب تسلسل الحوادث على السنين، وتوالي الخلفاء، سعيا منه لكتابة التاريخ بصورة واضحة ومختصرة [34]، وتميز أسلوبه بالوضوح والانسجام والخلو من الألفاظ الشاذة أو التعابير الغريبة، ولم يهتم بالصنعة البيانية وتزويق الألفاظ كبعض المؤرخين[35].
وقد أفاد اليعقوبي البحث من خلال معلوماته الهامة التي قدمها عن بلاد اليونان، من حيث استعرض التطورات الثقافية من حيث أشهر علماء وفلاسفة اليونان واسهب بشكيل كبير حول علومهم التطبيقية والطب الذي اعتبره عمدة إنجازاتهم العلمية، كما عرض اهم التطورات السياسية فتناول فالفترة الأولى من حكمهم، وقد اكتفى بعرض موجز وسريع لملوك اليونان الأوائل دون الخوض في تفاصيلهم، كما أنه لم يتطرق في حديثه إلى ذكر جميع ملوكهم[36]. وكان تركيزه في حديثه عن الفترة اليونانية خلال حكم الاسكندر المقدوني وغزواته على بلاد فارس بشكل مختصر ومركز، وانفرد ببعض التفاصيل عن غيره وعرضها بأسلوب واضح ومتسلسل [37].
2– الطبري[38]:هو محمد بن جرير بن يزيد كثير[39]، وقيل خالد[40]، ابن غالب، ويكنى بأبي جعفر رغم عدم زواجه[41]، بسبب انقطاعه لطلب العلم والتصنيف والتدريس، ويعتقد أنه تكنى بذلك التزاماً بآداب الإسلام وامتثالاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رغّب المسلمين باتخاذ الكنى[42].
ولد عام (224هـ / 838م)[43]، وقيل عام (225هـ /839م) بآمل[44]، ولقب بالآملي نسبة إلى مكان ولادته في مدينه آمل*[45]، من أعمال طبرستان*[46]، وقيل البغدادي بسبب استقراره في بغداد حتى وفاته[47].
انفرد بروكلمان بنسبته إلى الأصل الفارسي بسبب “… ذكرته الموافقات التاريخية بين ما يعرضه من أخبار بدء الخلق المستقاة من الكتب المقدسة وبين أخبار الأساطير الفارسية “[48]. واعتماده على هذا السبب ليس صحيحاً، لأن الطبري لم يقصر هذه الموافقات على الأساطير الفارسية بل له موافقات بين أخبار بدء الخلق والأساطير البيزنطية[49]، ودعم بروكلمان فكرته عن أعجمية الطبري بولادته في بلدة آمل من أعمال طبرستان [50] وهو استناد لا يمكن القبول به أبداً لأن المسلمين دخلوا هذه المناطق عام (29هـ/ 649م) أي قبل ولادة الطبري بمئة وخمس وتسعين عاماً، ثم تعرضت لهجرات عربية واسعة، علاوة على كونه أحد أكبر المدافعين في مؤلفاته عن الأمة واللغة العربية [51].
نشأ الطبري في كنف أسرة ذات ورع وتقوى وعلم، وتربى في أحضان والده الذي أولاه الرعاية والاهتمام، وحثه وهو صبي صغير على طلب العلم والتفرغ من أجله، فحفظ القرآن وعمره سبع سنين، وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنوات، وكتب الحديث وهو في التاسعة من عمره، كما شجعه والده على الرحلة من أجل العلم وعمره اثنتا عشرة سنة[52]، وقيل عشرون سنة[53].
وعدَّ الطبري من أكثر العلماء ورعاً وزهداً وأمانة، وكان “عازفاً عن الدنيا تاركاً لها ولأهلها، يرفع نفسه عن التماسها”[54]، لا تأخذه في الله وفي الحق لومة لائم[55]، على الرغم مما يلحقه ذلك به من “الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد “[56].
تنقل الطبري بين مختلف المراكز العلمية في عصره طلباً للعلم، حيث زار الري وبغداد، والبصرة، والكوفة[57]، ثم اتجه إلى مصر عام (256هـ/869م) وقيل عام (263هـ/876م)[58]، ومرّ بطريقه على دمشق[59]، وبيروت[60]، ثم عاد ثانية إلى بغداد، ورحل منها إلى طبرستان عام (290 هـ /902م)، لكنه ما لبث أن عاد إلى بغداد للمرة الثالثة، واستقر في رحابها، وانقطع للقراءة والتأليف والتدريس[61].
وتلقى علومه على عدد من الشيوخ [62] منهم فقهاء من أبرزهم في الري: محمد بن حميد بن حيان، أبو عبد الله الرازي (ت248هـ/ 862م) وهو(محدث وفقيه)[63]، ومحمد بن مقاتل الرازي(ت248هـ/ 862م) الذي أخذ عنه فقه العراق (فقيه) [64]، وأحمد بن حماد بن سعد، أبو محمد الأنصاري الرازي الدولابي (ت296ه/908م) الذي كتب عنه كتابه “المبتدأ والمغازي” وهو (فقيه ومؤرخ)[65].
وفي بغداد أخذ الحديث عن أحمد بن منيع، أبي جعفر البغوي البغدادي (ت244هـ/ 858م) (محدث وفقيه) [66]، وإسحاق ابن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجرا، أبي يعقوب المروزي(ت245هـ/859م) (محدث وفقيه)[67]، والحسن بن محمد بن الصباح، أبي علي البغدادي
الزعفراني (ت 260هـ/873م) (محدث وفقيه)[68]، ومنهم أدباء مثل أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار، أبي العباس، (ت 291هـ/903م) (نحوي)[69]، ودرس فقه الشافعي عن الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار، أبي سعيد الاصطخري(ت328هـ/939) (فقيه)[70].
ويلاحظ أن معظم شيوخ الطبري كانوا من المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والنحويين، عراقيين وشاميين ومصريين، حيث كان لهم أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية، ورفدوا ثقافته الواسعة، حتى إنه جمع بين العلوم الدينية وعلم التاريخ، فأصبح أحد أعلام عصره، وتصدر مركزاً مهماً بينهم، وحرص على الاطلاع على مختلف المذاهب الفقهية [71].
إلا أن الملاحظ على شيوخه ندرة المختصين أو المشهورين من الإخباريين أو المؤرخين، وكثرة علماء الدين بشكل خاص، ويبدو أن اهتمام الطبري الرئيس انصرف إلى الجانب الديني، في حين ظل الجانب التاريخي مكملاً ومتمماً له[72].
تميزت الفترة التي عاش فيها الطبري بوجود العديد من الخلافات المذهبية والاضطرابات السياسية، الأمر الذي جعل الاتهام بالبدعة أو التشيع عملاً شائعاً في ذلك العصر، وخاصة بين العلماء الأقران الذين كانت تختلف وجهات نظرهم العلمية [73].
وأشار الحموي في كتابة معجم الأدباء أنه اتهم من قبل الحنابلة بالتشيع؛ لإغفاله ذكر أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م) في كتابه اختلاف الفقهاء، واعتباره إياه محدثاً وليس فقيهاً[74]، وخاصة أن الحنابلة كانوا في بغداد خلال هذه الفترة “ألوفاً” لالتفاف الناس حول مذهب أحمد بن حنبل، بسبب موقفه من خلق القرآن في عهد الخليفة المأمون والمعتصم (218-227هـ/833-842م)[75].وقد قذف الحنابلة دار الطبري بالحجارة، ومنعوا طلابه من الدخول عليه “فركب نازورك صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة “[76]، و”ظلمته الحنابلة “[77]، فخلا الطبري في داره، وصنف لهم كتاباً “أسماه الاعتذار ذكر فيه مذهب أحمد بن حنبل واعتقاده، وجرح من ظن فيه غير ذلك”[78].
وأضافت بعض الدراسات الحديثة أسباباً أخرى لاتهامه بالتشيع مثل انفراده بمذهب مستقل، وعدم أتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، بالإضافة إلى كونه من أهل بلدة عرفوا بتشيعهم [79]، كما أشارت هذه الدراسات إلى أن تتلمذه على شيوخ اتهم بعضهم بالرفض مثل محمد بن حميد الرازي(ت230هـ/884م)، واستناده في تفسيره إلى أشعار الشاعر الشيعي الكميت بن زيد (ت126هـ/743م)، تشكل عوامل إضافية تدعم الاتهامات الموجهة إليه بالتشيع[80]، وهذه الأسباب لا تصلح لأن تكون أدلة علمية لضعف الأسس التي استندت إليها[81]، خاصة وأن مقارنة آراء الشيعة الرئيسية مع ما أورده الطبري في مصنفاته، يكشف النقاب عن الاختلاف الكبير بين أفكاره وأفكارهم[82].
توفي الطبري عام (310هـــ/922م)[83] “، ودفن في بغداد ليلاً خوفاً من العامة لأنه اتُّهم بالتشيع… ولم يؤذن به أحد ” [84]، وقيل دفن في ضحى النهار[85]، واجتمع عليه من لا يحصيهم عدداً إلا الله، وصلي على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً [86]. وأشارت معلومات أخرى إلى أنه توفي عام(311هـ/923) أو (316هـ/928م)[87]. وذكر ابن خلكان (ت681 هـ/1282م) رواية تدلل على شهرة الطبري وارتباط تلك الشهرة بتاريخه، فقال:” ورأيت بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبراً يزار، وعند رأسه حجر عليه مكتوب هذا قبر ابن جرير الطبري، والناس يقولون: هذا صاحب التاريخ وليس بصحيح، بل الصحيح أنه توفي في بغداد”[88].
أشاد كثير من أئمة الحديث والفقه والأدب والتاريخ بمكانة الطبري العلمية وسعة ثقافته، وسلامة دينه وورعه وقوة إخلاصه وصدقه، وجليل قدره وفضله، فهو ” علامة وقته وإمام عصره وفقيه زمانه…. في جميع العلوم، علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه”[89]. واعتبر “أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله عز وجل، عارفاً بالقرآن، بصيراً بالمعاني، فقيهاً بأحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم”[90] وهو ” المحدث الفقيه المقرئ المعروف المشهور”[91].ووصف بأنه “أفضل من رأيناه فهماً وعناية بالعلم ودرساً له…”[92]، وهو من ” أبرز أئمة التفسير والفقه والتاريخ”[93] ومن “المجتهدين الذين لم يقلدوا أحداً”[94]، واعتبر “فقيه العالم “[95].
صنف الطبري ستةً وأربعين كتاباًً[96] في شتى أنواع المعرفة، مثل: التفسير، والحديث، والقراءات، والفقه، والتاريخ. وقيل مكث ” أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة…”[97]، وقيل ” إن قوماً من تلاميذ ابن جرير حصّلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق”[98]، وقد أثرت العلوم التي حذقها أو ألف فيها الطبري تأثيراً كبيراً على تفسيره وتاريخه[99].
ويمثل كتاب تاريخ الرسل والملوك [100] أو “تاريخ الأمم والملوك”[101] أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه على منهج مرسوم، وساقه في طريق استقرائي شامل، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان.
وعّده المؤرخون قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب في فترة التكوين[102]، وقد وصفه المسعودي (ت 345هـ/956م) فقال:” وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي على المؤلفات، والزائد على الكتب والمصنفات، فقد جمع أنواع الأخبار، وحوى فنون الآثار.
واشتمل على صنوف العلم، وهو كتاب تكثر فائدته، وتنفع عائدته، وكيف لا يكون كذلك، ومؤلفه فقيه عصره، وناسك دهره”[103]، وقال عنه ياقوت الحموي: “وهذا الكتاب من الأفراد في الدنيا فضلاً ونباهة، وهو يجمع كثيراً من علوم الدين والدنيا”[104]، أما ابن خلكان (ت681هـ/1282م) فقد عَدَّ تاريخ الطبري “أصح التواريخ وأثبتها”[105].
يتألف تاريخ الرسل والملوك من قسمين: الأول ما قبل الإسلام: منذ بدء الخليقة ولغاية البعثة النبوية الشريفة، وهذا القسم تناول فيه بدء الخليقة، وهبوط آدم وحواء، وإبليس، وقصة قابيل وهابيل، ثم عرض الأنبياء من بداية خلق آدم وصولا لمحمد (ص) قبل الهجرة[106].
ثم تحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم، ثم ذكر ملوك الروم منذ المسيحية، واقتصر على سرد قائمة بأسماء الملوك ومدة حكم كل ملك. ثم عطف على عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم. ثم أشار إلى ملوك اليمن من التبابعة وغيرهم، وقصة جذيمة الأبرش مع الزباء الملكة المعروفة، وأخبار المناذرة والغساسنة. ثم تحدث عن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم تناول جزءاً من سيرته قبل البعثة[107].
وفي القسم الثاني تناول التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول (ص) حتى عام(302هـ/ 914م)، ويمكن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة أجزاء: عصر الرسول والخلفاء الراشدين،العصر الأموي،والعصر العباسي[108].
أفاد البحث من روايات الطبري التي قدمت معلومات هامة في المجال السياسي، فذكر تاريخ اليونان، وخصوصاً الاوضاع السياسية والعسكرية لبلاد اليونان وتولي الاسكندر المقدوني عرش الإمبراطورية، واهم إنجازاته العسكرية، و فتوحاته في مشارق الارض ومغاربها ووصف فترة حكم الاسكندر مليئة بالصراعات وعدم استتباب الامن في البلاد ا وكثيرة غزواته[109]،ولم يتطرق الطبري إلى الحياة الثقافية كعلوم اليونان وآدابهم واشهر فلاسفتهم وحكمائهم.
3– المسعودي: هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود[110]ويبدو أن لقبه أخذ من نسبه إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود [111]، الذي لازم الرسول (ص) في سيرته وغزواته[112]. ولد المسعودي بإقليم بابل من أرض العراق على ما ذكره في “مروج الذهب ” وأشار إلى ذلك بقوله “وأوسط الأقاليم الذي ولدنا به هو إقليم بابل، وولد في قلوبنا الحنين إليه إذ كان وطننا ومسقطنا”[113].
بينما ذكر الذهبي (ت748هـ/1347م) والصفدي (ت 764هـ/1362م) أنه ولد في بغداد[114]، وانفرد ابن النديم (380هـ /990م) بالقول إنَّ المسعودي ولد في المغرب[115]، وقد وقع في السهو والخطأ عندما ذكر ذلك. ويبدو لي أن الخطأ ناتج عن رحلات المسعودي الكثيرة وتنقله بين الأقطار؛ فلعله يكون قد أقام ببلاد المغرب لفترة من الزمان فنسب إليها. وقد كتب بحرارة عن حنينه لوطنه وحبه وشوقه للعراق الذي ولد ونشأ فيه” وإن من علامة وفاء المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه، وأن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة”[116].
واستقرت أسرة المسعودي في الكوفة واهتمت بالعلم والأدب ولم تتدخل في أمور السياسية والصراعات التي شهدتها البلاد خلال العصرين الأموي والعباسي[117]، واتُّهم المسعودي بالتشيع والاعتزال[118]، بينما ذكر الذهبي في ترجمته من السير أنه كان معتزلياً[119].
اهتمت أسرته بتعليمه وتثقيفه وتنشئته نشأة علمية، وحرصت على تزويده بمختلف العلوم والمعارف، وكانت بغداد في عصره مركزاً من أهم مراكز العلم، واشتهرت بمكتبتها الأدبية والتاريخية التي ضمت تراث العرب، وقصدها العلماء والأدباء، وتلقى المسعودي علومه الأولى فيها[120].
تنقل المسعودي بين العراق والشام ومصر، ويحدثنا المسعودي عن نفسه بأنه أتم تأليف كتابه مروج الذهب في الفسطاط بمصر عام (336هـ/947م)، واستقر فيها وتوفي سنة (345هـ/956م)[121]، وقيل (346هـ/957م) ودفن بالفسطاط، والراجح أنه توفي سنة 346هـ/957م)، لأن الغالبية العظمى من المصادر تؤكد وفاته في هذه السنة[122].
اهتم المسعودي بدارسة التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والديانات القديمة والعقائد والفرق والمذاهب الفقهية[123]، كما درس العلوم اللغوية والأدبية وتعلم اللغات الفارسية والهندية واليونانية والسريانية، وأحاط بكل فنون العلم والمعرفة، وكان موسوعي الثقافة والمعارف[124].
أراد المسعودي أن ينمي ثقافته ويزيد من اطلاعه، فلجأ إلى الرحلات والأسفار في مختلف البلدان والأقاليم، مستمداً معلوماته من خلال المشاهدة، ولمس بنفسه حياة الشعوب، واطلع على الثقافات والحضارات الأخرى، لذا قضى نصف عمره يقطع البلدان ويتجاوز البحار والحدود؛ فقدم صورة واضحة عما شاهده في رحلاته، ولم تكن أسفاره وسيلة للكسب والتجارة والمغامرة، بل كانت غايته منها الوقوف بالتجربة، والعمل بالمشاهدة على أحوال الأمم،
كما أشار إلى الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها في رحلاته وخاصة في البحر وركوب السفن[125].
تلقى المسعودي علومه على يد عدد من الشيوخ، فقد استقى علوم التاريخ في بغداد عن الطبري (ت310هـ/933م) (فقيه ومحدث)، وابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسين (ت321هـ /922م) (أديب ومؤرخ)[126]، وعن ثعلب أبي العباس أحمد بن يحى (ت316هـ/928م) (محدث نحوي)[127]، وأخذ علم اللغة والأدب والنحو[128]، عن نفطويه، أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي (ت323هـ/934م) (نحوي وأخباري) [129]، والرازي، أبي الحسين حمد بن جعفر (312هـ/924م) (محدث)[130]، والحميري، عبد الله بن جعفر (ت315هـ/ 927 م) (عالم ومحدث)[131]، والأنباري، أبي بكر القاسم بن بشار (ت328هـ/939م)(نحوي ولغوي)[132].
وفي البصرة التقى الجمحي، أبا خليفة الفضل بن حباب (ت 305هـ/917م) صاحب اللغة وإمام زمانه في علم البيان(محدث وأديب وأخباري)[133].
وانتقل المسعودي في رحلاته إلى بغداد، واستقى علوم الفقه والحديث من القاضي وكيع، أبي بكر محمد بن خلف (ت306هـ/918م) (فقيه ومحدث) صاحب كتاب أخبار القضاة، وفي الكوفة التقى بالعباس بن محمد بن الحسين (ت 310هـ/922م) (فقيه)[134]، ومحمد بن عمر الكاتب (ت325هـ/939م) الذي وصف بأنه “شيخ الشيعة”(محدث)[135].
أما بالنسبة لتلاميذه؛ فإن مصادر ترجمته لم تذكر أحداً ممن أخذ عنه العلم، ويبدو أن رحلات المسعودي الكثيرة وتنقله في البلاد قد شغله عن أن يكون له تلاميذ كُثُرٌ.
أما مصنفاته وآثاره العلمية، فقد ألف أكثر من ثلاثين مؤلفاَ من الكتب العلمية المتنوعة[136]، ككتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والممالك الدائرة، وكان يضم ثلاثين مجلداً ولم يصلنا منه سوى جزء واحد[137]، والكتاب الأوسط: كتاب في التاريخ العام، تناول فيه الحديث عن الخليقة حتى الفترة العباسية وهو كتاب توسط بين كتابه الأول أخبار الزمان وكتبه الأخرى التي ألفها فيما بعد[138].وكتاب التنبيه والإشراف: يُعَدًّ هذا الكتاب آخر الكتب التي ألفها المسعودي وهو كتاب عام في التاريخ والجغرافيا، واشتمل على عدة موضوعات تحدث فيها عن العقائد والأديان والفلسفة والنجوم والفلك والأرض[139].
أما مروج الذهب ومعادن الجوهر فهو من أعظم المصنفات العربية، شرع المسعودي في تأليفه سنة (332هـ/944م). وعن سبب تسميته قال:”وقد سميت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب، ومعادن الجوهر لنفاسة ما حواه من معلومات قيمة ومفيدة للباحثين، وجعلته تحفة الأشراف من الملوك وأهل الدرايات”. وأدرك المسعودي قيمة كتابه ونهى عن التصرف فيه، بل وحذًّر من يعبث به بغضب الله تعالى[140].
وبين الأسباب التي حملته على تأليفه هذا الكتاب، الرغبة في السير على شاكلة العلماء والحكماء في التأليف بأن جعل مؤلفه علماً منظوماً، وذكر الخبر كما وصله دون إسهاب أو اختصار، وذكر في مقدمة كتابه “وكان ما دعاني إلى تأليف هذا في التاريخ وأخبار العالم وما مضى في أكناف الزمان من أخبار الأمم ومساكنها محبة احتذاء الشاكلة التي قصدها العلماء وقفاها الحكماء”[141].
ولمروج الذهب دراسة تاريخية جغرافية تحدث فيها المسعودي عن: التاريخ منذ بداية الخَليفة، وأخبار العالم، وأخبار الأنبياء والملوك وسيرها والأمم ومساكنها[142]ورتب موضوعاته ترتيبا موضوعياً [143]، مراعياً التسلسل الزمني [144]. فقد وضع المسعودي في هذا الكتاب تاريخاً عاماً عالمياً يقع في مائه وأثنان وثلاثون باباً، وقسمه إلى قسمين: الأول تناول فيه المبدأ والخليقة، وقصص الأنبياء، والبحار وعجائبها، وامتازت معلوماته الجغرافية بالدقة خلال الحديث عن البحار والأنهار والجزر وركوب السفن وطبيعة الأرض والتضاريس والفلك[145].
كما تحدث عن الأمم من ملوك وشعوب، والأمم القديمة كأخبار الصين، وأمم الآلات، والخزر، والترك، والسريان، والفرس، واليونان، والرومان، ومصر، والسودان، والصقالبة، والفرنجة وغيرهم، وأديانهم وعاداتهم. ثم تقاويم الأمم في التأريخ وسنيها وشهورها، والبيوت المعظمة لدى الأمم المختلفة، حتى يصل بعد ذلك كله إلى البعثة النبوية والخلافة الإسلامية، ويعرض حياة الرسول (ص) وسيرة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسين حتى عهد المطيع سنة (334-363هـ/946-974م)[146]. ويذكر التفاصيل الدقيقة في أيامهم وحياتهم بالسنة والشهر وأحياناً باليوم[147].
أفاد المسعودي البحث بمعلومات قيمة؛ فقد تناول الحياة السياسية في بلاد فارس، فذكر اول مساكنهم جمعت كلمتهم عليه ويدعى “يونان”، وأشار إلى أي عصر ينتمي ونسبه[148]، وذكر أنساب اليونان وما قاله الناس في ذلك، حيث تعددت الروايات والأقوال حول اماكن وجودهم واصولهم [149].
واستعرض ملوك اليونان وأخبارهم، مبتدِئاً بأول ملوكهم وأشهرهم يونان مؤسسها والقائم عليها وانتهائها باخر امرأة حكمتهم وكشف النقاب عن حياته الملوك والقابهم وإنجازاتهم[150]، وعلاقتهم الخارجية الهند والصين وبني اسرائيل[151].
أعطى المسعودي صورة غير شاملة عن النشاط الفكري والثقافي، وأظهر اهتمام اليونان بالعلوم والآداب المختلفة في الكثير من المجالات الحياتية وأوضح مدى اهتمامهم بعلوم الفلسفية والطبية والتطبيقية وشرعوا تأليف المؤلفات المتنوعة التي أظهرت مدى اهتمامهم بالموضوعات العقلية والعلمية ،التي تخدم حياتهم وتفيدهم في تحسين أوضاعهم وحكمهم، [152]، وكان لدى ملوك اليونان اهتمام كبير بالأدب والمعرفة ، ونقل بعض الكتب من الهند وجلبوا فلاسفتهم وحكمائهم[153].
الفصل الثاني:- مظاهر الحياة الثقافية والسياسية عند اليونان
أولا:- إنجازاتهم العلمية
المحور الأول: سبب التسمية واصولهم
وبسبب الحروب اليونانية الرومانية، زمن الاسكندر المقدوني واتصاله ببلاد اليونان أرجعوا نسبهم الى بلاد الروم ، حيث كانت الديار واحدة ومشتركة في ذلك الوقت، في الطبيعة والمذهب [154]، ولكن من الخطأ نحن كمؤرخين نسبهم للروم واذا حاولنا التدقيق بطريقة كلامهم ندرك تماما بان الروم أقل فصاحة وبلاغة في كلامهم من حيث لغتهم وطلاقة السنتهم، ومقدرتهم على والمقدرة على ترتيب الكلام ،وصوغ الخطابات البلاغية ،والتفكير العقلاني المبني على الفلسفة في ادارة الحكم السياسي والعسكري ، لذلك ليس من الصحيح نسبهم اليهم ،ومن غير المعقول ان نرجحهم لأب واحد[155].
وجميع الكتب الموجودة عندهم تم ترجمتها الى اللغة اليونانية ، وهذا ان دل يدل انهم اخذوها وعملوا فيها وقاموا بترجمتها وتحديد ان اليونان سبقتهم في جميع العلوم وتحديد الفلسفة العقلانية التي جعلتهم اقوى الجيوش على وجه التحديد[156]، فحين يذكرانهم ينسابون الى ولد اسحاق، وقيل الى ابناء يافت بن نوح، ومنهم ذهب في نسبهم ان يونان التي ترجع اليه بلاد اليونان اخو قحطان من ولد عابد بن شالح [157]،أي يعودون لزمن الأول[158].
فاليونان الذي ترجع اليها بلادة استطاع ادارة بلاده بقوة حكمته وصلابته في الادارة والحكم ،وبنفس الوقت بالجبروت ،والين تارة اخرى، وحسن تدبيره للأمور وصواب رأيه ،واتزان عقلة في تعامله مع شعبة ومع اعدائه بنفس الوقت، وقدرة على تدبير امورهم وامور بلادة بعقلانية وحكمة، كما مدحته الشعوب بفصاحته وحسن أخلاقه [159].
فعاش شعوب اليونان في أول حياتهم وبدايات تأسيسهم في مناطق الغرب، وعندما ازدادت عددهم وكثر نسلهم واول مكان استقروا في أثينا، المدينة المعروفة بمكانتها العلمية والفلسفية، وترعرع فيها أصحاب الحكمة وأشهر الفلاسفة، وأول المدن التي تميزت لفترة من الزمن بالتطورات الثقافية والفنية التي جعلتها تكتسب صفة الريادة سواء في الحكم او العلوم المختلفة، واول ما بدأت فيها الديمقراطية، وخاصة في ظل الظروف التي يسودها اشكال الظلم والاستبداد الذي كان سائدا ،في ظل النظام الطبقي في بلاد اليونان[160].
وفي زمانه شيد البنيان وعظم شأنه، وعليت مكانته ، وكبرت مملكته بين اسفار الارض[161]،خلفة في الحكم ابنه هربيوس الذي سار على نهج والده في الحكم والادارة فنجح حكمه، وكسب محبة رعيته فتحلى بقيم الجود والسخاء، وجعل عقله سيد حكمة وطريق نجاحه، فعاش سيدا رشيدا مدبرا محبوبا بين رعيته [162] ، فزاد نسله وتوسعوا في مناطق العالم فغلبوا على مناطق المغرب من بلاد الفرنجة والنوكبرد * وأجناس الأمم من الصقالبة وغيرها[163].
المحور الثاني: علوم اليونان وفلاسفتهم
لم يكن ظهور الفلسفة والعلوم في المجتمع اليوناني على يد افراد من الفلاسفة بقدر ما كان في صورة العديد من المدارس الفلسفية التي حمل لوائها الفلاسفة والمفكرون ونتج عن كل منها العديد من الأفكار الفلسفية والعلمية .وقد بدأ التمايز بين العلم والفلسفة بداية القرن الخامس ق.م وتحديدا الفترة التي بدأت فيها اثينا في الاهتمام بالتوسع السياسي والتجاري وزادت اهتمامات المواطنين السياسية والاقتصادية وأدى هذا الوضع الى ظهور طائفة من الفلاسفة تحترف بتعليم المواطنين شئون السياسة وتدريبهم على الخطابة وهي طائفة السفسطائيين وتميز هؤلاء الفلاسفة بجنوحهم الى الى التعليم اكثر من الفلسفة. اما اهم الفلاسفة الذين ظهروا في بلاد اليونان في الفترة ما بين القرن الخامس والرابع ق.م وستحدث عنهم من خلال الدراسة وتأثير الكثير من الملوك بحكمهم والأخذ من علمهم في الحكم والادارة.
بدأ اهتمام اليونان في كثير من العلوم المتنوعة والمختلفة، وتحديدا بعلوم الطب والحكمة والفلك والرياضة والطلسمات، وغيرها شأنهم شان مختلف الحضارات وهذا ما أكدته مصادر الدراسة ،ولكن المختلف عند اليونان انهم درسوا العلوم من منظور فلسفي وعقلاني، ويعود إلى البيئة الجغرافية والعلمية والفكرية التي صقلت عقول المفكرين والحكماء والفلاسفة، حيث نشؤا وترعرعوا في مدينة الفلسفة والمتفلسفين المدينة الأيونية[164]، فقسم ركز اهتمامه بعلوم الطب ويعود الفضل الأول لهذا التقدم والتطور الفيلسوف ابقراط (460-377)ق.م، لما قدمة للبشرية من إرشادات ونصائح متعلقة بالأعراض التي ترافق مختلف الأمراض التي يمكن بواسطتها ان يستدل على مستقبل الأمراض وما ينبغي لكل واحد منها من التدابير والاحتياجات ، فكان أول لقب أبا الطب وأعظم حكماء عصرة، وبعلمة ومعرفته في الطب ،ويرجعون اليه الأطباء في امور التطيب فالف جميع مصنفاته لخدمة امور المتطيبين[165].
ويلاحظ المؤرخين على ان ابقراط كتب طيلة حياته الكتب والمصنفات ،وجمعيها تحتوي على تعليمات تخدم الانسان ،واعتمد في معالجته ومداواته فالف في هذا المجال العديد من المصنفات التي تخدم مجال تخصصه منها كتاب الفصول، وكتاب تقدمه المعرفة والأهوية والأزمنة ،واخرها كتاب ماء الشعير[166]، اعتمد بشكل أساسي على نظام دقيق ،في التغذيةو الحمية ومزواله الرياضة الجسدية اكثر من اعتماده على الادوية والعقاقير في اصناف الأمراض وطريقه الوقاية منها، وحول مسببات الأمراض والأطعمة التي تحمي الانسان من الامراض وعدم الزيادة منها ،واهم الامراض التي تصيب الانسان وطرق الوقاية منها [167].
ويعود الفضل الية والمرجع الأول لكثير من الأطباء والفلاسفة حيث أخذو عنه وترجموا مصنفاته ،واستفادوا من علومه وخبرته العلمية والطبية، ومنهم من تتلمذ على يدية وترجموا كتبة ومؤلفاته للاستفادة منها وخاصة في مجال الطب ،ومنهم الف كتب واعتمدوا فيها على تأليفه وعلمه وخبرته ونسبوها اليه[168]، وأشهر تلاميذه واكثر من أقروا بفضله وعلمة في الطب دياسقورريدس صاحب كتاب الأشجار والعقاقير ،وأرسجانس صاحب تصنيف الكناش الذي تحدث فيه عن الصحة البدنية.[169]
وخلفة في مجال الطب جالينوس (129-216)ق.م ،ويعد من أهم الشخصيات الطبية الثانية بعد ابقراط في الأهمية ، تتلمذ على يدية ، وتميز باتساع علمة وبحكمته المنطقية في الداء والدواء ، وبثقافته العلمية وإسهاماته الفلسفية في العلوم[170]،وتناولت مصنفاته ومقالته حول تجاربه بالعلل والأمراض التي تصيب الأنسان.[171]وكان اشهر من احيا طب أبقراط فقد شرح كتبه وطبب وعالج وحل معضلات كثير من الأمراض التي حار فيها غيره من الاطباء وصنف عددا كبيرا من الكتب التي تخدم جميع تخصصات الطب، وكان المنطق والعقل جزءا لا يتجزأ من علمه، ومن هنا نستدل دراسته الرياضيات والمنطق لفهم الكتب الطبية اعتمد بشكل كبير على العقل والتفكير الكلي حتى يتمكن من امتلاك القدرة على تفسير الامراض وأعراضها وسبل الشفاء منها[172].
ومن هنا نرى العقول التي تبنى على الفلسفة وتحليل الأمور بالحكمة التي خرجت هذه العقول ولان العلم من أجل الاستفادة ، نرى الفلسفة اليونانية تختزل العقول والفكر وتظهر على ملامحها ابداع الشعوب وابتكارها للعلوم وخاصة العلوم الصعبة التي تحتاج الى العقل وقوة الملاحظة والدقة والبرهان والقدرة على التطبيق ومن هنا تأتي تميز اليونان عن غيرهم في الفنون العسكرية والقتالية وادارتهم السياسية . وساعد التطور السريع في التكوين السياسي الاثيني دفعها نحو الرواج والانفتاح مع العالم الخارجي فتحت انظار اليونان والعالم نحو التركيز عليها، وجعلها مركز الإشعاع الفكري والفني والحضاري والثقافي وخلال فترة قصيرة نوعا ما بالمقاييس التاريخية هي القرن الخامس ق.م، أصبحت منبت لأعظم المفكرين وكبار الفلاسفة والأدباء والفنيين ،فنعكس كله على اثراءها بالعلم والعلوم المختلفة ،ومن هنا بدأ اهتمام اليونان بمختلف العلوم وجميع التخصصات العلمية والنظرية والآداب.
وكان المجسطي المعروف بطليموس مهتم بعالم الفضاء والأفلاك وتحركات النجوم وعلوم الإسطرلاب[173]، كما اهتموا بعلوم الهندسة والطبيعية كالفلاحة والفراسة [174]،ومنهم من أضاف للعلم والمعرفة نكهه جديدة من خلال اداخلهم صنف جديد وهو علم الطلسمات*[175]، برع في هذا المجال بلينوس النجار الملقب باليتم، أو ديوجاس الملقب بين ابناء عصرة بالكلب ويعود الى “أن أهر على الاشرار ،وأبصبص للأخبار، وآوى الأسواق”[176].
ومن حكمائهم في الرياضيات والعمليات الحسابية العالم المعروف بلقب الفيتاغورس (580-570)ق.م ،[177]فاعتمد بشكل اساسي في عملياته الحسابية على الاثبات والبرهان والوصول الى الحلول الصحيحة وهذا يحتاج الى قدرة عقلية وبنفس الوقت فطنة في الانتباه لأمور الصغيرة والكبيرة ونتيجة تأثيرهم بعالم الفلسفة نبعت قدرتهم على أدارك الامور والوصول الى ادق التفاصيل[178]،ويعتبر من الاوائل الذين نادوا بنطق الأعداد فنسبة الاشياء لبعضها البعض عبارة عن عدد ،حتى نغمات الموسيقي عبارة عن عدد لأنها ليست الا موجات صوتية واهتزازات تقاس بوحدات معروفة في علم الصوت ،ولم يرمز الفيتاغوريون للعدد بالأرقام بل كانوا يصورنه بالنقط [179]،فالعالم بنظرة ليس سوى انسجام بين نغم والعدد وليس هناك اختلاف بين المحاكاة والذات، ومن هنا نقرر ان تتوصل تحرر فيتاغورس من الاتجاهات الفردية وارتباطها بالعالم الخارجي ويستمد أرائه من ميوله للصوفية التي تنسجم مع تطور فكره وعقليته على أسس الديانة العقلية والأخلاقية التي تلائم مع التيار الفيتاغورس[180].
ولا يزال تأثيره قائم حتى يومن هذا ويتبوأ مكان الصدارة عندما نحاول دراسة تطور الفلسفة اليونانية باعتبارها المشغل العرفاني الذي أنار دروب العقل البشري أمام أغلب الحكماء والفلاسفة الذين كان لهم دور رئيسا في التاريخ الإنساني ،ومما لا يشك ان المدرسة الفيتاغورية قد اعطت الفكر العالمي زخما فلسفيا .ربما هذا التنوع الكبير لمختلف العلوم تعتمد بشكل كبير على التفكير والفلسفة والعقل والمنطق بنفس الوقت ،ومن هنا نستطيع ان نرجع الاسباب التي جعلت اليونان يفوقون على غيرهم من الحضارات والأمم بمجال العلم والفلسفة والحكمة ،ومعظم الفلاسفة والحكماء ظهروا في مدينة أيونية التي اضافت للحضارة اليونانية نوع من الابداع والتفوق والتمايز لمختلف العلوم والمعارف، ومن هنا نستطيع نقول انها منبت جميع الفلاسفة والحكماء.
نأتي للعالم الحكمة نيقو ما خس المعروف بالحكيم الفتيا غوري ،اعتمد عليه جميع الفلاسفة القدماء في فلسفته وبناء نظرياتهم وأفكارهم ،وجمعيهم عرفوا الفلسفة بمعني الحكمة[181]، وهي حقيقه العلم بالأشياء الدائمة وله كتاب الارثماطيقي، اسهب في الحديث عن الحكمة وفضلها وما راه العلماء والحكماء في فضل العلم [182]، وافتتح مقدمة كتابة ان اصل الاشياء الموجودة في الطبيعة وجميع ما في الدنيا يعود تقديرها للعدد ،[183]فالحكمة بنظرهم العلم وترجع اليه الأمور والأشياء[184].
ونأتي الي عظيم الفلاسفة والمتفلسفين، أرسطوطاليس المعروف بأرسطو ولد(384 – 322)ق.م ،تلميذ أفلاطون واضع اصول الحكمة وانواعها وانقساماتها وتشعباتها ، فهو ليس فقط احد الفلاسفة الكبار في الفلسفة القديمة ولكنه على الوجه الخصوص يلقب بالمعلم الأول ،وظهرت فلسفته حول صلاح العالم وفساده يعود الى خلاف النفس فالف كتابه عن الفلسفة فسماه المدخل لعلم الفلسفة وذكر ته اليونان بلغتها “ايساغوجي” واعتمد بشكل أساسي في الحديث عن الفلسفة فهو المؤسس بدون منازع للمنطق فوصفه اليونان انه اشهر من كتبه بمنطقية واليه يعود الفضل في تنظيم الفلسفة اليونانية وتفريغ العلوم وايجاد المنطق مرتبا ومنظما له اسسه وقوانينه[185].
وتنبع اهمية الانفتاح على العلوم الطبيعية والعقلية لدى الأمم والحضارات، وأن ذلك من شأنه
ان يسهم في صقل شخصية الأنسان، ويسهم في تطورها، لذلك تجاوزت مؤلفاته الطبيعية، فهو يرى ان الوجود الطبيعي هو الذي يتعلق بالمادة في الذهن والواقع فمهما تصورنا الانسان فأننا لا نتصوره سوى لحم وعظم وهذا ينطبق على سائر الموجودات الطبيعية في المادة التي تنسجم معها وكل ما هو مادي متحرك حركة محسوسة والتغير او الصيرورة عند انواع من الوجود وتسمى كونا ومن الوجود الى الوجود تسمى فسادا ومن الوجود الى الوجود أي انتقال الشيء من حال الى حال. فلكل شيء في الطبيعة له وظيفة وغاية [186].
لذلك جمعت تصانيفه حول الطبيعة منها واستخداما الخبر الطبيعي[187] ، والسماء والعالم ،والكون والفساد [188]، وكتابه المنطق في الآثار العلوية وغيرها[189]،اما في مجال النفس فحتل كتابة الصدارة الحس والمحسوس والكلام الروماني، والتوحيد[190]،وكتاب المنطق وما بعد الطبيعة[191].
ثانيا:- تطور الحياة السياسية عند اليونان
المحور الأول: أوضاع السياسية والعسكرية للبلاد اليونان خلال حكم الإسكندر المقدوني(336ق.م.335ق.م)
ليس من السهل معرفه بداية عرش ملوك اليونان ، وأول من حكمهم الا انه غيرهم من الملوك كالفرس الذين اتخذ لقب كسرى دون ذكر اسم ملكهم، ولقبوا ملوك الروم بالقيصر ،في حين كان لقب ملوك الحبشة النجاشي ،وملوك اليمن تبع ،وتسمية ملوك الزنج فليمس .ومن هنا نستدل ان اول ملوك اليونان سارو غيرهم من الأمم أتخذوا لقب بطليموس [192]،وذكرة المسعودي ايضا فليبس او فيلفوس[193].
واتجهت فتوحاته نحو بلاد المشرق نحو بلاد الشام ومصر والمغرب ،وكانت تخضع لحكم نبوخذ نصر البابلي ويؤدون اليه الخراج لبلاد فارس[194]،ومن في انظمه الحكم الإمبراطورية يكون النظام فيها ملكي وراثي فخلفه في حكم بلاده ابنه الإسكندر بن فليبس المعروف المقدوني،[195] تولى عرش والدة وهو في العشرين من عمرة 336ق.م [196]، حيث كانت مملكته تكتنفها المخاطر وتمزقها الحروب والفوضى ومكائد الاعداء الحاقدين ، وفي عهدة دارت الحروب بين بلاد اليونان والفرس وكان يحكمها دارا بن دار المعروف بلقب دار يوس،[197] حيث كانت بلاد اليونان تدفع له الخراج والإتاوة وتوقفت في عهد الإسكندر المقدوني وامتنع عن دفعها من بعد والدة فقال” أنه ذبح الدجاجة التي كانت تبيض الذهب وأكلتها”[198].
انتهج الاسكندر سياسة مخالفة لوالدة فغزا بلاد فارس في عهد الملك دار بن دار فشرع بالقيام بحملة عسكرية ضد الإمبراطورية الفارسية ، فدارت بين الطرفين معركة قتل على أثرها ملك الفرس وتزوج بابنته ،كما ذكرته مصادر الدراسة،[199] وخضعت له بلاد الفرس ،وجميع الأمم في بلاد الشام والعراق ،[200] وصولا لأرض السند والصين والتبت ، [201] فضم الهند وسيطر على ملكها ومقتنياتها وقتل ملكها فور صاحب مملكة المناكير وعرف بقوته فنقادات اليه جميع ملوك الهند وحملت اليه الاموال والخراج، فقتله مبارزة [202].
كما شملت سياسته التوسعية مدينة رومية وأسكنها اناس من اليمن حيث وصف انه من عرب المتخلفين لذلك نسبه لعرب القحطانيين[203]،فهابته ملوك الأرض وحملت اليه الهدايا والضرائب ولأتاواه [204]،بعد أن اذاقهم طعم الذل وعظم قتله في رجالهم وقطع البلاد الى كور وبنى له مدنا في سائر البلاد التي فتحها حيث بلفت اثنتي عشرة مدينة[205]، منها الاسكندرية بارض مصر،[206] ومدينة نجران بأرض العرب ،ومدينة مرو بأرض خرسان ومدينة جي بأرض أصبهان، ومدينة على شاطئ البحر تدعى صيدودا، ومدينة بأرض الهند تدعى جروين ،ومدينة بارض الصين تدعى قرنية ،بالإضافة الي سائر المدن في بلاد الروم،[207]هنا اكتسب لقب ذو القرنين لبلوغه أطراف الأرض[208].
من صفات الملك المقدوني انه كان متجبرا، طاغيا ،متسلطا على عبادة ،فهابته ملوك الأرض وحسبت له الحساب ،وفي حضرته يسكت الجميع هيبه وخوفا ،[209] وبرغم من قوته العسكرية وفطنته الكلامية ومقدرته الخطابية ، فأظهر اهتمامه بالحكماء والفلاسفة من كل مشارق الارض ومغاربها،[210] واصبح عنده قدرة وَمَهارَه عالية في ادارة بلادة وتدبير اموره ولا سيما مولعا منذ صغرة بجميع المعارف ومحبا للقراءة والاطلاع الواسع لجميع انواع الكتب، وتحديدا تِلكَ العِلومِ الَتي تُنيرَ بَصيرَتُه في الحكم والادارة، وكان يلجا اليهم ويتبع بمشورتهم في أي قرار يتخذه ولا يصدر أي الأمور يخص مملكته وشؤون ورعيته دون الرجوع اليهم والأخذ برأيهم ومشورتهم[211].كما تتلمذ على يد معلمة ارسطوا فن البلاغة والنحو والفلسفة والطبيعية والمساحة واصول التفكيري العقلاني والنظرة الموضوعية وعلم المنطق والفن والطب.[212]
[213] كما كان مولعا بجميع المعارف والأدب ومحبا لقراءة والاطلاع لجميع انواع الكتب وأهمها الفلسفة والطب والعلوم الطبيعة والأمور التي تهتم بالصحة،[214] ونتيجة لا سفارة الكثيرة وأخباره الكثيرة اخذ علوم الطب وعلم اللغات عن ملوك الهند ، وسمع قصص الأمم ومشاهدة فنونهم ومكايد حكمهم ،واختلاف أخلاقهم وعجائب صورهم [215] .
توفي الاسكندر المقدوني في مدينة شهر زور، وقيل في العراق وقيل في نصيبين ،حيث وفاته المنية اثناء رجعة من فتوحاته ،فاشتد علية المرض[216]، وقيل في بيت المقدس، [217]ومات قبل وصولة الي بلادة ،فوضع في توب من الذهب مرصع بالجواهر الثمينة، وطلي جسمه بالأطلة الماسكة لأجزائه،[218] وحمل به الى مسقط رأسه ومكان وجود والدته بالإسكندرية التي قام ببنائها 332ق.م وسميت على اسمة[219] وأخبر قائدة بوصيته لوالدته حيث أمر ان تعمل له وليمه وتبعث كل اهل مملكته باستثناء من فقد محبوبا وخليليا وعزيزا فلم يجب احد لدعوة ،[220]وان دل على تجبره برعيته ومتكبرا ومتسلطا بنفس الوقت طاغيا في حكمة ومملكته وغير محبوب بين رعيته .[221]
وعند وفاته وصفاه المقربين منه عند جاء بتوبته ووضع امامهم، أصبح الملك اسيرا بعد ان كان هو من يأسر الناس،[222]فيحين وصفه احدهم عندما راه مطلي بالذهب “كان من يخبأ الذهب فاصبح اليوم الذهب يخباه، [223]في حين وصفه صاحب خزانة الكتب الحكمة ومن المقربين له حيث كان لا يبعد عن الملك في حين راه مستلقي بتابوته لا يستطيع ان يقترب منه،[224]في حين وصفه احد حكماء الهند ومن كان مقرب منه ويأخذ برايه ومشورته ،كان الموت من الأمور التي تثير غضب الملك واليوم غضبت على الموت،[225]وعند حضروه كانت كل الاذان تنصت له عندما يتحكم واليوم عندما سكت لا يستطع احد ان يتحكم برغم مسموح لهم الكلام،[226]في حين ذكرته زوجتك روشنك بنت ملك الفرس دار بن دار ان جميع الكلام الذي خرج من جميع فوهة الحاضرين في حضرة موت زوجها فيه نوع من الشماتة وانها لم تتوقع بيوم من الايام دار الملك يغلب،[227] اما والدته فأنهت الحديث وختمت كلامهم انها فقدت ابنها كالروح وجسد لا كنها سوف يبقى ذاكراه في قلبها.[228]
ومعظم الكتابات التي تناولت الاسكندر بانه ذلك الشاب التي تلاحمت الاساطير قصة حياته لدى الكثير من المجتمعات التي وصلت اخباره فسارعت الي تمجيد بطولاته ونظرا لموته المبكر، توفي الاسكندر وقد استمر في حكمة اثني عشر سنة سته حكمها اثناء ملك دار بن دار وستة اخرى بعد وفاته، [229]وذكرة الطبري انه استمر حكمة اربع عشرة سنة.[230]وقيل ثلاثين سنة جال الارض منها اربعا وعشرين سنة.[231]
المحور الثاني: أشهر ملوكهم
خلفة في الحكم خلفيته بطليمس(الثاني)، كان حمة مختلف عن الذي سبقة فتميز فترة حكمة بأسلوب تسيس في الحكم ومقدرته على التدابير الامور ولين تعامله مع رعيته وشعوب الأرض واصطدم مع بني اسرائيل وملوك الشام،[232]ببلاد فلسطين وايليا من ارض الشام وسباهم وقتل عدد كبير منهم ثم رد بني اسرائيل في فلسطين وحمل بعضهم الجواهر الاموال والآلات والذهب والفضة وهيكل بيت المقدس.[233]
وأول ملوك الأرض من الروم والعجم واليونان لعب بالشواهين(بالبزاة)، واصطيادها،[234] وتعبر اليونان من اول الشعوب التي اصطادوا العقاب، وذكرها بأربع اجناس البازي والشاهين والصقر والعقاب [235]، وفي رواية اخرى ان الروم من سبقتهم بهذا الهواية .[236]
فخلفة بطليموس الثالث المعروف في بلاد اليونان بلقب الصانع ،[237]واستمرت فترة حكمة ستة وعشرين سنة ،[238] وبطليموس الرابع المعروف بمحب الأب ،واستمرت فترة حكمة تسع عشرة سنة، وشملت فترة حكمة حروب ملوك الشام وهو صاحب انطاكية والإسكندرونس وبنى فأمية* بين حمص وانطاكية،[239]وحكم اليونان من بعده بطليموس صاحب كتاب المجسطي ،واستمر حكمة اربعا وعشرين سنة،[240]ومن بعدة بطليموس محب الام واستمر خمسا وثلاثين سنة،[241]وبطليموس المخلص سبع عشرة سنة،[242]وبطليموس الجوال ثمانية وستين سنة،[243] بطليموس الحديث ثلاثين سنة.[244]
واخر ملوك اليونان كانت من النساء فلبطره تميزت بحكمتها وفلسفتها وعلمها، وحبها للعلم والمعرفة ومقربتها من الحكماء والفلاسفة وكتبت في الطب والرقية والحكمة كما ترجمت الكثير من الكتب، وبنهاية حكمها انقضى ملكهم وصحوت ايامهم ملوك وانمحت اثارهم وما زالت علومهم قسم من علومهم الا بقي فيها في ايدي حكمائهم [245].استمر حكمها اثنين وعشرين سنه[246]، في حين بلغ عدد حكام اليونان مع ملكها اربعه عشر ملكا ومدة ايامهم وسننيهن ثلاثمائة سنة وستة واحدة[247].
الخاتمة
المجتمع اليوناني لم يكن مجتمعا مغلقا تنحصر قيمته الحضارية أساسا في المنطقة التي قام بها على قسم من الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط ،بحيث لا تتعدى هذه المنطقه لتأثير بغيرها أو تؤثر في غيرها الا بشكل عابر او جانبي ،وإنما كان هذا المجتمع منفتحا على غيرة من المجتمعات التي سبقة، ساهم في ازدهار النشاط الحضاري ،والتي ظهرت في منطقه الشرق الأدنى في مصر وسورية وبلاد العراق، وفي منطقه أسيا الصغرى (تركيا الحاليه)وقد تأثرت بهذه الحضارات الكبيرة ،حيث وصلت الى مرحلة النضوج بدأت تنشر المناطق المحيطة بالبحر المتوسط وتؤثر فيها ،ثم أخذ هذا التأثير الحضاري يمتد في العصور التاليه، الى مناطق قريبه او بعيده ،وقد ظل هذا التأثير مستمر في صورة او في اخرى، وما زال تأثير الحضارة اليونانية لا يزال قائما في عالمنا المعاصر بصورة مباشرة او سواء يسمى الناحية السياسية او الاقتصادية او الفكرية او والفنية والأدبية ،فتناول الفصل الأول الجانب الفكري هو أساس موضوعنا ،اثرت الافكار التي قدمها فلاسفة اليونان وعلى راسهم سقراط وافلاطون وأرسطو ،ومن هذا الصدد نستطيع ان نقول تفنن اليونان في منجزاتهم في مجال العلوم الذي ادخله علماء اليونان في علوم الفلك ،والطلسمات والرياضة ،والرياضيات ،ولا ننسى التقدم الذي احرزه اليونان في سجال الطب ،كما ذكرت مصادر الدراسة الابداع الذي ادخله في جميع العلوم الفلسفية والعقلانية ،نتيجة طبيعة المنطقة التي عاشوا فيها .
قائمة المصادر والمراجع:
قائمة المصادر:
1-ابن الأثير.ابو الحسن عز الدين علي محمد الشيباني،(630ه/1233م)،الكامل في التاريخ،12مجلد،ط1،دار صادر ،بيروت،لبنان،1385ه/1965م.
2-البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (463ه/1072م)،تاريخ بغداد،14 جزء، دار أكرم ضياء العمري ،ط2،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،1401ه/1981م.
3-البكري,ابي عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد,(ت487ه/1094م))المسالك والممالك ,جزاءان ,دار اكتب العلمية,ط1,بيروت,لبنان,1424ه/2003م.
4-ابن تغربي بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، الأتابكي،(ت874ه/1469م)،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،16جزءا،ط1،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1413ه/1992م.
5-الجزري، علي بن محمد الجزري بن الأثير عز الدين أبو الحسن ،(ت630ه/1232م)،أسد الغابة، مجلد واحد، تح محمد ابراهيم، ومحمد أحمد عاشور ،(ب.ط) دار الشعب، بيروت، لبنان.
6-ابن الجوزي، أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علي البغدادي،(ت597ه/1201م)،المنتظم في تاريخ الرسل والملوك والأمم،10 مجلدات، تح محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ،ط1،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،1412ه/1992م).
7-ابن حيان ،أبو حاتم، محمد،(ت354ه/965م)،الثقات ،9اجزاء،(ب. ط)،دائرة المعارف العثمانية،1395ه/1975م.
8-ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،(ت852ه/1449م)،تهذيب التهذيب ،12جزء،دائرة المعارف النظامية ،بيروت،لبنان،1327ه/728م.
لسان الميزان،7اجزاء،ط3،مؤسسة الأعلمي،بيروت،لبنان،1406ه/1986م.
9-ابن حزم، أبو محمد علي،(ت456ه/1064م)،جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،402ه/1983م).
10-الحموي، أبو عبد الله ،ياقوت عبد الله الحموي الرومي،(ت626ه/1229م)،معجم الأدباء،14جزءا،ط3،دار الفكر، بيروت،لبنان،1400ه/1980م.
11-ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر ،(ت651ه/1253م)،وفيات الأعيان،8اجزاء،تح إحسان عباس، (ب. ط)دار الثقافة ،بيروت، لبنان.
12-الداودي، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد(ت945ه/1538م)،طبقات المفسرين ،مجلدان ،تح لجنة من العلماء بأشراف الناشر ،(ب. ط)،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
13-الدينوري، أبو حذيفة أحمد بن داود،(ت282ه/895م)،الأخبار الطوال،ط1،دار الكتب العلمي ،بيروت ،لبنا ن، 1421ه/2001م.
14-الذهبي،أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي، (ت748ه/1347م)،سير أعلام النبلاء،25جزءا،ط1،تح شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،1403ه/1983م.
15-ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري،(ت230ه/845م)الطبقات الكبري،8 مجلدات،(ب.ط)1988م،دار صادر،بيروت،لبنان،1406 ه/1985م.
16-السمعاني،أبو سعيد عبد الكريم محمد بن،منصور،التميمي، (ت562ه/1167م)،الانساب،12مجلد،ط1،دا،الجنان،بيروت،لبنان، 1408ه/1988م.
17-الشيرازي،ابو إسحاق، جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي،(ت467ه/1084م)طبقات الفقهاء، تح ،إحسان عباس ،ط1،دار الرائد العربي،بيروت،لبنان،1390ه/1970م .
18-الصفدي،ابو الصفا ،خليل بن ايبك بن عبد الله الأديب صلاح الدين،(764ه1363م)الوافي بالوفيات،33جزء،ط3دار،صادر،بيروت،لبنان،1422ه/1991م.
19-الطبري،أبو جعفر ،محمد بن جرير (ت310ه/922م)تاريخ الرسل والملوك،11جزء،تح محمد ابو الفضل ابراهيم ،ط4،دار المعارف ،مصر ،القاهرة،1412ه/1991م.
جامع البيان في تأويل آي القران، تح احمد محمد شاكر،24جزءا،ط1،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،1421ه/2000م.
20-ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر،(ت774ه1373م)البداية والنهاية،7مجلدات،ط2،مكتبة المعارف،بيروت،لبنان،1409ه/1988م.
21-المزي، ابو الحجاج ،جمال الدين يوسف،(ت742ه/1341م.تهذيب الكمال في اسماء الرجال،34مجلد،تح،احمد علي عبيد ،وحسن احمد اغا، دار الفكر ،بيروت،لبنان،1414ه/1994م.
22-المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي المسعودي،(ت346ه/957م)،مروج الذهب ومعادن الجوهر،4اجزاء،تح مصطفى السيد،(ب.ط) المكتبة التوفيقيه ،مصر، القاهرة.
التنبيه والأشراف،(ب. ط)،دار ومكتبة الهلال،بيروت،لبنان،1402ه/1981م.
23-ابن النديم، أ بو الفرج ،محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق المعروف بالوراق،(ت392ه/1002م)،الفهرست، تح رضا تجدد، (ب .ط)،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1423ه/2002م.
24-اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح،(ت292ه/905م)،تاريخ اليعقوبي، جزءان في مجلد،ط2،دار صادر ،بيروت،لبنان،1431ه/2010م.
ثانيا: المراجع:-
1-بروكلمان،كارل،تاريخ الأدب العربي،6اجزاء،ترجمة عبد الحليم نجار،ط2،دار المعارف ،مصر، القاهرة .
2-حتى،فيلب،تاريخ العرب،(ب.ط)،دار الكشاف للنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،1385ه/19965م.
3-حسن،ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،4اجزاء،ط7،مكتبة النهضةالمصرية،مصر،القاهرة،1384ه/1964م .
4-الخربوطلي،علي حسني،المسعودي،ط2،دار المعارف،مصر،القاهرة،1401ه/1980م. .
5-الخوانساي،محمد مهدبين صالح الكشوات الكاظمي الموسوي، روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، تح اسد الله اسماعيليان، دار الكتاب العربي،1390ه/1970م.
6-الدوري،عبد العزيز ،بحث في نشاه علم التاريخ عند العرب،(ب.ط) دار المشرق،بيروت،لبنان،1246ه/1830م.
7-الزركلي،خير الدين، الأعلام(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)،8اجزاء،دار العلم للملاين،بيروت،لبنان،1401ه/1980م.
8-زيدان جرجي، تاريخ التمدن الإسلامي،3اجزاء،(ب .ط) ،دار مكتبة الحياة ،بيروت،لبنان،1387ه/1967م.
9-ستيس ,ولتر, تاريخ الفلسفة اليوناني, ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد, دار الثقافة للنشر والتوزيع, مصر القاهرة.
10-العاملي، محسن عبد الكريم الأمين الحسيني، أعيان الشيعة،ط4،مطبعة الانفاق،بيروت،لبنان،1384ه/1964م.
11-العزاوي، عبد الرحمن حسين ،وزارة الطبري السيرة والتاريخ، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،العراق،1410ه/1989م.
12-علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام،10اجزاء،ط2،2،ط3،دار العلم للملاين ،بيروت، لبنان ،ومكتبة النهضة،بغداد،العراق،1398ه/1978م.1401ه/1980م.
13-فازيليف، العرب والروم ،ترجمة ، محم عبد الهادي شعيرة وفؤاد حسين،(ب.ط) ،دار الفكر العربي، مصر، القاهرة.
14-القمي، عباس، الكنى والألقاب،ط3،المطبعة الحيدرية،النجف،العراق،1389ه/1969م.
15-كحالة، عمرو رضا، معجم المؤلفين،5اجزاء،دار احياء التراث العربي،بيروت،لبنان،1377ه/1957م.
16-ملحم، عدنان محمد، المؤرخون العرب والفتنه الكبرى،ط1،ط2،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،1419ه/1422.1998ه/2001م.
17-المنجد، صلاح الدين، اعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب، مؤسسة التراث العربي،بيروت،لبنان،1379ه/1959م.
[1] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص5. الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص156. أنظر أيضا: الزركلي، الأعلام، ج1، ص95. الدوري، عبد العزيز، بحث، ص58-ص60. بروكلمان، كارل، تاريخ، ج4، ص(236-238).
[2] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص5. مشاكلة، ص9. الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص156. أنظر أيضا: الزركلي، الأعلام، ج1، ص95. الدوري، عبد العزيز، بحث، ص58-ص60. كحالة، عمر، معجم، ج1، ص161
[3] الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص156.
[4] ملحم، عدنان، المؤرخون،ص45.
[5] م ن، ص45.
[6] الطبري، تاريخ، ج8، ص143. ابن تغري بردي، النجوم، ج2، ص10. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص45.
[7] ملحم، عدنان، المؤرخون، ص45.
[8] ياسين، الجعفري، اليعقوبي، ص20.
[9] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص5. انظر أيضا: الزركلي، الأعلام، ج1، ص95. ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[10] عباس، القمي، الكنى، ج3، ص296. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[11] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص5. أنظر أيضا: الزركلي، الأعلام، ج1، ص95.
[12] حسن، حسن، تاريخ، ج3، ص405.
[13] ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[14] عباس، اللقمي، الكنى، ج3، ص296. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[15] الطبري، تاريخ، ج8، ص143. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[16] ابن تغري بردي، النجوم، ج2، ص40. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[17] محسن، العاملي، أعيان، ج10، ص330. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[18] فيليب، حتى، تاريخ، ج2، ص475. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص46.
[19] ملحم، عدنان،المؤرخون، ص47.
[20] ابن تغري، بردي،النجوم، ج2،ص42.
[21] م ن، ص42.
[22] الطبري، تاريخ، ج8،ص(198-199).
[23] الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص157. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص47.
[24] اليعقوبي، مشاكلة، ص(34-35). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص47.
[25] اليعقوبي، البلدان، ص(125-126). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص47.
[26] الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص175.
[27] صلاح الدين، المنجد، أعلام، ج2، ص(41-42).
[28] فازيليف، العرب والروم، ص236.
[29] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص(5-190). انظر أيضا: الدوري، عبد العزيز، بحث، ص59. ملحم، عدنان، المؤرخون، ص48.
[30] اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص(7-507).
[31] الدوري، عبد العزيز، بحث، ص(51-52).
[32] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص158، ص(174-175).
[33] اليعقوبي’تاريخ،ج1، ص(5-6).
[34] الدوري، عبد العزيز، بحث، ص(51-53). ملحم، عدنان، المؤرخون، ص48.
[35] ياسين، الجعفري، اليعقوبي، ص92.
[36] اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص158.
[37] م ن، ص (143- 146).
[38] ابن النديم، الفهرست، ص385. البغدادي، تاريخ، ج2، ص (162-163). السمعاني، الأنساب، ج4، ص(46-ص47). ابن الأثير، الكامل، ج7، ص(9-10). ابن خلكان، وفيات، ج4، ص(191-192). الذهبي، سير، ج14، ص(267-282). ابن حجر، لسان، ج5، ص(100-103). انظر أيضا: الدوري، بحث، ص(63-64). ملحم، عدنان، المؤرخون، ص59.
[39] ابن النديم، الفهرست، ص385. البغدادي، تاريخ، ج2، ص162. السمعاني، الأنساب، ج4، ص46. المزي، تهذيب، ج1، ص407. الذهبي، سير، ج14، ص267. ابن حجر، لسان، ج5، ص100. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص59
[40] ابن النديم، الفهرست، ص385. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص423. ابن خلكان، وفيات، ج4، ص191. الصفدي، الوافي، ج2، ص284.
[41] السمعاني، الأنساب، ج4، ص46. ابن حجر، لسان، ج5، ص100. الذهبي، ميزان، ج3، ص499. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص59.
[42] عبد الرحمن الجمل، منهج، ص36
[43] ابن النديم، الفهرست، ص291. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص423، 428. ابن خلكان، وفيات، ج4، ص191. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص59.
[44] ابن النديم، الفهرست،ص291.الحموي، معجم الأدباء، ج6،ص429.أنظر أيضاً: ملحم،عدنان،المؤرخون،ص59.
* آمل وهي أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لان طبرستان تتكون من سهل وجبل، ويشكل موقعها في الأقليم الرابع، حيث أشتهرت بعمل السَّجادات الطبرية، والبُسط الحسان، وقد تخرج منها كثير من العلماء منهم الطًّبري صاحب التفسير والتاريخ المشهور. الحموي، معجم، ج1،ص77.الحميري، الروض، ص(5-6).
[45] ابن النديم، الفهرست، ص385.الذهبي، سير،ج14، ص267. أنظر أيضاً: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص59.
* طبرستان وهي من البلدان الواسعة والكبيرة، تمتد عبر سلسلة جبال ضخمة أعطها هيبة عند قدماء العرب، وتسمى هذه السلسلة الآن سلسلة جبال البروز وهي تمتد عبر أقاليم مازندران وكلستان شمال سمنان، وكان يسمي الفرس حاكم إقليم طبرستان الاصبهبذ. الحموي، معجم، ج4، ص(15-16).
[46]ابن خلكان، وفيات، ج4، ص191. الذهبي، سير، ج14، ص267.
[47] الداودي، طبقات، ج2، ص110.
[48] بروكلمان، كارل، تاريخ، ج3، ص45. انظر: أحمد الحوفي، تيارات، ص274.
[49] عبد الرحمن، العزاوي، الطبري، ص26.
[50] بروكلمان، كارل، تاريخ، ج3، ص45.
[51] عبد الرحمن، العزاوي، الطبري، ص26، 29.
[52] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص430.
[53] ابن الجزري، غاية، ج2، ص107.
[54] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص438.
[55] ابن الأثير، الكامل، ج7، ص9. السبكي، طبقات، ج3، ص125. ابن كثير، البدايه، ج11، ص157. الداودي، طبقات، ج2، ص117.
[56] ابن كثير، البداية، ج11، ص157.
[57] الذهبي، سير، ج41، ص269.
[58] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424، 432، 434. السبكي، طبقات، ج3، ص125. الذهبي، تاريخ، ج23، ص279. الصفدي، الوافي، ج2، ص285.
[59] الداودي، طبقات، ج2، ص110.
[60] البغدادي، تاريخ، ج2، ص162. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424.
[61] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424، 430، (435-436). الذهبي، سير، ج14، ص269.
[62] ابن النديم، الفهرست، ص291. البغدادي، تاريخ، ج2، ص162. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424. الذهبي، تاريخ، ج23، ص(279-280). السبكي، طبقات، ج3، ص121. الداودي، طبقات، ج2، ص(110-113).
[63] البغدادي، تاريخ، ج2، ص(259-264). الذهبي، تاريخ، ج18، ص(425-427). أنظر أيضا:ملحم، عدنان، المؤرخون، ص61.
[64] ابن الأثير، الكامل، ج6، ص127. الذهبي، تاريخ، ج18، ص472. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص61.
[65] ابن حجر، تهذيب، ج1، ص24. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص61.
[66] البغدادي، تاريخ، ج5، ص(160-161). ابن الجزري، غابة، ج1، ص139. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص62.
[67] البغدادي، تاريخ، ج6، ص(356-365). الذهبي، سير، ج11، ص(476-478). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص61.
[68] ابن حيان، الثقات، ج8، ص177. البغدادي، تاريخ، ج7، ص(407-410). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص61.
[69] البغدادي، تاريخ، ج5، ص(204-212). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص62.
[70] البغدادي، تاريخ، ج7، ص268. ابن خلكان، وفيات، ج2، ص(74-75). أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص62.
[71] ملحم، عدنان، المؤرخون، ص62.
[72] م ن، (62-63).
[73] الذهبي، سير، ج14، ص273.
[74] الحموي، معجم الأدباء، ج9، ص(40-41). ابن الأثير، الكامل، ج7، ص9.
[75] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص436. الصفدي، الوافي، ج2، ص286.
[76] البغدادي، تاريخ، ج2، ص164. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص436. الذهبي، سير، ج4، ص277. السبكي، طبقات، ج3، ص125.
[77] البغدادي، تاريخ، ج2، ص164. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص437. الصفدي، الوافي، ج2، ص285.
[78] البغدادي، تاريخ، ج2، ص164. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص437.
[79] الخوانساري، وروضات، ج7، ص9، 54.
[80] الطبري، جامع، ج24، ص40.
[81] محمد، امخزون، تحيق، ج1، ص201.
[82] الطبري، جامع، ج3، ص(227-230). الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص432، (453-454). الذهبي، سير، ج14، ص271. الصفدي، الوافي، ج2، ص286. الدودي، طبقات، ج2، ص116.
[83] الشيرازي، طبقات، ص93. السمعاني، الأنساب، ج4، ص47. ابن الأثير، الكامل، ج7، ص9. الذهبي، ميزان، ج3، ص498. ابن حجر، لسان، ج5، ص100. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص65.
[84] ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص217. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص423، 427. ابن الأثير، الكامل، ج7، ص9. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص65.
[85] البغدادي، تاريخ، ج2، ص166. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص65.
[86] البغدادي، تاريخ، ج2، ص116. الذهبي، سير، ج23، ص285. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص65.
[87] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص462. أنظر أيضا: ملحم، عدنان، المؤرخون، ص65.
[88] ابن خلكان، وفيات، ج4، ص192. الصفدي، الوافي، ج2، ص285.
[89] ابن النديم، الفهرست، ص291. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص425، 427، (437-438).
[90] البغدادي، تاريخ، ج2، ص162. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424.
[91] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص432.
[92] الحموي،معجم الأدباء،ج6،ص423.
[93] ابن خلكان، وفيات، ج4، ص191. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص423. الداودي، طبقات، ج2، ص112.
[94] الصفدي، الوافي، ج2، ص(284-285).
[95] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص427. السبكي، طبقات، ج3، ص123.
[96] ابن النديم، الفهرست، ص(2991-292). البغدادي، تاريخ، ج2، ص(162-169). الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص(424-462). ابن خلكان، وفيات، ج2، ص(191-192). الصفدي، الوافي، ج2، ص285.
[97] البغدادي. تاريخ، ج2، ص163. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424.
[98] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص426، 441. الصفدي، الوافي، ج2، ص258. السبكي، طبقات، ج3، ص123.
[99] العزاوي، الطبري، ص(74-75).
[100] ابن النديم، الفهرست، ص291. البغدادي، تاريخ، ج2، ص163. الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص424. ابن الأثير، الكامل، ج7، ص87. ابن خلكان، وفيات، ج4، ص191. الصفدي، الوافي، ج2، ص284. السبكي، طبقات، ج3، ص(121-122).
[101] البغدادي، تاريخ، ج2، ص163.
[102] الدوري، عبد العزيز، بحث، ص63.
[103] المسعودي، مروج، ج1، ص15.
[104] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص445.
[105] ابن خلكان، وفيات، ج4، ص.191
[106] الطبري، تاريخ، ج1، ص(9-637).
[107] م ن، ص ج1،ص561-ص632
[108] الطبري،تاريخ، ج3، ص(9-623). ج4، ص(5-575). ج5، (5-626). ج7، ص(7-656). ج8، ص (7-667). ج9، ص(7-667). ج11، ص(16-687).
10 الطبري،تاريخ،ج1، ص(146-147)، 214، 206، 235، 369، 378.
[110] ابن النديم، الفهرست، ص219. ابن حزم، جمهرة، ص197. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص90. الذهبي، سير، ج15، ص569. الصفدي، الوافي، ج21، ص5، السبكي، طبقات، ج2، ص307.
[111] الحموي، معجم الأدباء، ج3، ص39.
[112] ابن سعد، الطبقات، ج6، ص(13-14). ابن حزم، جمهرة، ص(197-198).
[113] المسعودي، مروج، ج2، ص58.
[114] الذهبي، سير، ج15، ص569. وتاريخ، ج10، ص340. الصفدي، الوافي، ج21، ص5.
[115] ابن النديم، الفهرست، ص219.
[116] المسعودي، مروج، ج2، ص334.
[117] ابن النديم، الفهرست، 219. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص90. الذهبي، سير، ج15، ص569. السبكي، طبقات، ج2، ص307.
[118] ابن حجر، لسان، ج4، ص225.
[119] الذهبي، سير، ج15، ص569.
[120] ابن حزم، جمهرة، ص197. الحموي، معجم الأدباء،، ج13، ص92. السبكي، طبقات، ج2، ص(307-308). الذهبي، تاريخ، ص(340-341). انظر أيضا:زيدان، جرجي، تاريخ، ج2، ص(100-122). الخربوطلي، علي، المسعودي، ص21.
[121] الذهبي، سير، ج15، ص569. تاريخ، ج10، ص340. ابن تغري بردي، النجوم، ج3، ص315.
[122] ابن النديم، الفهرست، ص219. ابن حزم، جمهرة، ص197. الحموي، معجم الأدباء، ص91. الصفدي، الوافي، ج21، ص7. السبكي، طبقات، ج2، ص307.
[123] السبكي، طبقات، ج2، ص307. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص(93-94). الذهبي، سير، ج15، ص569. تاريخ، ج10، ص340.
[124] ابن النديم، الفهرست، ص219. ابن حزم، جمهرة، ص197. السبكي، طبقات، ج2، ص(307-308).
[125] المسعودي، مروج، ج1، ص7. التنبيه، ص6، 45. أنظر أيضا:زيدان، جرجي، تاريخ، ج2، ص313. علي، جواد، المفصل، ص3، 5، 7.
[126] المسعودي، مروج، ج4، ص284. الذهبي، سير، ج15، ص96. 569.
[127] المسعودي، مروج، ج3، ص337. ج4، ص251. الذهبي، سير، ج3، ص157.
[128] ابن النديم، الفهرست، ص227. ابن حزم، جمهرة، ص198. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص93. الذهبي، سير، ج15، ص570.
[129] ابن النديم، الفهرست، ص257.
[130] الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص81.
[131] الذهبي، سير، ج12، ص22.
[132] الحموي، معجم الأدباء، ج11، ص(201-202).
[133] السبكي، طبقات، ج2، ص176.
[134] ابن النديم، الفهرست، ص71. 166.
[135] الحموي، معجم الأدباء، ج31، ص62.
[136] المسعودي، مروج، ج1، ص(7-8). أخبار، ص(17-20). ابن النديم، الفهرست، ص248. ابن حزم، جمهرة، ص197. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص94. أنظر أيضا:عمر، كحالة، معجم، ج7، ص80.
[137] الخربوطلي، علي، المسعودي، ص37.
[138] المسعودي،مروج،ج1، ص8. التننبيه، ص7. الحموي، معجم الأدباء، ج13، ص95. الذهبي، سير، ج15، ص569. الصفدي، الوافي، ج21، ص6.
[139] المسعودي، التبيه، ص(6-7).
[140] المسعودي، مروج، ج1 ص22.
[141] م ن،، ص(8-9)، 12، 22، 26.
[142] م ن، ص(8-9).
[143] الخربوطلي، علي، المسعودي، ص39.
[144] المسعودي، مروج، ج1، ص14.
[145] م ن، ج2، ص290، (294-295).
[146] المسعودي،مروج،ج2، ص(331-410). ج3 (3-409). ج4، ص(3-357).
[147] م ن، ج1، ص27، ج2، ص386، ج3، ص79، ج4، ص(4-15).
[148] م ن، ج1،ص (252-253).
[149] م ن، ص(210-214).
[150] المسعودي,مروج,ج1، ص(224 -216).
[151] م ن، ج1، ص205. التبيه، ص255.
[152] م ن، 255.
[153] م ن, ص( 256-259).
[154] -م ن,،ص252.
[155] -م ن،ص252.
[156] -المسعودي,مروج,ج1،ص252.
[157] -م ن،ص252.
[158] -م ن،ص252.
[159] -م ن،ص253.
[160] -م ن،ص254.
[161] م ن،ص.254
[162] المسعودي,مروج,ج1،ص254.
[163] م ن،ص254.
* والنوكبرد:-بلاد متصلة بارض المغرب واسم ملوكهم في سائر الأعصار أداكيس, ومدينتهم العظمى ودار مملكتهم بنبت ويخرقها نهر عظيم يقال له سانيط, وهو أحد أنهار العالم الموصوفة بالكبر والعجائب.
البكري,المسالك,ج1,ص342.
[164] -المسعودي,مروج,ج1،ص255.
[165] -المسعودي,مروج,ج1ص255.
[166]– م ن،ص255.
[167] -م ن،ص255-256.
[168] -اليعقوبي،تاريخ،ج1،ص114.
[169] -م ن،ص114.
[170] -م ن،ص114.
[171] -م ن،ص117.
[172] -اليعقوبي,تاريخ,ج1ص117.
[173] -م ن،ص113،ص139.
[174] -م ن،ص113.
[175] -م ن،ص113.
*الطلسميات:وهي خطوط واعداد يزعم كاتبها انه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب او دفع أذى.
المسعودي،مروج،ج1،ص268.
[176] -م ، ص119.
[177] -اليعقوبي,تاريخ,ج1،ص133،ص119.
[178] -م ن، ص113.
[179] -احمد امين، وزكي نجيب ،قصة الفلسفة اليونانية،ص27،ص30.
[180] -اليعقوبي،تاريخ،ج1،ص119.
[181] -م ن,ص123.
[182] -اليعقوبي,تاريخ,ج1،ص124.
[183] -م ن،ص124.
[184] -م ن،ص123-ص124.
[185] -م ن،ص127.
[186] -وولتر،ستين،تاريخ،ص154-ص156.
[187] اليعقوبي،تاريخ،ج1 ،ص131.
[188] م ن،ص131.
[189] -م ن،ص131.
[190] م ن،ص137.
[191] -المسعودي،مروج،ج1،ص255.
[192] -م ن،ص254.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[193] -المسعودي،مروج،ج1،ص254.
[194] -م ن،ص254.
[195] م ن،ص254.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[196] المسعودي،مروج،ج1،ص254.
[197] م ن،ص254.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[198] المسعودي،مروج،ج1،ص254.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[199] -المسعودي،مروج،ج1،ص255.الطبيري،تاريخ،ج1،ص573.
[200] المسعودي،مروج،ج1،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[201] المسعودي،مروج،ج1،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[202] المسعودي،مروج1،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[202] المسعودي،مروج،ج1،ص255. [202] م ن،ص256. [202] الدينوري،الاخبار،ص81. [202] م ن،ص81. [202] المسعودي،مروج،ج1،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573. [202] -المسعودي،مروج،ج1،ص256. [202] – م ن، ص ص256المسعودي،مروج،ج1،ص256.[203] م ن،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[204] المسعودي،مروج،ج1،ص255.
[205] م ن،ص256.
[206] الدينوري،الاخبار،ص81.
[207] م ن،ص81.
[208] المسعودي،مروج،ج1،ص255.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[209] -المسعودي،مروج،ج1،ص256.
[210] – م ن، ص ص256.
[211] -م ن،ص256،ص261.
[212] ام هاني،رمضاني،ص171-172.
[213] -المسعودي،مروج،ج1،ص261.
[214] -م ن،ص261.
[215] المسعودي،مروج،ج1،ص266.
[216] -المسعودي،مروج،ج1،ص256.الطبري،تاريخ،ج1،ص573.
[217] الدينوري،الاخبار،ص80.
[218] المسعودي،مروج،ج1،ص256.
[219] -م ن، ص258.
[220] -م ن، ص258.
[221] -م ن ،ص258.
[222] -م ن،ص256.
[223] -م ن،ص256.الدينوريالاخبار،ص81.
[224] -م ن، ص 256.
[225] -م ن،،ص257.
[231] الدينوري،الاخبار،ص80
-[232] المسعودي، مروج، ج 1، ص267
[237] -م ن،،ص269
[238] -م ن،ص269
[239] -م ن،ص269
*فامية:مدينة كبيرة وكوره من سواحل حمص يقال لها أفامية وذكر قوم أن الأصل في فامية ثانية وذاك أنها ثاني مدينة بنيت في الأرض بعد الطوفان.المسعودي،مروج،ج1،269
[240] -م ن،ص269
[241] -م ن،ص269
[242] -م ن،ص269
[243] -م ن،ص269
[244] -م ن،ص269
[245] المسعودي ،مروج،ج1،ص270.
[246] م ن،ص269.
[247] م ن،ص271-ص272.




