الثورات العربية وابستمولوجيا العلوم الاجتماعية
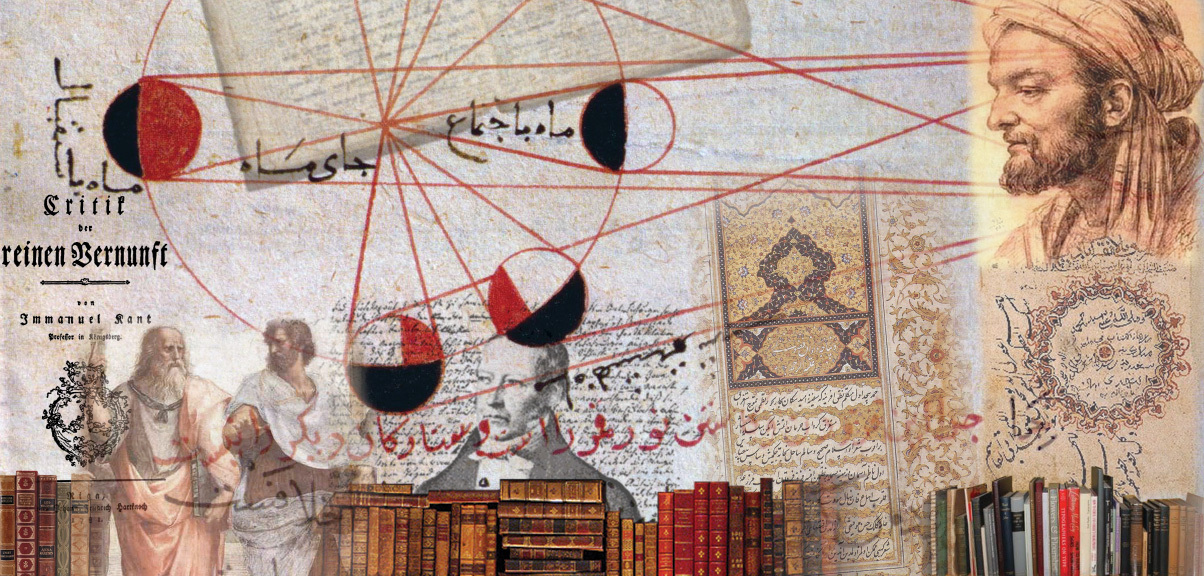
اصدار دراسة بحثية محكمة في “المركز الديمقراطي العربي ” بعنوان : الثورات العربية وابستمولوجيا العلوم الاجتماعية
اعداد الباحثة : ياسمين كامل منصور عمر
إشراف:
أ.د/ محمد بشير صفار
” لقد شعر عظماء الرجال من الفلاسفة بالحاجة إلى العلم والتصوف معاً ، فإن وحدة التصوف مع رجل العلم تشكل أعلى مكانة مرموقة يمكن إنجازها في عالم الفكر .. ” برتـراند راسـل
الفهـــرس
مقـــدمــة …………………………………………………………………………………….. 3
الفصل الأول
في نشأة المنهج الوضعي والبدائل المنهجية في العلوم الاجتماعية
المبحث الأول :
المنهجية الوضعية في دراسة العلوم الاجتماعية …………………………………………. 17
المبحث الثاني :
العلوم الاجتماعية في العالم العربي ………………………………………………………… 22
المبحث الثالث :
في أسلمة العلوم الاجتماعية ……………………………………………………………….. 28
الفصل الثاني
أسلمة العلوم الاجتماعية وتأصيل المنهج الصوفي
المبحث الأول :
نحو صياغة منهجية للعلوم الاجتماعية ……………………………………………………. 36
المبحث الثاني :
التصوف : التعريف والخصائص …………………………………………………………… 39
المبحث الثالث :
الضوابط المنهجية والمصادر المعرفية للنموذج الصوفي ………………………….. 43
الفصل الثالث
الثورة وإعادة التأمل الفلسفي في ضوء النموذج الصوفي
المبحث الأول :
الفلسفة والتصوف : من التقرير إلى التغيير ………………………………………………. 53
المبحث الثاني :
الإنسان الكامل في الفكر الصوفي ………………………………………………………….. 57
المبحث الثالث :
الثورة في التراث الإسلامي الصوفي ………………………………………………………. 61
الخــاتمـــة …………………………………………………………………………………… 65
الصوفية الإسلامية وابستمولوجيا العلوم الاجتماعية
محاولة في التأصيل المنهاجي
تقـــديــــم :
مضى على نشأة العلوم الإجتماعية في الوطن العربي ما يقرب من نصف قرن إلا أنها لاتزال عاجزة عن تحليل الظواهر المجتمعية والتعامل معها ، فقد كشفت التطورات الأخيرة وإندلاع الثورات العربية على عجز العلوم الإجتماعية عامة والسياسية خاصة ، حيث لم يقتصر الأمر فقط – كما يظن البعض- على مجرد التنبؤ بقيام الثورات وإنما أمتد الى التردد حول وصف تلك الظاهرة بـ “الثورة” ، ونخطئ إذا أعتقدنا أن الثورة هي مجرد ظاهرة أو حدث عرضي تعجز مناهج تلك العلوم على تناوله ، ومن ثم يسعى هذا البحث إلى تشريح الثورة وتوضيح أسبابها وأدواتها ومدى جدواها ، إنما الثورة هنا هي لحظة كاشفة عن مأزق في تلك المناهج التي تعكس التعامل مع ظاهرة مجتمعية وسياسية معينة أي ممثلة لفلسفة العلوم ذاتها ، وبالتالي أصبح سؤالنا ليس لماذا لم نتنبأ بالثورة ؟ وإنما ماذا يمكن أن تقدمه هذه المناهج للثورة ؟ وهو ما يقودنا الى الحديث عن مأزق العلوم الإجتماعية وبنية النظريات وآلية المناهج ذاتها ، لنجد أنفسنا في نهاية الأمر في مواجهة مع الفلسفة ، فنصل إلى أن تلك الأزمة إنما تنبع جذورها من تعسر الفلسفة الناتج عن توقف العقل عن التفكير في التساؤلات الفلسفية الكبرى .
وتعود تلك الأزمة إلى هيمنة النموذج الوضعي الغربي نتيجة قدراته التعبوية والتنظيمية مما جعله يحقق تقدماً في إعتباره أرقى ما وصل إليه الإنسان ، مما إنعكس بالضرورة على المعرفة العربية فأدى إلى إنفصالها عن الواقع الذي تقوم بدراسته أو ما يسمى بإغتراب العلوم الإجتماعية ، فتحولت المشروعات النهضوية في العالم الثالث والعالم الإسلامي إلى محاولة للحاق بالغرب ، إلا أن هذا النموذج مغاير لطبيعة المجتمعات العربية من حيث السياق الواقعي والتاريخي لنشأة العلوم الإجتماعية الغربية القائم على مسلمة الصراع ما بين العلمي والديني ، والتي أضحت في هذا السياق ضرورة لا محيد عنها ناتجة عن الإحتكار الكنسي للفكر والعقل مما أدى الى تقييد الفكر وجمود العلم وأستقر في ذهن الإنسان الغربي في تلك الفترة وجود علاقة عكسية بين الدين والحضارة ، وقد جاءت محاولات بناء النهضة مرتبطة بالقضاء على هذا الاحتكار وسقوط تلك السلطة اللاهوتية .
فمع بداية القرن الثامن عشر قطع الفكر الغربي أشواطاً في التحرر من الفكر الديني وهو ما أطلق عليه بعصر التنوير ، ومع قيام الثورة الفرنسية وإقصاء كل ما هو ديني تمت السيادة لهذا النموذج وأستطاعت الوضعية أن تحقق نجاحاً باهراً في العلوم الطبيعية ولم يبق سوى ان تمتد إلى الدراسات الإنسانية وتحرير الدين والأخلاق وهو ما كان على يد كونت ثم عمد دوركايم الى الترجمة العملية .
ومن ثم تشكلت المصفوفة الثقافية المعرفية في ضوء المجتمعات الغربية على الثنائيات الاستقطابية القائمة على ديناميات الصراع كثنائيات العلم والدين ، الذات والموضوع ، المادي والروحي ، الواقع والمثال ، والعقل والوحي . هذا المنطق الحدي في التصنيف أسفر عن تشوهات داخل مناهج العلوم الإجتماعية من حيث الإختزال وحصر الظواهر الكونية والإنسانية في العالم المحسوس ، بل وتبسيط غاية المناهج البحثية فلم تعد تبحث عن العلة الأولى لوجود الظاهرة وانما عن الأسباب المباشرة إعتباراً كون البحث عن العلة الأولى سمات المنهج اللاهوتي ، وعلى المستوى الآخر تجذير مبدأ الحياد القيمي – أي الفصل بين العلم والأخلاق – فقد أصبح العلم أداة لمعرفة كيف نحقق الأهداف وليس ما هي الأهداف الواجب تحقيقها .
وقد ظهرت عدد من المحاولات تبحث عن خروج من الأزمة داخل هذا النموذج ذاته وهذا وإن دل فهو يدل على أن هناك بالفعل قصور عاجزة أمامها العلوم عن أداء مهمتها .
ومن واقع هيمنة المنهج الغربي على الأكاديمية العالمية والعقلية العربية والإسلامية تحولت هذه الدول بمثابة صدى لتلك الإخفاقات ، بل ساهم في تفاقمها وزيادة أثرها الجدلية السائدة حول العلاقة بين المعرفة والسلطة والثروة المكونة للمعادلة الثلاثية التي أصبح العلم أضعف أطرافها خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تخضع العلم لخدمة أغراض السلطة وتدجين المفكرين والعلماء لخدمة النظام والحزب .
تلك الظروف التي دفعت الى إعادة النظر في هوية العلوم الاجتماعية العربية وطبيعة الدور الواجب القيام به ، فظهرت العديد من الدراسات التي تدعو إلى التخلي عن النموذج الغربي وبناء منهجية عربية على قاعدة التراث وقد أختلفت هذه الدراسات في موقفها من النموذج الوضعي وبل وفي تعاملها مع التراث ذاته ، فظهر لدينا عدد من الإتجاهات كما سنرى لاحقاً .
وعلى الرغم من أهمية تلك المحاولات التي تشكل تراجعاً عن النموذج الحضاري الغربي ومحاولة الإقتراب من التراث إلا أنها لم تنجح في التخلص من مظاهر التبعية ومن حضور الآخر ، وهو ما يظهر في الرغبة الصريحة والمعلنة في ضرورة إلغائه ومجاوزته كشرط لتحقيق الإستقلال المعرفي ، ومن ثم يصبح الهدف الأساسي الكامن خلف تلك الجهود هو اللحاق بالغرب مع الحفاظ على الهوية بقدر الإمكان ، لذا تحولت هذه الجهود من محاولات للتخلص من التبعية والعودة إلى الذات إلى مزيد من تبني وترسيخ جذور هذا النموذج الغربي وإعتباره بمثابة المرجعية لتحديد مدى أهمية التراث وعلميته وفق إقترابه او إبتعاده عنه .
ونظراً لهذا العجز المهيمن على العقلية الإجتماعية والذي يمثل في ذاته تعبيراً عن مأزق للفلسفة ، وفشل المحاولات سواء داخل النموذج الغربي أو من المنظور العربي والإسلامي ، فستحاول هذه الدراسة العمل على إكتشاف منظور منهاجي آخر وبحثه لمعرفة مدى قدرته على بعث الروح العلمية مرة أخرى من خلال عودة الفلسفة التأملية ، أي أنها ستسعى إلى الربط بين أضلاع المثلث الثلاثة فمن جانب الثورات العربية باعتبارها لحظة كاشفة عن أزمة العلوم الإجتماعية ، ومن جانب جذور هذه الأزمة الممثلة في الفلسفة ذاتها ، لنصل إلى الضلع الثالث ألا وهو هذا البديل المنهجي الممثل في المنهج الصوفي .
وعلى الرغم من إدراك كون تلك الدراسة لن تتمكن من تناول هذا النموذج بكافة جوانبه بل وإيضاح الكثير من القضايا والإشكالات المرتبطة به فهذا الأمر يحتاج إلى عدد من الدراسات وفترة طويلة من الدرس والتمحيص إلا أنها قد تسهم في إلقاء الضوء على هذا النموذج وتناوله في إطار دائرة جديدة طالما أغفلتها الدراسات السابقة .
المشكلة البحثية :
في إطار البحث عن ما أصاب العلوم الإجتماعية العربية من مأزق وضعنا أمام حاجة ملحة لإعادة النظر في النظرية الاجتماعية المعاصرة والبحث في إمكانية صياغة منظور حضاري معاصر قادر ليس فقط على علاج ما نراه من قصور وتناقضات وانما على المشاركة في المشهد الاجتماعي الحضاري باستكمال أهم مراحله البنائية التي تطلب إستدعاء العلم بقيمه وأخلاقياته . ومن خلال التعرف والإطلاع على محاولات التعامل مع تلك الأزمة والتي تراوحت ما بين الثورة على المنظور المعرفي القائم وتقديم الجديد وبين تجديد القائم وإصلاحه يمكن تحديد المشكلة الأساسية للدراسة في :
“من خلال التتبع لحركة التاريخ الاجتماعي يمكننا إستنتاج أن العلوم الإجتماعية في العالم الغربي ما قامت إلا لبناء المجتمعات وإعادة التوازنات وضبط لسلوك الأفراد بعد ما أحدثته فيها الثورات والصراعات الإجتماعية ، إلا أنها عجزت أو لربما لم ترق حتى الآن إلى القيام بهذا الدور في مجتمعاتنا العربية ذلك على الرغم من تبنيها لهذا العلم الغربي ، فكان لزاماً التساؤل لماذا أخفقت هذه العلوم في الواقع العربي وإختلاف نتائجه عنه في الغربي على الرغم من تماثل المناهج والأدوات ؟ ”
وفي إطار الإشارة إلى وجود عدد من النماذج المعرفية والبدائل المنهجية للبحث في هذه التساؤلات بل ومحاولة معالجة الأسباب ، إلا أننا سرعان ما نكشف عن قصور هذه المحاولات أيضا ، فيبقى هناك حاجة ملحة إلى السعي نحو إستعادة هذه العلوم لجانبها القيمي والأخلاقي بحيث تسهم بشكل فعال في الواقع الاجتماعي المعاش بتوجيه مساره وتعديل حركته ، ومن خلال التعرف على طبيعة التطور التاريخي للنظرية المعاصرة وإختلاف مآلاتها ونتائجها ، فإننا نحاول أن نطرح رؤية جديدة قد تسهم بشكل أو بآخر في إعادة الفلسفة الكلاسيكية في ثوب معاصر .
هذا المنهج الذي يجب وأن ينطلق من البحث في الاخلاق وكيفية إستعادة الجانب القيمي الذي أودت به الوضعية الغربية ، وذلك ما يدفعنا إلى تناول السؤال البحثي التالي :
“هل يمكن الاعتماد على الخبرة الروحية للحضارات – الحضور الروحي – أو ما يطلق عليه بالتصوف في إستعادة الدور البنائي والإرشادي للعلم الاجتماعي خاصة في مراحل ما بعد الثورات ؟ ”
الأسئلة الفرعية :
تسعى الدراسة إلى الإجابة على المشكلة البحثية الرئيسية وذلك من خلال البحث حول مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرى المتمثلة في الآتي :
(1) ما هي الدواعي التاريخية لنشأة النموذج الوضعي والتي تجعله يعجز عن فهم العالم العربي ؟
(2) ما هي النماذج المعرفية البديلة لعلاج النتائج السلبية لإستدعاء النموذج الوضعي الغربي في دراسة الظواهر المجتمعية العربية ؟
(3) ما أوجه القصور في هذه النماذج ؟
(4) هل يمكن الاعتماد على التصوف في إستعادة روح التأمل الفلسفي للعلوم الاجتماعية ؟
(5) كيف يمكن لهذا النموذج أن يقدم مخرجاً لما آلت إليه حال العلوم الإجتماعية ؟
(6) كيف يمكن للعلوم الاجتماعية من خلال هذا الفكر الصوفي أن تقوم بدورها المجتمعي المنشود ؟
المفاهيم الأساسية للدراسة :
– المنهج : تهتم هذه الدراسة بالجانب المنهجي أكثر من التطبيقات العملية ومن ثم تعتمد على رؤية وموقف معين من التعريف للمنهج ، فالمنهج له معنيان : أحدهما إبستمولوجي يرمز إلى تلك المواقف الفلسفية حول طبيعة الواقع وسبل معرفته وإمكانية الوصول الى تلك المعرفة ، والآخر معنى تقني يتمثل في الطريقة والاجراءات التي يتم إتباعها لبلوغ غاية معينة أو لأغراض البحث .
بينما في جانبه الفلسفي الابستمولوجي يتم النظر إليه بإعتباره مجموعة من المنطلقات والخلفيات والمفاهيم الفلسفية والتصورات العقلية بل ومجموع الآليات المعرفية التي تشكل النقطة المرجعية والجهاز المفاهيمي للباحث والذي يمارس عليه ضغطاً مباشراً أو غير مباشر . وهو ما سوف تعتمد عليه الدراسة في تعريفها للمنهج .
فهو عبر هذا السياق يعني العقل الذي تشكل وتكون عبر سيرورة تاريخية حتى أصبح مع الزمن سلطة تفرض نفسها في كل مجالات المعرفة .
– النموذج المعرفي : يعتبر توماس كوهن أول من قدم مفهوم النموذج المعرفي في إطار تفسير كيف يتطور ويتقدم العلم فهو أول من أعطى له دلالة إصطلاحية وبعد علمي وأدخله في بؤرة فلسفة العلم .
ونظراً لحداثة هذا المفهوم وغموضه فإنه لا يمكن تقديم تعريف دقيق له حتى أن كوهن نفسه قام باستخدمه باثنتين وعشرين دلالة فضلاً عن إعترافه ذاته بغموض المفهوم في كتابه “بنية الثورات العلمية” .
إلا أنه يمكن تعريفه في ضوء ما توصل إليه كوهن كونه “مجموعة متآلفة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات والتطبيقات التي يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين” ، أي أنه يشكل طريقة للتفكير والممارسة من خلال مجموعة المنطلقات والتصورات التي تتدخل في إستجابة الباحث وإدراكه للإشارات المختلفة من العالم حوله .
وقد قام كوهن في محاولة لإعادة ضبط هذا المفهوم وتوضيحه بطرح مفهوم “المصفوفة المعرفية” وهو يتكون من أربعة عناصر يعتبر النموذج المعرفي أحدها :
(1) تعميمات رمزية : وهي الرمز والإشارات التي تعد بمثابة اللغة المستخدمة في حقل معرفي معين وهي متفق عليها بين أعضاء هذا الحقل ، ويتشكل هذا البعد الرمزي في العلوم الإجتماعية من خلال المفاهيم .
(2) الأبعاد الميتافيزيقية : وهي المسلمات المقبولة على سبيل اليقين ولا تخضع للمناقشة ومجموع هذه المسلمات يسكل القاعدة الأساسية لعملية التفسير للظواهر والمعضلات المختلفة .
(3) القيم والمعايير السائدة في الحقل المعرفي والتي تحدد ما إذا كان الشئ علمي أم غير ذلك .
(4) النموذج المعرفي : وهو القواعد والوسائل المستخدمة في حل المشكلات وطرق التعامل مع مصادر المعرفة وهو يمثل مشترك أساسي بين جميع الفرق والمدارس العلمية حتى المتنافس منها .
وحدد ريتشاردسون وهولت خمسة عناصر مكونة للنموذج المعرفي كما ورد عند توماس كوهن تتمثل في العنصر المفاهيمي المستخدم في صياغة الفروض النظرية والمحدد لبؤرة البحث ، الحقائق النظرية وهي مجموعة الافتراضات التي تم إثبات صحتها إلا أنها تكون عرضة للمراجعة واعادة التدقيق ، القواعد التفسيرية التي تصف الظاهرة ثم قاعدة تحديد الإشكالات الأجدر بالتناول والتي من شأنها المساهمة في تطوير النموذج إختبار التظريات في ضوء الإحتكاك بالواقع وبالتالي إعادة الصياغة والنظر في الفروض ، وأخيراً التحكم التكويني المحدد لما سيكون عليه القوانين وماهية النظريات وأكد كوهن كون هذا العنصر لايزال غامضاً .
وفي إطار تطور المفهوم أخذ مساراً مختلفاً وإطاراً أعم ، حيث أن النموذج المعرفي عند كوهن أقتصر كونه نموذج تفسيري بالأساس ينتمي لمحاولة فهم التمايزات بين النظريات العلمية و التمييز والتصنيف بين عدد من الفرضيات النظرية العقلية التي تعتمد في إثباتها على القدرة البرهانية ، وهو ما يتيح الحرية للنقد والجدل ، أي أن النموذج المعرفي عند توماس كوهن ذو نسق مفتوح ينتمي إلى مجال الابستمولوجيا.
إلا أنه في فكر ماكس فيبر وعبد الوهاب المسيري قد أتخذ بعداً أعمق في إطار محاولة فهم التمايزات العقائدية والايديولوجية والثقافية ، وهو يقوم على عدد من المسلمات والوثوقيات القطعية الايمانية التي لا تعتمد على البرهان العقلي ، بحيث لا تقبل هذه النماذج المعرفية الايمانية الجدل العقلي وانما تعتمد على طرق التلقي الألوهية الغيبية ، أي أن النموذج المعرفي عند المسيري وفيبر هو نسق مغلق وينتمي إلى مجال الانطولوجيا والميتافيريقا .
وسنعتمد في الدراسة على تعريف النموذج المعرفي بالمعنى الواسع باعتباره محاولة في الوصول إلى الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني ، فالتحليلات المعرفية للظواهر التي تقع في قلب المجال الابستمولوجي تكمن بداخلها إفتراضات ومسلمات أنطولوجية مسبقة ، أي أن النماذج المعرفية تشمل تقاطعات ذات أبعاد وجودية وأخرى علمية عقلية ، وبالتالي يمكن تعريفه كونه “مجموعة القيم والتصورات والمنطلقات المعرفية والمسلمات العقلية التي تتدخل في تحديد القضايا الأولى بالدراسة وتتحكم في طبيعة الهيكل المفاهيمي للمعرفة وماهية النظريات المكونة للعلاقة ما بين الباحث والظواهر الإجتماعية المختلفة” .
فكل واقعة وحركة لها بعد ثقافي وتعبر عن نموذج معرفي وعن رؤية معرفية معينة قائمة على “صورة عقلية مجردة ونمط تصوري وتمثيل رمزي للحقيقة نتيجة لعملية تجريد (تفكيك وتركيب) ” حيث يقوم النموذج على مجموعة من العمليات العقلية :
(1) إستقبال الإشارات من العالم .
(2) قيام العقل بعملية إختزالية لهذه الاشارات بحيث يبقي على بعضها ويستبعد البعض الاخر .
(3) ترتيبها بحسب أهميتها طبقاً للعديد من الاعتبارات المختلفة .
(4) تكوين الصورة الذهنية عن العلاقات الجوهرية في الواقع .
ومن ثم يتحكم هذا النموذج المعرفي في تلقي الظواهر وتفسيرها بل وفي الاهتمام او الاستبعاد لتلك الظواهر ، وما تتحكم في الباحث من تحيزات كامنة داخل النسق تشكل إتجاهاته وتعاملاته مع الواقع حوله . وتدور تلك النماذج او المنطلاقات القطعية حول ثلاثة عناصر أساسية ” الغيب – الطبيعة – الإنسان ” .. وسوف نركز هنا على الإنسان – الموضوع الأساسي للعلوم الانسانية- والذي يمكن أن تمثل دراسته نقطة في إتجاه تحديد موقف النموذج من العنصرين الآخرين ” الغيب – الطبيعة” وكذلك معرفة أبعاد التأثيرات المتبادلة بينهم .
– أسلمة العلوم الإجتماعية : اختلفت التسميات والتعريفات لهذا النوع من الدراسات والذي يهدف إلى الرد المنهاجي على الأزمة المعرفية للوضعية الغربية ، وتتناول الدراسة مفهوم الإسلامية ليس باعتبارها نظرة دينية ضيقة بالمعنى الغربي بما يؤول إلى التناقض فيما بين المعارف الدينية والدنيوية باعتبارهما ينتميان لمجالين معرفيين مختلفين ، وإنما باعتبارها قاعدة تأسيسية لمنظور معرفي حضاري يستجيب لمفاهيم الإسلام ومسلماته العقدية ، أي كمشروع معرفي يستند إلى المرجعية الإسلامية كمنطلق للبحث والنظر .
6
منهجية الدراسة :
تنصب هذه الدراسة على بحث وتحليل النماذج المعرفية المطروحة لدراسة الواقع الاجتماعي العربي الاسلامي ، ومن ثم فهي بحث في المعرفة وكفية تكوينها وأسسها ومسلماتها ومصادرها وأدواتها أيضاً ، لذا فلابد أن تعتمد على واحد من إقترابات تحليل المعرفة وهم أربعة إقرابات أساسية : الأول هو المدخل السيكولوجي أو الدراسة النفسية للمعرفة فهي تركز على قدرات الادراك للمعرفة وتطورها ونموها ، إلا أن علم النفس الادراكي نادراً ما يركز على القضايا الابستمولوجية ويتجاهل تأثير المجتمع والتاريخ على المعرفة ، والثاني ، الاقتراب الفلسفي الذي يعتمد على الابستمولوجي كمدخل لدراسة منتوجات البحث العلمي وكيف تم الوصول إليها والفرضيات والمبادئ الكامنة خلفها ، إلا أنه يتجاوز جهاز المعرفة الإنساني وتكوينه في المجتمع أو في التاريخ ، ثم الاقتراب الاجتماعي أو ما يسمى بعلم اجتماع المعرفة والذي يدرس ويبحث في الظروف الخارجية لعملية المعرفة ويحلل طبيعة شبكة المعلومات والقاعدة الاجتماعية للجماعة العلمية ، وأخيراً هناك الدراسة التاريخية للمعرفة أو الاقتراب التاريخي لمعرفة جذور الفكر وتطوره وهو يعالج المعرفة كجزء من التاريخ .
وهذه الاقترابات الاربعة تعمل معاً نوع من التكامل المنهاجي لدراسة أحد أنواع المعرفة من أجل الوصول إلى جوهر الدراسة العلمية وهدف الباحث من أي حقل معرفي ، هذه الأهداف أو الوظائف التي حددها جالتونج في :
1- إكتشاف النماذج المعرفية وبنائها وتطويرها .
2- الوصف أو المهمة الإمبريقية .
3- الشرح أو الوظيفة النظرية .
4- التعليق والنقد .
وسوف تحاول الدراسة أن تأخذ في الاعتبار هذه المداخل جميعاً للمساعدة في تكوين صورة أوضح عن النماذج المعرفية وإمكانية نقدها بل والمساهمة في الكشف عن بديل آخر وهو غاية الدراسة ، إلا أنها كذلك سوف تعتمد على التحليل الابستمولوجي (الفلسفي) كمدخل أساسي للدراسة .
الإقتراب الفلسفي الابستمولوجي : ستعتمد الدراسة بصورة أساسية على المدخل الأبستمولوجي لدراسة وتحليل البدائل المعرفية مع الاستفادة بالمداخل الأخرى في تناولها وفهمها حسب ما تتطلبه إحتياجات البحث .
والابستمولوجي هو أحد أفرع الفلسفة الثلاثة (الانطولوجي – الابستمولوجي – الأكسيولوجي ) ، ويعني هذا المدخل بنظرية النقد أو دراسة المعرفة ، وكثيراً ما يتم الخلط بين الابستمولوجيا وبين نظرية المعرفة ، إلا أنه في حين تبحث نظرية المعرفة في جميع أنواع المعرفة فإن الابستمولوجيا تختص بالبحث في المعرفة العلمية فقط .
ويقوم هذا الاقتراب على الدراسة النقدية للمبادئ والنتائج العلمية ، والتي تهدف إلى معرفة أصولها المنطقية ، قيمها وثقلها الموضوعي ، أي أنه يتخذ من المعرفة العلمية موضوعاً ، بهدف الكشف عن مبادئها ونشأتها ومقارباتها وتفسيراتها للواقع ، وهو ما يتم وفق نظرة نقدية فاحصة .
ويعود هذا الفرع من الفلسفة إلى أفلاطون – أول من أصل لهذا المبحث – وذلك من خلال بحثه في ماهية المعرفة وأين توجد ؟ وهل بمدنا الأحساس بالمعرفة ؟ أم مصدرها العقل فقط ؟ وما هي العلاقة بين المعرفة والاعتقاد الصحيح ؟ ولم يشهد هذا الفرع أي تطور منذ ذلك الوقت وحتى القرن العشرين ، وهو ما إعتبره كارل مانهايم ضرورة نتيجة لإنهيار الفكر الديني أحادي الرؤية مما أوجب إعطاء إهتمام بالمعرفة وكيفية الوصول إليها ، ويعتبر راسل أول من وضع تعريف الابستمولوجي في القرن الجديد وإن عمل على ربطه بصورة لا تقبل الفصل بالفلسفة ، بحيث أعتبره نوعاً من الشك المنهجي .
مراجعة الأدبيات :
من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع يمكن رصد العديد منها ، ويمكن تناول أهمها في ضوء بعض الاتجاهات الرئيسية ، وفي بداية الأمر تناول البحث ثلاثة إتجاهات تتراوح ما بين دراسات الانتاج الاجتماعي المعرفي بعد الثورات العربية وآخر يتناول البدائل المنهجية المختلفة وأخيراً دراسات النموذج الاشراقي الصوفي ، إلا أنه في ظل إستمرار الثورة بأحداثها وتبعاتها حتى لحظتنا هذه ومن ثم توالي الكتابات والدراسات فيها ، وكذلك ظروف البحث ذاته دفعت إلى تجنب هذا الاتجاه والاقتصار على إتجاهين رئيسيين :
(1) إتجاه يتناول البدائل المنهجية للعلوم الإجتماعية
(2) إتجاه يتناول المدخل الروحي الصوفي
بحيث نوضح نهاية الأزمة وعرض بدائل الحل بل وقصورها ، ثم محاولة البحث في حل يمكنه أن يعيد لتلك العلوم روحها وهيبتها وذلك من خلال عرض هذه الدراسات ذات الصلة بالموضوع من أجل الاستفادة منها والبناء عليها .
أولاً : دراسات خاصة بالبدائل المنهجية للعلوم الإجتماعية :
ينقسم هذا الإتجاه إلى ثلاثة إتجاهات أخرى ، أولها القائم على تأسيس علم إجتماع عربي قومي من خلال العودة إلى الذات القومية أو العربية ذلك لأن العقل العربي أقرب إلى فهم طبيعة مجتمعه مما يحل الإشكال الحادث بسبب إستيراد الغربي ، ويتمثل هذا العقل في التراث الاجتماعي العربي من إرث فكري وعادات وتقاليد وعلاقات ، وتتمثل الجهود الأولى لهذا الإتجاه مع الدكتور أحمد الخشاب القائل بالايديولوجية القومية الصالحة لتفسير الواقع الاجتماعي العربي ، وأبرز الدعاة لهذا الاتجاه الدكتور معن خليل عمر والذي يرى أنه من الممكن الحصول على القواعد الأساسية للحياة الاجتماعية العربية المعاصرة ويغنينا عن تبني تراث المجتمعات الأخرى في دراسة واقعنا ، ويشير كذلك الدكتور عبد الباسط عبد المعطي إلى كون علم الاجتماع العربي يركز جهوده على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية حتى يمكنها الخروج بها من الأزمة التي تعيشها .
وبالنظر في مقولات هذا الإتجاه نجده يركز على الكتابات الاجتماعية للكتاب العرب الذين عاشوا في القرن الثامن إلى الرابع عشر الميلادي ، وبالتالي فهو يقوم على النظرة الانتقائية للتراث الاجتماعي فقد كان واجبا عليه أن يشمل التراث الاجتماعي بشكل عام في مرحلة الاسلام وما قبلها والعصر الجاهلي وتناول العادات والثقافات المختلفة وكذلك التنقيب عن الثقافات المضادة التي فرضت على هذا المجتمع العربي ، كما يؤخذ عليه أنه يأخذ من النزعة العرقية القومية أيديولوجية لتأسيس منهجية علمية وهو من الصعب أن يحل محل النظريات العالمية .
ويتمثل الجانب الثاني لهذه البدائل في دراسات أسلمة العلوم الإجتماعية مثل كتابات الدكتور زيدان عبد الباقي والذي حاول أن يعرض مواضيع لعلم الاجتماع من المنظور الإسلامي ويسعى إلى الربط بين المنهاج الرباني والمنهاج العلمي وكذلك محاولة طرح بعض المصطلحات الاجتماعية بمنظور إسلامي ، وكذلك الدكتور زكي محمد إسماعيل في دراسته التي حاول فيها تعريف أسلمة العلوم الاجتماعية كونها دراسة للمواضيع المتصلة بالقضايا الاسلامية ، إلا أن هناك من الدراسات الأكثر علمية والتي تتخذ من الإسلام منطلقاً في التفكير والتحليل ومن أبرز مؤسسيه علي شريعتي والذي نادى بضرورة إتخاذ الإسلام كأيديولوجية عقائدية قادرة على الوقوف في وجه الأنساق الوضعية ، وكذلك جهود الدكتورة منى أبو الفضل في العديد من كتاباتها من أجل التأسيس للنموذج التوحيدي وإستعادة لدور الوحي ، وهناك دراسة هامة بعنوان “منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية” محمد محمد أمزيان يحاول أن يضيف في هذا المجال ويضع من الضوابط المنهجية لهذا الاتجاه ، فضلاً عن العديد من الدراسات التي تصدر من قبل مجلة أسلمة المعرفة التي تحاول أن تسد ثغرات حوله .
بينما يأتي الاتجاه الثالث في ضوء الاحتواء للفكر الحداثي الغربي ومن أبرز رواده محمد أركون في مشروعه “نقد العقل الإسلامي” والتي هدف منه دراسة بنية العقل الديني وطريقة اشتغاله ووظائفه ويتمثل مفهوم العقل في مجموعة المبادئ والمسلمات القبلية التي من خلالها ينطلق عقل المسلم في التفكير واتخاذ مواقفه تجاه الواقع ، وحاول أن ينتناول أهم المؤلفات في الإسلام وبخاصة رسالة الامام الشافعي باعتباره أول مؤلف لتأسيس أصول الفقه ، وينطلق منها إلى معرفة العناصر الابستيمية للعقل الإسلامي ، وهناك كذلك دراسة الدكتور محمد عابد الجابري “نقد العقل العربي” الذي أختلف مع أركون في العودة إلى عصر التدوين في أواخر الدولة الأموية وهو العصر الذي تكونت فيه الأسس النهائية للعقل العربي متحدثا من خلاله عن النموذج المعرفي الإسلامي .
ثانيـاً : دراسات تتناول التجارب الصوفية :
تتعدد الدراسات التي تتناول التصوف بحيث لا يمكن حصرها ، إلا أننا سنحاول فقط أن نقوم بتقسيم المداخل لدراسته والإشارة إلى عدد منها بما يسمح بتحديد موقع دراستنا هذه وما يمكن ان تساهم به ، ومن هذه الاتجاهات : المدخل التاريخي الذي يقوم بتتبعها لدى المتصوفة المسلمين عبر القرون المختلفة من أجل توضيح تطورها وهو ما يتم من خلال التركيز على النصوص والمعاني في كتاباتهم ، إنطلاقاً إلى التأكيد على إختلاف هذا المصطلح وتطور توظيفه بطرق وأساليب مختلفة عبر التاريخ الإسلامي ، فهناك حركة الزهد في القرنين الأول والثاني الهجريين ، ثم عصر المصنفات الصوفية في القرن الثالث حتى نهاية القرن الخامس ، حتى ظهر ما أطلق عليه في تاريخ التصوف بالتصوف الفلسفي ، ثم إنتشار الطرق الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجريين .
وهناك المدخل الفسلفي في دراسة التصوف والذي تزعمه ولتر ستيس وهو لا يكتب عن تاريخ التصوف وإنما يعمد إلى تشريح ماهيته مؤكداً أن التصوف ليس ذلك الجانب الديني العباداتي المحض إنما هو الحضور الروحي الإنساني الأشمل ، وقد تناول بالشرح طبيعة التجارب الصوفية وما يتعلق بها من رؤى وظواهر ، وقد مثل كذلك أحد دارسي التصوف من جانب المنطق وذلك بتطبيق النظريات المختلفة وتوضيح موقف التصوف منها ، وهناك دراسات تتبع تطبيق هذا المنطق لكنها تسعى إلى ذلك من أجل نقده وهدم أسسه والتأكيد كونه لا يتماشى مع قواعد التفكير الصحيح .
وتعد أكثر الدراسات التي تناولت التصوف تقع في إطار الدراسات اللاهوتية ، والتي تنقسم إلى إتجاه مؤيد للتصوف يسعى للدفاع عنه باعتباره تزكية للنفس ومنهج للتربية الروحية لدى الانسان بل أن البعض رأى فيه حلاً لتلك الأزمة الأخلاقية اليوم ، ويركز هذا النوع على الاقبال على دراسات حياة المتصوفة وما فيها من روحانيات وفيوضات إلهية وتحاول أن تسعى قدر الإمكان – سواء صراحة أو في الخفاء- دفع الشبهات من معارضيه ، في حين أن الجانب الاخر يضع على عاتقه الهجوم عليه وذلك بتفكيك نصوصه ورموزه الخيالية وتأويلات المتصوفة في وصف تجاربهم وذلك للخروج بنتيجة أساسية مؤداها تكفيرهم أو على الأقل تأكيد شطحاتهم مما قد يخرجهم عن الملة ، وأكثر ما تسعى إليه هذه الدراسات هو ربط الأقوال والنصوص بما يشابهها في الديانات والثقافات الأخرى ولاسيما الوثنية واليهودية والغنوصية ويتم تناول هؤلاء المتصوفة تحت مسمى التصوف الفلسفي ، أي أن هذا الجانب يريد أن يقصر التصوف في جانبه الأخلاقي الديني – على إعتبار أن الاخلاق لا تتصل بالفلسفة – .!
أما الجانب المعرفي في دراسات التصوف لا تكاد تكون بالكثيرة ، ولكنها تحاول أن تتعرف على مصادر المعرفة والتلقي لدى هؤلاء المتصوفة ، لكن ما نلاحظه أنها تقتصر في دراستها على الطرق الصوفية دون الفكر وبالتالي تقوم بإعطاء دور واسع لللشيخ وما يرتبط بذلك من نتائج تتحدد في الكرامات ، ودراسة أخرى عمدت إلى تناول المنهج الصوفي الإسلامي منتقلة من الجانب الرمزي (السيميولوجي) إلى الجانب المعرفي وذلك بالاعتماد على التحليل التفكيكي لرموز اللغة وأدوات المنهج . وتأتي نهاية الدراسات التي تتناولها من الجانب السياسي وهي تقتصر بدورها على الطرق الصوفية باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة وتتناول ما يمكن أن تلعبه من دور في الحياة السياسية ، ومن أبرز الدراسات في هذا الجانب هي دراسة عمار علي حسن وما تمثله من تحليل نقدي للمكونات المختلفة لتلك الطرق متراوحة ما بين الفكري والتاريخي والمعرفي موضحة دوره في التنشئة والمشاركة السياسية .
وفي هذا الإطار يوجب علينا الإشارة كذلك إلى ظهور عدد كبير مؤخرا تتناول هذه الطرق باعتبارها أداة للدول الغربية من أجل التحكم في الشعوب الإسلامية وتنشر فيها اللامبالاة والسلبية خاصة بعد صدور تقرير مؤسسة راند بعنوان “بناء شبكات مسلمة معتدلة” والتي أوضحت فيه تعامل السياسة الأمريكية مع الأحداث في العالم اجمع .
ملاحظات حول الأدبيات السابقة :
بعد أن اطلعنا على عدد من الدراسات المتعلقة بالموضوع محل البحث ، وفي ضوء ما سبق أن ذكرناه من تعليقات خاصة بكل إتجاه على حده ، علينا الآن أن نتعرف على موقف هذه الدراسة من تلك الأدبيات ، وذلك من خلال التعرف على الإيجابيات للاستفادة منها، والسلبيات حتى يمكن تفاديها والبناء عليها كذلك ، فمعرفة اوجه القصور والثغرات في البناء المعرفي هي التي تسمح بإمكانية تقديم ما يمكن أن يخدم الحقل المعرفي ذاته ، ومن هنا نلاحظ أن هذه الدراسات استطاعت ان تستشعر وجود خلل في البنية المنهجية للعلوم الاجتماعية ، فسعت إلى البحث عن حلول من خلال استبدال المنظور المعرفي القديم بآخر جديد قادر على ان يستوعب الواقع الذي نشأ منه ، إيماناً بأن رفض المنظور القديم من دون استبداله في الوقت نفسه بآخر هو رفض للعلم ذاته ، إلا أنها في إطار سعيها لتكوين هذا البديل تعثرت في تشكيل أدوات منهجية بامكانها التعامل مع الواقع المجتمعي وانما ظلت حتى الان قيد الدعوة ، وهو الأمر الذي يرجع في الحقيقة إلى سيطرة عقلية التحدي ، فهذه الدراسات لم تتمكن من التخلص منطلقات النموذج السابق وانما بنت فكرها عليها ، فالمتغير فقط النتائج على نفس المقدمات ، فلم تحاول أياً منها البحث في الأسس العلمية والبنية الفلسفية للعلم ذاته .
ومن جانب آخر ، نجد أن كلا الاتجاهين – المنهجية والصوفية – أغفلت الأهمية الفلسفية والاجتماعية بل والعلمية للتصوف وذلك بما يملكه من مفاهيم ورؤية وموقف خاص ، بل أقتصرت أغلب الدراسات عن الصوفية على الجانب اللاهوتي وتجنب تناولها كنموذج للمعرفة نظراً للصعوبة الناتجة عن الإختلاف الواسع حوله بل وفي داخله أيضاَ . وهو ما سوف تحاول هذه الدراسة القيام به.
تــقسيـــم الدراسة :
من خلال المشكلة البحثية الرئيسية التي نسعى إلى تقديم الإجابة أو المعرفة حولها من خلال التكامل المنهاجي بين الاقترابات المعرفية بشكل عام والاعتماد على المدخل الابستمولوجي بشكل خاص وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على تقسيم الدراسة ، وستنقسم الدراسة الى ثلاثة فصول رئيسية :
– الفصل الأول : يتناول هذا الفصل البحث في نشأة المنهج الوضعي والبدائل المنهجية في العلوم الاجتماعية ، ومن ثم ينقسم إلى عدة مباحث فرعية ، يتناول المبحث الأول منها المنهجية الوضعية في دراسة العلوم الاجتماعية وذلك من حيث دواعي النشأة والأسس المنهجية وكذلك النتائج المترتبة عليه ، ثم يأتي المبحث الثاني ليوضح إنعكاس هذا النموذج الوضعي على الدراسات العربية فيحلل في أسباب تلك التبعية وأشكالها ونتائجها وصولاً إلى وضع البدائل المنهجية كمحاولة للفكاك من تلك الهيمنة ، وفي المبحث الثالث يتم التعرض الى أسلمة العلوم الاجتماعية كخطوة أخيرة وقفت عندها تطور مناهج العلوم الاجتماعية في الوطن العربي .
– الفصل الثاني : بداية من هذا الفصل يتم الكشف عن المنهج الصوفي وموقعه في دراسات اسلمة العلوم الاجتماعية ، وينقسم إلى ثلاثة مباحث : الأول يتناول المحاولات العلمية للصياغة المنهجية للعلوم الاجتماعية ويتم التطرق خلالها كذلك إلى الوجود الصوفي في دراسات أسلمة العلوم الاجتماعية
من أجل الوقوف على نظرة هذه الدراسات لهذا المنهج ، بينما يركز الثاني على شرح طبيعة المنهج ذاته والتعريف به ومحاولة تزضيح خصائصه ليأت بعد ذلك المبحث الثالث مقدماً طبيعة العرفان الصوفي وكيفية تسكينه للأدوات المعرفية المختلفة .
– الفصل الثالث : تذهب الدراسة في هذا الفصل الى تناول التأمل الفلسفي في ضوء النموذج المعرفي الصوفي وذلك بالتركيز على الفلسفة السياسية ، وهو يشمل ثلاثة مباحث : يتناول التصوف والفلسفة السياسية ويتضح فيه مدى إختلاف التأمل الصوفي عن غيره من انماط التفكير انعكاساً لطبيعة المعرفة في ذلك النموذج ، وبالتطبيق على قضية الانسان الفاضل محور التفلسف السياسي وهو ما يتم في المبحث الثاني ، ثم التطرق لموضوع الثورة في قلب النظرية الصوفية في المبحث الثالث .
الفصل الاول :
في نشأة المنهج الوضعي والبدائل المنهجية .
في العلوم الاجتماعية.
إننا في إطار هذا البحث نسعى إلى دراسة البدائل المنهجية السائدة في الوطن العربي والتي تحكم الرؤية أثناء الدراسة للمجتمع وللفرد وللمواطن ، وفق نظرة نقدية فاحصة في محاولة إلى إبراز أحد الجوانب التي طالما أغفلتها الدراسات على الرغم من أنها تحفل بالعديد من الأدوات والمفاهيم الهامة والمتعلقة بالإنسان في علاقته بالدوائر الوجودية المختلفة ، علينا بداية أن نتناول بالتحليل هذه البدائل وأسباب الدعوة إليها وآلياتها ، وتعاملها مع القضايا المجتمعية المختلفة ، بل تأثيرها على العلوم الاجتماعية وعلاقتها بالواقع المجتمعي أيضا ، إلا أنه حال الباحث في الوطن العربي بل والاسلامي بشكل عام عند محاولته لفهم طبيعة البحث العلمي ، حيث يتوجب عليه – أولاً وقبل أي شئ – أن يفهم العلم الغربي ودواعي نشأته وأدواته وتطوره ، وذلك إقراراً بهيمنة النموذج الغربي على العقل العربي الذي أصبح يفرض عليه قضاياه وأدواته المستخدمة لدراستها والنتائج التي يصل إليها ، مما ساهم في تحويله إلى صورة ناقصة أو إنعكاس للصورة الأساسية هذا الانعكاس الذي دائما ما يكون فارغ المضمون عديم الروح ، لا تلبث أن تكون حركته مشلولة تتوقف على إرادة خارجية.
فأصبح واجباً البحث في دواعي ظهور المنهجي الوضعي الغربي والدوافع التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وتحديد نتائج الاعتماد عليه في العلوم الاجتماعية من أجل الوقوف على السلبيات والنقائص لكي نكون على وعي بها من أجل تداركها ، وفي إطار الهيمنة الفعلية لهذا النموذج فإنه يبقى أن ندرس كيفية إنعكاسه من خلال المدارس الاجتماعية المختلفة في الوطن العربي والتي جاءت كصدى لتلك الافكار الغربية ، وكذلك مدى تأثيرها على فهم ودراسة المجتمع العربي ذاته .
ونتيجة لهذه الهيمنة ظهرت دراسات اخرى ترفض هذا النموذج وتدعوا إلى صياغة بدائل نابعة من الخصوصية الثقافية ، وتعددت تلك المحاولات إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من صياغة مناهج علمية يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل ، لذا فإننا لكي نتمكن من تطوير هذه الدراسات يجدر علينا أن نقف عند المحاولات السابقة للتعرف على أوجه القصور .
وبالتالي يمكن تقسيم هذا الفصل إلى عدة مباحث أساسية كالآتي :
أولاً : المنهجية الوضعية في دراسة العلوم الاجتماعية
ثانياً : العلوم الاجتماعية في الوطن العربي
ثالثاً : في أسلمة العلوم الاجتماعية
بحيث نتمكن نهاية من تكوين صورة شبه شاملة عن حالة هذه العلوم في بلادنا العربية وتطورها ، والوقوف عند المراحل الهامة التي مرت بها ، وكذا التوصل إلى تحديد موقف خاص منها تمهيداً للحديث عن المنهج الصوفي في الفصل القادم وكيف يمكنه أن يقدم بعض الحلول في تقويم هذه البدائل .
المبحث الأول : المنهجية الوضعية في دراسة العلوم الإجتماعية:
في إطار سعي تلك الدراسة إلى البحث عن بديل منهجي أو بمعنى أدق المساهمة في تشكيله ، فإنه يكون من المهم توضيح سياق نشأة المنهج الإجتماعي السائد ، وفي ظل هيمنة المنهج الوضعي الغربي على العقلية العربية بل والعالمية فإنه لابد من تناول دواعي قيام هذا النموذج وأسسه المنهجية ، ثم رصد إنعكاس هذا الفكر الغربي على المدارس العربية ومحاولتها لتلفيق هذا النموذج المستورد في ظل ظروف ثقافية مختلفة مما أدى إلى إغترابها عن الواقع ذاته ، فأصبح هناك فجوة بين المفاهيم ومدلولاتها وكذلك العلاقات فيما بينها ومن ثم القضايا التي يتم تناولها في ظله ، أي أن إستعارة هذا النموذج الغربي كان له مردوده السيء على العلوم الإجتماعية في الوطن العربي . وبالتالي سوف يدور نقاشنا التالي حول مجموعة من النقاط الرئيسية كما سنرى .
أولاً : دواعي قيام المنهج الوضعي – الغربي :
إن النموذج المعرفي السائد وبلا شك هو نتاج تطورات تاريخية وثقافية وفكرية معينة ، والعلم ما هو إلا وليد هذا النموذج فيتأثر ببيئته ومشكلاته وكذلك الواقع الذي نشأ فيه ، وعندما ننظر إلى الأصول الاجتماعية لنشأة النظرية الغربية نستطيع أن ندرك ما يستند إليه من مسلمات حول فكرة الصراع بين العلم والدين والتي أصبحت ضرورة تاريخية لا محيد عنها ، هذا الصراع الذي أنتج عدد من الخطوات التقدمية في سبيل العلمية داخل العالم الغربي وذلك نظراً لما عايشه من مقدمات إحتكارية استدعت هذا المنهج الفكري .
وبالتالي هناك عدد من الدواعي التاريخية لقيام تلك الوضعية ، ويأتي في صدارة هذه الأسباب ما يسمى بالإحتكار الكنسي للفكر العلمي حيث أحتكرت الكنيسة الكاثوليكية مجال التفكير وجعلته قاصراً على التقاليد البابوية بحجة أن “الإنجيل كلمة الله ” ، وهو ما أدى إلى سيادة النزعة النصية وتجميد التفكير العلمي ، وأتخذت العلاقة ما بين العلمي والديني شكل مواجهة تناقضية لا وسط بينها . حتى أدرك المفكرون أن عودة الروح العلمية لا تتم إلا بتقويض هذا الفكر الديني الذي يتسم بالخرافة التي أدخلها باباوات الكنيسة ، وبالتالي من يريد أن يكون حراً لابد وأن يكون علمانياً .
بينما يأتي في المرتبة الثانية هذا التحالف ما بين الإقطاعي واللاهوتي ، فقد وقفت الكنيسة خلف السلطة السياسية والإستبداد الإقطاعي بزعم أن “الحكم لله” ، ثم ظهرت نظرية “حق الملوك الإلهي” وأصبح الحكم الملكي يستمد شرعيته وسنده من الكتاب المقدس بدعم الكنيسة ، وهو ما يتجلى في تقاليد تولى السلطة من حفل تتويج التي يقسم فيها الملك اليمين وهو عمل ذو مغزى ديني وجزء من سلطة الكنيسة ، وأمتدت سلطة اللاهوت الكنسي في تحديد القوالب الفكرية والأخلاقية للناس ، بينما وقفت السلطة الزمنية الاقطاعية عند حد تقديم التغطية الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الكنيسة والالتزام بالتقاليد البابوية ، هذا التلازم أسفر عن أبشع صور الإضطهاد الفكري الذي تمثل في محاكم التفتيش التي أعتبرت بمثابة الجهاز التنفيذي لهذا التحالف والذي ملأ العالم بالدماء وقيد العقول بالخرافات وأدى الى جمود العلوم ، فارتبط التخلص من هذا الإستبداد الملكي بتقييد السلطة الدينية وسقوط البابوية المطلقة .
وأدرك المفكرون أنه لا سبيل لنهضة العلم وأعادة الاعتبار للانسانية إلا بتقويض هاتين السلطتين ، خاصة أن هذه الفترة من الاحتكار الكنسي قد توسطت فترتين أزدهر فيهما التفكير العلمي ، فمن ناحية جاء العهد اليوناني بما تبدى من ابتعاد عن الدينية وأنتج فكر متحرر بقدر كبير رغم وجود تقديس للمسلمات الغيبية وما تمثل من محاكم تفتيشية وإعدام بعض المفكرين بحجة الإساءة للمعتقدات الدينية ، ويزداد الأمر حدة عندما يرتبط الموضوع المباشر للبحث هو الانسان من حيث قيمه وعقائده وعلاقاته الاجتماعية ، ومن جانب آخر فترة ما بعد سلطة الكنيسة حيث علمانية العلم (القرن الخامس عشر وما بعده) ، حتى أستقر في ذهن الانسان الغربي وجود علاقة عكسية بين الدين والحضارة ، فكلما سيطر الدين ماتت الحضارة وتجمدت العلمية ، وذلك من مسلمة مؤداها أن الدين هو المسيحية الكاثوليكية والمسيحية هي رجال الكنيسة و رجال الكنيسة نواب الله في الأرض !! .
وقد جاءت محاولات بناء النهضة مرتبطة بالقضاء على هذا الاحتكار وسقوط تلك السلطة اللاهوتية ، وتزامنت تلك المحاولات مع دخول العلوم الإسلامية إلى الدول الأوربية – القرني الحادي والثاني عشر- وإنشاء العرب مدارس في أوربا لتلقين العلوم ، إلا أن الإتجاه العلمي المتأثر بالظروف الإجتماعية السائدة قام على نظرة فاصلة بين ما هو واقعي وبين الديني تلك النظرة التي شكلت المصفاة الثقافية لعملية التلقي ، مما أساء الفهم والتفسير للتراث الإسلامي المنقول .
وصاحب هذا الإنهيار للتفكير الاهوتي تحول في السلطة الزمنية نتيجة فك هذا الارتباط وانفتح الطريق أمام نمط جديد من السلطة السياسية والروحية بل والممارسة العلمية ، ووصل هذا الفصل ذروته مع مطلع القرن الثامن عشر حيث أستطاع الفكر الغربي أن يقطع أشواطاً في التحرر من الفكر الديني حتى أطلق عليه بعصر التنوير ، والذي قصد إبعاد كل ما هو ديني عن التوجيه بل وإستبداله بأخرى قائمة على معايير عقلية . وحتى نهاية هذا القرن كانت ملامح الحداثة واضحة والأرض ممهدة لقيام ثورة فكرية وثقافية ، إلى أن كانت الثورة الفرنسية التي أعتبرت بمثابة الأساس لبلورة المنهج الوضعي من خلال التأكيد على القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية وإعلاء المذهب الفردي وما تطلبه من إستدعاء للمذهب التجريبي والمنفعة الأخلاقية والسياسية .
وقد مثلت فلسفة أوجست كونت في القرن التاسع عشر تتويجاً للنضال الذي قاده المفكرون ضد الاستبداد الديني ، وسادت نظرة أساسية تقول بأن التفكير الديني قد ساد مجتمعات ما قبل العلمية أما الآن وبعد أن بلغ المجتمع مرحلة الوضعية فلا مبرر للإحتفاظ به ، فالعلم بما يعتمد عليه من براهين عقليه قادر ان يملأ الفراغ الناتج عن تحييد ما هو ميتافيزيقي ، وهو ما ظهر في قول سان سيمون : “إن السلطة العلمية والوضعية هي نفسه ما يجب أن يحل محل السلطة الروحية” .
حيث ظهرت حالة من الفوضى بعد تلك الثورة ناتجة عن التحول الثقافي ، لأن الدين كان يأخذ على عاتقه تقديم تصور شامل تتوحد تحته كل العقول ، لكن مع إنهيار الديني تلاشت تلك الوحدة ، ولم يعد هناك أي وجود لقواعد عامة يخضع لها الناس في تفكيرهم وسلوكهم ، لذا أعتقد كونت أن عليه أن يقوم بمهمة إصلاحية أساسها إعادة بناء نظام عام للتفكير من خلال هذا البديل الوضعي العلمي .
واستطاعت الروح الوضعية أن تحقق نجاحاً باهراً على مستوى العلوم الطبيعية ، ولم يبق سوى أن تمتد إلى كل مجالات التفكير بما في ذلك الإنسانية والدين والأخلاق والإجتماع ، بحيث تصبح يقينية خاضعة للملاحظة والتجربة وإستنتاج القوانين وهو ما سعى كونت إلى وضع أساسه النظري ، ثم جاء دوركايم فعمد إلى ترجمة هذه المبادئ النظرية إلى ممارسة عملية فأخضع الأخلاق للدراسة الواقعية الحسية بعيداً عن تأملات الفلاسفة .
ثانياً : الأسس المنهجية للمنهج الوضعي :
تقوم الوضعية الغربية على مجموعة من المسلمات اللازمة لما هو علمي ، باعتبار أن العلمية هي طريقة للكشف عن الحقائق الموضوعية من خلال الملاحظة وتسجيل الشواهد التي ترتبط بالفروض المراد إختبارها والتحقق من صدقها ، وهذه الخطوات المنهجية واحدة في كافة المجالات العلمية إفتراضاَ أن للعلم منهجاً واحداً قابلاً للتطبيق على جميع الظواهر ، بل أن تلك العلمية قد تقتدي إختزال لجميع الظواهر في الوقائع الطبيعية بحيث لا تختلف عن بعضها البعض إلا في درجة التعقيد والتركيب ، ويمكننا أن نوجز هذه الأسس في مجموعة من النقاط الرئيسية :
– تقديس النموذج الطبيعي : قام المنهج الغربي على إعتبار العلوم الطبيعية السلطة المرجعية للعلوم الإنسانية ، وحاول علماء الاجتماع تطبيق المنهج التجريبي في كل المجالات مستفيدين من الانجازات التي حققها على المستوى الطبيعي ، فظهرت محاولات وحدة المنهج في التفكير بغض النظر عن طبيعة الموضوع المدروس ، فأصبح ينظر إلى علم الفيزياء كونه نموذجاً مثالياُ للعلمية مما دعى إلى إستخدام مناهجها القائمة على الملاحظة والتجربة في العلوم الإجتماعية .
ويذكر كوفمان أسباب هذا الربط ما بين العلوم الاجتماعية والطبيعية بل وإعتبار انها أحد فروعها فيقول : “إن مرجع هذا الزعم بأن العلوم الاجتماعية قد أصبحت فروعاَ من العلم الطبيعي أن العلوم الطبيعية كانت عند القدماء فرعاَ من الفلسفة موضوعاَ ومنهجاَ .. لهذا عجزت عن تفسير الظواهر الطبيعية طوال العصور القديمة والوسطى ، فلما وضعت مناهج البحث التجريبي في أوربا منذ مطالع العصور الحديثة ، وقامت دراسة الظواهر الطبيعية على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية ، كشفت عن كنوز من الحقائق لم تكن لتكتشفها لو ظلت تستخدم المناهج العقلية ، وتوصلت الى كشف قوانين دقيقة .. وكانت العلوم الاجتماعية تعاني إبان العصور الحديثة من أزمة مرجعها الى الشك الذي يساور الناس بصدد قوانينها ومناهجها لأن حظها من خدمة البشرية يعد ضئيلاً بالقياس الى ما حققته العلوم الطبيعية من خدمات للمجتمع الانساني ، ومن هنا نزع جمهرة المشتغلين بالعلوم الاجتماعية الى تغيير مناهجها حتى تصبح لها من النفع في المجال العملي ما للعلوم الطبيعية ، فتأدى بهم هذا إلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية التجريبية على العلوم الاجتماعية ” .
– سيادة النزعة التجريبية في دراسة الظواهر الإجتماعية : تم إخضاع جميع الظواهر الإجتماعية للتجريب وإقصاء التجريدات والتأملات الفلسفية مما أدى إلى تفضيل نمط الظواهر والأوضاع التي تكرر نفسها والسلوك الواقعي للناس على تلك الظواهر التي تحدث مرة واحدة ، كما تتطلب تلك النزعة حتمية التحرر من الأفكار السابقة عن الظواهر والاعتماد على التجربة والمشاهدة ، وقد كان الهدف من ذلك قطع الصلة ما بين التفكير الديني وبين فهم وتفسير الظواهر أي إقصاء دور الدين (الوحي) من دائرة العلم .
– الحس مصدر المعرفة الإجتماعية : أكدت وضعية دوركايم على كون الحس هو الدعامة الأساسية للعلم ونفي وجود أي مصدر آخر ، فجميع المعارف تأتي من الحواس ، وعلى الرغم من تأكيدنا على أهمية الحس في تقصي الحقائق لكن نزعت الوضعية إلى نفي أي مصدر معرفي آخر خارج هذا الإطار ، فالطبيعة والواقع والحس كلها كلمات ذات معنى واحد يدل على المعنى اليقيني للوضعية ، وكل ما يأتي من وراء الطبيعة خداع للحقيقة .
– مادية الظواهر الإجتماعية : ربطت الوضعية ما بين الظواهر الاجتماعية والعلوم الطبيعية ، وأصبح علم الاجتماع جزء من العالم الموضوعي تخضع ظواهره لقوانين البحث العلمي ، والأخذ بشيئية الظواهر الاجتماعية ومعاملتها كونها مجرد أشياء خارجة عن ذواتنا وهو ما أكد عليه دوركايم بقوله : “إننا لا نقول في الواقع بأن الظواهر الإجتماعية أشياء مادية ، ولكننا نقول أنها جديرة بأن توصف أنها كالظواهر الطبيعية تماماً” .
وهذه الدعوة إلى شيئية الظواهر الاجتماعية تجاهلت طبيعتها النابعة من إرادة حرة وواعية ، و تعاملت معها كونها أشياء جامدة ، يتم فهمها من الخارج عبر الملاحظة والتجربة .
ثالثاً : نتائج المنهج الوضعي على العلوم الإجتماعية :
بعد أن أوضحنا دواعي قيام هذا المنهج الواقعي المادي وأسسه المنهجية في تحديد العلمية ودراسة الظواهر المختلفة ، يمكننا أن نرصد مجموعة من النتائج التي ترتبت على هذا المنهج بمسلماته العقلية بما يجعلنا قادرين على إدراك أهمية ودواعي ظهور الدعوة إلى أسلمة العلوم الإجتماعية “علم الإجتماع الإسلامي” ، لكن يجدر بنا كذلك أن نشير إلى أن هذا المنهج كان بالفعل خطوة ضرورية في سبيل إحياء العلمية وعودة الثقة إلى العقل مرة أخرى بعد أن ساد التفكير الخرافي كما أشرنا سابقاً في مرحلة الاستبداد الكنسي ، أي أنه كان ضرورة أستدعتها الظروف التاريخية والصراع بين السلطتين الزمنية والدينية بل العقلية والدينية كذلك .
وقد استطاع هذا المنهج أن يساهم في تقدم العلوم الطبيعية نظراً لما تتميز به موضوعاتها من محايدة وامكانية التجريب والتحكم فهي خالية من الوعي أو الإرادة التي تتسم بها الأفعال الإنسانية ، فكان هذا المنهج بما أدى إليه من عزل الجانب الروحي والدين والسحر والشعوذة وغيرهم سبباً في مواصلة إنطلاقها بينما تخلفت عنها العلوم الاجتماعية ، وإن ذهب هوسرل في رأيه إلى كون هذه الإنطلاقة في الحقيقة ليست مانعة للقول بأزمة العلوم حتى الطبيعية ، فتقدم العلوم الطبيعية بقدرتها على الوصول لقوانين تحكم الظواهر في العالم الموضوعي لا يعني أنها لا تعاني من نفس التخلف الذي تعانيه الإنسانية ، فإنه يمكننا أن نتحدث عن أزمة للعلوم بشكل عام حتى وإن حققت بعض التطورات ، لأن الأزمة في الحقيقة هي أزمة في المنبع الذي تقوم عليه العلوم كافة أي أزمة فلسفة التي وان لم تكن العلوم ذاتها لكنها كما توصف هي “أم العلوم” ومن ثم فأي خلل في الأصل يؤدي إلى خلل مضاعف في الفروع .
لكن لا ينفي ذلك أن تلك الأزمة قد وجدت لها صدى واسع في الدراسات الاجتماعية بما أوجده المنهج الوضعي من إلزامية في إختزال الظواهر في جوانبها المادية الواقعية بحجة قابليتها للإدراك العلمي ، ويمكن أن نرصد عدد من النتائج المترتبة على الوضعية المادية في دراسة الظواهر الاجتماعية :
– إختزال الظواهر الإجتماعية في جوانبها المادية الواقعية : قامت الوضعية الغربية بالدعوة إلى وحدة المنهج العلمي في التفكير بفرض المنهج الوضعي منهجاً علمياً عاماً يمتد إلى دراسة كافة مجالات الحياة ، وإعتبار نموذج العلم الفيزيائي بمثابة السلطة المرجعية للبحوث الإجتماعية ، فأصبح الباحث لا يفرق في دراسة الظواهر الإجتماعية بين الحسية القابلة للملاحظة والإدراك المباشر للظواهر الدينية والأخلاقية ذات الطبيعة المخالفة .
هذه الإختزالية أثرت في نظرة العلوم الإجتماعية إزاء الإنسان والعالم ، فعلى الجانب الإنساني رأت ضرورة الإقتصار على إدراك الجانب العضوي والسلوك الواقعي وتغفل في ذلك الجوانب الأخرى كالعاطفة الدينية بل ترفض تماماً التسليم بوجود حياة داخلية خاصة للإنسان ، وكذلك في النظرة على العالم فهي تؤكد على إختزال الظواهر في جانبها المادي وإستبعاد كل العناصر الغيبية حتى في دراسة الظاهرة الدينية .
فالوضعية بطابعها المادي عليها أن “تقنع بمعالجة نوع خاص من الظواهر يقتصر على الظواهر ذات الطبيعة المادية القابلة للادراك الحسي وهو مالم تقبل به الوضعية لإيمانها بوحدة منهجها وعموميته وضرورة إستيعابه الظواهر كلها ، وهي ممارسة فيها الكثير من التعسف المنهجي .. فأصبحت تلج عالماً مجهولاً لها لا تملك مفاتيح أبوابه ، وهو ما سيجرها إلى تخبطات منهجية وتأملات شخصية لا تتمتع بحد أدنى من العلمية” .
– نسبية القواعد الأخلاقية : رفضت الوضعية إعتبار النظرية الأخلاقية نظرية تأملية ميتافيزيقية ، أي التأمل والبحث في المثاليات الأخلاقية الافتراضية التي لا تقع ضمن الوجود الواقعي ، فالأخلاق بالمعنى الواقعي تطلق على مجموعة الأفكار والأحكام والعادات التي تتصل بحقوق الناس وواجباتهم والتي يعترف بها الأفراد بصفة عامة في عصر معين ، فأصبحت علمية الظواهر الأخلاقية تتطلب دراسة ما يوجد فعلاً فأقتصرت الاخلاق على الكشف عن القوانين التي تسيطر على الظواهر .
وقد أدت نسبية الأخلاق إلى إختزال مهمة العلوم في البحث عن الأسباب المباشرة لخلق الظواهر وليس البحث عن العلة الأولى لوجودها ، فالبحث عن العلل الأولى أصبح من سمات المنهج اللاهوتي الذي يؤمن بوجود حقائق مطلقة ، في حين ان الوضعية ترفض ذلك المطلق وتؤمن بنسبية الأشياء ، والعلم لا ينبغي له أن يبحث عن الغايات التي نسعى وراء تحقيقها ، فهو لا يميز بين الخير والشر لأنه لا وجود للخير والشر في العلم .
– الوضعية في البحوث الإجتماعية : تعني الموضوعية في البحوث الاجتماعية شيوع النظرة اللاشخصية والحيادية القيمية ، فهي تنشد ليس فقط الابتعاد عن الاحكام الاخلاقية في البحث بل الاقلاع عن كل فكرة إصلاح ، فالباحث الاجتماعي ليس مصلحاً إجتماعياً فجل ما يقوم به هو أبحاث تفيد المعرفة كمعرفة .
من خلال ما سبق أن أشرنا إليه ، يمكننا أن نستنتج أن تلك الأزمة تمتد إلى الأسس نفسها التي قام عليها علم الاجتماع ، فأصبح يفتقد إلى وجود إطار مرجعي موحد وعجز المناهج عن تقديم بديل عن اللاهوتي وملأ هذا الفراغ الناتج عن تحييد كل ما هو ديني ، فخضعت العلوم الاجتماعية للصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الماركسي والرأسمالي .
المبحث الثاني : العلوم الاجتماعية في العالم العربي:
ارتبط علم الإجتماع العربي منذ نشأته بالمنهج الغربي ، حيث شهد ميلاده واقع إستعماري همه الأول هو تقسيم الوطن العربي إلى مناطق نفوذ ودويلات والعمل على تحريك الصراعات داخل كل دولة وبين الدويلات بعضها وبعض ، مستغلاً في ذلك الأطر البنائية الاجتماعية والعلمية التي أنشأها داخل كل دولة والتحالفات التي كونها مستخدماً سياسة فرق تسد. وسعت هذه القوى الاستعمارية منذ البداية إلى توظيف البحوث والدراسات الاجتماعية والانثربولوجية لخدمة وتكريس أهدافها ومصالحها ، حتى أنه قيل أن بريطانيا في ذلك الوقت كانت لا ترسل أي إداري لمستعمراتها إلا بعد أن ينال تدريباً في العلوم الاجتماعية ، فيصبحوا مؤهلين لإستخدام أدواتها المنهجية وطرق بحثها ، واستطاع هؤلاء الاداريين وغيرهم من الباحثين في تلك الفترة إرساء التقاليد البحثية وكذلك وضعت قاعدة من الابحاث والدراسات الاجتماعية الهامة التي لا يستطيع أن باحث تجاهلها ، حتى أصبحت تشكل نماذج إرشادية تهتدي بها الدراسات حتى في مراحل ما بعد الاستقلال ، تلك المرحلة التي تولت فيها الجامعات والمراكز مهمة البحث العلم الاجتماعي متبنية المناهج السائدة ومطبقة للأهداف الاستعمارية التي تخدم الغرب دون أن تدرك كذلك .
وقد ساعد في هذا التغريب سوء الأوضاع في البلدان العربية وانشغالها بالاستقلال السياسي وتحقيق التنمية ، فعمدت هذه البلدان الى إهمال البحث العلمي والاعتماد على نتائج ما توصلت إليه الدراسات الغربية ، هذه الاسباب وغيرها ما ساعدت على ترسيخ جذور النموذج الوضعي والتي سوف نشير إلى أهمها في الآتي :
أولاً : عوامل التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية العربية
أوضحنا كيف كانت نشأة العلوم الاجتماعية في العالم العربي مرتبطة بشكل كبير بالعالم الغربي وهو لا شك أسفر عن تبعية للدراسات والبحوث فظهرت في الوطن العربي مدارس تحاكي مثيلتها في الغرب دون إدراك للفروق السوسيولوجية والتاريخية لظهور هذه المدارس ، وأخذ المفكرون العرب على عاتقهم نقل ما توصل إليه الغرب من نتائج ونظريات ، وما تبعه من قطيعة مع التراث والوحي بل ومحاولة إخضاعه للدراسة وفق ذلك المنهج المادي ، وعلى الرغم من تعدد دوافع تلك التبعية إلا أننا نرى أن أهمها يتمثل في :
– النشأة الاستعمارية للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي : طبيعة النشأة الاستعمارية لعلم الاجتماع جعلته يخضع لتوجيه السلطة الاستعمارية التي سعت الى فرض أنماط ثقافتها الغربية ومنهجيتها على الثقافة المحلية ، وقد أستطاع الاستعمار كما يقول د/شريعتي نقل ثقافته بما فيها من تناقضات وصراعات الى المجتمعات الاسلامية ، وفتن مفكرونا بهذه الثقافة الواردة حتى قنعوا بأن طريق التقدم هو طريق الغرب نفسه بما في ذلك ضرورة التحرر من القيم والثقافة الماضية .
– الإستلاب الفكري وغيبية الوعي الذاتي : عانى الفكر العربي في تعامله مع المنتجات الفكرية الغربية من غيبوبة وعدم الوعي بالفروق الثقافية بين الحضارتين فعملوا على التقليد والتطبيق دون التساؤل حول ما إذا كانت هذه الرؤى والنظريات تتوافق بالفعل مع الوضع العربي أم لا .
فالفلسفة الغربية حين رفضت التفكير الديني أستندت إلى ظروف واقعية معينة جعلت هذه الخطوة من الأهمية في سبيل دفع الحركة العلمية والتخلص من كل ما يتناقض مع الأسلوب العلمي والتأكيد على أهمية العقل في مقابل الخرافة التي كان يدعمها التفكير الديني ، وقد أخذ المفكرون العرب هذه المقدمات باعتبارها مسلمات لابد أن تقوم عليها أي محاولة للنهضة دون الوعي بالخصوصيات الحضارية ، وذلك على الرغم من تأكيد الفلاسفة الغربيين أنفسهم على هذه الفروق ، كما ظهر في آراء كونت الذي يعد من مؤسسي الوضعية المادية حيث أكد أنه ” في الوقت الذي كان فيه الغرب المسيحي مشغولاً بقضايا لاهوتية عقيمة ، كان العالم الاسلامي ينفتح على العلم والمعرفة والفنون وبالتالي أصل إجتماعيته جنباً إلى جنب مع روحانيته. ” .
– آليات تغريب الفكر العربي : تضمن الفكر العربي آليات تغريبه وإغترابه كذلك عن واقعه المعاش ، وتعد أهم هذه الآليات : ظاهرة النقل المباشر بحيث اتجهت الدراسات الاجتماعية إلى تقليد الدراسات الغربية ونقلها من واقعها ونمطها الثقافي إلى واقع آخر ونمط ثقافي مختلف ، دون أي محاولة لإعمال الفكر في مدى إنطباقها وملاءمتها للمجتمع الذي تنقل إليه ، وهو ما يظهر أحياناً في الاهتمام بقضايا نظرية وتطبيقية ذات أهمية في بلد المنشأ لكنها تفتقر إليها في البلاد الناقلة .
والأخطر من نقل الدراسات بواسطة الترجمة وغيرها هو نقل المسلمات والمقولات الاجتماعية دون التنبه إلى ما تعكسه من مواقف أيديولوجية وفلسفية معينة وهو ما أطلق عليه بـ “تهريب القيم والميتتافيزيقا الغربية” ، فأصبحت الدراسات العربية تقوم على موقف ميتافيزيقي معين لا يتناسب مع طبيعة الظروف التاريخية والحضارية لها ، حتى وصلت الى حد إستبدال الرؤية الميتافيزيقية الاسلامية بغيرها باسم الالتزام بالمنهجية العلمية في التفكير .
قد ساهم كذلك في هذا التغريب تبعية لغة التعبير في الكتابات العربية وما يظهر من إستخدام ألفاظ أجنبية بحروف عربية ، وشيوع إعتقاد خاطئ بأن اللغة ما هي إلا وسيلة للتعبير وطريقة للاتصال فالمهم هو أن يصل المعنى المراد دون الاهتمام بسلامة اللغة وركاكة الألفاظ وبالتالي لا حرج في أن نستخدم الألفاظ والمصطلحات الأجنبية طالما كونها تؤدي الغرض ، ولكن الحقيقة أن اللغة إنعكاس لمواقف قيمية خاصة بالمجتمع الناشئة فيه ، فقبول لغة وتعبيرات الآخر يستتبعه تبعية للفكر .
ثانياً : التقليد الغربي للدراسات الاجتماعية في الوطن العربي
ساهمت الآليات السابق ذكرها في تجذير المنهج الوضعي في العقل العربي وسحب التجربة الغربية على واقع الثقافة العربية ، مما أدى إلى تبني المدارس الإجتماعية في الوطن العربي مقولات الوضعية وإسقاط التجربة المسيحية على تاريخ الثقافة الإسلامية وبناء المعرفة على نفس المقدمات الابستيمية ونفس الأسس المنهجية ، فظلت الثقافة العربية حبيسة التصورات الميتافيزيقية الغربية الداعية إلى رفض الدين وإعتباره من بين مصادرها المعرفية في تناول القضايا الإجتماعية وكذلك إعتبار الأسلوب الديني أسلوباً متجاوزاً ، فعمد الإجتماعيون إلى إعادة صياغة أفكارهم وفق هذا المنظور ، وجاء التراث السوسيولوجي ليعكس صورته في الغرب بل عكس كذلك في بعض مراحله حالة الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الغربي الرأسمالي والشرقي الإشتراكي خاصة مع بداية الإستشعار بعجز النموذج المعولم عن تقديم الجديد مما دعى إلى البحث عن آخر مغاير أو مناقض له .
وقفت الدارسات العربية في مرآة العلوم الاجتماعية الغربية بحيث تعكس صورتها وما توصلت إليه ، فجاء تطورها وموقفها بل والقضايا التي تقوم بتناولها وطريقة تفسيرها لها في إطار الصدى لأصوات العقول الغربية .
فظهرت مدارس تتبنى المذهب الدارويني التطوري كسبيل إلى تقديم إجابة حول القضايا الإجتماعية المختلفة ، فالعلوم الطبيعية الداروينية هي أم العلوم الحقيقية ويقتضي أن تكون أم العلوم البشرية كافة ، وقد مثل هذا الفكر في عبد الجبار نعيم في كتابه “مشكلة المجتمع العربي المعاصر” والذي دعى فيه إلى ما أسماه بنظرية الصراع الحضاري كإطار مفسر لمشكلات الوطن العربي الأساسية ، وأفضى بالأسباب المؤدية إلى كثرة الثورات والإضطرابات العربية إلى القيم وتضادها بالإضافة إلى تأثير العوامل الخارجية المرتبطة بالإتصال الثقافي بين الدول وغيرها من خارج القطر العربي . ولكن تظل المدرسة الدوركايمية هي الأكثر إنتشاراً وهيمنة على الدراسات الإجتماعية في العالم العربي بل والإسلامي وفق قناعة بأنها تعبير عن الشكل النهائي الذي أنتهى إليه علم الاجتماع في صراعه مع الدين ليصل إلى أعلى درجة ممكنة من العلمية ، وسيطر هذا المذهب بطبيعته على عقلية الجيل الأول من الإجتماعيين المتخصصين الذين كثيراً ما رددوا آراء دوركايم بأن العلم الاجتماعي قد حقق ذاته ومنهجه بعدما دخل في مرحلة الوضعية وتحرر من الفكر الديني الذي لم يعد من إختصاصه أن يهتم بالمشكلات العلمية ، وأصبح نتاجاً لذلك محاولة إفتعال نوع من الصراع داخل النسق الثقافي العربي على غرار ما طبع به التاريخ الثقافي الغربي ، فظهر إتجاه علماني عربي يرفض وجود أي محاولات لتأسيس علم إجتماع قبل ظهور المدرسة الوضعية ، حيث أشار أحد الكتاب في شرحه لكتاب أبن خلدون وسعيه لتأسيس علم العمران الذي يتناول الظواهر الإنسانية بأبعادها المختلفة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الثقافة التي شرع في إطارها إقامة مشروعه أي الثقافة العربية الإسلامية التي خضعت لنسق معرفي يهيمن عليه إعتبارات لاهوتية وميتافيزيقية لذا فهذه الثقافة لا يمكن أن تنشئ منهجاً لدراسة الظواهر الانسانية بطريقة علمية ، وأن النهضة الأوربية هي بداية نشأة العلوم الانسانية.
وفي سبيل التبرير لهذا الإفتعال قدم د/فؤاد زكريا في مقالته الخاصة بعنوان “الفلسفة والدين في المجتمع العربي المعاصر” الرؤية الأحادية النظرة لكل من النموذج الإسلامي والعصر المسيحي الحديث ، فقد انطلق من مقدمة تاريخية بأن المسيحية كانت مؤسسة رسمية تتدخل في شئون الفرد والمجتمع والدولة كما أخذت على عاتقها التوجيه الفكري ووضع الاسس العلمية بناء على النصوص الكنسية ، فلم يكتب للعلم التطور والانجاز إلا بعد التراجع لهذه النظرة المهيمنة للمسيحية على العقل والتفكير ، ليصل إلى نتيجة مفاداها القول بتطابق النموذجين ومن ثم تكرار نفس النتائج حال تولي الدين وظيفة توسعية تسلطية متعدية لحدود التوجيه الأخلاقي والشعوري .
ولم يقف الأمر عند حد السلطة المرجعية الدينية وإنما أمتد كذلك للدعوة لإحداث قطيعة ابستمولوجية مع التراث الذي بما يستند إليه من الوحي والتصورات الدينية بزعم أنها تؤدي إلى جمود العقل العربي والحيلولة دون الاجتهاد والابتكار ، ففي تعريف الجابري مثلاً للعقل العربي يقول : “كان العقل العربي ومايزال عقلاً فقهياً أي عقلاً تكاد تقتصر عبقريته في البحث لكل فرع عن أصل وبالتالي لكل جديد عن قديم يقاس عليه وذلك بالاعتماد على النص” .
ولا شك أن حالة التقليد والصدى العربي تلك تأثرت كذلك بالصراع الأيديولوجي فأصبحت الجهود مقسمة بين الاتجاهين ، وظهرت بذلك مدارس تعكس المذهب الماركسي في تناول القضايا الإجتماعية خاصة بعد أن أبدى بعض الاجتماعيين أسفهم عن عدم إستجابة الجامعات المصرية لتطبيق المناهج الاشتراكية في دراسة العلوم الاجتماعية والاستمرار في الخضوع لهيمنة النماذج الرأسمالية الغربية التي تعكس طبيعة المجتمع الغربي وتعمل على خدمة مصالحه ، ذلك على الرغم من الانجازات التي حققها العلم العربي بصفة عامة ومصر خاصة في سبيل تحقيق الاشتراكية الأمر الذي يقتضي التحول الايديولوجي في دراسة القضايا الاجتماعية العربية ، حيث أصبحت تلك الاشتراكية – كما يتخيلون عقيدة الأمة بأكملها وتجسيداً لآمال الشعوب هذا على الجانب الحركي ، بينما في إطار الفكر والعلمية أضحت الاشتراكية بديل لا غنى عنه لقدرته على التعبير عن المجتمع العربي الجديد وبحث مشكلات التحول الثوري الحادث فيه .
وهكذا ظلت علومنا الاجتماعية في سجال ما بين الاقطاب العالمية المهيمنة تعكس رؤيتها وتخدم مصالحها ، كما ظلت نتائجها بعيدة عن واقعنا متجاهلة طبيعته ومن ثم لا تنطبق عليه ، فإننا في هذا البحث لا نهدف إلى مجرد مناقشة الآراء أو الرد عليها وإثبات الخطأ فيها أو حتى تقديم تقرير تاريخي لتطور منهجية العلوم الاجتماعية العربية ، إنما لبيان الفجوة بين المنهجية والواقع في العالم العربي والتشويه المفتعل لثقافته ، وهو الأمر الذي يكمن جوهره في دوافع القليد وآليات الاستلاب وفقدان الوعي بالذات التي اجتمعت جميعها لتجذر الاتجاه التغريبي وتحول دون إعتبار الخصوصية في الفكر المنهجية الاجتماعية ، فعلى الرغم مما عانته العلوم الاجتماعية من إشكالات عدة وإخفاقات إستدعت بصورة ملحة إحياء الثقافة الإسلامية وطبيعة الحياة العربية بنظمها وتراثها وتقاليدها المختلفة .
ثالثاً : البدائل المنهجية للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي
كرد فعل للنتائج السلبية التي انعكست على البحوث الاجتماعية ، ظهر بعض الاجتماعيين باحثين عن خروج من هذه الدائرة المفرغة التي تنتهي كل خطوة فيها إلى مزيد من الخضوع والاغتراب ، فأصدروا عدد من الدراسات التي تبحث عن بدائل مختلفة ، وعلى الرغم مما قد يوجه إليها من إنتقادات إلا أنها تمثل بلا شك خطوة هامة في سبيل الكشف عن طبيعة المشكلة والتي تعد أهم خطوات الوصول إلى الحل ، ومن أهم البدائل التي كشفت عنها هذه المحاولات :
أ- علم إجتماع عربي / قومي :
في إطار محاولات الخروج من دائرة الإغتراب الفكري والمنهجي كانت تلك الدعوة القائلة بضرورة العودة إلى الذات المتمثلة في الذات القومية أو العربية أي ضرورة حضور العقل العربي في الدراسات الإجتماعية المتعلقة بالأمة العربية ، لأن العقل العربي هو الأقرب لفهم طبيعة مجتمعه ومناخه وهو وحده القادر على إعطاء صورة متكاملة لحياة المجتمع ويتجاوز تلك السلبيات التي وجدت في الدراسات الإجتماعية ، قالقومية العربية هي الايديولوجية الوحيدة التي تصلح لأن تكون نظرية مفسرة للواقع الاجتماعي العربي بصدق .
فالرجوع الى التراث الاجتماعي العربي بما يشتمل عليه من نتاج فكري سابق وعادات إجتماعية وتقاليد موروثة أو معاشة سيمكننا من الحصول على القواعد الأساسية لحياة الاجتماعية العربية المعاصرة ويغنينا عن تبني تراث المجتمعات الأخرى .
ويضع أنصار هذا الإتجاه الأسس المنهجية القائمة على دراسة التراث العربي وإعادة قراءة الكتابات الاجتماعية للكتاب العرب الذين عاشوا ما بين القرن الثامن الى القرن الرابع عشر الميلادي ، وهي الفترة التي تمثل الارهاصات الأولى لعلم الاجتماع ومحاولة دراسة الظواهر المجتمعية بأسلوب موضوعي وعلمي يمكن الاستناد إليه كقواعد للفكر الاجتماعي الإنساني ، فإننا إذا ما أردنا فهم وتحليل واقعنا وحياتنا الاجتماعية الحالية علميا وموضوعيا علينا العودة الى عناصر ومكونات البناء الاجتماعي العربي التي تكمن في تراثنا الاجتماعي . وبالتالي فإنه في مقدور هذا المنظور خدمة الأهداف القومية للأمة العربية والخروج بها من الأزمة التي تعيشها .
وعلى الرغم من مرور عقود على هذا الاتجاه إلا أنه لم يتجاوز إلى الآن حد الدعوة ، دون الانتهاء إلى وضع صيغة علمية وأسسه منهجية واضحة يمكن التسليم إليها في دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة ، ويقتصر في دعوته تلك الى ضرورة العودة للتراث الاجتماعي على الرغم مما تتبناه تجاهه من إنتقائية ، فهذه النزعة القومية العرقية لا تأخذ نموذجها وأسسها من المبادئ الاسلامية إنما من التراث الاجتماعي الذي يضع الدين جنباً إلى جنب مع العادات التي أستقرت في وجدان الشعوب ، وفي مقابل ذلك تدعي أن هذا الارث متمثل في فترة زمنية معينة تشتمل على الانتاج الفكري لكل من الجاحظ والغزالي والفارابي وابن رشد وغيرهم والتي لم تكن نتاجاً عربياً قومياً إنما هي جهود ناتجة عن تفاعل لهذه العقول مع الثقافة الاسلامية ، ومن ثم إنتقائية النظرة للتراث فإن هذا العلم القومي إذا ما أراد أن يقدم صورة شاملة حول التراث الاجتماعي والفكري عليه أن يمتد ليشمله في مراحل ما قبل الاسلام والعصر الجاهلي ثم في العصر الاسلامي والتنقيب في الثقافات والعادات التي تم استيرادها بمعزل عن الثقافة العربية .
من جانب آخر نلاحظ أن القومية كنزعة عرقية وليست إتجاهاً مذهبياً لا تستطيع تقديم نظرية متكاملة ومن الصعب أن تقوم القومية كمفهوم عرقي كبديل منهجي يحل محل النظريات الغربية ، ففي حين تقوم الغربية على اسس الرأسمالية كمقولات منهجية في التحليل والتفسير ، والماركسية تعتبر الأسس المادية والاقتصادية هي الحاكمة لنظرتها وتصوراتها ، فالنظريتان تقدمان تصوراً كاملاً حول الانسان والعالم ، بينما هذه النزعة العرقية لم تتمكن من التحول الى مذهب له عقائده وتصوراته ونظرته في الحياة ، ولا يخفى كذلك أن الدعوة الى الذات العربية القومية في العصر الحالي تعني في جوهرها الدعوة الى ذوات مختلفة ومتعددة بتعدد الخلفيات العقائدية والمواقف الايديولوجية والعادات الاجتماعية التي سادت في كل مرحلة تاريخية حتى أصبحت تتداخل بعض الرؤى الغريبة عن واقعه في نسيجه الاجتماعي بحيث لا نتمكن من التمييز او الفصل بينها .
وبالتالي لم يكن من السهل إقامة هذا البديل العربي على مجرد الحدود الجغرافية أو إستدعاء تراث الماضي في نظريات الحاضر بإدعاء الخصوصية وإقامة المفاضلات بين الشرق والغرب وترجيح أحدهما أو إثارة القضايا الحضارية الخاصة بالأمة العربية ، إنما الأمر يتطلب عمق فكري واستيعاب حضاري أكثر من ذلك ، فإن قيام علم إجتماع عربي يحتاج إلى ربط المشروع بالوعاء الحضاري وتجديد الرؤية للتراث وحضور الخلفية العقائدية وتأصيل الثقافة الاسلامية كذلك بما يسمح بتكوين رؤية خاصة حول العالم والانسان وتقديم منظور منهجي شامل قادر على تناول القضايا العالمية المختلفة متجاوزة حدود الثقافة العربية .
لكن رغم أن تلك المحاولة قد تجلت في أقصى صورها في مجموعة من التوصيات والدعوة الى عقد ندوات ومؤتمرات وإصدار بعض الاطروحات العامة دون أي تحديد منهجي واضح ، إلا أنها بلا شك تعد خطوة هامة في سبيل يقظة الفكر الاجتماعي حيث اصبح علماء الاجتماع العرب يستشعرون وجود أزمة فعلية في الفكر العربي تجاه الظواهر المجتمعية ، هذا الاستشعار الذي يعد خطوة أولى نحو التحليل والبحث عن البديل .
ب- علم الإجتماع الإسلامي :
بعد أن أفلست المحاولات السابقة عن تقديم حل للخروج من الأزمة أضحت الثقافة الإسلامية إحدى الضرورات المنهجية التي توجب البحث فيها والرجوع إليها ، وقد جاءت الدعوة إلى ما يسمى بعلم الاجتماع الإسلامي أو إسلامية المعرفة أو أسلمة العلوم كتأكيد على ضرورة حضور العقل الإسلامي في ضوء التغيير الحضاري خاصة بما يمتلكه من تصور ممتد وشامل لكافة القضايا والمجالات الانسانية وقادر على طرح رؤية عالمية من منظور خاص وليس العكس .
فهذه الدعوة لا تعني مجرد إضافة العبارات الدينية وإقحام الآيات القرآنية على النصوص الوضعية بما يضفي ذلك الغطاء الديني الإسلامي فحسب ، كما لا تعني مجرد سحب الانتماء الذاتي للدين على الموضوعات محل البحث ، إنما هي محاولة لإعادة صياغة منهجية ومعرفية للعلوم ومناهجها وذلك في ضوء المنظور الإسلامي ، أي “فك الارتباط بين الانجاز العلمي الحضاري البشري والحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة ، وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ديني غير وضعي بحيث يتم إعادة صياغتها ضمن بعدها الكوني الذي يتضمن الغائية الإلهية في الوجود والحركة ” .
ويمكن تقسيم الجهود في ضوء هذا المنظور الاسلامي البديل إلى طائفتين : تقوم الأولى منها على النظرة الموضوعية للعلوم وإعتبار أن الموضوع هو أساس علم الاجتماع ومن ثم فإننا إذا أردنا تأسيس علم إجتماع إسلامي لابد من الإقتصار على موضوعات وقضايا متعلقة بالعالم الإسلامي دون غيره ، وإن تم البحث في هذه الموضوعات بالمنهج الغربي ذاته بما يشير إلى قراءة سوسيولوجية غربية للواقع الإسلامي ، فهذا الاتجاه يقوم على تعريف الأسلمة باعتبار أنه “إذا كان علم الاجتماع الديني يدرس الظاهرة الدينية في عمومها سواء اسلامية او غير اسلامية ، فإن علم الاجتماع الإسلامي يقتصر في دراسته على الظواهر الاسلامية من حيث نشأة الظاهرة وتطورها وطبيعة النظم والانساق الاجتماعية في المجتمع الاسلامي وعلاقة هذه النظم بغيرها من النظم الاجتماعية غير الاسلامية ” ، ففي حين تعد أسلمة العلوم توحي بضرورة أن يتم إتخاذ الاسلام منطلقاً في التحليل يقابل الخلفيات العقائدية الأخرى المسيطرة سواء تعلقت بالموضوعات الإسلامية أو غيرها أي أنه منظور شامل له مناهجه وادواته و منطلقاته الخاصة في الفهم والتحليل للظواهر ، يذهب هذا الإتجاه الى العكس من ذلك فهو يتناول علم الاجتماع الاسلامي كونه أحد فروع علم الاجتماع الديني الذي يقتصر على دراسة نوع معين من الظواهر والقضايا ويخضع لنفس الأدوات والمناهج التقليدية ، وإن ذهب البعض بمحاولة إعادة طرح المصطلحات الاجتماعية بما يقابلها في المنظور الإسلامي .
بينما يقوم الإتجاه الآخر على النظرة المنهجية العقيدية التي تتخذ من الإسلام منطلقاً في التفكير والتحليل والعمل على إعادة القراءة النقدية للتراث الاجتماعي الإسلامي ، أي محاولة فرض المذهبية الاسلامية كبديل منهجي مقابل للنظريات والمناهج الوضعية ، فهي هنا لا تعني هذا الارتباط بالقضايا الخاصة بالعالم الاسلامي – كما في الإتجاه السابق – إنما هي نظرة منهجية ، وقد وجدت العديد من الجهود البارزة التي تهدف الى التحديد المنهاجي لهذا المنظور والتي لاقت من الأهمية والتأثير ما دعى إلى الإهتمام بتقديم الدراسات والاطروحات المختلفة وإستدعاء التراث بنظرة تجديدية نقدية في محاولة لرسم الأطر المنهجية ، لكن ذلك دون أن تترسخ تلك المحاولات في إطار مؤسسي تطبيقي أو أن يتم تبنيها في تدريس العلوم الاجتماعية المختلفة التي لازالت تستسلم لهيمنة النماذج الغربية ، كما يهيمن كذلك على المراكز العلمية المتخصصة وتوجيه البحوث والدراسات الاجتماعية .
المبحث الثالث : في أسلمة العلوم الاجتماعية:
تعد أسلمة أو إسلامية العلوم الاجتماعية آخر المحاولات التي توصلت إليها الجهود في هذا الحقل والتي أصبحت تدور في نطاقه العقول في سعيها لإقامة هذا المنظور المعرفي الخاص ، والقول بأنها آخر المحاولات لا يعني التوقف عند نقطة معينة أو إقرار حال عدم الاجتهاد إنما نعني بها ذلك البديل العلاجي الذي توصلت إليه الدراسات التي طالما اختلفت بين هذا وذاك حتى تيقنت من عدم الجدوى دون الإقرار بأهميته ولازالت تسعى في تطويره ووضع أسسه ورسم ملامحه ، فإننا لا نريد أن نقف عند مرحلة معينة أو إنتقاء إتجاه من التفكير دون غيره لكن من منطلق الاتفاق مع ما تم التوصل اليه من ضرورة صياغة نموذج إجتماعي يرتبط بالهوية ويعكس الخصوصية الثقافية للأمة العربية الإسلامية ، وكذلك السعي الى معرفة مدى قدرة هذه المحاولات على النجاح في التأصيل لهذا المنظور المنهاجي الحضاري ، ولعله يكون مفيداً في هذا الصدد أن نتتبع الكيفية التي تشكلت في إطارها العلاقة بين النموذج الوليد وبين الاخر المهيمن أو بمعنى آخر قياس التأثير الحادث نتيجة سيادة رؤية منهجية وعلمية معينة في دراسة وتشكيل رؤية أخرى جديدة .
وتتعدد الرؤى الخاصة بإسلامية المعرفة ومن ثم تعريفاتها ومحتواها ومعالمها ، ففي الوقت الذي تذهب فيه الدكتورة سامية مصثطفى الخشاب إلى كون علم الاجتماع الإسلامي انما هو “علم وضعي يصف ويشرح ويحلل ويقارن ويحاول الوصول الى القضايا الكلية والمبادئ العامة بل ويزداد على هذا بحث القوانين والعلاقات العلية والسببية الكامنة في طبيعة الموضوعات المدروسة” ، وتخصص موضوع هذا العلم كونه الذي يصف ويحلل معطيات الفكر الاسلامي ، على أساس ان هذه المعطيات تعكس وتجسد آراء واتجاهات ونظريات إجتماعية منبثقة من طبيعة الاهتمامات والقيم والمشكلات التي سادت في المجتمعات الاسلامية في المراحل الأولى من نشأته . يعتبر الدكتور محمد عمارة فكرة إسلامية المعرفة في مصاف المذهب في وصفه لها بأنها “المذهب القائل بوجود علاقة بين الإسلام وبين المعارف الإنسانية ، والرافض لجعل الواقع والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية ، فهي المذهب الذي يقيم المعرفة على ساقين أثنين : الوحي وعلومه ، والكون وعلومه ، وليس على ساق واحدة هي الوجود” .
بينما يشير الدكتور عرفان عبد الحميد إلى الأسلمة كونها منهجاً فكرياً في التثاقف الحضاري ذا بعدين متضايفين ، الأول : يشمل الجهد الفكري المعاصر في سعيه لهضم جميع ما أنجزه الفكر الغربي ، والثاني : تحرير هذا الانجاز من مضامينه الفلسفية المادية الغربية وربطها بإطار قيمي إسلامي .
وهناك جانب آخر يذهب الى رفض تضييق المفهوم وحصره في إطار مغلق ، وذلك لأنها قبل كل شئ ، هي بناء لنظرية المعرفة التوحيدية التي تؤمن بأن للكون خالقاً واحداً أحداً ، وتتخذ من الوحي والوجود مصادر أساسية للمعرفة التي تتم في إطار التوحيد الخالص لتتكون تلك المعرفة الرشيدة المحققة لغايات الاستخلاف والعمران والشهود الحضاري .
وتضيف الدكتورة منى أبو الفضل كون هذا النموذج التوحيدي إنما هو نموذج وسطي يمثل جماع المتقابلات حول ميزان حاكم يضبط العلاقة بين النسب والمقادير والثابت والمتأرجح ، إعتماداً على مرجعية راسخة يقدمها الوحي ، وتطرح هذا النموذج – الذي من شأنه العمل على استكشاف إمكانيات أوسع للبحث الاجتماعي وتعزيز أدوات البحث ومعاييره – كمقابل للنموذج الثقافي التذبذبي المعولم .
ويمكننا أن نلاخظ من خلال التعريفات السابقة أنها جميعاً سعت نحو تحديد جوهر الأسلمة ببيان مصادر المعرفة الإسلامية وقيمتها والتي تتم من خلال الجمع بين القرائتين (الوحي والكون) ، ومن جانب إستيعاب الفكر الغربي وإنجازاته ومحاولة تفكيكه وتركيبه من جديد بربطه بالتراث الإسلامي مما يحررها من النظرة المادية الأحادية ، إلا أننا لا يمكن أن نقر أنه هدف جميع الدراسات دون غيره لكنه قد يمثل المشترك العام بينها جميعا ، فمن الملاحظ كذلك عدم وجود إجماع حول طبيعة هذا المفهموم ومجال عمله وتطبيقاته ، بل وطريقة تناوله والتي تراوحت ما بين الرؤية من خلال نموذج آخر مغاير أو إعتباره نموذج جديد ، بل ومن خلال النظرة المتفحصة إليها نرى هيمنة الوضعية في النظرة والصياغة لهذا المنظور .
أولاً : لماذا أسلمة العلوم الإجتماعية ؟
تم التطرق إلى الظروف التي أدت إلى ظهور هذا النوع من التفكير في المبحث السابق ، والذي جاء ضمن محاولات عديدة لاعادة النظر في العلوم الاجتماعية بعد أن أدرك الاجتماعيون بما يعانيه هذا الحقل من إشكالات تعوقه عن فهم الواقع وتفسيره بل وعلاجه ، فظهرت العديد من الانتقادات النابعة عن عدم الرضى عن الأداء المنهجي والعملي لهذه العلوم في الوطن العربي خلال النصف قرن الماضي والتي تعد إعتراف ضمني بأهميتها ودورها الفاعل في الوقت نفسه ، ولعل المتتبع لحركة التاريخ الاجتماعي يمكنه أن يتلمس أهميته في صياغة الوضع الأوربي وبناء أسسه بعد أن مزقته الصراعات والثورات الاجتماعية إبان فترة التحول من النظام الاقطاعي الى النظام الرأسمالي .
بل إن المعروف أن علم الاجتماع في بدايته كان مشروعاً يهدف لبناء مجتمع جديد تسود فيه قيم وعلاقات إجتماعية تضبط سلوك الأفراد وتنظم العلاقات وتعيد التوازنات للمجتمع الفرنسي ، وكما يؤكد سان سيمون أن مراحل ما بعد الثورات هي مراحل يسودها إعادة البناء الاجتماعي المؤسسي والفكري وأنه على علم الاجتماع أن يقوم بهذا الدور ، بل أن هذه المهمة هي التي ولد من أجلها علم الاجتماع في كل من فرنسا وبريطانيا ، لذا فإنه إذا كان علم الاجتماع في الوطن العربي تابع لعلم الاجتماع الغربي فهل عليه أن يقوم بدور مشابه ؟ وهل أدى دوره كما كان ينبغي له ؟ ، ولأن الاجابة جلية لا تدع أي مجال للشك ، فإنه كان لزاماً البحث في أسباب الإخفاق في الواقع العربي وإختلاف نتائجه عنه في الغربي على الرغم من تماثل المناهج والأدوات ، فكيف استطاعت هذه العلوم أن تبني مجتمعات في أوربا والغرب وتنظمها وتعيد نظامها بعد أن تم تقويضها ، ولم تتمكن من مجرد فهم المجتمعات العربية والاسلامية أو تحقيق الهدف المأمول منها ؟ ، بل أدت الى مزيد من الاغتراب القيمي والاجتماعي وتشتيت في منظومة العلاقات .
والأصل أن علم الاجتماع الغربي استطاع منذ نشأته أن يوجد لنفسه نموذجاً إرشادياً خاصاً حل تدريجياً محل النماذج الارشادية السابقة والتي عجزت عن أداء دورها في فترة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها القارة الأوربية ، فمهما بلغت الانتقادات الموجهة له لا يمكن إنكار كونه نموذجاً تاريخياً لحظياً – أي أنه نابع من ظروف اللحظة التاريخية – وهو ما لم يدركه الاجتماعيون العرب في بداية الأمر ، أو أنهم جبروا على تلقيه واستيعابه – أياً ما كان الدافع لتبني هذا المنظور فإننا أمام واقع لا يمكن الفكاك منه وعلينا أن نتعامل معه وننطلق منه – ومن ثم جاءت المحاولات الأخيرة لنبدأ من سؤال محوري مفاداه : لماذا لا يوجد في علم الاجتماع العربي هذا النموذج الإرشادي الخاص ليسير عليه ، نموذج يأخذ في الاعتبار الخصوصية الجغرافية والدينية والتاريخية والثقافية للوطن العربي ، نموذج يعيد الروح لطبيعة العلم والحيوية لدوره الفاعل في بناء المجتمع وتوجيه خطاه ؟
فكانت بداية التفكير في الاطار المرجعي الذي يؤسس لعلم إجتماعي قادر أن يعيد بناء المدركات والمفاهيم ويشكل القيم ويوجه المجتمع ويرشد السلطة ، إلا أن هذه البداية جاءت تتلمس طريقها بخطى بطيئة وضعيفة فكيف لها أن تدعو لمثل هذا المنظور في ظل تبعية السلطة وتعنتها ورغبتها في أن يبقى الوضع قائم كما كان دون تغيير قد يأتي أول ما يأتي عليها ، فساد قول بأنه حتى وإن نشأ علم إجتماع مرتبط بالقيم ونابع من الخصوصية ومن تطلعات هذه القطاعات العريضة من أفراد المجتمع فإنه حتماً سيصطدم بالواقع الذي تهيمن عليه قوى فكرية وسياسية واقتصادية غربية ونخب حاكمة مستفيدة من هذا الوضع ، هذا العائق بالأمس ما يجعل من الأهمية طرح الموضوع الآن بعد ما شهدته المجتمعات العربية من حالة ثورية استطاعت خلالها الشعوب أن تفرض كلمتها على السلطة ، ورغم ذلك لم نجد هذا الدور الذي تخيلنا أن يقوم به علماء الاجتماع ، بل أنه على العكس تراجع بشكل ملحوظ في حالة من الشعور بعدم صلاحية الأدوات المتاحة للتفسير والتوجيه أي الشعور بالاغتراب المنهاجي والعلمي ، فقد إندمج هؤلاء جميعا في صفوف الجماهير الثائرة كأفراد مواطنون يشاركون في واقعهم المعاش إلا أن الإطار المرجعي الفكري ظل بعيداً خلال تلك الفترة فأفتقد المجتمع وجود هذه الجماعة العلمية القادرة على تأصيل الوضع الراهن والتخطيط له وتوجيه مساره ، وجاءت مجموعة من الاجتهادات التي تحاول بين حين وآخر تفسير المشهد الا انها لا تلبث ان تتعسر وتخفق في محاكاته فتظهر أخرى وهكذا ، إلا أن الأهم هي تلك الدراسات التي جاءت تعيد النظرة إلى بنية الفلسفة العلمية للعلوم الاجتماعية وتبحث في العلاقات السببية والمآلات والكيفية العلاجية .
ثانياً : الانتقادات الموجهة لدراسات أسلمة العلوم الاجتماعية
على الرغم من ظهور هذا النوع من الدراسات منذ 1981 ومرور أكثر من ثلاثة عقود على نشأته وتقديم العديد من الإسهامات في تقويمه وتثبيت أسسه ، إلا أنه في المقابل ظهرت دراسات أخرى تبدي تخوفها من عدم وضوح ملامح وطبيعة هذا المنهج ، فقد نشر الدكتور زكي نجيب محمود مقالاً بعنوان “لك الله يا علوم الإنسان” أثار فيه بعض الشكوك حول الاسهامات في الدعوة الى إسلامية العلوم الانسانية ، هذه الدعوة التي ترتد- حسب أصحابها في نظره – إلى مسألتين :
الأولى : ألا نعتمد في مراجعنا على مراجع غربية ، إنما هي مراجعنا نحن .
الثانية : أن تنصب أبحاثنا العلمية في مجال العلوم الانسانية على واقع حياتنا نحن .
وقد رأى أنه وإن كان من المقبول الاهتمام بدراسة واقعنا المعاش ، إلا أنه ليس من المفيد الاقتصار على المراجع العربية بل إن إهمال المراجع الغربية في العلوم الانسانية الحديثة يفضي إلى التخلف العلمي ، ذلك لأن التخلف العلمي في بلد ما أو في عصر ما ليس إلا أن تدور الحركة العلمية والتعليمية كلها حول كتب الأقدمين ، تقرأ وتشرح وتلخص وتحفظ ، فيصبح من أجاز ذلك عالماً ، لكنه عالماً في كتب الأقدمين وليس في حقائق واقعه الجديد .
كما كتب الدكتور برهان غليون بحثاً بعنوان “الإسلام والعلوم الاجتماعية : تساؤلات حول أسلمة المعرفة” أبدى فيه خشيته من أن يتحول مفهوم مشروع أسلمة المعرفة إلى بحث تأملي ويتم فرض الموقف العقائدي على العلم وهي الحالة التي لن تسفر عن نتائج جيدة على العلم .
فبحسب تعبيره ان المعرفة التي لا تنطبق إلا على حالة واحدة ليست معرفة علمية بل هي رؤية ذاتية جماعية ، وان أسلمة المعرفة إذا كانت تعني تخصيص العلم وقومنة العالمي ورفض ما هو مشترك بين بني البشر فلن تساهم أبداً في تطوير العلم والتجربة العلمية .
وفي ضوء ما سبق من إبراز للجهود العلمية التي تقدمت لتطوير هذا الاتجاه وتأسيسه وكذلك الاتجاه المقابل الذي لا يرى انه لابد وان يأخذ أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الملاحظات في إعتبارهم حتى يتمكنوا من تقويم منهجهم ليظهر بشكل علمي يمكن تطبيقه ، يمكننا أن نورد مجموعة من الملاحظات الخاصة على ذلك فيما يلي :
– هيمنة النموذج الوضعي على دراسات إسلامية المعرفة بشكل عام : على الرغم من أهمية تلك المحاولة باعتبارها خطوة هامة لاغنى عنها في سبيل العودة إلى الذات والاقتراب من التراث وفهم الواقع المعاش ، إلا أنها لم تنجح في التخلص من مظاهر التبعية ومن هيمنة الاخر في توجيه رؤيتها تجاهه وتجاه ذاتها كذلك ، حتى من القول أنها ما قامت إلا من أجل الاستقلال المعرفي وبناء منظور منهجي فكري خاص يستند الى دوائر الثقافة العربية الاسلامية بدعائمها القيمية والمعرفية والغيبية ، ووتتجلى هذه الهيمنة في شقين :
الأول : ظهور الدراسات في علم الاجتماع الإسلامي التي تعتبره جزء من علم الاجتماع التقليدي ، ومن ثم تدعو إلى دراسته وفق المناهج الوضعية المادية وبنفس المناهج والمنطلقات الابستيمية ، وتعتبر أن الفارق الأساسي الذي يحقق شعار الإسلامية هو الارتباط بدراسة قضايا دينية وتحليل مشكلات خاصة بالعالم الإسلامي ، بل وتسعى إلى إفراغ مضمونه من أسسه القيمية وإدخاله في نطاق العلوم التقريرية ، فهو علم تقريري يدرس ما هو كائن ولا يتصدى لما ينبغي أن يكون .
الثاني : الرغبة الصريحة والمعلنة في ضرورة إلغاء المنظور الغربي ومجاوزته كشرط أساسي لتحقيق الإستقلال المعرفي المنشود ، وكأن هذا الحقل لا يستطيع أن يثبت ذاته في حال وجود الآخر ، فهي تسعى الى التخلص من منظور معولم الى آخر معولم أيضا ، دون أن تفطن كون المنظور العالمي هو الذي يقدر على تقديم رؤية كافة القضايا والمسكلات الانسانية والمجتمعية والتي ترى فيه الانسانية غايتها وصلاحها ، فكان نتاج هذه الجهود مزيد من تبني وترسيخ جذور النموذج الغربي وإعتبار وجوده أو عدمه هو رهن وجود المشروع الإسلامي .
– عدم التحديد لموضوع العلم ومجال بحثه : يتفق أنصار هذا الاتجاه على كونه محاولة لدراسة النظم الاجتماعية وما يتصل بها من ظواهر دراسة وصفية تحليلية متكاملة من أجل الوصول الى تصور واضح وعلمي لأبعاد النظام الاجتماعي ومبلغ تحقيقه لوظائفه ، وينبغي أن يكون شاملاً للجانبين الاستاتيكي والديناميكي ، أي دراسة للنظام في عناصره وعلاقته ووظائفه ، وكذلك في حركته وتطوره ، إلا أن الاختلاف يظهر فيما يتعلق بموضوعات هذا العلم الذي تراوح بشكل كبير ما بين :
أولاً : الاقتصار على إبراز الدور العلمي والطليعي للرواد الذين ركزوا اهتماماتهم على الاتجاهات الاجتماعية ، ويذكر منهم الألوسي والفارابي وابن مسكويه وابن خلدون وغيرهم ، وكذلك إبراز المعطيات التي قدمها الفكر الاسلامي للفكر الانساني بصفة عامة ، وإعادة تقييم الموروثات والقيم الاجتماعية التي خلفتها الثقافة الاسلامية .
ثانياً : دراسة الانجاز المعرفي الغربي والجهد الفكري المعاصر في إطار إسلامي بعد تفكيكه وإعادة تركيبه في إطار إسلامي قائم على الوحي والتراث .
ثالثاً : رأى البعض أن مجال هذا العلم إنما يتمثل في دراسة موضوعات خاصة بالمجتمعات الاسلامية .
هذه الاراء المختلفة إنما تنم عن عدم وضوح الرؤية أو تحديد للمجال والموضوعات محل البحث .
– تداخل العلاقة بين المصادر المعرفية المختلفة : تجمع الكتابات الخاصة باسلامية المعرفة على ضرورة الربط بين القرائتين والاعتماد على المنهج المعرفي التراثي ، فهو يشدد على مجاوزة القراءات الأحادية للحقيقة ، تلك القراءات التي اجتزأت الواقع وانتهت إلى تشويه الرؤية ، إلا أن بعض هذه الكتابات تخلط بين هذه المصادر المعرفية وتتداخل فيها الأدوار بل وكيفية تفعيل هذا الدور مع الواقع نفسه وبخاصة التراث ، حيث أصبح النص الإسلامي الموحى عند بعض الباحثين يشمل كل ما أنتجه العقل المسلم من خلال تفاعله مع هذين المصدرين الاساسيين للمعرفة ومع الواقع ، فاصبح علم الاجتماع لديهم مقتصر على اعادة قراءة هذا التراث وتحليل معطيات الفكر الاسلامي باعتبار أنه يتناول القيم والمشكلات التي سادت المجتمعات الاسلامية في المراحل الأولى من نشأته وانتشار الشريعة الإسلامية .
– عدم وضوح الأسس المنهجية لهذا العلم : حفل هذا الحقل بالعديد من الكتابات خاصة في بداية ظهوره من أجل التأصيل وتثبيت الأسس إلا أنه لا يزال حتى الآن مجال غير واضح ، فهناك العديد من الكتابات التي سعت نحو الدعوة الى وضع مناهج لمنظور حضاري إسلامي إلا أنها تفتقر الى التطبيق الجاد وإبراز الأدوات الموضوعية القابلة للإستخدام في المجال البحثي العلمي ، فمعظمها لا تزال في وضع الدعوة ولم تخرج حتى الآن الى طور الممارسة والتطبيق .
كل الملاحظات السابقة يمكن أن نردها بالأساس إلى سبب واحد ألا وهو الرغبة في الفكاك من تعالي النموذج الوضعي وتحديه وسرعة تقديم غيره ، لذا جاءت تلك المحاولات في هرولة سريعة نحو التطبيق والتفعيل فتراوحت ما بين الاقبال على تحديد نطاق التطبيق على الموضوعات وبين توضيح العلاقة مع المصادر المعرفية والدخول في جدال مع التراث ، وتناست هذه الدراسات نقطة في غابة الأهمية والتي تدور حول القاعدة الفلسية للعلم ذاتها والتي تتمثل في وضع القاعدة الخاصة بالعلاقات على المستويات المختلفة وتوضيح الرؤية الخاصة بالكون والوجود والانسان ، فكان غياب هذه القاعدة سبباً في إنهيار أي بناء معرفي جديد .
بعد هذه الملاحظات السابقة والمآخذات التي أخذت على الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية هل يمكن القول بأن أسلمة المعرفة استطاعت بالفعل ان تلعب دورها المنشود ؟ وهل هي قادرة على أن تمارسه في المستقبل على الأقل ؟ ، إن ما سبق من بيان لإستمرار لسيطرة النظرة الغربية على العقول العربية ونتائجها المختلفة توحي أنه لا يمكن أن تقوم هذه العلوم بدورها في القريب وانها ستحتاج حتماً إلى مزيد من الجهود وكذلك إلى التعاون بين السلطات السياسية والجهات العلمية على السواء حتى يمكن بالفعل تحقيق الاستقلال ، كل هذا يدعو الى ضرورة تكثيف السعي للخروج من هذا الضيق خاصة في ضوء اللحظة الفارقة التي تستدعي بلا شك إعادة التفكير في المطلقات العقلية والمسلمات الفكرية والمنهجية العلمية .
فكما يؤكد هوسرل أن في اللحظات الفارقة – التي تتمثل الآن في الثورة – يتم إستدعاء دور العلم ويبدأ الناس الى البحث عن حلول لمشاكلهم في رحابه ، إلا أن الواقع يوضح عجز هذه العلوم عن تقديم حلول جادة أمام هذا الواقع المفارق لبنيتها الغربية مما حال دون القيام بمهمتها مما أدى إلى سقوط هيبة هذه العلوم وقيمتها في نظرهم ، ويذهب هوسرل كذلك الى أن أصل هذا المأزق إنما يقع في القاعدة الفلسفية لهذه العلوم ، لذا فاننا اذا ما أردنا ان نبحث عن حلول للواقع المعاش علينا ان نعود الى العلوم ومن ثم الى فلسفتها .
وفي ضوء هذا التنافس والتصارع بين النخب السياسية المختلفة والتخبط في السياسات والادارة من قبل السلطة الحاكمة ، بل وحتى حالة الضعف التي تنتاب المعارضة والافتقار الى وجود مشروع فكري شامل قادر على توجيه مسار المجتمع وتقويمه وتوحيد كلمة الشعب تحت رايته ، باتت أهمية تدخل العلم من الأهمية بمكان ، لكن القصور في نظرة البعض الى دور العلم جعلتهم يزعمون توهم الفصل بين الفكر والعمل ، وبين العلم والممارسة ، والادعاء بأن العلوم الاجتماعية والسياسية خاصة انما تنفصل عن النشاط الانساني والسياسي ، وان كان الأمر كذلك فما أهمية العلم إذن ؟! ولا ننس أن نذكر من جديد أن العلوم الاجتماعية ما ظهرت إلا لتساهم في بناء المجتمعات الأوربية . وبعد أن افرغت هذه المحاولات البحثية والمنهجية من مضمونها القيمي تأثراً بالفكر المادي حتى الإسلامي منها ، أضحى العجز عن تقويم هذا السلوك شئ من الصعوبة المتعسرة ، مما أقتضى أن نبحث عن روح هذه الاتجاهات ، وهو ما نزعم أن العلم الصوفي ببعده الروحاني والأخلاقي قادر على أن يسهم بشكل كبير في هذا الأمر .
الفصل الثاني :
أسلمة العلوم الاجتماعية وتأصيل المنهج الصوفي:
لاحظ العديد من الفلاسفة أن عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي والرواج الفكري والتطور العلمي ، وهو ما عبر عنه هوايتد أيضاً ، مما يجعلنا نتساءل عن تلك العلاقة ما بين الدين والعلم ؟ أو بينه وبين العقل ؟ ومن ثم بينه وبين الفلسفة ؟ هذا التساؤل الذي طالما شغل بال العديدين ممن حاولوا تقديم إجابة عليه من منطلقات مختلفة ، ويبرز موقف الوضعيين كموقف مضاد لوجود تلك العلاقة وسعيهم الجاد نحو قطع أي صلة بين العلم والعقل من جهة وبين الدين والوحي من جهة أخرى ، وهو الموقف الذي غلف الفكر العربي في مراحل الضعف والتسليم ، وعلى النقيض ظهرت دراسات الدعوة الى إسلامية المعرفة لرفض ذلك التعميم الوضعي مؤكدة على الخصوصية الثقافية ، فعمدت الى التخلص من قيد العقل وتهميش الدين وشعار الموضوعية وأحيت الوحي من جديد إستناداً إلى قاعدة التراث الذي تشبع أصحابه بالتفكير الديني والاعتماد على الوحي كأحد مصادر المعرفة ، وظهرت في أعقاب تلك الدعوة العديد من المداخل والاتجاهات المختلفة التي تحكم التعامل مع هذه المصادر ، إلا أنها دخلت في جدال حول العقل والتراث أضحت معه تلك الدراسات نوعاً من فرض الذات في ثوب الماضي أو بمعنى آخر إضفاء صبغة إسلامية على الانتاج العلقي بواسطة التراث باستناده الى القران والسنة ، وأغفلت الجانب الروحي التي زعمت في البداية إجتهادها إلى إحيائه .
ويمثل التصوف قلب الروحية في الدين ، وعلى الرغم من مناداة العديد من دراسات هذا الحقل بأهمية هذا المنهج بما له من قدرة على إعادة ترتيب القيم وتقويم للأفكار وتزكية للنفوس وذلك وفق قاعدة أخلاقية ، إلا أنها لم تتعد كون الإشارة التي لم تتبلور في شكل منهجي واضح .
وهو ما سوف نتعرض إليه في هذا الفصل ، قبعد أن تناولنا في السابق بنوع من التفصيل طبيعة الأزمة التي يعاني منها علم الاجتماع ، و المردود الفكري عليها من خلال البدائل المنهجية المختلفة ، نستكمل هنا حديثنا بالانطلاق من أحد أهم تلك المشكروعات الفكرية متناولين واحد من أوجه القصور الهامة بها ، وهو إغفال المنهج الصوفي بما له من أهمية علمية وعملية وقيمية وأخلاقية .
وسيتناول الفصل مجموعة من النقاط الأساسية :
أولاً : الصياغة المنهجية للعلوم الاجتماعية في ضوء الأسلمة
ثانياً : التصوف : التعريف والخصائص
ثالثاً : الضوابط المنهجية والمصادر المعرفية للنموذج الصوفي
وسيتخلل هاتين النقطتين الرئيسيتين عدة محاور مختلفة تسهم مع بعضها البعض في التعريف بالمنهج الصوفي وتوضيح ملامحه وتحديد موقعه بين المناهج والدراسات المختلفة ، بحيث نصبح بعد ذلك على إستعداد لقبول الحديث عن القيمة العلمية والفكرية لهذا المنهج ، ويصبح كذلك في مقدورنا أن نتعرف على ما يمكن أن يلعبه من دور في الثورة .
المبحث الأول : نحو صياغة منهجية للعلوم الإجتماعية
أولاً : مناهج البحث الاجتماعي في أسلمة المعرفة:
تعددت المناهج والاتجاهات التي تعتمد عليها دراسات الأسلمة في محاولتها لإعادة المرجعية القرآنية وإستعادة دور الوحي في العلوم الاجتماعية ، وقامت بعض الدراسات بالتصنيف لهذه الاتجاهات والمداخل الفكرية جميعاً بل وتفتيتها حتى أضحى كل منها على حده ، أي منفصل بذاته لا علاقة له بالآخرين ، إلا أن الأمر بالضرورة على النقيض ، حيث أن الهدف من إعادة دراسة الظواهر الاجتماعية والانسانية من منظور حضاري شامل هو البحث عن بديل يسمح بالوصول إلى فهمها بالأبعاد المختلفة القيمية والروحية والمادية والغيبية كذلك .
(أ) المنهج التوحيدي
أو كما يطلق عليه بالنموذج الثقافي الوسطي ، والذي يعتمد في مرجعيته بالوحي ، تلك المرجعية التي تكفل له إمكانية تعدد الأبعاد وتحديد النسبة والتناسب بينها بما يمكن من فهم الظاهرة الانسانية بأبعادها المختلفة ، كما يتميز بقدرته على إحتواء البعد الغيبي في إطار البحث الإنساني ، فحدود المعرفة ذات الدلالة الاجتماعية تنبسط لتشمل الدنيا والآخرة والمحسوس والمادي والروحي والغيب .
وتعدد أبعاد الخبرة الانسانية لها تأثيرها المباشر على ميدان النظرية الاجتماعية ، بحيث تسمح بتعدد الأبعاد المعرفية والقيمية والأنماط الإدراكية .
(ب) المنهج الأصولي
ذهبت العديد من الدراسات إلى الدعوة للعودة إلى المنهج الأصولي في تناول الظواهر المجتمعية ، وتستخدم الأصولية في هذه الدراسات بمعنى مختلف عنه في أصول الفقه ، والذي يرتبط بإخضاع الأحكام الشرعية لأدلتها التفصيلية فحسب ، إنما يقصد به المعنى الشامل الذي يتجاوز دائرة التشريع ليمتد إلى مجال الفكر والثقافة والتصورات التي يحملها الإنسان للكون والحياة . أي أنه يقصد به “ذلك النهج الذي نهجه علماء الاسلام في صياغة أفكارهم وثقافتهم وتصرفاتهم وفق الأصول الشرعية الكلية حتى تأخذ الصفة الدينية التي تستمد شرعيتها من عقيدة التوحيد ، ويعتبر هذا النهج هو الضامن لإستمرارية الوحي بالمجهود البشري ، والغاية منه جعل الهيمنة على أفعال الإنسان للوحي الصبغة الشرعية وتحقيق معنى الألوهية في الأرض ” .
ثم ظهرت بعض الدراسات تسعى إلى التطبيق لهذا المنهج بدقة في مختلف المجالات الثقافية (العقيدية ، التشريعية ، الاجتماعية) ، وعلى المستوى الاجتماعي يذهب الباحثين إلى كون النظرة المنهجية التي ألتزم بها علماء الاسلام لربط كل الأنماط الثقافية الاجتماعية بالوحي والعمل على تكييفها حسب مقتضياته ، هي نفس النظرة التي ينبغي أن تحكم تعاملنا مع التراث الاجتماعي الذي وجد في ظل البيئة والحضارة الاسلاميتين .
ويضع هذا المنهج الإطار أو النظرة التي يتم من خلالها تناول التراث الاسلامي ، حيث سادت بعض الكتابات في محاولتها لإبراز طابع الأصالة الثقافية الهوية الاسلامية نوع من التبجيل للتراث ، بل وصل الأمر إلى حد التأكيد على ضرورة أن تدور علومنا الاجتماعية في ساحة هذا الفكر ، إلا أن تلك الرؤية للتراث من منظور ذلك المنهج تنزع هذا الطابع من القداسة ، ليقوم بتناوله وفق نظرة نقدية ومتفحصة وواعية لمضامينه والتي في ضوئها ستتحدد نظرتنا لتراثنا الاجتماعي .
(ج) المنهج الصوفي
تسعى دراسات إسلامية المعرفة إلى الاعتماد على المرجعية القرآنية والعقيدية عند الانطلاق إلى دراسة الواقع الإجتماعي ، هذه المرجعية التي تتخذ من التوحيد والعمران والتزكية قيماً عليا في التعامل مع هذا الواقع ، وعلى الرغم من تأكيد هذه الدراسات على هذا التكامل المنهاجي بين أوجه المرجعية القرآنية إلا أنها توقفت في حدود سعيها لهذا النوع على مجرد إطلاق تساؤلات حول مدى قدرته على المساهمة في تكوين المعرفة العلمية .
ثانياُ : التصوف في الدراسات الاجتماعية الإسلامية
في ضوء الموضوعات التي حفلت بها دراسات اسلامية المعرفة كسبيل نحو التأصيل النظري لهذا المنظور المعرفي والحضاري الجديد ولحسم موقفها من العديد من القضايا ، تطرقت من ضمن ما تناولت منها موضوع التصوف إلا أننا نلاحظ قلة الدراسات التي حاولت أن تتصدى لهذا الموضوع نظراً لغموضه وعدم وضوح معالمه بل وتتداخله في ثقافات مختلفة مما يضفي عليه أبعاد عديدة تزيد من صعوبته ، وحتى تلك الدراسات التي قامت بتناوله لم يحالفها الحظ في حسم الموقف منها بشكل واضح وانما لازال هذا الموضوع يحتاج المزيد من الجهد .
وتعد أبرز هذه الدراسات التي اهتمت بالاشارة الى التصوف في إطار سعيها نحو علم الاجتماع الاسلامي ، هي دراسة سامية مصطفى الخشاب بعنوان “نحو علم إجتماع إسلامي” ، حيث انطلقت الكاتبة من خلال رؤيتها لعلم الاجتماع الاسلامي كونه ذلك العلم الذي يحلل معطيات الفكر الاسلامي وتناول القضايا الخاصة بالعالم الإسلامي أيضاً ، وقد قامت الكاتبة في بداية مؤلفها بتحليل ظاهرة الدين واعتمدت في تحليلها هذا على مصادر أجنبية تعتبر الدين مجرد ظاهرة اجتماعية مجردة من أصلها الإلهي ، ثم أفردت الباب الثالث إلى دراسة التصوف باعتباره أحد الموضوعات التي يجب على هذا العلم أن يبحث فيها ، إلا أنها تناولت التصوف في ضوء الطرق الصوفية كظاهرة إسلامية خاصة ، وقد تناولت بالتعريف هذه الظاهرة بعد أن أقرت بصعوبة الوصول الى تعريف محدد وذكر بعضها دون أن تتبنى أحدها ، ثم عمدت إلى ذكر الخصائص العامة المشتركة بين أنواع التصوف المختلفة ، مع الإشارة إلى مراحل تطوره .
إلا أنه يمكن ملاحظة أن الكاتبة قد وقعت في مأزق دراسة التصوف كظاهرة من خلال المنهج الغربي التقليدي وليس من المنظور الإسلامي الذي يتوجب أن المؤلف يعمل على التأصيل له ودراسة الظواهر من خلاله ، فنجد على سبيل المثال أنها قامت بالاعتماد على الفلاسفة الغربيين في تحديد خصائص التصوف ، مما أسفر بها الى نوع من الخلط بين التصوف وبين الطرق بل بين التجربة والأحوال وبين تأثيرها ونتائجها المعرفية والأخلاقية ، فلم تتمكن الكاتبة في النهاية من تقديم جديد يذكر في هذا المجال سوى التأكيد على ضرورة تناوله في إطار الأسلمة كأحد الظواهر التاريخية للمجتمعات الإسلامية .
وهناك دراسة أخرى تعرضت للتصوف في إطار التصنيف للاتجاهات الاجتماعية المختلفة في التراث الإسلامي وذلك في دراسة بعنوان “نحو علم إجتماع عربي” لدكتور معن خليل عمر ، فقد اختلفت الاتجاهات لديه ما بين التبادلي والتنظيمي والعلائقي والصراعي والعقلي ، مصنفاً للتصوف ضمن الاتجاه العملي وهو اتجاه يقوم على أساس أن القلوب والنفوس منشأ الأعمال ، وشخصية الانسان ليست بظاهر السلوك وإنما الخلق هيئة في النفس وعنها تصدر الأعمال ، فالقلب هو المسير للأعمال السلوكية لذا يجب مراقبة القلب وتطهيره .
ومنهج هذا الاتجاه قائم على التجربة الذاتية العملية والتذوق الشخصي واستبعاد التفكير العقلي حول تحليل الافعال الاجتماعية والتركيز على الطريقة الذاتية في معرفة حقائق الأفعال .
لاشك أن دراسة التصوف من المهام التي يتوجب على علم الاجتماع الاسلامي إنجازها ، بشرط أن تقوم هذه الدراسة على أساس موضوعي ومن منظور إسلامي وهو ما يتطلب التخلص من الرؤية الغربية له باعتباره مجرد ظاهرة تخضع للأدوات والمناهج التقليدية ، كما يحتاج هذا الحقل كذلك الى تخطي الوقوف عند الجانب الاخلاقي الى البعد الفلسفي والمعرفي ومحاولة اكتشاف ما يمكن أن يضيفه الى المعرفة الانسانية بمصادره المختلفة كالكشف والالهام بالاضافة الى ماي حتله القلب من مكانة بارزة في الوصول الى الحقيقة .
المبحث الثاني : التصوف .. التعريف والخصائص:
بعد أن تعرضنا لأهمية التصوف وتناوله في دراسات المنظور الإسلامي ، علينا أن نتعرض إلى المفهوم والتعريف به وبخصائصه ، ويعتبر مفهوم التصوف من المفاهيم التي تنال قدراً كبيراً من الاختلاف ، نظراً لإعتباره مشترك إنساني عام ونقطة جامعة بين ديانات وفلسفات وحضارات متباينة ، أي أنه يتعرض الى تأثير مزدوج الإتجاه أي تأثير وتأثر ، ففي حين أنه يعد إطارًا لفهم معاني المفاهيم الأخرى القاعدية والمحورية وكذلك تسكين أدوار الأدوات المعرفية بما ينعكس في ترتيب العلاقات التفاعلية ، إلا أنه كذلك يخضع إلى تأثر من قبل الثقافة والسياق الذي يتم تناوله فيه مما يسهم في إضفاء طابع من الخصوصية على المفهوم ويؤدي إلى إختلافه ، بل إن تناول التصوف في ضوء كونه تجربة روحية وشعورية يجعلها تختلف من إنسان إلى آخر.
تتعدد الآراء حول تعريف التصوف بل وحول ماهيته سواء كونه تجربة أم إنفعالاً وهل هو مجرد رياضات روحانية لا تتخطى الجانب الديني والأخلاقي أم أنه رؤية فلسفية تجاه العالم والوجود ، بالإضافة إلى وجود محاولات واسعة نحو إحتكار تلك التجربة الروحية وإخضاعها الى ثقافات وديانات معينة دون غيرها ، ومن ثم تتراوح تلك التعريفات ضيقاً وإتساعاً بين المتصوفة والباحثين .
أولاً : في تعريف التصوف :
يذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن التصوف هو : “رياضة النفس ومجاهدة الطبع ، برده عن الأخلاق الرذيلة ، وحمله على الأخلاق الجميلة ، إبتغاء السعادة” . وهذا التعريف يركز على الجانب الأخلاقي دون غيره ، الذي يرى في التصوف أنه طريق من أجل السمو بالنفس الإنسانية وإصلاح الإنسان كخطوة نحو كماله ، حيث يقال أن التصوف هو إبتغاء الوسيلة إلى منتهى الفضيلة .
ويشير المستشرق الإنجليزي نيكلسون – الذي جمع نحو سبعة وثمانين تعريفاً حول التصوف إعتماداً على النصوص الأدبية والفكرية – أن التصوف هو “فلسفة الإسلام الدينية التي وصفت في أقدم تعريفاتها بأنها الأخذ بالحقائق ” ، بحيث تنتهي تلك الفلسفة إلى التأمل في الله والخضوع المطلق للمشيئة الإلهية .
ويذهب الشيخ عبد الواحد يحيى – بالإنفراد – إلى الأخذ بالقيمة العددية في تعريف التصوف حيث يرجع إلى القيمة العددية لحروفها ، وبالتالي فحروف كلمة صوفي تماثل في قيمتها العددية لحروف “الحكيم الإلهي” أي أن الصوفية هي الحكمة الإلهية .
وإلى قيمة هذه الإختلافات يذهب نيكلسون في توضيحها أن التعاريف المتعددة حول التصوف وإن كانت ذات فائدة تاريخية لأنها تعبر عن التطور التاريخي للمصطلح ، إلا ان فائدتها الرئيسية أنها تعبر عن أنها تجربة غير ممكنة التحديد ، لأن المتصوفة دائما ما يحاولون التعبير عما أحسته نفوسهم ، وأنه لن يكون تعريف يضم كل فخية من الشعور الديني المستكن لكل فرد .
وبالتالي هناك عدد من التعريفات التي يمكن أن نصنفها إلى عدة إتجاهات ، إلا أننا نجملها في ثلاثة إتجاهات رئيسية : (تصوف فلسفي – عقائدي / روحاني – عملي / تصوف ممارسة) ، وهذا التصنيف لا يعني الفصل التام بين هذه الأنواع وإنما فقط يسهل في تناول التعريفات والتعامل معها ، حيث نجد العديد من التعريفات التي تجمع بين أحد هذه الأنواع دون غيرها وأخرى تتناول نوعين وثالثة قد تجمع بينهم جميعاً ، بل اننا قد نصنف الإتجاه الواحد من هذه الأنواع إلى عدة إتجاهات أخرى .
وفي حين يذهب التصوف الفلسفي إلى ذلك التصوف الذي يعمد متبنيه إلى مزج الأذواق الصوفية بالأنظار العقلية مستخدمين في التعبير عنه مصطلحاً فلسفياً إستمدوه من مصادر متعددة ، وثمة طابع عام يطبع التصوف الفلسفي هو أنه ذو موقف وجودي خاص ، يمثل بمثابة الإطار العام الذي يتم فهم العقائد من خلاله ، ويتسم هذا النوع بالإسراف في إستخدام الرمزية وأنه ذو لغة إصطلاحية خاصة . ويذهب البعض إلى أن هذا النوع لا يمكن إعتباره فلسفة حيث أنه قائم على الذوق كما لا يمكن إعتباره تصوفاً خالصاً لأنه بعد عنه بلغة الفلسفة وينحو إلى وضع مذاهب للوجود . ومن ثم فهذا الرأي لا يرى في الذوق أداة للمعرفة العلمية وبالتالي هو خروجاً عن قواعد العلم العقلي الموضوعي ، وليس تصوفاً كذلك لأنهم يعتبرون التصوف مجرد حالة وجدانية لا تتعدى الروح ولا علاقة لها بالعقل والمعرفة .
فإن التصوف العقائدي الروحاني يأخذ إتجاهاً أضيق ، فهو ينظر إلى التصوف كونه مجرد خصوصية تخضع لتقاليد وثقافة العقيدة التي يتم ممارسته فيها ، ففي الإسلام هناك ما يسمى بالتصوف السني الذي يتقيد أصحابه بالكتاب والسنة ويربطون أحواله ومقاماته بهما ، حيث يشير البعض أنه “مزجاً جذاباً بين علمي الحقيقة والشريعة ، بين الظاهر والباطن ، بين قوة العلم وروحانية الدين ” ، وكذلك في اليهودية هناك جانب من التصوف الألوهيمي وتجذر النزعة التوحيدية والتمسك بالشريعة المكتوبة والشفوية ، فمثلاً ابن ميمون الذي كان ذا فكر توحيدي و صاغ أصول الديانة اليهودية على أساس هذا التوحيد . ومن ثم يقوم هذا النوع من التصوف على التمسك بالطقوس العباداتية التي تسهم في تطهير النفس و صلاح الإنسان ، ويضرب ستيس مثال الصلاة : تلك العبادة التي ربما لا نرى منها سوى تلك الإعتبارات السطحية التي تهدف إلى تغيير مسار الأحداث الطبيعية بالتوسل إلى الله كالالتماس من أجل نزول المطر أو حتى تغيير في القلب أو الذهن أو حتى جسم الشخص الذي يصلي أو في إستلهام قوة روحية أو أخلاقية أكبر سوف تؤدي إلى تحريك سلسلة من الأحداث السيكولوجية التي تبدو أنها تأتي إستجابة لهذه الصلاة ، إلا أن التصوف يمكننا من الوصول إلى تبريرات أعمق فمثلاً المتصوفة المسيحيون يرون الصلاة رغبة في الإتصال أو الإتحاد بما يعتبرونه الموجود الإلهي وهو أقصى معروف يمكن للوجود البشري أن يسعى إليه ، بل يعتبرون الصلاة إذا فهمت أنها إلتماس لمعروف فهي فساد شائع للصلاة الحقيقية ، وفي ذلك المثال تبريراً أو سبباً واضحا يجعلنا لا نتوقف عند التصوف كونه مجرد الرياضات الروحانية والسلوكيات المصاحبة والإنفعالات المرتبطة بتلك التجربة ودراسة صداها في العالم الخارجي ، خاصة أن المتصوفة أنفسهم يؤكدون أن ذلك ليس غاية المنتهى وإلا لربما كان الإصلاح بتلك الرياضات الحركية والشعورية التي قد يزول تأثيرها بمجرد الإنتهاء منها ، ومن هنا فالصلاة في المثال السابق لا تتوقف على المعنى المادي القائم على مجموعة حركات في ترتيب منتظم ، إنما هي إتصال في علاقة خاصة مع الموجود المطلق .
بينما تصوف الممارسة أو العملي فيقصد به تصوف الطرق ، والطريقة الصوفية تتألف من جملة مقامات يجب على الصوفي / السالك أن يتحقق بها ولا ينتقل من مقام إلى المقام الذي يليه حتى يصل إلى درجة الكمال فيه ، وتعد التوبة هي أول هذه المقامات أي الفرار من المعاصي والإلتجاء إلى الله ، أما الغاية الخلقية من الطريق الصوفي فهو إنكار الذات بالزهد ومتاعها ولذاتها ، والصدق في القول والعلم ، والصبر والإحسان إلى الخلق ، والتوكل على الحق ، والإذعان التام لإرادته . ويذكر ابن سينا في تعريفه للتصوف هذه الأنواع جميعاً فهو عنده ” ليس تصوف التقرب بالأعمال فقط بل هو درجات ما بين الإعراض عن متاع الدنيا ، والمواظبة على العبادات ، والإنصراف إلى تقديس الجبروت وإستدعاء شروق نور الحق”.
وهناك تصنيف آخر لأشكال التصوف تترواح ما بين التصوف التوحيدي وآخر حلولي ، فالتصوف التوحيدي يصدر عن إيمان بإله يتجاوز الإنسان والطبيعة والتاريخ ، ويؤمن بالثنائيات الدينية كسماء / أرض ، إنسان / إله .. وغيرهما ، وتتبدى هذه الرؤية في تدريبات صوفية يقوم بها المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله . بينما ذلك الحلولي هو الذي يرى في الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة ) كامناً فيها ، فيصبح الإله والعالم وكل الوجود وحدة واحدة ، وهو ما يؤدي إلى الواحدية الكونية التي تنكر التجاوز على الإله بحيث يصبح لا وجود له خارجهما .
وتصنيف ثنائي ثالث ما بين التصوف الأخلاقي وآخر معرفي ، حيث يشير التصوف الأخلاقي إلى مجموعة العبادات والتدريبات الروحانية التي يمارسها الإنسان من أجل التقرب إلى الله أو تحقيق السعادة بالسمو على ما هو مادي ، ويعتبر تعريف العقاد للتصوف من أبرز الأمثلة على هذا النوع حيث يعبر عنه بكلمة واحدة وهي ” القناعة ” ، بينما المعرفي هو الذي ينظر كون التصوف طريقة للمعرفة لها أدواتها الخاصة والتي تنتج حقائق لها صداها العلمي ، ومن هنا يعرف جورج شوليم الصوفية اليهودية بأنها : معرفة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية أو العرفان .
خلاصة القول ، يمكننا أن نخرج من تلك التعريفات بأن التصوف ما هو إلا وسيلة من أجل الوصول إلى الفضيلة بغاية تحقيق السعادة والكمال ، فعلى المستوى المعرفي فهو بمثابة الأداة التي تمكن المتصوف من إدراك ماهية الأشياء الباطنية بواسطة هذا الحدس الكشفي أو كما يسمى النور الداخلي الرباني ، وعلى المستوى الأخلاقي كذلك فهو يمثل إعلاء النزعة الروحية داخل الإنسان ليسمو فوق غرائزه الدنيئة حتى يمكنه أن يصل إلى هذا الإنسان الكامل بإتصاله بالموجود المطلق .
ثانياً : خصائص التصوف :
في ضوء الاقرار بالتمايز في التعبير عن التجارب الصوفية والرؤية في تعريفه ، يبدو من المهم أن نتساءل عن طبيعة هذا التمايز وعن الخصائص المشتركة بينها جميعاً ، وقد وردت العديد من الخصائص في كتابات الكتاب الغربيين إلا أننا نفضل هنا الاعتماد على ما جاء عند المسلمين نظراً لانها تهتم بذلك التصوف الاسلامي وهي الأجدر بالضرورة على معرفة طبيعته .
وقد أشار الدكتور التفتازاني أن للتصوف خمس خصائص نفسية وأخلاقية وأبستمولوجية وهي :
أ- الترقي الأخلاقي : فكل متصوف له قيم أخلاقية معينى ويهدف إلى تصفية النفس من أجل الوصول إلى تحقيق هذه القيم ، وهو ما يتطلب بالضرورة القيام ببعض الرياضيات النفسية والمجاهدات البدنية والزهد في الماديات وغير ذلك مما يحقق السمو الروحي للسالك .
ب- الفناء في الحقيقة المطلقة : وهو الأمر الذي يميز التصوف بمعناه الاصطلاحي الدقيق ، والمقصود بالفناء هو أن يصل الصوفي من رياضاته الى حالة نفسية معينة لا يعود يشعر معها بذاته كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة .
ج- العرفان الذوقي المباشر : وهو معيار ابستمولوجي دقيق يميز التصوف عن غيره من الفلسفات ، فإذا كان الانسان يعمد الى اصطناع مناهج الفعل في فلسفته فهم فيلسوف . أما إا كان يؤمن بأن وراء إدراكات الحس واستدلالات العقل منهجاً آخر للمعرفة الحقيقية يسميه كشفا او ذوقا ، هذا الكشف الذي يذهب إليه الصوفي آني سريع الزوال .
د- الطمأنينة أو السعادة : هي خاصية مميزة لجميع أنواع التصوف والتي تحدث نوع من التوافق النفسي عند الصوفي ، وهذا من شأنه أن يجعل الصوفي متحرراً من كل مخاوفه ، وشاعراً براحة نفسية عميقة .
هـ- الرمزية في التعبير : أي أن العبارات الصوفية عادة ما تحمل معنيين : أحدهما ظاهر اللفظ ، والآخر بالتحليل والتعمق ، وهذا المعنى الأخير صعب كثيراً الوصول إليه على غير المتصوفة ، ومن هنا توصف التجارب والتعبيرات الصوفية بالرمزية .
ويكن أن نضيف على هذه الخاصائص بعض السمات الأخرى التي تعد صفة خاصة بالتجارب الصوفية :
أ- الإستعصاء على التعبير : أي أن ثمرة التجربة الصوفية لا يمكن التعبير عنها حتى أنها تقترب في ذلك من الاستحالة ، حتى أن وليم جيمس وصف نتيجة ذلك عند ابن عربي بالخرس ، ويقرر إقبال السبب في ذلك أنها ناتجة عن معرفة مباشرة لا يمكن الإطلاع عليها ونقلها لانسان اخر وان حالات الصوفية أشبه بالشعور منها بالتعقل .
ب- التطهرية التدريجية : فالتجربة الصوفية تسبقها عملية تطهير شاقة تمكن الصوفي من الاستعداد لدخول هذه التجربة وعلى الرعممن وجود بعض المتصوفة الذي يؤكدون تلقائية تلك التجربة إلا أننا يمكن أن نلاحظ انهم مروا بعملية تأمل شاقة مضمونها الشك والبحث عن الحقيقة وبالتالي تنقسم تلك الهملية إلى تطهير نفسي واخر تأملي ذهني .
ج- باطنية التجربة الصوفية : فالصوفي هنا لا يسعى لمعرفة حقيقة ظواهر الأشياء إنما يحاول الوصول إلى حقيقتها الكامنة خلفها ، والتي يؤمن إيمانا قوياً أن قدرات الإنسان العادية لا تمكن تحقيقها ، إلا أنها مع ذلك موجودة ويمكننا الوصول إليها بطرق شاقة .
د- موضوعية النتائج : فكل ما ينتج عنها من معرفة هي معرفة صادقة ولا يمكن الشك فيها لأنها تتجلى من المصدر الإلهي مباشرة .
هـ- النظرة القدسية للعالم : فالعالم بظواهره وأشيائه المختلفة يحوي بداخله سر وجوده ، وأن كائناته تحمل من الصفات الإلهية بل والبراهين على وجوده
المبحث الثالث : الضوابط المنهجية والمصادر المعرفية للنموذج الصوفي:
سادت الوضعية المادية في الحكم على مدى علمية المجالات والتفكير العلمي ، مما أدى إلى الاعراض عن التأمل الفلسفي والبحث في الاسئلة الحاسمة بالنسبة للبشرية ، وعلى عكس المتوقع من إزدهار تلك العلوم الروحية بربطها بالطبيعية ، فقد أدى ذلك الاقحام إلى تلك المحنة المشؤومة حتى أضحى الفكر العلمي الموضوعي معه عاجز عن البحث عن حلول لما نواجهه في حياتنا اليومية نتيجة لإقصاء إعتبارات الذات الانسانية الحرة ، ولعله من الممكن إلتماس أصداء تلك الأزمة اليوم في العجز عن مناقشة الثورة او حتى مجرد إدراك قرب حدوثها بل وأحياناً أخرى يعجز عن فهم لماذا لا تقوم الثورات ، هذا الأمر الناتج عن تنحية الإرادة الانسانية بسبب الربط بين ظواهر الكائنات البشرية وتلك الخاصة بالعالم الطبيعي التي تحدث بشكل آلي ، وعلى الصعيد الاخر إلحاح تلك الموضوعية في الحيادية القيمية للباحث ، أي أن الباحث عليه أن ينحي كل مواقفه القيمية ويصبح جهده قاصر على تسجيل ما هو قائم في العالم العيني ، مما أنتج لدينا فئة من الخبراء دون الفلاسفة ، فأخذ العديد في التساؤل لماذا فقد العلم ريادته ؟ وعمدوا في البحث عن إجابة هذا السؤال من خلال النقد الواعي للتطورات التاريخية للفلسفة التي أنتهت في الحاضر إلى تلك الوضعية التي أطاحت برأس الفلسفة “الميتافيزيقا” الباحثة في الأسئلة العليا التي تمثل روحها بمثابة المعنى الأخير لكل المعارف ، ونظراً لإنهيار هذا النوع من الفلسفة النوعية فقد تدهورت معها العلوم المادية ، وأدت إلى إنهيار الاعتقاد في العقل المطلق الذي يمد العالم بمعناه مما أفقد الانسانية ذاتها فأحدثت خلل في بنية كافة العلوم الحديثة أرتبط بها خلل في الروح البشرية والعقل ، ويرى هوسرل أنه لا مفر من تلك الأزمة دون أن يدرك الفلاسفة مهامهم الأساسية في هذه الحياة والتي تكمن في خدمة الإنسانية بأسرها وألا نقتصر على مجرد التفلسف الغائي النابع من تلك الخصوصية الثقافية . ولكي نتمكن من ذلك علينا بداية أن نضع مجموعة الأدوات التي تساعدنا في البحث بداية بتحديد أنفسنا فهو يقول : “منذ الآن ، سنسير جماعياً مسلحين بموقف روحي شكي إلى أقصى حد لكن ليس سلبياً مطلقاً ” ، فإننا لن نخضع لهذا الإختزال الموضوعي لجوانب الانسان في الحواس إنما سنسعى معاً في الآتي إلى النظر في المنهج الصوفي من خلال نقد إنساني لتلك النزعة لإحياء البعد الروحي من جديد من خلال الواقع المعيشي .
أولاً : في إعادة تحديد العلمية
يواجه العلم صعوبات عديدة عند تعريفه نظراً لاستغلاله كأداة في الصراعات الأيديولوجية والإختزال للحقائق في جانب واحد هو الطبيعة (الإنسان والعالم المحيط) ، فأصبحت العلمية تشير إلى البحث النظري بمعنى أن العلم هو “جهد مبذول للمعرفة والفهم الذي يحيط بظواهر الطبيعة على أن تشمل الطبيعة كلا من الإنسان والعالم الذي يحيط به “، ويلخص هذا التعريف العلم في هذا العالم الطبيعي المحسوس والخارجي دون أي محاولة للبحث من أجل الوصول إلى الحقائق الجوهرية الكامنة خلف تلك الظواهر ، إنما العلمية تقتصر في الأدوات المستخدمة لفهم الظاهرة بمعزل عن غيرها في معمل التجارب ، في حين يقول برونفسكي أن العلم هو “تنظيم لمعرفتنا بالطريقة التي من شأنها أن نتسلط على أكثر ما هو كامن وخفي في الطبيعة ” أي أنه لا يعترف بالحدود الفاصلة بين المعرفة وأنه لابد من الإلمام بجميع ظواهر الوجود ، ومن خلال التعريفين السابقين نلاحظ أن هناك إتجاهين في تعريف العلم والتي عبر عنهما برنال في قوله “إن العلم بوصفه أنبل زهرة للعقل الإنساني وأعظم نبع واعد بالمآثر المادية له صورتان : الأولى صورة (مثالية) يبدو فيها العلم معنياً بكشف الحقيقة وتأملها ، ومهمته أن يبني صورة عقلية للعالم تلائم وقائع الخبرة ، الثانية هي الصورة (الواقعية) التي تسود فيها المنفعة وتتعين الحقيقة كوسيلة للعمل النافع وتختبر صحتها بمقتضى هذا الفعل المثمر” . وقد لعب السياق التاريخي للتجربة الاوربية دوراً حاسماً في هذا الإختلاف حيث الإعلاء من البعد الحسي والمنهج التجريبي وكذلك في إعتبار النموذج الطبيعي بمثابة المرجعية لتحديد مفهوم العلمية ، حتى أصبحت تلك العلمية تتلخص في “مجموع العمليات المرتبطة بالمجال المحسوس واختزال المجالات الأخرى ذات الطبيعة المغايرة في جوانبها الواقعية المادية ” ، ومن هذه المجالات خاصة ما يتعلق بالمجال اللاهوتي والعقائدي فالموضوعات الخاصة بهذا المجال هي خارجة عن الإطار العلمي ، وقد أدى هذا الإقحام والفرض لنظريات وطبيعة العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية إلى تشوهها وتخلفها ، فالبحث العلمي يمر بمجموعة من الخطوات بداية من عملية جمع البيانات ووضع الفروض ثم إستخدامها لوصف الظاهرة محل البحث وتحليلها إلى عناصر ثم تفسيرها من أجل الوصول إلى قوانين مما يسهم في تكوين خبرة عن هذا النمط من الظواهر وبالتالي لابد أن تتكرر الظاهرة في المستقبل بنفس الطريقة وفي ضوء نفس العوامل حتى يمكننا التحكم فيها أو تعديلها أو إبطال أثرها .!
ولعل الحديث عن العلم هنا لابد أن يأخذنا قليلاً نحو تاريخ العلم نفسه ، لأن العلم هو عملية معرفية متراكمة وممتدة عبر الزمان وبالتالي فهي مرتبطة بالجذور ولا يمكن فصلها عنها ، ويشير هربرت دنجل إلى ما أسماه “العامل المفقود” وهو النقد الداخلي للعلم المؤسس على المعرفة التاريخية ، هذا النقد هو الذي يقوم من مسار تتطور العلم ذاته ، ويمكننا في ذلك أن نتوقف عند التجربة الأوربية – منتصف القرن التاسع عشر- وهو ليس من باب التحيز أو الرغبة في الوقوف عند مرحلة دون غيرها وإنما لأهمية تلك المرحلة في تغيير مفهوم العلمية –كما أشرنا- بل وفي تأثيرها على العلوم الإجتماعية بشكل أساسي والتي نحن بصدد الحديث عنها ، فقد كان العلم في تلك المرحلة قائم على اللاهوت والخضوع إلى سيطرة الكنيسة ، إلا أنه بعد الإنقلاب على كل ما هو ديني بل على ما هو كنسي ، تحول كذلك العلم فبعد أن كان خاضعاً لسلطة الكنيسة أصبح حالياً خاضعاً لمنطق الطبيعة وتحول كل ما يرتبط بالدين هو مجرد خرافة ولا صلة لها بالعلمية ، وتحول الأمر في العقل الأوربي إلى ثنائية حادة كل طرف فيها هو على نقيض تام من الآخر، وشاع مصطلح “علم الفيزياء الإجتماعي” الذي ابتكره كونت في محاولة منه لتأسيس علم جديد دون إدراك إختلاف الطابع بين ما هو طبيعي وما هو إنساني ، وقد أصبح بعدها المفكرين على يقين من أن الطبيعة الإنسانية تتبع كذلك قوانين يمكن تعقلها كما هو الحال في العلوم الطبيعية المادية ، فالقوانين التي تحكم المجتمع هي قوانين منظمة غير عشوائية تصدر عن إحتياجات البشر .
وقد دفع هذا الإقتداء بالنموذج الفيزيائي إلى الإنبهار بما حققته العلوم الطبيعية والهرولة نحو تطبيق قواعدها ومناهجها على الظواهر الإنسانية والإجتماعية ، مما عكس هذا الإقتداء المسرف تصوراً معيناً للإنسان لا يفرق بينه وبين أشياء الطبيعة إلا من جهة الدرجة . وقد أصبح التعامل مع الظواهر الإجتماعية تعامل منزوع الروح والإرادة فهي مجرد تجارب خاضعة لجبرية القوانين تلك الرؤية التي تحولت إلى قناعة ومسلمة يتم الإنطلاق منها في البحث ، وقد وصل الأمر كذلك إلى محاولة تطبيق المنهج القياسي على تلك الظواهر ، أي أن القياس الكمي والملاحظة الحسية والتجربة أصبحوا شرطاً في تحقيق علمية العلوم الإنسانية ، وقد إختلف الموقف من هذا الربط وتجاهل الفوارق بين النموذجين إلى إتجاهين أساسيين : أولهما يتبنى النموذج الطبيعي يرى فيه النموذج الأوحد للوصول إلى العلمية في دراسة الإنسان والمجتمع ، في حين أن الموقف الآخر يرفض هذا الرأي ويسعى إلى بلوغ درجة العلمية في العلوم الطبيعية دون الإلتزام بنموذجها ويقر بمجموعة من الفوارق الموضوعية والمنهجية التي تميز كل نموذج عن الآخر مما يوجب إختلاف لمعنى العلمية في تطبيقها فعدم الإلتزام بالنموذج الطبيعي في الوقائع الإنسانية لا يعني عدم علميتها . وهذه الإختلافات بين النموذجين نستطيع إجازها في عدد من النقاط الرئيسية :
– طبيعة الظواهر والوقائع محل البحث : إن العلوم الإنسانية تركز على دراسة الإنسان والمجتمع وما يتسم به من إرادة وعفوية وتعقيد مما يؤدي إلى عدم إنتظام السلوك وكذلك تداخل العوامل المؤثرة مما يصعب إخضاعه للتجارب وفصل المتغيرات ، فالظاهرة تخضع لعدد من الظروف التي يصعب تكراراها على نفس الوتيرة من أجل الوصول إلى نفس النتائج ومن ثم وضع قانون آلي تضخع له ويمكننا التنبؤ بها في المستقبل .
– نوعية العلاقات المنظمة للظواهر الإنسانية : حيث ان العلاقات المنظمة للمجال الإنساني هي علاقات قيمية كيفية ولا تخضع للمفاهيم القياسية ، على عكس العلاقات في العلوم الطبيعية التي تتسم بكونها بعلاقات سببية آلية .
– إختلاف العلاقة بين المنهج والظواهر الإنسانية (المنهج والموضوع) : يقوم المنهج الوضعي على دعامة اساسية هي أن الباحث يدخل إلى الدراسة وفق حتمية التحرر من الأفكار المسبقة حول الظاهرة، فالمعرفة تأتي من الخارج عن طريق الملاحظة الخارجية وتطبيق الأدوات التجريبية التي ساعدت في تقدم العلوم الفيزيائية ، إلا أن هذه الوسائل لم تؤد إلى نتيجة مطابقة في العلوم الإنسانية بل دفعت بها إلى التخلف وجعلت الدراسات في هذا المجال قاصرة على الوصف الظاهري للسلوك الإنساني مركزة في ذلك على الجوانب المادية من الحركات والأفعال ، لكن لا يكفي هنا أن نصف الوقائع والحركات للأفراد للإلمام بمعرفة الوقائع بأبعادها المختلفة إنما لابد من التفسير مع الملاحظة الداخلية الكيفية فالقياس والتجريب لا يستقيم في دراسة تلك الحالات ، فالأخلاق على سبيل المثال هي لا تستقيم دراستها بتجريدها من عناصرها القيمية وإقصارها على تفسير الأفعال بل هي تلتزم بالحكم عليها طبقاً لمثال ما مطروح مسبقاً .
– دور الباحث : في حين يقتصر دور الباحث في العلوم الطبيعية على مجرد إجراء التجارب في معزل عن الظروف الخارجية ودون تدخل منه ، فإن هذا الدور يأخذ بعداً أعمق في الأبحاث الإجتماعية فهناك صعاب تجعل دوره أساسي في الحكم على الظواهر وتوجيه نتائجها تلخص في (الذاتية – القيمية – الأيديولوجية) ، ومن ثم يبدو الحديث عن هذا الباحث منزوع القيمة نوع من عدم الإدراك والإختزال في إطار المعاداة لكل ما هو روحي والتي أرتبطت في العقول الأوربية بالديني .
على الرغم من هذه الفوارق بين المجالين إلا أن ذلك لا يعني التعارض ، فلكل مجال طابعه المميز وأدواته وأسلوبه في التعامل مع ظواهره الخاصة ، وأن طبيعة الظواهر الإنسانية بما تتطلبه من مقاييس وأدوات مغايرة لتلك التي في النموذج الطبيعي لا يعني انها خارجة من مظلة العلمية . وإننا هنا لا نسعى إلى وضع تعريف للعلم أو وضع صورة محددة لابد من الإلتزام بها ، لكن فقط نوضح أن لكل نموذج طبيعته الخاصة ومعاييره العلمية المحددة له ، بل إن كلمة علم في حد ذاتها تختلف طبقاً للنموذج المعرفي المتناولة فيه ، وبالتالي فمفهوم العلمية يخضع للظروف الزمانية والمكانية والمنطلقات الابستيمية مما لا يجعلنا في حاجة إلى الإلتزام بما تم الوصول إليه في ظل السياق التاريخي الأوربي والنظر إليه بعين اليقين ، فالعلم هو عبارة عن أسلوب للمعرفة يهدف إلى البحث وإكتشاف الحقائق وله أدواته ومناهجه التي تتلائم مع كل مجال على حده وتتناسب مع ظواهره المختلفة على أن تتسم نتائجه بخصائص تجعلنا نقر بعلميتها وهي (الصدق – التعميم – الموضوعية) . وبالتالي فالموضوعية ترتبط ما إذا كانت المعلومات والوصف مطابق للواقع وشامل للوقائع المشابهة بحيث يكون التعميم مقبولاً وكذلك أهمية الموضوعية بما تشير إليه من مسئولية أخلاقية وتجريد للأهواء الشخصية في نتائج البحث وأن تخضع تلك النتائج للأدلة والبراهين .
بعد أن تناولنا طبيعة العلم وإختلاف طبيعته طبقاً للمجال والنموذج والحضارة ، علينا أن نتساءل الآن .. ماذا يمكن أن يقدمه النموذج الإشراقي الصوفي ؟ وما هي مميزاته التي تجعل الأخذ به ضرورة هامة وخطوة في تقدم تلك العلوم ؟
لعل من الأهمية هنا أن نشير إلى أن المشكلة التي تناولناها هي في الأساس مشكلة تسكين الأدوار للأدوات المعرفية المختلفة طبقاً للظواهر محل الدراسة ، وهذا التسكين الذي يخضع كما أوضحنا لعوامل أيديولوجية ومنطلقات حتمية ، وقد اتخذ إتجاهات مختلفة بين الإقصاء والتضمين والإعلاء ، وهو الأمر الذي يخضع له كافة النماذج ويشكل محور الإختلاف بينها ، ففي حين عمد النموذج الغربي المادي إلى إقصاء كل ما هو روحي ديني وإعلاء جانب الحس وتسكين دور العقلي في الإستنباط من المشاهدات الحسية ، ذهب أنصار النموذج الروحي إلى تأكيد دور الوجود الروحي والسعي نحو تأكيد دور الدين ، وقد اتخذت دراسات أسلمة المعرفة خطوة هامة في توضيح أهمية الوحي كأداة هامة في الوصول إلى المعرفة ، والتأكيد أنه مع أهمية المنهج التجريبي في تناول الظواهر المادية لكن هناك من الظواهر غير المادية التي يجب التعامل معها ، إلا أن هذه الدراسات رغم ذلك وقعت في عدة مفارقات بعضها ظل أسير النظرة الوضعية وإعتبار ان الوحي له دور في الدراسات الميتافيزيقية والمعارف اللاهوتية بعيدة عن الظواهر الإجتماعية ، بل أن بعضها أعتبر أن أي دراسة صادرة في هذا المجال قبل الضوابط المنهجية الوضعية لا تخضع للعلمية – مثل كتابات ابن خلدون – ، وعدد منها على الرغم من تأكيده على دور الوحي وضرورة أخذه في الإعتبار إلا أنها ترى في الوحي أحد أدوات الميثودولوجيا الإسلامية أي التعامل معه في ضوء حضارة وثقافة معينة دون الإشارة إلى دوره في الأديان الأخرى ، فماذا عن دوره في اليهودية والمسيحية وماذا عن دور الدين في حد ذاته في العقائد اللاوحدانية بل والمجتمعات اللاعقائدية ؟ فهذه الدراسات تخرج هذه المجتمعات من منظورها الضيق ولا ترى سوى الذات ، فلكل نموذجه الخاص . بينما ذهبت بعض الدراسات إلى الإشارة لدور الوحي كونه أحد مصادر الأسلوب العلمي التاريخي نظراً للمادة الغزيرة التي يقدمها في هذا المجال فضلاً عن المصداقية كونه صادراً من مصدر إلهي ، فهو لا يتعدى كونه مصدرًا للمعلومات والحقائق التاريخية ، وتقديم تصورات حول الإنسان وحركته ، وتصوراته حول أنماط الحياة الإنسانية ووضع مجموعة قوانين عامة حول الانظمة الإجتماعية .. ولكن ما الفرق بين الوحي إذاً وبين أنماط الاستدلال التاريخي في البحث وما هي الغاية من ذكر القصص والحقائق داخل النصوص الدينية وماذا عن الفروق في تناول تلك الحقائق كما هو واضح بين العهد القديم وما بين القران الكريم وماذا كذلك عن دور العقل والحواس فهل أقتصر العقل والبحث على مجرد الدراسة النظرية لما جاء به الوحي ثم العمل على تفسير الواقع طبقاً لها أي تحول الواقع إلى مجرد لوحة يرسم عليها الباحث نتائجه العقائدية التي لابد أن تكون إنعكاس أساسي لها بل وماذا عن الإختلاف في النتائج ذاتها وإختلاف الوقائع والمتغيرات التي قد تؤدي إلى إسقاط فروض الباحث وما توصل إليه ؟! .
إننا علينا أن نعي أن “السعي من أجل بناء علم إجتماع من منظور إسلامي لا يعني سعياً لاستبدال المنظور الإسلامي بالمنظور الغربي لعلم الإجتماع ، ففي ذلك إستبدال متحيز لإطار بإطار وهو خطأ لا ينبغي ان يسقط فيه أبناء حضارة ذات نزعة إنسانية وإسلامية كما حدد الوحي الإلهي طبيعتها ، بل لابد أن تكون هذه الدعوة تأتي من منظور تطويري يقدم الحقيقة الإنسانية والإجتماعية من زاوية جديدة” .
ثانياً : التسكين الصوفي للأدوات المعرفية :
كما أوضحنا سابقاً أن العرفان الإشراقي الصوفي يقوم على تسكين لأدوات المعرفة الإنسانية حواسه وقلبه وخياله وعقله حتى يمكن الوصول إلى الحقائق الكامنة في الظواهر الوجودية حولنا ، فلكل أداة منها دورها الذي لا يمكن الاستعانة بغيرها فيه ، أي أنه لا يذهب إلى تجاوز أي منها ، وسوف نتناول هذه الأدوات مع التركيز على الكشف باعتباره أبرزها . ولكي نفهم درجات السمو العرفاني في التجربة الصوفية علينا أن نربطها بمراتب الوجود وهو ما يميز التصوف الفلسفي .
مراتب العرفان الصوفي
مراتب الوجود مراتب العرفان
عالم المادة المعرفة الحسية
عالم المثال القوة المتخيلة
عالم العقل الأنوار العقلية
من خلال هذا الرسم التوضيحي يمكننا أن نكون فكرة عن أدوات المعرفة الصوفية وترتيبها التصاعدي الذي يساعد الإنسان في معرفة أصل الحياة والوجود والتي تمثل غاية العلوم في الحقيقة ، ويأتي في بداية هذه الوسائل الحواس والتي تقابل في مراتب الوجود عالم المادة أو الطبيعة أي أن الحواس لها عالمها الخاص الذي يمكنها أن تلعب فيه دورها الحاسم وتشكل ما يعرف بالمعرفة الحسية ، وكما يقول ماكس مولير “إن حواسنا تدلنا على ماله نهاية ولكن بعد النهاية وورائها وما فوق النهاية وتحتها وحتى في داخل النهاية نرى أبداً اللانهاية ماثلة لنا تضغط على حواسنا ، وعلى ذلك فإننا لانستطيع فهم كنهها ولا الإحاطة بها ..” ، أي أن للحواس ميدانها المنحصر في الظواهر الموجود في الكون ولا يمكنها أن ترتقي بنا لمعرفة الحقيقة الباطنة فيه فقط هي تعطي مجموعة مشاهدات للعقل من أجل الاستدلال من خلال طرح مجموعة تساؤلات حوله ، ومن ثم فإن المنهج التجريبي بما فيه من تسليم لنتائج المشاهدات الحسية لا يمكنه سوى تحقيق معلومات وقوانين للعالم الطبيعي لكنه إذا ما إمتد إلى مجالات الوجود بما فيها من تساؤلات وجودية كبرى فإنه يعجز عن تقديم أية نتائج مهمة فقط هي مجرد بيانات ظاهرية مجردة تعطي إحساس متوهم بالوصول إلى العلمية .
وتقول المشائية الإسلامية بنوعين من المعرفة (المعرفة العقلية – المعرفة الحسية) مقابلة لأنواع الوجود (العقلي – المادي) ، إلا أن الفلاسفة المتصوفة يضيفون نوع آخر خاص بـ (المعرفة الخيالية) التي تقابل عالم (المثل المعلقة) ، وبناء على ذلك يميز الفارابي بين ثلاثة أنواع للإدراكات النفسانية هناك الإدراك الحسي “القوة الحاسة” ، والإدراك الخيالي “القوة المتخيلة” ، والإدراك العقلي “القوة الناطقة” ، وبالتالي تكون القوة المتخيلة هي وسط بين الحسية والعقلية مهمتها حفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحس وتركيبها إلى بعضها . بينها هي عند السهروردي لها وظيفة مختلفة فالإدراك الخيالي يتعلق بالمثل المعلقة – وليس المحسوسات الخارجية – الذي هو واقعاً بين عالم العقل والحس وكذلك الإدراك الناتج عنه يتوسط الإدراك الحسي والإدراك العقلي ، لكننا نلاحظ تأكيده كون الصور الخيالية مثل لها وجودها المستقل عن النفس الإنسانية أي أنها مثل موجودة بالفعل وبانتظار من هو قادر على إدراكها .
وإذا ما تطرقنا في حديثنا إلى العقل نجد أنه يلعب دور متفاوت لدى المتصوفة إلا أنه حاسم في نفس الوقت ، وبما أننا منذ البداية نركز على النمط الفلسفي نقول أن المعرفة الصوفية قائمة على أسس عقلية بحتة وأن صورة العقل ليست مساوية لذلك القائم على الاستدلال والتركيب للمشاهدات والاستنباطات الحسية ، فإن العقل في صورته الأولية تلك عاجز عن الوصول إلى الحقائق العليا أو إدراك الله ، إلا أنه يدخل في مراحل للتطور التصاعدي المتدرج حتى يصل إلى درجة الفيض والإلهام ويتم هذا التدرج باتساع معلومات الفرد ، فكلما اتسعت وأوغلت في التجريد كلما اقترب من العالم العلوي ويصبح أهلا لتقبل الأنوار الإلهية وأضحى على إتصال مباشر بالعقل الفعال ، ومعنى ذلك أن المعرفة الانسانية لا يحصلها العقل باجتهاده في الواقع بل هي تتجلى في صورة هبة من العالم الأعلى وهي بذلك تكون معرفة إشراقية ، وذلك هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه نظرية الفيض . ولا يتم هذا التدرج بدون المرحلة السابقة المتعلقة في عالم المثل فهي بمثابة تأهيل للعقل حتى يبدأ في سلمه المعرفي .
ويتساءل السهروردي في كتابه “حكمة الإشراق” عن كيفية الجمع بين التأله (الفيض الإلهي) وبين البحث (المعرفة العقلية) عند الحكيم الإشراقي ؟ إن ذلك لا يتم بين هين النظامين الفكريين مالم يتوسطهم المعرفة الخيالية على الرغم من أنها تأتي في التدرج المعرفي في مرتبة أدنى من العقلية ، وهو ليس تخفيض للمعرفة الصوفية التي طالما زعمت لنفسها اليقينية وإنما هي تأكيد على قوة العقل في إدراك اللامتناهي بعد أم مر بتجربة إشراقية وسعت من أفقه . وتأكيداً كون تلك المعرفة ليست منفصلة عن الوجود بل هي سائرة جنباً إلى جنب مع مراتب الوجود ، فالسالك يبدأ طريقه بعالم الحس والمادة إلى عالم المثال ثم يتجاوزه بعد ذلك إلى عالم النور العقلي .
ولكن قد ندخل في خلاف إذا ما قارنا بين تلك النظرة الفلسفية للمعرفة الصوفية وبين غيرهم من المتصوفة الوجدانيين القائلين بعجز العقل عن إدراك الله لأن الله لا يرتقي إليه الفكر فالمنطق لا يجاوز المحدود ، وإنما تتم هذه المعرفة الإشراقية بواسطة القلب وهو ما أصطلح على تسميته بالنفس الناطقة ووظيفته في الغالب الإدراك والتقبل ، فإذا إستنار القلب بنور الإيمان يصبح مرآة تتجلى فيها المعارف الإلهية ، ثم تأتي الروح باعتبارها سر من أسرار القلب بحث تدرك مالا طاقة للعقول على إدراكه ، أما النفس تعامل هنا كونها لطيفة إلهية تعني الحقيقة والذات الإنسانية أي أنها حميدة روحانية تخالف معناها الفلسفي كونها القوة الغضبية الشهوانية داخل الإنسان . وبالتالي يصبح القلب هو أداة المعرفة بالله وهو بمثابة الحلقة الأساسية في الرابطة الروحية فهو القادر على معرفة الله وأن الروح التي هي أحد أسرار القلب تعشقه وتنجذب إليه .
ولكي نفهم هذا الإختلاف نشير إلى الرسم التالي :
العرفان الصوفي ….العقلانيين الوجدانيين
عالم المادة معرفة حسية عالم المحسوسات الحـواس .
عالم المثل قوة متخيلة عالم الأفكار العقـل .
عالم الأفكار فيض عقلي عالم روحي/باطني القـلب.
وذلك يعني أن المعرفة الصوفية وجدانية أداتها القلب الذي يمثل مرآة يجب أن تتجلى فيها الصفات الإلهية وأن نقاء المرآة القلبية هو منوط مجاهدة الفرد أولاً ثم الفضل الإلهي نتيجة الفيض الرباني . وكذلك فإننا نجد مفارقة بين هؤلاء المتصوفة الذين يقولون بالمعرفة الكشفية التي أساسها صفاء السريرة نافين أي معرفة حسية وعقلية ، وبين آخرين يؤسسون معرفتهم الاشراقية في كون الحقائق تتجلى من العقل الفعال واهب الصور ولا تحصل إلا بفيض منه ، فهي إشراقات تنزل من هذا العالم الأعلى على تلك النفس العاقلة لدى من أستطاع أن ينمى قواه المدركة فيتحقق له الاتصال بنور الأنوار.
ولكن إذا ما حاولنا الربط بين النظرتين قد نجد أنهما ليسا مختلفتين تماماً ، وذلك ليس من باب التوفيق بينهما وإنما فقط محاولة للإستنتاج ، فإن كل أداة لها عالمها الخاص بما يتوافق مع قدرتها على الإدراك ، وقد سبق أن أشرنا إلى أن العقل هنا ليس بمعناه التقليدي فهو يخضع لنوع من الرقي الإدراكي الذي يتوافق مع السمو الروحي لدى الفرد ، وأن الأدوات المعرفية من شأنها أن تحيط الإنسان بالمشاهدات الوجودية المختلفة والتي لا يقدر كل إنسان على الالمام بها جميعاً ، فهناك من الحقائق الموجودة في الكون وتعجز عنها الحواس إلا أنها ترتقي في تجريدها إلى العقل لتتكون تلك المعرفة العقلية التجريبية فيتشكل ذلك العقل بالقوة ، ثم تأتي تلك المرحلة الأسمى من خلال درجة أعلى من التجريد وإدراك قدر أكبر من الحقائق فيتشكل العقل بالفعل ، وإذا ما وصل الإنسان إلى ذلك الإشراق القلبي بنور الإله تجلت له معرفة يقينية تنعكس في العقل المستفاد المتصل بالعقل الفعال بشكل مباشر . أي أن العقل يعتبر بمثابة الآلة البشرية القادرة على تحويل المشاهدات والمعلومات من العوالم المختلفة إلى مدركات من خلال التجريد ويرتقي بها إلى درجة العلمية ، ومن هنا فإننا نلاحظ وجود المتصوفة الفلاسفة وإنعكاس الحضور الروحي في كتاباتهم وفلسفتهم العقلية بما يسمح بنوع من المحاجة العقلية بينهم وبين غيرهم من الفلاسفة فتصبح يقينية تلك الحقائق مرتبطة بما تحققه من أدلة وبراهين عقلية ، وإن كان من الضروري أن نقر كذلك بأنه ليس كل ما يتجلي ويدرك بواسطة القلب يمكن أن يدرك إلى كلمات وبراهين عقلية بواسطة تلك القوة الناطقة ، فهناك من الفيوضات التي تأبى هذا التأويل والبرهان العقلي لذا دائما يؤكد المتصوفة على صعوبة التعبير لكننا كذلك نلمس بعدها الروحاني في آرائهم وكتاباتهم .
ويذهب إقبال في كتابه “تجديد الفكر الديني” إلى إقرار تلك الحقيقة قائلاً : “إن الرأي القائل بأن العقل في جوهره متناه لا يقدر على إدراك غير المتناهي رأي ينهض على تصور خاطئ لحركة العقل في تحصيل المعرفة ، فالفكر من حيث طبيعته ليس قاصراً معطلاً بل هو متحرك فعال يكشف عما فيه من لانهائية مثله مثل الحبة التي تحمل في طياتها من أول الأمر وحدة الشجرة الكاملة على أنها حقيقة ماثلة ، وهذه الوحدة أو الكل هي نوع من اللوح المحفوظ يشتمل على جميع إمكانيات المعرفة التي تتعين بعد على انها حقيقة ماثلة تظهر في سلسلة من التصورات المتناهية ” .
لكن لا يمكن أن يتوقف الحديث في الأدوات المعرفية عند هذا الحد دون أن نتطرق إلى أداة هامة لا يمكن إغفالها وهي الوحي .. ففي ظل أننا نتحدث عن تصوف إنساني يوجد في الأديان المختلفة ومع الإقرار بإختلاف طبيعة الوحي فيها فإنه يجدر أن نبحث عن دوره داخل هذا النموذج الصوفي خاصة أن هناك أديان لا يوجد فيها مثل هذه الأداة . تسعى دراسات أسلمة العلوم الإجتماعية إلى التأكيد على أهمية الوحي ضمن المصادر المعرفية التي تجعلنا قادرين على فهم أصل الحياة من خلال الفهم الدقيق للأديان المنزلة ، فهو الأداة التي جاءت من المصدر الإلهي الأعلى لتقويم العالم البشري ، فهي تعتقد أنه ليس ثمة تعارض بين العلم والدين ، وتتمركز أهمية الوحي في العلوم الإجتماعية من خلال مقدرته على صياغة قوانين عامة تحدث بمقتضاها الظواهر فالقرآن يتحدث عن وقائع وأحداث مختلفة إذا حللناها أدركنا أن مضمونها وليس شكلها قابل للتكرار والاطراد ووجود علاقات سببية ومنطقية بين هذه الظواهر ، وكذلك فللوحي وظيفة أخلاقية وإجتماعية هامة أنه يدعو إلى فطرة الخير وصلاح الانسان والاستقامة في الفكر والعمل ، لكن العالم الاجتماعي لا يستطيع أن يسلم بالوحي والرسل في نظرياته لأن كما أوضحنا هناك بعض الديانات تخلو من الوحي والرسل ، لكن إذا ما نظرنا إلى هذا النموذج نجده يبحث في العلل الباطنية للظواهر عامة وللكتابين المقروء والمرئي على السواء ، فإذا كنا نؤمن أن الحقيقة الجوهرية الكامنة في الوجود واحدة فإنه بالضرورة جميع الطرق تؤدي إليها في النهاية ، فحتى ملاحظتنا للطبيعة هي في الحقيقة سعي وراء نوع من الاتصال بالذات المطلقة ، وبالتالي فهو يعطي بعد أعمق للوحي وللعقائد بل للمارسات الإنسانية عامة فعلى سبيل المثال الصلاة هي أحد أحوال الاتصال بالله وكذلك التأمل والنظر بل والبحث العقلي ، وفيما يتعلق بالنصوص الدينية فهو يبحث عن مغزاها ومضمونها الفلسفي .. فعلى عكس تلك الدراسات التي تأخذ بالسرد الظاهري للروايات والقصص كونها مصدر تاريخي نجد الإشراق الذي يسعى لمعرفة هذا المغزى ، فيعمد إقبال في كتابه إلى عقد مقارنة بين العهد القديم والقرآن الكريم فيما يتعلق بالنظرة إلى الطبيعة البشرية ووجود الإنسان ووجد أن هذه القصة لا تهدف إلى هذا الهدف الظاهري السردي لظهور الإنسان على الكوكب وانما إلى ارتقائه من الشهوات الغريزية إلى حرية الارادة وإدراك الوعي الذاتي .
الفصل الثالث :
الثورة وإعادة التأمل الفلسفي في ضوء النموذج الصوفي:
لعله منذ الوهلة الأولى من الإطلاع على عنوان هذا البحث يتبادر إلى الذهن سؤال ملح حول وضع الثورة وكيفية تناولها في ضوء أزمة العلوم الاجتماعية ، وبعد أن فصلنا في الصفحات السابقة أسباب هذه الأزمة ونتائجها وشرحنا في طبيعة التصوف وخصائصه ، علينا أن ننظر الآن في علاقته بالثورة وكيف يمكن أن يلعب دوراً في إستكمال حلقاتها ، وبداية يجدر بنا أن نشير إلى كون الثورة هنا لا تعني ذلك المفهوم الذي يشير إلى التغيير النخبوي والنظام السياسي الرؤية الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية ، إنما الثورة هي إشارة إلى تلك اللحظة الفارقة التي تصبح فيها جميع مسلمات المجتمع السابقة موضع التساؤل حتى أنها تمتد إلى إعادة النظر في الإنتاج العقلي بل وأدوات المعرفة ، أي في بنية العلوم وفلسفتها مما يؤدي إلى إحداث ثورة حقيقية . ويصبح التساؤل هنا حول هذه المراجعة الفكرية والمعرفية ، فنذكر أنها ليست المراجعة السبية القائمة على التشكيك أو الإسقاط للمسلمات العقلية .
وكذا فإن الثورة عندما تقوم فإنها تقر ضمناَ رفض مجموع المواطنين بالنظام السياسي السائد وما يقوم به من سلبيات ويسوده من فساد ، لكنها في مقابل ذلك قد لا تملك بالضرورة صورة لذلك المجتمع الجديد الذي تسعى إلى بنائه وهو الأمر الذي يتوقف عليه نجاح الثورة بمعناها الأشمل ، والذي يشير إلى كونها إعادة لبناء العالم الإنساني ، وهو ما تنتظره الجماهير أن تقوم به النخبة المثقفة وتقدمه علومهم وخاصة الاجتماعية ، ونظراً لإخفاق هذه العلوم في إستيعاب المشهد منذ البداية فإنه يبدو من الصعب أن تتمكن من لعب دوراً فيه ، مما أفقدها الهيبة والريادة ، وإننا إن أردنا أن نبحث في جذور هذه الأزمة إنما نجدها في فلسفة هذه العلوم ، فبعد أن قامت الوضعية بالربط بين العالمين الاجتماعي والطبيعي وقصرت البحث على المشاهدة والحس تلاشت أي محاولات للتأمل العقلي ، وأضحت الفلسفة مجرد تفكير في الوقائع دون أي مضمون قيمي أو أخلاقي ، مما نزع عن تلك العلوم أي قدرة على توجيه مسار المجتمع ، فعلوماً لا تهتم إلا بالوقائع تصنع بشراً لا يعرفون إلا الوقائع .
وفي ضوء تأكيدنا على أهمية تلك اللحظة التي يتوقف عليها شكل المجتمع وبنائه ، فإننا نكون أمام حاجة ملحة إلى إعادة النظر إلى القاعدة الفلسفية التي تقوم عليها هذه العلوم ، وبالنظر إلى التصوف نجده بما يشتمل عليه من نظريات ومفاهيم قادر على أن يعيد الربط بين الواقع بعلاقاته ومساراته وتعقيداته وبين الغيب بثوابته ومطلقاته ، ويقدم إطاراً دافعاَ إلى مزيد من البحث والتأمل ، ولا يسعنا هنا أن نتناول المزيد من النظريات والمفاهيم إلا أنه بالامكان أن نركز على رؤية هذا النموذج للانسان الذي هو محور الاهتمام للعلوم الإنسانية والإجتماعية والسياسية أيضاَ ، ومن ثم نتناول نظرية الإنسان الكامل بما تقدمه من رؤية لإصلاح المجتمع وتقويمه ، وهي رؤية شاملة تبدأ من الإنسان بالمعنى المطلق لتمتد بالضرورة إلى الفرد ثم المواطن لتشمل بعد مجموع المواطنين ، قتنال من السلطة إما بتأكيد الشعب لرغبتهم في الصلاح أو بتأثرهم بهذا المنهج ذاته ، فهي نظرية تربوية شاملة ، قد نقول أنها لا تسعى إلى هذا المجتمع الكامل يقيناً ، لكنها تحاول الاقتراب منه .
ومن ثم يتيح هذا النموذج نوعاً من الإثراء المزدوج ، أحدهم على الجانب العلمي من خلال دعوته لإعادة الربط بين الغيبي والواقعي وإعطاء أهمية للجانب الواقعي والوجداني والشعوري والديني في الانسانيات ، والآخر على الجانب الحركي من خلال تصحيح مسار النخبة والارتقاء بالمستوى الأخلاقي قي المجتمع . لذلك فإن هذا الفصل سيدور حول نقاط أساسية كالتالي :
أولاً : الفلسفة والتصوف
ثانياً : الإنسان الكامل في الفكر الصوفي
ثالثاً : الثورة في التراث الإسلامي الصوفي
المبحث الأول : الفلسفة والتصوف “من التقرير إلى التغيير”:
من المسلم به أن الواقع هو نقطة البداية الأولى لأي فلسفة أو فكر ، فإن الفيلسوف حين يتحدث عن العلل البسيطة للظواهر أو يحاول التوصل إلى الماهيات المجردة فإنه لا يسعى إلى التأمل الخالص أو إكتساب الحقائق لذاتها ، إنما لأنه يرى وجود ضرورة ملحة تستدعي هذا التأمل بما ينعكس على الواقع من جديد ، أي أن الفلسفة كما هي نتاج للواقع وظروفه فإنها كذلك تسعى إلى تغيير هذا الواقع وليس التعامل معه وتبريره فحسب ، هذا الدافع للتغيير لدى الفيلسوف إنما يترجم في شكل بناء خيالي للواقع المعاش والذي يجسد فيه المسافة بين القائم الفعلي وبين المثال المأمول ، ويعتبر أن هذا النموذج هو الصورة الكاملة لما يجب أن يكون عليه هذا الأول ، فتتجلى تلك المثالية كدعوة حقيقية نحو التغيير .
إلا أن الفلسفة ومنذ سيادة النزعة الوضعية استسلمت إلى التراجع في هذا الدور لتقتصر في مهمتها على تبرير الأوضاع السائدة ، أي أنها عملت بأدواتها الاختزالية المختلفة إلى تقويض هذا الفكر التأملي المثالي ورفض تلك الصورة اليوتوبية الخيالية التي تتضمن غالباً بعداً قيمياً ، والتصوف بأبعاده القيمية الأخلاقية قد يكون قادراً على إعادة هذا النوع من التفكير لما له من رؤية خاصة تجاه الكون والوجود والإنسان ، وكذلك بما يحمله من تصور عن إمكانية الوصول إلى السمو الروحي بما يحقق الكمال الإنساني .
وأصبح البعض يرى في الأبحاث الاجتماعية ودراسة الانسانيات مجرد بحث لتحليل وتفسير السلوك وطبيعة العلاقات دون التوجيه والترشيد ، وهو الأمر الذي حاول الاجتماعيون كثيراً إقناع أنفسهم به خاصة في تعاملهم مع الثورة ، ذلك على الرغم من من التأكيد على أن الممارسة إنما هي محض نتاج رؤية فلسفية معينة ، حيث ينظر إليها كونها “بحث تأملي في المبادئ الأولية التي ينبني عليها النشاط العملي ، وهي تمارس على مستويات متباينة ومن مداخل متضاربة في بعض الأحيان ، وقد أدى هذا التباين والتضارب إلى الاعتقاد بأن طبيعة الفكر ما هي إلا جرد إنعكاس للواقع ” .
وعند تعريف الفلسفة يمكننا أن نجد العديد من التعريفات ، أهمها الذي يقترحه ليوشتراوس أثناء محاولته لفهم طبيعة الفلسفة السياسية ، ففي مقال له بعنوان “ماذا الذي يمكن تعلمه من الفلسفة السياسية؟” يعرفها بأنها تلك المحاولة الحقيقية لمعرفة طبيعة الأشياء ، حيث يتساءل بداية ما الذي تستهدف الفلسفة معرفته على وجه التحديد ؟ ويرى شتراوس أنها بحث في طبيعة الأشياء ، وفي تطبيقه على الفلسفة السياسية محور بحثه الأساسي وجد أنه من الضروري معرفة طبيعة الأشياء السياسية الذي يعد شرطاً ضرورياً للتفلسف إلا أنه ليس كافياً ، ذلك لأن الفلسفة لا تستهدف فقط فهم طبيعة الأشياء كما هي إنما تتعداه لتكون رؤية حول الصورة المثلى لما يجب أن تكون عليه ، وهو هدف لا يعد ضرباً من ضروب التأمل الخالص ، إنما نتاج ضرورة ملحة يفرضها الواقع ، فحتى القادة السياسيين في ممارستهم العملية إنما ينطلقون من تصوراتهم عن هذا المجتمع الفاضل أو النظام الأمثل .
وهكذا يعتبر الواقع المعاش بداية الفلسفة باعتبار أنه ينطوي دائماً على توجيه ضمني نحو التعرف على طبيعة النموذج أو المجتمع الصالح الذي هو الخير الأقصى .
والتعريف السابق يتضمن مجموعة من العناصر المكونة للفلسفة كالتالي :
– أن الفلسفة نمط من المعرفة
– التعرف على طبيعة الأشياء التي تدور حولها هذه المعرفة
– وضع معايير للنموذج الفاضل
أي أن الفلسفة بوجه عام ما هي إلا أحد ألوان المعرفة تشبه في ذلك باقي أنواع العلوم ، بل هي المعرفة التي تمثل قاعدة لبناء هذه العلوم ، وأن الفيلسوف عندما يسعى لهذه المعرفة في محاولة منه للتعرف على جوهر كل الأشياء من حوله بل ومعرفة علاقاتها بمكونات الكون حولها ، فالفيلسوف الحقيقي هو من يهدف الوصول إلى جوهر الشئ في إطار علاقته بالكل الأشمل .
وفي إطار موضوع تلك الدراسة الذي يبحث في المعرفة المتعلقة بالإجتماعيات أو الانسانيات ، لابد من تحديد طبيعة هذه المعرفة أو بمعنى أدق الموضوعات التي تتناولها ، ونذكر أن تلك المعرفة هي أرقى أنواع المعارف لأنها تتعامل مع أعقد الظواهر وأهمها ، فهي تتعامل مع الانسان وعلاقته بالاخرين وبالمجتمع من حوله بل وبمكونات الكون بمعناها الأعمق ، أي أننا نبحث في الخير للانسان وسعادته ونسعى إلى بناء تلك الصورة التي تحقق إكتماله أو بمعنى أدق عن الانسان الكامل – كما سنرى بعد ذلك – بما يحقق العنصر الثالث من الفلسفة .
ومن الأهمية ونحن نتعرف على طبيعة المعرفة الاجتماعية أن نذكر التقسيم للعلوم وتحديد موقع العلوم الاجتماعية منها ، ويذكر شتراوس هذا التقسيم التقليدي ما بين العلوم النظرية وأخرى عملية ، وهو تقسيم منافي أو مغاير لما بات عليه ظننا الحالي في العلوم ، بحيث تشمل العلوم النظرية : الرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة وجميعها تقوم على مبدأ الضرورة ، في مقابل العملية التي تشمل : السياسة والأخلاق والاقتصاد ، وموضوعها الإرادة أي أنها تقوم على مبدأ الاختيار . وبالتالي فإننا لكي نفهم طبيعة هذه المعرفة لابد ان نردها إلى هذا التقسيم حتى يتثنى لنا أن نفهم ماهيتها بعيداً عن التشويه المفتعل والناتج عن ربطها بالعلوم النظرية ، ويؤكد شتراوس كذلك على أن العلوم الطبيعية وإن جاز لها أن تستغني عن الأحكام القيمية وتستبدلها بعبارات وضعية ، فإنه لا غنى عنها في مجالات البحث السياسي والاجتماعي ، فالوضعيون يرفضون القيمة إيماناً بعدم وجودها أصلاً وإستحالة الوصول إلى معنى مطلق للخير ، فإن شتراوس على النقيض يرى أن القيم المطلقة أمر تؤكده الأحكام الفطرية للانسان في كل زمان ومكان ، فالانسان بطبيعته الفطرية يميل إلى الخير ويثور على الشر ويرفضه ، بل أنه في ميله الى الخيرية لا يتوقف عند حد بل أن نزوعه نحو الخطأ الكامن على شئ من الشر أحياناً يجعله يهدف إلى المزيد من الخير فلا يتوقف سعيه إليه أبداً .
يبقى لنا أن نبحث في أهمية هذا النمط المثالي من التفكير وكيف يمكن أن يعيد الروح إلى الفلسفة روح العلم وكيف يمكن للتصوف أن يلعب دوراً في ذلك ؟ كل هذا يمكن تحديده من خلال التعرف على أنواع الفلسفة وتحديد نوع الفكر الصوفي منها .
أولاً : الوضعية وأزمة الفلسفة
لكي نتمكن من الوصول إلى تلمس أثر النمط الوضعي المادي في التفكير على طبيعة الفلسفة ، يمكننا أن نطرح تصور شتراوس لتصنيف الفلسفة في ضوء حديثه عن تطور الفلسفة السياسية حتى بلغت هذا العصر ، ويفرق هنا بين نوعين من الفلسفة السياسية الكلاسيكية أو التقليدية والفلسفة الحديثة :
– الفلسفة التقليدية : تعتبر اليوتوبيا روح الفلسفة الكلاسيكية والتي تتمثل في كتابات أفلاطون وأرسطو ، وتهدف إلى إكتشاف دستور ونظام للحكم وفق نظام طبيعي أي الاتفاق مع الطبيعة البشرية ، ومفهوم الطبيعة عند اليونان يقيم فاصل بين المثال والواقع ، أي أن المثال يبقى مجرد أمنية لا تتحقق في الواقع إلا صدفة لكن رغم ذلك تظل هناك محاولات للوصول إلى أقرب صورة ، ففي الوقت الذي نؤمن فيه باستحالة تحقيق الجمهورية نؤمن كذلك بامكانية إحداث تغييرات محدودة في الواقع في الطريق إلى المثال البعيد . أي أن الوضع يشبه متصل ذو حدين يقع الواقع عند جانبه الأيسر والمثال عند أقصى اليمين ، وفي المحاولة للاقتراب من هذا الحد يتم إحداث تغييرات ، وتبقى الغاية ليست الوصول إلى الحد الأقصى وإنما الانتقال إلى الجانب الأيمن من المتصل .
ومن هنا يتميز هذا النوع من التفكير المثالي بالعملية أو التطبيقية ، فهذه اليوتوبيا الخيالية لا تهدف مجرد التأمل النظري أو حتى وضع تنبوءات تتعلق بالمسار المستقبلي للواقع وإنما تستهدف محاولة تغييره بشكل عملي ، أما السمة الثانية تتمثل في كونها فلسفة غير خادعة أي لا توهمنا بإنزال المثال كما هو على الواقع ، كما أنها تحافظ على المسافة بين المثال والواقع ذاته ولا يمكن أن تسقط إلا بالصدفة وتلك هي السمة الثالثة .
– الفلسفة الحديثة : تخللت هذه المرحلة للفلسفة ثلاث موجات ، تبدأ الموجة الأولى منها مع أعمال ميكافيلي وتستمر حتى القرن الثامن عشر ، لتبدأ الموجة الثانية وتحقق ذروتها مع فكر كانط وهيجل إلى أن جاء نيتشه بانتقاداته التي وجهها إلى المثالية الألمانية ، ثم بدأت الموجة الثالثة التي لاتزال قائمة حتى الآن .
ويتسم هذا النوع من الفلسفة بالرفض للتصوف الكلاسيكي للتأمل الفلسفي ، ويعد ميكافيلي أول من قدم هذا النقد وقد حذا حذوه جميع المحدثين في رفضهم لليوتوبيا التقليدية في أنهم إعتمدوا على ما ينبغي أن يفعله الانسان إلى لا ما يفعله في الواقع ، مما جعلهم يقتصرون في فكرهم على موضوع الفضيلة والأخلاق لا البحث في الحقيقة الواقعة وهذا الأمر الذي خلق تلك الصعوبة في التنفيذ . ومن خلال هذا النقد تم الانقلاب على هذا النمط المثالي والتحول لدراسة ما هو كائن وإصلاح الواقع .
وبعد أن إكتمل النموذج الوضعي في صورته المعاصرة أصبح يشكل خطراً على الفلسفة ، وهي في رأي شتراوس تشكل مع التاريخية جوهر أزمة العصر والتي تتكون من جانبين : أحدهما نظري متمثل في الانهيار الذي أصاب الفلسفة نتيجة للصعود الوضعي والتاريخي ، الآخر عملي وهو أن العالم الغربي لم يعد يدرك عن يقين ماهية أهدافه .
فقد أصبح أنصار الوضعية في القرن العشرين يرفضون أن يستهدف البحث التوصل الى القيم ويقولون بضرورة أن يكتفي بدراسة الوقائع وهو الأمر الذي لم يعد يقتصر على الدراسات السياسية فقط وانما انصرف إلى سائر العلوم الانسانية ، بينما الاتجاه الثاني لم يتحول مما ينبغي أن يكون لدراسة ما هو كائن كما في الاتجاه السابق ، بل في تصوره أن العمل على استكشاف ما هو متحقق فعلا في لحظة تاريخية معينة ، فالانسان لا يمكن فهمه إلا في ضوء التاريخ .
وفي ضوء ملامح هذه الأزمة ، يدعو شتراوس إلى ضرورة العمل على إنتشال الفلسفة من سقطتها وإيقافها على قدميها من جديد .
ثانياً : الفلسفة في الفكر الصوفي
إن الإنهيار الواضح في الفلسفة الحديثة يستلزم نوعاً من العودة إلى الفلسفة الكلاسيكية ، من خلال إعادة إكتشاف للكتابات بالباطنية أي تقول في باطنها غير ما يقوله ظاهرها فلا يفهمها إلا خاصة الخاصة ، وهو ما يتميز به الكتابات الصوفية كما رأينا في الخصائص .
ولاشك في أن الفكر الصوفي قادر على أن يعيد الجانب القيمي من جديد والذي أودت به الفلسفة الوضعية ، كما أنه يحقق ميزة أخرى هامة تتوافق مع دعوة شتراوس في العودة الى النمط اليوتوبي الكلاسيكي وفي نفس الوقت قادر على أن يتجاوز ذلك التخوف الذي أعلن عنه أثناء العودة ذاتها والذي يتمثل في الفرق بين الكتابات الكلاسيكية وبين الواقع الحديث ، بينما التصوف استطاع أن يطور نفسه مع الوقت فإننا لسنا في حاجة للرجوع للخلف بقدر ما نحتاج أن نكتشف إلى ما موجود بالفعل ، ونشير إلى وجود عاملين هامين ساعدا على إحتفاظ الفكر الصوفي بجانبه القيمي اليوتوبي : أولهما هو الرمزية في الكتابات الصوفية بحيث يصبح من الصعوبة الوصول إلى المعنى الحقيقي للعبارات ، والثاني هو بعد التصوف بالاحتكاك المباشر بالسياسة فقد امتدت الرمزية في الكتابات السياسية ، واتخذ المتصوف مدخلاً أخلاقياً في تناول الأمور السياسية ذاتها .
ويمكن أن نضع بداية بعض الملاحظات على الفلسفة في ظل الفكر الصوفي والتي سوف نشاهد تبعاتها في البمحث القادم عند تناول نظرية الانسان الكامل ، وبداية هذه الملاحظات أنها تأتي إنعكاساً للأدوات المعرفية التي تعتمد على الكشف والإلهام وفق نظرية الفيض الإلهي على العقل الفعال أو القلب ، أي أنها تأتي بتوفيق إلهي خارجي لذا تكون نتاج هذه الفلسفة أنها تضع مثالاً مجاوزاً للزمان والمكان وهو ما يتجلى في الحديث عن الاتحاد ووحدة الوجود ، وإن كنا في هذا الصدد لا نسعى إلى دراسة هذه النظريات ولكن فقط نوضح أثرها على الفكر والتأمل ، ومع الادراك بتنزه وتقديس الإله فإنه لا يمكن الاتحاد الكامل معه بحيث يصبحان شيئاً متطابقاً ، ذا فإنه في ذلك إقرار بعدم إمكانية تطبيق المثال بشكل كامل وانما فقط الاقتراب إليه من خلال إعلاء البعد الأخلاقي في نفوس البشر مما ينعكس على سلوكهم وعلاقاتهم .
المبحث الثاني : الإنسان الكامل في الفكر الصوفي:
توقفنا في السابق عند دعوة شتراوس إلى ضرورة العودة إلى التأمل المثالي التقليدي باعتبار أنه السبيل إلى الخروج من الأزمة التي أدت إلى الوضعية وسيادتها على العلوم الاجتماعية بعد تقويض بنية الفلسفة التأملية مما أدى إلى عجزها عن ممارسة الدور القيمي على المستوى الانساني الأمر الذي امتد كذلك الى المستوى العلمي ، وقد أوضحنا كذلك في إشارة سريعة كيف يمكن للتصوف أن يلعب دور في هذه الصحوة وكذا مميزاته عن غيره من أنماط الفكر .
ويتفق الفكر الصوفي مع تعريف الفلسفة عند شتراوس وفقاً لرؤية سقراط والتي تدور حول مسألة الكمال ، لأن طبيعة أي شئ لا تتجلى إلا من خلال إكتماله ، ومن ثم ذهب مفكرو اليونان إلى أن طبيعة الانسان تتجلي في إكتمال روحه ، والروحي هي النفس الانسانية بالنطق والعقل ، وعلى هذا فإن الخير بالنسبة للانسان هو أن يحيا حياة عقلية بمعنى أن يسود عقله باقي مكوناته وأن تكون أفعاله صادرة عن بصيرة عقلية ، وبالقياس على نطاق المجتمع السياسي ، فإن فضيلته تتمثل في أن يسوده العقل بمعنى أن يتولى الحكم فيه أولئك الذين أوتوا الحكمة بحيث يكون هؤلاء الحكماء في المجتمع بمنزلة العقل من الانسان الفرد وهذا هو العدل والخير . وفي حين أتفق المتصوفة مع اليونان في تعريف الفلسفة ونمط التفكير أتفقوا كذلك في التأكيد على دور الروح وكيفية الوصول إلى الكمال المنشود ، فكمال الانسان يتأتي باكتمال روحه ، واكتمال الروح يكون بسموها وتهذيبها واتصالها بالحق المطلق .
أولاً : الانسان في الفكر الصوفي
ينطوي جوهر الفلسفة الصوفية على إيمان عميق بالإنسان وبفاعليته وقدرته كإنسان . وينطلق هذا الجوهر من التأكيد على قدرة العبد (الفرد ، الإنسان) على الوصول إلى الله ، والاتصال به ، دون وسطاء من وكلاء أو شيوخ أو رجال دين ، حيث أصبحت العلاقة ما بين العابد والمعبود علاقة مباشرة ، ينكشف المعبود للعابد بلا وكيل أو حجاب ، وأصبح بإمكان الفرد أن يرى بنفسه كيف أن الله عادل ، ورحيم ، وجميل ، فسقطت تلك المؤسسية الكهنوتية الوسيطة ، وكشف المتصوفة أن هذا الظلم والقسوة وغيرها من الممارسات على الأرض ليست من صنع الله ، وانما من صنع البشر ، وأن فطرة الإنسان التي فطره الله عليها ترفض بالضرورة مثل تلك الممارسات .
وتتبنى الصوفية رؤية خاصة حول الإنسان ، يمكن تلخيصها في أنها ترى فيه كيان ووجود قابل لأن يصطنع ويبنى لبنة لبنة ، كما ينمو الجسد ، فإن الروح قابلة للسمو وذلك بتعهدها بالرعاية ، بل يعتبرون أن محور عملية البناء في الوجود بأكمله هو البناء الانساني ، وذلك لأن الوظائف العمرانية الكبرى إنما مركزها ومحورها الاساسي هو ذلك الانسان ، فالوظائف الثلاثة العظمى كالخلافة والعمارة والعبادة ، يكون الانسان فيها القاعدة والمحور ، ومن ثم ليس غريباً أن ينصب إهتمام المتصوفة على الانسان بغية بنائه .
وتتجلى مهمة بناء الإنسان في الروح ، فالانسان روح وجسد متكاملان ، فيكون أساس البناء منصب على الروح وتهذيب النفس ، فالروح هي أساس التكريم مناط التغيير أهم ما يقاس به الانسان الفرد والجماعة الانسانية في مساعيها الحضارية هو إرثها الروحي . لذا تأتي معظم دعوات الإصلاح مرتكزة على الدعوة للتربية وإعلاء شأن العقل الإنساني إلى أسمى مراتبه ، حتى أنهم يعرفون التصوف ذاته كونه تقوى وصفاء ، وأنه يرمي بقيمه إلى بناء الانسان وإعلائه إلى مستوى عقيدته ، فيكون فاعلاً حضارياً في خلافته لربه وعبادته لخالقه وتعميره لأرضه ، أي أنه يهدف إلى التأسيس للأخلاق باعتبارها جوهر الحضارة .
ويفرق المتصوفة بين مراتب الانسان التي أخسها الانسان الحيوان وأرقاها الانسان الكامل ، وهو فرق في الدرجة لا في النوع ، ويفرق ابن عربي أسباب النقص عند الانسان الحيوان بأن الانسان بشكل عام يجمع في خلقته كل حقائق العالم ، لذا فمتى ظهر النقص في العالم ، فمن الضروري أن يظهر أولاً في الإنسان ، فكان الانسان الحيوان مرآة العالم الناقص ، وكذا نسبة الكمال إلى الانسان الكامل .
ويمكننا أن نستنتج أن الانسان الأعلى في الفكر الصوفي لا يخرج عن كونه برزخ بين الوجود والامكان ، والمرآة الجامعة بين صفات القدم والحدثان ، والواسطة بين الحق والخلق .
ثانياً : نظرية الانسان الكامل
يعد الانسان الكامل عند صوفية الاسلام أعلى مقامات التمكين التي يمكن أن يصل إليها السالك ، وأنه إذا وصل إليها الصوفي كانت نفسه النفس الكاملة ، وكان نور الحق العين التي يرى بها ، وهنا فقط تصح له الوراثة . ومن أشهر المتصوفة الذين تناولوا هذا المقام الصوفي كل من : عبد الكريم الجيلي ومحي الدين ابن عربي وشهاب الدين السهروردي والذي أطلق عليه “الحكيم المتأله” وعند ابن الفارض باسم “القطب” .
ويعرف ابن عربي هذا الكامل في قوله ” الإنسان الكامل هو العارف الذي تمكن من إدراك إنسانيته الباطنة، أي إدراك أنه المظهر الوجودي لله الذي جمعت فيه من جهة صفات العالم، ومن جهة أخرى صفات الله ” . فهو الذي أدرك ذاته إدراكاً تاماً ، ومن ثم أصبح وارثاً لسر النبوة، وما سر النبوة عنده سوى إدراك الحقيقة الوجودية المطلقة ، التي وصلها النبي بالعناية والمدد الإلهي . ويقول الششتري مؤكداً على ذلك :
فعسى نبلغ الأماني بوصولي لكمالي ،
وعليــك هـو إتكــالي ،
قبل أن تأتي المنيــــا.”
ويذهب عبد الكريم الجيلي في قصيدة شبسري إلى تعريفه بأنه ذلك الذي يسلك الطريق المزدوج ويخترقه نازلاً إلى عالم الكثرة والتعدد في الظواهر والذنوب حتى يبلغ أعمق عمائقه ثم صاعداً إلى النور والوحدة الالهية ، حيث يقول في قصيدته : “ألا فلتعلم إذن من ذا الذي أتى الوجود وقد ولد ليكون الانسان الكامل ، بدأ يتجلى في القالب ، ثم وهبته روح الحياة قوة الاستعداد ، وتلقى من لدن القدير حرية الحركة ، فرفعه الله إلى مكانة حامل الارادة ، وفي الطفولة الكشف له إدراك العالم ، وتحقق فيه بالفعل همس الكون ، فلما ترتبت لديه الجزئيات ، شق الطريق من المركبات الى الكليات ، هنالك تولاه الغضب والشهوات ، وعنها أنبثق البخث والطمع والكبرياء . فتولدت فيه الصفات الذميمة وصار أسوأ من الحيوان والجن والدواب … فإذا ما لقيه نور وارد من روح العالم ، صادر عن فيض الألطاف المنجية أو من إنعكاس برهان (أي نتيجة برهان ودليل عقلي) صار قلبه من أصفياء الخير الالهي ، وعاد ادراج السبيل الذي أتى منه … فإن اتحدت نقطة ابتدائه مع نقطة انتهائه ، لم يبق في مقام القرب من الله الذي وصل إليه مكان لملك أو نبي ” .
وفي فلسفة الششتري يعتبر الكمال وصف مجازي لأن الكامل على الإطلاق هو الله ، فالكمال لا يوجد مطلقاً إلا للكبير المتعال ، ولا يقال كامل إلا “بالإضافة لمن دونه ، وكذلك للناقص ، فلا يصح الكمال إلا لله تعالى ، ولا يوجد في خلقه إلا ناقص” .
فعلى الرغم من إختلاف المتصوفة في لقب ووصف هذا الانسان الكامل بل وصفاته ، إلا أنهم جميعاً أتفقوا كونه الغاية من التصوف وعلى السبيل للوصول إلى تلك الغاية ، والذي يتمثل في السعي نحو الرقي الأخلاقي والسمو الروحي من خلال مجموعة من الرياضات التي تسفر عن تهذيب النفس وفناء البدن ، حتى يصبح الانسان مرآة لنور الحق ، وينال أحد مراتب الكمال الإنساني .
ويذكر المتصوفة مجموعة من الخصائص المميزة لهذا الانسان الكامل أهمها :
1- الانسان الكامل روح العالم ونسبته إليه كنسبة الروح الإنساني إلى البدن ، قبقاؤه ببقائه .
2- أنه موجود على الصورة الالهية ، ومرآة الحق فيرى الحق نفسه فيه .
3- أن الانسان الكامل له جانبان (إلهي وخلقي) .
4- أنه واحد يظهر في كل زمان ومكان ، وأكمل صور ظهوره هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الأنبياء ، ثم الأولياء .
5- كل إنسان يحمل في نفسه القابلية لكي يكون كاملاً .
ونذكر أن الكمال ليس فئة واحدة ، وإنما يذهب أهل التصوف إلى تصنيفهم إلى قسمين رئيسيين : الأول كامل غير مكتمل وهم الأولياء ، والآخر كامل في ذاته مكتمل لغيره وهم الأنبياء عليهم السلام. والكمال والتكميل إما في القوة النظرية أو القوة العملية ، وتتمثل القوة النظرية في معرفة الله ومعرفة حقه ، أما العملية ففي طاعته ، وبالتالي كل من كانت درجاته في هاتين القوتين أعلى كانت درجة كماله بالضرورة أعلى ، أي أنه لا يوجد مقياس أو نهاية تعرف بالكمال وإنما هي بداية لا نهاية لها ، يسعى خلالها الإنسان إلى الوصول لدرجة أعلى .
ويمكننا الآن أن نتساءل عن كيفية بلوغ هذا الكمال الذي يصبح الانسان من خلاله وارثاً لعلوم النبوة ؟
لقد إختلف رأي المتصوفة في هذا الطريق ، فالبعض أخذ بـ “الإرادة” ، فالإنسان هو المسئول عن وضعه ومرتبته وبعمله يحقق وجوده ، فلا كمال ولا نقصان إلا بحسب نظر الإنسان ، فهذا الجانب يرى أن الله قد خص كل إنسان بالقدرة على الوصول لهذا الكمال وهو أمر لا يتحقق إلا بالفعل القائم على العلم ، فبالعلم يستطيع الانسان أن يرتقي بذاته ويخلق منها ذاتاً كاملة ويعلي من شأنها ويحقق حريتها ، ولا يشترط هنا في العلم أن يكون شرعياً فقد يصل الانسان الى معرفة ربه من خلال العلوم الفلسفية او الرياضية ، فمن أي طريق تصل إليه ، وكما يقولون في الطرق الاختلاف وفي المدينة الائتلاف . والبعض الآخر ذهب إلى التأكيد على “الفيض الإلهي” أو “الحكمة الإلهية” الممثلة في العلم اللدني ، حيث أن بلوغ طريق الكمال وتحقيق الانسان لمرتبة القطبية ليست بتداول العلوم المنقولة بل هي هذا العلم اللدني والكشف الرباني وهو ما قال به ابن عربي الذي منع مريديه من تعاطي العلوم من فلسفة وفقه وكلام ، لأنها تجعل حجباً كثيفاً أمامهم لمعرفة حقيقة الوجود ، زعماً بأن الكامل الأمي أفضل من الكامل العالم ، وأن الوارث على الحقيقة لا يكون إلا أمياً . لكن ذهب الششتري رداً على ذلك بقوله أن “الأمية في النبي كمال . وأنزلت الولي المفروض عن درجة الاعتدال ولا يسلم ذلك لغير النبي ، لأنها من المعجزات التي كانت تختص برسول الله ، لئلا يكون للناس على الرسالة حجة” .
ولكن هل يمكن بالفعل تحقيق هذه النظرية في الواقع الفعلي ؟ لا يمكننا أن نصل إلى إجابة حاسمة حول هذا السؤال من خلال الأدبيات الصوفية نظراً للاعتماد على الصور والتشبيهات فضلاً عن كثرة الرموز التعبيرية ، ومن جانب آخر إختلاف التأويل بين المتصوفة وتعبيرهم عن هذه التجارب ، إلا أننا يمكن أن نذهب إلى القول بأن هذا المثال للكمال الانساني لا يمكن أن يتحقق في الواقع على نفس الصورة التي يأمل إليها المتصوفة أنفسهم – خاصة مع الايمان بأن أرقى هذه الدرجات كانت خاتم الأنبياء – وإن تحقق لهم الفناء ، فمن حيث أنهم يصنفون مراتب الكمال الانساني التي يعتبر أعلاها مقاماً هو مقام النبوة ، إلا أنه حتى هذا المقام لم يتمكن من التواصل المباشر بينه وبين الحق ولم يكن تلك المرآة العاكسة بالشكل الكامل والمراد ، إنما توسطهم في ذلك جبريل عليه سلام الذي كان يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن ربه .
وبالقياس على نموذج المدينة الفاضلة التي تتحقق في حال إذا ما قام عليها العقل أو الحاكم الفيلسوف ، وتحوي بداخلها مجموع المواطنين الصالحين ، فإن الانسان الكامل ومن ثم المجتمع الكامل ، الذي تحكمه الروح التي تتسم بالسمو والرقي الأخلاقي الذي يمكن القائم على الأمور بالاتصال بالملكوت وتطبيق الحق البين .
المبحث الثالث : الثورة في التراث الاسلامي الصوفي:
لا يمكن إغفال الحديث عن الثورة في إطار هذا البحث حتى وإن كان يتعرض في جوهره إلى المعرفة العلمية وبنيتها الفلسفية ، بل أن الثورة طالما استحوذت على جانب ليس بالقليل من التفكير الفلسفي ، ونزعم أنها في إطار موضوعنا القائم على الفكر الصوفي تتخذ بعداً أعمق وإهتماماً أوسع ، فالسؤال عن العلاقة بين الثورة والتصوف سؤال قائم ومتجدد ، لا تلبث الألسنة أن تطلقه في كل مراحل التحول خاصة الثورية منها ، وهو ما تكرر بالتبعية في أعقاب الثورات العربية ، وعلى الرغم من إمتناع العقل الصوفي من تقديم إجابة واضحة حاسمة عليه ، إلا أن الفرق الصوفية سرعان ما إنغمست في الحياة السياسية وخرجت من عزلتها رغما عنها في مواجهة للصعود الإسلامي ، لكن هل بالضرورة تعبر هذه الفرق عن موقف التصوف الحقيقي من الثورة ، ولأننا نفرق دائما بين التصوف وبين الفرق الصوفية ، فإنه يجب أن نبحث في موقف التصوف تجاه الثورة .
والأصل أن العلاقة بين التصوف والثورة قديمة قدم نشأته ذاتها ، بل أن التصوف بكسره للأطر التقليدية وتطهير للوجدان وسمو بالروح وانبثاق الحدس يمثل أسمى معاني الثورة ، ويقال أن :الأصل النظري لهذه العلاقة أن كل تصوف فيه لمحة من الثورة ، وكل ثورة فيها لمحة من التصوف ” . ولكن إذا كانت هي تلك الحالة في الثورة على المستوى الروحي فكيف يمكن أن نربط بين الثورة المصرية وبين الفكر الصوفي ؟ في إطار الاجابة على هذا السؤال سنقوم بتناول أهم محاور الثورة في إطار التصوف .
واستطاع حلمي سالم في كتابه “الشعر والتصوف والثورة” أن يؤكد على وجود خمس مناطق مشتركة يلتقي فيها كل من التصوف والثورة ، وهي (الحرية – التمرد على الجمود – التسامح والمواطنة – المساواة – البعد الاجتماعي) ، فلاشك أن الثورة لا تقوم إلا لطلب الحرية والتخلص من قيد الاستبداد والظلم الذي تمارسه السلطة ، تلك الحرية التي تعد كذلك أحد المطالب الأساسية في التجربة الصوفية فهي في جوهرها محاولة للتخلص من الاستبداد المجتمعي والسياسي ، وتتجلى بصورتها الكاملة في الكتابات الصوفية التي تحاول التعبير عن ذلك المطلب بلغة غريبة نابعة من الرغبة في التحرير الذي يطول حتى اللغة والخيال . فالكلمة المفتاحية للتجربة الصوفية تكمن في تلك الكلمة السحرية سواء على مستوى العلاقة ما بين العبد والرب ، أو بين الانسان والعقل ، أو بينه وبين العالم . ولأن التصوف في جوهره ثورة ، فإن التراث الصوفي وحياة المتصوفة تعكس هذا الجوهر بأبعاده المختلفة الاجتماعية والمعرفية والدينية كما في التالي :
أولاً : الثورة في الصوفية
على عكس السائد بأن النزعة الصوفية تعبير عن ظاهرة فردية تنتمي لعالم روحي منفصل عن العالم الواقعي ، إنما هي ظاهرة إجتماعية تشابكت مع المعطيات الحياتية والعلاقات الاجتماعية والأحداث السياسية ، فقد جاءت في بعض الأحيان رداً على الظلم والاستبداد في العصور ، وتكيفت في أحيان أخرى مع طبيعة الأوضاع معلنة المسار السلمي غير المباشر في التغيير .
(1) الثورة الاجتماعية عند الصوفية
وقد أرتبطت الصوفية بالمجال الاجتماعي والسياسي فالأمر على عكس الشائع بأن التصوف يقتضي العزلة ، إنما يدعو إلى الانخراط والاصلاح باعتبار أن إصلاح المجتمع هو الاختبار الحقيقي لمبادئ الصوفية ، وهو الأمر الذي انعكس في التراث الصوفي وأضحى سمة واضحة من سمات الفكر الفلسفي الصوفي ، وهو ما يظهر في القرن الثالث – يطلق عليه بقرن الثورات الاجتماعية – والذي جرت فيه ثلاث حركات كبرى : البابكية ، إنتفاضة الزنج وهبات القرامطة ، تلك الحركات ظهرت مرتدية قناعاً دينياً بحكم أن النسق الذهني المسيطر في هذا الوقت تمثل في سيادة التفكير الديني ، هذا القناع الذي أخفت وراءه أهدافها ونزعاتها الدنيوية ، وقد قدم الحلاج في هذا القرن مثالاً واضحاً عن الارتباط ما بين الثورة والتصوف فقد كان حليفاً سياسياً للانتفاضة الزيدية التي أثارها الزنج كما أتصل بحركة القرامطة ، فأصبحت حياته تتضمن عنصري التمرد : الفلسفي الفقهي (الديني) ، والسياسي الاجتماعي . فعلى المستوى الاجتماعي ثار الحلاج على سلطتي الحكام والأغنياء أو الحكم والمال اللتين تنطويان على أسباب المأساة الإنسانية في نظره ، فثار عليهما حتى أودت الثورة بحياته وتم صلبه .
ومن أهم المتصوفين الاجتماعيين بعد الحلاج هو عبد القادر الكيلاني ، الذي لعب دوراً في الصراع الطبقي ، فقد كان يرى أن أصحاب السلطة لصوص ودعى إلى نهب ثرواتهم وأموالهم وتوزيعها على الفقراء ، فإن السلطة والأموال مصدران للطغيان يوجب معارضتهما دفاعاً عن الخلق والحق ، فتمنى لو أن الدنيا في يده ليطعمها للجياع . كذلك الأمر بالنسبة لشهاب الدين السهروردي الذي تم قتله بعد اتهامه بالهرطقة الدينية والتمرد السياسي .
وبعد تلك الثورات ذات النمط المباشر والتي أودت بحياة أصحابها ، إنحصر نطاق النضال السياسي والاجتماعي الصوفي ليأخذ نمطاً غير مباشر ، معتمداً على السلوك الفردي المعارض كإعلان القطيعة في التعامل مع الحاكم وخدمته ، تحريم الفيض منه ، تحريم منع الأموال عن الفقراء .
(2) الثورة الدينية
إذا كان التصوف الاجتماعي يمثل الجانب العملي فإن التصوف الفقهي الفلسفي يمثل الجانب النظري الذي يدعم دائماً الممارسة الاجتماعية ، وإذا كان التصوف الاجتماعي يتعارض مع سلطتي الحكم والمال ، فإن التصوف الفقهي يتعارض مع سلطة الدين ، وتختلف نظرية الصوفية معرفياً في جانبين أساسيين : الألوهية والنبوة وعلاقة الانسان بهما ، ففي الوقت الذي يذهب فيه الكثيرين إلى إعتبار أن العلاقة بين العابد (الانسان) والمعبود (الله) هي علاقة عبودية جوهرها الترهيب والترغيب ، فإن الصوفية ترى أبعد من ذلك كونها علاقة محبة ، هذا الحب الذي يمثل أساس الوجود بالنسبة لهم .
فيعرف البعض التصوف على هذا المستوى كونه الحب المطلق الذي يتميز به التصوف الحقيقي عن طقوس الزهد الأخرى ، وأن حب الإله يجعل المريد يتحمل الآلام والمصائب التي يبتليه الله بها ليختبر حبه ، بل أن يصبح يتلذذ بها ، فهو الذي يمكن المحب من الاتصال بالحضرة الالهية .
وعلى الجانب الاخر تقع علاقة الانسان بالنبوة التي تمثل في النظرية الصوفية مجرد مقام يمكن للانسان الوصول إليه ، بل أنها في داخلها تنطوي على عدة مقامات أعلاها خاتم النبوة ، لذا أطلق العديد منهم على المقام الصوفي الأسمى لقب النبوة .
(3) الثورة المعرفية
تتأسس النظرية الصوفية في معرفيتها على منهج الذوق الذاتي والحدس الداخلي المتحررين من العقل والنقل ، وذلك لأن المعرفة الصوفية وجدانية أداتها القلب الذي يمثل مرآة يجب أن تتجلى فيها الصفات الإلهية وأن نقاء المرآة القلبية هو منوط مجاهدة الفرد أولاً ثم الفضل الإلهي نتيجة الفيض الرباني .
فهي تثور على المذهب التقليدي القائل بأهمية الحواس كأساس للمعرفة أو حتى تلك التي تعتقد في العقل ، ويؤكد على أن للحواس ميدانها المنحصر في الظواهر الموجود في الكون ولا يمكنها أن ترتقي بنا لمعرفة الحقيقة الباطنة فيه فقط هي تعطي مجموعة مشاهدات للعقل من أجل الاستدلال من خلال طرح مجموعة تساؤلات حوله ، ومن ثم فإن المنهج التجريبي بما فيه من تسليم لنتائج المشاهدات الحسية لا يمكنه سوى تحقيق معلومات وقوانين للعالم الطبيعي لكنه إذا ما إمتد إلى مجالات الوجود بما فيها من تساؤلات وجودية كبرى فإنه يعجز عن تقديم أية نتائج مهمة فقط هي مجرد بيانات ظاهرية مجردة تعطي إحساس متوهم بالوصول إلى العلمية .
وإذا ما تطرقنا في حديثنا إلى العقل نجد أن صورة العقل ليست مساوية لذلك القائم على الاستدلال والتركيب للمشاهدات والاستنباطات الحسية ، فإن العقل في صورته الأولية تلك عاجز عن الوصول إلى الحقائق العليا أو إدراك الله ، إلا أنه يدخل في مراحل للتطور التصاعدي المتدرج حتى يصل إلى درجة الفيض والإلهام ويتم هذا التدرج باتساع معلومات الفرد ، فكلما اتسعت وأوغلت في التجريد كلما اقترب من العالم العلوي ويصبح أهلا لتقبل الأنوار الإلهية وأضحى على إتصال مباشر بالعقل الفعال ، ومعنى ذلك أن المعرفة الانسانية لا يحصلها العقل باجتهاده في الواقع بل هي تتجلى في صورة هبة من العالم الأعلى وهي بذلك تكون معرفة إشراقية حدثية .
ثانياً : التصوف والثورات العربية
شرعت الدراسات التي ظهرت بعد الثورة تتساءل عن دور التصوف ، وذلك بالبحث عن المناطق المشتركة بين الصوفية وبين الثورات الحالية لإثبات أن التصوف في جوهره لا يتعارض مع الثورة وإنما هو في ذاته ثورة بالمعنى الشامل ، ومن ثم إتجهت إلى التأكيد على ثورية أعلام الصوفية ورفضهم للظلم والاستبداد ، وعلى الجانب الاخر ظهرت من الدراسات التي أخذت تطلق من التساؤلات حول تفسير هذا الفكر لقيام الثورات فتوضح أسبابها في ضوء القوانين والسنن الإلهية العمرانية ، إلا أن أياً منهما لم يسأل ماذا يمكن أن يقدمه التصوف في المسيرة الثورية البنائية للمجتمع ؟ أي كيف يمكنه أن يستكمل بعض خطوات الحدث الثوري ؟ وكيف يمكنه أن يقوم بالدور الذي عجزت العلوم ذاتها عن القيام به ؟ .
ونزعم هنا أننا بصدد إشكال مزدوج ، لأننا لا نسعى إلى فهم الثورات في ضوء الفكر الصوفي ومنطلقاته فحسب ، وإنما نربط ما بين التصوف والثورات والعلوم الاجتماعية . وكما سبق وأشرنا في مقدمة هذا الفصل أن الثورة كما في مشروع هوسرل هي بمثابة لحظة كاشفة عن مأزق في البنية الفلسفية للعلم أو كما أشار كون إلى أنها مجرد تعبير عن أزمة في النموذج المعرفي السائد ، فيصبح هذا الحدث ممثلاً في سؤال كبير وملح عن دور العلم ، وبناء على ما بيناه في الصفحات السابقة عن تراجع هذا الدور والزعم بأن التصوف قد تكون له من القدرة على معالجته ومساندة البديل إنطلاقاً من التأكيد على أنه لا يمكن رفض النموذج السائد أو التأكيد على عجزه دون تقديم بديل قادر على أن يقوم بدوره وإلا تضمن ذلك رفضاً شاملاً للعلم ذاته .
والتصوف بما أظهره من قدرة على إعادة التأمل الفلسفي وخلق هذا المثال الكلاسيكي يتمكن من إعادرة الروح إلى العلم ، فهو لم يقتصر على مجرد التحليل والتفسير والوصف للواقع وإنما يمتد إلى توجيه وإرشاده فيصبح له بعداً قيمياً عملياً ودوراً مجتمعيا ً لا يمكن إنكاره ، فهو يقدم النموذج الذي يجب أن تكون عليه المجتمعات وضرورة السعي إليه ، هذا النموذج إنما هو علاج لمشكلات المجتمع كما هي في الواقع ، ويظن البعض أن الفكر الصوفي المثالي إنما يسبح في علياء سماء الخيال لا يمكنه التفاعل على الأرض ، وهو ظن خاطئ ، لأن المثال هنا كما أوضحنا في (الإنسان الكامل) ليس ضرباً من الخيال المعزول عن حقيقة الطبيعة البشرية وإنما هو رؤية لما يمكن أن تكون عليه نتيجة للاستيعاب الشامل لها ، ومن ثم فهو يضع من الآليات والوسائل ما تمكن من تحقيقه أو بمعنى أدق الاقتراب منه . وبهذا الفكر اليوتوبي يستطيع العلوم أن يستعيد دوره المجتمعي من جديد وتعود إليه مهابته في نفوس الشعوب التي لا يهمها كم الإنتاج الفكري والابحاث والدراسات بقدر ما تهتم فقط بنتائجه في حياتهم العملية ، هذا فضلاً عما يمتلكه من رؤية خاصة للأبعاد الكونية المختلفة مما يعيد النظر الى العديد من المفاهيم والنظريات والقضايا ويبعث عن مزيد من البحث . وبذلك يلعب التصوف والعلم دوره المنتظر في الثورة بتقديم هذا المجتمع الجديد المأمول وكيفية الوصول إليه والتمكين من الانخراط في الواقع وتقويمه وإستكمال حلقات الثورة في إعادة بناء العالم الانساني .
الخـاتمـــة :
تدور هذه الدراسة في إطار الدراسات النظرية المعرفية التي تتناول بالتحليل النماذج المختلفة بنظرة ناقدة من أجل الكشف عن السلبيات ومدى تأثيرها على دراسة الظواهر الاجتماعية ، وتنطلق الدراسة من نقطة أساسية هي النظرية الوضعية نظراً لهيمنتها على العقلية الاسلامية والعربية مما أدى إلى إنعكاس سلبياته على العالم العربي فضلاً عن وجود عدد من الأسباب التي أدت الى تفاقم هذه الآثار . ومن خلال منهجية الدراسة المتمثلة في الاقتراب الابستمولوجي كأحد إقترابات دراسة المعرفة ، قامت الدراسة بتحليل هذا النموذج والتعرف عليه من حيث دواعي ظهوره وأسسه المنهجية ونتائجه على النظريات الاجتماعية ، ثم دراسة حال هذه العلوم في الوطن العربي مما يؤدي إلى الشعور بوجود الأزمة الناتجة عن استدعاء هذا النموذج وتطبيقه على واقع مناقض ، هذه الأزمة التي دعت ظهور عدد من البدائل في إطار محاولة البحث عن علاج ، وهي رغم اعتبارها خطوة ضرورية في التأكيد على وجود تلك الأزمة إلا أنها لم تتمكن من الفكاك من التبعية لهذا النموذج التغريبي على نحو كامل .
ومن خلال التعرض إلى تحليل طبيعة الأزمة وتناول البدائل المختلفة بنظرة نقدية ، أمكن التوصل إلى كون الأزمة في الحقيقة إنما تكمن في الفلسفة ، تلك هي البنية الأساسية للمعرفة العلمية كافة ، تلك البنية التي أغفلتها دراسات هذه البدائل وإندفعت نحو التطبيق إيماناً من ضرورة التخلص من سيطرة الوضعية على الدراسات الاجتماعية ، فأسفرت عن زيادة في الارتباط بذلك النموذج المغاير ، فالأصل في إقامة النموذج المعرفي هو وجود رؤية فلسفية يمكن الاستناد إليها في تحديد الأطر الكلية التي تتناول علاقة الانسان بالكون والعالم والله ، تلك الأطر التي تحدد نظرة الانسان والباحث تجاه الظواهر المجتمعية المختلفة ، كل ذلك أدى إلى إغفال تلك الدراسات لأحد المناهج الهامة لتي تكشف عن إمكانية لتجاوز الاسقاطات القيمية والروحية التي لا تزال تعبأ بها البحوث والدراسات الانسانية ، كما أنه يمتلك رؤية فلسفية تجديدية يمكنها أن تعيد من الدور المجتمعي للعلوم في التوجيه والترشيد ، لذ جاءت المحاولة في هذه الدراسة تتجه نحو الكشف عن هذا المنهج ، ومن منطلق المقدمات السابقة تحتم تناوله من جانب فلسفي وليس معرفي بحت ، وقامت بالتعرض لأحد أهم النظريات الخاصة بالانسان الذي يشكل محور العلوم الاجتماعية والفلسفة الصوفية على السواء . وإستطاعت أن تصل من خلال البحث والتحليل إلى مجموعة من النتائج الرئيسية التي يمكن إختصارها في بعض النقاط كما يلي :
– أن طبيعة الأزمة المعرفية في العلوم الاجتماعية العربية لا ترجع فقط إلى هيمنة النموذج الوضعي على العقلية الاكاديمية وقدرته التنظيمية ، وإنما إلى ضعف العقل العربي وعدم قدرته على تكوين رؤية خاصة نابعة من الهوية الثقافية والوعاء الحضاري الخاص ، فلم يتمكن من تشكيل المصفاة الثقافية والمعرفية الخاصة به أثناء تلقيه العلم الغربي ، وهذا الضعف الذي أفرز نظرة من القدسية لكل ما هو غربي ، فأصبحت هناك رغبة ملحة في تقليد الأجبني ليس على المستوى المجتمعي والاقتصادي واللغوي بل امتد ليشمل العلم والثقافة والمعرفة .
– أن بداية التغيير في العلم لا تكون برفض النموذج السائد ، وإنما بحصول نظرة جديدة للعالم يتم تبنيها في تناول الظواهر المجتمعية المختلفة ، وهذا ما لم تدركه العديد من الدراسات الخاصة باسلامية المعرفة ، فالاقتصار على دراسة التراث وإضافة الصبغة الدينية الشرعية على الدراسات والبحوث الاجتماعية ليس بالضرورة تعبير عن التمسك بالطابع الاسلامي المميز إنما هو في الحقيقة إغتراب مزدوج ، أحدهما على مستوى الواقع المعاش والاخر على مستوى المكون الفكري والثقافي .
– العلاقة ما بين المعرفة والواقع ، فنستطيع أن نقول أن الدراسة أستطاعت أن تسقط بشكل ضمني هذه المسافة المزعومة والمفتعلة ما بين العلم والمعرفة وبين الواقع والممارسة ، والتي أفتعلها الاجتماعيون أنفسهم تعبيراً عن عجزهم عن الانخرط في الواقع أو بمعنى آخر حجة على إنخراطهم المتخبط فيه ، ونذكر أن ذلك أحد أنماط مواطهة الأزمة العلمة ، والتي تتمثل في محاولة دفعها ونفيها حتى لا يتم تحميل النفس عبأ الشك والبحث من جديد .
– وجود علاقة قوية بين التصوف والفلسفة ، فهو ليس حكراً للدراسات الدينية ، حيث سلطت الدراسة الضوء على بعض جوانبه التي ترتبط بشكل مباشر مع الفلسفة الانسانية محور المعرفة الاجتماعية ، وهو ما يمكن أن تعتمد على دراسات الأسلمة جنباً إلى جنب مع غيره من المناهج .
– تناول البحث لسؤال أساسي تردد كثيراً خاصة في الوقت الحالي في الحقلين السياسي والصوفي والذي يدور في نطاق علاقة التصوف بالثورة ، وقد أثبت أن الثورة هي جوهر الفكر الصوفي ، بل أنها تتخذ فيه معنى أعمق ، فهي لا تتوقف على مجرد التغييرات الشكلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وإنما هي إعادة بلورة للعلاقة بين الانسان بالدوائر الكونية المختلفة .
وعلى الرغم من ذلك كله ، علينا الاقرار بصعوبة هذا الموضوع وقصوره في تناول كافة أبعاد المنهج المطروح ، بحيث يصعب أن تقوم دراسة واحدة بشمول كافة أبعاده نظراً لتشعبه وإمتداده في كافة أبعاد الحياة الروحية والثقافية والمعرفية والاجتماعية بل والعقيدية وغيرهم ، كما تناولت الدراسة أحد الأبعاد الخاصة بالمعرفة الانسانية وهي الفلسفة إلا أنها إفتقرت كذلك إلى وجود جزء تمهيدي لتكوين المعرفة في ضوء هذا الطرح وكيف يمكن تناول الأفكار والقضايا وهو ما يمكن أن تقوم الباحثة بتناوله في بحث آخر – إن شاء الله – ، إلا إننا بالضرورة في حاجة إلى ظهور العديد من الدراسات لتناول هذا النموذج في إطار مغاير لتلك النظرة المعتادة والقاصرة على الرؤية الدينية للتجربة الصوفية ، بحيث يمكننا في النهاية تقديم قادر على أن يدرس الظواهر بأبعادها المختلفة المعنوي والمادي ، وفق تسكين لأدوات المعرفة المختلفة ، وتحديد للعلاقات على مستوى الدوائر والمسارات .
المــراجع:
أولاً : مراجع عربية
(1) الكتب
– أحمد الخشاب : التفكير الاجتماعي : دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، 1973 .
– أبي نصر الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1906.
– أدموند هوسرل : أزمة العلوم الأوربية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية : مدخل الى الفلسفة الفنومينولوجية ، ترجمة : اسماعيل المصدق ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، 2008 .
– إسماعيل الفاروقي : إسلامية المعرفة : مبادئ عامة – خطة العمل – الانجازات ، سلسلة قضايا إسلامية معاصرة ، دار الهادي ، بيروت ، 2001 .
– آنا ماري شيمل : الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف ، ترجمة : محمد اسماعيل ورضا حامد ، منشورات الجمل ، بغداد ، 2006 .
– أنطوني دي كرسبني ، وكينيث مينوج : أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ، ترجمة : نصار عبد الله ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1996 .
– توبياس هيلمستروف ، ياسمين سينر وايميت نوهي : فهم الصوفية وإستشراف أثرها في السياسة الأمريكية ، ترجمة : مازن مطبقاني ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ، 2004 .
– توفيق الطويل : اشكالية العلوم الاجتماعية .. انها ليست علوما ، في : احمد خليفة ، سهير لطفي وآخرون : إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 1984 .
– توماس س. كوهن : بنية الثورات العلمية ، ترجمة : حيدر حاج اسماعيل ، المنظمة العربية للترجمة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 2007 .
– جلال أمين : بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث ، في : أحمد خليفة ، سهير لطفي ، وسيد عويس : إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 1984 .
– جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1973 .
– جورج سباين : تطور الفكر السياسي ، الكتاب الثاني ، ترجمة : حسن جلال العروسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2010 .
– جوزيبي سكاتولين ، وأحمد حسن أنور : التجليات الروحية في الاسلام : نصوص صوفية عبر التاريخ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2008 .
– حلمي سالم : الشعر والتصوف والثورة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2012 .
– دوركايم : قواعد المنهج في علم الاجتماع ، ترجمة : حمود قاسم ومحمد بدوي ، دار المعرفة الجامعية ، 1988 .
– ر. أ. نيكلسون : الصوفية في الإسلام ، ترجمة : نور الدين شريبة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2012 .
– ر. نيكلسون : في التصوف الإسلامي وتاريخه ، ترجمة : أبو العلا عفيفي ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1956 .
– زكي نجيب اسماعيل : نحو علم الاجتماع الاسلامي ، دار المطبوعات الجديدة ، الاسكندرية ، 1981.
– زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره ، الطبعة الثالثة ، مكتبة غريب ، القاهرة ، 1981 .
– زيدان عبد الباقي : علم الاجتماع الديني ، مكتبة غريب ، القاهرة ، 1981 .
– سارة عبد المحسن عبد الله : نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الاسلام ، الطبعة الاولى ، دار المنارة ، 1991 .
– شبلي شمبل : فلسفة النشوء والارتقاء ، المجلد الأول ، مطبعة المقتطف ، 1910 .
– صلاح قنصوه : الموضوعية في العلوم الإنسانية ، دار التنوير ، 2007 .
– عبد الباسط عبد المعطي : اتجاهات نظرية في علم الاجتماع ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، 1981.
– عبد الرحمن بدوي : الانسان الكامل عند صوفية الاسلام ، الطبعة الثانية ، وكالة المطبوعات ، 1976 .
– عبد الوهاب المسيري : إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد .. مقدمة في فقه التحيز ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا ،الولايات المتحدة ، 1998 .
– عرفان عبد الحميد : في التصوف المقارن : ملاحظات منهجية ، اسلامية المعرفة ، السنة التاسعة ، عدد 35 ، 2004 .
– علياء وجدي (محرر) : الخصوصية الثقافية : نحو تفعيل التغيير السياسي والاجتماعي ، برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2008 .
– عمار علي حسن : الصوفية والسياسة في مصر ، الطبعة الأولى ، مركز المحروسة للبحوث ، 1997 .
– عمر عبد الله كامل : الإنصاف فيما أثير حوله الخلاف ، الوابل الصيب ، القاهرة ، 2010 .
– عنايت خان : تعاليم المتصوفين ، ترجمة : ابراهيم استنبولي ، الطبعة الثانية ، دار الفرقد ، دمشق ، 2008 .
– فريدريك معتوق : منهجية العلوم الإجتماعية عند العرب وفي الغرب ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1985 .
– لطف الله خوجه : موضوع التصوف ، دار الاوراق الثقافية ، الطبعة الأولى ، 1432 .
– ليفي بريل : الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية ، ترجمة : محمود قاسم ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1952 .
– محمد أبو القاسم : منهجية القرآن المعرفية : أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية ، دار الهادي ، بيروت ، 2003.
– محمد أركون : نقد العقل الإسلامي ، دار الطليعة ، 2005 .
– محمد البهي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، مكتبة وهبه للطباعة ، 1395 هـ.
– محمد الجوهري (تقديم) : قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع ، ترجمة : مصطفى خلف عبد الجواد ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، 2002 .
– محمد الشريف : التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي : مساهمة في دراسة ثنائية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط ، الجمعية المغربية للدراسات الاندلسية ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2004 .
– محمد عابد الجابري : بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 1986 .
– محمد محمد أمزيان : منهج البحث الإجتماعي بين الوضعية والمعيارية ، الطبعة الثانية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا ، الولايات لمتحدة الأمريكية ،1992 .
– معن خليل عمر : نحو علم إجتماع عربي ، دار مجدلاوي ، 1992 .
– منى أبو الفضل ، ونادية مصطفى (تحرير) : الحوار مع الغرب :آلياته – أهدافه – دوافعه ، دار الفكر ، سلسلة التأصيل النظري للدراسات الحضارية ، 2008 .
– نصر محمد عارف ، وكمال عبد اللطيف : إشكاليات الخطاب العربي المعاصر، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 2001 .
– هادي العلوي : مدارات صوفية : تراث الثورة المشاعية في الشرق ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، 1997 .
– ولتر ستيس : التصوف والفلسفة ، ترجمة : إمام عبد الفتاح إمام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2012.
– يوسف زيدان : الفكر الصوفي بين عبد الكريم الجيلي وكبار الصوفية ، الطبعة الثانية ، دار الأمين ، 1998 .
(2) الرسائل
– السيد محمد بركة : مشكلتا المصطلح والمنهج في التصوف الإسلامي (من السيميولوجي إلى الابستمولوجي) ، أطروحة ماجستير ، جامعة المدية ، 2007 .
– محمد محمد امزيان : منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية ، أطروحة الماجستير ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ،
– نصر محمد عارف : نظربات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية ، ، أطروحة دكتوراة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1995 .
(3) الدوريات :
– طارق عبد السلام لعجال ، وأحمد زكي إبراهيم : التصوف بين التوظيف السياسي والثابت التاريخي ، مجلة التمدن ،1-2012 .
– عبد الحكيم يوسف الخليفي : الخيال والتجربة الصوفية لدى شهاب الدين السهروردي من خلال كتابه حكمة الإشراق ، مجلة أفكار ، عدد 10 ، 2009 .
– عرفان عبد الحميد : في التصوف المقارن : ملاحظات منهجية ، اسلامية المعرفة ، السنة التاسعة ، عدد 35 ، 2004 .
– قرين جميلة : الحقيقة الصوفية بين العقل والكشف ، مجلة كلية آداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد السادس ، يناير 2010 .
– محمد العدلوني الادريسي : الإنسان والإنسان الكامل في فلسفة الششتري الصوفية ، مجلة فكر ونقد ، العدد 71 ، سبتمبر 2005 .
– محمد صفار : الفلسفة والثورة : قراءة في قراءة ابن رشد لجمهورية أفلاطون ، أوراق فلسفية ، العدد الحادي والثلاثون ، 2012 .
– ملكية جابر : اسهام الابستمولوجيا في تعليمية علم الاجتماع ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد الثامن ، يونيه 2012 .
– منى أبو الفضل : النظرية الاجتماعية المعاصرة : نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل ، اسلامية المعرفة ، العدد السادس ، السنة الثانية .
– ناجم مولاي : مفهوم الانسان الكامل في الفكر الصوفي ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد السابع ، 2012 .
(4) ندوات ومؤتمرات :
– خليل عبد الله المدني : علم الاجتماع في الوطن الواقع والطموح : دراسة في نشأة وتطور علم الاجتماع في مصر والسودان والسعودية ودوره العلمي والمجتمعي ، في ندوة بعنوان : علم الاجتماع من منظور إسلامي ، مركز الدراسات المعرفية ، القاهرة ، 17 – 20 فبراير 2007 .
(6) مواقع الأنترنت
– عبد الاله الياسري : حول مدارات صوفية
www.m.ahewar.org
– محمد رحومة : نظرية المعرفة عند الصوفية
www.Defiblog.blagspot.com/2011/06/blog-post_01_htm
– محمد سعيدي : بناء الانسان في الفكر الصوفي الاسلامي : قراءة أولية في الأدب الصوفي
http://www.kasnazan.com/article.php?id=837
(7) مصادر أخرى :
محمد صفار : محاضرات في النظرية السياسية ، الفرقة الثالثة ، قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2011 – 2012 .
ثانياَ : مراجع اجنبية
(1) Books
– J. D. Bernal : the social function of science , G, Routledge , 1980.
– Johan Galtung : On the meaning of Nation as a variable , In : Manfred Niessen , and Jules peschar : International comparative research : problems and theory mythology and organization in eastern and western Europe , Oxford , Pergamon press , 1982 .
– Pierre Ansart : Sociologie de Saint Simon , presses universitaires de france , 1973 .
– Yavuz H. and Esposito J. (eds) : Turkish Islam and the secular state : the Gullen movement , Syracuse university press , 2003 .
(2) periodicals
– Leo Strauss : what can we learn from political theory ? , review of politics , vol.69 , 2007




