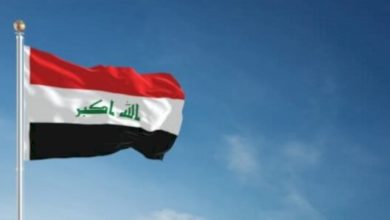حقوق الإنسان وحرياته ألأساسية بين القانون والسياسة والدين

اعداد الباحثة : أسية أهرواز – المغرب
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمــــة :
يمثل موضوع حريات الإنسان وحقوقه الأساسية أحد أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والدولي ٍ, حيث عقدت بشأنه العديد من المؤتمرات الدولية ووقعت عشرات المعاهدات عليه , ونظرا لأهميته فقد شغل موضوع الحريات العامة أذهان رجال الفكر والقانون , وما يزالون منشغلين به , ووظفوا أقلامهم وفكرهم في سبيل توضيحه أو المطالبة به
ومن منطلق أهميته كذلك أضحى من المقررات الدراسية في الكثير من الجامعات خاصة كليات الحقوق , والعلوم الإنسانية , تدريس الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحليل مضمونها وتبيان حدودهما وإبراز موضعهما القانوني واجبا ملقى على عاتق الجامعات وذلك من أجل تعميق الإنسان وترسيخ فكرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في وجدان الطلبة وتعميق الوعي لديهم بأن هذه الحريات والحقوق هي مبادئ عالمية جاء النص عليها في الكثير من الوثائق والاتفاقيات الدولية وبالتالي يجب الدفاع عنها بوصفها من المكاسب الحضارية , إن مسألة الحريات العامة مشكلة اجتماعية وثيقة الصلة بمسائل القانون والسياسة , لذا فإن موضوعها ليس وليد العصر الحاضر وإنما هو قديم قدم الإنسانية نفسها ويشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخها فهو قد ارتبط بالشرائع السماوية وبالجماعة التي يحكمها القانون والنظام وتشرف على شؤونها سلطة عليا توازن بين طموحات مجموع القوى الاجتماعية والسياسية المتصارعة بغرض تحقيق التناغم والتوافق بينها , وعليه فإن الحريات العامة تقدم صورة للإنسان في المجتمع وللمواطن في مواجهة السلطة السياسية ومن ثم أصبحت الحريات من الاستحقاقات السياسية التي يعود أمر تنظيمها وتقنينها إلى مؤسسات الدولة صاحبة الحق في فرض سيادة القانون . ولذلك فالحريات العامة هي مجموع الرخص والإباحات التي يعترف بها القانون للمواطنين كافة دون أن تكون موضوعا للاختصاص المانع وهي بذلك تولد حقا قانونيا يستلزم اعترافا من الدولة للأفراد بممارسة عدد من الأنشطة المحددة دستوريا وقانونيا , بمعزل عن أية ضغوط أو إكراهات سلطوية. في الوقت الراهن حريات الإنسان الأساسية لصيقة بشخصه . وعن كمال إنسانيته ونقصانها مرغوبان بقدر مايتمتع به من حقوق وحريات ومن هنا قيل : الإنسان بحقوقه وحرياته , فإذا كان يملك كل الحقوق والحريات كانت إنسانيته كاملة , وإذا تطاول أحد عليها أو على حق من حقوقه وحرية من حرياته الأساسية أو انتقص منها , كان في ذلك التطاول أو في هذا الانتقاص , انتقاص واعتداء على إنسانيته , وكلما تعددت الحقوق والحريات التي تسلب من الإنسان , يكون الانتقاص من إنسانيته بنفس القدر.
إن الاعتراف بالقيمة الفلسفية والسياسية والاجتماعية للحريات العامة التي جاءت نتيجة كفاح طويل للبشرية , عبر ثورات طويلة وتضحيات جسام ضد السلطة المطلقة, وبالتأثير الكبير الذي تخلقه في إطار النسق السياسي و الاجتماعي , عمدت العديد من المجتمعات والشعوب إلى تضمينها في تشريعاتها كفالة لممارستها وضمانة لعدم المس بها.
بيد ان ما تعرفه الحريات العامة من اهتمام واعتراف بأهميتها للمجتمعات الحديثة , تجاوز إطارها المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي , فدوليا كان الاهتمام بالحريات العامة وحقوق الإنسان من بين أولويات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة , حيث أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948 م , كما عملت على إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان , ونفس المنحى جسدته المنظمات الإقليمية والقارية, حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقضية حقوق الصادرة عن المجلس الأوروبي , والاتفاقية الأمريكية الإنسان , والميثاق الإفريقي , ومشروع الاتفاقية العربية ومشروع لحقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي.
غير أن الجدير بالملاحظة هو أنه رغم هذا الاعتراف والإقرار الواسع بأهمية الحريات العامة وضرورتها في بناء مجتمع سوي ّ, فإننا يمكن أن نقول بدون مبالغة أن أخطر ما يواجه الحريات العامة في عالم اليوم , يتمثل من جهة, في التضييق المستمر عليها من قبل الأجهزة التنفيذية داخليا, وذلك لأن طبيعة الدولة الحديثة وما تتمتع به من سيادة وهيمنة , أوجد العديد من المجالات والتصرفات التي لا يحق للمواطنين مساءلتها عنها, بالرغم مما تسببه لهم من إضرار, ومن جهة أخرى , الهيمنة الدولية على الشعوب الفقيرة وعلى مصادرها دوليا. ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول , أن قضية الحريات العامة بالرغم مما عرفته من اعتراف وطني ودولي , تظل في حاجة دائمة إلى إعادة النظر في قضيتها وإشكالاتها , خاصة في ظل تنامي ظاهرة العولمة وسيادة الدولة الديمقراطية الليبرالية في شكلها المتوحش والتي تحمل في طياتها العديد من مظاهر المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولمعالجة هذا الموضوع سأقسمه إلى قسمين سأعالج في :
- القسم الأول : الضمانات السياسية والقانونية والدينية للحريات العامة وضوابط ممارستها
- القسم الثاني : حقوق الإنسان وحرياته بين القانون والسياسة والدين
القسم الأول : الضمانات السياسية والقانونية والدينية للحريات العامة وضوابط ممارستها:
نتج عن شيوع نموذج الدولة الدستورية في المجتمع السياسي المعاصر , إفساح المجال أمام المواطنين لممارسة حقوقهم وحرياتهم بطريقة سمحت لهم بالحصول على قدر كبير من العدالة وتكافؤ الفرص فيما بينهم, إلا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق لولا وجود ضمانات نابعة من طبيعة النظام السياسي نفسه تسمح بتكريس هذه الحقوق داخل المجتمع وتجاه السلطة من جهة, لولا قيام المشرع بوضع ضوابط معينة لتنظيم هذه الحقوق وتحديد ما يترتب عنها من واجبات من جهة أخرى فما هي هذه الضمانات ؟ وما هي هذه الضوابط؟
إن الضمانات المتوفرة للحريات العامة التي سارت اليوم كمظهر للحضارة الإنسانية وضمان الممارسة يعني حماية الحريات العامة من الاعتداء عليها سواء كان ذلك من قبل السلطة أو من قبل الأفراد على حد سواء , فإننا يمكن أن نقول أن الضمانات العامة لممارسة الحريات ترتدي شكلين : سياسي وقانوني.
فالضمانات السياسية : هي تلك المبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام السياسي في طبيعته التي ينال أساسها رضا غالبية المواطنين على وجوده ,والضمانات القانونية هي تلك القواعد القانونية والدستورية المستمدة من تراث الشعب وأعرافه وتقاليده والتي تشكل سدا منيعا أمام الانحرافات المحتملة للسلطة السياسية عن غاياتها الأساسية في ممارستها لمبدأ القوة السياسية, خاصة ونحن نعلم أن السلطة تميل إلى وضع القيود على مؤسسات الدولة وحماية أمنها الداخلي والخارجي, لهذا نجدها تلجأ إلى توسيع نطاق الأفكار المقابلة لفكرة الحريات, كفكرة السلطة التقديرية أو فكرة أعمال السيادة, وفكرة الظروف الطارئة, لكي تحقق أكبر استفادة منها, في مواجهة حريات الأفراد, وفي الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحريات لمواطنيها, تحقيقا لمفهوم التوازن داخل الجسم الاجتماعي والسياسي .
المبحث الأول : الضمانات القانونية للحريات العامة:
تأتي الضمانات القانونية في مقدمة ضمانات الحريات العامة لأنها تأتي ضمن إطار البنية القانونية للدولة, فتحاط بالجزاءات القانونية التي تكفل لها الفعالية إذا تم تنظيمها تنظيما سليما على هدي المبادئ والقواعد والأحكام التي يتألف منها الكيان الدستوري للدولة والذي يجعل ممارستها في علاقتها مع الأفراد والجماعات تنتظم في إطار القانون وتتقيد بأحكامه.
أولا : مبدأ فصل السلط :
يعد مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات القانونية الهامة للحريات العامة , ويقصد بالفصل بين السلطات كضمانة من ضمانات حماية الحريات , أن تكون لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث اختصاصاتها المحدودة , بحيث تكون منفصلة عن الأخرى فصلا مرنا, فيقوم هناك نوع من التعاون بين السلطات وتمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى حرصا على عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم, وتتفادى الدولة الانحراف بالسلطة أو التعسف باستخدامها, لذا فإن الغاية الأساسية ونقطة البدء بالنسبة لهذا المبدأ تتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياته. وبل وعلى ضوئه أضحت عقيدة فقهاء القانون العام اتجاه نحو القول : أنه لا حرية سياسية بدون مبدأ فصل السلطات. ويتضمن مبدأ فصل السلطات معنيين أساسيين:سياسي وقانوني, فالمعنى السياسي فمضمونه: عدم تركز سلطات الدولة في قبضة شخص أو هيئة واحدة وأما المعنى القانوني فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة ,وبهذا المعنى تنقسم النظم إلى نظام رئاسي ,ونظام برلماني ,ونظام شبه رئاسي.وفي كل الأحوال ,فإن من شأن مبدأ الفصل بين السلطات حماية حريات الأفراد بوجه تعسف السلطة. وهو مقياس لمدى ديمقراطية النظام واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة.
ثانيا : مبدأ سيادة القانون :
نظرا للأهمية الكبرى التي يتصف بها القانون والدور المميز الذي يلعبه في تسهيل شؤون الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل عام , فقد أجمع علماء القانون والسياسة على ربط مفهوم سيادة القانون بوجود الدولة الديمقراطية . فهذه الدولة لا يمكن أن تكتسب هذه الصفة إلا إذا إستندت مؤسساتها على أولوية القانون الذي يجب أن يسود الحكام والمكومين على السواء. فالمبدأ يقتضي إذن , احترام الحكام والمحكومين لقواعد القانون القائمة في بلد ما وسريانها سواء في علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو في علاقات هيئات الدولة ومؤسساتها . أي أنه يفترض توافق التصرفات التي تصدر سلطات الدولة ومواطنيها مع القواعد القانونية فيها . وعلى هذا الأساس يمثل مبدأ سيادة القانون, قمة الضمانات القانونية لحماية حريا ت الأفراد الأساسية , بل أنه يعد الأساس الجيد لاكتساب السلطة السياسية في الدولة وشرعيتها والعامل الأهم في استقرارها وثباتها لهذا فهو مطلب هام تنادي به كافة الأنظمة الديمقراطية , حتى غدت الدساتير والقوانين في تلك الأنظمة بما تتضمنه من نصوص تؤكد على تطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون تأكيدا للديمقراطية وضمانة أكيدة لحرية الرأي العام.
الدولة القانونية : لم يكن إخضاع الدولة للقانون بالأمر الهين لأنها سلطة, وكل سلطة تميل إلى الإطلاق , وقد زاد في هذا الاتجاه ذلك التأكيد الذي تم لمفهوم سيادة الدولة منذ القرن الرابع عشر , لكن التطور مر عبر مراحل طويلة , وبموافقة الدولة التي تعتبر في أنشطتها الحالية محدودة بالقانون, على أنه تحديد نابع عن إرادتها , وهو في النهاية تحديد ذاتي, ومن هذه الزاوية يعتبر تطور النظام الدستوري في كليته تعبير عن التنازل الذي قامت به الدولة من أجل الخضوع للقانون. وبأن معنى أخر إن الدولة لا تعدو أن تكون شخصا من أشخاص القانون العام تلتزم كباقي الأشخاص بمبدأ سيادة القانون, وهذا يعني أن تكون أعمال هيئاتها العامة وقراراتها النهائية في حدود ذلك المبدأ وفي إطاره. أما إذا كانت على غير هذا الحال فإنها لا تكون صحيحة ولا نافذة أو ملزمة في مواجهة المخاطبين بها , ويكون لكل صاحب شأن حق طلب إلغاؤها ووقف تنفيذها , فضلا حق طلب تعويض الأضرار التي تسببها وفقا للأوضاع القانونية المقررة. وعليه ,فإن أهم ما يميز الدولة القانونية , هو ان السلطات الإدارية لا يمكنها أن تلزم الأفراد بشيء خارج القوانين المعمول بها , وذلك يعني تقييد الإدارة على مستويين :
- الأول : لا تستطيع الإدارة حينما تدخل في علاقات مع الأفراد أن تخالف القانون أو تخرج عليه.
- الثاني : ولا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا إلا تطبيقا لقانون أو بموجب قانون .
تدرج القواعد القانوني: كان للمدرسة النمساوية وخصوصا “كلسن” و “مركل” الفضل في استخلاص هذه القاعدة التي تقوم على أن النظام القانوني في الدولة يرتبط بتسلسل وارتباط قواعده القانونية بعضها ببعض. وهذا يعني أنها ليست جميعا في مرتبة واحدة من حيث القيمة القانونية والقوة بل تتدرج هي فيما بينها, مما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض. وهو ما يعني أن تلتزم كل قاعدة قانونية بأحكام ومضمون القواعد التي تعلوها , فتقف قواعد القانون الدستوري على قمة الهرم القانوني , ثم يلي الدستور التشريع العادي الصادر من البرلمان أو القوانين العادية الصادرة عن الهيئة التنفيذية إعمالا للحق الدستورية الممنوح لها وفقا للأوضاع القانونية المقررة في الدولة , ثم يلي ذلك اللوائح العامة , ثم تقف القرارات الإدارية عند ذلك النظام القانوني وينتج عن هذا التنظيم أن الأدنى يجب أن يتقيد بالأعلى فالقانون مقيد بالدستور , واللائحة بالإلزام, ووجوده في المجتمع مقيدة بكليهما , والقرار الإداري مقيد بأحكام اللائحة والقانون والدستور. مما لاشك فيه إن هذا التدرج يعد من لوازم الضمانات القانونية للحريات العامة, لما يؤدي إليه من إقامة النظام القانوني في الدولة على أساس من التنظيم المحكم, بالإضافة إلى أنه يسهل أعمال الرقابة القضائية .
الرقابة القضائية : يراد بالقضاء بمعناه الاصطلاحي الفصل بين الناس في الخصومات على سبيل الإلزام , ووجوده في ضرورة لإنصاف المظلومين . فحال الناس لا يخلو من ظلم والقضاء هو الوسيلة التي ترد بها الحقوق إلى أصحابها وتصان بها الحريات والأعراض والأموال. والدولة التي يوجد فيها قضاء مستقل وتلقى أحكامه احترام الكافة لها , من الحكام والمحكومين, توصف بأنها دولة قانونية ,حيث يشعر أهلها بأمان واستقرار ويتمتعون بقسط كبير من الحرية الشخصية أما إذا لم تتوافر للقضاء حصانة ولا استقلال , ولم تقابل بالاحترام الواجب لها فإن هذه الدولة والحال كذلك يمكن وصفها بأنها دولة بوليسية , وئدت على أرضها الحرية . لهذا نجد بأن الكثير من الدول تعارفت على قاعدة ترد بصيغة أو أخرى ومؤداها للسلطة القضائية الحق في الفصل في النزاعات وهي الحارس والضامن للحريات الأساسية ويتضح دور السلطة في حماية من خلال إعطاء المواطنين في الدولة حق التقاضي ,إذ بإعطائهم هذا الحق يمكنهم إذا تم الاعتداء على حقه, أو إذا أهدرت حرياته أي كان المعتدي عليه فردا أو سلطة , مقاضاة تلك السلطة, أو مقاضاة ذلك الفرد أمام المحاكم المختصة فيحصل على مافاته من حقوقه وما أهدر من حرياته .
الرقابة الدستورية : إن ما يميز الدولة القانونية هو خضوعها لأحكام القانون واحترامها لتدريجها, وفي ظلها يتأكد سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى للدولة بحيث تخضع له جميع سلطات الدولة. ومن مبدأ سمو الدستور , نبعت النظرية المسماة بالرقابة الدستورية على القوانين , وعلى سائر الأعمال التشريعية . نظرية تقوم على التمييز بين طبيعة وقوة ونفوذ المقتضيات الدستورية من جهة,وبين القوانين العادية من جهة ثانية. وبما أن الدستور يعد القانون الأساسي للدولة فلا بد لقوانين الدولة العادية من أن توافق نصه وروحه. وبتعبير أخر , إن المقصود بالرقابة في هذا المقام هي تلك الرقابة المنصبة على ملاحظة الانسجام التشريعي بين قواعد البنية القانونية العادية على قواعد القانون الدستوري , بحيث تكون الأولى غير مخالفة للأخيرة . فإن خالفتها كانت غير مشروعة , أي أن الأصل أن تكون قوانين نابعة من جوهر الدستور ومتطابقة مع نصوصه بحيث تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
الرقابة الوقائية : تكون سابقة على صدور القانون ونفاذه. ويوضح ذلك المجلس الدستوري الذي يتولى فحص دستورية القوانين قبل إصدارها , فإذا تبين للمجلس عدم دستورية القانون المعروض عليه, فإنه يترتب على ذلك عدم إمكان إصداره وتنفيذه بأي طريق من طرق الطعن ,كما أضفى عليها صفة الإلزام بنسبة لجميع السلطات العامة والإدارية والقضائية.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين : إن الأثر القانوني المترتب على الرقابة القضائية على دستورية القوانين هو تبلور صور رئيسيتين لها وهما : رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء.
ويقصد برقابة الامتناع , أن يتولى القاضي النظر في القانون ليتحقق من مدى اتساق قواعده مع أحكام الدستور , فإذا ما تبين له الالتقاء والتوافق بينهما عمل على تطبيق القانون على القضية المعروضة أمامه أما إذا الوضع على خلاف هذا النحو أي إذا وجد أن القانون غير دستوري فإنه يمتنع عن تطبيقه على القضية المطروحة أمامه , وهذا يعني أن هذه الصورة من الرقابة القضائية لا تحول دون استمرار القانون ونفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يمكن إعمال بعض أحكامه فيها, بل إن هذه الصورة لا تتنافى مع تطبيق ذات القانون الذي سبق لأحد المحاكم الامتناع عن تطبيق أحكامه في قضية معينة إذا ما عرض ذات النزاع على محكمة أخرى وتطلب الأمر تطبيق نفس القانون.
رقابة الإلغاء : أطلق فقه القانون العام علة هذه الصورة رقابة الإلغاء لأنها تمنح القاضي سلطة إبطال القانون المخالف للدستور في مواجهة الكافة عن طريق الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية, أي أن هذه الصورة تفترض عرض نزاع أصلي أوفرعي على القاضي , ويتعلق ذلك بنوعيه بالطعن بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه أو المطبق فعلا, فإذا ثبت للقاضي عدم دستورية أي مخالفة لأحكام الدستور حكم بإلغائه واعتباره كأنه لم يكن من تاريخ صدوره , أو على الأقل إنهاء حياته للمستقبل بحيث لايمكن التعويل عليه والاستناد إليه.
رقابة المشروعية : تعتمد الدولة القانونية الحديثة على مبدأ المشروعية وهو يعني سيادة حكم القانون, أي أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون , على أن يأخذ القانون هنا بمعناه العام والشامل لجميع القواعد الملزمة في الدولة سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة وأيا كان مصدرها مع مراعاة التدرج والتسلسل في ارتباطها وقوتها, ومبدأ المشروعية بهذا المعنى مستقل عن شكل الدولة , فهو يسري على الدولة الديمقراطية كما يسري على الدولة التي تأخذ بأي صورة أخرى من صور الحكم مادامت تخضع للقانون, أما إذا صدر هذا المبدأ صارت الدولة بوليسية. وهكذا يجب على السلطة التنفيذية في أدائها لوظيفتها الإدارية أن تحترم إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون الواجب ولا تتنكر لها أو تعمل على إهمالها بعدم تطبيقها من جانبها أو بعدم زجر المخالفين لها ويترتب على ذلك نتيجة بالغة الأهمية وهي أن كل قرار إداري يصدر عن الإدارة يجب أن يكون مستندا إلى نص قانوني بالمعنى العام. ولما كان هدف مبدأ المشروعية هو الحد من الطغيان واستبداد الإدارة وممثليها وإلزامهم حدود القانون في قراراتهم وتصرفاتهم, كان جزاؤهم عن مخالفتهم لهذا المبدأ يتمثل في إجراء الرقابة القضائية على تلك الأعمال باعتبارها الوسيلة الفعالة لحماية مبدإ المشروعية , ذلك أن أعمال الإدارة هي أولى الأعمال بالرقابة القضائية , إذ أنها تمس حقوق الأفراد وحرياتهم خاصة بعد أن تحولت وظائف الدولة من الإطار التقليدي إلى المستوى الاجتماعي ـ الاقتصادي , مستهدفة من ذلك تحقيق بعض مظاهر العدالة الاجتماعية بين الأفراد .
المبحث الثاني : الضمانات السياسية:
تتخذ الضمانات السياسية للحريات العامة داخل المجتمعات الحديثة عدة مظاهر يمكن تلخيصها على الشكل التالي :
أولا : رقابة الرأي العام : يلعب الرأي العام في أيامنا هذه دورا كبيرا في الحياة السياسية لأي مجتمع من المجتمعات المنظمة في إطار الدولة الحديثة ومع أنه دائما موجودا عبرا لعصور إلى أن شكل التعبير عنه لم تتخذ صفته المتطورة إلا في عصرنا الحاضر.وثمة تعريفات كثيرة للرأي العام يقول أحدها أنه “ مجمل وجهات النظر والاتجاهات والمعتقدات الفردية التي تعتنقها نسبة لها دلالتها من أعضاء المجتمع حول موضوع معين بالذات”. وتكاد كل التعريفات تجمع على أن التعبير عن الرأي العام من ناحية ومحاولة تغييره وتوجيهه والتأثير فيه أو حتى تكوين رأي عام من جديد من ناحية أخرى لن يتم إلا عن طريق الإقناع الذي يتطلب التوصل بكل ما يستلزمه من مناقشة مختلف الآراء وفحصها ونقد الأفكار والمعارضة ,مع الاستعداد لقبولها إن تبث صحتها ففرض الرأي أو الفكر عن طريق القهر والقسر والإملاء ومطالبة الآخرين باعتناقه والأخذ به بغير اقتناع منهم لايعني أبدا “رأي عام” بالمعنى الضيق للكلمة أي أن حرية التفكير وحرية التعبير وحرية إبداء الرأي هي الأساس الذي يقوم عليه الاتجاه العام في المجتمع الذي يمثل الحد الأدنى من الاتفاق حول موضوع معين أو قضية معينة أو أوضاع معينة بالذات. وواضح من هذا أن الرأي العام لا يعني أبدا الرأي الواحد أو الرأي الموحد ,مادام الأساس الأول في تكوينه وظهوره , هو الحوار الحر الذي
يترك الباب مفتوحا طيلة الوقت لاختلاف الآراء وتباين وجهات النظر , التعبير عن هذه الاختلافات. من هذا المنطلق لا نبالغ كثيرا في القول ان الرأي العام في المجتمعات الديمقراطية المتطورة هو الضامن الأساسي من الناحية السياسية للحريات العامة وهو يستطيع ممارسة دور مباشر في حمايتها لاسيما عن طريق الاستفتاءات أو عن طريق الاحتجاجات المباشرة كالتظاهرات وغيرها من الممارسات .
رقابة الشعب : إن إحدى أبرز أشكال رقابة الرأي العام يظهر في نظام الديمقراطية للرقابة على أشخاص السلطة العامة وتتمثل هذه الأعمال في مايلي :
أولا : الاستفتاء الشعبي : وهدفه التعرف على رأي الشعب في قضية من القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو دستورية …ألخ
ثانيا : حق الاعتراض الشعبي : ويقضي بأن يتقدم عدد من الناخبين بالاعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال فترة معينة من تاريخ نشره , وذلك يتعين وقف تنفيذ القانون وعرضه على الشعب فإذا لم يوافق عليه الغير .
ثالثا : حق الاقتراع الشعبي : حيث يساهم الشعب فعليا في عملية التشريع فإذا مارأي عددا من الناخبين أن الحكومة تصدر مشروع ما مع ضرورته وحيويته للشعب فلهم حق التقدم باقتراح مشروع قانون ورفعه إلى البرلمان ومناقشته وللبرلمان حق الموافقة على المشروع أو رفضه بعد مناقشته .
رابعا : عزل رئيس الجمهورية : تقرر بعض الدساتير حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية بشروط خاصة وفي حدود معينة ويعتبر الشعب في هذه الحالة حكما بين رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي , وعموما فإن هذه تعتبر من أهم مظاهر الديمقراطية غير المباشرة ,وهي تكفل نوعا من الرقابة الحقيقية للشعب بعيدا عن سيطرى الأحزاب السياسية وذلك لما توضحه من رغبات الشعب وتحقيقها والسير على مداها .
الاحزاب السياسية :
قبل منتصف القرن التاسع عشر وقبل وجود الأحزاب السياسية كان الأفراد منقسمين فكريا وعقائديا انقسامات شتى لأن لكل فرد فكره الخاص به الذي ينبع من مصلحته الشخصية وظروفه الاجتماعية والاقتصادية وانتماءاته الثقافية والحضارية,حيث أنه رغم وجود بعض التشابه والتقارب في آراء ومصالح وظروف الأفراد, إلا أنه غير منظم غير مستقر وغير مستمر أيضا, لأنه إذا اختلفت المصالح والظروف ,ووجهات النظر بينهم سرعان ما يضعف هذا التعاون إلى درجة التلاشي أو يزول نهائيا, لكن بعض ظهور الأحزاب السياسية وضعت حدا لهذا التشتت عن طريق تجميع وتكتيل الأفراد المتقاربين في المصالح والظروف والمبادئ والأفكار السياسية في تنظيم أو حزب سياسي يبلور ويصقل تقاربهم في إطار واحد بعيدا عن أهوائهم الشخصية أو مصالحهم الخاصة والذاتية , ذلك أن الحزب يخلق بالتدريج كتلة متماسكة من الإفراد تخضع لتنظيم معين وتسير وفق توجيه واحد لتحقيق الأفكار والمبادئ والإيديولوجيات التي جمعتهم ووحدتهم, وبذلك تكون الأحزاب قد نقلت الخلافات الفكرية والسياسية بين الأفراد من نطاق الصراع بين المصالح الخاصة إلى نطاق الصراع بين المصالح الخاصة إلى نطاق المنافسة بينهم لتحقيق المصلحة العامة .
المعارضة البرلمانية :
إن نظرة فاحصة في أصول الديمقراطية تبين ذلك الاتفاق حول الحاجة إلى المعارضة والسبب الرئيسي في ذلك هو الانتخاب لا يمكن أن يكون اختياريا بأي معنى ولتحقيق هذا الخيار لابد من تنظيم المعارضة تنظيما يبين مهمات وأدوار هذه المعارضة. كما هو الشأن بالنسبة للديمقراطية الغربية حيث يكون التمييز بين الوظيفة الحكومية ووظيفة المعارضة. وعليه تعد المعارضة جزءا متمما للنظام السياسي وهي لا يجب في إطار هذا النظام أن يكون هناك تسامح بين الجماعات المتنافسة ذات الاتجاهات المختلفة, لأنه دون ذلك التسامح لن يكون هناك قبول بالممارسة السليمة , أي تقييد الذين خارج الحكم بالقرارات التي يتخذها الذين في الحكم, واعتراف الذين في الحكم بحقوق الذين خارجه. وتعتمد المعارضة في وجودها على أساس نظام حزبي ثابت هدفه التوصل إلى الحكم لعرضه لمبادئه وسياسته على الناخبين والمنتخبين كمبادئ وسياسات الحكومة أو مجلس منتخب في المستقبل ولذلك فهي تستطيع السير في مناقشة مستمرة داخل المجلس التشريعي وفي البلد حول كيفية إكمال المنجزات الحكومية وكيفية حماية الحريات الفردية والجماعية .
ثانيا :حدود الحريات العامة : إذا كانت كل الحريات التي لم يرد النص عليها صراحة في الدستور تعتبر مباحة طالما أنه ليس ثمة نص تشريعي صريح أو اجتهاد قضائي يدخلها في نطاق الأعمال المحظورة قانونا , فإن تحديد مفهوم الحرية وإقرارها ,لا يعني أنها حرية مطلقة بلا قيد ولا شرط ,إذ ليس هناك من حريات عامة مطلقة يستطيع الأفراد ممارستها على هواهم , أو كما تمليه عليهم مصالحهم الذاتية الضيقة ,لأن هذا يعني وبكل بساطة , اختفاء الدولة ,وشيوع الاضطراب والفوضى في العلاقات الاجتماعية نفسها. وإذا لابد من وجود ضوابط وحدود. للحرية ينبغي أن تقف عندها , مثل:
أ-حترام الدستور والقانون : من غير المقبول لأي فرد مهما كان أن يخل بقواعد الدستور أو القانون,بدعوى ممارسة الحرية, ومن ثم ممارسة الحريات العامة , التي يكفلها القانون, فالمشرع يكون مسؤولا عن وضع الضمانات القانونية للأفراد من أجل التمتع بحرياتهم وضمان حمايتها حماية كافية .
ب ـحماية النظام العام: إذا كانت مقتضيات النظام العام لا تسمح بأن تكون الحريات مطلقة ,فإن الحريات لا تسمح كذلك بالعبث في تغيير مفهوم النظام العام . لذا فإن حريات الأفراد يقابلها حق الدولة, ذلك أن هذه الأخيرة لكي تدوم لابد لها من النظام ومن تقابل الحريات العامة ومن النظام العام, ينتج أن الحريات لا يمكن أن تكون مطلقة, كما أن النظام العام بدوره لا يمكن أن يكون مطلقا, ومن هنا يتعين إيجاد علاقة متوازنة بين الحريات العامة والنظام العام, والمحافظة على التوازن بين الحريات والنظام يتطلب إدراكا ووعيا بأن الحريات من الناحية الواقعية لا يمكن أن تكون إلا نسبية كما أن النظام العام بدوره يجب ألا يتعدى حدودا وإلا اتسم بالديكتاتورية. وهذا يعني أن النظام العام لكي يكون ديمقراطيا أن يكون نسبيا . ويمثل النظام العام الأساس العقائدي الذي يشكل أحد عناصر الفكر الديمقراطي ,وهو لا يعتبر في هذا الفكر انتقاصا من الحريات بوجه عام, لأنه شرط كامن في الحريات ذاتها أو شرط لممارستها وليس عدوانا عليها , فالديمقراطية ليست من الفوضى ,لذا فإن حدها النظام العام الذي يعتبر الحرية المشتركة للكافة.
ج ـ المحافظة على كيان الدولة: تحرص الدولة على أن تحمي نفسها ووجودها أيضا, من أية محاولة للاعتداء على كيانها باسم الحرية, فالحريات لا يجوز أن تمتد حتى تصل إلى حد تدمير كيان الدولة ذاتها,وإلا كانت نتيجة ذلك تدمير الحريات أيضا , ومن المبررات المتفق عليها لوضع قيود على الحريات وضمان وجود الدولة واستمرارها بشرط عدم إساءة استخدام حق حماية الدولة في كبت الحريات , وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الحرية ووجود العدالة .
د ـ حماية حريات الاخرين : والمقصود بها حماية الفرد في ممارسة لحرياته الخاصة, من إمكان تقييد هذه الحرية, أو الانتقاص منها أو الإضرار بها من قبل الفرد أو أفراد آخرين في المجتمع. وبهذا المعنى تقتصر الحرية على “ قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين وهكذا فإن لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تؤمن للأعضاء الآخرين للمجتمع والتمتع بهذه الحقوق نفسها , هذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا بالقانون “كما ورد في (المادة الرابعة ) من الإعلان الفرنسي لحقوق المواطن الصادر في 1789م ولأنه تعبير عن الإرادة العامة , ومتمتعا بتأييدها وموافقتها , فإن القانون هو الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تثبيت القواعد التي تحدد وبالتفصيل النظام العام للحريات.
هـ ـ حماية النظام الاخلاقي : تكتسي حماية النظام الأخلاقي للمجتمع أهمية خاصة إذ ليس هناك من مجتمع يتقدم ويستمر بدون مجموعة من القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد التي تؤمن تناسقه وبقاءه, ومن هذا المنطلق أولت الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان أهمية خاصة لهذه المسألة حيث ورد في المادة التاسعة والعشرين من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948م في فقرتها الثانية , على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها , ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام وللمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي “ وأجازت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966م ,استخدام مسألة حماية الأخلاق العامة كمبرر لتقييد بعض الحريات مثل حرية التعبير , فقد ورد في (المادة 18) الفقرة الثالثة ,خضوع “حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو المصلحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية.
القسم الثاني : حقوق الإنسان وحرياته بين القانون والسياسة والدين:
- أولا : حماية الحريات والحقوق في دستور الجمهورية التونسية
تونس دولة مدنية ,تقوم على المواطنة ,وإدارة الشعب ,وعلوية القانون. الحديث عن تونس دولة مدنية يستدعي النظر إلى هذا الفصل باعتباره جزء لايتجزأ من الوثيقة الدستورية في ارتباط وثيق مع باقي المقتضيات الدستورية ز لكن سؤال التنصيص على الدولة المدنية لا يقضي أن تونس دولة حرة , مستقلة,ذات سيادة ,الإسلام دينها والعربية لغتها ,والجمهورية نظامها ,كما ينص على ذلك الفصل الأول .فهذا المعطى يثير تساؤلات عديدة , فالتساؤل الأول ,يتعلق بالضرورة حول دين الدولة أي الإسلام وليس دين المجتمع وهل المجتمع يخضع لسيادة وعلوية القانون ,يعني أن هناك رغبة في علمنته ,أي إبعاد الدين عن الحياة العامة. في منحى آخر , يتم طرح سؤال ثان يتعلق بأسلمة الفصل الأول من الدستور التونسي ,عندما تم التنصيص على دين الدولة في مقابل ذلك علمنة الفصل الثاني من نفس الدستور مع ملاحظة أساسية أنه لا يجوز تعديل هذين الفصلين , مع إشارة واضحة في الفصل الثالث أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الإستفثاء. مما لاشك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين مع مقتضيات الفصلين الأول والثاني والثالث من الدستور التونسي ,بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لتونس هي ذات بعد سياسي أكثر منها ذات أبعاد قانونية ودستورية, إذ يلاحظ الترويج لمصطلحات ومفاهيم يراد بها التوافق السياسي والأخلاقي ما بعد الثروة وليس ترسيخ المبادئ العامة للتعاقد بين المواطن والدولة. في ترتيب , قد يكون غير موفق لمفاهيم غاية في الأهمية, صراع الدولة ـ الجمهوريةـ من جهة والدولة ـ من جهة ثانية ,فكان من الممكن التنصيص في بداية الحديث عن الجمهورية التونسية دينها الإسلام … لتفادي أي لبس فيما يخص إشكالية دين الدولة والمجتمع والنظام السياسي في علاقته بإرادة الشعب ومركزية المواطنة كأساس لسيادة القانون. إن إثارة مسألة الدين في علاقته مع التدين , يجد مبررا له, عندما نقرأ جيدا ما نص عليه الفصل السادس من الدستور “ الدولة راعية للدين, كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية , ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها, تلتزم بمنع دعوات التفكير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”. الواقع أن المشرع الدستوري التونسي عندما جعل من تونس دولة مدنية ,كمبدأ دستوري أسمى ,لم يكن مطالبا
بالتنصيص على أن الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ,كما هو مبين وموضح في مقتضيات الفصل 65 لتفادي الإغراق في التفاصيل والتي تفقد الدستور قيمته وعلو يته وسموه. فضمان حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي يعيد طرح سؤال العلاقة بين الدين والدولة, من جهة الأخلاق والسياسة من جهة ثانية.
فالاعتبارات متعددة ,من الصعب فصل الدين عن الدولة ,نظرا لطبيعة المجتمع ولعلاقة الفرد وممارسته الشعائرية والدينية على اعتبار الدين في المجتمع التونسي مكون أساسي في الحياة اليومية . في مقابل ذلك من الواضح أن الدولة كشخص من الأشخاص المعنوية العامة لها مسؤولية مدنية وأخرى معنوية, في حين محاولة التوفيق بين ماهو شأن خاص وشأن عام يهم خدمة المواطن وحماية حرياته وحقوقه الأساسية فالدولة لها من الأليات الدستورية والقانونية والمالية والبشرية ما يمنحها القوة والقدرة على إعمال القانون وسيادته . فالفصل السادس من الدستور التونسي ,قد يتم استغلاله لفائدة حسابات ضيقة تبتعد عن ما هو دستوري وقانوني إلى ما هو سياسي قد يعصف بالتلاحم المجتمعي المطلوب وقد يؤجج الصراع بين التيارات الإسلامية والعلمانية ويمهد الطريق إلى الانقسام المجتمعي. ما يثير العديد من التساؤلات بالنسبة للمتخصصين في مجال القانون الدستوري هو ما نص عليه فصل 23 من الدستور التونسي . فماذا يقصد بكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد, إذا كان المشرع الدستوري ـ نفسه ـ أقر بشكل واضح أ الإسلام هو دين الدولة التونسية , وأن الدولة تتمسك بمبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية في توطئة هذه الوثيقة الدستورية, كان من الممكن تجاوز هذا المقتضى الدستوري وعدم التنصيص عليه ,إذ من الممكن تجاوز هذا المقتضى الدستوري وعدم التنصيص عليه , إذ من الممكن تجاوز هذا المقتضى الدستوري وعدم التنصيص عليه , إذ من الممكن اعتباره مقتضى قانوني في مجال القانون الجنائي على غرار الفصل السادس من نفس الدستور. لذلك تحتاج مفاهيم عديدة في دستور الجمهورية التونسية للتوضيح والتفسير لكي تتوضح بعض المبادئ الدستورية للمواطنات والمواطنين, فالدستور التونسي دستور صراع المفاهيم , يقتضي قراءات متعددة من الصعب تحديد على الأقل لفهم مقتضياته في شموليتها. صحيح أ، النظام السياسي في تونس قبل ثورة الربيع العربي حقق العديد من الإنجازات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكن في مجال الحقوق السياسية كانت هناك صعوبات ومضايقات ,جعلت من النظام السياسي التونسي يقترب من الاستبداد .
ثانيا : الحق في المواطنة والديمقراطية
يعد طرح مسألة ثنائية المواطنة والديمقراطية عند الحديث عن النظام السياسي في علاقته بالمجتمع . إذ أن متطلبات المواطن وحاجياته تتطور بتغير دينامية المجتمع فإذا كان للمواطن حقوق مكفولة بالوثيقة الدستورية ف إن عليه واجبات كذلك منصوص عليها في الدستور. إن دمقرطة المجتمع لها إطارها التشريعي والقانوني فالمجتمع يخضع لسلطة القانون دون تمييز على أساس جغرافي أو عرقي أو ديني أو ثقافي . فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ,في حمايتها وتعزيزها والدفاع عنها, في مسؤولية مزدوجة بين الدولة كفاعل أساسي في الشأن العام من جهة وفاعلين غير رسميين وخاصة هيئات المجتمع المدني من جهة أخرى. لكن يبقى سؤال المسؤولية المعنوية يطرح بشكل دائم كلما تعلق الأمر بدراسة الحق في المواطنة والذي يعد الآلية الأساسية لأي تطور المجتمع والدولة على حد سواء. إذ أن عولمة هذا الحق , تعيد ترتيب أولويات النظام السياسي في أدواره ووظائفه , علما أن الحق في المواطنة يكتنفه بعض الغموض خاصة عندما نتحدث عن مجتمعاتنا العربية والتي هي في غالبيتها تبحث عن بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية , والتضامن والعيش المشترك. أضحت مسألة المواطنة ضمن القضايا الملحة المطروحة سواء على مستوى الدول على المستوى العالمي في ظل المرحلة الراهنة من تطور البشرية والتي يطلق عليها اختصارا “ العولمة متعددة الأبعاد” , فتعدد زوايا دراسة موضوع المواطنة والديمقراطية, يطرح إمكانية مناقشته انطلاقا من المواطنة بين التكريس الدستوري ومطلب بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات . إلى ترسيخ المبادئ الأساسية للديمقراطية وعلاقتها بالمجتمع
أولا : المواطنة بين التكريس الدستوري ومطلب بناء دولة القانون والمؤسسات:
مما لاشك فيه , أن سياق الأحداث التي اجتاحت المنطقة العربية ,موازاة مع الانتفاضة المجتمعية في أرجاء الجمهورية التونسية, جعلت مفهوم المواطنة يحظى بقسط كبير من الاهتمام من طرف المواطن من جهة , ومن النظام السياسي من جهة أخرى. ففي ظل هذا المتغير , ومع الإلحاح الكبير لفئات عريضة للمجتمع , خاصة في ساحات الاحتجاج, بكل من تونس وبعد ذلك مصر, كان من اللازم الاستجابة لكل هذه المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية , في شكل إصلاحات سياسية ومؤسساتية ودستورية. فعلى مدى سنوات من الإصلاح المؤسساتي في المغرب , بدأـ هذه المؤسسات بإدماج الآليات الديمقراطية في برامجها وإستراتيجيتها لتحقيق نوعا من المصداقية السياسية. وهنا يتجلى النموذج المغربي , القائم دوما على تلازم الديمقراطية والتنمية, و على نهج متطور في الحكم , مؤسس على التفاعل الإيجابي مع الدينامكية البناءة للمجتمع المغربي, ومع التحولات الجهوية والدولية , وذلك بإرادة سيادية خالصة وعمل تشاركي وجماعي متواصل , وانفتاح على المستجدات العالمية . هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتم إلا بالترسيخ الدستوري للمواطنة بالإضافة إلى المواطنة كآلية من آليات مأسسة دولة الحق والقانون والمؤسسات .
أ ـ الترسيخ الدستوري للمواطنة: إن البعد التاريخي والسوسيولوجي للمواطنة , مر بعدة مراحل في التاريخ الحديث , حيث تأثر بوجهات نظر مختلفة ,منها على الخصوص النظرة الفلسفية للمواطنة في الحكم في مدينة أثينا واسبرطة, هذا من جهة , في حين أن التوجه الدستوري والقانوني لمفهوم المواطنة تأثر بأفكار كل من جون” جاك روسو” و”هوبز” و”جون لوك”, فيما كان يسمى العقد الاجتماعي , إضافة إلى الإضافة النوعية للمنظر الأول في مجال فصل السلط “مونتسيكو”. ففي سياق الحديث عن هذا المفهوم ,فإن ما شهدته المنطقة العربية من أحداث واحتجاجات لامست بشكل مباشر وغير مباشر مسار البحث عن تحديد واضح للمواطنة في علاقته بمجالات مختلفة لها علاقة بالشأن العام. فالمسار الأول طبع النموذج المغربي في الترسيخ الدستوري للمواطنة إضافة إلى دستور تونس .
النموذج المغربي في ترسيخ المواطنة :
يعد خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011, منعطفا متميزا في التاريخ السياسي الحديث للمملكة, وخاصة فيما يتعلق بقراره إجراء تعديل دستوري شامل’ يستند على سبعة مرتكزات أساسية , منها, تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية ,في نطاق تعددية حقيقية ,وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية , والمجتمع المدني, دسترة هيئات الحكامة الجيدة , وحقوق الإنسان , وحماية الحريات ولما كان للمواطن حقوقا سياسية متعارف عليها دوليا , وفي إطار المساواة أمام القانون فإن المشرع الدستوري المغربي جعل من تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي , وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية, وفي تدبير الشأن العام مسؤولية الأحزاب السياسية .فالحق في المواطنة يستدعي الحديث عن الألية الحقوقية ثم الآلية الدستورية .
أولا : الآلية الحقوقية يؤكد الدكتور محمد أحمد العدوي على أن مسألة المواطنة أضحت ضمن القضايا الملحة المطروحة على مستوى الدول أو حتى على المستوى العالمي في ظل المرحلة الراهنة من تاريخ تطور البشرية والتي يطلق عليها باختصار “العولمة المتعددة الأبعاد” , حيث أن المواطنة علاقة تبادلية للحقوق والواجبات المختلفة بين المواطن ودولته , وتتضمن المساواة وسيادة القوانين وقيام الدولة بتطبيق العدل في مؤسساتها وسياساتها على جميع المواطنين. ويرى “ديلانتي” أن المواطنة تتكون من أربع عناصر : الحقوق و المسؤوليات والمشاركة والهوية.
في مقابل ذلك ,فالفقيه “سيمور” “مارتن ليبست” , ربط المواطنة الحديثة بنمو قيم وسياسات السوق في إطار شمولي ألا وهو الليبرالية .
لذلك يجب التأكيد على أن الآلية الحقوقية مدخل أساسي لفهم المواطنة وفي سياقها المغربي
فالخيار الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ تساوي المواطنين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومواقعهم الاجتماعية وعقائدهم الدينية في الحقوق والواجبات الوطنية, وعلى مبدإ حق المواطن في المشاركة في صنع القرار السياسي ومسؤولية تطوير وتوجيه الفاعل في القيادة السياسية عن قراراتها وأفعالها أمام الشعب , تحول هذا الخيار مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين إلى ضرورة تاريخية ومطلب شعبي , وخرج عن دائرة المجال السياسي بين المثقفين والسياسيين
تبعا لارتباط المواطنة بالحقوق والحريات والقانون ,وبالتفاعل القائم بين السلطة والمواطنين ,فإنها ترتبط بشكل أساسي بالنسقين السياسي والاجتماعي, والتأثير المتبادل بينهما. فالنسق السياسي يستدعي الحديث عن الدور والوظائف التي يلعبها النظام السياسي في تطوير وتوجيه الفاعل في النسق السياسي , انطلاقا من الإستراتيجية المعلنة والمحددة سلفا, لكن مع الاحتفاظ على مع مفهوم السلطة في معناه العام لكن بالتقييد بالحكامة القانونية والتي هي مصدر القوة أي نظام يريد كسب الثقة من طرف المواطن. لكن هذا الاتجاه أو الأسلوب لا يكفي لتحقيق هذه الثقة في ظل نسق سياسي يتميز برهنات متعددة ومختلفة لا تستجيب للمطالب المشروعة للفرد والمجتمع على حد سواء ,لذلك وجب إدماج النسق الاجتماعي بكل تشكيلاته المجتمعية وتوجهاته ذات الرجعية التقليدية أو الحديثة , مما يجعل من الأفيد التقيد بالحقوق والحريات المعترف بها في القانون في شكل قواعد ومبادئ قانونية لا تتجاوز المبادئ الدستورية . فإذا كانت المواطنة تقوم على الاعتراف بالحقوق والحريات , وإقرار الالتزامات التي تتأسس انطلاقا من البنية الفوقية للدولة وإنتاجياتها ,فإن توطيدها يتوقف على مدى ترسيخ هذه الحقوق والحريات في المجتمع والعمل بها , كما يؤكد على ذلك الدكتور محمد الرضواني هذا الجانب من المواطنة من منطلق يؤسس لثقافة الحق فالاعتراف الآلية الحقوقية من جهة, ويمنح مفهوما جديدا من الصعب تحديده وتقييمه ألا وهو المسؤولية المعنوية للشخص العام, وتحديدا الدولة والجماعات الترابية والهيئات والمؤسسات العمومية , نظرا لأن تجزيء المسؤولية المعنوية للدولة خارج النص أو الوثيقة الدستورية يؤدي بالضرورة إلى تشتيت المسؤولية في مواجهة السلطة أو بالأحرى ممارسة السلطة على المستوى الترابي التراتبي. فهذا التحول يلاحظ في الدولة ,مثل المغرب, نظرا للتغير الجوهري الذي طرأ في الوثيقة الدستورية ,مع تكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي تكتيكي في ممارسة السلطة وإعادة انتشار الدولة مع منح اختصاصات وصلاحيات الجهة. فلا يمكن تصور سلطة وممارسة السلطة في غياب المواطن, إن المواطن وفي إطار التعاقد ,سواء أكان اجتماعي أوسياسي ,يمنح الشرعية و المشروعية للفاعل في الشأن العام ممارسة اختصاصاته وصلاحياته ,خدمة له أي تقديم الخدمة العمومية أو المعنوية في إطار احترام القانون وسيادة الثقافة الديمقراطية. إذا كانت المواطنة الحديثة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وتدل بذلك على علاقة مادية ورمزية تجمع بين الدولة والمجتمع. فإن مفهوم المساواة يكتسي صبغة قانونية أي له دلالة قانونية ودستورية تختلف عن المفهوم الاقتصادي والاجتماعي المؤطر بالحقوق الأساسية في معناها العام .
والواضح أن ثنائية المواطنة وحقوق الإنسان في منظومة موحدة عند توافر الشروط الموضوعية لذلك, ومن بينها ,سيادة القانون ,والتداول السلمي على السلطة واحترام التعددية الحزبية والسياسية من طرف النظام السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة عندما لق الأمر بالحكامة السياسية كآلية لتوطيد الممارسة السياسية والانفتاح السياسي .
ونظرا لأهمية الفرد في إشكالية المواطنة,سواء كموضوع أو كفاعل, وتبعا لارتباط المواطنة بمجموعة من المرتكزات السياسية والقانونية والاجتماعية ,فإنه يمكن التسليم بارتباط المواطنة ببنياتها السياسية ومكوناتها .
ففي نفس السياق ,لابد من جعل هذا الارتباط النسبي,لأنه ومع الانفتاح التكنولوجي والانفجار ألمعلوماتي وبروز تأثير العالم الافتراضي بفعل العولمة بمختلف أبعادها ومستوياتها, فإن المواطن أصبح يتأثر ويؤثر في مجريات الأحداث , سواء على المستوى المحلي والجهوي والوطني من جهة أو على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي من جهة ثانية .فالمواطن”المعولم” يستمد قوة فعله ورد فعله من خلال انخراطه في هذا العالم الافتراضي الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية التقليدية , ولا يخضع إلا للقانون المحلي لدولته, فيتطاول على قوانين دول أخرى , قد يرتكب جريمة في بلد ما دون أن يكون هنالك واقعيا , إننا أمام تحديات جديدة ,تستلزم الأخذ بالأمن الإنساني في كل تنويعاته وأشكاله , مع الحرص على تحصين الأمن الرقمي ليواكب دينامية المجتمع الواقعي والافتراضي على السواء .
إذ أن الحق في الولوج إلى خدمات الشبكات العنكبوتية, يستلزم الحرص على احترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل سواء الوطنية أو العالمية, إن هناك حد أدنى يجب احترامه , فهذا الحق مضموم لكن يوازيه ويقابله الواجب في إطار الالتزام والمسؤولية المواطنة والحق في المواطنة ,وهي بالأساس مشاركة فعالة تدمج الحق بالواجب والالتزام بالمسؤولية, علما أن البعد الهوياتي للمواطنة يشكل بدون شك مدخلا أساسيا لفهم وتحليل وحتى انتقاد الحق في المواطنة .
إن اعتراف النظام السياسي , للمواطن بكامل حقوقه ,دون تجزيء ,يعد انتصارا لثقافية حقوق المواطنة, التي لاتعني فقط رابطة الميلاد والجنسية ,بل تتعداها إلى تحقيق معايير ومؤشرات تعتمدها أغلب التقارير سواء المحلية والوطنية أو العالمية.
ففي السياق نفسه فإن للمواطنة أسسا متعددة, ترتبط في مستواها الترابي التراتبي بمسألتين غاية في الأهمية :
المسألة الأولى : فتتعلق بشرعية النظام السياسي ومدى مشروعية السلطة في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والتي يكون فيها المواطن العنصر الأهم وذلك من خلال ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة .
المسألة الثانية : فتتمحور حول مساهمة المواطن الذي يتمتع بكل حقوق المواطنة في الشأن العام في مستواها الوطني أو الجهوي أو المحلي .
إن سياق تبني دستور المملكة المغربية الجديد, يتميز بعدة دلالات فالأولى , تعيد رسم التعاقد الجديد بين المواطن والدولة ,والثانية تدمج حقوق المواطنة كاملة والثالثة تؤكد على ثنائية الحق والواجب في علاقته بالقانون. فالاعتماد على مدخل حقوق المواطنة يكتسي أهمية كبرى في سياق دمج المواطن في مجاله العمومي. فإذا كان المجال العمومي, متحكم فيه من طرف سلطة محددة أو مجموعة من السلطات ,فإن منطق التجاوزات يبقى حاضرا , ومن هذا المنطلق فإن أهمية سيادة القانون في هذا الفضاء العام,يكون أشمل وأفيد نظرا لمعطيين أساسين, إذ يعتبر الحق ركيزة أساسية في استغلال الفضاء العام بصفة فردية أو جماعية من طرف المواطن, من جهة في المقابل ذلك الحضور القوي للحماية القانونية للحق أو لمجموعة من الحقوق تبقى مرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التمكين الحكماتي لممارسي السلطة في المستوى الترابي التراتبي رغم تعدد المتدخلين والفاعلين. فالنظام السياسي المغربي, جعل من المواطن ,صلب اهتمامه,لسببين أساسين : يعد السبب الأول استراتيجيا,حيث لا يمكن تأسيس ما بات يعرف بدولة الحق والقانون والمؤسسات إلا,بإدماج كامل لمجموع الحقوق والحريات يعترف بها عالميا مع الخصوصية المثبتة في الدستور المغربي لسنة 2011. أما السبب الثاني فيتعلق بما هو برغماتي, في إطار ترسيخ حقوق المواطنة بشكل ترابي تراتبي سواء تعلق الأمر بالوثيقة الدستورية , أو القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية . فهناك من يربط أزمة الديمقراطية بأزمة المواطنة, إذ أن هذا الافتراض قد يكون صحيحا في جانب وغير ذي مصداقية في جوانب متعددة , خاصة إذا أخذنا الإشكالات التي تعيق الممارسة الديمقراطية في الدول الغربية ,فالمواطنة بمعنى لا يمكن أن تنجح إلا في ظل نظام سياسي يعترف ويؤمن ويسعى لتطبيق الديمقراطية بمعنى الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية والتعددية الحزبية ومشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام إما بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك فإنه لا يكفي التنصيص على المواطنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها في الدستور لنقول بأن الدولة ديمقراطية , بل المواطنة هي ألية من الآليات يجب إدماجها في سياسات عمومية مندمجة للتمكين الديمقراطي والحكماتي وفي إطار تفعيل القرار التنموي سواء على المستوى المحلي أو الوطني. فالبرغم من التضخم الحاصل في الترويج لمفهوم المواطن والمواطنة في الوثيقة الدستورية لسنة2011, مقارنة مع ما تم التنصيص عليه من طرف المشرع الدستوري في دستور 1996, إلا أنه يلاحظ أن هناك علاقة بين المواطنة كواجب و مواطنة كحقوق في سياق التراتبية والأبعاد والمجالات .
إن قيام دولة حديثة لا يتجسد في القطع مع الممارسات التقليدية للنظام السياسي, بل هو إدماج حقيقي لمفاهيم كونية لدولة الحق والقانون والمؤسسات ليس فقط في الوثيقة الدستورية بل في الإمكانات والقدرات التي يملكها النظام السياسي في تحديث آلياته عبر المدخل المؤسساتي إضافة إلى مدخل السياسات العمومية .
أولا: المدخل المؤسساتي: لم يجد المواطنون المغاربة الطريق معبدة, لتكوين دولة ديمقراطية, بعد حصول المغرب على الإستقلال إذ أن الحياة السياسية المغربية مرت بأربع مراحل أساسية :
- المرحلة الأولى : امتدت من دجنبر 1955 إلى 1962
- المرحلة الثانية : فابتدأت من 1963 إلى غاية 1974
- 1975 إلى 1974 من المرحلة الثالثة إلى 2000 1992من أما المرحلة الرابعة
لقد شهدت المرحلة الأولى ,إرساء الأسس العصرية والسياسية للدولة المغربية, إذ شهدت صدور القانون الأساس للمملكة في يونيو 1961وظهور أول دستور في 14 دجنبر 1962, في حين تميزت المرحلة الثانية بصدور دستورين , الأول في 31 يوليوز 1970 الذي اعتبر بمثابة دسترة لحالة الاستثناء , والثاني في 10 مارس 1972.
أما دستور 4 شتنبر 1992 جاء بالعديد من التغيرات همت الحكومة ومؤسسة البرلمان, واستمر مسلسل الإصلاحات طيلة سنوات التسعينات, حيث جاء دستور 1996 ببعض التغيرات, مع الاتفاق حول حكومة التناوب في 14 مارس 1998. إن هذه الكرونولوجيا المختصرة حول موضوع تبني الدساتير في المغرب, تؤكد عدة حقئق أساسية :
- المعطى الأول : أن دساتير المغرب السابقة لم تصمد من حيث الزمن إلا لسنوات قليلة .
- المعطى الثاني : أن الصراع على الوثيقة الدستورية ,هو صراع في الحقيقة داخل المجتمع السياسي والاقتصادي المغربي .
- المعطى الثالث : هو أن التوافق على الدستور في المرحلة السابقة هو توافق تكتيكي ـ براغماتي ـ وليس استراتيجي
- المعطى الرابع : أن التوافق على الدستور في صياغة غاياته وآليات اشتغال مؤسساته هو توافق سياسي وليس اجتماعي ,علما بأن المجتمع المدني كان مغيبا نظرا لغياب الإرادة السياـسية للفاعل في الشأن العام لإدماجه , وغياب الآليات التشريعية والقانونية .
من خلال قراءة تحليلية لهذه الحقائق , لا يمكن أن نسقطها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي, في قراءة الدستور في علاقته بالديمقراطية .
الخيار في المغرب , خيار الديمقراطية لا رجعة فيه بالنسبة لكل الفاعلين سواء رسمين أو غير رسمين .
لا يمكن للمتتبع للحقل السياسي في المغرب ما بعد الاستقلال إلا أن يقر بوجود صراع على السلطة , بدء بما وقع بين مجموعة الحركة الوطنية والتيارات فيما بينها, في فترة من فترات التنافس والتدافع لممارسة السلطة , بحثا عن المشروعية والتموقع في الساحة السياسية.
وقد مر التنافس الإيديولوجي والصراع السياسي بفترات بلغ العنف والعنف المضاد ذروته, مباشرة أو عبر وسائط من خلال صراع شرس أحيانا جعل الحقل السياسي يستقطب كل الاهتمام وينعكس على كل المجالات ,إلا أنه ابتداء من سنة 1975 أخذ منحى الاعتراف التدريجي المتبادل , والاعتراف بفضيلة التعايش والقبول الشكلي بالإختلاف يفرض نفسه في الساحة بعد الحسم النهائي في مسألة السيادة العليا وشكل النظام السياسي ملكية دستورية. فالحقل السياسي المغربي, تميز في تلك الفترة بالحركية والدينامية أفرزت تجديدا للنخب السياسية والحزبية كان لها من الوعي ما يجعلها قادرة على فهم الواقع السياسي المغربي في الدمقرطة وإقامة المؤسسات والتحديث والتنمية , وبناء الدولة العصرية.
مدخل السياسات العمومية:
يعتبر مبدأ فصل السلط من أهم المبادئ التي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011, إذ يتم بموجبها سيادة مبدأ احترام القانون في ممارسة السلطة سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية ,إضافة إلى عدم التعسف في استعمال السلطة من طرف أي جهة كانت .
فالنظام السياسي المغربي أضاف إلى قدراته التقليدية القدرة على إدماج فصل السلط في ممارسة الشأن العام , مما يمنح وظيفة أساسية ألا وهي وظيفة الانتقال سياسي مغلق إلى نظام سياسي حداثي منفتح. ففي سياق هذا الانفتاح, فإن المشرع الدستوري المغربي ,جعل من السياسات العامة للدولة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية, مفاهيم مدسترة وذات أولوية بالنسبة للسلطة التنفيذية. ينص الفصل 92 من دستور المملكة المغربية على : « يتداول مجلس الحكومة,تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا والنصوص التالية :
- السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري.
- السياسات العمومية.
- السياسات القطاعية.
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصل الحكومة تحمل مسؤوليتها.
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام.
مشاريع القوانين , ومن بينها مشروع قانون المالية, قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور
- مراسيم القوانين
- مشاريع المراسيم التنظيمية
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 الفقرة الثانية 66 و70 الفقرة الثالثة من هذا الدستور
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري
تعيين الكتاب العاميين ,ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية, ورؤساء الجامعات والعمداء, ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور , أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة .ويحدد هذا القانون التنظيمي , على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف ,لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
انطلاقا من هذا الفصل يمكن رصد عدة ملاحظات, فأما الملاحظة الأولى تتعلق بصعوبة تحديد مجال السياسات العامة والسياسات العمومية , نظرا لوجود ترابط وتكامل بينهما, لكن السياسات القطاعية تتعلق بكل قطاع على حدى
الملاحظة الثانية فتنسجم مع التوجه القائل بأن البرنامج الحكومي هو آلية من آليات تنفيذ السياسات العمومية للحكومة.
إذ كان لزاما على المشرع الدستوري المغربي تخصيص فصل كامل في هذا الشأن نظرا لأنه لا يمكن إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلا من خلال الفعل والتفاعل مع متطلبات المواطنين والمواطنات, لهذا نص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه : ويعرض البرنامج الذي تنوي الحكومة القيام به, في مختلف مجالات النشاط الوطني, وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والخارجية .
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه, موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين, يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة المجلس النواب, العبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم, لصالح البرنامج الحكومي .
الملاحظة الثالثة : وهي عبارة عن سؤال من تحمل المسؤولية السياسية للحكومة في حال عدم تفعيل وانجاز البرنامج الحكومي ’في ظل أن مكونات الحكومة في المغرب’ تضم أحزابا متعددة ’ علما أن حكومة السيد عبد الإله بنكران ’ضمت أإربع أحزاب في نسختها الأولى والثانية , لكن عشية إجراء الانتخابات التشريعية لسابع من أكتوبر 2016 لم تتمكن هذه الحكومة بالتصريح بحصيلتها وهو ما عزاه بعض الباحثين والأكاديميين إلى عدم الانسجام الذي كان حاصلا في الفترة الانتدابية والاختلاف حول منهجية العمل, مع الصعوبات التي اعترضت الحكومة الأولى وتوجه إلى المعارضة.
الملاحظة الرابعة : أن النظام الانتخابي في المغرب لا يتيح لحزب واحد تشكيل الحكومة لوحده, لذلك يلجأ الحزب المرتب لأحزاب أخرى لتشكيل الحكومة, مما يؤدي غلى صعوبة تنفيذ برنامجه الانتخابي إذ يجب أن يراعي البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للغالبية ,مما يجعل البرنامج الحكومي المزمع تنفيذه لايحمل التغيير اللازم وإرادة الناخبين بشكل واضح.
فالسياسات العمومية ,تحتاج غلى فاعلين رسميين وغير رسميين لذلك فالفاعل الرسمي له الترسانة التشريعية والقانونية والإجرائية والفنية ,أما الفاعل غير الرسمي ,يحمل مشاريع ومقترحات ,تساهم في الاقتراح والإعداد والتنفيذ والتقييم لأي سياسة عمومية .
أولا : التمكين الديمقراطي في السياسات العمومية:
مما لاشك فيه ,ان المسار الديمقراطي في البلدان العربية مسار طويل وشاق نظرا لتعقد فهم ماذا تريد الأنظمة السياسية من المجتمع والمواطن من جهة , وماذا يريد المواطن من النظام السياسي الحاكم من جهة ثانية.
فإذا كان الحق في الديمقراطية هو مسؤولية مزدوجة بين النظام السياسي من جهة والمواطن من جهة ثانية, فإن توظيف هذا الحق في اي مشروع مجتمعي يعد بحق ألية من أليات تطوير الوظائف والأدوار التنموية والأمنية لأي نظام سياسي ,لكن في المقابل ذلك فالسياسات العمومية في المستوى الماكر وحكماتي, تعيد طرح السؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة في نجاح أو فشل الاستراتيجيات والخطط والتي تهدف إلى تعزيز وحماية الخقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها وكما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية .
فدسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية, يستدعي بالضرورة الحديث عن معطيين أساسيين ,فأما المعطى الأول فهو سؤال الاستقلالية في اتخاذ القرار وسيادة القانون ,أما المعطى الثاني فيتعلق بقدرة الفاعل في الشأن العام بتنزيل هذه المقتضيات الدستورية وبلورتها في قوانين تنظيمية وعادية تحقق الديمقراطية كثقافة ومبدأ.
إن أزمة الديمقراطية التمثيلية تتطلب الحرص على مأسسة الديمقراطية التشاركية والتي لها مداخل دستورية وتشريعية وقانونية في مستوى أول, ورغبة من الفاعل في الشأن السياسي والشأن العام الترابي التراتبي في انخراط تام للمجتمع المدني في بلورة إستراتيجية تعتمد المشاركة والحكامة التشاركية في الديمقراطية التشاركية باحترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمؤشر من بين المؤشرات حكامة الجيدة.
فالتمكين الديمقراطي يحتاج إلى تنزيل سليم للمقتضيات الدستورية فالتمكين الديمقراطي يولد الإحساس بأن الأمن السياسي يمكن تحقيقه بتظافر الجهود من طرف السلطات الثلاث في إعمال الحكامة ومؤشراتها وأبعادها ,يؤدي بالضرورة إلى مزيد من الشرعية والمشروعية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي.
ثانيا : التمكين الحكماتي التنموي:
إن أي سياسة عمومية يجب أن تتوفر على مؤشرات ومعايير واضحة وذات بعد حكماتي, يتمثل أساسا في الرؤية الإستراتيجية وأن تكون قابلة للتنفيذ والتقييم مع توضيح الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالفاعل الرسمي والغير الرسمي في الاقتراح والإعداد والتنفيذ والتقييم, إضافة غلى المحاسبة السياسية والإدارية.
فالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنات والمواطنين في تزايد مستمر, تحتاج إلى حكامة سياسية في مقام أول وإلى إدماج البعد التنموي الترابي التراتبي , في إطار احترام الخصوصية للتراب وانفتاح المجال,فالإنصاف المجالي هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الإستراتيجية مع الاشتغال على تذويب الهوية الاجتماعية والثقافية في الهوية الوطنية لكي يتم ترسيخ المواطنة المسؤولية في مقام ثان .
- خاص – المركز الديمقراطي العربي